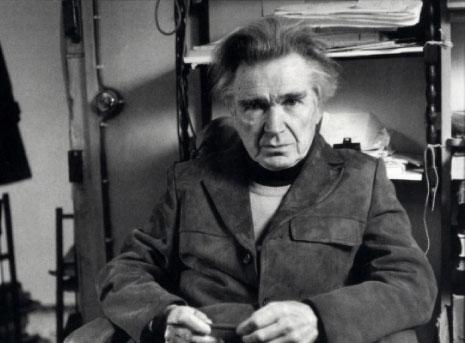طغيان المرئي: الثورة السورية نموذجاً
الصورة توّحد عالماً يميل نحو التمزّق
علي جازو
يشكّل تدفّق الصّور الهائل، وتسجيل مقاطع الفيديو، وبثّها المستمر، قوامَ الإعلام الجديد. وتترافق نشرات الأخبار، سياسية أو ثقافية أو رياضية، مع كمّ هائل من تسجيلات صورية تخاطب العين وحدها.
هكذا غدت الصورة جسمَ الخبر ومادته الأساسية، في الوقت الذي تجهد فيه الكلمة (الإعلامية) للحاق بالصورة والإحاطة بها، تعليقاً وشرحاً وتوضيحاً. وفي ظلّ هذا السيلان الصوري المذهل والمحير تتراجع القدرات السمعية بما تنطوي عليه من إصغاء وتدرج وبطء؛ فالصورة تعرض المرئي دفعة واحدة مختزلة الزمن “العادي” إلى كثافة آنية ضيقة وسريعة، حاملة الأمكنة إلى قربٍ يكاد يلمس يدَ المتفرج وعينه. لكنّ الصورة توحّد عالماً يميل نحو التمزق أكثر فأكثر، وهي بذلك جسرٌ من وهم، رغم كونها وثيقة تؤكد الخبر. على هذا النحو المربك يترافق التوثيق الخبري مع التمزيق النفسي، في وحدة بلا انسجام وتواصل بلا حيز، فالمكان المنقول، مع أحداثه وأخباره، عبر الفضاء السائل، ليس سوى مادة تتبخر تحت اليد “الواهمة” أنها تمسك إذ ترى، والعالم الذي يحضر بكبسة زر واحدة يكاد لا يشبه العالم الحقيقي في شيء؛ فالأخبار منتقاة، وهي لا تنقل سوى جزء مما يحدث، غير أنها بتركيزها على الجزء وحده تحوله إلى مادة كلية وأساسية وطاغية. إظهارٌ كثير مؤدّاه الفعلي إخفاءٌ أكثر. في عالم تطفو فيه الصور، هكذا، تشقى الكلمة خائفة من أن تغرق. لكأن السباق الحالي، المفروض على مجتمعات وثقافات بكاملها، صراعٌ يلهث بين الصوت الذي غدا أقرب إلى صورة، والصورة التي تكتم الصوت غير المرفق بها.
كانت الصورة من قبل نادرة، ووجودها مرفقة بخبر أو حادث أو مناسبة، عملت على جانب أساسي هو الحفظ والتوثيق. كانت بذلك وعاء الذاكرة ومادة الحنين التي تقيس أثر مرور الوقت على البشر والمدن والأشياء، لكن الصورة على ذلك النحو الحذر والبطيء كانت الدليل والذاكرة التي ترافق الدليل. كانت مهمة لأنها نادرة، كانت تقتنى وتحفظ، وليس لأي أحد أن يأخذ صورة أو يسجل حدثاً عبر التصوير وقتما يشاء. غير أن سيولتها الإعلامية خلال السنين القليلة الأخيرة، والمترافق مع تراجع القراءة إلى مستويات مخيفة، قد حولها إلى كابوس. وتطور الكاميرات الحديثة، جعلها سهلة الاستعمال ولا يحتاج مستعملها إلى كثير خبرة، فرصة مغرية لالتقاط صور كثيرة ومشاهد فيديو لا يمكن التفكير بإحصائها. لا يخفى هنا التأثير الدعائي إلى هكذا ميول، ولا يراعى لدى الكثير ممن يبث الصور الجانبُ الفني والذوقي والأخلاقي في هكذا عمل، ولا مدى التأثير الممكن الذي تخلفه هكذا صور وتسجيلات على ذوق الملتقي وإحساسه، وهو كسول بطبعه في مجتمع يحتل فيه التلفزيون كلّ مكان تقريباً.
يقال إن ثمة مليون قطعة مسجلة عن حوادث الثورة السورية، وهذا الرقم بحد ذاته مرعب، رغم أن النشطاء والإعلاميين السوريون اضطروا إلى الاعتماد على أنفسهم لتغطية وقائع الثورة السورية، وكان هذا الاعتماد بحد ذاته ميزة تفردت بها الثورة السورية دون سواها من ثورات الربيع العربي، وقد كسروا بذلك التعتيم الإعلامي الذي كان جزءاً أساسياً من مراقبة الخبر والحدث في سوريا المخنوقة بنظام كبتَ كل شيء. كبت توسلت به السلطة الديكتاتورية مراقبة صارمة بغية كتم الحقيقة والتلاعب بها، وتزييفها. غير أن الخطير، وغير الملاحظ ربما، أن الصورة الرقمية، التي هي وثيقة شديدة الأهمية من دون شك، تكاد تتحول، بسبب كثرتها، إلى مادة للنسيان. فالحدث نفسه يتحول من مجال الاهتمام والمراقبة والتسجيل التوثيقي، وبفعل مرور الزمن وحلول الجديد محل القديم، إلى مجال الفرجة اليومية التي سرعان ما تنسى في اليوم الآخر، وليس بغريب أن يكتب نشطاء “كفرنبل المحتلة” منذ أيام قليلة، على إحدى لوحاتهم الاحتجاجية المميزة، ساخرين وناقمين على قناة (الجزيرة مباشر) أنها تحول يوميات الثورة السورية إلى مادة شبيهة بما تبثه قناة روتانا طرب من حيث كونها مادة للسهر وقضاء الوقت. ربما كان هذا سبباً خفياً للجوء كثير من السلطات إلى بث تسجيلات معينة في أوقات محددة. هي إذن طريقة في التلاعب بالعقول والمشاعر والميول العامة. فالصورة لكثرة ما تعرض تفقد دلالتها، ثم انها تتحول، خصوصاً صور العنف والقتل الهمجية والمفزعة، من دائرة الرفض والإدانة إلى مجال الألفة والاعتياد، فالناس لكثرة ما رأوا أناساً يضربون ويعذبون، لكثرة ما شاهدوا الإهانةَ جثثاً تنزف في الشوارع، وموتاً في الطرقات ودماء تسيل، اعتادوا عليها. إن عادات خطيرة تنشأ على هذا النحو، إذ يتحول الكائن الإنساني إلى رقم، وينقلب الإحساس بالألم الهائل إلى مجرد متابعة لإحصاء يومي عابر.
الصورة الحديثة لذلك، ربما، لم تعد فاعلة “نزيهة”، لم تعد حاملة رسالة قدر ما تحولت إلى وسيط مادي صرف. إنها أشبه بممر أو نفق تتراكم فيه صورة فوق صورة حتى تتحول إلى جبل يحجب الرؤية في الوقت الذي تدعي فيه أجهزة الإعلام إنها عينُ المشاهد ودليله إلى العالم الذي غدا تحت اليد ببساطة ويسر، لكنه خرج من حيز الفاعلية النشطة إلى قفص الانفعال المتيبس. الصورة الحديثة إشارة إلى زمن العزلة. والأمر الأخطر من هذا وذاك، أن الصورة لم تعد دافعة إلى الفكر والنقاش. ذلك أن انتقالها من حيز الاهتمام الخاص إلى حيز الفرجة الجماهيرية حولها إلى سلعة ومادة للعرض العمومي، مع ما يعنيه ذلك من تحول قيمة الخبر ومدى رصانة التحليل وأثر الإعلام كله، في هكذا حال، إلى نوع من البيزنس والاستهلاك. وليس غريباً عندها أن ترى بين عرض ينقل جثة قتيل أو تشييع رفاة شهيد، فاصلاً “قصيراً” يتم الإعلان فيه عن جهاز موبايل جديد أو مكيف حديث أو نوع فاخر من الشوكولا. ترى بأي ضمير مهني يتم كل ذلك: انتقال “عادي” من مرأى جثة الضحية إلى مذاق قطعة شوكولا، من القصف والتدمير، إلى “ثلاجة لكل المهنة نفسها هنا إلى عمل آلي محض. ومع هكذا ديناميكية متسرعة ولاهثة ولا مبالية، حيث يجب ملئ الوقت كيفما كان بما هو متوافر، وللأسف هو غزير ومتجدد. كيف يمكن للفكر الإنساني أن يجد مكاناً فاعلاً، إذا كانت كل الأمكنة، كما يعرضها الإعلام التلفزيوني الشره، قد غدت محض صور، تحل محلها صور أخرى إلى ما لا نهاية. لكأنّ زمن الصورة “المزدهر” هو زمن عزلة قاسية، فلا شيء مما يحدث في سوريا يصل إلى أحد، رغم أنه يصل إلى الجميع، طالما أن المتفرج ليس سوى متفرج في النهاية. تقول الصورة: ألم ترني؟ يردّ المتفرج الذي أصبح لا أحداً وكلّ أحد في آن واحد: أراكِ وأنساك معاً. أن تتفرج، فقط، أن يحولك الخبر المرئي إلى متفرج لا غير، إنما يحملك من حيث لا تدري إلى أن تغدو بدروك صورة، مادة للعرض.
المستقبل