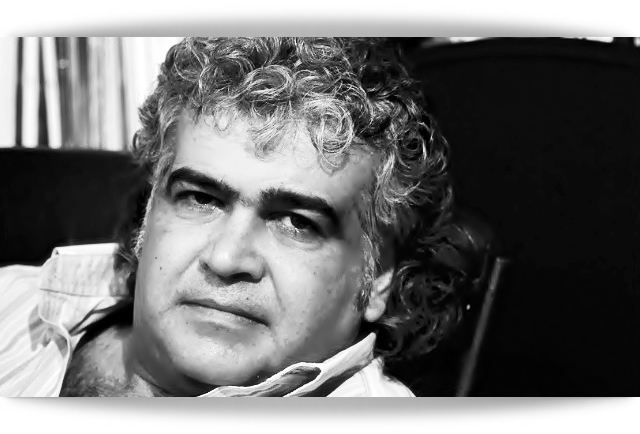طلال ديركي: فاجأني الأميركيون في صندانس

راشد عيسى
“العودة إلى حمص” هو برميل بارود سينمائي وسط الجبهة. هكذا وصف الناقد الأميركي ويزلي موريس فيلم المخرج السينمائي السوري طلال ديركي لدى عرضه أخيراً في الدورة الثلاثين لمهرجان “صندانس” الأميركي للسينما المستقلة، حيث نال الجائزة الكبرى لأفضل فيلم وثائقي أجنبي. يدور الفيلم حول شخصية حارس المرمى الحمصي عبد الباسط الساروت، الذي انضمّ إلى تظاهرات مدينته ضد النظام السوري، وقادها وكان من أبرز مغنّيها. لكن الفيلم لا يتوقف عند ذلك، بل يحاول تقديم صورة المدينة المحاصرة المدمّرة، التي تشكّل نموذجاً لحال البلاد كلها اليوم. هنا حوار مع طلال ديركي بعد تسلّمه الجائزة..
– أين عرض الفيلم حتى الآن، وكيف تنظر إلى ردود الفعل حوله؟ هل فاجأتك؟ هل توقّعتها؟
العرض الأول للفيلم كان في افتتاح مهرجان “أدفا” – هولندا. وكانت حالة نادرة أن يختار المهرجان العريق للأفلام الوثائقية فيلماً عربياً للافتتاح. ردود الفعل مفاجئة أكثر من المتوقع. الجمهور كان محبّاً، لكن في المقابل هناك موضوع الدين والإسلاموفوبيا، الذي ما زال معشّشاً في عقول الكثير من الأوروبيين. ما فاجأني أكثر هو المواطن الأميركي في عروض “صندانس”. ذلك المواطن الذي لا يملك أي خلفية واضحة عن السوريين أو عن ثورتهم. فوجئت بالعشرات بعد كل عرض، يهمّون لعناقي ويعتذرون عن حكومتهم، يبكون ويسألون عن حال حمص وأهلها، بعضهم يقول لقد ضحك الساسة علينا.
– الإسلاموفوبيا هي ما حرم الفيلم من الحصول على جوائز في ذلك المهرجان؟
تماماً. في “أدفا”-هولندا، وصلني شعور أنه من غير الممكن تكريس بطل ذي خلفية مسلمة يردّد كلمة الله طوال الوقت. كان ذلك على ما يبدو عائقاً أمام لجنة التحكيم هناك. هذا الشعور وصل أيضاً لمنتج الفيلم الألماني هانز روبيرت أيزنهور. لكن في “صندانس” حسمت اللجنة أمرها لمصلحة حصول الفيلم على الجائزة.
– لم يعرض الفيلم منذ تاريخ إنتاجه إلا في مهرجانات، ألا يفترض بفيلم يدعم الثورة أن يجد طريقه إلى جمهور الثورة، وإلى الجمهور السوري عموماً المعني بما يجري في حمص وسواها؟ لماذا يكتفي الفيلم بأن يكون فيلم مهرجانات؟
يحتاج الفيلم في سياقه الترويجي للمهرجانات العالمية. إنه حلم يرافق أي فيلم. هذا تقليد معروف سينمائياً. لو كان العرض متاحاً في بلدنا لكان عرضنا الأول في دمشق، وفي حمص طبعاً. لكنني أتحضّر لتقديم عروض عدة في الداخل السوري المحرّر، الشهر المقبل. في المقابل، أنت تعرف أن تسريب الفيلم عبر الإنترنت يعدّ مخالفاً للعقود مع المحطّات والمنتجين للعمل، وإن حدث ذلك فإن فرص عرض الفيلم على المحطّات ستعتبر ملغاة بحكم أن الفيلم قد سرّب وعرض. ومن ناحية أخرى فإن ذلك يعرّضنا كسوريين مع شركاء ألمان للمحاسبة، ما سيؤثر سلباً في دخول السوريين بمشاريع سينمائية مع الأوروبيين.
– ليس “العودة إلى حمص” فيلمك الأول، لديك أفلام قبله، لكن يبدو كأن هذا الفيلم بالذات هو بداية مسيرتك، ما قد يعني أيضاً أن الثورة هي التي أطلقتك مخرجاً. ما تعليقك على ذلك؟ ما الذي توفّر في الفيلم ليجعل منه تلك الانطلاقة؟ كيف تقيّم تجربتك السينمائية سابقاً؟
“العودة إلى حمص” هو فيلمي الطويل الأول. أخرجت أفلاماً قصيرة قبله مثل “رتل كامل من الأشجار” و”بطل البحار” وبعض الأفلام التلفزيونية الوثائقية. تجاربي السابقة تفتقر إلى العناصر اللازمة لإنجاز فيلم سينمائي. لذلك فقد اعتمدت في “بطل البحار” على تمويلي الخاص، وتأخر إنجاز الفيلم سنتين، وقد أوقفت عرضه مع بداية الثورة. أما فيلم “رتل كامل من الأشجار” فهو من أسوأ تجاربي المهنية، نفّذته “المؤسسة العامة للسينما” ودخلتُ فيه برهان خاسر حين قبلت شروطهم بأن تحذف من نصّي ثمانية مشاهد من أصل تسعة. أتحمل المسؤولية حينها، كان عليّ أن أنسحب وأنتظر فرصة أفضل وثقة أكبر. هو في النهاية فيلم قصير لا يتجاوز التسع دقائق، استخدمه مدير المؤسسة الفاسد حينها كوثيقة للتشهير بي، وساعده حينها الكثير من الصحافيين التابعين لمؤسسته. في ما يخصّ الشقّ الثاني من سؤالك، نعم لولا الثورة لما كان الساروت ولما كانت حمص ولما أخرجت فيلماً عنها. لولا كاميرات الموبايل التي حملها الشباب لما كانت أيضاً الثورة. الثورة والسينما ونحن جزء لا يتجزأ. هذه بلدي وهؤلاء أهلي، ولا أحد غيرنا يستطيع أن يدفع الحزن والألم عنّا. لذلك أجد السينما وسيلة للخلاص والبقاء. السينما التسجيلية طريقة لتصحيح التاريخ.
– هل تجد أن الهدف التعبوي، التحريضي هو واحد من أهداف الفيلم؟
الفيلم منحاز بامتياز، ويدور حول شخصية تعتبر بطلة. لا مكان للشعارات والبطولات في الوقت ذاته. الفيلم عن الإنسان السوري بالمطلق، هزائمه وانتصاراته. أن تقف مع شخوصك وحياتهم وموتهم هذا شيء معروف ومعتمد في المهنة، ولا يعني تعبئة أو تحريضاً. الطرف الآخر مثلاً غير متواجد عندي ضمن مساحة الغرف الضيقة أو حتى في ساحات التظاهر وفي الجبهات. هو قرّر أن يكون العدو البعيد. عموماً هذا مسعى قديم عندي، أن أنجز فيلماً تسجيلياً عن شخصية شعبية متمرّدة منفردة، وتفاجئك بأفعالها. رغبة قديمة في ظلّ الحكم الشمولي الذي يمنع ظهور أبطال خارج شخص القائد المفدّى.
– هل اخترت منذ البداية أن تكون مخرجاً تسجيلياً؟ ألا تجد في حكاية الساروت مادة غنية لفيلم روائي؟ هل فكرت بذلك، أعني بإنجازه كفيلم روائي؟
أثناء دراستي، وحتى بعد تخرجي وعملي، كان الفيلم الروائي مسعى وعشقاً بالنسبة إلي. دخلتُ صناعة الفيلم التسجيلي حديثاً في العام ٢٠٠٨، ربما بسبب غياب الإمكانية الإنتاجية لصناعة الروائي. لكنني أعترف أن صناعة الفيلم التسجيلي أعقد بكثير من الروائي، فخياراتك هنا مفتوحة على المجهول، أنت لا تملك السيطرة الكافية لا على شخوصك ولا على موقع التصوير. أنت شاهد ذكي على الحدث ويمكن أن تصبح جزءاً منه، كما يمكن أن تطرد نهائياً منه، بمعنى أن تأخذك لعبة الحياة والموت بعيداً. السينما التسجيلية لا تنتصر إلا بانتصار الإنسان وقيمه. أمامك الفرصة لأن تعيش ما عاشه عبد الباسط الساروت، بلحظاته الحقيقية ووجعه وقسوته، فكيف ترضى أن تصور ساروت مزيّفاً، يضع المكياج قبل التصوير ويعود إلى منزله بسيارته الفاخرة. هل كنت لترضى بذلك لو استطعت أن تكون مع الحقيقي؟ لو سألتني ما هو أفضل للسينما السورية حالياً وللإنسان السوري فسأجيب بثقة مطلقة الفيلم الوثائقي.
– هل تجد أن البلاد تشهد حقاً ربيعها الخاص على مستوى السينما؟ كيف يمكن الاستفادة من المناخ الجديد من أجل سينما مغايرة؟
البلاد تشهد ثورة سينمائية من دون شك. الدول العربية تصنع أفلاماً تحصد جوائز عالمية ومنها ما يرشح للأوسكار. السينما الفلسطينية أيضاً تشهد ربيعاً هو الأقوى بين الدول العربية. أنا متفائل بأن تكون السينما السورية بحجم الوجع واللحظة. كيف يمكن للسينما أن تغيب عن شعب تغيّر معظمه بالمطلق وتغيّرت حياته ومشاهدته وقناعاته؟ أن لا يرفق هذا التغيير بسينما يعني أن هناك مشكلة خطيرة بصدق.
– كيف تتعاطى مع الأفلام السينمائية التي تنجز في ظل النظام؟ هل توافق الحملات التي تجري من وقت لآخر لمنعها من المشاركة في مهرجانات عربية أو دولية؟
أنا لا أفهم كيف تنجز أفلام عن الحب والموسيقى والبساطة في ظلّ المجازر والدمار الممنهج والكراهية والحقد الذي صبّه النظام على الشعب السوري. كيف يمكن أن تنجز فيلماً وتتقاضى عنه مالاً ملوثاً بدماء أناس صادفتهم بحياتك، وأنت تتقاضاه لتغطّي على الجريمة. يا لهذا الانحطاط الأخلاقي!
– ماهي القيمة الفنية والسينمائية لهذة الأفلام أو لهذة المؤسسة، أسألك مجدداً؟
أنا شخصياً لو كنت مدير مهرجان سينمائي وجاءني فيلم من رواندا، لصالح مرتكبي مجازر التطهير العرقي فسأرفضه بالمطلق. مجدّداً كيف يمكن فصل الفن عن الأخلاق؟!
– ككردي، هل تجد أن لديك هاجساً ما لتقديم مأساة الأكراد كأكراد في سوريا؟
فيلمي التسجيلي القصير “بطل البحار” الذي بدأت به العام 2007 لم يكتمل حتى العام 2010، وهو عن هجرة الأكراد غير الشرعية من سوريا إلى أوروبا والتضييق المعتمد ضدّهم من نظام البعث. كان باللغة الكردية في الوقت الذي كانت فيه اللغة ممنوعة، كما هو حال أي تفصيل ثقافي آخر يخصّ الأكراد. في العام ٢٠١١ أنجزت فيلماً تلفزيونياً قصيراً بعنوان “آزادي” لمحطة “فرانس ٢٤” وهو عن الأكراد في الحراك السوري. أقولها لك بصراحة مطلقة، المأساة الكبرى الآن في حمص وحلب وريف دمشق ودرعا ودير الزور، وبصراحة أيضاً أنا ابن دمشق، أشعر بانتماء لحمص مثلاً أكثر من عفرين أو القامشلي، ذكرياتك هي التي تصنعك، لا الجينات الوراثية.
المدن