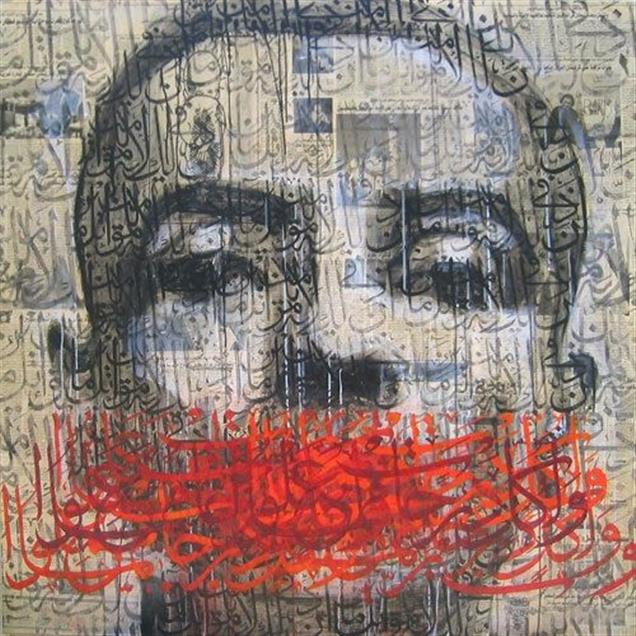على خط التماس

راتب شعبو
على الطريق يقف شاب بلباس الجيش بجانب خيمة مرتجلة من أغصان الشجر يلتجئ فيها حرّاس الطريق، وفي يده بارودة روسية. الملل بادٍ على وجهه، فنادراً ما تمرّ السيارات من هذا الطريق الذي يقع في منطقة تماس مع “المسلحين” (هكذا استقرت التسمية لدى السوريين الموالين بعدما تدحرجت طويلاً بين تسميات شتّى مثل “الجيش الحر” والإرهابيين والإسلاميين والعصابات والمعارضة المسلحة أو المعارضة وحسب). من البديهي أن القوات النظامية التي تقاتل هؤلاء “المسلّحين” مسلّحة هي أيضاً، غير أن تسمية هؤلاء بالمسلّحين تحمل دلالة على استنكار حملهم السلاح، فللجيش وقوات الأمن الحق في حمل السلاح، أما هؤلاء فإن حملهم للسلاح مخالف لطبيعة الأشياء ولذلك يكفي أن تعرّفهم بالمسلّحين.
القرية التي يوجد فيها هذا الحاجز شبه مهجورة، هدوء عام، الحركة شبه معدومة، والشاب الذي بلباس الجيش ينتظر بصبر فارغ انتهاء مناوبته.
حين تقترب السيارة يتقدم الشاب بتثاقل، ينظر في الوجوه ويعفينا من طلب الهويات، مشيراً إلينا بالمتابعة. لم يجد في السيارة علامات معادية. الطريق خالية تماماً من السيارات، المدرسة التي بجانب الطريق خالية من التلامذة، ومن الأولاد الذين يستغلون عادة خلوّ المدرسة كي يلعبوا في ساحتها. فقط الدجاجات التي تلتقط ما تيسّر لها من الأرض، والبقرة المربوطة بجانب أحد البيوت، تدل على وجود بعض الأهالي هنا. منذ أشهر دفن الأهالي هنا خمسة من أبنائهم في اشتباك مع “المسلحين”. حينها كان الحاجز هنا شبيهاً بثكنة عسكرية صغيرة. عدد كبير من العناصر وأرتال من السيارات وجمهرة من السائقين والركاب. كان الحاجز حياً لأن الحركة إلى الشمال كانت ممكنة، وكان يمكن عناصر الحاجز أن يمارسوا سلطة طارئة على العابرين. ولكن بعد المعركة التي استهدفت الحاجز تغيرت الحال. تم الاستغناء عن الحاجز واستعيض عنه بجبل من التراب. فإما مرور غير كريم عبر حاجز وإما لا مرور. البديل من الحاجز هو قطع الطريق بالكامل. لم تعد الخدمة على الحاجز مغرية. باتت واجباً ثقيلاً ومملاً.
منذئذ ترك معظم الأهالي بيوتهم وانتقلوا إلى حيث يمكنهم تدريس أبنائهم وإلى حيث الأمان، وتطوّع بعض شباب القرية لحماية البيوت من النهب. تسأل أحد هؤلاء المتطوعين: هل يهاجم المسلّحون القرية لنهب البيوت؟ يقول: لم يحدث ذلك، ولكن هناك من يسرق تحت ستار المسلّحين. ويبتسم ابتسامة دالة.
نمضي في طريقنا. غير بعيد من المدرسة نجد، إلى جانب أحد البيوت، رجلاً منهمكاً بزرع شتلات البندورة. وليس بعيداً منه، تتجه امرأة شابة صوب بيتها وعلى ظهرها جرزة من الحطب. وبضعة أولاد يلعبون في أرض مجاورة للطريق. آلة الحياة أبقى من كل المعوقات.
على الطريق الصاعد إلى القرية التالية، وعند تقاطع الطريق الاسفلتي مع السكة الحديد التي كان يعبرها يوماً القطار المتجه إلى حلب أو العائد منها، نجد مجموعة من الفتيان بلباس الجيش، يلتفتون إلى السيارة العابرة ثم يواصلون انشغالهم بإعداد النار. علامة عدم الاكتراث هذه، تمنحنا رخصة مرور.
في القرية التالية تبدو الحياة أكثر طبيعية. على رغم أنه لا يفصلها عن “المسلّحين” سوى واد عريض. البيوت مأهولة، والحركة نشطة. للسرفيسات مواعيدها إلى اللاذقية، ومنها. هنا اعتاد الأهالي على أصوات القصف التي تبدو كأنها واجب يومي يؤديه الجنود النظاميون قبل أن يخلدوا إلى الراحة. تمر القذائف في أجواء هذه القرية قبل أن تؤدي مهمتها في مكان ما على الجبل المقابل. بات الريفيون يميّزون أيامهم هنا باختلاف وتيرة القصف، ويستشعرون التبدلات السياسية منها أيضاً. تقول امرأة: “كان القصف اليوم أشدّ من أيّ يوم آخر، خير إن شاء الله، ما الذي حصل؟”، ثم تعبّر عن استيائها من القتال وعن تأففها من الطرفين، وتتساءل بضجر: “من أجل ماذا؟”. حين ينتهي الكلام، يكرر عجوز قوله: “لو بقيت سلمية، ولو كانوا يريدون الإصلاح حقاً، لكان الجميع معهم، لكنهم يقتلون ويخربون”.
وسط القرية نصبت خيمة عزاء لمواساة أهل “شهيد بطل” سقط في دير الزور في مواجهة “المسلّحين” من دون أن يتمكنوا من إحضار جثته. في الخيمة يقول فلاّح تقع أراضيه على السفح المقابل لمناطق وجود “المسلحين”، إنه يراهم يومياً ويرونه في ذهابه إلى أرضه وغدوه منها، ثم يعلّق مع ضحكة خفيفة: “لو أرادوا قتلي لقتلوني مئة مرة”. ويضيف: “لو أرادوا تهجير هذه القرية أو قتل أهلها لفعلوا، ما الذي يمنعهم؟”. غير أن هذه الكلمات لا تجد لها مكاناً في منظومة القناعات الناجزة.
بفتور، يدخل الناس خيمة العزاء ويخرجون متوجهين إلى بيوتهم بخطوات حائرة كنظراتهم. ولكن ثمة رجل يدخل بثقة ويقف في أول الخيمة وإلى جانبه رجلان أقل اعتداداً بنفسيهما. ينظر الرجل في وجوه المعزّين مليّاً ثم يسلّم على الجميع بصوت مرتفع. رجل في الخمسينات من عمره، متأنق ويحمل في يده مسبحة زرقاء يداعب حبّاتها بهدوء. يصافح الجميع ويجلس واثقاً كما دخل، ويتكلم بصوت عالٍ. يستفسر منه بعض من يعرفونه عن أشياء تتعلق بهموم خاصة. يردّ الرجل بثقة. يُطمئن حيناً ويقطع أمل السائل حيناً آخر. يشرب القهوة المرة ثم يترحّم على الشهيد وينهض بعدما جعل من نفسه لدقائق قليلة مركز اهتمام الخيمة. يبرر استعجاله بأن لديه تعزية أخرى في قرية ثانية. ينفرد قليلاً بوالد “الشهيد البطل”، ويصعد سيارته ويمضي. في الخيمة يدور الحديث عن سطوة هذا الرجل وعن فساده الذي جعل منه شخصية لها وزن. “لكنه يقف مع المنكوبين بفقد أبنائهم”، يُمِرّ أحدهم تعليقه وسط زحمة الحديث.
في طريق العودة تكون الحواجز أقل استنفاراً. نستعمل جهة واحدة من الاوتوستراد الموصل إلى اللاذقية، فالقنص الذي يمكن أن يستهدف السيارة من الجهة الغربية حيث يتمركز المسلحون في الجبال، ممكن على ما يقال. طريق العودة خالٍ كطريق الذهاب. أما على الحاجز الكائن في مدخل المدينة فإن الانتظار يطول بما يسمح لبائع قهوة أن يستثمر انتظار الداخلين وضجرهم.
النهار