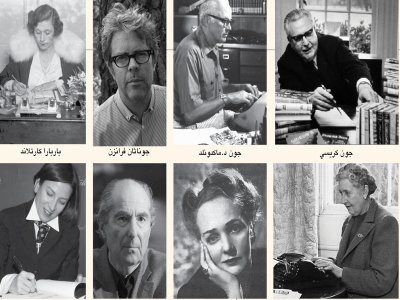عمر أميرالاي في مفكرة سينمائي سوري..نهاية فيلم طويل/ محمد ملص

عمر أميرالاي شخصية سينمائية خاصة، منحت السينما حضورًا ذا أهمية كبيرة، في الوسط السينمائي السوري. حقق أفلامًا عدة تتجلى أهميتها، ليس فقط باختياره السينما التسجيلية، للتعبير عن رؤيته للقضايا الاجتماعية والسياسية الراهنة، بل في الفرادة في رؤيته، واللغة والأسلوب السينمائي الخاص. وأغنى بهذه الأفلام الآفاق والمدى الذي تطمح له السينما في سورية، والسينما التسجيلية بشكل عام. كان للقائنا وتعارفنا أن نشأت بيننا صداقة خاصة لمدى طويل من الزمن، تشاركنا خلالها النشاط السينمائي، والعمل في العديد من الأفلام. ما يعطي لهذه الصداقة خصوصيتها، وللقضايا التي كان اثنان من السينمائيين السوريين يعيشانها، ما يجعلني أعتقد بأنها تستحق العودة إليها واستعادتها.
نهاية فيلم
لا أريد أن أعرف؟! لمَ أرى أن “الموت” الذي أخذ عمر آميرالاي في الخامس من شباط 2011، كان خيارًا سينمائيًا لنهاية “فيلم” طويل. خيار ذو مذاق صاعق، كما هي أفلامه. ويحمل فرادة تتصف بها هذه الأفلام.
أتاني النبأ منتصف ذاك النهار، فتخَرس كل شيء لدي، ورأيته يستيقظ في الصباح، ويستمع لنشرة الأخبار الفرنسية كعادته، ثم يصغي لموسيقا “باخ” الذي يحب، ويتأمل داخل نفسه من جديد: ما حدث، ما يحدث، ما يعتمل في النفس. فتمدد في داخله “سيناريو” طويل، وجثمت على صدره “ذاكرة” كامنة وكتيمة، كان من المعتاد أن يقاومها. فغلبته، ولفحته بزنار من النار. “بصيرته” التي ألهمته دائمًا في أفلامه، ألهمته الآن أن يختار اللحظة مجازًا لنهاية الفيلم. لم يدع أحداً ليشهد “اللحظة” إلا لمياء شقيقته التي تسكن ليس بعيدًا عنه. فما أن وصلت لمياء إليه، كان زنار النار يلتف حول قلبه ويصعقه.
في اللحظات التي كان يتوارى فيها تحت التراب، وقفت على منأى من الحشد الذي يودعه مطبقًا عيني بصمت، كان يتناهى إلي صوت التراب يهمي نحو جسده. لم أتذكر من ركام الأشياء التي جمعتنا، إلا صوته يقول لي:
– قررت أن أعمل فيلم “لقد سرقت موتي” عن صديقي ميشيل سورا.
حين أنهى الدافن وصاياه، اقتربت منه واقتطعت ورقة خضراء من جواره، وضعتها عند رأسه وهمست له:- لقد سرقت موتنا يا عمر!.
لم يفارقني الإحساس بهذا الافتقاد وهذا الغياب خلال السنوات السبع التي مضت، بما حل بنا وما حدث في بلدنا. لم تغب عن ذاكرتي تلك الصداقة ولقاءاتنا – شبه اليومية -. فكنت أحس بالمرارة مع كل لحظة من لحظات هذا الزمن الطويل وما يحدث لنا وبنا. وفي الكثير من الأحيان كنت أحس بغصة خانقة لافتقاد تلك الصداقة وتردّي المفاهيم والقيم التي أخذت تطغى من حولنا.
في منتصف 2012، للبدء بتصوير فيلم “سلم إلى دمشق” اخترت أن أعود وأضع على قبرك “بوستر” فيلمك “الحياة اليومية في قرية سورية” الذي يسميه صديقنا السينمائي قيس الزبيدي بـ “الفيلم الأسطورة” لـ “وشم” السينما به.
مفكرة خاصة
وفي نيسان هذا العام 2017 في النهار الأخير لمهرجان “فجر” السينمائي في طهران وقعت عيناي في تصفحي لبرنامج العروض على عرض الفيلم الكمبودي – الفرنسي “منفى – Exile ” 2016 للمخرج ريثي بانه – Rithy Panh. فقررت أن أشاهده دون أن أعرف الكثير عنه أو مخرجه.
مع بدء صور الفيلم وصوت راويه أحسست بقشعريرة غامضة تلفني. ثم أخذت أغوص في عالمي الداخلي وأستعيد نصي الخاص. وعلى مسار الفيلم وجدت نفسي في حوار لا حدود له مع صديقي ذاته. كأننا أمام شاشة النادي السينمائي بدمشق نشاهد “منفى” ريثي بانه، ونتأمل ونتحاور حول تعبيره عن ذاكرته عن تلك المرحلة التي حكم كمبوديا خلالها “الخمير الحمر”.
بعدها عدت إلى دمشق وأنا أشعر بفضول قوي لاستعادة “المفكرة” الخاصة بالعلاقة بيننا. وفي تصفحي لليوميات والحوار الذي كان يجري بيننا والتعاون لتحقيق سينما سورية، كدت أن أقع في إغواء مشروع لفيلم سينمائي عن الصداقة، دحضًا مني، ورفضًا لغياب وتدني علاقات الصداقة، وأشكال العلاقات في هذه الأيام، وسعير الابتذال للرأي و”خندقة” الأفكار.
الصداقة الوجدانية الصافية التي ربطت بيني وبين عمر آميرالاي، والتي عاشت لربع قرن، نمت وترعرعت بالثـقة في ما يراه كل منا لدى الآخر وفي تقدير تطلعاته مهما يبدو من اختلافات.
كان الشعور بالصفاء الداخلي والأمان الذي يجلله هذا الفضاء من التلاقي الفكري والطموح السينمائي، ما يجعل كلاً منا يقدم نفسه أمام الآخر بلا حدود. لم يتلكأ أمام أي هاجس أو احتياج شخصي، ولم يكن الشعور بالحرص والرعاية المتبادلين، من الوصايا اليومية لوالدته فقط، بل للشعور العفوي – الأشبه بالسليقة – ليدل عن الوداد الداخلي لسينمائيين عثر كل منهما على الآخر في حقل من الألغام.
حياة سينما
كانت حياتنا اليومية معًا “سينما”. فعملنا على إحياء النادي السينمائي وعروضه وحواراته وإقامة التظاهرات السينمائية كتظاهرة “السينما والسياسة” و تظاهرة “الفلاحون والسينما”. كما حققنا للتلفزيون بالتعاون مع عدد من السينمائيين الكثير من حلقات “نادي السينما في التلفزيون” رغم صعوبة ما كنا نعيشه من عوائق ومواجهات سياسية وفنية حملتها تلك الأيام.
تشاركنا ما نعيشه، ما نفكر به، التحريض، الإلهام، وأحيانًا العمل في ما تحقق و أجهض من المشاريع.
(كنت قد أشرت في كتابي “وحشة الأبيض والأسود الصادر 2016 إلى العديد من المشاريع). في الأفلام التي حققها كل منا، كنا ندرك ضرورة “الوقوف” إلى جانب كل منا مع الآخر، ومشاركته له في أي جانب من الجوانب المتعددة للفيلم، وفي أي حدود يحددها الفيلم قيد التحقيق.
ومحاولتي جذبه إلى السينما الروائية، تشاركنا -والروائي صنع الله ابراهيم – كتابة سيناريو القرامطة. وفي الفرصة التي أتيحت له، ليحقـق فيلمًا روائيًا عن “أسمهان”، عملنا معاً على التوثيق وعلى التصور، وصياغة الأفكار المساعدة لكاتب السيناريو الإيطالي، لكتابة سيناريو الفيلم، وفقًا للخيار الإنتاجي للفيلم. بل إننا بعد كتابة السيناريو قمنا معاً بإعادة كتابة عدد من المشاهد كما نشتهي.
وحققنا معًا بمشاركة أسامة محمد فيلمين هما “نور وظلال”(95) و”مدرس” (96).
وكما أفعل أحيانًا مع أفلامي، كتابة مفكرة للفيلم الذي أحققه، أتيح لي أن أكتب مفكرة لفيلمين من أفلامه، هما “في يوم من أيام العنف العادي مات صديقي ميشيل سورا 1993″ و”هناك أشياء كثيرة كان يمكن للمرء أن يقولها 1998”.
***
قبيل عودتي النهائية من الدراسة في موسكو أتاحت لي النشاطات السينمائية التي كانت قائمة في دمشق آنذاك، أن أعرض في صالة “الكندي” مع أفلام الطلبة الدارسين: فيلمين من الأفلام التي نحققها خلال الدراسة. فيلم “حلم مدينة صغيرة” (71). وفيلم الدبلوم “الكل في مكانه وكل شيء على ما يرام سيدي الضابط” (74).
لا أتذكر على الإطلاق في أي من هذين العرضين كان عمر آميرالاي بين الحضور، وجرت بيننا نهاية العرض تلك المصافحة الرحبة المصحوبة بابتسامته ذات الدلالات الواضحة.
عدت إلى سورية نهائيًا في أيلول 74، أحمل معي أفلامي وذاكرتي لما قرأته عن الأفلام التي تحققت وتتحقق في سورية. كان همي حينها أن أحقق فيلمي الأول قبل أي شيء آخر. فعلاً في الشهور الثلاثة المتبقية من العام، حققت الفيلم الروائي القصير “قنيطرة 74”.
في تلك الفترة شاهدت، ربما على شاشة التلفزيون السوري، الفيلم التسجيلي “محاولة عن وادي الفرات” لعمر أميرالاي.
كان هذا الفيلم بالنسبة لي بمثابة المفاجأة بما تثيره تلك الدقائق القليلة لفيلم عمر، من سينمائية هامة قوية ومجددة. وما أثارني أيضًا في عمله السينمائي ليس خياراته فقط، بل هي النظرة العقلانية والموقف في رؤية الواقع. وكأننا كنّا على جانبي طريق واحد. في نظرتي المقابلة للسينما وفي شحنتها الوجدانية والموضوعية للواقع.
وفي هذا وذاك فإن السينما “وثائقية” كانت أم “روائية” أم … فإنها هي السينما بذاتها. والسحر هو في القيمة الفنية المبدعة لها.
في رؤيتي هذه، خطوت في عام 75 نحو فيلم وثائقي عن امرأة كنت قد التقيت بها خلال تصوير فيلم قنيطرة 74.
هذه المرأة عاشت وبقيت في القنيطرة خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي لها. فرسمت “بورتريه” سينمائياً لها بعنوان “الذاكرة”.
بعدها شاهدت فيلم “الحياة اليومية في قرية سورية”، شعرت بتقدير كبير من جديد، وأحسست بالمدى في التفارق والتقارب بيننا. فتخلق في داخلي فضول بأن نلتقي ونتعارف ونتحاور. فقررت اللقاء معه.
كلام في ساحة “عرنوس”
هل كان ذاك الفضول وتلك التساؤلات رغبة بالحوار؟ بالتباري؟ بالتحدي؟، أم الشعور بالمودة لسينمائي حقق فيلمين مجددين كــ “محاولة عن وادي الفرات” و “الحياة اليومية في قرية سورية”. أعتقد أنه كان هذا كله، قبل أن نلتقي وبعده.
لم أعثر في مفكرتي على أي كتابة تخص اللقاء الأول الذي جرى بيننا. كل ما لدي يشير إلى أن علاقتنا في العام 75 قد اتخذت صيغة العمل.
ما أتذكره هو أني أتيت مرة إلى المؤسسة العامة السينمائية للقاء السيد حسن حلبوني في دائرة الدراسات السينمائية. وأتذكر أنه ما أن رحب بي حسن حلبوني بصوته المتراخي والبطيء، والذي يبدو كأنه غير متزامن مع تعابير وجهه، فقد كنت ما أزال واقفًا حين دخل عمر وانبرى حسن حلبوني بعينيه الناعستين وابتسامته العدمية بعبارات طيبة إلى تقديم كل منا للآخر.
فدخلنا في الكلام وقوفًا وتبادلنا الأسئلة والإجابات، ودار الكثير من الكلام حول السينما السوفييتية والروسية. ومررنا على إيزنشتاين الذي أعتبره معلمي الأول ودزيغا فيرتوف الذي على ما يبدو كان يعتبره ملهمه. واستمر الكلام إلى اللحظة التي لاحظنا فيها أن الموظفين بدأوا يتحركون بحياء من حولنا، وتبين لنا أن الدوام قد انتهى.
خرجنا من المؤسسة ونحن نتبادل الكلام دون شعور بالتوجس أو الحذر. وبعد أن توقفنا مطولاً في ساحة “عرنوس” سألني عمر:
– شو عندك؟ تعال معي لنكمل! فهنا بيتي وسنتناول الغداء ونحكي!
في بيته تعرفت على أمه الحارس الذي لا يغفو. وفي المساء تعرفت على صديقته الفرنسية ميشيل. أذكر أني عدت إلى بيتي ليلاً وأنا أحس بالإثارة العالية والحماس. ولم أكتب شيئاً.
ضفة ثالثة