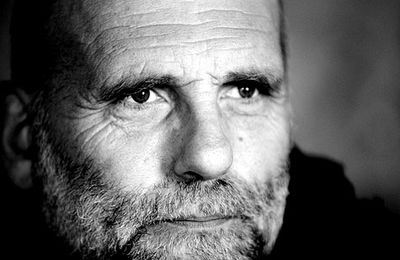عمر أميرلاي… أربع سنوات تبدو دهراً

مانيفستو العسف والعطب والانهيارات المريعة\ علي وجيه
دمشق | أمّا وقد تنبّأ عمر أميرلاي (1944 – 2011) بطوفان بلاده، فهذا يعزّر راهنيته بعد أربع سنوات على الرحيل. صحيح أنّ الطوفان السوري خلّف مستنقعاً كريهاً، إلا أنّ أميرلاي كان من المتحمّسين لبداية «الثورات العربية». التوقيع على بيان المثقفين المؤيدين للثورة المصرية آخر آثاره العامة. بالتأكيد، كان التسجيلي السوري الأشهر والأكثر فرادةً، لينخرط أكثر بعد منتصف آذار (مارس) 2011 لو أسعفه الوقت (غاب يوم 5 فبراير). تمكن المراهنة أيضاً على مسافة نقدية من كل شيء وكل شخص. هذه قناعة غير قابلة للمساومة في منهجه.
لم يكن ليستكين لقدسية ثورية أو تأليه نضالي، ولأعمل مبضعه النقدي في كل ما يمكن أن يشغل باله. أصلاً، اعتاد على الشعور بالرعب من الغريزة الجماعية وتدفّق الحشود. لا وجود للحقيقة المطلقة. الظنّ فضيلة وليس إثماً. إذاً، لا مفرّ من زعزعة اليقين وخلخلة المكرّس. هذه وسيلة صارمة لغاية التغيير السياسي والاجتماعي والفكري. هو «اللص» الذي يفضّل الدخول من النافذة، لتفادي الباب الذي يعبره الجميع. اليوم، يبدو أميرلاي نابضاً أكثر من أي وقت مضى. تحوّلات مسيرته الحافلة وشهاداته الحيّة، تكتب مانيفستو صارخاً عن العسف والعطب والانهيارات المريعة في هذه المنطقة. تفكّك اللعنات المخيّمة على الشرق، كوابل مطر حامضي لا ينقطع. في الفني، يحضر سؤال حول تواصل الجيل السينمائي الجديد مع إرث الكبار.
عدسة متسللة، متربّصة،
تهوى الألم الإنساني وتوثيق الشقاء والقهر
اطّلاع القليلين لا يزيل الهلع من جهل الغالبية. كيف يمكن التعامل مع «سينمائي» سوري لم يسمع بـ «الحياة اليومية في قرية سورية» (1974)؟ التسجيلي الآسر الذي أنجزه أميرلاي وفق تصوّر مشترك مع سعد الله ونوس. محزن هذا الفقر في التأسيس على ما بناه الرجل. في المقابل، تأثيره مقروء في تجارب أسماء مثل حازم الحموي، وميار الرومي، ومحمد علي الأتاسي وزياد كلثوم.
قريباً من مقام الشيخ محيي الدين بن عربي في دمشق، ولد عمر. «عاهدتُ نفسي، مذ صرتُ مخرجاً، أن أنذر له ذبيحتين على روحه الطاهرة كلما رزقتُ فيلماً». طفولته المسترخية في حيّ الشعلان، أتاحت له الكثير من الوقت لمراقبة الناس ودراسة طباعهم. التلصص من النافذة حفر في جمجمته، ليتسلل إلى كادره الأخير في «طوفان في بلاد البعث» (2003)، من خلال تشكيل نافذة ومئذنة. في منتصف الستينيات، طار إلى باريس، ليتلقّى تعليمه في «المعهد العالي للدراسات السينمائية» IDHEC. هزيمة 1967 والثورة الطلابية 1968، حدثان جللان اقتحما عالمه، وشكّلا قناعاته إلى الأبد. أدرك عمر الشاب أنّ التفاعل الخلّاق مع الشارع هو الصلب الحقيقي للمشروع الفني، مقرّاً أنّ الحال المزرية لهذه المنطقة تثقل كاهل الجميع. هكذا، حسم خياره التسجيلي الذي لم يتغيّر يوماً. عاد إلى الشام، وجرّب التعاطي الإيجابي مع التجربة البعثية من خلال تشجيع بناء سد الفرات. «محاولة عن سد الفرات» (1970) هو «الجريمة» الفنيّة التي سيحاكم نفسه عليها بعد 33 عاماً في «الطوفان». من «الماشي» في هذا الشريط، رجوعاً إلى «المويلح» في «الحياة اليومية في قرية سورية» (المؤسسة العامة للسينما)، مروراً بـ «صدد» في «الدجاج» (1977 ـ التلفزيون العربي السوري)، نقّب أميرلاي في الريف السوري كنموذج أصيل عن البلد بأسره (ألم ندفع ثمن تهميش الريف في ما بعد؟). وثائق بصرية مغرقة في الواقعية والالتحام مع النفس والوحل والأسفلت وكومبيوترات المدارس القابعة في صناديق مغلقة. نرى أناساً مشلوحين، منسلخين عن السيرورة التاريخية والحياتية. تلاحقهم عدسة أصيلة، متسللة، متربّصة، تهوى الألم الإنساني وتوثيق الشقاء والقهر. كيف فعلها عمر بإنتاج عام؟ حسناً، لقد لجأ إلى الاحتيال على الجهات العامة لتصوير ما يريد. في نظر عمر، هذه ليست معضلة أخلاقية بقدر ما هي إحالة على سؤال: «لماذا يضطرّ السينمائي إلى الاحتيال أصلاً؟». في «طوفان في بلاد البعث» (2003)، شنّ الهجوم الأشرس على النظام البعثي. سجّل نبوءةً لم تتأخّر كثيراً في التحقق الكابوسي. بطريقة ما، تواءمت إشكاليته وشراسته في المواقف مع هدوئه المهيب وصوته الرخيم ووسامته المحببة. حتى خصومه يتحدّثون بكثير من الاحترام عن صلابته حتى النهاية. واصل العمل على مشروع تلو الآخر، رغم المنع الذي لازم معظم أفلامه. هو صاحب أكبر فيلموغرافيا ممنوعة في السينما السورية، وربما العربية. عروضها اقتصرت على الأماكن الخاصة والمراكز الثقافية الأجنبية، فيما وجدت بعض الأشرطة طريقها إلى الفضائيات. منذ أيام، استعاد «منتدى البناء الثقافي» في دمشق شريطيه «وهنالك أشياء كثيرة كان يُمكن أن يتحدّث عنها المرء» (1997) و«طبق السردين» (1997). في 1981، تمّ إغلاق «النادي السينمائي» الذي أنشأه مع مجموعة من السينمائيين والمثقفين اليساريين عام 1974. كانت هذه المجموعة نجحت في إقامة مؤتمر تحضيري للسينمائيين السوريين عام 1976. آنذاك، شارك أميرلاي في لجنة صوغ مشروع «المجلس الوطني للسينما» و«الصندوق الوطني للسينما»، اللذين كانا من توصيات مؤتمر لم يتكرر. بعدها، غادر أميرلاي مجدداً. عمله الاحترافي في الإنتاجات الفرنسية، وسّع دائرة اهتماماته. خرج إلى المنطقة العربية برمّتها ليمشي وسط حقول ألغام سياسية واجتماعية. في «مصائب قوم» (1981)، قارب الحرب الأهلية اللبنانية من خلال شخصية سائق وحفّار قبور، اتضح لاحقاً أنّه عميل إسرائيلي. هذا الانطلاق من الخاص إلى العام، ومن المجاز البسيط إلى القضية الشائكة، بقي من مهاراته التي لم تخذله لحظةً. حدسه عالي الاستشعار في الالتقاط والمضي قدماً في مسار نقدي لا يهادن. كذلك، قدرته على التقاط نبض شخوصه ودفعها إلى البوح، كما نساء «الحب الموءود» (1983) منهنّ النجمة المصرية نادية الجندي. في التسعينيات، انطلق مشروع سجالي آخر في مقاربة غير تقليدية لشخصيات عامة: «إلى جناب السيّدة رئيسة الوزراء بنظير بوتو» (1990) عن رئيسة الوزراء الباكستانية الشهيرة، و«في يوم من أيام العنف العادي، مات صديقي ميشال سورا…» (1996) عن الباحث الفرنسي المعروف الذي اغتيل في بيروت، والأكثر إثارةً للجدل «الرجل ذو النعل الذهبي» (1999) عن رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. شريط يلامس العلاقة التاريخية الحرجة بين المثقف والسلطة.
بذكاء، ذهب أميرلاي إلى غير المتوقع، متفادياً التنميط ومحترماً «عقداً أخلاقياً وفروسياً» جمعه بالحريري. لم يكن صدامياً بالدفق المعتاد، إلا أنّه فتح الباب على عالم شائك. هذا لم يغيّر شيئاً من كرهه للسلطة بكافة تجلياتها. محلياً، أخذ المشروع بعداً آخر، اشترك فيه زميلاه محمد ملص وأسامة محمد. رأينا «نور وظلال» (1994) عن الرائد السينمائي السوري نزيه الشهبندر، و«المدرِّس» (1995) عن التشكيلي السوري الأشهر فاتح المدرِّس، و«وهنالك أشياء كثيرة كان يُمكن أن يتحدّث عنها المرء» عن صديقه سعد الله ونوس في أيامه الأخيرة.
على الأرض، عمل أميرلاي على تحقيق فضاءات بديلة وموازية للعمل السينمائي، الضرورة الملحّة في «السينما السورية» اليوم. صحيح أنّ علاقته بالسلطة لم تكن على ما يُرام خصوصاً بعد «الطوفان»، لكنّها لم تكن جامدة تماماً. هذا ذكاء السينمائي الذي كان ينجح دائماً في خلق هامش لحركته. هكذا، سعى إلى إحياء النادي السينمائي في التسعينيات، واضعاً في ذهنه ضرورة توسيع نشاطه إلى مختلف المحافظات السورية. أيضاً، عمل على إنشاء معهد للسينما مع بعض السينمائيين منهم أسامة محمد وهيثم حقي. أسّس «المعهد العربي للفيلم» في عمان، ودرّب العديد من السينمائيين الشباب. يُضاف إلى ذلك مساهمته الرئيسة في انطلاق «مهرجان أيام سينما الواقع» Dox Box عام 2008. «إغراء» عنوان آخر مشاريع أميرلاي الذي كان يحضّر له مع المنتج عروة النيربية عن الممثلة السورية التي اشتهرت بجرأتها. كان في جعبته أيضاً تسجيلي عن سيرة عائلته انحداراً من جدّه العثماني.
في ذكرى رحيله، تحقق «الطوفان» دماءً. صار «الدجاج» مذبوحاً «حلال»، و«طبق السردين» مغمّساً بالأشلاء. «سينما الأندلس» القابعة عند الشريط الحدودي مع العدو، باتت شاهدةً على عنف داخلي. نوم سعد الله ونوس لم يعد يفلح في درء الإحباط، فيما سينما الوحشة تقطر أرواحاً قربنا. لنستحضر العبارات «الثورية» الأخيرة من «الحياة اليومية في قرية سورية»: «علينا جميعاً أن ننخرط في النضال من أجل خلاصنا المشترك. ما من أيد نظيفة، ما من أبرياء، ما من متفرجين. إننا جميعاً نغمّس أيدينا في وحل أرضنا، وكل متفرّج هو جبان أو خائن…».
40 عاماً على «التغريبة» السورية/ يزن الحاج
هل ثمة مغزى من الكتابة عن شريط تسجيلي بعد أكثر من 40 عاماً على إنجازه؟ ربما تنبغي إضافة كلمات عدة إلى هذا السؤال ليكون له مغزى بذاته. شريط تسجيلي سوري. 40 عاماً على إنجازه ومنعه من العرض. هكذا سيستقيم السؤال إلى درجة كبيرة، بل ربما لا معنى للحديث عن شريط «الحياة اليومية في قرية سورية» (82 دقيقة ــ 1974) من دون التطرّق إلى حياة مبدعَيْه سعد الله ونّوس (1941-1997)، وعمر أميرلاي (1944-2011).
شارك ونوس في إعداد الفيلم بعد إخفاق محاولته «الانقلابية» المسرحية بعد عرض «حفلة سمر من أجل 5 حزيران». أخرج أميرلاي الفيلم إثر خيبة أمله بعد شريطه التفاؤلي الأول «محاولة عن سدّ الفرات» (1970). ولذا كان «الحياة اليومية…» نقطة انطلاق جديدة لمبدعيه، يمكننا فيها تلمّس جذور أعمالهما اللاحقة التي أوغلت في التشريح القاسي للمجتمع السوري انطلاقاً من «العقد المُغيَّب» في التاريخ السوري الراهن، أي عقد السبعينيات. هنا بالذات تكمن أهمية هذا الشريط التسجيلي الذي يعتبره بعضهم أول شريط تسجيلي عربي.
يحدّثنا ونوس عن الظروف التي رافقت إنجاز الشريط في مقالته «سيرة فيلم موقوف» (1975). يشير إلى أنّ العمل استغرق عاماً كاملاً على ثلاث رحلات بين نيسان (أبريل) 1971، ونيسان (أبريل) 1972، إذ «وجدنا أنفسنا منذ بدء العمل مضطرين للقيام بمهام الإحصاء والدراسات الميدانية والبحث الاجتماعي، إلى جانب الهاجس الفني في بناء الفيلم بأسلوب واضح، ومضمون صائب».
شارك سعد الله ونوس
في إعداد «الحياة اليومية
في قرية سورية»
لم يكن الفيلم، إذاً، مجرد محاولة سينمائية للتوثيق، بل كان فعلياً محاولة تأسيس عمل فني «ملتزم» لو أردنا استعادة هذا المصطلح الذي أوشك على الانقراض. يبدو هذا واضحاً منذ اللحظات الأولى في الشريط. سيجد المشاهد نفسه كأنه داخل عقل كارل ماركس وهو يشرّح معنى «الاغتراب»، حيث يبدو المسحوقون كأنهم يعيشون في كوكب منعزل عن ثمار إنتاجهم التي تعبوا طوال أعوام في زراعتها بحيث يراكم الملّاكون رأس المال فيما يحصد الفلاحون الرياح والرمال. مشهد ماركسي بامتياز. الفارق أنّ ما يحدث في الشاشة والواقع لم يكن تمهيداً للثورة، بل إحدى نتائج «ثورة آذار» عام 1963، وبعد تطبيق الإصلاح الزراعي. تذكّرنا بعض لقطات الشريط في صحراء قرية «المويلح» بالطبيعة «غير الصامتة» التي سنجدها في أعمال يوسف عبدلكي لاحقاً: الجمجمة بعيونها الجوفاء، العظام العارية، علبة السردين الصدئة المفتوحة على الخواء، حذاء مرمي بإهمال، والنظرات الاتهامية القاسية في عيون الجميع. عناصر مرتبطة بالضرورة، وتزيد وطأة الألم الثقيلة حين نراها غارقة في العواصف الرملية الجارحة، أو مغروسةً في الأرض المتشقّقة الجافة التي تنتظر معجزة الطوفان. الشيء الوحيد المتحرك في هذه الصورة الساكنة هو الآلة بضجيجها الجنوني، وحركتها الرتيبة الصارمة، ودلالاتها السلطوية التي تتقاطع مع الرحى التي تبرز في لقطات سريعة، حيث يتم سحق الجميع بلا استثناء.
القولبة تطغى على كل الأشياء والأشخاص بحيث نجدهم مقسومين إلى نمطين ثابتين: عناصر السلطة من شرطة ومسؤولين سياسيين وثقافيين يكرّرون كليشهيات جامدة بإيقاع مونوتوني ذي دلالة خطابية عسكرية جلية. أما باقي «الشعب»، فهو ذو ملامح جامدة، وصوت مشبع بالانكسار، فيما عيونه تبرق للحظة بتحديقة قاسية تختصر جميع المعاني. ليس ثمة فارق واضح بين السياسي الذي يؤكّد أنّ «الثورة غيّرت حياة الفلاحين تغييراً فعلياً» وبين الضابط الذي يبرّر القمع لأن «المواطن ليس جاهلاً فحسب، بل يحمل شيئاً من الخبث»، وبين الحديث المضحك للمسؤول الثقافي عن سيارة الوحدة الثقافية التي ستعرض فيلماً وثائقياً عن «القطر العربي السوري في لقطات جيدة»، فيما تبدو «اللقطات السيئة» المقابلة واضحة على ملامح الفلاحين وهم ينصتون إلى محاضرة عن أهمية السينما في قرية ليس فيها جهاز راديو. تبدو الستارة البيضاء/ الشاشة عند عرض الفيلم الدعائي كأنها جهاز تخدير مركزي سيُستبدل بالتلفزيون بعد سنوات، بحيث تتأكد السلطة من وصول الرسالة الرسمية التخديرية إلى الجميع. وحده الأستاذ كان العنصر المتبدل في هذه الصورة الثابتة. كان أقرب إلى صورة السلطة حين كان يُلقي الدرس في الصف كبلاغ عسكري، وبثياب أنيقة وذقن حليقة أمام الكاميرا ويركز على أهمية التنوع الغذائي في قرية لا تعرف سوى الخبز والشاي طعاماً؛ فيما بدا أكثر عفوية وتحرراً في غرفته ببيجامته و«شحاطته» التي لم تتوقف عن الاهتزاز. كانت الكاميرا هي من تتحدث فعلياً، وكانت الشاهد المتنقّل من فضاء مكاني إلى آخر، وصولاً إلى الحافلة المتجهة إلى المدينة، حيث نجد الجميع مسافراً لسبب وحيد، وإن تنوّعت أشكاله، هو الشفاء من «الاستلهاب» الذي يبدو عند تكرار المفردة، كأنه السبب الحقيقي لكل العلل في تلك البلاد.
الصمت وسيلةً للبوح هو ما تركّز عليه كاميرا أميرلاي، حيث سيحاكم المشاهد بنفسه أقوال الجميع بخاصة المسؤولين الذين يؤكّدون «نقص وعي» الفلاحين. سنجد فعلياً بأنّ الخطاب العفوي «غير الخشبي» الذي يتفق عليه المسحوقون الأميّون هو المحكمة الحقيقية لمزاعم السلطة التي تريد «تصعيد العشائرية للصالح العام»، بينما يشير الفلاحون بعفوية إلى وجوب القضاء عليها. وحين يؤكّد المسؤولون النقابيّون أنّ الإصلاح الزراعي يحقّق نتائجه، تلتقط الكاميرا «تغريبة» الفلاحين إثر طردهم من الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة
الملّاكين.
لا خلاص من هذا الجحيم إلا بطوفان يجرف كل شيء. هذا ما ينبئنا به شريط «الحياة اليومية في قرية سورية» الذي يتماهى مع صرخات اللوعة في بلد لا حاجة فيه للاستطرادات، إذ إنّ الاختزالات كافية جداً: لا حزب آخر سوى «الحزب»، ولا جبهة سياسية سوى «الجبهة»، ولا نقابة فلاحية سوى «الاتحاد». كل الصفات الأخرى نافلة وزائدة عن الحاجة. ينتهي الفيلم كما بدأ، بأطفال يذرون الرمال في العيون الجوفاء لحيوان نافق في الصحراء، ثم يجرّون هيكله العظمي على الرمال بحيث يفتحون طريقاً جديدة ستردمها عاصفة رمليّة أخرى على إيقاع الآلة/ الرحى التي لا تتوقف. «هذه بلادنا، وكل متفرّج لا يغمس يده في الطين جبان أو خائن». تبرق الكلمات الأخيرة لمبدعَيْ الفيلم، قبل الإظلام الأخير.
أمام شجرة الليمون/ محمد عبد العزيز *
في الفناء الخلفي لمنزلي، ثمّة شجرة ليمون تبعد عن منزل عمر صفين من الأبنية، وربّما ثلاثة. خمس حبّات ليمون صفراء شموس الذاكرة. أربع سنوات مرّت. أجلس على الدرج. يمرّ طيف عمر بحضوره الرخيم. تهبّ نسمة هواء باردة. تهتزّ الأغصان، وتعود ساكنةً. أقول لنفسي: «ربّما كان في الأرجاء». أدرك أنّ الموت تحوّل صيغةً فيزيائيةً أخرى للقراءة. ذرّات ضوء. فوتون. سباحة في الوعي الكلي الكوني المطلق. تردد. إشارة. دلالة. حقيقة مضافة. هنا، منبع ذاك الشعور بالحضور. صوت المدفعية الثقيلة من بعيد.
عودة الصدى الكتيم للقذيفة. أسمع صدى صوته الرخيم لآخر مرة سمعتها وسط دمشق، وهو يمرّ بقربي: «كيفك محمد؟». على حافة قبره، كنت أقف مع الحشد المودّع أشاهد جسده يوارى. «فريم باي فريم» كل منّا يرمي حفنة تراب. بكثير من الحب دفن، وبكثير من الحب سنتذكره. بكثير من الحب ومن النبل والصدق والشجاعة، صنع سينما عجز أغلبنا عن مقاربتها.
أمام شجرة الليمون أجلس. خمس حبّات صفراء، شمس للذاكرة. ظلام الإسلاميين يحلّ بكل سواده، ويرخي بظلّه الثقيل على البلد. يخرج «فيد إن» كادره الأخير: تلك النافذة الغارقة في الظلام، وفي الخلف جامع قيد الإنشاء، كتيماً صلداً يحضر.
* سينمائي سوري
وثائقيات مطرّزة بدمغة روائية/ خليل صويلح
على سفح جبل قاسيون، يرقد جثمان عمر أميرلاي كأنه اختار مكاناً يتيح له تثبيت العدسة على منظر بانورامي لدمشق كي لا يفوته المشهد كاملاً. هل يدير حواراً الآن، مع الشيخ محيي الدين بن عربي الذي يرقد على بعد أمتار منه حول معنى التصوّف، أم أنه يضع اللمسات الأخيرة على الجزء الثاني من «الطوفان»؟ لكن هل يتيح له ضجيج الموتى، وأصوات القذائف، أن يرتّب أفكاره بهدوء، جرياً على عادته في طهي مشاريعه السجالية المؤجلة؟
كان محمد ملص قد زار قبره وسجّل لقطة من فيلمه «سلّم إلى دمشق» (2013) بما يشبه مرثية لصديقه الغائب، يعلمه بأننا «كسرنا الخوف يا عمر»، كما لو أنه يستكمل حواراً قديماً، أوقفه الموت المباغت في ليلة ماطرة من شباط (فبراير) وكان «الربيع العربي» في أول تفتّحه، قبل أن يتحوّل رماداً. ما نعرفه تماماً الآن، أنّ أميرلاي لم يغادر دمشق، استجابةً لقناعته بأن «الملعب الحقيقي للسينما هو الشارع، أو الواقع اليومي». ربما، لو لم يباغته الغياب في لحظة مفصلية، لدارت عدسة كاميرته نحو خرائط أكثر طوفاناً، مستكملاً رهاناته الأولى على سينما خشنة وغير مهادنة، تحفر مجراها بعنف، في هتك الجانب المظلم والمهمّش والمغيّب، من الحياة السورية، منذ أن حمل كاميرته صوب «سد الفرات» مطلع السبعينيات، لتوثيق «مشروع اشتراكي» يتواءم مع تطلعاته حينذاك في ولادة مجتمع سوري جديد، هو العائد للتو من باريس، وأصداء انتفاضة الطلبة (1968) التي صوّر بعض تجلياتها في الشارع الغاضب. هذه الحماسة ستخبو تدريجاً، إثر توغله في عمق الريف الفراتي. وإذا به يحقق شريطاً متفرّداً عن «الحياة اليومية في قرية سورية» (1974). كان الشريط بمثابة صفعة مدويّة للخطاب الرسمي المضاد بشعاراته التزينيّة لريف مهمل تتحكم بمصيره قيم عشائرية، وعسف سلطوي جائر، وموت بطيء لبشر مخذولين ومتروكين في عراء الطين والعجاج والتلوّث. كما سيذهب إلى «صدد» في بادية حمص، ويحقق «الدجاج» (1977) في إدانة صريحة لثنائية التدجين والمرسيدس، إلى أن أغلق القوس في «الطوفان» (2003) على مآلات الشعارات البرّاقة، في سرد بصري تهكمي بلغ ذروته القصوى في تشريح زيف الخطاب المعلن، وببغائية التعليم، والحداثة الشكلانية.
ما يؤخذ على سينما أميرلاي ربما، نبرتها الثأرية في إطاحة الخصم، بعد تقييده بحبال متينة من الأفكار المسبقة. كأن شخوص أفلامه يتحرّكون فوق خشبة مسرح للدمى. يختطف من أفواههم العبارة الذهبية التي يرغب في تصديرها بما يتوافق مع الفكرة المضمرة، فيما يطيح مونتاجياً بأوهام هؤلاء الشخوص، ونياتهم الحسنة في احتضان الضيف. «ذياب الماشي» في «طوفان في بلاد البعث» أحد هؤلاء الضحايا على نحوٍ ما. كان العجوز يروي تاريخه النضالي من موقع الاعتزاز بالنبرة ذاتها التي يستضيفه فيها ميكرفون التلفزيون الرسمي وسطوة كاميرته. الكاميرا التي لطالما صوّرته نائماً في مقعده الأبدي في «البرلمان» بوصفه زعيماً لعشيرته. الأمر ذاته في المباغتة والمراوغة، يتلقاه مدير الناحية في «الحياة اليومية في قرية سورية» حين يلقي خطاباً مضحكاً، في كيفية إذكاء النعرات العشائرية للسيطرة على هؤلاء البشر القساة، وكذلك معلم المدرسة في «طوفان…»، لحظة ترديد الشعار الصباحي، ما يعده مخرجنا انتصاراً لما يضمره، وخذلاناً لضحايا الصورة في تظهيرها اللاحق.
على الضفة الأخرى، سيمجّد شخصيات مشهورة، من دون أن يتخلّى عن توقه لقطف ثمار أفكار مضادة للقمع والاستبداد وهزائم الأنظمة، فيغدو خطاب شخصيةٍ ما، لحظة احتضارها، إدانة إضافية، لما يرغب بتعزيزه، كما في أشرطته عن سعد الله ونوس، وفاتح المدرّس، ونزيه الشهبندر (بمشاركة محمد ملص، وأسامة محمد)، بينما يجد في موت صديقه ميشال سورا صورة كاملة للعنف في بيروت الحرب الأهلية. وسيبقى شريطه «الرجل ذو النعل الذهبي» محيّراً: هل تمكّن حقاً من رسم صورة حقيقية عن الراحل رفيق الحريري، أم نجا الرجل من الفخ الذي نُصبَ له؟
بالطبع، لم تجد معظم أفلامه طريقها إلى الشاشة الوطنية، إذ مُنعت رقابياً، وربما أُتلف بعضها، لمخالفتها المواصفات، فهناك فرق بين أن تصنع أشرطة ريبورتاجية دعائية، كما يفهم هؤلاء الرقباء السينما الوثائقية، وأن تحقّق سينما نقدية من العيار الثقيل. وإذا به يصبح- مرغماً- صاحب أكبر سجل للأفلام الممنوعة، في نسخة موازية لما أصاب مخرجاً مثل أندريه تاركوفسكي في الحقبة السوفياتية. هكذا ارتبط اسم أميرلاي بالسينما الوثائقية، من دون أن يتمكّن من خوض غمار السينما الروائية، بعد محاولات مجهضة في هذا المجال. ذهب سيناريو «القرامطة» إلى الأدراج، وتلاه مشروع «أسمهان»، فعاد إلى ملعبه الأول، مطرّزاً وثائقياته بدمغة روائية لا تخفى على العين، سواء في البناء الحركي للشخصيّات، أم في آليات السرد البصري، أو لجهة كثافة المعنى الدرامي. ذلك أن الصورة هنا، تخضع لأكثر من قراءة، مثلما تبطن أجوبة لا تبدو مرئية للوهلة الأولى، لفرط بساطة مقاصدها المعلنة، إلى أن يسحب البساط بمكر من تحت أقدام الرواة، تاركاً إياهم يخوضون في أرضٍ زلقة بلا ضفاف، وخالعاً أقنعة البلاغة عن هشاشة اليقين، بين حدّي التهكم والمرارة.
صاحب أكبر سجل للأفلام
الممنوعة في نسخة موازية
لما أصاب تاركوفسكي
في المقابل، لا نعلم ما هو مصير مشروعيه الأخيرين، إذ كان يستعد لإنجاز وثائقي، ربما لو أنجزه حقاً، لكان الأكثر إشكالية وإثارة للجدل في مسيرته الفكرية وتوجهاته الإيديولوجية. المشروع بعنوان «جدّي العثماني»، وهو محاولة في تفكيك هويته الشخصية المركّبة، بحكم أصوله العثمانية، وعائلته الشركسية، ونشأته العربية. هذا الخليط الإثني الملتبس، أعاده إلى سيرة جده الجنرال العثماني الذي كان حاكماً عسكرياً في أكثر من ولاية عربية. في حوار «الأخبار» معه قبل رحيله، أوضح فكرته قائلاً «آن الأوان لكسر منطق الحارة، فالانهيار العربي الذي نعيشه اليوم بكل تشرذمه وانحلاله، أتى محصلةً لانهيار الإمبراطورية العثمانية التي أفتخر بانتسابي إليها. أما دعوات التحرر من نير العثمانيين، فهي أكبر كذبة صنعها التيار القومي العربي في أروقة وزارة الخارجية البريطانية، فقد كانت الاحتجاجات العربية على الاستبداد العثماني في عهد عبد الحميد الثاني، وجمال باشا السفاح، لا على الانتماء إلى الإمبراطورية. كانت حركات احتجاجيّة لا نزعات انفصالية. فيلمي سيُضيء هذا الالتباس المقصود عن طريق سيرة عائلية وجنرال عثماني خدم الإمبراطورية إلى آخر يوم في حياته». أما مشروعه الثاني الذي أجهضه الموت، فيتعلّق بسيرة ممثلة سورية محتجبة، هي نهاد علاء الدين. «إغراء» كانت من أكثر الممثلات السوريات جرأة، وكسراً للممنوعات، حين ظهرت عارية تماماً في فيلم «الفهد» (1972) للمخرج نبيل المالح. الفكرة محاولة لإعادة الاعتبار إلى ممثلة حرّة دفعت ثمناً باهظاً من دون أن تنال تكريماً من أحد.
لو لم يعاجله الموت، على الأرجح، لطوى مشروعيه الأخيرين، واشتبك مع مخاضات الطوفان السوري وارتداداته. وربما كان سيبحث عن «أبو علي» سورياً هذه المرّة، بدلاً من «أبو علي» في فيلمه «مصائب قوم» (1981) الذي تناول الحرب الأهلية اللبنانية، راصداً حياة «متعهّد جنازات»، المهنة الرابحة في كل الحروب.
كيف ينظر أبناؤه إلى سينماه؟
كيف ينظر أبناء عمر أميرلاي من السينمائيين الشباب في سوريا إلى سينماه؟ وما تأثير هذه السينما على توجهاتهم في تحقيق أشرطة وثائقية مختلفة؟ سؤال طرحته «الأخبار» على مجموعة من هؤلاء الذين يتلمسّون خطواتهم الأولى، في سينما لطالما راكمت تصوّرات جاهزة عن الفيلم الوثائقي بوصفه مادة دعائية وفولكلورية، وأرشيفاً لتمجيد الخطاب الرسمي. يختزل فراس محمد سينما المعلّم بعبارة واحدة «التفكير خارج الصندوق، لكنها في الوقت نفسه، سينما التفكير في المكان المعتم من الواقع». أما ورد حيدر فيراها «سينما الوعي والمصداقية في قوالب جديدة تضع المشاهد في منطقة اللاتوقّع، بتحايلها على محيطها الزماني والمكاني. وفي المقابل فإن هذه السينما لا تخلو من العواطف الذاتية المؤثرة، رغم أنها سينما موجّهة». من جهته، يصف أحمد الحاج أفلام صاحب «طبق السردين» بأنها تبشيرية وصادمة، لا تخلو من نبوءة، نقلت الفيلم التسجيلي السوري إلى مصافٍ أخرى، ولطالما سحرتني طريقته في تحقيق أفلامه». ويضيف: «سنحتاج إلى سنواتٍ طويلة لنشهد طوفاناً جديداً، في السينما الوثائقية السورية لنبلغ عتبة أفلامه». بالنسبة إلى عمرو علي، فإن سينما أميرلاي «كانت تضع يدها على الجرح في مقاربة الواقع، وكل ما هو مسكوت عنه بإماطة اللثام عمّا يقضّ مضجع المجتمع، من دون أن يقع في مطب الخطابة والمباشرة، في لغة سينمائية مبهرة، وسرد يتحايل على المحظورات». أما الناقد ماهر عزّام، فلديه وجهة نظر مختلفة عمّا سبق، بقوله «إنها سينما مؤدلجة… تُنجز بناء على موقف مسبق، ولخدمة هدف جاهز بخلاف الوثيقة. هي سينما تلجأ إلى الوثائقي وعينها على مؤسسات التمويل الأوروبية على أساس أنها صورة واقعية عن ظلال المجتمعات الرازحة تحت الأنظمة الشمولية».
عذراً عمر…/بيار أبي صعب
كان ذلك أشهراً قبل أن تغمض عينيك للمرّة الأخيرة في بيتك الدمشقي، على تباشير «ربيع» سرعان ما انقلب كابوساً كافكاويّاً. أذكر صوتك على الهاتف يسألني إن كنت مستعداً للمجيء إلى الشام للمشاركة في ندوة عن المسرح، تحت جناح رولا ركبي في الطابق السفلي لفندق لطيف، في تلك الحانة التي سيغمرني فيها دفء جمهورها، وحساسيته، وإصغاؤه، وفوران الأسئلة في وجدانه.
شعرت بمزيج من الاعتزاز والإثارة والخشية، ولم أتردد لحظة: حين يقترح عليك عمر أميرلاي المشاركة في نشاط في قلب دمشق، فتلك شهادة تعتزّ بها! ومعنى ذلك حكماً أنّ الندوة (التي سيجاورني فيها برهافته المعهودة المسرحي أسامة غنم)، ستكون أبعد ما يمكن عن البروباغندا، وتلك المكاذبات الرسميّة التي لم تكن يوماً لنا. فهمت، من دون أي نقاش بيننا، أنني على موعد مع أعلى سقف نقدي متاح للسائد. أي للسلطة. أليس عملنا نقد السلطة أيّاً كانت؟ فكيف بالأحرى في بلدك الغنيّ، خزّان الأصالة الثقافيّة والخصوبة الانسانيّة بالنسبة إلينا نحن اللبنانيين. بلد يحلم أهله بمستقبل أفضل، فيضيق القفص (الصدري) برئتهم، لحظة بدا الأمل متاحاً، وفكرة التغيير تسكن ذرات الهواء؟
ما زلت أذكر كل تفاصيل الندوة. الروائح ولون المقاعد، مناخات السبعينيات، الصمت الثقيل أيضاً والغصات المحبوسة. رولا الواقفة إلى جانبي ملاكاً حارساً، نظرات الشباب والصبايا، وجه ميشيل الذي كان صادقاً ومضيئاً، دمعته حين ذكر جوزف و«الأخبار»، ابتساماتك الارستقراطية المهذّبة والصديقة، ترحيب أسامة (محمد) الحار ونكاته، شَعر ديما الطويل، غضب سمر… يا الله. كم مرّ من الوقت على كل ذلك؟ الحديث عن المسرح أخذنا حتماً إلى الحديث عن التغيير. تحدثتُ عن تونس (بمسرحها وثورتها) وعيني على سوريا. أذكر أنني تحدثت عن التجربة التشيكوسلوفاكيّة حيث لعب مسرح الهواة دوراً حاسماً في «الثورة المخمليّة» التي «لم تُرَق فيها نقطة دم واحدة».
كم مرّ من الوقت على كل ذلك؟ ذهبتَ على عجل، متسللاً. ودّعك رفاقك وسط حصار رسمي. حزنّا لأنّك لن ترى اكتمال حلم صار صنواً لوجودك في السينما والحياة. أهمّ مخرج وثائقي عربي في جيله على الاطلاق، لن يتاح له أن يؤرّخ لهذا «الطوفان» الذي تنبّأ به. كيف نصارحك اليوم بمرارة، بأنّك أحسنت صنيعاً بالانسحاب قبل الكارثة؟ الطوفان أكل الأخضر واليابس. هل كان بوسعنا أن نحزر أن تحالف البنى الاستبدادية والمصالح الاستعمارية لن يسمح لنا بالتقدم ولو خطوة نحو جمهوريتنا؟
ها أنا اليوم أنظر إليك بارتباك، لا أملك كلماتي. ترى هل فرّقتنا «الثورة»؟ لا أظنّ. فرّقنا الزلزال عن أنفسنا. ابتلع الأخدود كثيرين منّا، الناجون يقاومون ببسالة الطاعون والكوليرا. الدكتور فاوست أصله عربي يا صديقي، يصفق للتتار ويرقص معهم على قبورنا. ليت الزمن يعود قليلاً إلى الوراء، إلى اللحظة التي كان فيها كل شيء ممكناً. أربع سنوات ولم نعتد على غيابك، نستحضرك مع آخرين، لنستعيد نقاط ارتكازنا. شخصياً لدي نقاش مؤجّل معك عن أفلام غودار، وفيلمك عن رفيق الحريري. «هناك أشياء كثيرة…». عذراً عمر، تفاؤل ونّوس الثوري، استبدلنا به يأس تاركوفسكي. عذراً لأننا لا نملك أن نواجهك الآن سوى بخيبتنا العظيمة. علينا أن ننتظر قبل أن نشمّ مجدداً «رائحة الجنّة».
الأخبار