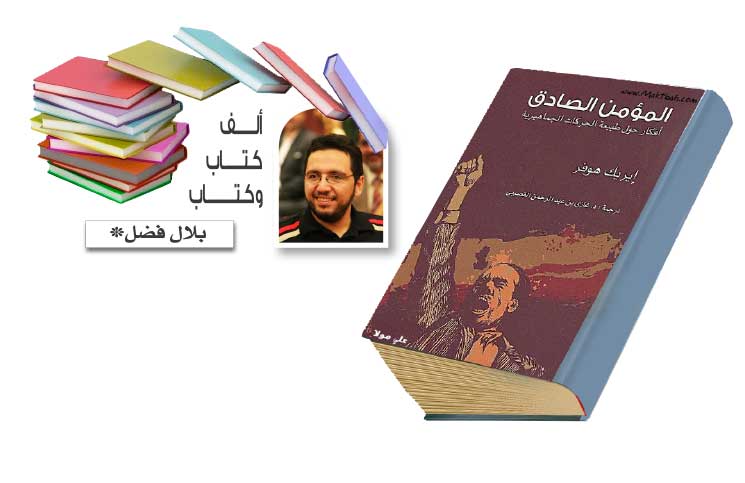عناية جابر، آلام بيروت تؤلمنا، لكنّها لا تجعلُنا نهجرُها/ عمر شبانة

في أحد فصول كتابها “لا أحد يضيع في بيروت” (دار عالم الفكر)، وهو يزيد على الخمسين فصلًا، تكتب عناية جابر، كما تقول “لمجد الكتابة الحيوية والرائعة، مجد الكتابة التي هي فخٌّ وهاوية، وشرايين زرقاء”. لذا نجدها، في كتابتها هذه، تراوح بين البوح عن الذات، والبوح عن العالم المحيط بها، وخصوصًا عوالمها الحميمة والأليفة، الحبيبة إلى القلب كما البغيضة. وفي الأحوال كلّها، تتنقّل بين عبارة سرديّة نثرية تمامًا، وعبارة مكثّفة ذات طبيعة شعرية، صورة أو استعارة أو مجازًا. لنخرج من الكتاب بـ”وليمة” من الأحاسيس والمشاعر، ومن التأمّلات المدهشة في الروح والقلب. هنا إضاءة على ملامح أساسية في الكتاب.
تتجلّى هذه العناصر كلّها تقريبًا، في النصّ الذي يحمل الكتابُ عنوانَه، فهو نصّ مركزيّ لغير سبب، خصوصًا أنّه يجمع صورًا من البوح، الذاتيّ والموضوعيّ، بل الكونيّ، إذ يذهب إلى قراءة الذات من خلال بيروت المدينة والشوارع، كما إلى قراءة بيروت مقارنة مع مدن عربية وعالمية.
في بيروت، نحن في مدينة بلا مداخل أو مخارج وما من خرائط بشـأنها. وهذه هي ميزة المدن التي تشبه “الأرحام والأحضان”. وبالتالي فإن بيروت هي “حضن كبير. حضن، هو ما يبحث عنه كل الناس، تستلقي فيه دافئاً ساخناً مُهدهَدًا. حضن يسع مُقيمين وأجانب، كبارًا وصغارًا. أبرياء وأشرارًا” .أما جَمال بيروت، فهو “خدرٌ وخامل”، أي أنّه الأجمل و”أجمل الجمال ما خمل”.
لكن بيروت، وفي الحقيقة، مدينة التناقضات، فهي إلى ذلك، ومقطع القول، وعلى العكس ممّا سلف، فإنّ “بيروت تؤلمنا بالفعل، آلامًا خفيفة، وخزات مُعذّبة سرعان ما تزول، وليست الآلام التي تجعلنا نهجرها. حروبها الأهلية، وحروب إسرائيل عليها، لم تقدر على لَمّنا من طرقاتها وشوارعها. نقطــعها غربية وشرقية، على وقع صوت المدافع وأزيز الطائرات وما تمنّ به علينا البوارج. هذه ليست بيروت كلّها، لكن لا أحد يضيع في بيروت. في التجوال في بيروت، شيء من حبكة الروايات. لا أحد يضيع في بيروت. أستغرب أحيانًا، أن تقع الكلمات في سياقها الصحيح رغم كل الألم”.
إنّها، في نصّ آخر “المدينة تنام غلط”، ففي عيادة طبيب لفحص الثدي المتورّم، يصف الطبيب حالة المريضة وسببه بأنه النوم الغلط على الصدر، وهو نوم يؤذي الثدي، لذا فهي تستعير هذا التوصيف لوصف بيروت والمرض الذي تعاني منه “أفكّر في مرض المدينة العُضال”، المدينة “تنام غلط، تتصرّف غلط. المدينة ورْمانة (من الورم)، ولا أحد يعرف حتى اللحظة سبب تورّمها”. إنّها، لو توخّينا الدقّة، مدينة عناية جابر و”بيروتها”، خاصّتها التي قد لا يشعر بها على هذا النحو سواها (عناية)، الشاعرة والناثرة والصحافيّة، وصاحبة الصوت العذب حين تغنّي أغاني “الطرب الأصيل”، في سهراتها الخاصّة، أو على بعض منابر الثقافة والفنّ البيروتية أو العربية.
العزلة هي الحياة
كثيرة هي “القصص” والحكايات والتأمّلات في هذا الكتاب، لكنّنا نتوقّف، في بقيّة النصوص، عند الأبرز، ونقف على مزيد من البوح والتأمّل، تأمّل في المكان والإنسان، في الحبّ خصوصًا، وفي العلاقات عمومًا. علاقة الأنثى بذاتها، بروحها وبجسدها، بأوهامها كما بوقائع حياتها اليوميّة. علاقتها بالآخرين، صديقات وأصدقاء وزملاء عمل وعابري طريق. واقعيّين حينًا، وهميّين أحيانًا. ترى نفسها من خلالهم، وتراهم في مرآة روحها التي تحمل تناقضات جمّة، الفرح والشقاء، الحلم والياس والأمل. وهي في كلّ الأحوال صاحبة مزاج خاصّ، كثيرًا ما تطغى عليه سوداوية مفاجِئة، تكسر ميزان اعتداله، وتجعل منها هي فكرةً في مهبّ الأفكار المتلاطمة.
في نصّ بعنوان “نهاية طبيعية”، نحن حيال “قصّة” علاقة، تسردها الكاتبة بصوتها هي، عن صديقة لها بلغت العلاقة معها حدود “التجمّد”، لسبب بسيط وغريب لا يخطر في البال، وهو أنّ صديقتها تنام بعد الغداء “لطالما عذّبتني فكرة أن لي صديقة تنام بعد الغداء..”، كما أن لا جديد فيها، لذلك نرى “الراوية” وهي تفكّر في شراء هدية عيد ميلاد لصديقتها، هدية قادرة على أن تنهي صداقتها التي خفتت وبهتت، وصديقتها لم تعد “صديقة حقيقية” لقد “فقدتْ نكهتها”.
إنها، كما تكتب في نصّ بعنوان “أمام البيانو بقدمين حافيتين”، تصف نفسها بأنّها “الفصاميّة الأبديّة”، وهي حين تعزف، تودّ “تدمير كل أشكال الهارموني”، مصابةً بهذا “اليأس المُغذّى جيّدا”، وتشكو “كلّ هذا الجفاء الأحمر”. واستطرادًا، بل استكمالًا لهذه السمة الروحانية، الفصام واليأس، فهي أيضًا تصف نفسها “أنتمي للشرفات.. لغبار الشارع، وأتنكّر للتجمّعات”، إذ تعتقد أن التجمّع، مهما كانت صيغته أو صورته، يسلبها استقلاليّتها و”فردانيّتها”، فتذوب فيه رغمًا عنها، أو كما تقول تشعر بـ”رعب الانمحاء في الجموع”. ما يجعلها تميل إلى “العزلة الكلية، بما هي حياة حقيقية يؤذيها الكشف والتظاهر”.
وهذه فكرة صائبة، يشعر بها المبدع الحقيقيّ، لذا لا تتورّع عن الاعتراف بأنّها في التجمّعات ينتابها “الخوف في ظل الجموع الهاتفة، حيث كلّ كلمة هي حادثة قتل”. وتصف حالتها بعد مشاركتها في إحدى التظاهرات “أصابني الغثيان. من ذلك الغثيان شيّدتُ عزلتي الضخمة من اعتقادي بأنّ الهتاف الجيّد شيء مخبوء في أعماقنا، وتقوّضه الأصوات الحاسرة في علنيّة الشوارع، تحت شمس لاهبة أو سماء ماطرة”. وكذلك فإنّ “فكرة الحشد، التجمهُر، ترعبني”. وباختصار، هي ترى أنّ فكرة تواجدها مع أكثر من شخصين أو ثلاثة على أكثر تعديل، “تُسقطني مريضة”. وتوغل في رسم صورة هذا الخوف من “الفريق الواحد، والمكان الواحد.. الهتاف الواحد والنبرة الواحدة”، وتختم أحد نصوصها بكونها لا تحبّ أن تبدو “أقلّ جمالا، ولا لحظة واحدة”.
ولا يغيب عن البال، في أثناء الكتابة عن نصوص عناية هذه، عنايتُها بخياراتها اللغوية، في ما يتعلّق بعالم العزلة والوِحدة، فهي بارعة في اختيار الصور والمفردات الغنية، والكفيلة بإشباع المعنى، كما لو كانت ترسم أو تصوّر أو تغنّي. نقف هنا على هذه العبارة التي تختزل الكثير من المشاعر والأحاسيس، حتّى لتبدو الوحيدة مفتونة بوِحدتها ومزهوّة بعُزلتها “كنتُ وحيدة على أفضل وجه.. وحيدة بشكل مذهل”. إنها مشاعر غريبة، بل سرياليّة إلى حدّ بعيد، فهي التي تعتبر، كما في عنوان النصّ الأخير في هذا الكتاب “يحقّ لي أن أكون غريبة”.
مزاج الشاعرة وتدابيرها
وإذا جاز اعتبار هذا الكتاب “ملامح” من سيرة عناية نفسها، نرى كيف ينعكس المزاج الخاصّ للكاتبة/ الشاعرة، في كتابتها لقصيدتها، بل في ما تسمّيه، ضمن رحلة كتابة القصيدة، تسمّيه “تدبير الشعر”، الذي يختلف في رأيها، عن “الشعر” ذاته، إذ إن “التدبير له طريقته المثيرة في التصادم والترنّح، وفي تقويض العبارات الروحيّة البسيطة، وإلقاء ظلال الشكّ على براءة العاطفة نفسها”. وهي تستمرّ في وصف عمليّة “التدبير” هذه، وصولًا إلى أن ترى كيف تطوّرت القصيدة، حتّى أصبحت “كما لو معبد صغير”.
وفي تأمّلاتها لمزاجها الروحانيّ، تأخذنا في رحلة مع “أيلول”، وفصل الخريف، فتعرّج على أجمل ما لحّن فيلمون وهبة وغنّت فيروز “ورقه الأصفر شهر أيلول”، لكنّ تأمّلاتها تأخذها إلى خلاصة أن “العالم يستقيم في أيلول”، وأنّ “الصيف والحرب متلازمان”، و”مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح للأيام هدف، ومذاق، ولا يعود يتخلّلها أية شكوى”، ما يجعلها صاحبة مزاج خريفيّ في أغلب أحوالها ومقاماتها، بل في جلّها.
عناوين كثيرة كان ينبغي الوقوف على “سحرها”، عناوين النصوص ابتداءً، والعناوين التي يمكن لنا استخلاصها من داخل النصوص، بوصفها مشاريعَ لنصوص “مبيَّتة” أو قادمة. لنختم، مثلًا، في علاقتها مع كتابها الأول، حين تراه في مكتبة صديق لها، فهي ابتداء شعرت بجدول صغير من الذكريات، ثم “حملتُه بنفور وافتتان”، لكنّها سرعان ما تقول “احتويتُه بين يديّ، وغمرني عطفٌ على كتابي ورغبة في حمايته، وكثير من الفضول”، وتختم “من يتذكّر كيف كانت أولى قصائده؟”.
ضفة ثالثة