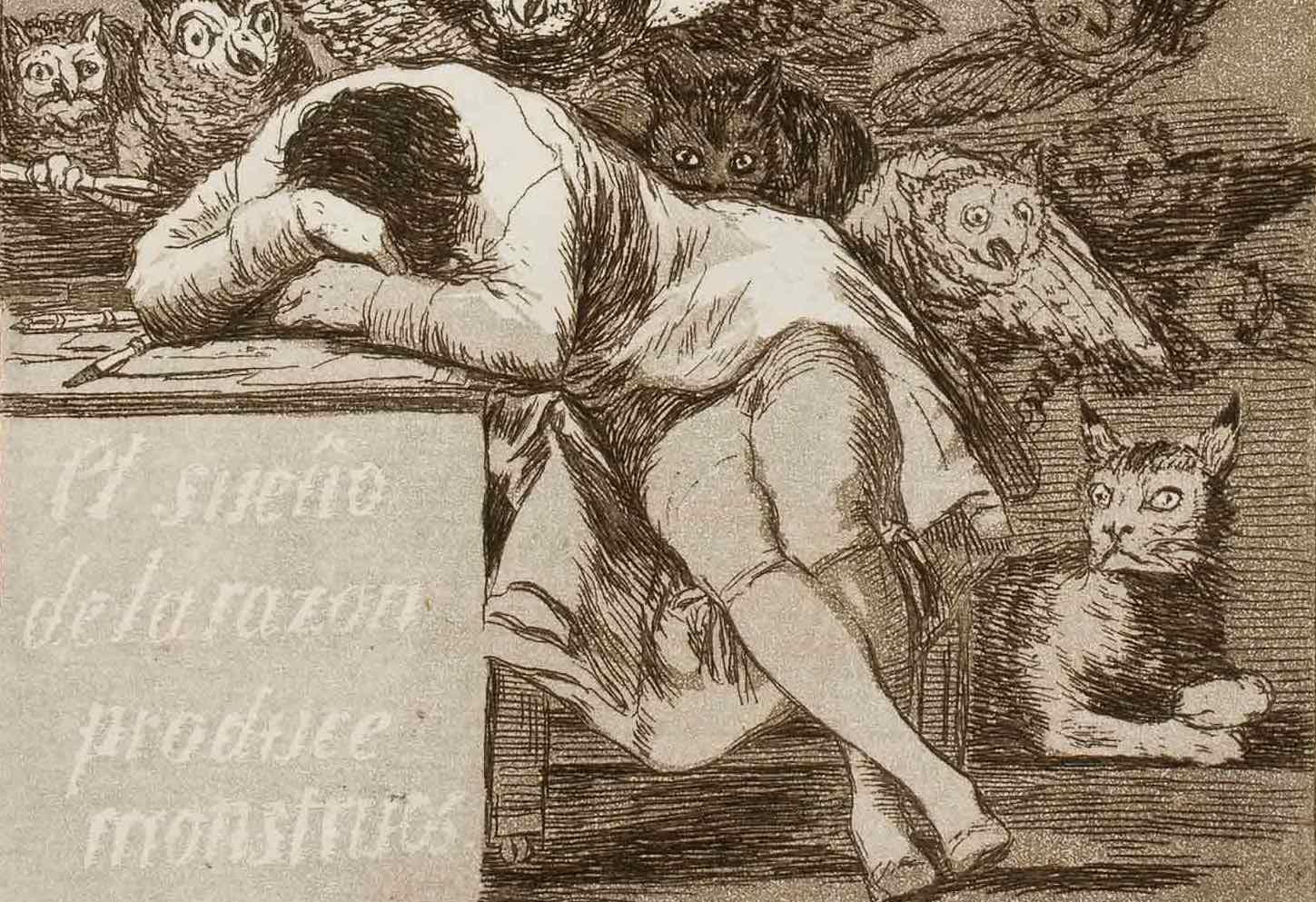عندما تدخل الإمبريالية في حساب الممانعين… فتصبح «أسرة دولية»

دلال البزري
حفظنا غيباً «المؤامرة التي تقودها الامبريالية والغرب بدعمها المسلحين السوريين». آلة «الممانعين» الدعائية، الرسمية وغير الرسمية، لم تقصّر في تنويع إنشاد هذه النغمة، بصياغاتها الجماهيرية والنخبوية في آن. ثمة من يقولها هكذا، من غير مواربة ولا تفلسف؛ وثمة من يقدمها بعبارات رصينة، «هادئة»، «مدعومة». والإثنان لا يخطآن هدفهما. إنغرزت الفكرة في أعماق «العقل الممانع». صارت دعامة صلبة من هيكله. ولشدّة رسوخها، لا يناقضها شيء. حتى لو ترافقت مع فرع آخر من فروع هذا «الفكر». وقوامه ان النظام السوري يخوض، أيضاً، في هذه الأثناء، حرباً شرسة ضد الارهاب المتمثّل بالـ»القاعدة» و»المسلحين السلفيين».
كيف؟ كيف يكون النظام بصدد مواجهة عسكرية مع المتآمرين الإمبرياليين، ومع «القاعدة» ونظيراتها الإرهابية في آن واحد؟ وهل الامبريالية والغرب في حالة وئام مع «القاعدة»؟ طبعا، لا إجابة محددة… فقط غمْغمات وتمْتمات تقتل الرغبة بالمتابعة. فالمهم بالنسبة للآلة الدعائية هو زرع الفكرتين، وإعتماد التكرار، البسيط أو المفذلك.
حسناً. مرّرنا التناقض الصارخ بين الفكرتين. ولكن ماذا نفعل عندما تنتقل الآلة ذاتها من التعبئة الدعائية إلى ما يشبه التحليل؟ ماذا نفعل بتلك الفرحة الخبيثة التي تغمر قلوب الممانعين عندما ينتقلون من «حق الشعوب المقدس بالتصدّي لمؤامرات الامبريالية» إلى التدقيق بميزان القوى المتحكم بالحرب بين الشعب السوري ونظامه؟ ماذا يقولون عندما ينتقلون من مستوى الترويج للـ»حق» الذي يدافع عنه النظام، الى مستوى «القوة» التي يستندون اليها في حربهم التي يصفونها بالـ»عادلة»؟ يرتفعون كعباً في «فكرهم»، ثم يفركون أيديهم بشبق الذين سوف يربحون حتماً، ثم يقولون: «لا خوف علينا. الأميركيون (لاحظ، بداية، «أميركيون» لا «امبرياليون») لا يريدون، لا يستطيعون التدخّل عسكرياً. هم أصبحوا ضعفاء. هم مشلولون الآن. خسروا حرب العراق وافغانستان، وها هم يلمْلمون أشلاءهم في أنحاء الارض. فيما الروس والصينيون، حلفاؤنا، صاعدون، يمْلون إراداتهم، يحبطون، يقزمون النفوذ الغربي. هؤلاء أصدقاؤنا الموثوقون…». إلى ما هنالك من عبارات أو معاني تتسرب مما تكتبه الأقلام «الممانعة» وما يفيض عن جلسات السمر السياسي، حيث يتغنون بقوتهم التي لن تهزم، وتاريخ المنطقة، وصواريخ حلفائنا المنصوبة هنا وهناك الخ.
الفرع الأصغر من محور الممانعة، فريق «حزب الله» وإخوانه في لبنان، لم يخرجوا عن هذا «الخط الفكري». منذ اندلاع الانقسام الوطني حول سلاح هذا الحزب عام 2005، لم تنطفء شعلة الاتهامات ضد الداعين الى نزعه: إنهم عملاء الإمبريالية والصهيونية، الذين ينفذون «المشروع الأميركي في المنطقة»، والقاضي بإقامة «فوضى خلاقة» ضمن «شرق أوسط جديد»… الى ما هنالك من أوصاف عبّدت الطريق لتخوين كل من تسوّل له نفسه التعرّض لهذا السلاح الالهي.
وطبعاً، عندما انفجر الشعب السوري بثورته، كان من السهل إدراج فكرة المؤامرتين الامبريالية والقاعدية في سياق عمالة وخيانة الداعمين لهذه الثورة والمناهضين لهذا السلاح. في الصالونات أيضاً، الجو أكثر استرخاء. فالفرع الأصغر من محور «الممانعة» مطمئن تماما الى ان الحكومة التي فرضها على اللبنانيين تحظى بدعم قوي من الإمبريالية نفسها.
لكن هذا الكلام خرج من الصالونات، بعد تفجير الأشرفية، وفرض نفسه على الاعلام، المكتوب خصوصاً، وصار التغني بموقف الأسرة الدولية (بعد «الامبريالية») باب من أبواب الشماتة بخصومهم؛ بعدما كالوا لهم كل أوصاف الخيانة والعمالة. لمن لم يتابع الوضع اللبناني بحذافيره: حصل تفجير في أحد أحياء بيروت المكتظة، لا يشك أحدٌ، حتى الممانعين في ما يشبه سريرتهم، بأن النظام السوري ارتكبها. وقد أودت بحياة أبرياء، فضلا عن أقوى شخصية أمنية متابعة لجرائم النظام السوري. المعارضون للحكومة طالبوها بالاستقالة على أثر هذا الانفجار. دول الغرب لم تبارك تحركهم، أو قلْ انها اعتمدت إلتباسا واضحاً. وقد بنى عليه محللو وكتّاب الممانعة رأياً، فرحاً ومتفائلاً. بماذا؟ بما أبداه خصومهم المعارضون من قلة فهم، وقلة دراية، قلة حساب… للواقع «الدولي». بقدرة قادر، انقلب الوحش الامبريالي، من صاحب مشروع…. إلى حكيم، يزن الاستقرار بميزان من ذهب… فما بالك لو تجاوز الأمر مجرد الالتباس؟
السينيكية السياسية هنا صادقة، غير مواربة. إبتعدْ قليلا عن آلة التعبئة، فماذا تجد؟ خطاب يقوم على مستويين متنافرين: «الحق»، حق الشعوب بتقرير مصيرها، بالتحرر من الهيمنة الإمبريالية. هذا حق بديهي، ينطبق على جميع الإمبرياليات. و»الممانعين» يحصرونها بالامبريالية الاميركية. وعندما تقف هذه الامبريالية ضد خصومهم، في تكرار لإختلال ميزان القوى لغير صالح هؤلاء الخصوم، يحضر منطق آخر، مناقض لتقرير المصير وحرية الشعوب. تصبح القوة العارية من أي حق هي التي سوف تحمل هذا «الحق إلى أصحابه الأصليين». وإذا أضفتَ الى ذلك عضوية العلاقة القائمة بين هؤلاء الممانعين وبين ايران، أي خارج مراكز قرارهم الوطني الحرّ، تدرك فداحة الاستهزاء العميق الذي تكنّه هذه العقول الكبيرة بعملية «مقارعة الامبريالية». أصحابها لا يؤمنون حقيقة بإستقلالية قرارهم، ولا بامكانية قيامهم بذاتهم. وذلك مرتين: مرة بارتباطهم العضوي بالخارج «الممانع»، ومرة باعتمادهم على حسابات فلكية تقول بأن الامبريالية لن تتدخل، لن تقوى، لن تتجرأ على التدخل للدفاع عن عملائها، القائمين بأعمالها.
والغريب ان هذه السينيكية، التي يفترض بها شيئاً من الإعتداد بالنفس، تستند في الواقع الى شعور متجذّر بالدونية تجاه «محور الشرّ» الأميركي، بحلفائه كافة. لا يبحث «الممانعون» عمن يصدّق على انتصاراتهم ومهاراتهم ومقاوماتهم إلا في التقارير الغربية: صحافة، مراكز تخطيط وتفكير، تصريحات…. تقرير فينوغراد الذي استهلكه «حزب الله» وحلفاؤه حتى الثمالة للبرهان على «النصر الالهي، الاستراتيجي…». ما أن يصدر شيء من هذا القبيل، يتناول الممانعين ايجابا أو تأكيدا على قوتهم ورهبتهم، إلا وينتقل ويذاع على الأثيرين. لسان حالهم يقول: «انظروا ماذا يقول عنا الشيطان الأكبر…! هل تريديون شهادة كفاءة أقوى من هذه؟ هل صدقتم الآن اننا…؟»الخ.
على المنوال نفسه، يتنهدون ويتأوهون أمام مثقفين غربيين يكرهون ثقافة بلادهم ونظمها، ويعوضون عن ذلك بحبهم الغامر للشعوب «الممانعة»، فيسهمون فكرياً في تثبيت دعائم «فكرها» السائد. روجيه غارودي يكرَّم ويهلَّل له، لأنه ينكر المحرقة اليهودية على يد النازية. تييري ميسان، يقيم صلات حميمة واحتفالية مع البعثيين وشركائهم بعدما يؤلف كتاباً عن تفجيرات 11 سبتمبر يقول فيه ان «القاعدة» بريئة منه وان اليهود هم مرتكبوها. نعوم تشومسكي، يبخَّر له ويطبَّل، لشدّة ما يكره النظام السياسي لبلاده، وقد نال مؤخراً الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية في غزة….
نحن هنا في صلب حب كراهية الغرب وأميركا… وأكثر المصابين بهذا الداء هم جماعة «الممانعة»، المستعدون دوماً لتفسير الكون كله بداء قدرات أميركا الخارقة الشريرة، والعاملين في الخفاء على الإستعانة بضعفها. قد يكون من الطبيعي صدور هذا التناقض من السياسيين الباحثين عن مجرد سلطتهم، عبر تجييشهم لتقليد الكراهية للغرب. أما أن يكون غالب هذا الداء من نصيب دعاة حرية مفترَضين، فهذا محض هراء. وذلك لسبب بريء جداً: ان الحرية تتعزّز بالمعرفة. ومعرفة الامبريالية لا يمكن ان تتم عبر هذا النوع من الشعوذة السياسوية. لا الشعور بالنقص تجاه الغرب يعرفنا عليه، ولا الكراهية السينيكية تمكننا من سرّ تفوقه علينا. ذلك انه، رغم تراجعه، ما زال الغرب متفوقاً علينا. مهيمنا على ثقافتنا ومقررا لقدر لا بأس به من مصيرنا.
ذلك من دون حساب امبرياليات قادمة… والصينية على رأسها.
المستقبل