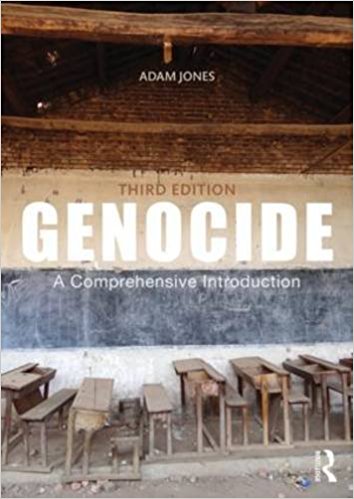عن اختلاف السرديات ومغالبة الهويّات
ماجد كيالي
يبدو أن ثورات الربيع العربي فتحت كل الصناديق المغلقة، وأفرجت عن كل القصص المحجوبة، وأطلقت كل السرديات المسكوت عنها، بحيث أنها وضعت المجتمعات العربية دفعة واحدة، وبطريقة فجائية، وربما تصادمية، في مواجهة ذاتها، وإزاء التعدّد والتنوّع، كما المختلف والمشترك، فيها.
ومثلاً، ليس في مصر مسلمين وأقباط، فقط، فأمّ الدنيا فيها عدا عن ذلك نوبيين وبدو وربما ثمة أمازيغ، أيضاً. وفي السودان ثمة تشكيلات مختلفة لاتتوقف على الانتماءات الدينية، فثمة عرب وأفارقة، وثمة فوقها تنويعات اثنية متعدّدة. هكذا الأمر بالنسبة للعراق ولبنان وسورية والأردن، أو المشرق العربي، الذي يتشكّل من فسيفساء من الأديان والاثنيات، وان كانت الغلبة لأرومة قومية معينة، ولطائفة دينية محددة.
هكذا بتنا نعرف أن المتوحّد ليس كذلك حقاً، وأن ثمة سرديات تعيش في الظلال، أو في حالة تعتيم مطبق، وأنّ هذا التوحّد القائم على الهيمنة، والحجب، والكبت، يحمل في طياته عوامل انفجاره وتشظيه، إن لم يتم كشفه ومواجهته والإفساح عن حيّز مناسب له في المجال العام.
وفي الحقيقة ليست المشكلة في التنوّع والتعدّدية، وإنما في محاولة إخفائها أو في محاولة قتلها، ذلك أن هذين (التنوّع والتعدّدية) ربما يكونا عامل حيوية وإثراء وقوّة للمجتمعات المعنية، في حال توفّرت لذلك الإدارة المناسبة، والنظام السياسي الملائم، والثقافة المنفتحة والمتسامحة.
وحقاً فإنه لمن المدهش، مثلاً، أن ترى في بلد حديث، من الناحية الزمنية، كالولايات المتحدة الأميركية، التي يقاس عمرها ببضع مئات من السنين، تعايشاً سليما بين مواطنيها الذين يتحدّرون من كل أجناس الدنيا وأديانها. وأن يحدث ذات الأمر، أيضاً، في بلد موغل بالتاريخ مثل الهند، مع مليار نسمة.
في مقابل هذين البلدين فإن واقع البلدان العربية يبعث على المرارة، والحسرة، لاسيما مع اعتبار العرب لذاتهم بمثابة امة عريقة تمتد لآلاف السنين، ومع اعتدادهم بلغتهم العربية، وبثقافتهم المشتركة، إذ أن كل ذلك لم يجعل التعايش في المجتمعات العربية سليماً، وبنّاءً، ولم يؤمن الهوية الوطنية أو القومية الجمعية، على النحو الحاصل في الهند أو الولايات المتحدة، مع ما نشهده من سيادة الانتماءات قبل الوطنية (الإثنية والدينية والعشائرية والمناطقية) في مختلف البلدان العربية.
واضح ان الفارق يكمن في أن الدولة في الهند، وفي الولايات المتحدة، انبنت على المواطنة الفردية، أي على العقد الاجتماعي بين المواطن الفرد، الحر، والدولة، وليس على العقد الاجتماعي بين الدولة، والجماعات الاثنية أو الدينية. ذلك أن غياب الدولة، باعتبارها دولة مؤسسات وقانون ومواطنين، ينفي الفرد لصالح الجماعة الدينية في أحوال معينة، والاثنية في أحوال أخرى، والتي ينتمي إليها ليس بخيارة الحرّ والخاص وإنما من خلال الولادة والوراثة؛ اللتين تؤبّدان الهويات والعصبيات ماقبل الوطنية.
وبديهي فإن هذه الهويات، كالهويات الوطنية، تنبني على التخيّل، وعلى صوغ سرديات جمعية، قد يكون لها تمثّلات في الواقع، لكن الزمن والذاكرة والمخيّلة، والحاجة إلى إضفاء قيم من مثل المجد والألم، البطولة والمأساة، تعلي من شأنها، وتجعلها بمثابة حقيقة إيمانية مطلقة، ولا جدال فيها.
المشكلة هنا أن الزمن القائم على المحو والاضطهاد يلعب لعبته بطريقة ماكرة، فكلما تعرضت هوية ما لمحاولة محو كلما انغرست أكثر في الذاكرة، ما يمنحها مع طول الوقت، ومع الشعور بالاضطهاد، ردود فعل دفاعية، تتجلى في إضفاء بعد ميتافيزيقي وأسطوري على السردية، التي تتحول من كونها مجرد سردية ثقافية إلى كونها سردية حياة، وسردية مقاومة، وسردية مجد وبطولة، ولعل هذا ما يفسّر أن معظم السرديات تنطوي على حكاية كبرى تتشابه بقدر ما تتواجه مع بعضها.
بديهي أننا سنصادف بين تلك السرديات روايات غالبين ومغلوبين، وروايات منتصرين ومهزومين، لكن الروايات التي تنطوي على شعور الضحية، أي على المأساة والألم، هي التي تبدو أكثر صلابة، وأكثر عمقاً، وأكثر عناداً، وأكثر انغلاقاً، لأنها سرديات وروايات تنطوي على روح مقاومة، في حين أن سرديات وروايات الغالبين تبدو أكثر انفتاحا واستيعابا وتسامحاً. ومن المفهوم أن الروايات الأولى هي روايات “الأقليات”، التي تخشى على ذاتها من الذوبان ومن الانفتاح، في حين أن الثانية هي روايات “الأكثريات”، لأنها تبدو أكثر اطمئنانا لأحوالها، ولوجودها.
بديهي أن في كل بلد ثمة “أقلية” ما تدّعي بأنها تعرضت للظلم ولعمليات التذويب لكن مشكلة هذه الروايات ليست صحة ما تدعيه، فثمة شيء صحيح في كل رواية، وإنما مشكلتها في إضفاء بعد أسطوري على ذلك، وفي محاولاتها إثبات أن ثمة بعد جوهري عند الآخرين يدفعهم لاستهدافها ومحوها، أو إضعافها، كما أن مشكلتها الأكبر في ادعائها احتكار مكانة الضحية.
في منطقتنا، مثلاً، ثمة حكايات وسرديات كثيرة ومؤلمة من هذا النوع، لكنها لا تقتصر على جماعة دينية أو اثنية معينة، بحكم خضوع هذه المنطقة للسيطرة العثمانية، وبحكم تعثّر قيام الدولة، باعتبارها دولة مؤسسات وقانون ومواطنين، الأمر الذي كرّس الانتماءات الأولية (الدينية والاثنية والعشائرية)، لاسيما أن النظم الاستبدادية استمرأت ذلك لتأبيد سلطتها. ومن مراجعة الحوادث التاريخية على امتداد القرون الماضية يمكننا أن نشهد أن ليس ثمة قصة لطائفة معينة أو لأرومة قومية معينة لاتشابه قصصاً أخرى لطوائف أو اثنيات أخرى.
هكذا، ثمة شيء مصطنع في الصراع الهوياتي، الذي يبدو فيه الجميع بمثابة ضحايا في مواجهة ضحايا، وهذا قمة المأساة، وهو ناجم عن وجود نوع من شعور مزيف عند كل جماعة هوياتية بأنها مستهدفة، والانكى بأنها تحتكر مكانة الضحية، في واقع ليس فيه سوى ضحايا، تشكّل أكثريات، في مواجهة أقلية هي السلطة المستبدة.
وتفيد التجربة بأن الاستبداد لا هوية، ولا دين محدد له، فقد يتلبّس لبوس الدين حيناً والعلمانية حيناً آخر، أو الليبرالية أو اليسارية أو الشيوعية أو القومية أو الوطنية أو الأممية وربما الديمقراطية. وفي الواقع فإن الاستبداد لاينتهي إلا بانتهاء أسسه. هذا يتطلب عقداً اجتماعياً يقيم دولة مواطنين أحرار، وفصل السلطات، والمساواة أمام القانون، من دون تمييز من أي نوع، وضمنه احترام حريات وحقوق الأفراد، والجماعات، وتداول السلطة. ففي هكذا دولة فقط لايوجد أقليات واكثريات هوياتية، دينية أو اثنية أو عشائرية، ولايوجد انقسامات عمودية، وإنما ثمة مواطنين يختلفون ويتفقون على مصالح وتوجهات سياسية واقتصادية.
قصارى القول، لايوجد في التاريخ سلطة نسبة إلى دينها، أو مذهبها، هكذا لم يحكم السنة لكونهم سنّة، ولا الشيعة لكونهم شيعة، ولا الدروز لكونهم دروزاً، ولا العلويون لكونهم علويين، ولا الكاثوليك لكونهم كاثوليك، ولا البروتستانت لكونهم بروتستانت، ولا الهندوس لكونهم هندوساً، ولا البوذيون لكونهم بوذيين. ثمة سلطة حكمت باسم هذا الدين وهذا المذهب وهذه الإثنية. ليس للسلطة المستبدة دين معين، فديدنها التحكم بالبلاد والعباد.
المستقبل