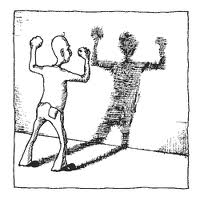عن «الإخوان المسلمين» في تعدّد أطوارهم/ حازم صاغية
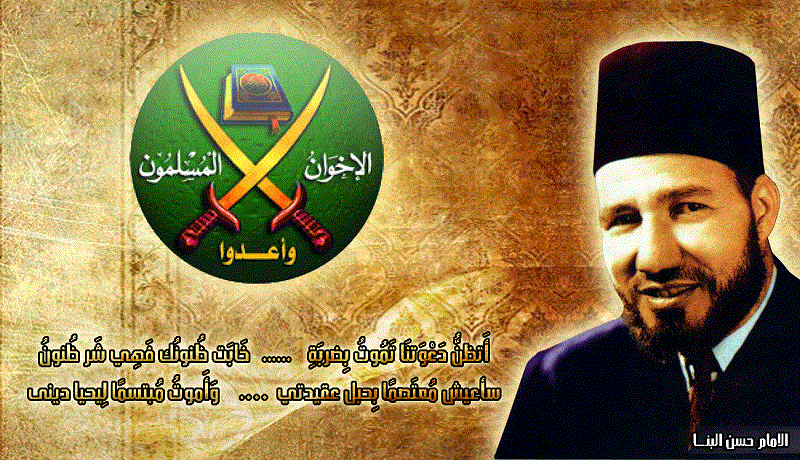
لدى الحديث عن مستقبل جماعة «الإخوان المسلمين»، وعن مستقبلنا معها، لا بدّ من العودة إلى المحطّات الكبرى في تاريخ هذه الجماعة، وإلى الأسباب الكثيرة التي قد تفسّر قوّتها، أو ضعفها، في هذه الفترة أو تلك.
فكما نعلم جميعاً، نشأ «الإخوان المسلمون» في 1928 في مدينة الإسماعيليّة، حيث يحظى الزمان والمكان بأهميّة ملحوظة. فآنذاك كانت السيطرة الغربيّة على مصر والبلدان التي تقطنها أكثريات مسلمة قد تمت واستُكملت. لا بل راح الحضور الغربي يتمدّد من الحيّزين العسكري والسياسي، بإملاءاتهما الاستراتيجية، إلى الحيّزين الاجتماعي والثقافي – التعليمي، حيث تُكتب له الهيمنة. أمّا الإسماعيليّة فكانت، في وقت واحد، مقرّ قيادة القوات العسكرية البريطانية والمركز الرئيس لعمليات التبشير المسيحي.
وفي الخلفية الإسلامية الأوسع، كان مصطفى كمال أتاتورك قد ألغى الخلافة في تركيا عام 1924، بعد عامين على إلغائه السلطنة العثمانية. هكذا بدا الحدث التركي مكمّلاً الهزيمة في مواجهة الغرب العسكري والسياسي والثقافي سواء بسواء، وإعلاناً مدوياً عن افتقار العالم الإسلامي إلى كلّ شيء في مواجهة العالم «المسيحي» الذي يملك كلّ شيء.
غني عن القول أن تلك الشروط التي دفعت حسن البنّا إلى أن يبدأ المشروع الذي بدأه، قد تغيّرت كثيراً. صحيح أنّ العالم الإسلامي لم يتوقّف مذّاك عن التراجع والضمور، إلا أنّ الفاصل بين «الذات» و «الآخر» تعرّض في تلك الغضون إلى تقلّص ملحوظ. وهذا ما يُستدلّ عليه، بين أمور أخرى، في اكتشاف «الإخوان» اللاحق مساحاتٍ مشتركة مع القوى الغربية إبّان تنازعهم مع الناصرية، أو في الاستعدادات الراهنة لديهم للحوار أو التعاون مع هذه الدولة الغربية أو تلك. وعلى رغم الاستمرار في إنتاج تلك الأدبيات السقيمة عن «المؤامرة» و «الصليبيّين» و «الكفّار» من مسيحيّين ويهود وماسونيّين، بات يُشكّ كثيراً في قدرة الوعي المضادّ للغرب على إحداث التعبئة التي كان يُحدثها في النصف الأوّل من القرن العشرين.
أمّا المحطّة الثانية فكانت في الأربعينات. فبالاستفادة من مناخ الصراع الوطني المصري ضد البريطانيّين، وفي ظلّ تأثر عام للحركات الوطنية في عموم «العالم الثالث» بالفاشيّتين الإيطالية والألمانية، وكل هذا معطوفاً على أوضاع داخلية مأزومة اقتصادياً وسياسياً، حقّقت جماعة «الإخوان» نمواً ضخماً بحيث قُدّر عدد منتسبيها في مطالع ذاك العقد بخمسة ملايين شخص. وقد ترافق النمو هذا مع إنشاء «النظام الخاصّ» في 1940 بوصفه ميليشيا إرهابية صنعها التأثر بالفاشيّة في ظلّ النزاع مع بريطانيا.
توّج هذا المسار نفسه، في أواخر الأربعينات، وفي موازاة الصراع على فلسطين ونشأة دولة إسرائيل في 1948، عنفاً مفتوحاً. هكذا، شهدت مصر حروب الشوارع مصحوبة بالاعتداءات «الإخوانية» والقومية المتطرفة على اليهود المصريّين، كما شهدت اغتيالات سياسية كالتي حصدت رئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي، قبل أن تودي بحسن البنّا نفسه.
ومسارٌ كهذا مُستبعد اليوم هو الآخر. فالفاشية الأوروبية التي انهارت في الحرب العالميّة الثانية، لم تعد مصدر استلهام وجذب، فيما الصراع العربي – الإسرائيلي فقد طاقته على التعبئة لينضوي في قنوات العمل السياسي والديبلوماسي البارد. وإذا صحّت هذه المعادلة في صورة عامة، فهي تبدو أكثر صحّة في مصر التي وقّعت، منذ أواخر السبعينات، معاهدتي كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل. ولئن تحفّظ هذا الطرف المعارض أو ذاك عن السلام المذكور، يبقى من الصعب الحديث عن معارضة جدية ومبدئية للسلام عند أي من القوى التي عارضت سياستي الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك.
لكنّ أواسط الخمسينات، وبعد عامين فحسب على انقلاب 23 يوليو 1952، افتتحت المحطّة الكبرى الثالثة. فبعد محاولة «الإخوان» اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر، اضطُهِدوا ونُكّل بهم وسيق الآلاف منهم إلى السجون.
لقد نمّ ذاك الصراع عن اصطدام جسدين سياسيّين متشابهين في نزوعهما الاستبدادي، ودليلُ هذا التشابه أنّ السلطة الانقلابيّة سبق أن استثنت «الإخوان» وحدهم، في بداية الأمر، من إجراءات الحل التي طاولت جميع القوى السياسية الأخرى. بيد أن تعرّض «الإخوان» للاضطهاد والتنكيل أكسبهم تعاطفاً كان من الصعب أن يحظوا به في ما لو استمرّوا حلفاء للسلطة ملحقين بها.
والوجهة الاسئصالية هذه بلغت ذروتها في أواسط الستينات، مع إعدام سيد قطب، منظّرهم الأكبر والأشدّ راديكالية الذي اعتمدته في وقت لاحق شلل الإرهاب الديني مرجعاً لها. إلا أن أواسط الستينات كانت أيضاً الفترة التي شهدت المصالحة الناصرية – السوفياتية بعد الخلاف المُرّ حول العراق والوحدة مع سورية. وبنتيجة المصالحة تلك عُهد إلى مثقّفي اليسار وإعلامييه، ممّن رضي حزبهم الشيوعي بحل نفسه نزولاً عند رغبة موسكو، بمهام ترقى إلى صناعة العقل العام في مصر.
في هذا المعنى يمكن اعتبار التطرّف الذي أبداه سيد قطب، لا سيّما في كتابه الأشهر «معالم في الطريق»، استجابة عكسيّة لما بدا تحديثاً وأدلجةً للاستبداد يتولّاهما مثقّفو اليسار والتحالف مع الاتحاد السوفياتي والشيوعية «الملحدة».
وهذه الظروف صارت، هي الأخرى، من التاريخ. فمثلما انهارت الفاشيّة بعد الحرب العالميّة الثانية، انهارت الشيوعيّة ودولها بعد الحرب الباردة. كذلك انعدمت الشروط، الخارجية كما الداخلية، لاضطلاع مثقّفي اليسار بدور مهيمن كالذي أُنيط بهم في أواسط الستينات. وأهمّ من هذا أن الناصرية نفسها ولّت وفات أوانها، مثلها مثل سائر نتاجات الانقلابات العسكرية التي عرفتها الخمسينات والستينات في عموم «العالم الثالث».
ومع الرئيس أنور السادات كانت محطة بارزة أخرى. فبعد شهر عسل طويل نسبياً، أريد فيه استخدام الإسلاميين في مواجهة اليساريين والناصريين، وفي مناخ احتدام الحرب الباردة ضد الشيوعية «الملحدة»، انقضّ السادات على «الإخوان» وسدّ في وجههم الحيّز الذي كان قد أتاحه لهم من قبل.
لقد تأكّد آنذاك أن «شرعية يوليو»، كائناً من كان المعبّر عنها، وكائنة ما كانت توجهاته السياسية التي يغاير فيها أسلافه، محكومة بصدام، يكاد يكون حتمياً، مع «الإخوان المسلمين». وهذا ما لم يغيّره الانتقال الكبير من التحالف مع موسكو إلى التحالف مع واشنطن، ولا إبدال الاقتصاد المستند إلى القطاع العام ودولة الرعاية باقتصاد «الانفتاح» الرأسمالي.
غير أنّ اقتصاد «الانفتاح» هذا أضاف سبباً آخر للتعاطف مع مظلوميّة «الإخوان» وضحويّتهم. ذاك أن انفجار المسألة الاجتماعية، لا سيما البطالة، بالتوازي مع انسحاب الدولة من وظائفها وتقديماتها، وفّر لهم فرصة الظهور بمظهر الراعي الاجتماعي، من خلال شبكات العون والإحسان التي ازدهرت في السنوات المديدة للعهد المباركي. وكانت الهجرة «الإخوانية» إلى السعودية والخليج التي بدأت في سنوات العهد الناصري، قد شرعت تطرح ثمارها، منتجةً بورجوازيين «إخوانيّين» ميّالين إلى تبسيط العمليات الاقتصادية وتلخيصها في أعمال العون والإحسان.
لكنّ الساداتية أفلتْ أيضاً مثلما أفلت الناصرية قبلها، وبعد أقلّ من عقد على اغتيال أنور السادات أُسدل الستار على الحرب الباردة جملة وتفصيلاً، فتكرّس موت الشيوعية كمادة للتعبئة الجماهيرية أو التحريض والاستنهاض.
أمّا المحطة الأخرى التي افتُتحت بقيام عهد الرئيس حسني مبارك، أواخر 1981، فبدأت ملطّخة بالدم. ذاك أنّ مبارك تصرّف منذ يومه الأول في الرئاسة بكثير من الثأرية مع «الإخوان»، ردّاً منه على اغتيال السادات على أيدي إرهابيّين إسلاميّين خرجوا من عباءة «الإخوان» قبل أن ينشقّوا عنهم. بيد أنّ الفرص القليلة التي حُمل العهد المباركي على إتاحتها لتلامذة البنّا وقطب كانت تكشف مدى قوّتهم وتنامي التعاطف معهم ومع مظلوميّتهم المديدة. هكذا أثبتوا، من خلال انتصاراتهم في انتخابات النقابات والجماعات المهنية، صلابة موقعهم التمثيلي في الطبقات الوسطى على تعدّد شرائحها، وكانوا على الدوام حاضرين في المدن كما في الضواحي والأرياف. وما إن أزفت انتخابات 2005 العامة، التي تسبّبت لاحقاً بالكثير من اللغط، حتى نالوا 48 مقعداً بدت كافية لإثارة الهلع في أوساط السلطة المباركية.
وقد سقطت المباركية بنتيجة ثورة يناير 2011، وانفتح الباب لمحطة جديدة في تاريخ مصر وتاريخ «الإخوان المسلمين» أنفسهم.
وعلى تقلّب تلك الأطوار وزوال الكثير من الأسباب التي أنعشت «الإخوان المسلمين» في هذه المرحلة أو تلك، فإنهم ظلوا قوة معتبرة في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية. وفي هذا السياق، يبقى عنصران يصعب القفز فوقهما، هما أكثر ما يفسّر دوام قوتهم في موازاة تحول الأزمنة.
أمّا الأول فإنّهم، بدعوتهم الخلاصية – الدينية وبتكوينهم الاستبدادي، تحولوا مركز الاحتجاج الأهم على تحديات التقدم. فقد يختفي هذا التحدي بذاته أو يختفي سواه، إلا أن التحديات التي يواجهها العالم الأبرشي القديم، لا سيما منه غير الأوروبي، لا تنقطع. وفي هذا تتشابه جماعة «الإخوان» مع حركات شعبوية كثيرة في العالم رفعت القوميّة أو الدين أو طرق الحياة المألوفة في وجه العولمة وطرائقها.
ولمّا كانت العقود الأخيرة قد دمجت صعود العولمة بإجراءات وسياسات اقتصادية حادة في نيوليبراليّتها، استطاع «الإخوان المسلمون» تقديم أنفسهم بوصفهم أصحاب البديل الاقتصادي الخلاصي، والتبسيطيّ بطبيعة الحال، وفي الآن نفسه الطرف الذي يخاطب مشاعر القلق والغموض ممّا يشوب المراحل الانتقالية الصعبة والمعقدة.
لكنّ العنصر الثاني الأهم، وهو مصري حصراً، فهو أن «شرعية يوليو» لم تتوقف عن العمل، على رغم ضمور الناصرية والساداتية والمباركية، وبغض النظر عن فوارق أساسية بين واحدتها والأخرى. وهذه الاستمرارية اليوليوية إنّما شكّلت مصدر القمع والتهميش اللذين انعكسا تعاطفاً متنامياً مع ظلامة «الإخوان» المتواصلة.
فإذا صحّ هذا التقدير أمكن القول أن نظاماً ديموقراطياً ينهي «شرعية يوليو»، كما يترافق مع تحسّن في الأوضاع الاقتصادية وفي فرص العمالة، هو شرط شارط لتغيير «الإخوان» أنفسهم. والتغيير المقصود هنا يستوحي تجربة الأحزاب المسيحية الديموقراطية في أوروبا الغربية والجنوبية ما بعد الحرب العالميّة الثانية، حين أدّت بها أهوال النازية والحرب إلى توسيع مسافتها عن قوى اليمين الأكثر تطرفاً، كما ساقتها إلى تعميق تجربتها الديموقراطية. وفي هذا المجال الأخير، حلّت درجة أكبر من الفرز بين التفويض السياسي المرهون بالانتخابات ونتائجها والتفويض الحياتي الشامل، ذي المنشأ الديني، والذي يفيض تعريفاً عن الديموقراطية. وعلى العموم يمكن القول أنّ الأحزاب المذكورة إنّما غدت أقرب إلى تمثيل وجهة نظر ثقافية وسياسية محافظة تمتثل للعبة الانتخابية ونسبية التفويض الذي تمنحه.
غير أنّ المسألة في الحالة المصرية تبدو أشدّ تعقيداً من هذا الافتراض الذي لا تحول صحته المبدئية دون طابعه الرغائبي.
ففضلاً عن أحداث كثيرة لا تتّسع لها هذه المقالة، كان الحدث الأبرز بعد ثورة يناير 2011 وصول المرشّح «الإخواني» محمّ مرسي إلى رئاسة الجمهورية، بوصفه رئيس الجمهورية الأول المنتخب في مصر منذ قيام الجمهورية.
إلا أن هذا الوصول الذي كشف عن قوة «الإخوان»، كشف أيضاً عن محدودية تلك القوّة. فقد نال مرسي في مواجهة أحمد شفيق، آخر رؤساء الحكومات في عهد مبارك، 7,51 في المئة من الأصوات فحسب. أهم من ذلك أن الانتقال من الدورة الأولى إلى الدورة الثانية رفع أعداد مؤيدي مرسي من 5 ملايين، هم قاعدة «الإخوان» الفعلية، إلى 15 مليوناً، أي أن 10 ملايين مقترع أعطوا مرشّح «الإخوان» أصواتهم، لا لأنهم يناصرونهم، بل لمجرد الرغبة في منع شفيق من الفوز.
وأهم ما تشي به هذه الحقيقة عجز الفئات العريضة التي صنعت ثورة يناير عن التقدم من الحلبة السياسية بصفتها هذه، أي من خارج الثنائية العريضة التي حكمت التاريخ السياسي والثقافي لمصر الحديثة، والتي تتشكّل من الجيش (وقد التحقت به «الفلول») والإسلام (معبَّراً عنه بـ «الإخوان المسلمين»، واستطراداً بالتنظيمات السلفية).
وهـــذا إنما يحمل على التذكير بحالات مشابهة استـــــطاع فيــــها رموز الطبقة الوسطى وشبانها أن يسقـــــطوا نظاماً، إلّا أنهم لم يستطيعوا، في المقابل، إقـــــامة نظـــــام بديل. لقد أطاح هؤلاء، مثلاً لا حصراً، النــــظام الشيــــوعي في الاتحاد السوفياتي السابق، غــــير أن السلطة استقرّت، بعد فترة التفسخ اليلتسني، في يد ضابط المخابرات السابق فلاديمير بوتين.
وتقودنا تجارب من هذا النوع إلى التفكير في صعوبات بناء الديموقراطية في البلدان التي تعاني ضعفاً في التقليد السياسي، ومن ثم ضعفاً في الحساسية الديموقراطية مشتركاً بين سائر الفاعلين السياسيّين.
لقد قدّم «الإخوان المسلمون»، خلال السنة التي حكم فيها مرسي، عديد الأمثلة على ضعف الإلفة مع طرق اشتغال النظام الديموقراطي، وهذا ما كثر تناوله في مصر وخارجها على السواء. فهم لم يفهموا حدود التفويض التمثيلي ونسبيّته، ولا أدركوا الفارق بين العام والخاص، أو بين الجماعة والشعب، لا سيما أقباط مصر ونسائها ومبدعيها، كما أبدوا جهلاً مطبقاً في مسائل أساسية تبدأ بالدستور وصياغته ولا تنتهي عند إدارة الحياة الاقتصادية. وفي غربتهم المتعددة المصدر عن السياسة، كانوا يحولون الانقسام السياسي أو الأيديولوجي بين المصريين إلى ما يشبه الخلاف بين «شعبين» في بلد واحد.
والحال أن «الإخوان» المصريّين، وعلى عكس «إخوانهم» الأتراك في «حزب العدالة والتنمية»، لم يصدروا عن تعطيل سياسي مديد فحسب، بل صدروا أيضاً عن افتقار كبير إلى المؤسسات المجتمعية الوسيطة التي يتعلّم الحزبيّون فيها السياسة كما يتعرّفون إلى اتّساع شبكة المصالح والأذواق والحساسيات في مجتمع تعدّدي ما. وفي هذا المعنى لم يرقَ مليونيرية «الإخوان» إلى بورجوازية الأناضول التي وقفت وراء نجاحات «العدالة والتنمية»، كما بقي البون شاسعاً جداً بين إعلامهم الهزيل والمتخلف وبين الطفرة التلفزيونية التركية التي بدأت في عهد تورغوت أوزال وانخرط فيها الإسلاميون الأتراك على أوسع نطاق ممكن.
إلّا أن خصوم «الإخوان» الذين نزلوا بملايينهم العظيمة إلى الشوارع، ما لبثوا أن وافقوا على تلخيص تحركهم المدني الرائع، أو على إجهاضه، بانقلاب عسكري ليس مستبعداً أن يستعيد مصادرة السياسة وتجديد «شرعية يوليو» مع كل ما يفاقم العجز عن التعاطي مع الأزمة الاقتصادية. وهنا ظهر بوضوح كيف أن الحساسية الديموقراطية، بما تنطوي عليه من تحمّل ورهان على طول النَّفَس والتحويل السلمي للقناعات وللمجتمع، ليست أفضل حالاً ممّا في بيئة «الإخوان المسلمين».
والنتائج المتحققة حتى الآن تدعم هذا التقدير: فحين يُجرى الحديث عن «مصالحة وطنية» تحلّ في صدارة «خريطة الطريق إلى المستقبل»، ويترافق ذلك مع إجراءات الحل والتعطيل حيال «الإخوان»، يبدو الأمر أبعد ما يكون عن الإفضاء إلى الديموقراطية والاستقرار.
وهذا ما يبعث على قلق كبير يتعدى احتمالات العنف «الإخوانيّ» الممكن، وعودة التعاطف مجدّداً مع حركة كانت تخسر يوماً بعد يوم من رصيدها حين كانت في السلطة. ذاك أن النسيج الوطني المصري نفسه بات على المحكّ، وهو ما يستدعي، أكثر من أي وقت مضى، مبادرة سياسية ومجتمعيّة كبرى توقف التراجع التدريجي نحو «شرعية يوليو» وما ينطوي عليه الاتجاه هذا من اعتذار ضمني عن الحرية التي أطلقتها ثورة يناير.
فالمؤكّد أنّ أحوال مصر لن تستقيم في ظلّ حكم هؤلاء «الإخوان»، لكن من الوهم الافتراض أن تلك الأحوال ستستقيم من دون «الإخوان». وهو وهم مكلف.
* كاتب ومعلق لبناني. جدير بالذكر أنّ هذا النصّ كُتب قبل عامين بطلب من مجلة مصرية آثرت ألّا تنشره
الحياة