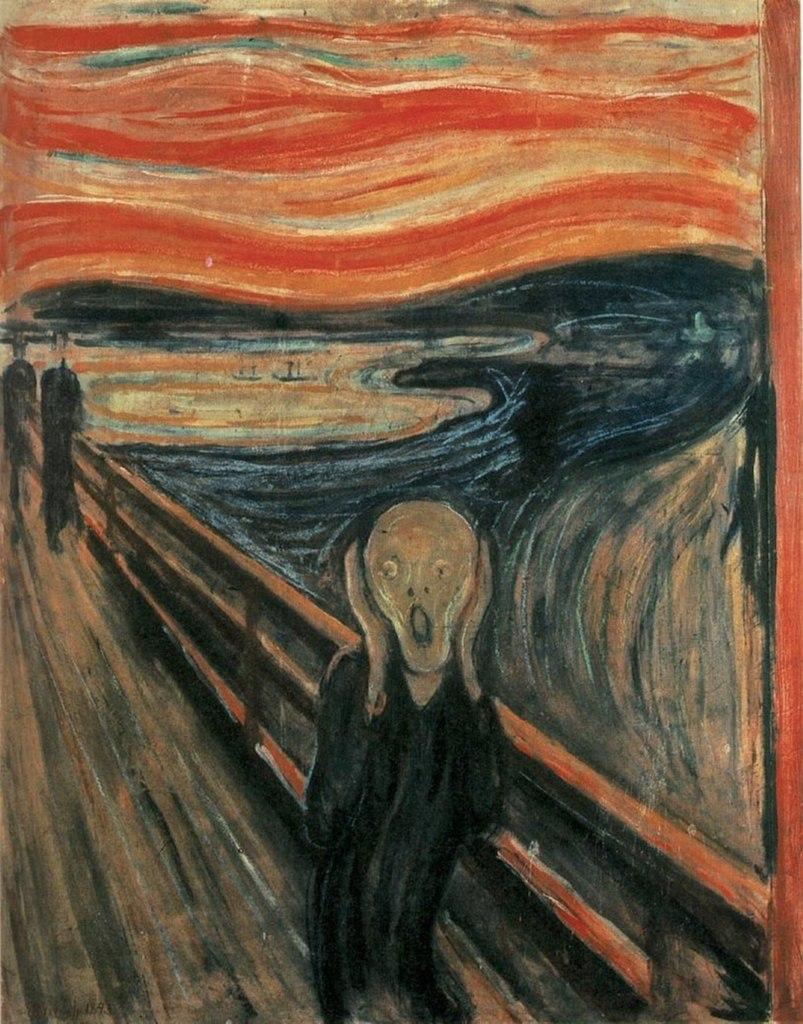عن الدور الروسي في الثورة السورية “مقالات مختارة”

دور لروسيا القيصرية في إجهاض الثورات/ سلامة كيلة
حينما تدخلت في سورية، برّرته روسيا بمواجهة الإرهاب وسحق الإرهابيين “الشيشان” قبل أن يعودوا إلى روسيا، وهي الصيغة التي برَّر بها الرئيس الأميركي، جورج بوش الابن، غزو أفغانستان ثم العراق. ثم أوضحت أكثر أنها تدخلت لمنع سقوط النظام في لحظةٍ كان عاجزاً عن الاستمرار، وكان يجب أن يجري إبعاد المتحكّمين فيه في سياق حلّ سياسي، لتحقيق تغيير يؤسّس لوضع جديد. وربما جرى ترداد تبريراتٍ أخرى، منها أن “النظام الشرعي” هو الذي طلب التدخل الروسي.
لكن، ربما أوضح تصريح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، الأمر من زاويةٍ أخرى، تنفي كل ما قيل قبلاً عن مبرّرات التدخل. قال، وهو يشير إلى “الضربات الجوية” التي أسفرت عن قتل 35 ألفاً “من الإرهابيين” أن روسيا “نجحت في وقف سلسلة الثورات في الشرق الأوسط”، وجزم أن “سلسلة الثورات التي انتشرت في أنحاء الشرق الوسط وأفريقيا انكسرت” (رويترز 22/12/ 2016). هو هنا يعلن “الهدف الأسمى” للتدخل في سورية، على الرغم من أن مصالح روسيا الاقتصادية والجيوإستراتيجية كانت في جوهر الأسباب التي دفعتها إلى التدخل وإقامة قواعد عسكرية، جوية وبحرية وبرية، لأجلٍ “غير محدَّد”. ويوضح شويغو بالتأكيد شعور روسيا الإمبريالية بخطر الثورات وخطورتها عالمياً، وعلى روسيا خصوصاً. بالضبط، لأن الوضع الاقتصادي الروسي ليس في وضعٍ مريح، والشعب الروسي يعاني من الفقر والبطالة كذلك.
وإذا كان هذا التقدير ليس في مكانه، بالضبط لأن أساس نشوب الثورات لا زال قائماً، فإن هذا الإعلان الواضح بأن تدخّل روسيا ووحشيتها قد أدتا إلى “إخماد ثورات الشرق الأوسط” يعني أن روسيا كانت، أولاً، ضد كل الثورات العربية، وهو ما وَضُح في موقفها من ثورات تونس
“روسيا هي ممثلة الإمبرياليات في سحق الثورات، وهي أداتها لهذا السحق” ومصر، ومن ثم اليمن وليبيا، حيث دافعت عن زين العابدين بن علي وحسني مبارك، وغضّت النظر عن سحق مظاهرات البحرين، وقبلت الدور السعودي الذي كان يناور لإجهاض ثورة اليمن، ولم تكن مع الثورة في ليبيا بل ظلت تدافع عن معمر القذافي، على الرغم من أنها تقول إن “الغرب” قد خدعها، حين وافقت على قرار مجلس الأمن الذي يسمح بالتدخل العسكري “المحدود”. لا يتعلق الأمر هنا، إذن، بالثورة السورية فقط، بل يصيب كل الثورات العربية، وكل الثورات الممكنة في العالم. ومن المنظار نفسه، كانت ضد ثورة أوكرانيا، وتدخلت عسكرياً لضم القرم، والسيطرة على شرقها. بمعنى أن روسيا الإمبريالية ضد كل الثورات، وهذا “طبيعي” لإمبرياليةٍ تريد السيطرة والاحتلال.
وثانياً تدخلت وهي مصممة على ممارسة كل الوحشية التي مارستها، من أجل إجهاض الثورة و”كسر” سلسلة الثورات التي بدأت من تونس. بالتالي، عملت على إكمال سياسات النظام، وإيران (وأدواتها) المتعلقة بالتدمير والقتل والترحيل، بكل الأسلحة المتطورة التي تمتلكها، من أجل تحويل الثورة إلى مجزرة. يوضح هذا التصريح أن السياسة التي وضعتها روسيا لتدخلها العسكري انطلقت من تدمير الثورة، بغض النظر عن الكلفة، ومن ثم كانت تعرف أن عليها، بالضبط، لأنها تواجه ثورة شعب، وليس إرهاب مجموعاتٍ صغيرة متحكَّم بها، أن تمارس كل الوحشية التي تجهض الثورة، بغض النظر عن عدد القتلى أو مستوى التدمير. ولا شك في أن إشارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حين لقائه كلاً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في برلين، موحية هنا، حيث أشار إلى أنه سيمارس في حلب كما فعل في غروزني، أي ممارسة عملية التدمير الشامل بكل الأسلحة (البراميل المتفجرة من اختراع بوتين، ومورست للمرة الأولى في غروزني).
تعتبر روسيا هنا أنها، من أجل كسر سلسلة الثورات، كان لا بد لها من أن تمارس كل الوحشية التي توقفها، ليس في سورية فقط بل في “الشرق الأوسط”. وهذا ربما يوضّح الأرقام التي أتى بها شويغو في التصريح نفسه عن قتل “35 ألف مسلح” أو “إرهابي”، بعد أن نفذ الطيران الحربي الروسي (فائق التطور) 18800 طلعة منذ سبتمبر/ أيلول من سنة 2015. وربما توضّح أسماء القتلى طبيعتهم التي يقول إنهم من الإرهابيين، ولقد نشرت الأرقام وصفات هؤلاء (وأكثر منهم) وأعمارهم في تقارير لمنظمات وهيئات سورية ودولية مستقلة، فهم في معظمهم من الشعب الذي يعتبره شويغو إرهابياً ما دام قام بالثورة (وشويغو يعترف بأنها ثورة). وجرى قتلهم عن عمدٍ، لأنهم قاموا بالثورة التي يعلن أنه كسرها، ليس في سورية فقط بل في “الشرق الأوسط وأفريقيا”… هو الرعب من الثورة إذن، من إمبرياليةٍ تريد النهب والسيطرة. وهو رعب الإمبرياليات الأخرى.
وثالثاً، أنها بهذا التدخل نفذت ما أرادت الإمبرياليات الأخرى، وكانت الأداة التي جرى
“تقول هذه الإمبرياليات إن الموت البطيء أفضل من الموت الوحشي، على الرغم من أنه في الحالين موت” استخدامها، ليس من أجل إجهاض الثورات فقط، بل وتحويلها، في سورية، إلى مجزرة تخيف شعوب العالم. وهذا يفسّر الموقف الإمبريالي الأميركي الذي كان يغضّ النظر عمّا فعل النظام من وحشيةٍ في القتل والتدمير واستخدام الأسلحة المحرّمة، وما فعلته روسيا بتدخلها. لقد أخافت سلسلة الثورات التي ظهرت كانفجار سريع وكبير يهدّد الرأسمالية كل الدول الإمبريالية، في لحظة أزمتها المستعصية على الحل، والتي فرضت سياسة التقشف التي تعني انهيار الوضع المعيشي للشعوب في البلدان الرأسمالية ذاتها، وتسريع نهب الأطراف وتدمير مقومات وجود شعوبها. لهذا، كان لا بد من مجزرة كبيرة تدمّر بلداً له تاريخ حضاري كبير (بعد أن دمرت الإمبريالية الأميركية العراق)، وموقع مميز، من أجل أن تعي شعوب العالم التي باتت تنهب بشراسة أن عليها قبول الموت الذي تعيشه، أو تنتظره من دون مقاومةٍ أو تمرّد أو ثورة، لأنها حينها ستدمر بكل العنف والوحشية. بالتالي، تقول هذه الإمبرياليات إن الموت البطيء أفضل من الموت الوحشي، على الرغم من أنه في الحالين موت، وأن الإحساس بالموت جوعاً هو الأساس الذي يفرض الثورات، مهما كانت النتائج، لأنه “رد الفعل الطبيعي” على الشعور بالموت هو الحركة، التمرّد، أي الثورة.
إذن، روسيا الإمبريالية هي ممثلة الإمبرياليات في السعي إلى سحق الثورات، وهي أداة هذه الإمبرياليات لهذا السحق. ولسخرية التاريخ أن يعاد كمهزلة، بعد أن كان تراجيديا حينما لعبت روسيا القيصرية دور “حصن الرجعية” (كما سماها ماركس) من أجل سحق ثورات سنة 1848 في أوروبا. إذن، يعود حصن الرجعية، لكنه هذه المرة مستفيداً من كل التطور التكنولوجي العسكري الذي أنجزته الاشتراكية مع الأسف، وليكون هو قوة الصدام المعلنة ضد ثورات الشعوب. وأن يسلّح بجيش “عرمرم” من “اليسار الممانع” في العالم كله، يقدّم له المبرّر الأيديولوجي لما يفعل، من خلال تشويه الثورات، و”القتال المستميت” للتأكيد على أنها “مؤامرة إمبريالية”، أو أنها ليست ثوراتٍ، لأنها بلا قيادة “ماركسية لينينية”، أو لأنها أتت بـ “الإرهابيين”. هذا اليسار الذي فقد كل فهم، وكل معرفة، وكل إنسانية، وبات أداةً بيد “حصن الرجعية” في ضخّ الترهات حول الثورات، وقام بالتمهيد “النظري” لسحقها.
إذا كان سيرغي شويغو هو وزير حرب الإمبرياليات، فيمكن القول إن قدري جميل وكثيرين من “شيوعيي” العالم هم هيئة الأركان الأيديولوجية في الحرب التي تخوضها الإمبرياليات ضد الثورة. وليبدو أن الاتحاد السوفييتي لم يُنتج سوى هاتين “القوتين”: حصن الرجعية العسكري وحصن الرجعية الأيديولوجي.
العربي الجديد
سورية.. نهايات مؤلمة واحتلال روسي/ عمار ديوب
كان عام 2016 عاماً للحسم ضدّ الثورة السورية، فإن كان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قد أنهى وجود الثورة والفصائل في الرّقة ودير الزور في 2014 ولاحقاً، فإن جبهة النصرة أنهتها في إدلب، وحاولت ذلك في حلب ودرعا. في درعا، دفعت الأردن وغرفة الموك إلى استقرار الفصائل هناك، وتحجيم “النصرة”. في ريف حماة ثم حلب، لعب التدخل الروسي دوراً مركزيّاً في إيقاف انهيار النظام، والذي كانت التوقعات تفيد باقتراب انهياره، بسبب ذلك في كلّ سورية، وحوصرت حينها جبهة النصرة (فتح الشام) في إدلب، وبعدها بدأت عملية استرجاع حلب بمساعدة إيران ومليشياتها الطائفية المستوردة من عدّة دول؛ والجهادية التي كان همها فرض خيارها ضد الثورة قبل مواجهة النظام لعبت دوراً تدميرياً في اجتثاث الفصائل. وبذلك، ساعدت الإيرانيين والروس في استعادة حلب. وتقول التوقعات بتكرار ذلك في إدلب في 2017، الأمر نفسه سيكون في الرقة ودير الزور. يمكن القول هنا إن النظام وإيران، ومعهما حزب الله، لم يستطيعا مواجهة الثورة قبل 2014، حينما كانت شعبيةً وبحماية الجيش الحر، وتغيّر ذلك كله بعد تعاظم دور “النصرة” و”داعش” والفصائل الإسلامية، وبدأ الإخفاق الكبير يتطور، واكتمل بالاحتلال الروسي.
أصبحت سورية في 2016 تتنازعها قوّتان، إيران بمليشياتها الطائفية، وقواتها هذه برية، وروسيا بأسطولها الجوي، ويضاف إليهما وجودٌ تركيٌ، كان حصيلته تفاهماً روسياً تركياً، وكانت نتيجته الضغط على فصائل حلب لتسليمها. وبذلك تشكّل حلفٌ جديدٌ من روسيا وإيران وتركيا، بهدف التحكّم في سورية. ستحسم الاختلافات بين الدول هذه لصالح روسيا، وخضوع الدولتين الأخريين لها، فلا يمكن أن تتساوى ثلاثة احتلالاتٍ في آن واحدٍ لدولة واحدة. وهذا ما يُلحظ في هامشية التدخل التركي واقتصاره على مناطق بعينها، وضد الكرد و”داعش”، وأما الخلافات التي تظهر تباعاً بين روسيا وإيران فهي تساهم في تحديد شكل العلاقة بينهما في
“السوريون كانوا حالمين بدولةٍ تمثّل أهداف ثورتهم، فإذ هم تحت احتلالٍ وبدولة “صورية”” السيطرة على سورية. طبعاً، كما ذكرنا مراراً، ستكون السيطرة بالتأكيد لروسيا؛ فإيران مرفوضة من المحيط الإقليمي لسورية، عدا عن ممارساتها الطائفية، والتي تتعارض مع رغبات السوريين بدولة “علمانية”، ومتناسبة مع تنوعهم الديني والقومي، وكذلك مع العصر. يشبه السوريون هنا الإيرانيين في رفضهم دولة ولي الفقيه، وكل التوجهات الطائفية لدولته، وهذا موضوع آخر. وللتذكير، يمكن العودة إلى نتائج انتخابات 2009 في إيران، والتي زُوّرت لصالح “الرئيس” أحمدي نجاد حينها، وتم دكّ الإصلاحيين في السجون، وما زالت قياداتهم فيها. أقصد أن لا مصلحة لكل شعوب المنطقة في الطائفية، بما فيها الإيرانيون، وهذا ما يشكل سبباً للتنسيق بينها ضد الأنظمة الطائفية، وكل أنظمة معادية لمصالح الشعوب.
يشمل وضع المدن الثائرة كذلك ريفي دمشق، فبعد أن صُفيت داريا، والتي صمدت أربع سنوات، فإن بقية الريف الغربي انهار تقريباً. وعكس ذلك، تقدّم النظام بشكل كبير في الغوطة الشرقية، وكذلك في بلدات القلمون؛ وقد ساهمت الفصائل الإسلامية بمحاولات فرض مشروعها على تلك المناطق، ووجود خلافات عميقة بين الفصائل وحروب قوية بينها. كما تمّ في العام 2016 في الغوطة الشرقية تمكين النظام ومليشيات إيران من التقدم، ولعب الروس دوراً في ترحيل آلاف المقاتلين من محيط دمشق، ومن بلدات عديدة، وهذا ما أمّنَ محيط العاصمة بشكل كامل؛ إذاً هنا إخفاق جديد وكارثي.
قمعت كل التحركات الشعبية في الغوطة الشرقية وفي حلب وإدلب وسواها بأشكال متعددة من تلك الفصائل، وبالتالي، لم تستطع المظاهرات والاحتجاجات تلك استعادة روح الثورة، كما كانت في 2011 و2012، بسبب رفض النظام أي اعترافٍ للشعب بأهداف الثورة، وبسبب إسلامية تلك الفصائل، والتي ترفض تلك الأهداف، وأيّ دورٍ للشعب.
يُضاف إلى الإخفاق العسكري للفصائل التهجير الكبير الذي شهدته كل المدن السورية والتدمير
“ما حدث للسوريين من مآسٍ سيسمح بخفوت حركة الشعب في بداية ذلك الاستقرار، على أمل الوصول إلى إصلاحات مستقبليّة فعليّة” الواسع لها، وتشرّد ملايين السوريين في دول الجوار وفي بقية المدن الآمنة. وبذلك، توقفت كل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية. توضح ذلك الأرقام المخيفة لحجم المليارات التي ستحتاج لها سورية، حينما تتوقع الحرب، والتي تنوف عن 250 مليار دولار.
حصيلة 2016 مشاورات روسية تركية إيرانية لكيفية السيطرة على سورية، ومحاولة تهميش الدور الأميركي والمعارضة السورية ودول الخليج. النظام أيضاً لا وجود له في تلك المشاورات. وبالتالي، وحينما تنعقد صفقةٌ متكاملةٌ بين هذه الأطراف ستنفذها المعارضة والنظام، وهذا يعني تصفية أي دور استقلالي لهما في تقرير وضع السوريين مستقبلاً.
سيكون السوريون في 2017 أمام واقع جديد، هو الاحتلال الروسي، والتدخلين الإيراني والتركي. سيتهمّش دور الأكراد بالتأكيد، ولن ترفض هذه النتائج القيادة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، والتي ستكون سعيدةً بتقليص الوجود الإيراني في سورية، وأيضاً الخليجي، وتحديداً السعودي.
حدثت الخسارة الثورية في سورية. وهذا مما لا يمكن إعادته إلى الوراء، وسيكون أمام السوريين تقبّل حكومةٍ لا تمثّل أهدافهم، وستكون تحت الاحتلال الروسي. بهذا الشرط، ستنتقل سورية نحو الاستقرار وإيقاف الحرب، وربما ستشهد إعادة إعمار بطيئة وديمقراطية بحدود دنيا ومضبوطة؛ ما حدث للسوريين من مآسٍ سيسمح بخفوت حركة الشعب في بداية ذلك الاستقرار، على أمل الوصول إلى إصلاحات مستقبليّة فعليّة.
اللوحة سوداء بامتياز، فالسوريون كانوا حالمين بدولةٍ تمثّل أهداف ثورتهم، فإذ هم تحت احتلالٍ وبدولة “صورية”، وبدمار مخيف، وبعدد قتلى يقترب من المليون وباقتصاد منهار؛ هذه هي وضعية سورية إن توقفت الحروب، وهو بالضبط ما يستدعي من كل الفاعلين المثقفين والسياسيين استيعابه جيداً، والعمل على إنهاض سورية والسوريين. وستكون المهمة مُركبةً من أجل تحقيق أهداف ثورتهم المغُتالة، ومن أجل التحرّر من الاحتلال الروسي ومختلف أشكال التدخل الخارجي.
العربي الجديد
الأسد وبوتين واليسار السياسي: بروباغندا تضليلية في خدمة أنظمة القمع السلطوية
للصراع السوري سرديات متعددة، تتمحور جميعها حول امتلاك سلطة تفسير الأخبار. لكن السردية التي يمثلها بشار الأسد فرضت نفسها في النهاية. ولولاها لما كان هو وحلفاؤه الإيرانيون والروس قادرين على السيطرة على حلب في ظل انعدام الاهتمام العالمي.
لما حدث أسباب كثيرة، أحدها هو أن تيارات اليسار في العالم الغربي، التي عادةً ما تزعم أنها مناوئة للحروب ومناصرة للسلام، دعمت الأسد وبوتين. الحديث هنا هو حول أوساط تصف نفسها بأنها “معادية للإمبريالية” أو “ناقدة” أو “بديلة”، والتي باتت فرحة بـ”تحرير” حلب.
وعلى الرغم مما تزعمه تلك الأوساط من أنها ناقدة، فهي لم تركز على القذائف الروسية أو الفظائع التي ترتكبها المليشيات الأجنبية التي تقاتل لصالح الأسد، بل نظرت إلى أولئك المحاصرين في حلب الشرقية، والذين قاموا بإطلاق استغاثات ورسائل وداع في الأيام والساعات الأخيرة من سقوط المدينة.
وبالأخص، اتجه تركيز تلك الأوساط إلى بانا العابد، وهي فتاة في السابعة من العمر من حلب الشرقية، والتي وصل عدد متابعي حسابها على “تويتر” إلى 300 ألف شخص. وبالنسبة لـ”المجموعة الناقدة”، فإن هذه الفتاة ليست حقيقية. إنها بالنسبة لهم أداة لنشر البروباغاندا يجلس صنّاعها على الأرجح في مكان ما بتركيا أو قطر.
لكن تقريراً مفصلاً لشبكة الأبحاث “ذا بيلينغ كات” يثبت بالدليل القاطع أن بانا موجودة فعلاً وكانت تقيم في حلب الشرقية. كما يذكِّر معدو التقرير أولئك الناقدين بأن حساب بانا على “تويتر” تديره بالفعل والدتها، وهي معلمة درست الصحافة في الجامعة وتتكلم الإنجليزية، أو أن الكهرباء وخطوط الإنترنت ممكنة في المدينة المدمرة. وفي الوقت الراهن، لم يعد هناك شك حول وجود بانا، بعد أن تمكنت وعائلتها من مغادرة حلب الشرقية بأمان، وبعد أن قام صحفيون وناشطون بنشر صور عديدة لبانا وعائلتها.
القنابل الروسية جيدة
ولكن ما إذا كان ذلك قادراً على تغيير وجهة نظر الناقدين، يبقى أمراً مختلفاً. ولا عجب في ذلك، إذ بغض النظر عن توجههم السياسي – سواءٌ أكانوا يساريين أم يمينيين – فإن أغلبهم كوّن مسبقاً صورته الخاصة حول الصراع – صورة يصدقون فيها أي كلمة تصدر عن الأسد أو بوتين، والدليل على ذلك الكم الهائل من التعليقات على أي مقطع فيديو لمقابلة صحفية مع أحد الرئيسين.
لهذا، فإن نصر الأسد في حلب – والذي يتم تصويره كذلك – يتم تسويقه على أنه نجاح في مواجهة العدوان الأمريكي على البلاد. أما القنابل الروسية، التي سقطت في الأيام والأسابيع الماضية ودمرت المستشفيات، فلا يتم ذكرها حتى كأمر ثانوي. بدلاً من ذلك، يتم تبرير هذه الهجمات بكل برودة أعصاب بأن “الإرهابيين” يستخدمون المدنيين كـ”دروع بشرية”.
عندما قامت طائرات أمريكية مقاتلة بتدمير مستشفى تابع لمنظمة “أطباء بلا حدود” في قندز بأفغانستان، لم يتم اللجوء إلى قصة “الإرهابيين” – وهذا صحيح في هذه الحالة. كما أن نفس الموقف استخدم في الحرب المدمرة باليمن، والتي تقودها السعودية بدعم من واشنطن. لكن عندما يكون مصدر القنابل موسكو، فإن الكثيرين من معارضي الإمبريالية ومن يسمون أنفسهم نشطاء سلام يكيلون بمكيال آخر، فإما يصمتون أو يحتفلون.
الأسد و”الحرب على الإرهاب”
يعتبر ياسين الحاج صالح كاتباً معارضاً معروفاً من سوريا. قضى الحاج صالح في عهد حافظ الأسد 16 عاماً في السجن، وينظر له كثيرون على أنه “ضمير الثورة السورية”. من بين كتبه “سوريا في الظل: نظرات داخل الصندوق الأسود”.
في حقيقة الأمر، فإن تيارات اليسار في الغرب تستخدم نفس الحجج التي يستخدمها من تنتقدهم تلك التيارات. فـ”الحرب على الإرهاب” باتت منطقية بالنسبة لهم طالما أن الأسد وبوتين هما من يقودانها وتصورها وسائل إعلامهما. المهم هو أن ذلك يتسق مع صورة أولئك عن العالم. لكنهم يتناسون في هذا السياق أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تعاونت بشكل مكثف مع جهاز المخابرات السوري بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لاسيما في مجال تعذيب “المشتبه بهم في قضايا الإرهاب”.
في سوريا، فإن الحرب “الجيدة” على الإرهاب تبدو كالتالي: يتم إعلان كل السوريين المعارضين للأسد كـ”إرهابيين” أو “أداوات في يد الإمبريالية الأمريكية” أو “ألعوبة” في يد السعودية أو تركيا. هؤلاء لا يمتلكون إرادة حرة ولا يشعرون بأي أسى وتُنزع عنهم صفة الإنسانية. أما الأسد، فيُنظر له كرئيس شرعي لدولة ذات سيادة، وكـ”رجل هادئ مفكّر”، بحسب ما يصفه الصحفي الألماني يورغن تودنهوفر.
في ذات الوقت، يتم تجاهل حلفائه الخارجيين أو التغطية عليهم، والذين لولاهم لكان الأسد قد سقط منذ فترة طويلة. وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالدعم الهائل من إيران أو روسيا، بل وينطبق أيضاً على العدد الكبير من المرتزقة وأفراد المليشيات القادمة من لبنان والعراق وباكستان أو أفغانستان.
هذه التفاسير وجدت آذاناً صاغية مؤخراً في تيارات اليسار بأمريكا اللاتينية، إذ وصف رئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الأسد مراراً بأنه “رئيس معاد للإمبريالية”، والذي تسعى الولايات المتحدة لإسقاطه.
موقف دول أمريكا اللاتينية، التي مرّت بمرحلة تحرير قادته تيارات يسارية، كان أوضح ما يكون خلال تصويت على قرار للأمم المتحدة يتعلق بحماية المدنيين في سوريا، إذ صوتت كل من كوبا وبوليفيا ونيكاراغوا وفنزويلا ضد هذا القرار، ووقفت إلى جانب روسيا وإيران ونظام الأسد.
غشاوة أيديولوجية
غشاوة وسخرية: يكتب عمران فيروز: “لهذا يتم تصوير نصر الأسد في حلب – كما تتم تسميته – كنجاح في وجه العدوان الأمريكي على البلاد. أما حقيقة أن سقوط القنابل الروسية وتدميرها للمستشفيات في سوريا فلا يتم حتى اعتبارها أمراً ثانوياً. بدلاً من ذلك، يتم تبرير هذه الهجمات بكل برودة أعصاب بأن “الإرهابيين” يستخدمون المدنيين كـ”دروع بشرية””.
في هذا السياق، يتم تجاهل أصوات اليسار السوري، وأفضل مثال على ذلك هو المثقف السوري ياسين الحاج صالح، الذي اعتُقل لسنوات طويلة من قبل نظام الأسد بسبب عضويته في الحزب الشيوعي.
لكن الحاج صالح أيضاً، الذي تعرض للتعذيب على يد النظام بسبب قناعاته وانتقد جرائم نظام الأسد في العديد من المقابلات الصحفية، ينظر له اليسار الغربي كشخص مضلل. بيد أن ردة فعلهم لم تصبه بصدمة كبيرة، فهو يصف اليسار في دول الغرب بأنه لاعب مضلل أيديولوجياً لا يريد أن يؤمن بوجود ثورة في سوريا، لاسيما وأن الصراع في نهاية الأمر يستند على انعدام المساواة بين نخبة صغيرة وحشية تقمع الأغلبية في البلاد منذ عدة عقود.
لكن الطاغية يمكنه أن يفرك يديه جذِلاً ومبتهجاً الآن، فنظامه والبروباغاندا الكاذبة التي يوزعها انتصر. لقد نجح بشار الأسد في توحيد اليساريين واليمينيين وراءه، إذ لم يعد سراً أن عدداً من أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، مثل حزب الحرية النمساوي وحركة “فورزا نوفا” الإيطالية والحزب الوطني البريطاني، تدعم الأسد بكل قوتها منذ سنوات. كما شاركت مرام سوسلي، الملقبة بـ”Partisan Girl”، في مؤتمر “مدافعي أوروبا” لحركات اليمين المتطرف، الذي أقيم في أكتوبر الماضي بمدينة لينز النمساوية. سوسلي تعتبر أحد أبرز المنظرين للأسد في مواقع التواصل الاجتماعي.
والآن بات من الواضح أن مَن ينفعل مِن تسمية الطاغية طاغية وينظر إلى كل سوري ملتح على أنه “إرهابي” أو يتعجب من سبب اتجاه الكثير من الناس إلى التطرف في ظل نظام قمعي كهذا، هو مذنبٌ أكثر مما يعتقد.
عمران فيروز
ترجمة: ياسر أبو معيلق
حقوق النشر: موقع قنطرة 2017
ar.Qantara.de
لن تستطيع روسيا تحقيق السلام في سورية/ رضوان زيادة
أعطى اتفاق الهدنة الروسي- التركي القاضي بإخراج المدنيين من مدينة حلب “أملا” لبعض السوريين الذين تقطعت بهم السبل، وفقدوا معنى الأمل كلياً، بأن روسيا، وخصوصاً مع إجبارها لتنفيذ الاتفاق ضد رغبة مليشيا حزب الله والمليشيات الإيرانية المتحالفة معها ومع نظام الأسد (زينبيون وفاطميون وحركة النجباء العراقية)، أعطى ذلك كله وهماً بأنه ربما تسعى روسيا لفرض أجندتها في “الحل السياسي”، ولو ضد رغبات إيران والنظام السوري الذي تدّعي دعمه.
منبع الأمل كان انعدام الأمل بتدخل “غربي”، يوازي التدخل الروسي، وبالتالي، لم يعد لدى السوريين إلا الوهم القائل بضرورة “التفاوض مع القاتل حتى يقتلنا برأفة”، وهو ما حصل فعلاً، فقد دخلت الفصائل العسكرية الكبرى، المنضوية اسماً تحت مسمى الجيش الحر، في مفاوضاتٍ مع ممثلي روسيا العسكريين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الروسي بذاته الذي أشرف على الاتفاق، وأعلنه من موسكو، حجة الفصائل العسكرية كانت أن تركيا “التي نثق بها” هي الضامن الرئيسي للاتفاق، وبالتالي لن تخذل تركيا السوريين في مفاوضاتهم مع روسيا.
وكان هذا التفاؤل السريع أيضا قد ظهر مع بداية التدخل العسكري في روسيا في سبتمبر/ أيلول 2014، ما دفع سوريين إلى القول إن روسيا الآن أصبحت الأواني الصينية، وكما يقول المثل “If you break it you owned” ، بمعنى أنك إذا كسرت الإناء، فإن ملكيته أصبحت لك، وعليك التدخل لإصلاحه، وبالتالي، مع التدخل الروسي في سورية، فروسيا لم تعد داعماً لنظام الأسد أو راعيا له، وإنما أصبحت، في الحقيقة، مالكة له. وبالتالي، عليها “إنقاذ سورية” من أجل الخروج بشرفٍ وكرامةٍ من تدخلها العسكري. لكن الأمور تطورت على غير هذا المبدأ كلياً، إذ تدخلت روسيا في كل الأماكن، مع تركيز عسكري وقوة نارية هائلة ضد المعارضة السورية المسلحة، بما دعم نظام الأسد، ثم تحوّل تدخّلها العسكري، أخيراً، في حلب إلى قدرة تدميرية هائلة خارج إطار القانون الدولي، ومكّنها موقعها الدائم في مجلس الأمن وامتلاك حق النقض (الفيتو) من حمايتها من أي مساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في حلب، عبر استهداف المشافي والمناطق المدنية المأهولة بالسكان. أخيراً، في ما يسمى “اتفاق خروج المسلحين” من حلب، والذي يعني عملياً اتفاق تهجير للمدنيين القاطنين في مدينة حلب إلى خارج مدينتهم.
إنه اتفاق تهجير قسري ضد القانون الإنساني الدولي، وليس اتفاقاً لحماية المدنيين. وهكذا تجدّد
“لن يستطيع أي سوري أن يتصوّر أن روسيا ربما تريد حلاً أو خيراً في سورية” الوهم من خلال فرض روسيا الاتفاق ضد رغبة المليشيات الطائفية في سورية، سوريةً كانت أم لبنانية أم عراقية أم إيرانية، وبالتالي، استشعر بعض السوريين في المعارضة أنه يمكن التحالف مع أخفّ الضررين، وهي روسيا، ضد إيران.
من أعقد الأمور الآن التي يمكن تحليلها اليوم معرفة النيات الروسية الحقيقية في سورية، وهذا ليس بسبب ازدواجية الخطاب الروسي، حيث تقول شيئاً وتفعل عكسه على الأرض، وإنما لأن النظام السياسي الروسي اليوم شبيه تماماً بالنظام السوري، فيما يتعلق بآليات السيطرة والتحكّم داخل المجتمع الروسي، فكل الإعلام الروسي تحول إلى بروباغاندا دعائية للكرملين في حربه في سورية ضد “الإرهاب”، وفقدان كامل لما يسمى “Checks and balances” داخل المؤسسات الروسية، فسلطة الكرملين اخترقت المؤسستين، التشريعية والقضائية. صحيح أن روسيا اليوم ليست الاتحاد السوفييتي في السابق، فيما يتعلق بالتعدّدية والتنوع داخل المجتمع الروسي. لكن، في الوقت نفسه، ليس لسنوات التغيير والديمقراطية القصيرة التي عاشتها روسيا خلال عهد يلتسين أي حضور أو تأثير. هناك موقف موحد بأن ما يفعله بوتين في سورية هو الصحيح، وأن الغرب لا يريد لروسيا النجاح في سورية، وكل سوري يعارض الموقف الروسي يصبح ببساطة “إرهابياً”، كما أن الحرب في سورية فتحت الفرصة لتجريب السلاح الروسي، بكل أنواعه وتقنياته، هذه هي الحجج التي ساقها ويسوقها الكرملين، كل يوم تقريباً، في دفاعه عن تدخله العسكري في روسيا.
غابت كليا الحجج المنطقية التي أرى أنها يجب أن تكون الأساس الأول لكل قائدٍ يقرّر تدخلاً عسكرياً مكلفا خارج بلاده، وهو ما فائدة أو علاقة هذه الحرب بالأمن الوطني الروسي؟ هل هناك حاجة لروسيا لكي تصرف كل هذه الموارد المالية والعسكرية والسياسية أو تستنفدها في الدفاع عن نظامٍ من المستحيل عليه الاستمرار بطريقةٍ سياسيةٍ أو قانونية، فاستمراره يعني استمرار الحرب السورية إلى ما لا نهاية، ولن يشعر اللاجئون السوريون الذين بلغ عددهم اليوم أكثر من 7 ملايين لاجئ بالأمان، من أجل العودة إلى سورية، طالما طريقة حكم الأسد في القتل والتعذيب والبراميل المتفجرة مستمرة في حكم ما تبقى من سورية.
وطالما أن روسيا اليوم لا تسأل نفسها هذا السؤال، سيبقى غياب العقلانية السياسية مبدأ رئيسيا
“سيبقى غياب العقلانية السياسية مبدأ رئيسيا في حكم روسيا” في حكمها، وأعتقد أن الفشل سينتظرها، ليس في المستقبل البعيد، وإنما في الأيام القريبة المقبلة، فصحيح أنه ليس لروسيا تاريخ استعماري في الشرق الأوسط، أو العالم العربي، كما يحاجج مستشرقوها دوماً، لكنها ارتكبت في سورية اليوم جرائم وانتهاكات بحق السوريين، ووقفت ضد حقهم في اختيار نظامهم السياسي كما يشاؤون ويرغبون وبشكل سلمي. وطبقت عليهم قواعد غروزني في التدمير والتهجير وحكم “ما تبقى” مهما كان الثمن. وبالتالي، لن يستطيع أي سوري أن يتصوّر أن روسيا ربما تريد حلاً أو خيراً في سورية. كانت رغبتها في استعراض القوة العسكرية تحدياً لدور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. والآن، مع الانسحاب الكلي للإدارة الأميركية تحت إدارة الرئيس باراك أوباما، لم يعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين شيء ليستعرضه، سوى استنزاف الموارد الروسية المالية والعسكرية، وتهالك رصيدها السياسي والقانوني إلى أدنى مستوياته الدولية.
العربي الجديد
بوتين… وخياراته حيال الأسد وخامنئي وترامب!/ محمد مشموشي
يبدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سواء في سياسته السورية أو في استراتيجيته الأميركية الآن، أمام خيار من اثنين: إما الدفع باتجاه تسوية سياسية سورية، ولو على حساب حليفيه فيها، نظام الأسد والنظام الإيراني، أو الغرق في وحول حروب مديدة، سورية وإقليمية، لا يعرف أحد متى وكيف تنتهي. وتجاه الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، التي يراها بوتين أكثر تفهماً له ولدوره من الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما: إما إرساء سياسة تقوم على حد أدنى من التنسيق على المستوى الدولي، والإقليمي/ الشرق أوسطي تحديداً، أو إعادة إنتاج ظروف تضع العالم أمام حرب باردة جديدة، لا يعرف أحد بدوره متى وكيف تنتهي.
ذلك أن بوتين الذي يعتبر نفسه صاحب «انتصار» مزدوج، في سورية بعد تدمير حلب وإخراج أهلها وفصائل المسلحين منها، وفي واشنطن بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية (بغض النظر عن الاتهامات الموجهة ضده بالقرصنة الإلكترونية لموقع الحزب الديموقراطي في سياقها)، يظن أنه بات يمـــلك من الأوراق ما يؤهله لجعل انتصاره المزدوج هذا حقيقة واقعية على الأرض.
لذلك، يتفق المراقبون على القول أن بوتين قام بخطوتين في آن واحد: في سورية، بادر الى طرح تسوية بدا منذ اللحظة الأولى أنها تتم في معزل عما يفكّر فيه كل من الأسد وراعيه الإيراني اللذين ما زالا يتحدثان عن «حسم عسكري». كما أنه في واشنطن، وعلى خلاف التقاليد المعمول بها بين الدول في مثل هذه الحال، رفض الرّد على طرد 39 ضابط مخابرات وديبلوماسياً روسياً من واشنطن بمثله، ما أثار علامات استفهام حتى في موسكو نفسها.
في هذا المجال، سيكون مفهوماً أن يبادل ترامب «صديقه» بوتين التحية بمثلها، فيشيد بخطوته هذه قبل تسلّمه السلطة في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، لكن ما ليس مفهوماً أن تتولى قوات الأسد وميليشيات حليفه علي خامنئي مهمة الانتهاك الدائم لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو وأنقرة تحضيراً لبدء مفاوضات في العاصمة الكازخستانية، أستانة، حول التسوية السياسية في سورية.
فهل يتراجع بوتين هذه المرة أيضاً، كما فعل بالنسبة الى بيان «جنيف 1» في 2012، الذي نصّ على مرحلة انتقالية وصلاحيات كاملة، عن مبادرته الجديدة هذه، أم أنه سيفرضها ولو بالقوة على الأسد وخامنئي… أقله باعتباره «صاحب الفضل»، ليس فقط في «انتصار» حلب الأخير، إنما أيضا وقبله في منع سقوط نظام الأسد المحتم من خلال تدخّله العسكري في سورية في خريف 2015؟
الحال، أنه لم يعد خافياً ما يريده الأسد (برعاية خامنئي) من بوتين وقواته المسلحة وقاعدتيه العسكريتين في طرطوس وحميميم: العمل عند النظام، ومن أجل بقائه حاكماً مطلقاً لسورية، فقط لا غير. وكل حديث عن تعديل النظام، أو حتى عن مجرد الإصلاح، لم يكن مطروحاً من قبل ولا هو مطروح الآن، ولا عند الأسد ولا عند خامنئي الذي ينظر الى سورية من خلال استراتيجيته الفارسية/ الإقليمية/ الشيعية، بدليل كلامهما الذي لم يتوقف يوماً عن «الحسم العسكري» من جهة و»تحرير كامل التراب الوطني» بعد النجاح في «تحرير حلب» من جهة ثانية.
هل أدرك بوتين هذه الحقيقة، أقله من خلال تجربة ما يقرب من عامين من العمل الحربي/ السياسي مع الأسد وخامنئي، أم أنه كان مشغولاً طيلة تلك الفترة بتوجيه «رسائل» الى أوباما وتلقي ردود عليها أكثر من أي شيء آخر؟
وهل يفسّر هذا الإدراك، أو حتى عدمه، ما شهده العالم من «احتفالية» بوتين غير المسبوقة بنجاح ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية على منافسته هيلاري كلينتون، وبتدخله القرصني غير المسبوق بدوره في تقديم العون له إلكترونياً (وربما بأكثر من ذلك؟!) لضمان هذا النجاح؟
ليس جديداً، في كل حال، القول أن مغامرة بوتين في سورية استهدفت، إضافة الى إعادة الدور والنفوذ السابقين، كلاً من أوكرانيا والدول الأوروبية الأعضاء سابقاً في الاتحاد السوفياتي والعقوبات الأميركية والأوروبية عليه، ولا أنه نجح الى حد بعيد في مغامرته حتى الآن.
لكن الدخول من الباب الخلفي الى واشنطن، بخاصة عبر التدخل في الانتخابات الرئاسية، لم يكن مأمون العواقب في أي يوم. سبق للرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون أن فعل ذلك ضد منافسه في انتخابات 1986 ليندون جونسون، عبر محاولة إفشال مبادرته للتسوية في فيتنام (كما كشف بالوثائق أخيراً)، لكنه قام بمبادرة مماثلة لها بعد انتخابه. كما سبق للمرشح رونالد ريغان أن أقام علاقة سرية مع إيران الخميني لعدم إنهاء مشكلة السفارة الأميركية في طهران قبل الانتخابات حتى لا يستفيد منه منافسه فيها جيمي كارتر، إلا أنه لم يتأخر لحظة واحدة بعدها عن تقديم الدعم لصدام حسين لمواصلة حربه ضد إيران.
كذلك، فإن دخول بوتين الآن الى المنطقة العربية، سواء من البوابة الإيرانية أو حتى من بوابة الأسد وحدها (بضوء أخضر من أوباما أو من ترامب؟!) لن يكون مأمون العواقب لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد.
وبذلك يبدو بوتيـــن أمام واحد من خيــــاريه هــــذين: إما تسوية سريعة، وعادلة حكماً، للكارثة التي تضرب سورية منذ نحو ستة أعوام، أو الغرق في وحول حرب مديــدة قد تصل الى روسيا نفسها. وفي حالة واشنطن، وصديقه الجديد فيها ترامب، إما التناغم معه حول نووية النظام الإيراني ووقف تدخلاته على مساحة المنطقة وفي دولها كل على حدة، أو العودة الى مناخات الحرب الباردة، وربما الى المواجهة.
والسؤال الفعلي هو: أي خيار من الاثنين يعتمده بوتين… وبسرعة هذه المرة، في سورية كما في تعامله مع الإدارة الأميركية الجديدة؟!.
الحياة
مصالح روسيا والمشروع الإيراني في سورية/ راغدة درغام
تبدو روسيا جبّارة ورائدة وهي تصنع بمفردها المستقبل السوري بشراكات جديدة وعلى أسس جديدة، تملي ما تريد. هكذا يبدو. واقع الأمر أن سيّد الكرملين الرئيس فلاديمير بوتين حشر نفسه في زاوية الرفض لما يرسمه ليس فقط من قِبَل الدول الأوروبية والعربية المعنية بسورية، وإنما أيضاً من جهة حليفه الاستراتيجي في سورية، المرشد الإيراني علي خامنئي- ولكلّ أسبابه. الثنائي «الضامن»، روسيا وتركيا، لحل في سورية أتى بعدما رفضت إيران أن تكون الثالثة بين الضامنين إذا كان الشرط هو سحب القوات العسكرية التابعة لها من سورية، وبالذات «حزب الله» والميليشيات التي بإمرتها. مشكلة الثنائي الضامن هو أن لا تحالف صادقاً بين روسيا وتركيا وإنما هناك زواج الحاجة العابر لطرفين أحدهما هش، بعدما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراءات التجويف الأمني رداً على المحاولة الانقلابية ضده وتَقَلَّبَ مراراً في السنوات الأخيرة في علاقاته مع مَن لتركيا مصلحة معهم، وبالذات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول العربية الخليجية، وكذلك مع المقاتلين في سورية. وثاني الطرفين (روسيا) ليس هشاً لكنه يغامر، وهو يبالغ بالثقة بنفسه وبالعلاقة مع واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهذا حشد ضد مشاعر الغضب والتأهب للتربص بها في الأمم المتحدة كي لا تنجح في سحب البساط من تحت أقدام الأسرة الدولية، عبر إخراج قضية سورية من مجلس الأمن، وكي لا تمضي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية بلا محاسبة. وعليه، فإن مشهد القيادة الروسية للملف السوري معقّد، وقد يصطدم بعراقيل أساسية، فمن جهة الدول الغربية والخليجية، ما تقوم به روسيا هو التحايل على الأسس التي وافقت عليها الأسرة الدولية المعنية بالحلول السياسية لسورية، بما يرسّخ بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة بعيداً من أي عملية انتقالية. وبالنسبة إلى الشريك الميداني والحليف الاستراتيجي لروسيا في سورية، فإن ما تطلبه روسيا من سحب كامل للقوات الأجنبية، بما يشمل «حزب الله»، مرفوض عملياً وعقائدياً لدى إيران. وهذا التعقيد يضع علاقة التحالف في مرحلة حساسة إنما ليس بالضرورة على طريق الطلاق، فالرئاسة الروسية تراهن على الرئاسة الأميركية وسيلةَ تأثير على الجميع، بمن فيهم شريكها الإيراني، نظراً إلى حاجة إيران لروسيا مع الولايات المتحدة في ملف العقوبات والأسلحة النووية.
ما تصطدم به الديبلوماسية الروسية وستصطدم به أكثر، هو وضوح الإصرار الإيراني على صيانة ما حققته لمشروعها الإقليمي في الحرب السورية ولو أدى إلى فراق مع روسيا، ففي هذا الأمر إنها المصالح الحيوية على البحر الأبيض المتوسط لكل من إيران وروسيا، التي ستُصان -على الأرجح- بتفاهمات توفيقية، لأن القواسم المشتركة الميدانية مازالت ضرورية للطرفين.
مسألة «حزب الله» والميليشيات العراقية والأفغانية وغيرها كافة، وهي التابعة لـ «الحرس الثوري» بقيادة قاسم سليماني، مسألة حيوية وليست تجميلية. منطقياً، إن بقاء هذه القوات الأجنبية في سورية يعطِّل الحل السياسي الذي تريده روسيا وتركيا بصفتهما ضامنَين وقف النار وساعيَين للتوصل إلى الحل النهائي للصراع في سورية.
علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، نفى أن تكون التفاهمات في شأن وقف النار شملت خروج هذه المجموعات المسلحة، معتبراً الكلام عن تفاهم على خروج «حزب الله» من سورية «عارياً من الصحة ودعاية يطلقها العدو». قال إن هذه المجموعات المسلحة دخلت سورية «بطلب من حكومتها»، وشدد على أن إيران لها مواقف ثابتة، وهي «دعم محور المقاومة»، وأن سورية «ركيزة مهمة في هذا المحور، الذي يبدأ من إيران مروراً بالعراق، وصولاً إلى سورية ولبنان وفلسطين». وهذا ما يسميه آخرون «الهلال الفارسي» أو «الهلال الشيعي»، الذي يربط إيران بإسرائيل في علاقة تهادنية وليس بفلسطين عبر «محور المقاومة».
محورَ مقاومة كان أو محورَ تهادن، لا تبدو إسرائيل قلقة جداً مما جاء على لسان ولايتي لجهة ربط إيران بفلسطين، أو لجهة بقاء الميليشيات الإيرانية في سورية على البحر الأبيض المتوسط. البعض يعتبر أن الصمت وعدم الاحتجاج الإسرائيلي عائد إلى الخوف من ذلك المحور الذي أنجزته إيران، والبعض الآخر يعير منطق التهادنية ثقلاً أكبر، لا سيما أن هذه الفكرة أميركية الصنع، والدعم في زمن جورج دبليو بوش وعلى أيدي المحافظين الجدد آنذاك.
وهناك رأي يشير إلى العلاقة الروسية- الإسرائيلية القوية، ويؤكد أن رهان إسرائيل هو على تمكّن روسيا من «تنظيف» سورية من أي خطر على إسرائيل من ميليشيات أو من قوات نظامية أو شبه نظامية.
السؤال المطروح الآن حول إيران هو: هل هي جزء من الحل في سورية أو جزء من المشكلة؟ الأمم المتحدة، في عهد الأمين العام بان كي مون، أصرّت على ضرورة إدخال طهران طرفاً مباشراً في المسألة السورية بصفتها جزءاً من الحل، رامية جانباً كل التحفظات على هذا الإصرار ومتجاهلة وضوح الأجندة الإيرانية في سورية. كذلك فعلت عمداً الولايات المتحدة والدول الأوروبية، عندما وافقت على إيلاء دور أساس لإيران على طاولة الحلول السياسية لسورية تلبية لإصرار الديبلوماسية الروسية، بل إن إدارة باراك أوباما اتخذت قراراً استراتيجياً يُسمَح بموجبه لإيران ولقوات «الحرس الثوري» بالتوغل عسكرياً داخل سورية، وأعطتها غطاءً قانونياً من خلال إلغاء قرارات مجلس الأمن التي منعت إيران من هذه الأدوار العسكرية، وكل ذلك من أجل الاتفاق النووي مع إيران. وهكذا، كانت إدارة أوباما طرفاً خفياً في ساحة الحرب السورية لمصلحة بقاء بشار الأسد، نظراً إلى أن مهمة «الحرس الثوري» والميليشيات التابعة لإيران كانت وما زالت جليَّة، وهي: بقاء الأسد في السلطة.
لماذا قررت أميركا وأوروبا وروسيا والصين غض النظر عن طموحات طهران الإقليمية والتي كانت القيادة الإيرانية تجهر بها ولا تخفيها؟ الإجابة تتعدى ما يُزعَم من أن الاتفاق النووي كان حاجة ذات أولوية قاطعة، فالكل كان يدرك تماماً ما هي جغرافية الطموحات الإيرانية وسكت. لذلك، فإن المواجهة السياسية حول سحب القوات التابعة لإيران من سورية لافتة. فإما أن تكون هذه مجرد خلافات تكتيكية، أو أن إيران ستصنَّف جزءاً من المشكلة بعدما دللتها الأمم المتحدة وجميع هذه الدول بصفتها الجزء الأساسي من الحل.
عسكرياً، يُطرَح السؤال: لمَن الكفَّة الأقوى في موازين الضغوط الميدانية؟ لإيران أو لروسيا؟ المواجهة العسكرية بين الاثنين تكاد تكون مستبعدة تماماً، إنما في حال الاضطرار لكسب هذه المعركة، هل إيران قادرة بلا محاسبة على تعطيل مسعى روسيا عبر نسف وقف النار؟ أم أن روسيا ستضطر للتراجع أمام إيران وإصرارها على عدم سحب «حزب الله» وميليشياتها من سورية؟ وما هي لغة الحل الوسط إذا تم التوصل إليها، وهذا هو المرجَّح؟
تداخل علاقة روسيا بإيران مع علاقة روسيا بتركيا أمر مهم. فلاديمير بوتين في حاجة إلى الاثنين وقد يريدهما معاً في موقعٍ أضعف. بوتين يدرك تماماً أن هشاشة أردوغان سيف بحدين: فمن المفيد لبوتين أن يكون أردوغان في حاجة إليه يأتيه في حالة وهن، إنما من الضروري ألا ينتصر «داعش» وأمثاله من الناقمين والمنتقمين من أردوغان، وإلاّ دفع أردوغان ثمناً غالياً لصفقته الحلبية مع بوتين، وأن يبدو أردوغان قادراً على تحدي واستيعاب ما يعتبره خطراً كردياً آتياً إليه من الساحة السورية. بوتين يحتاج إلى أردوغان كغطاء سنّي بعدما تحالف عسكرياً مع إيران التي تفرض نفسها متحدثاً مستفرداً باسم الشيعة، لكن بوتين يصقل في الوقت ذاته علاقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسيسي يلبي، إذ إن مصر هي الدولة العربية شبه الوحيدة الداعمة للصيغة التي تعرضها روسيا لحل الأزمة السورية والقائمة على استفراد روسيا بالحل في آستانة عاصمة كازاخستان، بافتراق جذري عن المواقف الخليجية الرافضة لهذه الصيغة.
الخيوط الدينية والمذهبية التي يلعب بها فلاديمير بوتين لافتة ومخيفة. إنه يلعب على أوتار الخلاف التركي- المصري بسبب «الإخوان المسلمين» الذين دعمهم أردوغان في مصر كما في سورية. ويلعب على أوتار خلافات تركية- إيرانية باتت لها نكهة المذهبية في الأيام الأخيرة.
الرئيس الروسي يرى أن الوقت مناسب له لتحويل إنجازاته العسكرية في حلب إلى ذخيرة سياسية على عتبة تسلّم «صديقه» دونالد ترامب الرئاسة الأميركية. إنه يريد حسم الفوز ضد «داعش» و «جبهة النصرة» وأمثالهما في سورية عبر تتويج الفوز بحلول سياسية، وهو يدرك أن بقاء ميليشيات إيران في سورية يمنعه من إعلان ذلك الفوز لأنه يحول دون إغلاق الصفحة ميدانياً. حتى محادثات آستانة معلّقة رهن القرار الآتي من المرشد الأعلى في طهران ومن قاسم سليماني في سورية.
بشار الأسد يترقب كيف ستتفق أو تختلف روسيا وإيران بشأن سورية. إنه واثق بأنه حيوي لكليهما ولن يتخلى عنه أي منهما، أقله في هذه الفترة. لكنه قد يكون أكثر ثقة بتمسك طهران به كأساس لمشروعها الإقليمي، وأقل ثقة بروسيا، مع أنها أهم رعاته دولياً. إنما إذا خذلها تخذله، فلدى روسيا خيوط قرارات دولية ليست متوافرة لدى إيران، أحدها يتعلق بما تعدّ له الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي من خطط للمحاسبة على الانتهاكات في الساحة السورية من جرائم حرب إلى استخدام أسلحة كيماوية.
الكل يتأهب للتموضع عشيةَ ما يوحى أنه قد يكون الصفقة الكبرى بين روسيا والولايات المتحدة. فإذا كانت ثقة بوتين بنفسه وبدونالد ترامب رهاناً رابحاً، سيعتبر الرئيس الروسي نفسه جبّاراً ورائداً باستفراد أو بشراكة أميركية. إلى ذلك الحين، لن يكون سهلاً على روسيا حياكة العلاقات الإقليمية والدولية المعارضة لاستفرادها ولقفزها على التفاهمات، ولن يكون نزهةً لها اللعبُ بالخيوط المذهبية والعقائدية التي انطلقت من ذلك «الثلاثي» الضامن للتسوية في سورية.
الحياة
سورية وروسيا والحلفاء الألداء/ أحمد جابر
مع تواتر الكلام عــن إمكانــيـة نفاذ أحكام اتــفاق وقف إطــلاق النــار في سورية، يتقدم إلى واجهة البحث موضوع «الائتلاف» العسكري العريض الذي تــتــدخــل قــواتـــه في القتال السوري.
وإذ نقول الائتلاف العسكري وليس السياسي، فهذا من باب التمييز بين الحسابات التي تصل إلى حد التناقض على المستوى الإستراتيجي، وتبدي الكثير من ممارسات التناغم على الصعيد الآني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصعيد الوطني السوري المباشر. ضمن هذه النظرة التمييزية لا حاجة لبذل عناء كبير للقول إن ما دفع المتدخل الروسي إلى الوضع السوري هو غير ما دفع الأميركي والتركي والإيراني والعربي، فلكل من هؤلاء مفكرة «حبلى» بالعناوين، ولو أن كل طرف حرص على أن يطلق على القابلة السياسية اسم قتال داعش، كرمز مكثف لكل مقولة محاربة الإرهاب التي تجمعت قواه فوق الأرض السورية، واجتمعت على خرابها أيضاً.
نجد من المهم، بل الأهم، في فترة حديث الهدنة المتداول، تسليط الضوء على الدور الروسي في سورية، فهذا الأخير تحيط به التباسات لا ترقى إلى الالتباسات التي تحيط بسواه، وهو يبدو بمعايير الاتصال والانفصال بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية، الأكثر قابلية لجعله في دائرة الضوء، بحيث تكون قراءاته واحتمالاته ومآلاته، ممكنة التحديد في شكل عام، وهذا يُسْر سياسي لا تتوافر عليه القراءات الإجمالية للأدوار الأميركية والتركية والإيرانية.
يغلب على الدور الروسي في سورية طابع «الخارجية»، فاللاعب الأجنبي هذا لا ينطق بالضاد لغة، ولا يتكئ على «قبيلة» من قبائلها، أما المسيحية التي ينتمي إليها، فما زالت في موقع الريبة عربياً، وما مارسه الفكر القومي حيال هذه المسيحية من تهميش وتبخيس دور، بسبب من دمجه بين القومي والدين، هذه الممارسة تتضخم اليوم بعد أن احتلت فروع الحركات الإسلامية كامل مساحة الوضعية السورية.
ما جرى ذكره يفاقم صورة الخارجية اللصيقة باللاعب الروسي، وهذا يحرمه بدرجات متفاوتة من توسل التشكيلة الاجتماعية السورية للتلاعب بسياقها، أي أن البنية السورية ممتنعة على الروسي أهلياً، وهذا يعاكس حال المتدخل الإيراني، ويفترق افتراقاً بيِّناً عن أحوال المتدخل التركي، وقد يكون حقيقياً الاستنتاج أن صفة الدخيل على الخراب السوري ستظل من نصيب الروسي، في الوقت الذي تكتسب صفة المتدخل كل معناها مع نظيريه التركي والإيراني.
في مقام الجردة العامة، ومن أجل الإحاطة بالجزء الأهم من تفاصيل اللوحة السورية، نعرض للتدخلين الإيراني والتركي، لنلاحظ أنه على صعيد الإيراني يستند تدخله إلى حاملة داخلية مذهبية يحتل نواتـها الشيـعة السوريون على قـلّة عــددهم، وتؤمّن صلابة تماسك النواة الهيمنة المذهبية العلوية على الحكم والسلطة مع اتساع نفوذها ورسوخه، وإلى ذلك يسيِّج التدخل الإيراني المشار إليه مذهبيات الجوارين العراقي والإيراني، وتدعمهما «أممية شيعية» تنتشر على رقعة بلاد متعددة واسعة.
المتدخل التركي تقتصر مرافعته على داخل سوري فيه شيء من «التركية»، فيه الكثير من الكردية، وهذه الأخيرة تلعب الدور ونقيضه، فهي إذ تقدم للتركي مادة دفاعية في حالة المناوأة، فإنها تقدم له حلفاً موضعياً في حالة تواضع الأهداف الكردية ضمن سورية المستقبلية، وحاجتها إلى حماية من خارج حدودها. هكذا تبدو الداخلية التركية مزدوجة: فهي متوجسة وعدائية حيال حزب العمال الكردستاني وتأثيراته في سورية، وهي مؤازرة وحليفة وداعمة، مع صنف آخر من الأكراد ظل على ارتباط بالنظام السوري حتى أمس القريب، ولا يبدو أنه انتقل إلى القطيعة الكاملة معه، وإن تبدلت التكتيكات السياسية وتغيرت ضروراتها.
في اللوحة أيضاً، وضع الكتلة السلطوية المتحكمة بسورية، فهذه بعد أن تراخت قبضتها وفقدت سيطرتها على أجزاء واسعة من وطنها، تجد نفسها موضوعياً في منافسة وخصام مع المتدخلين الذين جاؤوا لنجدتها، فانتقلوا إلى بيدر الحسابات ليناقشوا حصصهم المناسبة من الغلال. مبعث الخصومة هي هذه القسمة التي قد تجعل الكتلة السلطوية شريكاً محاصصاً هامشياً من جهة، وتجعلها عاجزة عن صياغة الردود الزجرية المناسبة ضد الشركاء، بسبب من أن الشريكين الإيراني والتركي داخليان إلى حدٍ بعيد، والتصدي لهما تترتب عليه كلفة بنيوية أهلية عالية.
بناءً عليه، قد يجد النظام السوري، أو ما سيتبقى منه، ضالته في الخارجي الروسي للاستعانة به على الآخرين. فهذا تحكمه معادلة من دولة إلى دولة، وليس من مذهب إلى مذهب، وبقدر ما تكون بنود الاتفاقية قاهرة في ظرفٍ ما، فإنها تصير خفيفة ولا يمكن الاستغناء عنها في ظرف آخر.
كخلاصة، يبدو الطرف الروسي الشريك الأقل إزعاجاً للنظام، والأكثر قدرة على إزعاج بقية المتدخلين، لذلك قد يتراءى للسلطوي حلم توظيف الطرف الروسي في خدمته، توظيفاً يقرب أحياناً من الأوهام. تلك حسابات مفتوحة والوضع السوري مفتوح على كثير من المفاجآت. فحلف النظام ليس وحيداً في الميدان وكثير من اللاعبين يراقب من علٍ في كل الأجواء، وكل فريق يضمر للآخر تحجيم دوره، أو إخراجه من ميدان المعادلة السورية العامة.
* كاتب لبناني
الحياة
سوريا وقواعد اللعبة الدولية/ سالم الكتبي
من خلال رؤيتهم لما يحدث من تطورات متسارعة في الأزمة السورية، يذهب الكثير من المراقبـين في الآونـة الأخيرة إلى القـول أن العـالم يتجـه إلى قطبيـة جـديدة تقـف على رأسها روسيا، وأن سيطرة الولايات المتحدة الأميركية على النظام العالمي القائم باتت من المـاضي، واعتقد، جـازماً، أن هذا الرأي بحاجـة إلى قـراءة متأنية لأنـه يتجـاهل أمورا عدة، ويرى وجهاً واحداً من الصورة.
ينطلق أصحاب وجهة النظر هذه في تحليلهم من انفراد روسيا بإدارة الوضع في سوريا، بالتنسيق مع كل من تركيا وإيران، حيث نجحت الأطراف الثلاثة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين قوات النظام السوري من ناحية، والتنظيمات الإرهابية من جهة ثانية.
وهنا اعتقد أن الأزمة أكبر وأعقد من مجرد الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فاحتمالات السلام تحتاج إلى ما هو أكبر من غياب المواجهات العسكرية كما وصف ذلك وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.
صحيح أن وقف إطلاق النار يمكن أن يكون مقدمة لإطلاق مفاوضات سياسية بين الأطراف المتصارعة في سوريا، وهذا ما يخطط له في العاصمة الكازاخية أستانة أواخر يناير الجاري، ولكن علينا أن نرى ما وراء الأحداث في هذه الأزمة، وهناك الكثير مما يقال في هذا الصدد.
من بين الأمور اللافتـة في المشهـد السوري المعقد أن روسيـا نفسها قـد تعـرضت لضربات عدة قوية على يد الإرهاب في شهـر ديسمبر المـاضي، ومـن غيـر المنطقـي أن تسارع هي ذاتها إلى قيادة وساطة بين النظام السوري وتنظيمات الإرهاب، إلا إذا كانت ترى أن الزمن ليس في صالحها، وأن إدارة دونالد ترامب القادمة قد تـأتي باستراتيجية جـديدة ليست في مصلحة موسكو، بمعنى أنه من الطبيعي أن تتريث روسيا حتى يتسلم الرئيس ترامب مهام منصبه في العشرين من يناير الجاري، كي تستفيد من التوافق معه في تنفيذ “صفقة” مفيدة للطـرفين، الـروسي والأميـركي، على حد سواء.
ولكن الرغبة في الإسراع بحسم الأزمـة والتوصل إلى تسويات في عجالة تعكس قلقاً من الأطراف التي تسـابق الزمن الآن على الأرض السـورية، حيال نوايا الإدارة الأميركية الجديدة.
الواضح أن الاتفاق الذي تم برعاية روسية-تركية لا يمتلك مقومات حل الأزمة نهائيا لأسباب واعتبارات عدة.
أول الأسباب أن الاتفاق يتجـاهل دور العديد من الأطراف المهمة في سوريا، بل إنه يتجاهل إيران ذاتها، وهي الطرف الذي يدير المشهد العسكري على الأرض، كما أنه لا يشمل مختلف التنظيمات الإرهابية في سوريا.
السبب الثاني أن إشادة المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، سامنثا باور، بمشروع القرار الروسي الأخير حول سوريا، والذي حظي بموافقة جماعية من المجلس لا تعني بالضرورة تسليماً أميركياً بإنفراد روسيا بإدارة الأزمـة في سوريا، ولا يجب أن نتجاهل الفرضية القائلة بأن إدارة باراك أوباما تضع في الفترة الأخيرة ألغاماً على طريق الإدارة الأميركية المقبلة، وهذا ما يتضح من خلال الامتناع عن التصويت على مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلي، أو دعم الموقف الروسي بشأن سوريا في مجلس الأمن.
يصعب، عملياً، أن تسلم إدارة باراك أوباماً أو الرئيس المقبل دونالد ترامب بإدارة روسيا للعالم، ولا يمكن أن توافق واشنطن على إطلاق يد روسيا في الصراعات والأزمات الحيوية بالنسبة للمصالح الاستراتيجية الأميركية، فهذا يعني، ببساطة، انهيارا لحقبة التفوق الأميركي وطياً لصفحة الهيمنة على النظام العالمي الجديد، ناهيك عن أن روسيا لا تمتلك مقومات إدارة هذا النظام بكل تفاصيله وتعقيداته، بل أعتقد أنها لا تطمح إلى ذلك من الأساس، وكل ما تبحث عنه في سوريا هو موطئ قدم على البحر المتوسط، وصفقة مقايضة للمصالح بين روسيا وأوكرانيا، ورد الاعتبار ومناكفة القوة الأميركية بحثاً عن تقاسم نفوذ أكثر مراعاة للمصالح الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط تحديداً.
هناك إشارات لا تخطئها عين المراقب، ومنها عدم رد الرئيس فلاديمير بوتين على طـرد الرئيس أوباما للدبلوماسيين الروس من الولايات المتحـدة، بل ومسارعته إلى تصحيح تصريح له قيـل إنه تعرض للتحريف من قبل وسائل الإعلام الأميركية، وكان قد تحدث فيه عن القوة العسكرية الروسيـة باعتبارها الأكثر تفـوقاً عالمياً، ولكنه عاد لتأكيد أن الولايـات المتحدة الأميركية هي الأكثر تفوقاً من النـاحية العسكرية، وهـذا ما يعني رغبة قوية من جانب الكرملين في تفادي إغضاب السيد المقبل للبيت الأبيض، وهناك حرص شديد على بناء مساحات توافق معه، بل وتجنب أي قرارات قد تتسبب في خسارة لغة الإشارات الإيجابية المتبادلة بين بوتين وترامب.
صحيح أن المسلك الروسي حيال الإدارة الأميركية المقبلة هو مسلك دبلوماسي فطن، ولكنه مسلك يعكس أيضاً توازنات القوى القائمة على الأرض، ولولا ذلك لما أخذت موسكو الإدارة الأميركية المقبلة بعين الاعتبار، ولبادرت بالرد على طرد دبلوماسييها بتصرف مماثل، وهذا ما اعتادت عليه خلال فترة الحرب الباردة، ولكنها تصرفت بمنطق مغاير للحقبة السوفييتية لتؤكد للجميع أن روسيا بوتـين تختلف عن روسيا السوفييتية، على الأقل لجهة إدارة التنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وأن الأمر لا يتعلق بصراع قطبي ولا بحرب باردة جديدة كما يقال، بل بصراع مصالح، ورغبة روسية قوية في إثبات الذات وانتزاع اعتراف أميركي بمصالحها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
كاتب إماراتي
العرب
حرب روسيا الهجينة ضد الغرب/ غاي فيرهوفشتات
توصل مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة إلى أن روسيا أدارت حملة اختراقات وتضليل للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لصالح دونالد ترمب.
وقد لا نعرف أبدا إلى أي حد كانت العملية السيبرانية التي شنتها روسيا ناجحة، ولكننا نعلم أن الكرملين حصل على النتيجة التي تناسب هواه. وكانت مجلة تايم مخطئة عندما اعتبرت ترمب شخصية العام، فمن الواضح أن هذا كان عام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ربما كان الهجوم على الولايات المتحدة مقدمة لمزيد من التدخل في الانتخابات في أوروبا، حيث يتسابق المسؤولون الآن للتصدي للعمليات السيبرانية الروسية قبل سلسلة من الانتخابات المهمة في عام 2017، بما في ذلك في هولندا وألمانيا وفرنسا.
وتحمل الهجمات السيبرانية الأخيرة في أوروبا تشابها غريبا مع الاختراقات المزعومة برعاية روسيا على اللجنة الوطنية الديمقراطية في الولايات المتحدة.
في أوائل عام 2015، اخترقت مجموعة على علاقة بالحكومة الروسية البرلمان الألماني فسرقت ملفات سرية وأعطتها لموقع ويكيليكس الذي نشرها. واتهم المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) روسيا بتدبير هجمات مماثلة على أنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة الألمانية.
ومن ناحية أخرى، تعرضت المفوضية الأوروبية أيضا لهجمة سيبرانية واسعة النطاق في نوفمبر/تشرين الثاني، ورغم أن الجاني لا يزال مجهولا فإن قِلة من الأشخاص أو المنظمات قادرة على تنفيذ مثل هذه العملية.
والهجمات السيبرانية ليست سوى عنصر واحد في حرب هجينة أوسع نطاقا تشنها روسيا ضد الغرب.
فقد ساعدت روسيا المنظمات القومية اليمينية المتطرفة والحركات الشعبوية في مختلف أنحاء أوروبا، فعلى سبيل المثال قدمت قروضا للجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان في فرنسا، ومنحت ساسة حزب استقلال المملكة المتحدة الفرصة للظهور في أوقات الذروة على محطات شبكة “روسيا اليوم” التي تمولها الدولة الروسية.
وقد تعهد الرئيس باراك أوباما أخيرا بالرد على هجوم بوتين على الديمقراطية الأميركية، ولكن كان من الواجب عليه أن يفعل المزيد وأن يتحرك قبل ذلك بكثير.
ومن الحماقة أن يتوقع الأوروبيون المساعدة من إدارة ترمب المقبلة؛ فقد عَرَض ستيفن بانون -وهو كبيرُ الإستراتيجيين في فريق ترمب والرئيسُ التنفيذي الأسبق لموقع “بديل اليمن” الأميركي المتخصص في التضليل Breitbart News- علنا مساعدة لوبان في الفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية في الربيع المقبل.
وتعترف مصادر روسية رسمية بأنها أنفقت 1.2 مليار يورو (1.25 مليار دولار أميركي) على حملات إعلامية أجنبية هذا العام فقط. ففي الاتحاد الأوروبي، ظَهَرَت آلاف المواقع المتخصصة في الأخبار الوهمية والزائفة، والعديد منها بلا ملكية واضحة: تضاعف عدد مواقع التضليل في المجر خلال عام 2014؛ وفي جمهورية التشيك وسلوفاكيا هناك نحو 42 من المواقع الجديدة تعمل الآن على تلويث البيئة المعلوماتية في الاتحاد الأوروبي.
وبشكل أقل خفية، أنفق الكرملين مئات الملايين من الدولارات لتمويل منافذ الدعاية ــمثل وكالة “سبوتنيك” للأخبارــ رغم انهيار الاقتصاد الروسي.
والواقع أن حملات التضليل الروسية معقدة ومتعددة الأوجه، ولكن المهمة التي تشترك فيها تتمثل في تقويض الثقة بالسلطات الديمقراطية الغربية. ويتخلص أحد الأساليب في التصيد بالاستعانة بوسائل الإعلام الاجتماعية.
كما تعمل وسائل الإعلام الاجتماعية كناقل رئيسي للإستراتيجية الروسية التي تعتمد على الرجعية التاريخية (يمثل الزعم بأن روسيا وحدها هي التي فازت بالحرب العالمية الثانية العنصر الرئيسي في هذا النهج)؛ وعلى نظريات المؤامرة التي يُرَوَّج لها بين الحركات القومية الأوروبية والأميركية، وتلقي اللوم على الغرب مثلا في التحريض على الحرب بأوكرانيا؛ وتنتهج إنكار الحقائق مثل وجود قوات روسية في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا.
لكي يدافع الغرب عن نفسه ضد هذه الهجمة، ينبغي له أن يحرص على تشجيع حرية وسائل الإعلام، ومكافأة المساءلة، وتوفير السبل القانونية لإغلاق قنوات التضليل النظامية.
وما يبشر بالخير أن الاتحاد الأوروبي عَدَّل مؤخرا ميزانية 2017 لتعزيز فريق “ستارت كوم” التابع لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، التي كانت تعاني بشدة من نقص التمويل، على الرغم من مهمتها الحرجة المتمثلة في الكشف عن التضليل وفضحه.
ولكن ينبغي للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أيضا أن يستفيدا من درس الانتخابات الأميركية، من خلال تعزيز الدفاع السيبراني الأوروبي الجماعي، والضغط على الدول الأعضاء لحملها على توسيع قدراتها السيبرانية.
وعلى الجبهة السياسية، لابد أن يعلم بوتين أن التدخل الخارجي في الانتخابات الوطنية لن يمر بلا عواقب سلبية وخيمة على المصالح الاقتصادية الروسية.
وإلى جانب التحرك من قِبَل الحكومات، ينبغي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على تصعيد الجهود الرامية إلى التحقق من دقة الأخبار على الإنترنت وتوازنها ومصداقيتها. وبوسع المنظمات التي تعمل معا أن تُحدِث الفارق المطلوب. فعلى سبيل المثال، أوقفت روسيا الطبعة السويدية من مجلة “سبوتنيك” لأن المنظمات الإعلامية السويدية لم تستخدم موادها.
وفي حين أفاد موقع فيسبوك بأنه يسعى إلى تحسين عملية تدقيق وفحص محتواه، فإن التدابير الطوعية قد لا تكون كافية؛ فقد اقترح بعض المشرعين الألمان أن الأمر ربما يتطلب استصدار تشريع لتنظيف منصات وسائل الإعلام الاجتماعية. ومع هذا، تُعَد الصحافة الحرة في أوروبا أقوى دفاعاتها، جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل على فضح الأكاذيب.
لا ينبغي للأوروبيين أن يتهاونوا أبدا في التصدي للحالة الراهنة التي آلت إليها صحافتهم الحرة. فقد أصبحت”Breitbart News” بالفعل في بريطانيا، وهي تخطط للتوسع إلى مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وفي غضون أيام من انتخاب ترمب، ذكرت نيويورك تايمز في تقرير أن “ماريون ماريشال لوبان (ابنة أخ مارين لوبان وقوة صاعدة في الجبهة الوطنية) نشرت تغريدة مفادها أنها توافق على دعوة ستيفن بانون… للعمل معا”.
الواقع أن الديمقراطيات الغربية دخلت فترة من التقلبات، ولم تعد روسيا تلعب وفقا لقواعد اللعبة التي كانت مطبقة حتى في أحلك أيام الحرب الباردة. ويشن بوتين بنشاط حربا هجينة ضد الغرب، وهي الحرب التي بدأنا استيعابها للتو.. ناهيك عن مواجهتها.
والآن حان وقت الدفاع عن قيمنا. ولابد أن عامنا هذا جعلنا على دراية تامة بحجم التحدي الذي يفرضه بوتين على الديمقراطية الغربية. وفي عام 2017، يتعين علينا أن نواجه ونهزم تكتيكاته بشكل مباشر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
الاستخبارات العسكرية الروسية ذراع بوتين في الحرب وعالم السيبيرنيطيقيا/ مايكل ويْس
لطالما اعتبرت الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسية، «جي آر يو» GRU، بديلاً عن جهاز كي جي بي (وكالة أمن الدولة السوفياتية). كادت تلك الهيئة تندثر مع أفول الاتحاد السوفياتي، ولكنها اليوم صارت رأس الحربة في المواجهة بين موسكو وواشنطن.
وتسديد عميل لجهاز الاستخبارات الخارجية التابعة لستالين ضربة فأس على رأس ليون تروتسكي، مؤسس الاستخبارات العسكرية السوفياتية، في المكسيك، كان مرآة التنافس العميق بين أجهزة التجسس الروسية المختلفة. ومذ ذاك، في التاريخ الطويل والمظلم للأجهزة السوفياتية والروسية، خبا ضوء الاستخبارات العسكرية الخارجية، أو GRU، ولمع نجم أجهزة أكثر قوة مثل كي جي بي التي عرفت منذ انهيار الاتحاد السوفياتي باسم «أف أس بي» (وكالة أمن الدولة الفيديرالية) وSVR (وكالة الاستخبارات الخارجية).
ولكن الخميس الماضي، سلطت الأضواء على «الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسية»، حين فرضت إدارة أوباما عقوبات على أربعة من كبار ضباطها لدورهم في اختراق البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية الديموقراطية وبريد مدير حملة هيلاري كلينتون، جون بوديستا. وفرضت كذلك عقوبات مؤسساتية على وكالة التجسس كلها، جنباً إلى جنب مع «أف أس بي».
وتضاءلت أهمية الاستخبارات العسكرية الروسية، إلى حد كبير، بعد الحرب الباردة. وقبل ثلاث سنوات، بدا أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة. فالجهاز هذا نزل به الوهن بعد 2008. وحينها، انتقد عميل الـ «كي جي بي» السابق، فلاديمير بوتين، أداءه خلال غزو جورجيا. ويعزو آخرون الوهن هذا إلى مجموعة من «الإصلاحات» التي قلصت موظفي الجهاز ألف موظف، وأعادت تقسيم الوكالة إلى 5 أقسام بدلاً من 8. وفي وقت زادت موازنات أجهزة التجسس الأخرى، خفضت موازناته إلى أكثر من نصف ما كانت عليه. ولكن الأحوال سرعان ما تغيرت. واليوم، يرى بوتين أن الجهاز هذا أحرز نصراً لا غبار عليه: السيطرة على شبه جزيرة القرم في 2014، وضمها إلى روسيا. وعلى خلاف الأجهزة الأخرى، تولى الجهاز مقاليد حرب روسيا القذرة في أوكرانيا. وصار «السلاح السري» الأثير على قلب بوتين، على قول مارك غاليوتي، المتخصص في شؤون أجهزة الأمن الروسية. فهو قام بمسح شامل للمنطقة، وراقب القوات الأوكرانية المرابطة هناك، وتنصت على اتصالاتهم.
والرجال الخضر الصغار الذين شنوا عملية القرم وحاولوا تكرار الإنجاز في دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، كانوا ضباطاً من القوات الخاصة في الاستخبارات العسكرية الروسية ممن يملكون خبرة كبيرة حصلوها في أفغانستان والشيشان والبلقان. ومن الأدلة الدامغة على دورهم، العثور في القرم على بندقية فينتوريز التي تستخدمها القوات الخاصة في هذا الجهاز. وفرضت العقوبات على إيغور ستريلكوف، القائد السابق لـ»الجمهورية دونيتسك الشعبية»، وأدرج على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي باعتباره عميلاً في الاستخبارات العسكرية الروسية.
وفي أيّار (مايو) 2015، قبضت السلطات الأوكرانية على اثنين من قوات الكوماندوس الحربية التابعة للاستخبارات العسكرية، هما يفغيني يروفييف وألكسندر ألكسندروف، وجرت مبادلتهما بناديا سافتشينكو، ربانة الطائرة الأوكرانيّة التي قبض عليها على الأراضي الأوكرانية وخضعت لمحاكمة صورية في روسيا. وصارت الربانة هذه رمز النضال، ونائبة منتخبة في البرلمان الأوكراني. ولا شك في أن مبادلة أسيرة حرب غير معلنة بجاسوسين هو خطوة بوتينية موفقة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الاستخبارات الروسي الوحيد الذي فرضت وزارة المالية الأميركية عقوبات عليه جراء غزو أوكرانيا كان اللواء إيغور سيرغون، مدير الاستخبارات العسكرية الروسية. وتوفي سيرغون العام الماضي، كما يبدو بسبب قصور في القلب (على رغم تردد إشاعات في كل من أوكرانيا وروسيا بأنه صفي بسبب إدارته السيئة «للانفصاليين» في دونباس)، ووجد خلفه، إيغور كوروبوف، نفسه اليوم وثلاثة من نوابه على لائحة عقوبات مماثلة، جزاء التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وثبت أن المسؤول عن الأعمال العدائية المستمرة في أوروبا هي جهة واحدة، الاستخبارات العسكرية الروسية. فقبل أسبوعين، وجدت شركة المعلومات كراودسترايك، أن الجهاز الروسي هذا ركز حربه الإلكترونية على أرض المعركة الأوكرانية من طريق زرع فيروس على تطبيق هاتفي ابتكره الضابط الأوكراني، ياروسلاف شيرستيوك، لإرشاد طواقم المدفعية على الأهداف، ووزع في المنتديات العسكرية من صيف 2014 إلى 2016. والفيروس هذا يتسلل إلى التطبيق، ويدعى «إكس-إيجينت»، وهو مرتبط بـ «فانسي بير»، فريق إلكتروني في GRU تبين أنه المسؤول عن خرق لجنة الحزب الديموقراطي ورسائل جون بوديستا. ولذا، في وسع الاستخبارات العسكرية الروسية مراقبة مواقع الجنود الأوكرانيين، وجميع رسائلهم القصيرة، وسجلات المكالمات، وقوائم الاتصال، وبيانات الإنترنت. وحجم العدوى غير معروف، ولكن يبدو أنها أصابت، بحسب مبرمج التطبيق، حوالى 9000 مستخدم، وجميعهم يستخدمون مدفعية D-30 (الدعامة الأساسية للمدفعية الأوكرانية).
والسابقة الأوكرانية تدعو إلى التساؤل: هل كانت السرعة التي سيطرت فيها القوات الموالية للأسد على شرق حلب، ناجمة عن تخريبات إلكترونية. قبل التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية، في أيلول (سبتمبر) 2015، دارت تقارير على تعامل ضباط من الاستخبارات العسكرية الروسية مع النظام السوري. وتعرض عميل سابق في الجهاز هذا لإطلاق نار في الوجه أثناء «قضاء عطلته» في منطقة الحرب.
ومنذ بداية حرب بوتين الثانية، صارت مهمات الاستخبارات العسكرية الروسية أكثر علانية. وأبرز الخسائر الروسية في سورية هو فيودور جورافليوف، الذي قتل أثناء أدائه لمهامه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. والعدد الحقيقي لعملاء الجهاز في سورية غير معروف، وهو يقدر بالمئات. ولكن سلاح بوتين السري ذاع صيته، ولم يعد سراً.
* صحافي أميركي، عن موقع «ذي دايلي بيست» الأميركي، 31/12/2016، إعداد علي شرف الدين
الحياة
اندلاع الحرب العالميّة الإعلاميّة الكبرى/ رائد جبر
كما وُصف عام 2016 بأنه «عام روسيا في سورية» و»التقلبات الكبرى التي قادت الى تعزيز نفوذ الكرملين في العالم»، تعكس مجريات العام أنه «عام اشتعال الحرب الإعلامية العالمية الكبرى» وفق وصف محلل قريب من الكرملين، اعتبر أن التطورات في 2016 أظهرت ضخامة تأثير الحملات الإعلامية والدعاية والدعاية المضادة في سير العمليات السياسية والعسكرية.
وبــدأ العام بحملات غير مسبوقة في مواجهة «الطابور الخامس» ومحاولات «بث الفتن وتشويه صورة روسيا»، وانتهــى بإقرار عقيدة «أمن المعلومات» التي تشدد على «مواجهة التأثير الخارجي عبــر وسائل الإعلام الهدامة التـــي تسعى الى تشويه وعي الروس، خصــــوصاً الشباب منهم، وتحطيم الروح المعنوية والقيم الروسية التقليدية».
قد يكون الوصف الأكثر دقة للمشهد الإعلامي في روسيا في 2016، هو ما كتبه معلق في مؤسسة حكومية موجهة حين وصف العاملين في وسائل الإعلام الروسية بأنهم «كتيبة صحافية مقاتلة». وتبدو هذه العبارة واحدة من الجمل النادرة التي يمكن وصفها بأنها «صادقة» على شبكات الإعلام الروسي، التي غابت عنها تقريباً فكرة أن الصحافي ناقل للحدث، وأن المعلومة يجب أن تكون كاملة، وحلّت مكان الفكرة هذه نظرية أن الصحافي مقاتل في المعركة التي تخوضها روسيا على جبهات كثيرة لإثبات صحة وجهة نظرها.
لكن هذا المعنى، لم يكن من اختراع المعلق، إذ تم «إنزاله» بتعليمات واضحة منذ أعلنت الماكينة الإعلامية الروسية «حربها على قنوات التضليل الغربية». ويكفي تذكُّر ما قاله ديمتري كيسيليوف، المدير العام لمؤسسة «روسيا سيفودنيا» التي أسسها الرئيس فلاديمير بوتين على أنقاض وكالة «نوفوستي» المنحلّة. وكيسيليوف المقرب من الكرملين قال في اجتماع عام للعاملين في الوكالة الجديدة يوم تسلّمه منصبه: «لا يوجد إعلام، كل الإعلام مرتبط بأجندات، توجد روح وطنية فقط وعلينا أن نتمسك بها وندافع عنها وعن وطننا».
في حزيران (يونيو) الماضي، نظمت الوكالة هذه «منتدى إعلامياً دولياً» دعت إليه «مؤسسات الإعلام الممانع»، وفق التعبير الرائج في الشرق الأوسط، ووسائل إعلام أوروبية تمثل أحزاباً يمينية قومية وممثلي وسائل الإعلام في «البلدان الحليفة» لروسيا. وأمام هذا الحضور، انتقد بوتين «الحرب الإعلامية التي يشنّها الغرب على روسيا». ويومها، أوضح كيسيليوف في كلمته أمام الحضور، هدف تنظيم اللقاء الذي سعى الى تشكيل «جبهة إعلامية عالمية لدعم سياسات روسيا»، وقال: «إننا أمام عصر جديد للصحافة، ويمكننا أن نقول وداعاً للتيار السائد، وعلينا أن نقدم معلومات بديلة لتلك التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على المشهد الإعلامي العالمي، بديلة عن المعلومات التي تروق لهم وتخدم مصالحهم».
هكذا، أشعلت روسيا التي تقع في ذيل اللائحة الدولية لحرية الصحافة بترتيب 181 مجاورة لإثيوبيا والسودان تقريباً، «الحرب الإعلامية العالمية».
وليس مهماً هنا، التوقف طويلاً أمام سيل المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام الروسية بهدف الترويج الداخلي، فالمتلقي الروسي يكاد لا يعرف شيئاً عما يحدث في سورية وفي أوكرانيا وفي مناطق أخرى من العالم غير أن بلاده تواجه إرهاباً يهدد وجودها. أما الصور ومقاطع الفيديو والمعطيات التي تتداولها وسائل إعلام «أجنبية»، فهي كلها من صناعة «قنوات التضليل الإعلامي».
وتدخل ضمن نشاط قنوات التضليل «فبركة» مقاطع الفيديو التي تشير الى وضع كارثي في حلب، أو الى معاناة إنسانية في بلدات محاصرة لسنوات في ريف دمشق. المتلقي الروسي مقتنع تماماً بأن كل النازحين من حلب ومن كل البلدات الأخرى «هرعوا الى أحضان الحكومة الشرعية بعدما ظلوا رهائن لسنوات عند الإرهابيين». ولا كلمة واحدة في الإعلام عن لجوء عشرات الألوف الى مناطق تخضع لسيطرة الأكراد أو فصائل المعارضة السورية. لكن هذا جزء يسير من حملات الحرب الإعلامية الموجهة لنقل الحدث السوري. فالنشاط الإعلامي أوسع بكثير من ذلك.
وفي أيلول (سبتمبر)، نشرت وسائل إعلام غربية تقريراً مطولاً عن حال الإعلام الروسي، يوضح للمرة الأولى سبـــب اتخاذ تدابير قانونية في بعض بلدان أوروبا ضد نشاط وسائل الإعلام الروسية، واعتبر التقرير أن «تشويه المعلومات وصناعة الأكاذيب ونشرها علـــى أوسع نطاق في وسائل الإعلام التقلـــيدية وشبكات التواصل الاجتماعي، هي من العناصر البارزة في العقيدة العسكرية الروسية، وأن حجمها صار أكبر من الدعاية السوفياتية سابقاً».
وأضافت أن الغرض هو التشكيك في الرواية الرسمية للحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للأحداث، أو التشكيك في فكرة وجود رواية حقيقية للأحـــداث أصلاً. ودار كلام التقرير على «تسليح المعلومات»، واعتبر أن «السلاح» هذا هو الأداة الأساسية التي تستخدمها روسيا حالياً. وصارت وظيفة المعلومات صنو وظيفة السلاح.
ونسب إلى رئيس الأركان الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، قوله أن دور الوسائل غير العسكرية في بلوغ أهداف سياسية واستراتيجية تعاظم، وتجاوز في كثير من الحالات قوة الأسلحة المادية وفاعليتها. وبين الأهداف الرئيسية للكرملين، إبراز دور اليمين الشعبوي وتشجيع ضمور التأييد لمؤسسة الاتحاد الأوروبي.
ولا يمكن الاختلاف مع التقرير في أن وسائل الدعاية الروسية تصف الغرب بأنه منقسم ووحشي ومتهالك وغير مستقر، وأن أمواج اللاجئين والمهاجرين العنيفين اجتاحته. وتبدو أوروبا أنها قارة على حافة الانهيار في الإعلام الروسي. فهذه الأوصاف هي الأكثر تردداً على شبكات التلفزة الروسية يومياً، وفي برامج الـ»توك شو» التي تجذب ملايين المشاهدين.
ولاحظ التقرير أن قناة «آر تي» الروسية «تبدو في كثير من الأحيان مهووسة بمراقبة الولايات المتحدة». وهذه العبارة نفسها تقريباً أوردتها صحيفة «نوفايا غازيتا» المعارضة في معرض تغطية واسعة لأداء الإعلام الروسي خلال انتخابات مجلس الدوما في أيلول (سبتمبر) الماضي، وقالت أن اللافت أن تغطيات الانتخابات (عندنا) تبدو أقل نشاطاً من اهتمام صحافتنا بسير الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة ومحاولات تصيد أخطاء الديموقراطيين وإبراز أفضلية خصومهم».
وساق التقرير الغربي عدداً كبيراً من الأمثلة على ما وصفه بـ»الأكاذيب والتشويه والدعاية الروسية»، واستهل الأمثلة بالكلام على تدخل الإعلام الروسي في النقاش الدائر في السويد حول شراكة عسكرية مع حلف الأطلسي، «الناتو».
ولاحظ أن المسؤولين في السويد واجهتم مشكلة مقلقة: سيل من المعلومات الخاطئة على شبكات التواصل الاجتماعي شوّشت إدراك السويديين المسألة. وذهبت هذه المعلومات الى أن إبرام السويد اتفاقاً مع الناتو، يؤدي الى تخزين الحلف أسلحة نووية سراً (في السويد) ويهاجم روسيا من دون موافقة الحكومة السويدية، والى اغتصاب جنود الناتو – المحصنين وتتعذر مقاضاتهم – السويديات من دون خوف من جزاء.
وذكر التقرير أن هذه المعلومات انتشرت في وسائل الإعلام التقليدية بالسويد إلى درجة أن وزير الدفاع الذي كان يتجول في أنحاء عديدة من البلاد، ظلّ يتعرّض للأسئلة طوال رحلته بناء على هذه المعلومات. ويظهر المثل هذا من غير لبس أن الكرملين يرمي في عقيدة أمن المعلومات الجديدة، الى إرباك الخصم إعلامياً وحشره في سجالات، ومحاولة التأثير في سير العمليات الداخلية في عدد من البلدان، ناهيك عن تقديم رؤية مغايرة الى المتلقّي الروسي في الداخل. وعلى أقل تقدير، تصبو الدعاية الروسية الى «إقناع الناس بألا يصدقوا أحداً».
الحياة