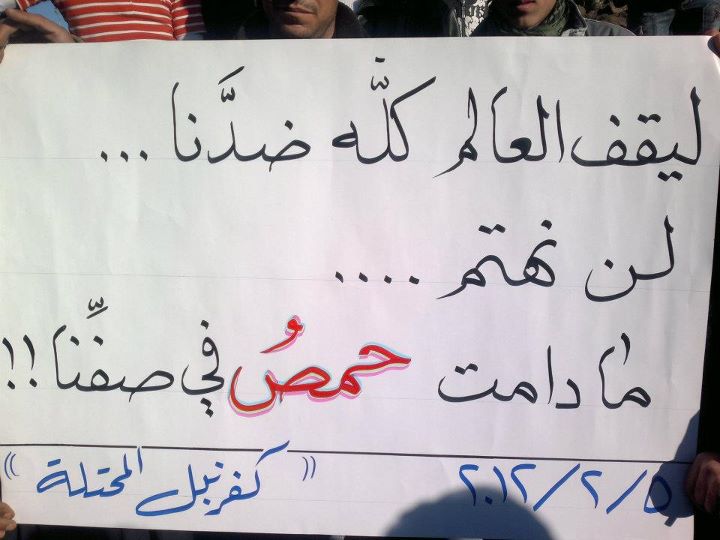عن الطائفية ما بعد كرم الزيتون

ياسين الحاج صالح
كان لمقتلة كرم الزيتون ليلة 11-12 آذار (مارس) الجاري تأثير فوري في حرارة المواقف والانفعالات الطائفية في سورية. كانت هذه الحرارة ارتفعت بثبات وبتناسب طردي دقيق مع توسع النظام في الإرهاب طوال عام الثورة المنقضي، لكنها بلغت درجة الحمى بعد كرم الزيتون. ومع الحمى يأتي الهذيان، كلام مفكك منفصل عن الواقع، يأخذ واحداً من شكلين: فهو إما انجرار طائش وراء التسعير الطائفي، أو اجترار كلام أجوف عن سورية التي للجميع، وعن السوريين الذين هم إخوة.
يدفع السوريون ثمن عقود طويلة من استغفال النفس، وتحريم النقاش في هذا الشأن على أنفسهم، والتشكيك في أن التفكير العلني فيه هو الطائفي. ومقابل ذلك لم تُقترح يوماً تصورات إيجابية عن الصيغ السياسية والمؤسسية والحقوقية لتنظيم الحياة العامة في البلد بما يضمن الأخوة المفترضة، ولم يجر يوماً تحليل واف لجذور المشكلة ودينامياتها. وبعد نحو نصف قرن من إدمان النميمة الطائفية، ليس هناك كتاب واحد مهم عن هذه المسألة الخطيرة كتبه سوري (هناك عشرات الكتب في لبنان على الأقل).
وإنما بفعل سياسة استغفال الذات هذه لا يفرض الموضوع الطائفي نفسه علينا على ما فعل بقسوة بعد كرم الزيتون، وطوال الثورة في الواقع، إلا لنجد أنفسنا نتكلم وفقاً لواحد من منطقين هاذيين: منطق الإباحية الطائفية الذي يرد المشكلات الطائفية إلى وجود طائفة أو طوائف شريرة، والحل هو التخلص منها طبعاً، أو منطق التعفف الطائفي الكاذب الذي يخدش سمعه أي تناول للطائفية، ويهنأ باله بالسكوت عليها. كلنا سوريون، كلنا إخوة، عيب يا شباب! وستبدو الطائفية في الحالين شجرة برية، جذرها في المجتمع أو أجزاء منه، وفرعها في الأفكار. بينما يسدل ستار من الصمت على مطرح تشكلها النوعي، النظام السياسي، الذي هو أيضاً الموقع الأفضل تأهيلاً لمعالجتها.
كرم الزيتون ووقائع كثيرة جرت في مسار الثورة هي نتاج نظام سياسي يتوسل الطائفية منذ عقود كأداة حكم أساسية. هذا واقع يعرفه السوريون كلهم من دون استثناء، وإن تكتموا عليه رهبة أو رغبة. في البلد حكم شخصي (غير مؤسسي وغير قانوني)، يستند إلى أهل ثقته في أمنه وإعادة إنتاجه لذاته، وأساس الثقة هذه طائفي (ليس وطنياً ولا مواطنياً)، وتجري أشكال من التمييز بين السوريين في الأجهزة الارتكازية، وتخويفهم من بعضهم على أسس طائفية. وما نسميه النظام في سورية، أي المركّب السياسي الأمني بخاصة (والمالي في العقد الأخير) هو مضخة الظواهر الطائفية التي يشكل ارتفاع الوعي الذاتي الطائفي وضعف التماهي الوطني قياساً إلى التماهي الطائفي أوجهاً اعتيادية لها.
وما وسم مذبحة كرم الزيتون من هول مشحون بالكراهية، سبق أن ميز جرائم الصرب في البوسنة ومذابح التوتسي في رواندا… مؤشر حاسم الى المدى الذي بلغه نمو الغول الطائفي في البلد برعاية النظام وأجهزته. كان عنف النظام السوري منذ بداية الثورة، بل منذ بداية النظام، يحمل القليل جداً من سمات عنف الدولة، أو حتى عنف نظام ديكتاتوري.
وتجنباً لسوء فهم سهل، فإن النظام الطائفي لا يمثل طائفة أو يرعى مصالحها، وإنما هو من يستخدم الطائفية أداة حكم رخيصة، ويجد في التفريق الطائفي وإعادة إنتاجه الموسعة ما يرسّخ مقامه في السلطة العمومية، وإن اقتضى ذلك، وقد اقتضى دوماً في الحالة السورية، توفير عتبات تماهٍ غير متساوية للسوريين في نظامهم السياسي، بحيث يشعر بعضهم بأنهم في بيتهم، وبعضهم بالغربة في وطنهم. الكلام على نظام طائفي هو كلام على نظام، ترتيب للسلطة والثروة والنفوذ، وليس على طائفة.
الطائفية ليست عاهة خلقية، ولا هي لعنة إلهية، وإنما هي نتاج خيارات بشرية وانحيازات بشرية، لذلك يمكن التخلص منها بأفعال بشرية مناسبة. ورثنا مثلما ورثت دول العالم كلها تكوينات أهلية متخارجة، ومتخاصمة أحياناً. لا شيء خاصاً بنا أو فريداً في ذلك. وكان المسار العام للتطور الاجتماعي والسياسي في سورية قبل الحكم البعثي يسير باتجاه تخارج أقل وتقلص تلك الفوارق الموروثة. أما بعد الحكم الأسدي فلم يقتصر الأمر على أنه لم تبذل جهود ضرورية لصنع مزيد من التداخل والقرابة بين هذه التكوينات، بل بذلت جهود كبيرة لتغذية خصوماتها وارتيابها ببعضها بعضاً. وفرضت في المقابل أولوية وطنية عليا هي الخلود في السلطة أياً يكن الثمن، وهو ما يكفي وحده للنظر إلى المجتمع المحكوم كمصدر أخطار ينبغي توقّيها، ويدفع إلى الصدارة ضرورة إضعافه بكل الوسائل المتاحة. وقد مر ذلك بخصخصة الدولة والبلد ذاته (سورية الأسد)، وترجم نفسه بتوريث الحكم ضمن الأسرة الأسدية مطلع هذا القرن.
وقد كان لب منهج النظام في الحكم هو منع المجتمع السوري من تطوير أي تماسك ذاتي في أوقات السلم (المجتمع الممسوك)، والعمل على تحويل الصراع السياسي إلى نزاع أهلي في أوقات تصاعد الاحتجاج عليه. ولا يفعل شيئاً مختلفاً أولئك الذين يلومون أفراداً أو جماعات أو «المجتمع» على ما هو نتاج النظام السياسي في البلد. حسن النية لا يغير من الأمر شيئاً.
والواقع أن مسؤولية النظام السياسي عن أية مشكلات عامة هي مسلّمة عملية في أي تفكير سياسي حديث. ليست هناك أشياء غير سياسية في المجتمعات المعاصرة، والمشكلات الاجتماعية مسؤولية الحاكمين في كل حال، أياً يكن هؤلاء. هذا حتى لو تجادلنا في مسؤوليتهم الأساسية عن التسبب المباشر بالمشكلات المعنية. وما كان صحيحاً أمس قبل الثورة، وما هو صحيح اليوم أثناءها، سيبقى صحيحاً غداً بعد الثورة. فليتحسب المجادلون لأنفسهم.
الخلاصة أن لدينا بـؤرة عـفـنة من الـوحشية والكراهية والتمزق الوطني هي «النظام»، الذي يتكثف تحديداً في الأسرة الأسدية، وأن فرصنا في تجاوز الانـقـسام الوطني ومواجهة مشكلات وطنية عمرها من عمر البلد، مرهونة بالتخلص من هذه البؤرة العفنة. التخلص مـن هـذا الـنظـام هـو الواجـب الوطـنـي الأول للـسـوريـيـن إن كـانوا يـتـطلعون إلى التـكوّن كـشـعب. لقد تسبب النظام الأسدي بكارثة اجتماعية ووطـنية وإنسانية في سورية، ما يقضي بأن التخلص منه هو واجب الـسـوريـين الوطني والإنـساني الأول.