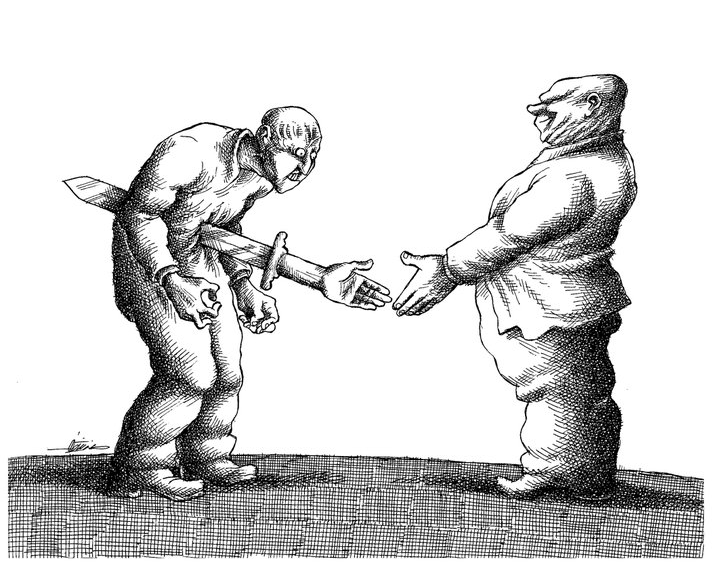عن المعارضة السورية –مقالات مختارة-

ثلاث وثائق تحدد توافقات المعارضة… وبقاء «عقدة» الأسد ومبادئ الدستور/ إبراهيم حميدي
نصوص الأوراق… ودي ميستورا يدعو «الهيئة» ومنصتي القاهرة وموسكو إلى جنيف
دعا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وفود «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة ومجموعتي القاهرة وموسكو إلى محادثات في جنيف في 22 الشهر الحالي؛ للوصول إلى «موقف موحد» إزاء ثلاث أوراق تتعلق بمبادئ الحل السياسي وآلية صوغ دستور جديد وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وفي حال توصلت الوفود الثلاثة إلى «موقف موحد»، يراهن دي ميستورا على دعوة وفدي الحكومة والمعارضة إلى مفاوضات مباشرة في جنيف في الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.
في موازاة ذلك، تجري اتصالات بين فرقاء المعارضة ودول إقليمية لترتيب نجاح المؤتمر المقبل للمعارضة في الرياض في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) والحسم بين خيارين: الأول، يقوده قياديون في «الهيئة» لعقد لقاءات مع «منصتي» (مجموعتي) القاهرة وموسكو بعد أيام، ثم العمل على توسيع «الهيئة» بناء على بيان مؤتمر المعارضة في الرياض نهاية العام 2015. الثاني، يسعى إليه معارضون آخرون للوصول إلى مؤتمر موسع للمعارضة يقر موقفاً مرجعياً أساسه القرار 2254 و«بيان جنيف».
إلى حين ذلك، يواصل دي ميستورا وفريقه العمل لإبقاء عجلة «المشاورات الفنية» بين «الهيئة» ومجموعتي القاهرة وموسكو، خصوصاً بعدما رفض اجتماع «الهيئة» الأخير إقرار مسودات الأوراق، التي تنشرها «الشرق الأوسط» اليوم، كان توصل إليها ممثلو المجموعات المعارضة الثلاث في محادثات سابقة في جنيف ولوزان.
الوثيقة الأولى: «مبادئ الحل السياسي»، تعود إلى جولة المفاوضات السورية في جنيف في أبريل (نيسان) العام 2016، عندما قدمها وثيقة من صفحتين و12 مبدأ إلى ممثلي الحكومة و«الهيئة»، بحيث تشكل أسس الحل السياسي المنشود في البلاد. وقتذاك، تحفّظ الطرفان على الوثيقة.
في الجولة التفاوضية في مارس (آذار) الماضي، جدد المبعوث الدولي الدماء في هذه الوثيقة التي سمت بـ«لا ورقة»، وقدم نسخة جديدة. ولدى المقارنة بين وثيقتي 2016 و2017، ظهر تراجع في السقف السياسي. إذ لوحظ غياب الحديث المباشر عن «الانتقال السياسي» والقرار 2254 في البند السادس من الوثيقة الجديدة، وإن كانت البنود الثلاثة للقرار 2254، أي الحكم، الدستور، الانتخابات، ستكون محل مفاوضات بين الأطراف السورية بهدف تحقيق الانتقال السياسي. وباتت تعرف بـ«السلال الثلاث» قبل أن تضاف إليها «سلة رابعة»، تتعلق بـ«محاربة الإرهاب».
ولدى مقارنة الوثيقتين، ظهر أيضا تغير في الملف الإشكالي الآخر المتعلق بدور الجيش السوري. إذ كان البند العاشر نص على التزام السوريين «إعادة بناء جيش موحد وقوي عبر نزع سلاح ودمج عناصر الفصائل المسلحة لدعم الانتقال السياسي والدستور الجديد مع احتكار السلاح. ولن يكون هناك تدخل من العناصر الأجنبية في الأراضي السورية»، في حين نص البند السابع من وثيقة 2017، على «الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي بشكلٍ حصري الحدود الوطنية لتحفظ شعبها من التهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، وعلى أجهزة الاستخبارات والأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون».
أمام مأزق المفاوضات السورية السياسية وانطلاق عملية آستانة نهاية العام الماضي برعاية روسية – تركية – إيرانية، والوصول إلى اتفاق «خفض التصعيد» في أربع مناطق هي: إدلب، ريف حمص، غوطة دمشق ودرعا. ثم توقيع اتفاقيات تفصيلية برعاية أميركية – مصرية – أردنية، اقترح فريق دي ميستورا قبل أشهر دخول وفدي الحكومة والمعارضة في مشاورات فنية حول آلية صوغ الدستور، إضافة إلى بذل جهد بين وفود المعارضة الثلاثة لـ«توحيد موقفهم» طالما أن «وحدتهم غير ممكنة» حالياً. عليه، دعا فريق الأمم المتحدة وقتذاك إلى جولات بين وفود «الهيئة» ومجموعتي القاهرة وموسكو في جنيف ولوزان قبل الجولة بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف في يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب وثيقة داخلية حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، قال وفد «الهيئة» في 13 يوليو، إنه طرح أربعة أسئلة على «منصتي» القاهرة وموسكو لـ«توضيح مواقف المنصتين، وكانت الأسئلة كالتالي والتي تركزت حول السلة الأولى: ما هو تعريف هيئة الحكم الانتقالي، آلية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، صلاحيات هيئة الحكم الانتقالي، الأساس القانوني لهيئة الحكم الانتقالي».
وكانت أجوبة «منصة موسكو» في 12 يوليو، بحسب الوثيقة، هي: «هيئة الحكم الانتقالي: هو الانتقال من ترتيبات الحكم الحالي إلى حكم جديد، ويتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية كاملة. آلية تشكيلها: الرئيس يكلف خمسة نواب له، أو يعين خمسة نواب له، وهؤلاء النواب يتم التوافق عليهم في مرحلة الاتفاق السياسي بين النظام والمعارضة ويكون مهامهم كالتالي: نائب للرئيس مسؤول عن الدفاع والجيش، نائب للرئيس مسؤول عن الأمن، نائب للرئيس مسؤول عن السياسات الخارجية، نائب الرئيس مسؤول عن القضاء والتشريع، نائب للرئيس مسؤول عن الحكومة، حيث يتنازل الرئيس عن كامل صلاحياته لنوابه».
وتابعت الوثيقة: «يتبع كل نائب رئيس عشرة أشخاص يشكلون مجلساـ مجلس للقضاء والتشريع مثلا، ما عدا النائب المسؤول عن الحكومة يتبعه ثلاثون شخصا هم يشكلون الحكومة، وهذا العدد، أي العدد الإجمالي هو 70 عضوا بمعدل عشرة أعضاء على شكل مجلس يتبع نواب الرئيس الأربعة وثلاثون عضوا لنائب الرئيس عن الحكومة صلاحيات نواب الرئيس واسعة وكذلك هناك صلاحيات للمجلس التابع له دون العودة لنائب الرئيس يتم الاتفاق عليه، وتتشكل هيئة الحكم الانتقالي من هؤلاء إضافة إلى عدد آخر يتم الاتفاق عليهم».
بالنسبة إلى «المرحلة الانتقالية»، أشارت الوثيقة إلى موقف «منصة» موسكو، أنها «تبدأ من لحظة الاتفاق وحتى ستة أشهر وتكون المرجعية في هذه المرحلة هو الدستور 2012، وبعد ستة أشهر تبدأ مرحلة جديدة تستمر حتى 17 شهرا، وحينها يعتمد إما إعلان مبادئ دستورية أو تعديلات على الدستور 2012 حتى يتم إعداد دستور جديد للبلاد».
أما موقف «منصة» القاهرة، بحسب الوثيقة، فكانت «متوافقة مع موقف الهيئة العليا، حيث يطالبون برحيل الأسد وزمرته في بداية المرحلة الانتقالية».
لكن الوفود الثلاثة، استطاعت التوافق على الأوراق المرجعية الثلاث. وإذ اعتبرتها «منصتا» القاهرة وموسكو، فإن «الهيئة» اعتبرتها «أوراقاً غير نهائية إلى حين اعتماد موقف مشترك من مسألتي رحيل الأسد ومبادئ الإعلان الدستوري»، إضافة إلى تحفظ البعض على البند الثاني من أسس «المرحلة الانتقالية» التي أشارت إلى «أن أي عملية انتقال سياسي ستتم تحت إشراف حكم انتقالي جديد وجامع وذي مصداقية يحل محل ترتيبات الحكم الحالية» من دون الإشارة إلى «هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة».
خلال اجتماع «الهيئة» الأخير الذي كان مقرراً أن يقر الأوراق الثلاث، قال قياديون إنها تضمنت «تنازلات وتفريطاً وتجاوزا للخطوط الحمر»، في حين ربط مفاوض آخر في «الهيئة» الإقرار السياسي لهذه الأوراق بتحديد مجموعتي القاهرة وموسكو موقفهما من أمرين: مصير الرئيس بشار الأسد ومبادئ الإعلان الدستوري.
عليه، بعث مكتب دي ميستورا دعوة خطية للوفود الثلاثة للاجتماع في جنيف أو ضواحيها بين 22 و27 الشهر الحالي لـ«عقد لقاءات إضافية في إطار المشاورات الفنية البناءة حول الدستور والقضايا القانونية». وستكون هذه الأوراق أساساً للمحادثات:
مبادئ الحل السياسي
– توافق الوفد التقني لكل من «الهيئة العليا للمفاوضات» ومنصة القاهرة ومنصة موسكو على رؤيتهم لورقة المبادئ الخاصة بالمبعوث الدولي للملف السوري والتي تشكل رؤية للشكل النهائي للدولة السورية، وهي ورقة حية قابلة دوماً للتجديد والتطوير:
1 – الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً احتراماً كاملاً. وفي هذا الصدد لا تنازل عن أي جزء من الأرض الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السورية المحتلة بكافة الوسائل المشروعة حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
2 – الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها واحترام تلك السيادة وتلك الحقوق بالكامل، وتحقيقاً لهذا الغرض تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي والإقليمي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه.
3 – يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي الاجتماعي، دون أي ضغط أو تدخل خارجي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
4 – تكون الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، تسودها التعددية السياسية وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وحماية الحريات العامة، وحرية المعتقدات وتتم بحكم قوامه الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، بما في ذلك المساءلة أمام القانون الوطني.
5 – تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والتمثيل العادل.
6 – في استمرارية مؤسسات الدولة العاملة، وتحسين أدائها وحماية البنى التحتية، والممتلكات الخاصة والعامة وفق ما نص عليه بيان جنيف، والقرارين 2118. و2254 والقرارات ذات الصلة، وتوفير الخدمات العامة لجميع المواطنين دون تمييز، وفقاً لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، وتقام لصالح المواطنين في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة آليات فعالة على نحو يكفل الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الخاصة والعامة.
7 – بعد نهاية المرحلة الانتقالية يريد السوريون جيشاً وطنياً واحداً، مبنياً على أسس وطنية يكون الترفيع فيه على أساس الكفاءة، وأن يلتزم الحياد السياسي، وتكون مهمته حماية الحدود الوطنية، وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب وفق الدستور، مع إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني، وأمن المواطن، وتخضع للقانون والدستور، وفق معايير احترام الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، وعدم تدخلها في حياة المواطنات والمواطنين اليومية، وحصر حق حيازة السلاح بيد مؤسسات الدولة المختصة.
8 – الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف، والطائفية، والالتزام الفعلي بمكافحتها، والعمل على إزالة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لمنع ظهورها.
9 – حماية حقوق الإنسان والحريات، ولا سيما في أوقات الأزمات، بما في ذلك كفالة عدم التمييز، والمساواة في الحقوق، والفرص للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية، أو الهوية الثقافية، أو اللغوية، أو الجنس، أو أي عامل تمييز آخر وإيجاد آليات لحماية تلك الحقوق، وكفالة الحقوق السياسية والفرص للمرأة وفق الأصول، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة تضمن تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار، مع كفالة مستوى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة وصولاً للمناصفة.
10 – تعتز سوريا بتاريخها وتنوعها الثقافي، وبما تمثله جميع الأديان والتقاليد من إسهامات وقيم بالنسبة للمجتمع السوري، ولا يسمح بأي تمييز ضد أي مجموعة من المجموعات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو الثقافية أو الإثنية، وسيتمتع أفراد هذه المجموعات كافة نساء ورجالاً بتكافؤ الفرص في مجال الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعامة.
11 – توفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى، التي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب ومحاربة الفقر وإنهائه مع كفالة سلامة النازحين واللاجئين والمهجرين قسراً وتوفير المأوى لهم، بما في ذلك كفالة حقهم في العودة إلى ديارهم.
12 – صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة، طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة، وبما يتسق مع إعلان اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.
القواسم المشتركة إزاء الانتقال السياسي
> توافقت الوفود في لوزان على اعتبار الأسس الخمسة عشرة التي وضعها دي مستورا في ملخصه لجولة أبريل 2016 أمام مجلس الأمن الدولي أساساً صالحاً لعملية الانتقال السياسي، وهذه البنود هي:
1 – أن عملية انتقال سياسي يقودها ويديرها السوريون أنفسهم أمر لا بد منه لإنهاء النزاع في سوريا.
2 – أن أي عملية انتقال سياسي ستتم تحت إشراف حكم انتقالي جديد وجامع وذي مصداقية يحل محل ترتيبات الحكم الحالية.
3 – أن الحكم الانتقالي سيتولى المسؤولية عن حماية استقلال سوريا، وسلامة أراضيها، ووحدتها وفقاً لمبادئ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
4 – أن الحكم الانتقالي سيكفل تهيئة مناخ من الاستقرار والهدوء والسلامة أثناء المرحلة الانتقالية بما يوفر للجميع، بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة، الفرصة بالمساواة مع غيره، لكي يرسخ مكانته ويقود حملته في الانتخابات المقبلة وفي الحياة العامة.
5 – أن الحكم الانتقالي سيكفل استمرار الوزارات والمؤسسات وغيرها، من كيانات الخدمة العامة في أداء وظائفها وتحسينها وإصلاحها خلال المرحلة الانتقالية.
6 – أن الحكم الانتقالي يمكن أن يضم أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة وأعضاء مستقلين وجهات أخرى.
7 – أن المرأة ستتمتع بالمساواة في الحقوق والتمثيل في جميع المؤسسات وهياكل صنع القرار خلال المرحلة الانتقالية.
8 – أنه سيتم تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب أثناء المرحلة الانتقالية.
9 – أن سوريا تحتاج إلى دستور جديد، وأنه سيكون من أهم مسؤوليات الحكم الانتقالي الإشراف على صياغة الدستور السوري بأيدي السوريين.
10 – أن الوسيلة المثلى حالياً في اعتماد الدستور الجديد هي الاستفتاء الشعبي.
11 – أن الأطراف تتطلع إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد في نهاية المرحلة الانتقالية.
12 – أنه يجب ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.
13 – أنه لن يتم التسامح مع أعمال الانتقام أو التمييز في حق الأفراد أو الجماعات، وأن جميع المواطنين السوريين متساوون ويتمتعون بالحماية الكاملة خلال المرحلة الانتقالية.
14 – أنه ينبغي كجزء من المرحلة الانتقالية، توفير التعويض والجبر والرعاية لمن تكبد بخسارة أو تعرض لإصابة.
15 – سيتم الاتفاق على ترتيبات الحكم في إطار المحادثات السورية بتيسير من الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأ التوافق.
الجدول الزمني وعملية صياغة واعتماد الدستور
– الجدول الزمني وعملية صياغة دستور جديد لسوريا تماشيا مع بيان جنيف، والقرار 2254:
لمحة عامة
– سوريا في حاجة إلى دستور جديد يضعه الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية.
– أي عملية لصياغة دستور يجب أن تندرج في سياق عملية انتقال سياسي يُتفق عليه في المحادثات السورية – السورية التي تضطلع الأمم المتحدة بتيسيرها في جنيف.
– ينبغي أن يبدأ إعداد الدستور الجديد بُعيد إنشاء حكم ذي مصداقية وشامل للجميع وغير طائفي، يشار إليه أدناه بهيئة الحكم الانتقالي.
هيئة الحكم الانتقالي
– ينبغي أن تستند هذه العملية الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي على أساس قانوني ودستوري سليم.
– الشعب السوري وحده هو من يحدد دستور سوريا المستقبلي.
– مع ذلك، تقع المسؤولية على عاتق المحادثات السورية – السورية للاتفاق على مراحل وعملية صياغة دستور جديد لسوريا.
– ينبغي أن تحدد هذه المراحل بوضوح جدولا زمنيا وعملية صياغة الدستور، بما في ذلك المؤسسات ذات الصلة وولاياتها.
– أي عملية صياغة متفق عليها في جنيف يمكن أن تسترشد ببعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالخصائص الدائمة للدولة السورية المقبلة، لكن لا يجب أن تتضمن مبادئ فوق دستورية لم يقرها الشعب السوري.
– أي عملية دستورية يجب أن تكون ملكاً للسوريين وبقيادة سوريا، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
– أي عملية دستورية يجب أن تجرى بشفافية كاملة، ومن خلال تواصل كامل وتنسيق مع عامة الجمهور.
– أي عملية دستورية يجب أن تقدم إجابات للمسائل التي يطرحها الجمهور، وهو ما يتسنى عادة عن طريق عملية قائمة على حوار وطني منفتح ومشجع على المشاركة وواسع النطاق.
– من المرجح أن تجُرى على امتداد مدة زمنية، مما يتيح فرصاً لنشر مشاريع الصياغة ومناقشتها ومراجعتها.
– المشاركون في العملية السياسية يجب أن يمثلوا كل قطاعات وشرائح المجتمع السوري.
– هذا التمثيل الواسع يجب أن يتم موازنته بفريق صياغة أصغر مؤلف من خبراء قانونين يكون مسؤولاً بصورة تامة أمام الفريق الأكبر حجماً والأوسع تمثيلاً ويعمل في إطار اتصال وثيق به.
– هيئة الحكم الانتقالي ينبغي أن تبدأ عملية صياغة الدستور فور إنشاء الهيئة وتحت إشرافها.
– ستتمثل الخطوة الأولى في قيام الهيئة فور تشكيلها بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سوري عام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل هيئة الحكم الانتقالي.
– الخطوة الثانية ستكون قيام الهيئة بتشكيل لجنة صياغة لصياغة الدستور بناء على توصية من المؤتمر الوطني فيما يتعلق بعضوية هذه اللجنة.
– تشكل الهيئة لجنة صياغة مسودة الدستور في حال لم يتم عقد المؤتمر الوطني خلال الأشهر الثلاثة المحددة على أن تعرض اللجنة وعملها على المؤتمر حين تشكيله.
– تقوم لجنة الصياغة بعد ذلك بتقديم تقارير دورية حول التقدم في عملها إلى الهيئة والمؤتمر الوطني والسلطات الأخرى ذات الصلة.
– يتم نشر عمل لجنة الصياغة أمام المجتمع السوري بأكمله، وتقرر الهيئة الشكل الذي يتم من خلاله تقديم نتائج عمل لجنة الصياغة والمؤتمر الوطني للشعب السوري.
المؤتمر الوطني
– يتألف المؤتمر الوطني من أشخاص يمثّلون مختلف شرائح المجتمع السوري، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الشخصيات الدينية والسياسية والفكرية والاقتصادية والنقابية وفق المعايير المعتمدة في الاتفاق السياسي بين الأطراف في جنيف. ويجب أيضاً أن يُمثَّل فيه سوريو المنفى والشتات.
– تكفل معايير عضوية المؤتمر الوطني أيضاً تمثيلاً مناسباً للمرأة. وينبغي تخصيص حصة تُطبّق كحد أدنى، لا تقل عن نسبة 30 في المائة ويمكن أن تتجاوزها، على أن تكون المناصفة هدفاً.
– أي شخص استبعد باتفاق الأطراف في جنيف من المشاركة في مؤسسات الحكم بسبب ضلوعه في انتهاك حقوق الشعب السوري لن يتمكّن من المشاركة في المؤتمر الوطني خلال الفترة الانتقالية وفي أي مرحلة لاحقة.
يفترض أن يتراوح عدد أعضاء المؤتمر الوطني بين 250 عضواً و300 عضو.
– يضطلع المؤتمر الوطني بدور استشاري إزاء هيئة الحكم الانتقالي ويكون مسؤولاً أمامها عن وضع إطار الحوار الوطني السوري في إطار جو عام يتسم بروح المصالحة.
ستكون المهام المحددة للمؤتمر هي:
– العمل بصفته مؤتمرا تشاوريا ومؤتمرا للمراجعة فيما يتعلق بصياغة الدستور؛
– إصدار توصية حول تشكيل لجنة صياغة؛
– إطلاق آلية لكفالة تشاور ونقاش عامين واسعي النطاق بشأن مشروع أحكام الدستور بالتعاون مع هيئة الحكم الانتقالي.
– إطلاق عملية حقيقية للمصالحة الوطنية.
– يُتفق على معايير الاختيار المحدِّدة للانضمام إلى المؤتمر الوطني في إطار المحادثات السورية – السورية، بينما يتولى الهيئة اختيار الأفراد وفقا لهذه المعايير المتفق عليها.
– يكون للمؤتمر الوطني أمانة عامة يرأسها أمين عام، ويقوم بتنسيق أعمالها رئيس ونائبين للرئيس.
– يُنتخب أعضاء لهذه المناصب في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوطني، التي سيرأسها أكبر أعضاء المؤتمر سنًّا.
– يُتخذ أي قرار بأي توصية بشأن مشروع الدستور بتأييد من ثلثي أعضاء المؤتمر الوطني.
– لن يُخوَّل المؤتمر الوطني سلطة سياسية ولن يتصرف بصفة كيان سياسي له صلاحية اتخاذ قرارات ملزمة عن طريق هيئة تنفيذية داخله.
– أي تنازع يُطرح في المؤتمر الوطني ولا يقبل الحسم بالتصويت سيحال إلى الهيئة التي تتولى تسويته.
لجنة الصياغة وعملية الصياغة
– تعين الهيئة في غضون 30 يوماً من إنشاء المؤتمر الوطني وبناء على توصية منه لجنة صياغة تتولى صياغة النسخة الأولى من الدستور.
– تضم لجنة الصياغة ما بين 30 و50 عضواً يختارهم ويعيّنهم الهيئة بناءً على توصية من المؤتمر الوطني.
سيتألف أعضاء لجنة الصياغة من خبراء ومن ممثلي شرائح الشعب السوري.
– يحق للجنة الصياغة حضور اجتماعات المؤتمر الوطني. وستقوم لجنة الصياغة برفع تقارير دورية للمؤتمر الوطني والهيئة والسلطات الأخرى ذات الصلة.
– تعد لجنة الصياغة المشروع الأول للدستور وسيقدم المشروع إلى المؤتمر الوطني وهيئة الحكم الانتقالي لاستعراضه والتعليق عليه في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل لجنة الصياغة.
– بعد ذلك، ستُراجع لجنة الصياغة المشروع استنادا إلى التعليقات الواردة في غضون فترة إضافية مدتها 15 يوماً.
– تقدّم لجنة الصياغة المشروع النهائي للدستور إلى المؤتمر الوطني وهيئة الحكم الانتقالي. وتقوم هيئة الحكم الانتقالي باعتماده وطرحه للاستفتاء
– يكون الهدف من المراحل العامة أعلاه هو كفالة تنفيذ عملية قصيرة الأجل لصياغة الدستور مدتها ستة أشهر، ليتسنى إتاحة وقت كاف لإجراء استفتاء دستوري وإجراء انتخابات في إطار الدستور الجديد وضمن أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254.
– تحدد المراحل العامة لعملية صياغة الدستور بما يراعي فترة الثمانية عشر شهراً المنصوص عليها في القرار 2254.
المبادئ الأساسية
– تُعِدّ لجنة الصياغة مشروعاً أولياً للدستور مسترشدة بالمبادئ الأساسية التي توافق عليها الأطراف في المحادثات السورية – السورية.
– تكون هذه المبادئ ذات صلة بالخصائص الدائمة لأي دولة سوريا مقبلة لكنها لن تشكل مبادئ فوق دستورية أو تتعارض مع الحق الأساسي للشعب السوري في تحديد الدستور.
النقاش العام والحوار
– يضع المؤتمر الوطني وهيئة الحكم الانتقالي برنامجَ تواصلٍ شاملا للجميع من أجل نشر مشروع الدستور وإتاحة نقاش عام بشأنه.
– توخيا لهذا الغرض؛ يمكن للمؤتمر الوطني إنشاء موقع إلكتروني بهدف تلقي تعليقات أفراد ومجموعات وجماعات من المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والجامعات، والأوساط الأكاديمية بشأن مشروع الدستور.
– إضافة إلى تهيئة أساليب تواصل محددة، إما من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الآليات لضمان مشاركة الشتات الموجود في المنفى.
– تقدّم نتائج هذا الحوار والنقاش العامين إلى لجنة الصياغة المسؤولة عن صياغة الدستور.
التصديق العام
– تعرِض هيئة الحكم الانتقالي نسخة نهائية مراجَعة من مشروع الدستور على استفتاء دستوري عام.
– تشكّل الهيئة وستعيّن لجنة انتخابية عليا لتدبير شؤون الاستفتاء وإدارته.
– يخضع الاستفتاء لإشراف الأمم المتحدة بما يكفل أعلى المعايير.
– تتولى الهيئة تحديث تسجيل الناخبين وتعديل القوانين لضمان المشاركة الشاملة لجميع السوريين الذين يحق لهم التصويت.
– تسنّ الهيئة قوانين بشأن تسجيل الأحزاب السياسية وأنشطة وسائط الإعلام والمجتمع المدني لضمان أن يُجرى الحوار والنقاش العامان بشأن مشروع الدستور والاستفتاء العام في جو من الحرية.
– تنص هذه القوانين الانتخابية صراحة على مشاركة أفراد الشتات الموجودين في المنفى واللاجئين الذين غادروا سوريا نتيجة للنزاع.
– وفقا لهذه القوانين الانتخابية المعتمدة من هيئة الحكم الانتقالي سيكون جميع المواطنين السوريين الحاملين للجنسية السورية مؤهلين للمشاركة في الاستفتاء الدستوري والانتخابات.
دور الأمم المتحدة
– تشرف الأمم المتحدة على الاستفتاء وستسهّل العملية.
– يُدعى المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة في سياق تنفيذ تدابير بناء الثقة، وإتاحة ما يلزم من الدعم الفعال لإنجاح العملية الانتقالية.
– تدعو الحاجة إلى وجود بعثة للأمم المتحدة تضطلع بدعم تنفيذ الاتفاق الذي يُتوصل إليه في محادثات في جنيف.
– تُنفَّذ نتائج الحوار الوطني بدعم تقني من الأمم المتحدة وفقا لآجال محددة من أجل بدء عهد جديد لسوريا تسوده الحرية والأمن والاستقرار والسلام.
الشرق الأوسط
هل من سبيل لمعارضةٍ علمانيةٍ في سورية؟/ راتب شعبو
لم تشكل المعارضة العلمانية في سورية تهديداً لوجود نظام الأسد في أي وقت من تاريخها النضالي، ودرب آلامها الحافل بالتعذيب (حتى الموت أحياناً)، والسجن الذي لا ينتهي، والتضييق على لقمة العيش، والحرمان من أبسط الحقوق. كان تهديد النظام يأتي دائماً من جهة إسلامية، حتى أن السياسة الأمنية للنظام تجاه معارضيه العلمانيين لا تُفهم إلا بدلالة صراعه ضد الخطر الإسلامي الممكن، والذي كان وحده ما يشكل الهاجس الأمني للنظام.
يعود بطش نظام الأسد بمعارضيه العلمانيين إلى عاملين، ليس بينهما الخوف من قدرتهم على إسقاط النظام، الأول رغبته في أن تبقى الأقليات المذهبية بعيدةً عن التأطير السياسي المعارض. يدرك النظام أن العلمانيين يتغلغلون جيداً في الأقليات المذهبية، فيما يقف الإسلام السياسي على حدودها، نظراً إلى بنيته التنظيمية والفكرية الطائفية. الغرض من قمع المعارضين العلمانيين إذن ضمان ولاء الأقليات المذهبية بتطهيرها من النزعات المعارضة، على اعتبار أن هذه الأقليات ترفض الإسلاميين بداهة، ولن تقبل بهم إلا مكرهةً، فهي تشكّل، والحال هذه، ركيزةً مضمونة للنظام، حين يواجه تحدياً إسلامياً.
قد يبدو مخالفاً لهذا القول إقدام نظام الأسد، في أوائل فبراير/ شباط 1980، مع اشتداد تهديد “الإخوان المسلمين” على النظام في حينها، على الإفراج عن المعتقلين الشيوعيين لديه دفعة واحدة، حتى من كان منهم في مرحلة التحقيق، بحركة فيها استعراضٌ، ورغبةٌ واضحة في لفت النظر. شمل ذلك الإفراج أكثر من مائة معتقل من مختلف مناطق سورية، جميعهم من رابطة العمل الشيوعي، باستثناء اثنين من الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي. لكن هذه الخطوة كانت في حقيقتها جزءاً من معركة النظام ضد الإسلاميين. فهي تنطوي على رسالة تهديدٍ بانفتاح يساري، موجهةٍ إلى الدول الخليجية الداعمة للإخوان المسلمين حينها، ورسالة إغاظة إلى إسلاميي الداخل الذين يروق لهم أن يروا العلمانيين في السجون، ولو على يد نظام يريدون إسقاطه. فضلاً عن أمله في حشد اليسار السوري مع النظام ضد “الإخوان”، وحين لم يحصل النظام على النتيجة المرجوّة من خطوته، عاد سريعاً إلى اعتقال من أفرج عنهم وملاحقتهم، ولم يكرّر هذه الخطوة لاحقاً.
العامل الثاني، توجيه رسالة ود وتطمين إلى الأنظمة الخليجية الإسلامية التي حرص نظام
“لا طريق أمام العلمانيين في سورية، وفي البلدان المشابهة، سوى البناء الصبور من الأسفل” الأسد دائماً على كسب دعمها، رسالة تقول إن النظام “عادلٌ” في قمعه، فهو يضرب اليمين واليسار، الإسلاميين والعلمانيين معاً. وفيها رسالة استرضاء للإسلاميين السوريين أيضاً، تقول إن النظام يحمي المجتمع المسلم، ولا يتساهل مع العلمانيين “المتطرّفين”.
ضاعت دائماً تضحيات المعارضين العلمانيين في الهوة القاتلة بين قمع النظام والخيار الإسلامي المتربّص. لم يحقق نضالهم أي تراكم مؤثر في سياق مسعى المجتمع السوري إلى الخروج من وهدة الاستبداد والانحطاط السياسي. وعلى الرغم من أن المطلب الديموقراطي يشكل مضمون الحركة الشعبية ضد نظام الأسد، لم يتمتع الديموقراطيون العلمانيون بأي أفضليةٍ في لحظات احتدام الصراع. كل احتدام للصراع مع النظام سوف ينقلب، كما لو بقانون، ليتخذ طابعا استقطابيا محدّدا، طرفاه النظام والإسلاميون. المفارقة السورية الثابتة: الديموقراطيون في الصفوف الخلفية من قيادة حراكٍ ديموقراطي في مضمونه، فيما تتصدّر تشكيلات إسلامية مضادّة للديموقراطية هذا الحراك.
إذا كان من السهل تفسير هذه المفارقة، فإن من العسير الخروج من أسرها. إنها مفارقة معلقة فوق رؤوس السوريين كأنها قدرٌ لا فكاك منه، ما أن ينهضوا للتغيير، وبمقدار ما يحتدم الصراع.
ماذا يمكن أن يفعل الديموقراطيون العلمانيون أمام هذه الحال؟ ما المخرج إذا كان تاريخ كامل من المعارضة الديموقراطية العلمانية لنظام الأسد يضمحل ويذوي، ويغدو بلا قيمةٍ أمام تشكيلٍ جهادي وليد؟ ما العمل إذا كانت القوة العسكرية لمثل هذا التشكيل، وما يقدّمه من مآثر قتالية ضد نظام ظالم وفاسد ومكروه، تجعل الناس معجبين، وأكثر ميلاً إلى سماع خطاب “شرعييه” ومنطقهم، من سماع خطاب ديموقراطيين علمانيين، عاجزين عن فعل شيء سوى الكلام. هذا فضلاً عن أن “الشرعيين” المسموعين يصدّون الناس عن هؤلاء العلمانيين بوصفهم كفاراً.
إذا شاء أن يحرز العلمانيون تقدماً، وأن يكون لهم تأثير وفاعلية في مجرى الصراع السياسي في سورية، عليهم التوفيق بين قدراتهم ومطالبهم، أن يدركوا أن الاستيلاء على السلطة بالعنف ليس في مقدورهم، وأن العنف سبيل مفتوح لسيطرة الإسلاميين، ولإحباط كل التطلعات العلمانية في المجتمع.
يمكن للديموقراطيين العلمانيين السوريين أن يكونوا قادة حركة تغيير سلمي متعدّدة الأشكال،
“العنف سبيل مفتوح لسيطرة الإسلاميين، ولإحباط كل التطلعات العلمانية في المجتمع” وهم وحدهم القادرون أن يخرجوا بمجتمعهم من وهدة الاستقطاب العقيم والمدمر بين النظام والإسلاميين. كان واضحاً التناسب الطردي بين مستوى الحضور العلماني السوري في الثورة ومستوى السلمية فيها. ولكيلا يكون سبيل التغيير السلمي مغلقاً بقوة القمع العاري اللامحدود الذي يواجه به النظام متحدّينه، على العلمانيين أن يركّزوا على النضال المطلبي المتدرج، وهذا يقتضي تشكيلاتٍ تنظيميةً غير حزبية، بمعنى أنها لا تتطلع إلى السلطة، وتعتبرها نقطة البداية.
ربما شكّل حراك الريف في المغرب نموذجاً للتأمل، من حيث سلميته، والحرص على حماية سلمية الحراك، بمنع أعمال التخريب في الممتلكات، ومن حيث بساطة المطالب، وابتعادها عن السياسة، وملموسيتها ومعقوليتها، مثل بناء جامعة ومستشفى متخصص، وفرص عمل للشباب. وبالطبع، من حيث المثابرة والثبات وابتكار أشكال الاحتجاج بطريقةٍ تسمح بتخفيف وطأة القمع والحد من خسائر الحراك. وقد سبق أن أبدع السوريون في هذا الباب، ولكن ليس في سياق مطلبي أو سياسي محدود، بل في سياق أقصى صراع سياسي، يمكن لنظام أن يواجهه، صراع إسقاط النظام.
لا يبدو أن أمام العلمانيين في سورية، وفي البلدان المشابهة، من طريقٍ سوى البناء الصبور من الأسفل، بعد أن أثبتت التجربة الحية في بضع السنوات الأخيرة أن مقولة “كل شيء يبدأ من السلطة السياسية”، هي باب ليس فقط للفشل والنكوص، بل وللدمار العام أيضاً.
العربي الجديد
السعودية و«المعارضات» السورية: إكراه السياسة وباطل التمثيل/ صبحي حديدي
مضى زمن شهد شيوع سردية رسمية أطلقها النظام السوري خلال الأشهر الأولى التي أعقبت انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا، آذار (مارس) 2011، مفادها أنّ الأمير السعودي بندر بن سلطان هو الذي يقف وراء «المؤامرة»؛ أي التسمية، الرسمية بدورها، التي استقرّ عليها النظام في توصيف الحراك الشعبي، الذي بدأ سلمياً تماماً، رغم لجوء النظام إلى العنف منذ تظاهرات درعا البلد. كذلك اتُهم الأمير، وعلى نحو شخصي وفردي أحياناً، بأنه يموّل أطراف تلك «المؤامرة»، خاصة بعد أن مضى النظام أبعد في ستراتيجيات التأثيم المعمم، فأطلق على الناشطين صفة «الإرهابيين». فيما بعد، عند تشكيل معارضات الخارج، وتوزّع غالبية المعارضين (عبر «المجلس الوطني» أولاً، ثمّ «الائتلاف الوطني») في ولاءات عربية وإقليمية ودولية؛ تولى معارضون أفراد (أمثال أحمد الجربا وميشيل كيلو واللواء سليم إدريس…)، تثبيت علاقة الأمير بهذه المعارضات، الإسطنبولية تحديداً كما يجوز القول، وتأكيد الكثير مما يُقال عن تحكّم المملكة العربية السعودية بإرادة «الائتلاف»، أفراداً ومؤسسة.
وفي ربيع 2014 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بإعفاء الأمير من منصبه كرئيس لـ«مجلس الأمن الوطني»، «بناءً على طلبه»، كما نصّ القرار؛ مما عنى أنّ مسؤولياته في «إدارة» تلك المعارضات قد آلت إلى جهة أخرى، تبيّن سريعاً أنها لم تعد استخباراتية صرفة، بل عُهد بها إلى وزير الخارجية عادل الجبير، ضمن متغيرات أخرى في سياسات المملكة الإقليمية، خاصة تورّط الرياض في اليمن وتشكيل تحالف «عاصفة الحزم». وعلى خلفية رغبة أمريكية في إعادة هيكلة المعارضات السورية، بعد أن ترهلت صيغة «الائتلاف» التي ولدت على أنقاض «المجلس الوطني»؛ تبنّت السعودية خيار «هيئة التفاوض»، وجمعت أطياف المعارضين (بما في ذلك الفصائل المسلحة، «الجيش الحرّ» أسوة بالجهاديين…) في مؤتمر الرياض، أواخر 2015. آنذاك، كان خطاب الجبير يسير هكذا، على سبيل الأمثلة: «بشار الأسد سيرحل عن الحكم في دمشق سواء كان عاجلاً أم آجلاً لأنه انتهى»؛ أو: «إن لم يستجب الأسد للحل السياسي، فإنه سيبعد عن طريق حل عسكري»، و»المسألة مسألة وقت»…
وكان اجتماع الرياض قد توصل إلى جملة «ثوابت»، أبرزها أنّ هدف «التسوية السياسية» هو تأسيس نظام سياسي جديد لا مكان فيه «لبشار الأسد وزمرته»؛ قوامه الالتزام بآلية الديمقراطية، والنظام التعددي الذي يمثل أطياف المجتمع السوري، الحفاظ على «مؤسسات الدولة السورية»، وضرورة «إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية». كذلك اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام (ترأسه رياض حجاب، الذي انشق عن النظام وهو في منصب رئيس الوزراء؛ وتألف من 33 عضواً، بينهم 11 عن «الفصائل الثورية»، و9 عن «الائتلاف»، و8 عن المستقلين، و5 عن «هيئة التنسيق»). كان سياقات المشهد العامّ في سوريا، يومذاك، تحكمها عناصر كبرى مثل التدخل العسكري الروسي المباشر، وتحولات الموقف الأمريكي نحو اعتماد الفصائل الكردية في الحرب ضدّ «داعش»، وتركيز الموقف التركي على قطع وتفكيك أيّ احتمال لإقامة كيان كردي على الحدود السورية ـ التركية وغرب نهر الفرات.
وقبل أيام، في أعقاب اجتماع بين الجبير وحجاب، راجت معلومات تفيد بأنّ الرياض أبلغت هيئة التفاوض أنّ الاهتمام الدولي لم يعد يشدد على رحيل الأسد في المرحلة الانتقالية، لأنّ التشديد انتقل إلى ملفّ محاربة الإرهاب؛ وبالتالي على الهيئة أن تعيد ترتيب خياراتها. وقيل كذلك إنّ الجبير تحدّث عن «إعادة هيكلة» الهيئة ذاتها، الأمر الذي قد يفسّر ـ في قليل أو كثير، لكنه غير منقطع الصلة كما يلوح ـ إعلان الهيئة عن عزمها عقد مؤتمرها الثاني، بعد الأول التأسيسي، في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل؛ تحت عنوان «اجتماع موسع مع نخبة مختارة من القامات الوطنية السورية ونشطاء الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل والقرار». وليس واضحاً، بعد، ما إذا كان هذا الاجتماع سوف يشهد انضمام ممثلي منصتَي القاهرة وموسكو، لكنّ الكثير من المؤشرات تذهب نحو هذا المآل. من جانبه كان جورج صبرا عضو هيئة التفاوض وممثل الائتلاف، قد أوضح أنّ الجبير «لم يمارس أي ضغوط، كلّ ما قاله إن ثمة متغيرات على الساحة الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالوضع السوري وإن الأولوية أصبحت للإرهاب وليس إسقاط الأسد، وعليكم أن تراعوا هذه المتغيرات»؛ موضحاً أنّ الوزير أكد على استعداد المملكة «لدعم المعارضة أيا كانت القرارات».
وبين ما راج في الأخبار، من تهمة تخلّي الرياض عن خيارات الأمس القريب بخصوص مصير الأسد؛ وما جزم به صبرا وسواه، من تبرئة ساحة الرياض وتنزيهها عن أيّ ضغط؛ ثمة ذلك الواضح المسكوت عنه من عناصر هذا التأزم، الأحدث عهداً، في حال المعارضات السورية عموماً، وهيئة التفاوض خصوصاً: 1) أنّ ما يُسمّى «المجتمع الدولي» لم يعد، بالفعل، ملتزماً بمبدأ إبعاد الأسد عن المرحلة الانتقالية (فما بالك بإسقاطه، حسب تعبير صبرا!)، وهذا واضح في تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ و2) أنّ المعارضات السورية، ذاتها، واقعة في حيص بيص، من حيث ما تبقى لها من أوراق تفاوض على الطاولة، وتمزيق بنيتها بين هيئة التفاوض ومنصة موسكو ومنصة القاهرة؛ و3) ما ينعكس على حركة هذه المعارضات من ضغوطات النزاع الخليجي ـ الخليجي الراهن، واعتماد الرياض مبدأ الانحياز القسري وقاعدة «مَنْ ليس معنا فهو ضدنا»…
ومع ذلك، وأياً كانت التبدلات التي طرأت على علاقة السعودية بالمعارضات السورية، في إسطنبول كما في الرياض؛ فإنّ الجوهر الأكبر، القديم والمتجدد، سوف يظلّ يدور حول السؤال الكبير: مَنْ نصّب هؤلاء، أينما كانوا وكانت صفاتهم ومؤسساتهم، ممثلين للشعب السوري؛ منذ جنيف 1 وحتى جنيف 7، ومنذ أستانة 1 وحتى يشاء الله؟ وهل يكفي القول، كما جاء في بيان الرياض 2015، إنّ المشاركين «ينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والأكراد والتركمان والآشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم»، لكي ينطبق الزعم على الواقع؟ أم تُفرض شرعية التمثيل، اعتباطياً وعشوائياً، لمجرد تأكيد البيان أنه «شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج»؟ أو تُختلق هذه الشرعية، كما يجري الزعم الجديد حول الاجتماع المقبل، بسبب من حضور «نخبة مختارة من القامات الوطنية السورية ونشطاء الثورة»؟
ألم تمارس السعودية، منذ أن أسلمت معارضات إسطنبول والرياض قيادها لأجهزة المملكة، طرازاً مزدوجاً من التدجين، قوامه إكراه السياسة (بمعنى فرض أجندات المملكة، الداخلية أو الإقليمية أو الدولية)؛ واستغلال باطل التمثيل (بمعنى إدراك هزال ما يمثله زيد أو عمرو في عمق الشارع الشعبي السوري، ومقادير تبعية هذا واستزلام ذاك)؟ ألم تُختبر سلوكيات تلك المعارضات، على مستوى «المجلس الوطني» ثمّ «الائتلاف الوطني» وصولاً إلى «هيئة التفاوض»؛ بحيث نشهد اليوم كسوراً وانشقاقات وتباينات حادة، حتى في إسقاط ثوابت كبرى؛ كما اعترف صبرا نفسه، مؤخراً: «لم يعد خافيا أنّ البعض بات يصرّ على بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، وحتى من داخل هيئة المفاوضات العليا هناك من يعتقد بإمكانية أن يبقى الأسد في المرحلة الانتقالية، أما المنصات الأخرى فهي لم تعد تخفي هذه المطالب»؟
إلام، إذن، هذا التمادي في خداع الشعب السوري، والغرق أكثر فأكثر في حضيض سياسة بالإكراه، وتمثيل لا ينهض إلا على باطل؟
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي
واشنطن والفصائل السورية «المعتدلة»: وقف التسليح أم فسخ العقود؟/ صبحي حديدي
لم يؤكد البيت الأبيض ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، حول إيقاف تسليح بعض «الفصائل المعتدلة» داخل المعارضة المسلحة السورية، وهو البرنامج الذي كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد اتخذه في نيسان (أبريل) 2013، وتمّ تنفيذ بعض مراحله عبر التنسيق مع الأردن وتركيا؛ قبل أن يتراخى تدريجياً، ثمّ يُجمّد عملياً، ويُطوى نهائياً.
وإذا كانت الإدارة قد امتنعت عن التعليق على هذا التطوّر، بالنظر إلى أنّ البرنامج اندرج في تصنيف «سرّي»؛ فإنّه تأكد عن طريق غير مباشر: عضو الكونغرس عن الديمقراطيين تولسي غابارد، نصيرة النظام السوري، رحبّت به؛ مقابل استنكار السناتور جون ماكين، وزميله ليندسي غراهام، عن الجمهوريين؛ فضلاً عن انكشافه على الأرض، في سوريا، لدى الفصائل المعنية ذاتها.
وثمة دلالة، ابتداءً، في العودة إلى «فلسفة» هذا القرار، التأسيسية إذا جاز القول، من وجهة نظر البنتاغون والمخابرات المركزية، في ما يخصّ الواقع السوري أولاً؛ قبل مناقشة الحيثيات الأقدم التي اكتنفت قرارات إدارات سابقة بتسليح فصائل عسكرية في أماكن أخرى من العالم. واستناداً إلى معلومات مارك مازيتي، في «نيويورك تايمز»، 14/10/2014، كانت نقاشات حامية قد نشبت داخل إدارة أوباما حول مسألة تسليح المعارضة العسكرية «المعتدلة»؛ بين رافضين للخطوة أو مشككين في جدواها (كانوا أقلية، ولكن كان الرئيس في عدادهم)؛ ومتحمسين لها، دون الارتقاء بها إلى مستوى «استراتيجية مخرج» تنتهي إلى إسقاط نظام بشار الأسد. ذلك دعا أوباما إلى تكليف المخابرات المركزية بإعداد «مراجعة» لتجارب التسليح السابقة، في جغرافيات أخرى، والإجابة على السؤال الحاسم: هل نجحت، إجمالاً؛ وهل ستنجح في سوريا، بصفة خاصة؟
المعطيات اللاحقة، التي جاءت في مقالات أو مؤلفات بعض ممثلي الإدارة يومذاك (هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية، وليون بانيتا وزير الدفاع، ودافيد بترايوس مدير المخابرات المركزية، مثلاً)؛ أكدت أنّ «المراجعة» خدمت المشككين. ومع ذلك فإنّ المشكك الأبرز، أوباما نفسه، أعطى الإذن ببدء برنامج تسليح عبر قاعدة عسكرية في الأردن، وبرنامج ثانٍ في المملكة العربية السعودية لتدريب 5000 مسلّح سنوياً على قتال «داعش».
ورغم أنّ «فلسفة» التسليح كانت تنطلق من تمكين الفصائل «المعتدلة» من قتال النظام السوري، إلا أنّ نقلة كبرى طرأت على هذا التوجه، إذْ انقلب نحو توجيه تلك الفصائل إلى قتال «داعش» فقط.
وليست خافية تلك الوقائع اللاحقة ـ العجيبة، المتناقضة، السوريالية أو تكاد! ـ التي جعلت بعض الفصائل تحجم عن قتال «داعش»، ليس لأنها لا تبغض التنظيم، إذْ كانت بالفعل تعاديه وتناهضه؛ بل لأنّ خيارها الأول هو قتال النظام، خاصة في المواقع التي كانت تتطلب الدفاع عن نقاط ارتكاز هامة أو استراتيجية. كذلك كان تخبط الترتيبات الأمريكية، وتباينها إلى درجة التعارض أحياناً، قد أسفر عن مواجهات مسلحة بين فصائل «معتدلة» يدعمها البنتاغون («قوات سوريا الديمقراطية»)، وأخرى تدعمها المخابرات المركزية (كتيبة «فرسان الحق»).
تلك المشاهد كانت مظهر السطح فقط، لأنّ الأعماق كانت تحتوي مشكلات أكثر تعقيداً من مجرّد السجال حول تنفيذ برامج التسليح والتدريب أو إيقافها؛ وكانت تتصل بعجز الأجهزة السياسية للمعارضة السورية، خاصة حين تبدأ عناصر الخلل من خيارات أمريكية في ذاتها (مثل رغبة هيلاري كلنتون في تجاوز صيغة «المجلس الوطني» إلى صيغة «الائتلاف الوطني»)، ثمّ تتمدد إلى تشتت ولاءات أطراف المعارضة بين قوّة إقليمية وأخرى، ولا تنتهي بالطبع عند المعضلات الذاتية للقوى والأطراف المهيمنة على تلك الأجهزة.
وهكذا، على نحو متعاقب أقرب إلى سيرورة تطور منطقية، بدا وكأنّ تجميد التسليح أو التدريب، بعد منحه بالقطارة كما يُقال، قد انقلب إلى ما يشبه فسخ العقد الأمريكي مع الفصائل العسكرية «المعتدلة»؛ خاصة حين اهترأت تدريجياً «عقيدة أوباما» في عدم التدخل المباشر، مع تشكيل التحالف الدولي ضدّ «داعش»، ثمّ انزلاق واشنطن إلى شكل بعد آخر من التدخل العسكري المباشر في سوريا. وكان طبيعياً، استطراداً، أن يُدرج البرنامج في إطار الخيارات اللاحقة لإدارة أوباما، في المنطقة عموماً (إيران، تركيا، أفغانستان…)، وفي العراق وسوريا بصفة خاصة.
ومع تحوّل نظرية «الخطّ الأحمر»، بصدد استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب النظام، إلى خطّ مجازي وشبه وهمي؛ ثمّ انتقال المساندة الروسية للنظام إلى انحياز عسكري شامل، واسع النطاق وأشبه بالانتداب؛ توجب على إدارة أوباما أن تعود إلى إعلاء كلمة المشككين في البرنامج، وطيّه مؤقتاً، تمهيداً لساعة مواتية تعلن دفنه نهائياً. وهنا، للإنصاف فقط، يصحّ القول إنّ إدارة دونالد ترامب لم تفعل ما يزيد على دقّ مسمار أخير في نعش هذا البرنامج، فهي لم تكن مهندسة إطلاقه، وبالتالي ليست أوّل حفّاري قبره.
وأمّا ما يخصّ التاريخ الأبعد لهذا البرنامج، فإنّ الحصيلة ليست هزيلة وفقيرة ومحدودة الإنجاز، فحسب؛ بل هي فاشلة غالباً، وكارثية أحياناً، حتى في أكثر أمثلتها إيحاءً بالنجاح. ولعلّ «الصناعة الجهادية» في أفغانستان، التي بدا أنها تكللت بالنجاح حين أجبرت الاتحاد السوفييتي على مغادرة البلد، هي المثال الساطع على «نجاح» انتهى إلى كارثة؛ لأنه جلب منظمة «القاعدة» وأسامة بن لادن، ثمّ الزرقاوي في العراق، فـ»النصرة» في سوريا، وصولاً إلى «داعش» شرقاً وغرباً. مثال الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان، في ضخّ أسلحة وذخائر بملايين الدولارات إلى اليونان لوأد الانتفاضات الشعبية هناك، كان يوازي هزيمة الوكالة في خليج الخنازير ضدّ كوبا وفديل كاسترو. وتبقى «إيران ـ غيت» نموذجاً فريداً على إمكانية التعاون بين واشنطن و»خصم» مثل إيران، ظلّ يبدو لدوداً حتى أُميط اللثام وافتُضحت قبائح الصفقة.
ويبقى أنّ الأساس الأكبر، ليس خلف تعثر برنامج التسليح والتدريب وحده، بل بصدد السياسة الأمريكية تجاه الانتفاضة الشعبية السورية عموماً؛ هو أنّ واشنطن، وكيفما تقلبت تقديراتها أو تبدلت، لم تستقرّ في أيّ يوم على خيار تغيير النظام، أو اعتناق مبدأ إسقاطه، أياً كانت الوسيلة. ذلك لأنّ الاستقرار على توجّه مثل هذا كان سيُلزمها بالمشاركة المباشرة في صناعته، عبر سلسلة عمليات سياسية واقتصادية وعسكرية ودبلوماسية واستخباراتية. وتلك «سلّة» إجراءات يندر أن تلجأ إليها أية إدارة أمريكية في عوالم ما بعد الحرب الباردة، فكيف بإدارة تعلن «عقيدة أوباما» ناظماً لسلوكها الدولي. كذلك، وعلى صعيد آخر أقلّ أهمية، توجّب أن تعثر الإدارة على حلفاء داخل المعارضة السورية الرسمية، يمكن الاعتماد عليهم فعلياً؛ ليسوا من صنف المعارضة العراقية التي اكتوت إدارات سابقة بنيرانها، ولكن ليسوا أيضاً مجموعة «مزارعين وأطباء أسنان لم يسبق أن حاربوا»، كما صنّفهم أوباما!
والحال أنّ الميزان العسكري الراهن، في ضوء التدخل الروسي الواسع، وتدخلات الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي «حزب الله» والميليشيات المذهبية، وما تبقى من جيش النظام؛ في مقابل مشاركة الولايات المتحدة في معركة مدينة الرقة، واقتصار البنتاغون والمخابرات المركزية على مساندة وتسليح «قوات سوريا الديمقراطية»؛ وكذلك، سياسياً ولكن عسكرياً أيضاً، هوس الغرب بمفهوم أقرب إلى شعار «داعش أولاً»؛ فضلاً، بالطبع، عن تناطح الفصائل العسكرية «المعتدلة» بين بعضها البعض، أو شللها إزاء تناحر الجهاديين الإسلاميين، «النصرة» و»أحرار الشام» بصفة خاصة… كلّ هذه العناصر، وسواها، تحيل برامج تسليح وتدريب «المعتدلين» إلى رفوف الغبار وأدراج الصدأ.
وحَسُنتْ مستقراً، أغلب الظنّ!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي
الفصائل السورية والمخابرات الأميركية/ بشير البكر
تداولت وسائل الإعلام، في الأسبوعين الأخيرين، خبر طلب الولايات المتحدة من بعض فصائل المعارضة السورية في الجنوب السوري إعادة الأسلحة التي قدمتها لها في الفترة الماضية، كما اشترطت عدم توجيهها إلى النظام، بل حصرياً ضد “داعش”.
لم يشكل القرار مفاجأة كبيرة، لأن الجبهة الجنوبية التي تشكل قوة قتالية كبيرة كانت معطلة منذ أكثر من عامين، قبل معركة درعا الأخيرة التي تكبّد النظام فيها خسائر كبيرة، ولم يحقق أهدافه. وجرى تجميد تلك الجبهة بقرار من الأطراف الممولة والمسؤولة عن التسليح. والمعروف أن ثلاث دول عربية كانت تتولى التمويل، السعودية والإمارات وقطر، في حين تتكفل أميركا بالتسليح، في وقت لم تكن فيه الهيئات التي تقدم نفسها ممثلة للثورة السورية، سواء المجلس الوطني أو الائتلاف الوطني، على علاقة أو حتى علم بالتفاصيل، وحسب الدكتور برهان غليون، رئيس أول مجلس وطني للمعارضة السورية، “كان التمويل يقدم مباشرة من غرفتي الموم في تركيا والموك في الاْردن، وكلاهما تحت إشراف الأميركيين”، وهل كانت هناك معونات خارج هذا الإطار؟ يجيب غليون “محتمل. لكن أنا شخصياً لا أملك أي معلومات دقيقة عنها، ولم يكن هناك من يمكن أن يعرف تفاصيلها سوى المعتمدين من الدول مباشرة من العسكريين”.
جرى دائماً رمي مسؤولية تعطيل الجبهة الجنوبية على الأردن. وفي إحدى المرات، ذهب رئيس “الائتلاف” الأسبق، خالد خوجة، إلى عمّان ليلتقي بالقيادات العسكرية المسؤولة عن الجنوب، فلم تسمح له الأجهزة الأردنية. وقد يتحمل الأردن قسطاً من المسؤولية، ولكن من التجني رمي كل الحمل على ظهره، لاسيما وأن سياسة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لم تطرح في أي يوم مسألة إسقاط النظام السوري عسكرياً، وهي صاحبة مشروع قتال “داعش” حصرياً، ولم تأتِ أجهزة الإدارة الجديدة بما يخالف خط الإدارة السابقة.
بات واضحاً اليوم أنه ليس هناك أولوية تتقدّم لدى واشنطن على هزيمة تنظيمي داعش والقاعدة، الأمر الذي يهدّد بإضعاف كل القوى العسكرية السورية التي لا تزال تواجه النظام، وهذا سيقوّي من “داعش” وجبهة النصرة والمليشيات الطائفية الإيرانية وحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي).
ما يستحق الوقفة الطويلة هنا هو حصاد أخطاء الأعوام الماضية على الشعب السوري الذي دفع ثمن خروجه ضد النظام مرتين. الأولى من النظام الذي لم يترك سلاحاً من أجل قتل هذا الشعب وتهجيره. والثانية رهان الفصائل العسكرية والهيئات السياسية التي تنطّعت لتمثيل السوريين، على الولايات المتحدة التي تخلت عن مسؤوليتها الدولية والأخلاقية لإغاثة شعبٍ تعرّض للإبادة ستة أعوام، خصوصاً بعد مجزرة الغوطة الكيميائية قبل أربعة أعوام.
مؤكّدٌ أنه لم تكن أمام السوريين خيارات في معركة بدأت أكبر منهم، ولكن كان لديهم استعداد للالتحاق بأجندات خارجية، وجدوا أنفسهم يلعبون أدواراً فيها، وهذا ما يفسّر جانباً من المآلات المأساوية العسكرية والسياسية، والأدهى من ذلك، وعلى الرغم من المأساة التي حلت بالبلد وأهله، لم يقم أحد بالمراجعة، وترك الجميع السفينة تلعب بها الأمواج، وكأنهم تواطأوا مع الأعداء لتركها للمصير المأساوي. ولا ينسى المرء هنا الذين دخلوا إلى الثورة، وهم لديهم أهداف خاصة، فعدد هؤلاء ليس قليلاً، ووصل بعضهم إلى مراتب متقدّمة، ومنهم من بات أمير حرب جمع ثروات طائلة من المتاجرة بشقاء السوريين وآلامهم. وشكل بعض آخر جيوشاً لعبت دوراً سلبياً لمنع قيام أي حالة ثورية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، ومثال ذلك الفصائل الإسلامية التي احتلت المشهد منذ عام 2013، وتعتبر مسؤولة عن القسط الأساسي من التدهور، بدءاً بمعركة القصير وحتى الوضع الراهن في محافظة إدلب التي تعمل “النصرة” على تحويلها إمارة لتنظيم القاعدة.
العربي الجديد
الحرب على الإرهاب وهيئة التفاوض السورية/ عمار ديوب
المدخل الأميركي والروسي للحل السياسي في سورية هو الحرب على الإرهاب. هذا ما يتحقق حينما يقال إن المرحلة الانتقالية ستكون تحت قيادة الرئيس بشار الأسد. أي أن كل الانتقادات السابقة للنظام السوري، ومنذ العام 2011، كانت بقصدٍ وحيد، وهو الهيمنة على الثورة وتطويعها، وجعلها مجزرةً حقيقيّة لثوارها ولحاضنتهم الشعبية، وبما يدفع قياداتها إلى الالتحاق بأميركا أو روسيا أو بلدان إقليمية متعدّدة.
دار نقاش تناول الهيئة العليا للتفاوض أخيرا، وأن وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، قال لهم: الأسد باقٍ وعليكم التفاهم مع منصتي القاهرة وموسكو، وأن كل الأمر بيد روسيا؛ ربما لم يقل هذا الكلام بهذا الوضوح، وربما قاله، وقد تكون لديه نيات معاكسة له، ولكن ما هو أكيد أن الرياض طالبت الهيئة بالتوسعة، وبضم المنصّتين المذكورتين، واللتين تؤكدان أولويّة الحرب على الإرهاب، وتأجيل مصير الأسد، بل وحقه الطبيعي بالترشح للرئاسة، كونه مواطناً سورياً حالما تنتهي المرحلة الانتقالية بقيادته. يتفق هذا الدور السعودي مع الرؤية الأميركية والروسية، وبوضوحٍ أكبر هو دورٌ قديمٌ، ومنذ أن وافقت السعودية والدول الإقليمية على عدم إيصال مضادّات الطيران للفصائل الحرّة، وبالتالي النظام باقٍ، والمعركة محدّدة بأنّها ضد الإرهاب، وعلى المعارضة أن تكون شريكةً في الحرب “المقدسة” هذه.
بدأ موقع هيئة التفاوض التي رفعت السقف عالياً، باعتمادها على نتائج جنيف1 بالتحديد، وبقية القرارات الدولية المُلزمة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، يتغير مع مسار أستانة ثم مسار عمّان، والنقاش يشمل كذلك منصة القاهرة، وبالتالي، فهي مطالبة بالخضوع الكامل، وإلا فإن مسار المفاوضات سيتقدم بدونها، كما صُرّح مراراً وتكراراً، وما سُرّب عن الجبير يصب في هذه الساقية.
يبدو أن المسألة السورية في طور النهاية، ووفق تقاسمٍ روسي أميركي لها. وهنا ليس من
“أميركا سبب إطالة الحرب في سورية واستنزافها وكانت تعمل على إضعاف تركيا وإيران” الصحيح القول إن الأمر كله بيد روسيا، وإن أميركا لم تكن شريكاً ولن تكون. لا.. أميركا هي السبب بإطالة الحرب في سورية واستنزافها بالكامل، وكانت تعمل كذلك على إضعاف كل من تركيا وايران ومليشيات الأخيرة، ويشكل كذلك دعمها حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) مؤشراً واضحاً على تخريبٍ متعمّدٍ لسورية، وهذا كموقف يصنّف ضد النظام والمعارضة معاً، ومن أجل تخريب البنية الاجتماعية السورية، وتعزيز الانقسامات الماهوية فيها، وفقاً لصراع القوميات والطوائف والمناطق.
القواعد العسكرية الأميركية ودعم الحزب الكردي ومجموعات سورية عربية صغيرة هنا وهناك، والإشراف على اتفاق الجنوب، ومحاولة الهيمنة على كل القرارات المتعلقة بسورية بالشراكة مع الروس، وذلك كله يقول إنه كانت لدى الأميركان، ومنذ بداية الثورة، استراتيجيتهم، والمتمثلة في تخريب الثورة وتدمير سورية وإنقاذ النظام؛ وهذا ينسجم مع سياسات أوباما وترامب، وليس فقط الأوّل كما يُشاع.
عملية تحويل الثورة إلى حربٍ بين جهاديين، وتهميش كل ما هو وطني في هذه الثورة، هو الذي مَكّنَ روسيا وأميركا من التحكّم الكامل بالشأن السوري، والتدخل باسم الإرهاب والحرب المستمرة عليه. وبذلك أكلموا تدمير المدن السورية، وتهجير السوريين، والحلقة الأخيرة ستكون إكمال تدمير كل من الرقة ودير الزور، وربما إدلب.
تشتت الفصائل الوطنية، وتشوّش وعي قطاعٍ كبيرٍ منها بالأسلمة وأساطير الصراعات الدينية، وتوسّع حضور السلفية والجهادية، هو ما يدعم فكرة الغرب، ومعه روسيا، بأن لا بديل عن النظام في سورية. عدا عن تورّط المعارضة السورية بمواقف خاطئةٍ جملة وتفصيلاً، وبدءاً بقبول “الإخوان المسلمين”، ومن دون اشتراطاتٍ تؤكد دعمهم مشروعا وطنيّا لكل السوريين. وثانياً تقبلهم جبهة النصرة كونها “ضد” النظام. وثالثاً غياب الرؤية لبناء مشروع وطني، وضرورة وجود قيادة موحدة، وتقود كل الأعمال المتعلقة بالخارج. ساهمت هذه العناصر بتهميش المعارضة ذاتها، وتوسع الحركات السلفية والجهادية. وبالتالي، لم يعد هناك بديلٌ للنظام في الحرب على الإرهاب، وفي دولة مدنيةٍ وفي حماية أمن إسرائيل.
إذا صحّ أن الحرب اقتربت من وضع أوزارها، وأن هناك مرحلة انتقالية مقبلة، فيصبح خيار
“هناك بالأصل فئات كثيرة من المعارضة، رافضة كل المسارات السابقة، ولهيئة التفاوض ذاتها” هيئة التفاوض أساسياً، ولكن ليس من المسموح فيه التلكؤ كثيراً، وطبعاً عليها قبول معارضي المنصات! وبالتالي، هناك قطاعاتٌ من المعارضة ستنفذ ما يُطلب منها بالتأكيد، وستصمت عن كل الكوارث التي سببتها مسارات أستانة وعمّان والقاهرة، وعن كل التباطؤ المتواصل في تطبيق هذه المسارات، والذي يتسبب بدمار وبقتل مستمر، ولا سيما في الغوطة وإدلب، وقبلهما في درعا وحمص.
مطلوبٌ من المعارضة إعادة تشكيل نفسها مجدّداً، ووفقاً للمشيئة الأميركية الروسية، والتي تأتيها مباشرة، أو عبر السعودية أو تركيا وسواها. لن تكون النهاية المحدّدة للوضع السوري لصالح الشعب السوري، ولا لصالح أهداف ثورته، ولا حتى لصالح الموالين الذين ضحّوا بالغالي والثمين لإنقاذ النظام من السقوط.
خيارات المعارضة في غاية المحدودية، وهذا يعني أنها ستنقسم بالتأكيد، وسيَرفضُ كثيرون منها الاستمرار بالعمل، وستظهر مبادراتٌ كثيرة في هذه المرحلة. وهناك بالأصل فئات كثيرة من المعارضة، رافضة كل المسارات السابقة، ولهيئة التفاوض ذاتها. مشكلتنا الكبرى في رفض قراءة الواقع، والمساهمة في إيصاله إلى تأزمه الحالي الكبير بين احتلالاتٍ وجهادياتٍ وتدخلٍ إقليميٍّ واسع وسلفياتٍ ووعي طائفي ماهوي واجتثاثي. هذه الوضعية الكارثية تنتج باستمرار أشكالاً جديدة من الحركات السياسية والثورية، ولو صحّ أن الحرب ستنتهي، وستكون هناك تغيرات أولية في شكل الحكم وضبط الجيش والأمن، أقول لو صح، فهذا سينقل سورية إلى مرحلة الصراع السياسي، وهذا لعمري أهم ما سعى إليه السوريون ليس في الأعوام السبعة السابقة، بل ومنذ تشكيل الدولة السورية، وليس فقط منذ 1963 كما يُكرس.
ربما ستكون فرصة للسوريين بالعودة إلى المطالبة بحقوقهم، وربما ستكون الفرصة متاحةً بشكل أكبر، لتشكيل معارضة فاعلة ووطنية بامتياز، وتمثيل مناطق سورية بأكملها، والابتعاد عن الصراعات الجانبية التي دُفعت سورية إليها، أي البدء بتشكيلِ هوية وطنيةٍ سورية، ومنفتحة على العالم، وتستوعب بداخلها كل الهويات القومية السورية، والمتأزمة بشكل كبير في اللحظة الراهنة.
العربي الجديد
المعارضة السورية بين مؤتمري الرياض/ حسين عبد العزيز
لم يأتِ مؤتمر الرياض الأول للمعارضة السورية، في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015، تتويجاً لنهوض سياسي لدى هذه المعارضة وداعميها الإقليميين، بقدر ما كان محاولةً لتشكيل كتلة سياسية موحدة ومتماسكة، من أجل الحد من الانحدار الذي أصاب المعارضة العسكرية عقب التدخل الروسي في 30 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، والحد من الانحدار الذي ضرب المعارضة السياسية عقب تفاهمات “فيينا 1″ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول و”فيينا 2” في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، ومن ثم القرار الدولي الذي شكل تراجعاً واضحاً عن بيان “جنيف 1” الداعي إلى تشكيل هيئة حكم ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
اليوم وبعد مرور نحو عامين على مؤتمر “الرياض 1” يجري التحضير لعقد مؤتمر “الرياض 2″، ولأسباب انعقاد المؤتمر الأول نفسها، يحاول المؤتمر المرتقب الحد من الانحدار الحاصل في صفوف المعارضة، بشقيها العسكري والسياسي، عبر توسيع مروحة الهيئة العليا للمفاوضات يما يتلاءم مع التغيرات العسكرية على الأرض والتطورات السياسية الدولية المعنية بالشأن السوري.
الفرق بين المؤتمرين كبير جداً، فقد كان الأول بمثابة الجبهة السياسية المتمرّدة على المتغيرات العسكرية ـ السياسية الحاصلة. ولذلك، جاء خطابه السياسي آنذاك متشدّداً، لجهة طبيعة المرحلة الانتقالية ومصير الأسد أولاً، ولجهة إدخال منصتي القاهرة وموسكو في الهيئة العليا للمفاوضات ثانياً، ولجهة اعتبار “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” ضمن المنظمات الإرهابية ثالثاً.
باختصار، كان هدف مؤتمر الرياض الأول الاتفاق على مرجعية سياسية ـ عسكرية للحل في
“مؤتمر الرياض الثاني الذي يجري الترتيب له أقرب إلى الواقعية السياسية منه إلى الدوغماتية السياسية” سورية، تعكس مطالب المعارضة الفاعلة، بشقيها السياسي والعسكري، بحيث تكون هذه المرجعية الأساس المتين للحل في مواجهة الصيغة الرخوة التي خرج بها اجتماعا فيينا الأول والثاني.
أما مؤتمر الرياض الثاني الذي يجري الترتيب له، فهو أقرب إلى الواقعية السياسية منه إلى الدوغماتية السياسية، وهذا التغير جاء بعيد انزياحاتٍ تركيةٍ تجسّدت بسلوكها مسلكاً سياسياً وفق إطار فن الممكن، والنظر إلى السياسة من باب الربح والخسارة. كما يأتي المؤتمر بعيد تفاهمات روسية ـ أميركية شكلت عباءة سياسية على الأطراف الإقليمية الفاعلة من الطرفين للانضواء تحتها. وعليه يمكن القول إن المؤتمر المنتظر بمثابة التحول الذي يهدف إلى المحافظة على المكتسبات السياسية، وتطويعها بما ينسجم مع التفاهمات الدولية، إذ سيعني رفض السعودية الاستجابة للمتغيرات الحاصلة سحب بساط المعارضة من أيديها، وهو أمر ستكون له تكلفة سياسية كبيرة للمملكة في الملف السوري. لكن الرياض وأنقرة لا تريدان في المقابل الاستسلام للمطالب الروسية، ومن ثم الأميركية بشكل مطلق، وهذا ما بدا واضحاً في عملية الاتفاق على عقد المؤتمر الذي يبدو أنه يتم عبر تفاهم سعودي ـ تركي بالدرجة الأولى، فقد رفضت منصتا القاهرة وموسكو عقد الاجتماع في الرياض، ما يعني أن التحضير للمؤتمر لم يتم بتفاهم إقليمي ـ دولي.
الغاية السعودية من المؤتمر إبعاد أطراف محلية محسوبة على أطراف إقليمية من الهيئة العليا للمفاوضات، لإدخال أطراف محلية مدعومة من أطراف إقليمية ودولية أخرى، تكون منسجمة مع مطالب الهيئة العليا للمفاوضات. هنا العقدة، ذلك أن إدخال منصّتي القاهرة وموسكو في الهيئة سيعني، بالضرورة، حدوث انزياحات سياسية لا تريدها السعودية، فيما يتعلق بشكل المرحلة الانتقالية ومضمونها ومصير الأسد، وعدم إجراء تعديلاتٍ سياسية في خطاب الهيئة سيدفع المنصّتين إلى عدم المشاركة في المؤتمر. وبالتالي، سحب الاعتراف الدولي بالهيئة، وهو ما لا تريد الرياض الوصول إليه.
الخلاف كبير بين الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو، ففي حين تتمسّك الأولى
“السعودية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من القبول بإجراء انزياحاتٍ سياسيةٍ” بمخرجات “جنيف 1” المتعلقة بهيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، ولا وجود للأسد في المرحلة الانتقالية. تجاوزت منصتا القاهرة وموسكو القضيتين، فهيئة حكم مطلقةٍ لم تعد تنسجم مع الواقع الحالي للأزمة السورية، وإبعاد الأسد من المرحلة الانتقالية تم تجاوزه دولياً.
حتى داخل الهيئة العليا للمفاوضات توجد خلافات حول هذه المسائل، وإن كانت المرحلة السابقة لم تبرز هذا التباين، بسبب هيمنة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على الهيئة، فهيئة التنسيق، ومستقلون كثيرون داخل الهيئة، هم أقرب إلى طرح منصّتي القاهرة وموسكو.
وربما تكون دعوة أنقرة إلى إجراء اجتماع لأعضاء “الائتلاف” تحركاً تركياً مكملاً للتحرّك السعودي، ضمن إطار إقناع “الائتلاف” بضرورة تعديل خطابه السياسي.
تبدو السعودية ضد أي انزياح سياسي في خطاب الهيئة، وهو ما عبر عنه بيان الحكومة السعودية الذي قال إن الحل في سورية يقوم على مبادئ إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ولكن، في المضمون يبدو أن السعودية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من القبول بإجراء انزياحاتٍ سياسيةٍ أصبحت بمثابة التابوهات الدولية غير المسموح لأطراف إقليمية بمواجهتها.
العربي الجديد
ترابط المصير بين محافظتي إدلب ودير الزور/ حسين عبدالعزيز
قبل أشهر قليلة، نشر الجيش التركي قواته عند الحدود السورية في محيط محافظة إدلب عبر ثلاث نقاط، في خطوة فسرت آنذاك باستعداد تركي لشن هجوم على المحافظة وإعادة ترتيبها ضمن تفاهمات مع روسيا والولايات المتحدة.
لكن، فجأة لم نعد نسمع أية أخبار عن هذا الانتشار العسكري، لينتهي الأمر بعد فترة بانقلاب نفذته «هيئة تحرير الشام» على حركة «أحرار الشام»، انتهى بطرد الأخيرة – حليفة تركيا – من المحافظة وتجريدها من المعابر الحدودية التي كانت تسيطر عليها.
الأمر ذاته حصل في الشرق السوري: الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في قاعدة التنف، ثم تتقدم خطوة إلى الأمام بإقامة قاعدة الزكف إلى الشمال، ترافقت مع عمليات إنزال جوي في البوكمال، وتحركات لفصائل «الجيش الحر» قرب الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، في خطوة فسرت آنذاك على أنها استعداد أميركي للهجوم على المحافظة من الجهة الجنوبية الشرقية.
لكن فجأة يتوقف الزخم الأميركي، وتتوقف العمليات العسكرية نحو دير الزور، في وقت شهدت فصائل «الجيش الحر» تراجعاً في مواقعها، وأصبحت محاصرة في جيوب صحراوية ضيقة من جانب النظام السوري، ثم لم يمض وقت طويل حتى شهدنا قوات النظام تتقدم بثبات جنوب الرقة لتقتحم الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور.
ما الذي حصل وأدى إلى هذه المتغيرات المفاجئة؟
سؤال تبدو الإجابة عنه صعبة، في ظل عدم جلاء المشهد العسكري تماماً في الشرق السوري وفي الشمال الغربي من سورية. لكن المعطيات الحالية تمنحنا قدرة على التفسير والتكهن الجزئي بأسباب هذا التغيير ومسار التطورات العسكرية وأبعادها الاستراتيجية.
هذه المتغيرات المفاجئة بدأت بعيد إعلان الاتفاق على هدنة الجنوب بين الرئيسين الروسي والأميركي، في مؤشر الى أن الزعيمين قد حددا الحصص الجغرافية لكل محور، وأهمهما محافظتا ديرالزور وإدلب.
بالنسبة الى دير الزور يمكن القول إنها تمثل درة التاج للنظام في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من سورية، لما تحويه من ثروات نفطية وزراعية وحيوانية، خصوصاً أن المحافظتين اللتين تتشابهان مع دير الزور من حيث الثروات هما بيد «قوات سورية الديموقراطية» (الحسكة والرقة).
وإذا أضفنا إلى ذلك موقع محافظة دير الزور على الحدود مع العراق، يصبح من المستحيل بالنسبة الى النظام وروسيا وإيران الاستغناء عنها، وتحركات قوات النظام في الصحراء الشرقية خلال الشهرين الماضيين على رغم الضربات الأميركية تؤكد أن محافظة دير الزور خط أحمر، وتم إبلاغ هذا الأمر للرئيس ترامب.
ويمكن تلمس ذلك من خلال الانتشار العسكري لقوات النظام في محيط المحافظة ضمن محاور جغرافية متعددة (ريف الرقة الجنوبي الشرقي، محور ريف حمص الشرقي، محور ريف حمص الجنوبي).
ومع ذلك، ثمة سلوك أميركي غامض وغير معروف الأبعاد، فالولايات المتحدة طلبت من «مغاوير الثورة» الانتقال إلى قاعدة الشدادي في الحسكة للمشاركة في الهجوم على تنظيم «الدولة الإسلامية» من الجهة الشمالية لدير الزور، في وقت لا يزال التحالف الدولي يشن هجمات جوية على مدينة البوكمال، وكأن واشنطن تريد موطئ قدم في المحافظة وتحديداً عند الحدود مع العراق.
من المنظور العسكري، لن تكون لقاعدتي التنف والزكف الأميركيتين أية قيمة استراتيجية بمعزل عن البوكمال، لكن الوصول إلى البوكمال يبدو صعباً في ظل الحاجز الجغرافي الذي أقامه النظام بين المدينة وقاعدة الزكف.
ولذلك، تبدو الصورة غامضة، وأغلب الظن أنها مرتبطة بمصير محافظة إدلب، فإما أن يفتح النظام بالاتفاق مع الروس جيباً جغرافياً لمرور الفصائل المدعومة أميركياً نحو البوكمال، وإما أن تنسحب الولايات المتحدة نهائياً من الشرق السوري، وتنقل قاعدة التنف إلى العراق، وهو ما كشفه قائد «مغاوير الثورة» وقائد «أسود الشرقية» قبل نحو شهرين.
هذا الغموض في الشرق يمكن تعميمه على محافظة إدلب، فالنظام يستعجل الدخول إليها، لكنه يصطدم بفيتو روسي لاعتبارات كثيرة، أهمها أن الجيش السوري غير مؤهل لدخول المحافظة، وثانياً لأن موسكو لا تريد أن تشارك قوى محسوبة على إيران في العملية كي لا تثير حساسيات طائفية داخلية وإقليمية، ولأن روسيا ثالثاً لا تريد إعطاء النظام مكاسب جغرافية هائلة قبيل الاتفاق على مستقبل الهدنات العسكرية والمسار السياسي.
في المقابل، لا يزال الارتباك سيد الموقف التركي، وقد عبر عن ذلك قادة في حركة «أحرار الشام» من حلفاء تركيا، وهذا الارتباك ناجم عن عدم حصول تفاهم مع موسكو وواشنطن حيال محافظة ادلب، لأن واشنطن وإلى حد ما روسيا لا تريدان توسيع الرقعة الجغرافية التركية في سورية، ومن جهة ثانية لا وجود لبديل عن تركيا في تحديد مصير المحافظة.
وعليه، يمكن القول إن مصير محافظة إدلب يرتبط بمصير دير الزور والعكس صحيح، على رغم التباعد الجغرافي بينهما، لكن التأثير الاستراتيجي لهاتين المحافظتين في مستوى الإقليم يجعل مصيرهما متشابكاً.
* إعلامي وكاتب سوري
الحياة
مأزق هيئة التفاوض السورية المعارضة/ سميرة المسالمة
أثارت تصريحات عضو وفد المعارضة السورية في التفاوض مع النظام، خالد المحاميد، غضب الهيئة العليا للمفاوضات الذي عبّرت عنه بقرارها إلغاء عضويته من وفدها التفاوضي، لاعتباره “أن الحرب بين المعارضة والنظام وضعت أوزارها”، على الرغم من أن تصريحاته تأتي في سياق الاتفاقات فوق التفاوضية التي تفرضها كل من روسيا والإدارة الأميركية على الصراع السوري، والتي تغيّر، في كل مرة، مسارات الصراع، ووجهاته ومساحاته، وفق ما يخدم الصراع على سورية، وتقاسم النفوذ داخل أراضيها بين قوتين رئيسيتين، وما يتبعهما من قوى أخرى، يكاد ظهورها واختفاؤها يحدّد حسب المزاج الأميركي، ولاحقاً الروسي.
لم يأت المحاميد بما هو خارج بنود الاتفاقيات التي سميت “خفض التصعيد”، على الرغم من أن انتهاكاتها تحدث يومياً، على مسمع ومرأى من الدول الضامنة نفسها، لكنه عبر بوضوح عما يجب أن تكون عليه الحالة المسلحة بين الطرفين. وكان هذا بالإمكان، لو أن الدول الضامنة مارست دورها، وكانت لكيانات المعارضة (السياسية والعسكرية) التي أعلنت تأييدها اتفاق الجنوب ومباركتها له، وهو محور تصريح المحاميد، فاعليتها أو سلطتها على الفصائل المسلحة التي حولت صراعها من النظام إلى التصارع بعضها مع بعض، لتصبح الحرب الحقيقية التي تستهدف الشباب السوري قد تضاعفت، حيث باتت الفصائل المتحاربة أحد أدواتها ووقودها؛ إلى جانب النظام ومليشيا حزب الله وإيران وطيران روسيا.
لم تكن صراحة المحاميد، على الرغم من ملاحظاتي على طريقة صياغة تلك التصريحات،
“مساحة الحركة عند “الهيئة” محدودة بسبب غلبة العامل الدولي” المأزق الوحيد الذي وجدت هيئة المفاوضات نفسها أمامه، بل كان واحداً من كثير غيره، فهي التي تعوّدت، كغيرها من كيانات المعارضة، الابتعاد عن مصارحة الشعب بكل ما يحيط بمسار ثورته التي تتولى هذه الكيانات قيادتها. والحقيقة، إن ما قاله المحاميد وضع الهيئة العليا في تناقضٍ واضح، من حيث هدف وجودها، وسبب استمرارها، إذ تجري الاتفاقيات بعيداً عنها، ومن ثم يصار إلى انتزاع موافقتها، كما حدث في مسار أستانة الذي هدف إلى تعطيل مسار جنيف، بل تغيير خريطة الأولويات الدولية، وتحجيم دور الملف السياسي الذي تضطلع الهيئة به، حسب قرار مجلس الأمن 2254.
لم تظهر “الهيئة العليا” إدراكها مخاطر وجود مسار تفاوضي آخر، لا تكون هي أحد أطرافه، هذا المسار الذي بدأ بعد خسارة المعارضة في حلب، وبعد أن أوقفت “الهيئة” مشاركتها في جولة جنيف في فبراير/ شباط 2016، معلنة “عدم العودة إلى جنيف قبل تحقيق المطالب الإنسانية”. بيد أنها عادت، بعد أكثر من عام، في مارس/ آذار 2017، إلى طاولة المفاوضات من دون أن يتحقق أيٌّ من مطالبها، بل وبعد أن عبّد الروس طريق “مفاوضات أستانة”، بالمشاركة مع تركيا وإيران باعتبارهما دولتين ضامنتين، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، وبعد أن أصبح مصير حلب بمثابة فزّاعة ترفع أمام كل الفصائل المعارضة للنظام، فلم تجد مفراً من حضور مفاوضاتٍ تتحدث عن المعارضة، وباسمها، وبحضورها من دون مشاركتها.
وعلى الرغم من كل الخسائر، والتراجعات، كان يمكن للهيئة أن تتجاوز عثراتها، وأن تعيد قراءة القرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف، والقرار الأممي 2254، وأن تدرك أن دورها التفاوضي يقتضي أن تكون عامل جمع السوريين، وليس محل خلافٍ أو اختلاف، بأن تعمل على صوغ “رؤية لسورية المستقبل”، تأخذ بالاعتبار طموحات كل السوريين في دولة مواطنين ديمقراطية، أساسها إعلاء شأن المواطن السوري، وتحقيق عدالةٍ تأخذ بالإعتبار كل مكونات الشعب السوري، لا مجرّد الحديث عن مشاركةٍ مع نظامٍ، على الأسس السابقة نفسها (كما جاء في الرؤية التي صاغتها ومنحت الحكومة المشتركة سلطات مطلقة). هكذا، فعندما علت الأصوات السورية بملاحظاتٍ بشأن تلك “الرؤية”، اعتبرت الهيئة تلك الأصوات مجرّد نشاز، بل وأبعدتها، لأن الهيئة بوصفها سلطةً فوقية، سارت وفق مبدأ من ليس معي هو ضدي، لكنها اليوم تعلن عن استعدادها لإعادة النظر بتلك الرؤية التي أعلنتها من لندن، ليس لقناعتها بضرورة الاستماع إلى السوريين الذين انتقدوا تلك الرؤية، بل لأن قراراً دولياً اقتضى ذلك؛ هكذا بدون توضيحاتٍ للشعب، وبدون أي مراجعة نقدية.
في المقابل، كانت هناك فرصة أخرى لقراءة قرار مجلس الأمن 2254 ذي الصياغة الملتبسة، والتي يمكن تدويرها باتجاهاتٍ مختلفة، لقراءات متعدّدة، تتناسب وكل الأطراف المشاركة بصياغته من جهة، وبالموافقة عليه من جهة أخرى، وبكل صراحة، إلا أن “الهيئة العليا” فضلت أن تقرأه من زاوية واحدة، لم يشاركها بها أيٌّ من الدول ذات القرار والتأثير في الحل السوري، فهي لم تلحظ أبداً أن هيئة الحكم ذات الصلاحيات التنفيذية التي تتمسّك بها، على رئيس النظام السوري أن يمنحها صلاحياتها، كما أنها لم تدرك معنى أن تذكر كل من منصتي القاهرة وموسكو بالقرار، ولم تأخذ في اعتبارها أن القرار 2254 منح مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان ديمستورا، صلاحية تشكيل الوفد المفاوض، أو على أقل ما يمكن أن لا يكتفي بوفد “الهيئة العليا للتفاوض” ممثلا عن المعارضة.
ندرك أن مساحة الحركة عند “الهيئة” محدودة، بسبب غلبة العامل الدولي، لكنها ليست كذلك
“كان واجبا أن تعمل الهيئة على تقريب وجهات النظر، من خلال طرح مشروع سوري توافقي، يتم الدفاع عنه” فيما يتعلق بترتيب بيتها الداخلي، بتنظيم علاقاتها مع قوى سورية موجودة على الساحة، كانت حسب مقاس الهيئة أم لا، وهي لا يفترض بها أن تكون كذلك، حسب عرف العمل السياسي. لذا، كان واجبا أن تعمل الهيئة على تقريب وجهات النظر، من خلال طرح مشروع سوري توافقي، يتم الدفاع عنه، بغض النظر عمن له عدد أقل، أو أكثر، في هيئة الدفاع، أقصد وفد التفاوض. ولهذا، انطلقت أصوات كثيرة ونداءات وطنية كثيرة بضرورة أن تعمل “الهيئة العليا” على عقد مؤتمر وطني جامع، قبل الذهاب إلى جنيف 5، وكنت قد كتبت، في مقالتي “سورية في حوار المنصات”، (“العربي الجديد” 1/3/2017) “إن السوريين ليسوا بحاجة إلى منصات تحاور النظام، وإنما إلى وفد واحد للمعارضة”، و”لماذا لا تجتمع هذه الأطراف المعارضة، لكي تناقش فيما بينها كل القضايا، وتخرج بتوافقات معينة، لتشكل وفداً يفاوض عليها مع النظام”؟
لكنني واحدة من سوريين كثيرين تم استبعاد آرائهم التي أصبحت اليوم شعار المرحلة، فقط لأنها تستجدّ الآن بناء على ضغط خارجي، على الرغم من أنه طلب يقع ضمن الحاجات السورية. لكن بعد أن خسرنا نحو عام ونصف العام من أعمارنا، وربح النظام حلب، ومناطق في ريف دمشق وحمص وحماه، ويسير الآن باتجاه دير الزور، وقد اطمأن إلى مناطق أخرى، تحت مسمّى اتفاقيات خفض التصعيد، وكانت خسائرنا بالأرواح كبيرة، عشرات آلاف الضحايا من شهداء، ومهجّرين ونازحين وجرحى. نعم، على الرغم من تأخرنا في قراءة قرار مجلس الأمن 2254 الذي صدر نهاية 2015، وعلى الرغم مما دفعته سورية لقاء ذلك. وعلى الرغم من أن قرار الاجتماع بين المنصّات لم يكن سيادياً للهيئة، ولم يتم العمل به بقرار وطني داخلي، إلا أن ضروراته تؤجل أسئلتنا الكثيرة بشأن من يتحمّل مسؤولية ذلك التأخير ولماذا؟
العربي الجديد
اتصالات دولية ـ إقليمية لدعم مؤتمر موسع للمعارضة السورية
بمشاركة مجموعتي القاهرة وموسكو وفصائل مسلحة لتشكيل وفد موحد للمفاوضات
لندن: إبراهيم حميدي
انطلقت عجلة اتصالات دولية وإقليمية لدعم جهود «الهيئة التفاوضية العليا» السورية المعارضة لعقد مؤتمر موسع للمعارضة بما في ذلك منصتا موسكو والقاهرة وممثلي فصائل مسلحة ومجالس محلية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للوصول إلى «وفد موحد» للدخول في مفاوضات جدية مع وفد الحكومة لتنفيذ القرار الدولي 2254.
في المدى المنظور، هناك مساران سوريان: الأول، عسكري ضمن عملية آستانة، لبحث تنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» وتجميد القتال بين القوات الحكومية والمعارضة وعزل التنظيمات الإرهابية، ويتضمن عقد اجتماع فني روسي – تركي – إيراني في طهران في الثامن من الشهر الحالي ثم اجتماع رفيع في آستانة قبل نهاية الشهر. الثاني، سياسي ضمن مفاوضات جنيف، عبر دعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وفدي الحكومة و«الهيئة» ومنصتي القاهرة وموسكو إلى جولة جديدة من المفاوضات في بداية الشهر المقبل.
رهان فريق دي ميستورا أن تؤدي الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف إلى اتفاق «الهيئة» ومنصتي القاهرة وموسكو على مباركة سياسية لثلاث أوراق: وثيقة المبادئ الأساسية للحل السياسي ذات الـ12 بنداً، وثيقة مبادئ العملية الانتقالية، وثيقة البرنامج الزمني لإعداد الدستور السوري. أي يبدي وفد «الهيئة» مرونة إزاء ربط الموافقة على إقرار المنصتين «الانتقال السياسي»، بحيث تكون هذه الوثائق مرجعية المعارضة للتفاوض مع وفد الحكومة على تنفيذ القرار 2254. أي إزالة ذريعة دمشق وموسكو بعدم التفاوض الجدي بسبب عدم وجود وفد موحد للمعارضة.
وأطلق اجتماع «الهيئة التفاوضية» الأخير في الرياض واتصالات دولية وإقليمية دينامية جديدة، طالما سعى إليها معارضون وفريق المبعوث الدولي عبر عقد مؤتمر موسع للمعارضة السورية يبني على مؤتمر الرياض الذي عقد في نهاية 2015. وبدأت اتصالات رفيعة المستوى بين دول إقليمية فاعلة كان دي ميستورا حاضراً في بعضها للتحضير للمؤتمر بموجب تفويض القرار 2254.
الهدف الأولي لهذا المؤتمر، وصول المعارضة السورية إلى «رؤية واستراتيجية وهيكلية جديدة»، وتوحيد أطرافها التي تشمل منصتي موسكو والقاهرة و«تيار الغد» برئاسة أحمد الجربا، وربما شخصيات وقوى كردية، إضافة إلى ممثلي فصائل مسلحة ومجالس محلية تبلورت بعد اتفاقات «خفض التصعيد»، مع تشجيع المشاركين على التعاطي مع الأمر الواقع الذي ظهرت تجلياته في الفترة الأخيرة، وتشمل اتفاقات «خفض التصعيد» في جنوب غربي سوريا برعاية أميركية – روسية – أردنية، وفي غوطة دمشق وريف حمص بـ«ضمانة» روسية و«رعاية» مصرية.
الرهان أنه في حال حصل مؤتمر المعارضة على دعم أميركي – روسي باعتبار أن سوريا هي ساحة التعاون الوحيدة بين البلدين، وتذخير من الاقتراح الفرنسي بتشكيل «مجموعة اتصال» دولية – إقليمية، أن يضع دمشق أمام خيار واحد: التفاوض مع «وفد واحد» من المعارضة لتنفيذ القرار 2254 للوصول إلى «انتقال سياسي سلس ومضبوط».
لا يزال البحث، بحسب مصادر، يتناول المبادئ المتعلقة بالمؤتمر، إضافة إلى الموقف الذي سيتخذه المشاركون من الرئيس بشار الأسد. بالنسبة إلى «الهيئة» فهي متمسكة بوثائقها القائمة على رفض أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية وتتمسك بمحاكمته. بالنسبة إلى موسكو، تريد أن يبقى خلال المرحلة الانتقالية ويشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن برنامج القرار 2254 مع قولها إن «ذهابه يعني انهيار النظام». في حين تقول واشنطن إنه «لا مستقبل للأسد وعائلته في مستقبل سوريا»، وباتت تفصل بين «النظام – الدولة – الجيش» و«السلطة – العائلة – الأسد»، بحسب مسؤول غربي. وأحد الاحتمالات الوسط التي اقترحها مسؤولون على صلة بالملف السوري، أن يركز مؤتمر المعارضة المنشود على «الدولة السورية المنشودة والانتقال السلمي السلس المنظم بإشراف دولي» وربما من مجلس الأمن.
«الهيئة التفاوضية»، التي فوجئ بعض أطرافها بالدفع لعقد مؤتمر موسع للمعارضة، بدأت اتصالات تمهيدية مع منصتي موسكو والقاهرة ودعتهما إلى اجتماع في منتصف الشهر الحالي. رد مسؤولي المنصتين كان منقسماً بين قبول الدعوة والاختلاف على مكان اللقاء من جهة و«اشتراط تغيير ذهنية الهيئة» من جهة ثانية. وأبلغت «الهيئة» المنصتين خطياً «أهمية الحوار حول إمكانية تشكيل وفد موحد بعد الاتفاق على أسس الانتقال السياسي»، مع تمييز ضمني بين قبول موقف منصة القاهرة الراضية بـ«الانتقال» والتشكيك بموقف منصة موسكو بسبب موقفها من «الانتقال السياسي»، بحسب مسؤول في «الهيئة».
ودخلت أنقرة على الخط، حيث وجهت دعوة لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض، أحد مكونات «الهيئة» لعقد اجتماع في تركيا في 18 الشهر الحالي لبحث المستجدات، في وقت شكلت فيه «الهيئة» وفداً موسعاً للذهاب إلى بروكسل في 28 من الشهر لعقد لقاءات مع مسؤولين أوروبيين وتدريب الفريق المفاوض على كيفية بحث «السلال الأربع» في مفاوضات جنيف، وتشمل الحكم وصوغ الدستور والانتخابات ومحاربة الإرهاب.
في موازاة ذلك، أطلقت «الهيئة» جهداً لـ«إنقاذ إدلب من مصير أسود بعد تهديدات أميركية برفع الغطاء عنها والتعامل معها عسكرياً باعتبارها أكبر معقل لتنظيم القاعدة في العالم». وأقرت «الهيئة» تشكيل «لجنة للتواصل مع القيادات العسكرية والفعاليات السياسية والوطنية والدينية في إدلب للوقوف على أوضاعها وكيفية تجنب وقوع كارثة فيها بسبب وجود هيئة تحرير الشام» التي تضم «جبهة النصرة» وكانت طردت «أحرار الشام» من مناطق عديدة وهيمنت على معظم إدلب، بما في ذلك حدود تركيا.
الشرق الأوسط