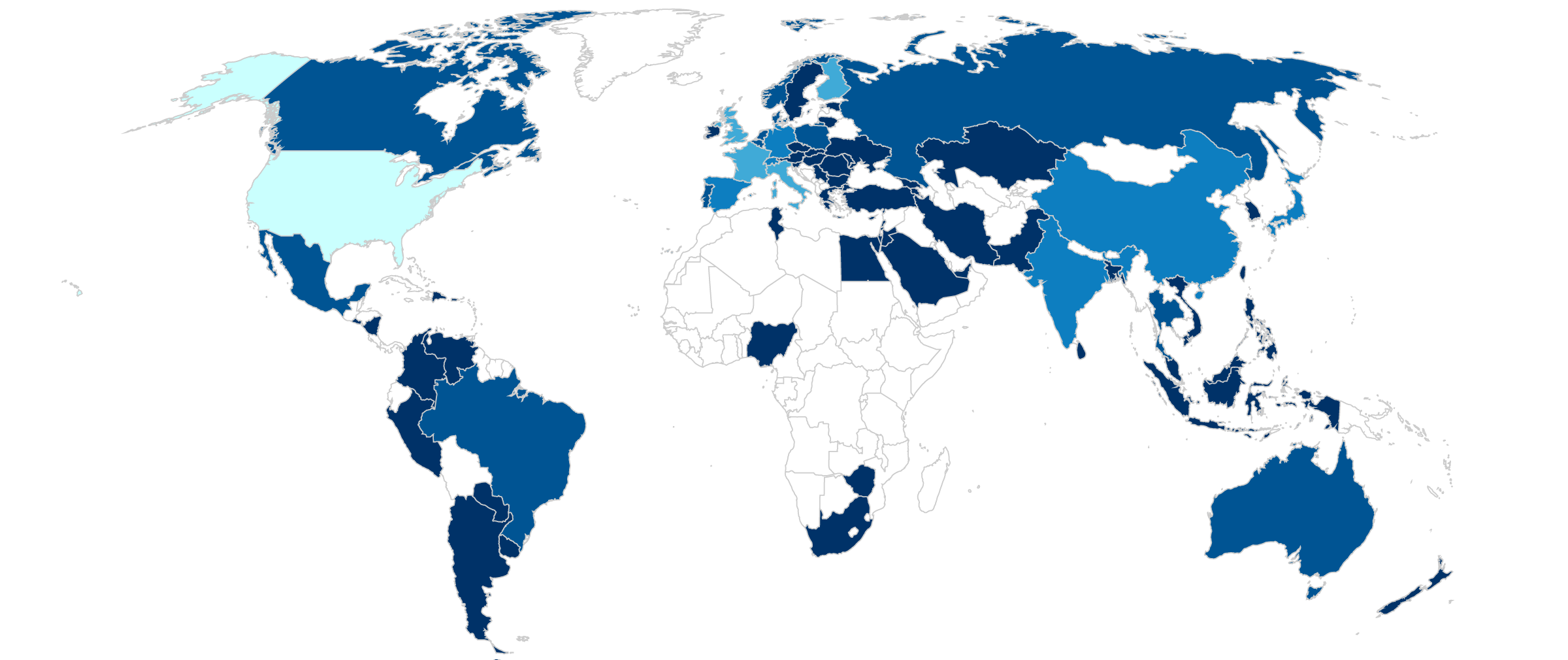عن نيتشه -عدة مقالات-

عصر مفرط في نيتشويّته: لا أخلاقية اليأس/ شوقي بن حسن
نيتشه فيلسوف محظوظ. في العربية، هو من الفلاسفة القلائل ممن تتوفر معظم أعمالهم، بعضها عَرفت ترجمتين أو ثلاثاً. أما في الغرب، فقد تسرّب فكره إلى كل شيء، وتزاحم حول منجزه المفكّرون مستثمرين خطواته العملاقة إلى الأمام وفي العمق، ومعيدين قراءته لدى كل منعطف تاريخي.
يبدأ نيتشه، من الأصول. انفتح منذ سنوات الدراسة على اللغة الإغريقية القديمة، ووضع أمامه مشروعاً، سيحافظ على بعض من ملامحه ويدمّر أجزاء أخرى منه. كان مقتنعاً بأن الفلسفة مندمجة مع تاريخها، لذلك سيُعرف في سنوات بروزه الأولى كفيلولوجي (مشتغل على تاريخ الفلسفة) لا كفيلسوف. بمعنى ما، اعتُبر بأنه من تقنيّي المعرفة الفلسفية، على حد توصيف أحد المتحمّسين له في ما بعد، ميشال فوكو. بعد ذلك، سيأتي نيتشه على جلّ مواضيع الفلسفة من الطريق الذي اختاره لنفسه.
لعل أكثر سؤال طُرح، ويُطرح حتى الآن حول نيتشه، الذي تمر اليوم ذكرى رحيله الـ 115، هو هل فكّرنا معه بحق؟ لقد خلّف تركة من الأفكار، معظمها نبوءات، فماذا حدث حين وصلت البشرية إلى النقاط التي توقّعها؟ كثيرون يتساءلون اليوم عن هيمنة قراءة دون أخرى على نيتشه، حتى قيل “ألم يَحجُب الشرّاحُ نيتشه عن القرّاء؟” خاصة أن كبار المفكّرين تصدّوا لهذه المهمة من مارتن هايدغر إلى جيل دولوز.
قياساً عليه، لنا أيضاً أن نتساءل: ألم يحجب المترجمون العرب مناطق من عبقريّته عنا؟ كثر هم مترجمو نيتشه في العربية، منذ فليكس فارس (“هكذا تكلم زرادشت” – 1938) إلى موجة ترجمته في العقود الأخيرة، مع علي مصباح ومحمد الناجي وفتحي المسكيني وحسان بورقية وشاهر عبيد وغيرهم. اللافت، هو أنه كلما تكاثرت الترجمات اكتشفنا أن النص المترجم الأول مختلف عن الثاني، وكأنّ أكثر من نيتشه وصل إلى العربية. هذا دون أن ننكر أنها عموماً ترجمات ممتعة.
إن كل هذه الأسئلة التي تُطرح اليوم عن نيتشه، هي نفسها قيمة مضافة نيتشوية في الفكر. إذ قلما نجد قبله حرصاً على الانتباه عند قراءة الفلاسفة. فمنذ أعماله الأولى، دعا صراحة إلى ضرب أفلاطون، كقاعدة انبنى عليها صرح الفلسفة، معتبراً أن العقل الغربي استسلم لسحر كتاباته فتجرّع بسلاسة سموم الانحطاط الذي بدأ يجثم في عصره على اليونان.
تجرّأ نيتشه أن يُسقط أفلاطون من قائمة الفلاسفة الحقيقيين، فهو ببساطة قد وقع في فخ الانبهار. بذلك يصل إلى ضرب صنم فكري آخر هو سقراط، ليعود نيتشه إلى النظرة الإغريقية ويقدّم مشروعيتها من جديد: سقراط كان مفسداً بحق.
هذا الرجل، بحسب نيتشه، “يكره العالم الواقعي ويسعى إلى ترويج هذه الكراهية”. بناء فكري شامخ سوف ينبني على هذه الملاحظة، خصوصاً حين يطبّق ذلك على كامل الصرح الأخلاقي للبشرية. ذلك الصرح الذي ظل ينفي عمق الحياة، باعتباره تحريفاً متواصلاً للأصل.
كانت هذه الآراء الحادة والغريبة، ورغم جودتها الفلسفية، بالنسبة لمتكلّمي القرن التاسع عشر، فلاسفة وأكاديميين، حجة للإبقاء على نيتشه في الظل. أما هو، فقد عرف، في وحدته، أن الحفر الذي يشتغل عليه سيوصله إلى الناس.
وقف نيتشه ضد تقديم أي عزاء أمام الحقيقة، حتى ولو كانت مُرعبة، وفي الغالب هي كذلك. اعتبر أن كل الآراء السائدة خمول ذهني، بل إن كل “كلمة، أي كلمة هي حكم مسبق”. رفض أن يسير كل شيء في العالم بقوة الوهم، مُوجّهاً للمناهج الفلسفية والعلمية أقسى الانتقادات، معتبراً إياها قيوداً وسلوكات تدل على خوف من الحقيقة.
بتلك المناهج، لم يكن أحدٌ يستطيع التفكير في المعضلات الكبيرة للعصر. كانت سبباً مُعطلاً منع الفكر من أن يرى أن أوروبا، ومشروع الحداثة الذي تمجّد به نفسها، قد سكنته العبثية وأنه يفضي إلى طريق مسدود. كان هجوم نيتشه أشنع من الوقوف عند تبيان الخلل، فهاجم صمت وعجز رموز عصره. كان يمتلك شجاعة أن يكون مُزعجاً.
لعل الصمت والعجز ما زالا مُهيمنَيْن إلى اليوم على منظومة الفكر. فالمشروع البديل بتجاوز الحداثة سرعان ما اصطدم بعُقمه. كما ظل التاريخ يتحرّك بقوة الوهم، بل إن المنجز التكنولوجي والفني للعقود الأخيرة، إضافة إلى الأدوات القديمة التي فكّكها نيتشه، سرّع وتيرة سيطرة القيم المُغالِطة على قيم الحياة الحقيقية، حتى تحوّل الواقع كما قالت نبوءته إلى “عملية تزييف للعالم باستمرار”، وتحوّلت فكرة القطيع إلى واقع معمّم تحت تسمية جديدة “المجتمعات الجماهيرية”.
يعتبر نيتشه أن كل النظم من طبقات وزواج وتربية (النظام السياسي أيضاً بلا شك) وغيرها، تستمدّ قوّتها ودوامها من إيمان العقول المستعبدة، أي من غياب الحجج. ويضيف أن العقول المستعبدة لا تعتنق إلا المبادئ التي تعود عليها بالمنفعة.
لعلنا اختبرنا شيئاً من هذا الحديث مع موجة الثورات والانتفاضات العربية الأخيرة. ما لبثت التجارب التي نجحت في إسقاط “أصنامها” أن خضعت مرة أخرى لها (بأشكالهم المستحدثة). في تونس أو في مصر أو في اليمن، ومنذ أن تحرّكت منظومة المنافع القديمة حتى دغدغت العقول المستعبدة لتعود إلى مبادئها الأولى، وتغمر هذه البلاد أو تلك موجة العودة إلى ما كانت عليه، عبر القوة وعبر اللعبة الديمقراطية وكواليسها.
لكأن ما يحدُث يبرهن على عبثية تسكن هذا الواقع العربي، ضمن عبثية أوسع للتاريخ البشري العام. هنا، تتشابه العصور، بين عصر نيتشه وعصرنا، عصورٌ عبثية بامتياز، ولا مخرج منها سوى الفكر النقدي.
يؤبد هذه العبثية أو تلك سيطرة “فاقدي الوعي” على الفكر، واحتكارهم للفرص. وهؤلاء بالضرورة، كما يرى نيتشه، يحبّون إنتاج فقدان الوعي وتعميمَه، وحين تهتز بهم الأرض تُسعفهم منظومة علاقات دولية مشبّكة في تحالفات داخلية ليستمر التضليل وقلب القيم رأساً على عقب.
إن عودة بلدان عربية إلى المربّع الأول؛ أتت مرة أخرى بطبقة من “الكهنة” السياسيين، يخترقها العجز أمام التحديات الاقتصادية والمجتمعية والجيوسياسية، فلا تملك أن تقدّم سوى مغالطات ومراوغات لتستمر في مواقع السلطة (حفر قناة سويس جديدة أو بناء جدار للتصدّي للإرهاب كأمثلة). يقول نيتشه: “الكهنة هم الأكثر إفساداً لأنهم الأكثر عجزاً. العجز الذي يُنمّي حقداً عقلياً مسموماً”.
فُتن نيتشه في شبابه ببسمارك، وخيّب أمله من جاؤوا بعده إلى الحكم، فانبرى يَسخر من الشعب الذي “ينتظر تقدّم الحمقى إلى الأمام”. يتواتر حضور هؤلاء مع العصور والبلدان، ويتحرّكون في المساحة الخالية التي تتركها الشعوب، حين تنسى أن تتسلح بإرادتها وبانتمائها للحياة، فـ “الذي يحيا يريد قبل كل شيء تحرير طاقته. الحياة نفسها إرادة قوة”. أما “اليأس فهو غير أخلاقي، وهو احتقار للواقع”. هكذا تحدّث نيتشه.
العربي الجديد
أرض مكتظّة بالدخلاء/ فريدريك نيتشه
الجمهور، أياً كان هذا الجمهور، يجب أن يبقى دائماً مدركاً أنه يُشاهد عملاً فنياً وليس واقعاً تجريبياً. المتفرج المثالي هو من يسمح لما يقع على الخشبة أن يؤثر فيه تأثيراً مضاعفاً، وأن يكون محباً لتناول السموم التي يقدمها له الرومانسيون. (مولد التراجيديا، 1971)
*
تستعمل الإنسانية كل فرد دون تحفظ كوقود لتسخين آلتها الكبيرة. آلة ليس لها من غاية سوى الإبقاء على نفسها. تلك هي الكوميديا الإنسانية. لذلك أفضل أن أكون مُهرّجاً لا قديساً. (إنسان، مفرط في إنسانيته، 1878)
*
فسحت الإنسانية المجال لغرائز النفي والفساد والانحطاط كي تمارس سيادتها عليها. وإن مهمتي تتمثل في الإعداد للحظة التي ستعود فيها الإنسانية إلى نفسها وتتخلص من سيطرة الصُدفة والقس. (الفجر، 1881)
*
كلّما تصرّف الناس بحرية أقل، تجلّت الغريزة القطيعية فيهم وظنّوا أنهم أخلاقيّون. أخلاقهم هذه مسمومة، لأنها ترى في حرية التفكير الشقاء ذاته. الأخلاق، في جوهرها، هي تكبيت الضمير القطيعي ورؤية النفس والعالم بنزاهة. وبمجرّد أن تفسُد الأخلاق، تنبثق الكائنات التي نسمّيها طغاة. (العلم المرح،1882)
*
إن الأرض مكتظة بالدخلاء وقد أفسدوا الحياة، فما أجدرهم أن تستهويهم الحياة الأبدية ليَخرُجوا من هذه الدنيا. إنهم لأشد الناس خطراً، إذ كَمَنَ الحيوان المفترس فيهم، فغدوا ولا خيار لهم إلا بين حالة التحرّق بالشهوة وحالة كبتها بالتعذيب. هؤلاء المسوخ لم يبلغوا مرتبة الإنسان بعد. هم مصابون بسل الروح، لا يكادون يولدون للحياة حتى يبدأ موتُهم. (هكذا تكلم زارادشت، 1885)
*
على الإنسان أن يقصي من تفكيره علم النفس القديم الخرع. عليه أن يُشرّح ضميره وأن يرضى بالتضحية بالعقل. إن القساوة هي ما يحرّض الإنسان وما يدفعه إلى الأمام. كل تعمّق وسبر للأغوار هو مسبقاً اغتصاب ورغبة في الإساءة. ومع كل طلب للمعرفة توجد على الأقل قطرة من القساوة. (ما وراء الخير والشر، 1886)
*
تبدأ ثورة العبيد في الأخلاق حين يصير الحقد نفسه خلاقاً وينتج قيماً. حقد هؤلاء يحرمهم من الفعل الحقيقي، وفي غيابه يطوّرون الانتقام في خيالهم. من خاصيات الحقد أنه يقوم بقلب النظرة التقييمية. إن أخلاق العبيد تحتج دائماً إلى عالم معاد لها، تحتاج دائماً إلى محفزات خارجية، ففعلها هو بالأساس رد فعل. (جينيالوجيا الأخلاق، 1887)
*
حَرم الألمان أوروبا من جني ثمار العصر التاريخي العظيم؛ عصر النهضة، وبددوا محتواه. لقد أعاد لوثر ترميم الكنيسة في اللحظة التي كانت فيها متقهقرة، حين عرف الناس أنها قد تحولت إلى نفي لإرادة الحياة. (قضية فاغنر، 1888)
*
تحطيم الأصنام حرفتي، ذلك أنه بمجرد أن أبدعت أكذوبة عالم المثل، حتى وقع تجريد الواقع من قيمته ومن معناه ومن حقيقيّته. الحقيقة وحدها هي التي ظلت إلى حد الآن خاضعة جوهرياً للحظر. (المسافر وظلّه، 1888)
*
الفنانون الفاتنون يعرفون كيف يحوّلون كل خلاف إلى تناغم، يجعلون كل شيء يستفيد من قوّتهم ومن خلاصهم الشخصي. الإبداع لديهم عرفان بالجميل لذواتهم. يقدّمون فنهم للمرضى الذين هم في حاجة إلى أوهام فاتنة ليتمكنوا من تحمّل الحياة. الضعفاء يطلبون المتعة في فن لم يتم تخيّله لأجلهم. (إدارة القوة، 1901، نشر بعد رحيل صاحبه)
*
الأوهام ملذات باهظة الثمن. وإن تحطيمها أبهظ ثمناً منها. هذا الثمن سيدفعه فقط من يعتبرون تحطيمها لذة أيضاً. (هذا هو الإنسان، 1908 – نشر بعد رحيل صاحبه)
نشيد فْليكس فارس/ نجوان درويش
أكمل فْليكس فارس (1882- 1939) ترجمة “هكذا تكلّم زرادشت” وأنهى مقدمته في 20 أيلول/ سبتمبر 1938 في الإسكندرية. المدينة التي انتهى ترجماناً في بلديتها بعد حياة محمومة بالمعرفة والسفر وفكرة القومية، توزّعت مسارحها بلادُ الشام وتركيا وأميركا.
رحل بعد أقل من سنة (27 حزيران/ يونيو 1939)، وبعد قرابة أسبوعين وصل جثمانه إلى لبنان، حسب وصيته، ليدفن في قريته “المريجات”، ولتختتم رحلة نفس كبيرة عاشت في زمن ضيّق هو عصر الخروج من الهيمنة العثمانية إلى الاستعمار الأوروبي، عصر تأسيس التوق للفكرة العربية. جملته الشهيرة “ويل لأمّة لا ينبت فيها رأس إلاَّ وهو مشدود بناصيته إلى أذيال الغريب” يمكننا أن نستبدل الغريب بالغرب فيها دون مساس بالمعنى.
ترك فارس -إلى جانب حياته العاصفة كنهضوي عروبي حالم- قرابة 18 كتاباً بين موضوع ومترجم، بعضها بالفرنسية، وهي اللغة التي ترجم عبرها كتاب نيتشه، والذي إن لم يكن أول ترجمة عربية عن الفيلسوف الألماني؛ فهو بالتأكيد أول حضور كبير له في العربية وكل حضور لاحق مدينٌ لترجمة فارس.
سيشعر القارئ، في بعض صفحات مقدمة “هكذا تكلّم زرادشت” بشيء من الوعظ في ثنايا هذه المقدمة؛ في حين أنها -وبعد قراءة متبصّرة- نقد دقيق لفهم نيتشه أو لا فهمه للحضارة التي يمثّلها المترجم، وهو هنا محاوِر وندّ لا مجرّد ناقل.
في الصفحة الأخيرة، يكتب فارس: “للعالم الأوروبي تأويله ولنا تأويلنا، وللصحراء في بلاد العرب رموزها، فلندع للأزمان تأويلها، ولنكرر ما جاء في نشيد الجاحد الطامح إلى الخلود: “إن الصحراء تتّسع وتمتد فويلٌ لمن يطمح إلى الاستيلاء عليها”.
جنيالوجيا الأخلاق وورثة تشريح الضمير/ نوال العلي
كلّ من يقرأ نيتشه يقع على مقال له أو شذرة هي الأقرب إليه من بين كل ما كتبه. وأغلب الظن أن كل من يقرأ مقاله الثاني من كتاب “جنيالولجيا الأخلاق” يجد قطعة تخصه كإنسان أو نتيجة لعصر الحداثة.
في المقال الذي يترجم فتحي المسكيني عنوانه بـ”الذنب، الضمير المعذب، وما جانس ذلك”، نعثر على مرآة لنا سكّان العصر الحديث، إننا ورثة تشريح الضمير وآلاف السنين من تعذيب الذات بفكرة “الله” ومحاولة مجاراتها ومداناتها والاقتراب المستحيل من المكتمل، تلك الفكرة التي أعلن الفيلسوف الألماني موتها، وكأنه بذلك يعلن أيضاً أن الفلسفة منذ أفلاطون كانت قطاراً يسير على السكة الخطأ.
في هذه القطعة من كتابه يمكن أن نطابق الفلسفة بالعالم، وأن نمد خطوطاً بين صورة الواقع وتطلع الفلسفة، ففيها يحاول نيتشه تفنيد كيف أن المعاناة ومن يعانيها يؤسسان معاً مفهوم “الذنب”، هذا الذي يعمل من أجل لحظة إنكار القوة والعيش بكثافة أو بشدّة، إذ يعتبر نيتشه أن التمييز الأخلاقي نتاج لإنكار القوة، بل إنه يأتي من محاولة الضعف تشويه القوة.
كتب نيتشه هذا الكتاب سنة 1887 بمحاذاة النشوة الألمانية، فبعد الانتصارات على الدنمارك والنمسا وفرنسا وتسيد اللغة الألمانية في أوروبا، كان ثمة مقدار ضخم من الشعور بتفوق القومية الألمانية والهتاف لولادة البلاد بشكلها الحديث، كل هذا كان يُشعر نيتشه بالقرف، بل واعتبر أن ألمانيا تعيش قمة انحدارها، فالفيلسوف الحداثي في هذه الحالة كان ضد الحداثة التي ستقود في نهاية الأمر إلى هيمنة الأخلاق البرجوازية في أوروبا، هذه الأخلاق التي تستبدل القوة وشدة العيش وصدقه بالشعور بالذنب وتأنيب الضمير.
لن تنهي المقال دون أن تتساءل مع نيتشه: كم من مرة رأينا بأم أعيننا ودفعنا كبشر من أثمان في سبيل تشييد فكرة “المثالي” على الأرض؟ وتمكين الأخلاق وهي ليست إلا تراكماً للسيطرة وإنكاراً للفطرة وكثافة الذات، كل هذه الأثمان إنما هي أعراض السقم الإنساني، وهو السقم الذي يجعلنا نصير جزءاً منسجماً مع الكل، ومقابل إصابتنا به نكافأ بأن نتعاقد على أن نصير أبناء هذا المجتمع أو ذاك، ذلك الدين أو ذاك، تلك الهوية أو هاتيك.
في مقال نيتشه هذا ثمة قلق أصيل من الترشيح (الفلترة)، ترشيح الطاقة والقوة التي قادتنا إلى أعلى القيم ومثالياتنا العليا التي هي في حقيقتها أعراض الخوف من العيش بشدة وصدق. وأننا إن تمكنا من اختراق هذه الحواجز والاشتراطات والعقود التي نبرمها مع الحياة من خلال هذه القيم، فإننا سنعطي أنفسنا فرصة العيش بملء ذواتنا، لا أن نعيش في العالم كمن يقترض شيئاً منه.