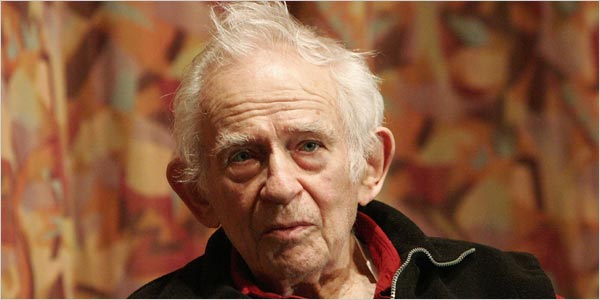فصل من رواية اختبار الندم لخليل صويلح

كنت تعرّفت إلى حارس مسرح القباني عن قرب، أثناء تردّدي إلى بروفات مسرحية لأحد أصدقائي في صالة هذا المسرح، كنوعٍ آخر من مقاومة الضجر. كان سميح عطا أرشيفاً حيّاً لكل العروض التي شهدتها هذه الخشبة طوال أربعة عقود، ولفرط شغفه بالمسرح، كان يحفظ مقاطع من بروفات العروض في خلطة عجائبية من الشخصيات.
بعد عناء وجدت النصّ الأولي للمشروع في ملفّ عشوائي يضمّ أفكاراً لمشاريع مجهضة، فأرسلته على الفور إلى بريد نارنج الالكتروني، وها أنذا استعيد قراءته كما هو مكتوب في نسخته الأولى:
«ما الذي يفعله سميح عطا، حارس مسرح القباني في وحدته، بعد أن فقد بيته في الضواحي خلال موجة قصف عنيفة؟ منذ سنتين وسبعة أشهر لجأ إلى المسرح . اختار ركناً من غرفة الملابس مكاناً لنومه. هل يصعد إلى الخشبة ليلاً بمفرده، ويستعيد أدواراً لعبها الآخرون، أم أنه يخرج عن النص ويبتكر حوارات جديدة لتبرير عزلته القسرية؟ وهل يجلس على كرسي «الملك لير»، أم يستعير شخصيات تشيخوف في وصف الألم البشري، أم يصعد الدرج إلى بوابة المسرح كي يتنفّس هواءً آخر عابراً بمحاذاة صورة أبي خليل القباني؟ الحارس الذي أمضى حياته في هذا المكان يحفظ مقاطع كاملة من المسرحيات التي حطّت على الخشبة. لكنني أظنُّ أنه خلال بروفاته الليلية المرتجلة قد عبث بالنصوص وخلط الأوراق، فتداخلت أصوات أوفيليا وهاملت والخال فانيا، وانزلقت بين الكراسي الفارغة. ولعله استعاد شيئاً من «قصة موت معلن» لماركيز كي يروي قصة موته الشخصي البطيء.
سوف ينظّف الخشبة من خطوات الممثلين، ويرتدي ثيابهم وأكسسواراتهم وصراخهم، وينشئ نصاً مختلفاً في الضوء الشحيح للمسرح بفصحى مرتبكة وحنجرة مجروحة وأصابع متشنّجة، فوق خشبة مهجورة.
لا نعلم ماذا يفعل حين ينتهي من أداء «أدواره». هل سيصفق لنفسه، وينصت للصدى، أم يتذكّر بيته المهدّم، ويعيد بناءه، كما لو أنه خشبة مسرح أخرى، ويدعو ضيوفاً وهميين لحضور بروفاته الليلية؟ أفكّر في حارس مسرح القباني وهو يضع أبريق الشاي أمام بوابة المسرح مساءً، وينتظر العابرين، متجاهلاً أن مدخل الشارع الذي يقود إلى المسرح مغلق بكتل ضخمة من الكونكريت. سيحمل إبريق الشاي في ليل القذائف ويدخل إلى عتمة المكان، ويختلط بأشباح شخصيات كانت تملأ فضاء الخشبة بالحب والاحتجاجات والغضب. سوف يلقي التحية على صور الممثلين داخل ملصقات العروض القديمة التي يحتشد بها الممر الطويل إلى الخشبة، ويمضي إلى ارتجالات جديدة مازجاً الأدوار في مونولوج واحد طويل، يختزل مأساته الشخصية.
فُتنت نارنج بالفكرة، حسب ما كتبته لي في ردّها على بريدي، كما أنها قد بدأت فعلاً، برسم سينوغرافيا متخيّلة للشريط تتكئ على معرفتها الشخصية بسميح عطا وبروح المكان» غداً سأذهب إلى المسرح لمقابلة الحارس، وإقناعه بأن يقف أمام الكاميرا، ليروي سيرته كاملةً. ملاحظة: سأخبرك بنتيجة استطلاعي فور انتهائي من عملي. هل ألتقيك في المقهى ظهراً، أم في البيت مساءً؟».
النسخة الثانية التي أنجزتها نارنج بمساعدة زملاء لها في الورشة من المشروع بعنوان» رسائل الحارس إلى أبي خليل القباني» تكشّفت عن وقائع جديدة تتعلّق بشغف سميح عطا بالمسرح واعترافه بأنه كان يعوّض خسائره كمدير منصة، ومنفذ ديكور، وكومبارس صامت، بصعوده الخشبة ليلاً لأداء أدوار كان يحلم بتجسيدها فعلاً. خلال وجوده وحيداً على الخشبة يستعيد محطات من حياته الشخصية، وكأن العبارات التي ينطق بها من نصوص الآخرين تعبّر عن همومه أو ذائقته الجمالية، وتطلعاته نحو حياة لم يعشها، كما كان يبغي، إذ يجد في مخاطبة رائد المسرح السوري أبي خليل القباني عزاءً روحياً يخفف من وحدته ووحشته الليلية. في الحوار الذي سجّلته نارنج مع الحارس أخبرها بأنه كان يعمل في ورشة دهان لدى متعهد، وكان قد وقع الاختيار على هذه الورشة لطلاء جدران المسرح، لكنه بانتهاء العمل، تمكّن من الحصول على وظيفة حارس، ثمّ عاملاً في البوفيه، وهو ما طوّر علاقته بأهل المسرح عن طريق حضوره البروفات على سبيل التسلية أولاً، لكن شغفه بهذا العالم العجائبي لم يقف عند هذا الحدّ، إذ بدأت تتسرب إلى أذنيه عبارات ذات رنين، لم يسمعها قبلاً، وسيذكر أولاً، مقطعاً من مسرحية «العنبر رقم6» لأنطون تشيخوف، وآخر من «عرس الدم» للوركا، ثمّ يتوقّف عند «الملك لير» لشكسبير. يعترف سميح عطا بأنه حين كان يوزع ملصقات العروض في الشوارع، كان يتخيّل اسمه مكتوباً بخطٍ عريض بدلاً من اسم ممثل العرض، ولطالما حمل باقات الورود بعد انتهاء عرضٍ ما إلى بيته مدعيّاً أمام زوجته أن إدارة المسرح كرّمته على الخشبة مع بقية فريق المسرحية» أنا الذي لم يهدني أحد وردة في حياتي كلها». وسوف يدخل في تراجيديا حياته الشخصية، حين عاد ذات يوم إلى بيته ليجده وقد تحوّل إلى أنقاض إثر اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة داريا المتاخمة لدمشق، وقد ذهبت زوجته ضحية القصف، فاضطر إلى أن يلجأ إلى المسرح ويصوغ حياةً متخيّلة فوق خشبة مهجورة. في تسجيلات لاحقة سوف يضيء مناطق معتمة أخرى تتعلّق بمناماته، وكيف داهمه كابوس عنيف، إذ رأى ابنه الذي انتهى مهاجراً إلى الدنمارك يغرق بعد انقلاب القارب في البحر، لينتشله أبو خليل القباني الذي ظهر فجأة من بين الأمواج المتلاطمة» كلما استمعت بالمصادفة إلى أغنية يا مال الشام يا الله يا مالي، الأغنية التي كتبها ولحّنها هذا المعلّم، أستعيد ذلك المنام».
كانت نارنج سعيدة بغنى المادة الأولية التي منحها إياها سميح عطا، واستعداده لتصوير وثائقي عن حياته، فهو الآخر كان بحاجة لمكاشفة الآخرين بما يكابده في وحدته بين جدران المسرح. سأقع خلال استماعي للتسجيلات على عبارات عميقة ومدهشة وردت في اعترافاته المرتجلة كهذه العبارة» أعظم مشحاف لا يستطيع محو ذكرياتي عن هذه الجدران». اقترحت أن يبدأ المشهد الأول بهذه العبارة، ثمّ يغوص سميح عطا تدريجياً باستعادة ذكرياته الأولى عن هذا المكان، وصولاً إلى لحظته الراهنة. طوال فترة التحضيرات للفيلم، لم تتوقف نارنج عن تزويدي بأسرار جديدة من مخزون الحارس، وهو ما أضفى حيوية على سلوكها الشخصي، فقد استبدلت غطاء رأسها بقبّعة مخطّطة من الصوف تخفي أذنيها تماماً، كما بدت عيناها أكثر اتساعاً بخط كحل ناعم يحيط برمشيها، وفيزون أسود ضيّق يكشف عن ساقين ممشوقتين بإغواء معلن. أخبرتني بأن الحارس وافق على أداء مشاهد قصيرة على الخشبة، مثلما كان يفعل في لياليه الموحشة، وهي بحسب تسلسلها:
– « حياة لعينة، والمصيبة أنها لن تنتهي بمكافأة على الآلام أو بمشهد ختامي كما في الأوبرا، بل بالموت»( من العنبر رقم 6- أنطون تشيخوف)
– «كم مرّة هزمتنا الخيانة …دون قتال»( من الملك لير- وليم شكسبير)
«أما أنا فسأعمل من رقادي حمامةً باردةً من العاج تحمل أزهار الكاميليا الندية إلى المقبرة. المقبرة؟! لا بل مثوى من تراب يحميهم ويهدهدهم في السماء … أبعدي يديك عن وجهي، فإن أيامًا رهيبة ستأتي. وأنا لا أريد أن أرى أحدًا. فقط الأرض وأنا. دموعي وأنا. وهذه الجدران الأربعة»(من عرس الدم- فريدريكو غارسيا لوركا).
لاحظت أن كل المقاطع التي اختارها سميح عطا بوصفها تاريخاً شخصيّاً له، كانت من مسرحيات أجنبية مترجمة، وغياب أية إشارة إلى نصوص عربية، وهو ما وعدتني نارنج بترميمه قبل التصوير، وذلك بتحريضه على استذكار عرضٍ محلّي ما حفر عميقاً في ذاكرته. بعد حيرة طويلة اختار شخصية الحكواتي مبرراً ذلك بقدرته على استدعاء شخصيات شعبية مثل عنترة، وأبي زيد الهلالي، وسيف بن ذي يزن، كما أنه رغب بتوجيه تحية لرشيد الحلّاق، آخر حكواتية دمشق الذي مات قهراً، إثر حرق كتبه القديمة على يد جماعة تكفيرية داهمت بيته في إحدى قرى غوطة دمشق. أعجبتني فكرته. قلت لنارنج» بموت الحكواتي نغلق القوس على انطفاء الحكاية بين زمني أبي خليل القباني والحكواتي، فقد لقيَ أبو خليل القباني مصيراً مشابهاً، حين أحرق الدهماء مسرحه، فاضطر إلى الهجرة من دمشق إلى القاهرة».
واجه السيناريو خلال مرحلة التحضير هزّات متتالية، نظراً لتضارب الآراء في الورشة، فبعد الاتفاق على تصوير سميح عطا بين أطلال بيت أبي خليل القباني الذي تحوّل إلى مكبٍّ للقمامة بدلاً من أن يكون متحفاً، طبقاً لوعود رسميّة متكرّرة، ثمّ الانتقال إلى المسرح، فضّلت نارنج عبد الحميد التصوير في المسرح فقط، بقصد تأكيد فكرة اللجوء والعزلة والوحشة.
على غرار ما يفعله في العادة، مساء كل يوم، أحضر سميح عطا إبريقاً من الشاي وجلس أمام واجهة المسرح يتأمل حركة الشارع شبه المهجور. تذكّر بائع الورد المواجه للمسرح الذي أغلق محلّه بعد أشهر من اندلاع موجة العنف وهاجر إلى السويد، كما استعاد صورة ندى وهي ترفع ثوبها إلى ما فوق ركبتيها أثناء شطف درج البناية المقابلة، صبيحة كل يوم سبت، واضطراب ركبتيه وهو يعترف لها برغبته في الزواج منها، إثر نظرات متبادلة بينهما، وملامسات عجلى، في مدخل البناية، أو في الميكروباص، فهما كانا يسلكان خط سير واحداً إلى إحدى الضواحي العشوائية عند تخوم دمشق» أهديتها ورداً لم يكن لي، لكنني أشعر بندمٍ لا يغتفر لأنني لم أدعوها مرّة واحدة لحضور عرضٍ مسرحي طوال حياتنا معاً، كما أنني لم أتمكّن من زيارة قبرها لصعوبة الوصول إليه». ارتبك سميح عطا خلال التصوير. طلاقته الشفوية لم تسعفه أمام العدسة، فكان لابد من إعادة تصوير اللقطة أكثر من مرّة. كان المشهد ينتهي بدويّ قذيفة قريباً من المكان، فيضطر إلى حمل إبريق الشاي واللجوء إلى الداخل. اختفى في غرفة الملابس، وحين خرج بعد دقائق كان يرتدي أغرب زي في العالم. عمامة ابن خلدون التي استعارها من مسرحية «منمنمات تاريخية»، وذقن» طرطوف» من مسرحية موليير، ومعطف وجزمة الجنرال من مسرحية»العائلة توت». لم يبرّر هذه الخلطة العجائبية من الأزياء، لكنه أوضح أن هذه الشخصيات تركت وجعاً لا يُنسى في روحه. وقف حائراً فوق الخشبة، فيما كانت الكاميرا تدور. مرّت دقائق من دون أن ينطق بكلمة واحدة. تبخّرت محفوظاته فجأة مثل تلميذٍ مضطرب في امتحان. تلاشت الكلمات في صمت الصالة. كانت عيناه معلّقتين بصورة أبي خليل القباني المثبّتة في عمق الخشبة، وبدا كأنه يستنجد به في استعادة ما كان يردّده بطلاقة أمامه في ليالي وحدته الموحشة. خَلعَ عمامة ابن خلدون، وذقن طرطوف. مشى بضع خطوات ثقيلة بجزمة الجنرال ومعطفه، وحين يأس تماماً من استعادة النطق، استند إلى الجدار، تحت صورة أبي خليل القباني مباشرةً، وجثا على ركبتيه، وكأنه في صلاة.
خرجنا من المسرح على أن نعود مرّة ثانية. كانت نارنج غارقة في خيبتها، وهي ترى فشل حلمها في تحقيق فيلم. قلت لها ونحن نجلس إلى طاولة في ركن من مقهى الروضة» لكلّ منا بروفته الأولى المحكومة بالفشل غالباً، أما سميح عطا فلشدّة شغفه بشخصياته المفضّلة فقد أضاع بوصلته، ثمّ هناك سبب آخر، فهو لم يستطع ترميم المسافة بين لغة فصحى لا تشبهه، وعاميّة يفكّر بها. عليك بتكرار التجربة معه».
بقصد تخفيف توتّرها، صرفنا الجلسة بإنشاء مقارنات مسلية في لعبة أضداد لغويّة، كأن نفسّر كلمة ما بعكس معناها الشائع. أن نطلب زيت الخروع، ونعني به القهوة مثلاً، وأن تذهب عبارة «أنا أكرهك» إلى باب « أنا أحبك»، وأن تعني كلمة» رعاع» صنفاً من النبالة، أو أن تكون الحرب نوعاً من الثمار الاستوائية.