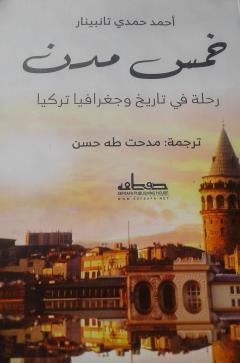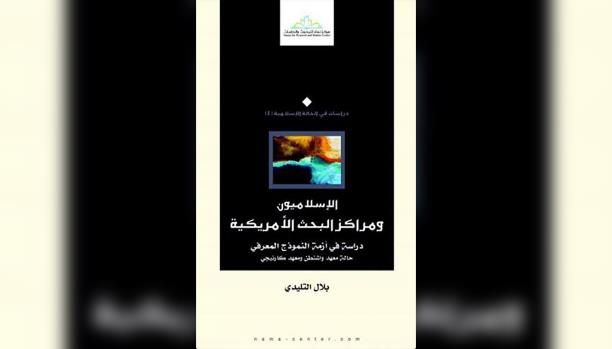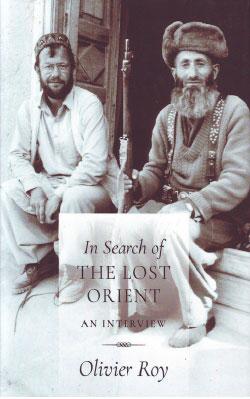فصل من كتاب المفكر الكبير وضّاح شرارة “ترجمة النساء”: أبو نؤاس واختلاط الشعر والرغبة

يأتيك وضاح شرارة دائماً من تنتظر أو لا تنتظر. يفاجئك ثم لا يفاجئك، حيث للمفاجأة دويها، و»شرارها»: من كل الأمكنة ببوصلة مفتوحة، على قدر ما هي موجهة. على امتداد أكثر من أربعين عاماً، وهو على حراك. حراك قد لا يصل وقد لا يصل، لكنه يصيب في كل الحالات، حيث يجب أن يصيب، ويمضي لكي لا يمضي، لكن في الحالين، لأنه يمضي إلى حيث يريد. يتكهن من باب العلم، ويعلم من باب الحلم، ويكسر حيث يصح الكسر، ويتوغل حيث الأسرار حية على يديه، تنكشف مغاليقها، وتهتز أقدارها وقراراتها. من السياسة اليومية يرفعها إلى مستوى المسائل. ومن المسائل الكبرى يغرسها في أرضها؛ ومن الأفكار يحصنها دائماً من الإيديولوجيا، ومن طيشها، وتجريديتها، وقهرها، وسمّها، وتفصيلها العالم على مقاس الجدران الوهمية. تسقط الإيديولوجيا الشمولية منها، والطائفية، والعائلية والجغرافية، والدينية، لتنتصر الأفكار، تحدث الإيديولوجيا وتذر أفكارها: تتفكك أبجديتها وتلتحم في مفرداتها. إنه «المشاكس» في زمن الاطمئنان، الثوري في زمن الركون الشجاع في زمن الخوف، المواجه في زمن الخطر. كأنما، الخطر رفيقه في «عزلته» المأهولة بالهواجس، والأسئلة، والكسر، والكشف، والقلق، والأرق. من السياسة إلى الطائفية، ليفكك هذه الأخيرة بنظمها وبعلاقاتها، وامتداداتها، وجنونها، وخنوعها، ويقارب الشعر من باب الولوج إلى بعده، ويحتضنه من باب تعريته من نوافله. ويصادق الفن من باب اختراقه، لكن بشفافية جارحة، والجة، مفضيّة إلى ما يفتح ألوانها على ما خلفها، وعجائنها إلى صفاءاتها المتحركة…
كثير وضاح شرارة. ومتعدد. وخصب في الاثنين، ومستقرئ، ومتوهج، وغامر على غير انفلات، وخاص على غير تقوقع، وعابر إلى غير محطة.
إنه الشغف بالكتابة. بالحقائق الخلفية. بالوقائع الموحية. إنه الشغف بالبحث، الذي إن وصل لا يصل، وإن لم يعد… فقد وصل. وكل وصول عنه عابر إلى وصول، وكل محط مفتوح على كل الجهات.
يكتب بلغة الأعماق، فكأن العبارة تصير الفكرة، والتأويل يصير ضوء العبارة، والخروج على السائد، وعلى خمول الكتابات الصحافية وحتى الفكرية، يصبح كشفاً، وتجديداً، يجافي الكليشيهات، والأنماط التعبيرية.
وعندما يعيد نشر مقالاته وأبحاثه عليك أن تنتظر أيضاً أن يتفتق الكثير من جوفها، ومن تحافيرها، ومن بين أحرفها وسطورها.
صدر له «ترجمة النساء»، حواش على بعض أخبارهن وأحوالهن (وآه من النساء يا وضاح!)، (عن رياض الريس للكتب والنشر 340 صفحة)، ويتضمن نصوصاً، سبق أن نشرت في دوريات ومجلات عدة وقد اخترنا من الكتاب فصلاً، هو من أروع فصول الكتاب وأحبها إلينا: «أبو نؤاس واختلاط الشعر والرغبة».
ب.ش
يقول أبو نؤاس في ساق من سقاته: إنه «يزوّج الخمر من الماء». ومثل هذا التزويج سائر مشهور حتى الابتذال. فليس هو ما يستوقف ويدعو إلى النظر أو إلى المسألة عن موضع الحرام من أشعار النؤاسي وعن علله. والحق أن أبو نؤاس ونحمل الإسم على الوحدة وعلى المنع من الصرف لا يحمل هذا التزويج بعينه، لا على الإتيان بجديد لم يأتِ غيره بمثله، ولا على غير المسبوق. فهو يجريه على معهود المعاني والقريب المتناول منها. والتزويج، أو المزاج، يقوم من شعره مقام الرسم أو المثال الذي تحتذي «المعاني»، وهي ما نسميه اليوم الصور، عليه. فتوليد المعاني إنما مثاله، النؤاسي، هو التزويج. ورأس التزويج، إذا جازت العبارة، هو تزويج الشعر من أحكام العمل أو المعاني التي تحكّم في ما هو مأمور به أو منهي عنه. وعلى نحو ما أن تزويج الخمر من الماء هو حال من أحوال الخمر، وليس أبداً من أحوال الماء، فتزويج الشعر من أحكام العمل، أي من «ثقافة» الناس في الثلث الأخير من القرن الثاني للهجرة وأوائل القرن الثالث، هو من أحوال الشعر النؤاسي، بل من أحوال الشعر عامة ومن غير تخصيص.
فإذا «تجاوز» أبو نؤاس «الحد»، على ما يقول التقديم الخاطف، ينبغي حمل «تجاوزه» على هذا: أي على مبالغته في إدخال غير الشعر تحت الشعر وفي حد الشعر. فهوي سعى في صوغ الدين والخلق والذوق والعصبية والحرب أو المُلك (أو السياسة) صوغاً شعرياً، وذلك من طريق حملها جميعها على الشعر وعرضها على أحكامه ومعياره. فالشعر، على هذا، معيار عام. وعمومه، على زعم أبو نؤاس، يضاهي عموم الدين، أي الإسلام. فلا معنى من المعاني التي تنتهي إلى علم الناس، وينظرون فيها ويقضون بقضائهم، إلا وللشعر فيها مذهب ونحلة ورأي. فالشعر حاسة من حواس الإنس، وميزان يزِنون به الأشياء كافة. ففي وسع الناس، بل من فرضهم، على زعم الحسن بن هانئ، وأوجب فروضهم، أن يؤوّلوا العالم على وجه الشعر، وأن ينشئوه ويجددوا إنشاءه على مباني الشعر.
[ أشعار ماجنة
إلا أن هذا المذهب يفترض أن يقوم الشعر بمثل الزعم الذي يزعمه أو يُزعم له، وأن ينهض به. وهو يفترض حداً (تعريفاً) للشعر يقوم بزعمه العموم ويحقق هذا القيام. والتماس هذا الحد في أشعار النؤاسي الماجنة، أو «المحرّمة» على صفة دار النشر (وهي صفة غير دقيقة على ما نرى من بعد)، هذا الالتماس لا يصح أن يكون على نحو التماس المفهوم المجرد أو النظري في كتاب موضوع على النقد أو على الجماليات. فأبو نؤاس ليس ناقداً، بديهة، بل هو شاعر محض. وهو يُعمل في قصائده وأبياته «فكراً شعرياً» (سبق مؤرخ تصوير القرن الخامس عشر الإيطالي، الفرنسي بيار فرانكاستيل، إلى الكلام على «فكر تصويري»)، أي مباني شعرية يجوز حملها، بعد تخليصها من أشعاره وقصائده وأبياته، على حد للشعر أو تعريف له. وهذا من غير شك عمل الناقد أو الكاتب في فن الشعر. وهو عمل متأخر عن الأشعار نفسها، ولا يزعم تفسيرها، ولا يطمع في القيام منها مقام الشاعر، صاحبها. فمثل هذا العمل إذا انتهى إلى غايته أو قدّر له أن ينتهي إليها أو إلى بعضها، قصاراه ان يقتص أثر الإنشاء الذي يسميه شعرياً، غير متنكب الهيهية أو إضافة الشيء إلى نفسه من غير وسيط يوسّع مُدركه ومفهومه، وقصاراه اقتصاص أثر الإنشاء في القصائد والأبيات التامة والناجزة.
ويتحقق اقتصاص أثر الإنشاء، ومثالاته في الجواب عن السؤال: على أي وجه، أو وجوه (الجمع أصح)، تتناول أشعار أبو نؤاس ما تتناوله، وتدل عليه بدلالتها هي؟ وعلى أي وجوه تصوغه فإذا به يُدرك على الصور التي تصوغه عليها وكأن هذه الصور، حقيقة، صور موادها وقوة هذه المواد وسلطانها؟
ولا يشك أبو نؤاس في أن الشعر «من عقد السحر»، مصدقاً قول التنزيل في البيان وفي السحر والشعر جميعاً. والقرينة النؤاسية على سحر الشعر تمكينه (تمكين الشعر) الشاعرَ من «تليين» الكاعب «ناهدة الثديين من هدم القصر»، إلى أن أجابت وصاله وزارته «مع العصر». ولا يصح «التليين»، شأن السحر، إلا من كائنات مختلطة ومتشابهة، وهي بخلاف الكائنات المحكمة التركيب والتنضيد، في كائنات تشبهها اختلاطاً وتلبيساً، وليس التباساً وحسب. والاشتباه هو صفة الكاعب البرمكية، في القصيدة نفسها. فهي «غلامية»، أي على الصفة التي تختصر فتنة من يفتتن أو نؤاس بهم وبهن، و»مطمومة الشعر» أو مقصوصته. أما هو فليس «حب الكواعب من أمرِ(هِ)» ولا من عادته وسنته. ولا يقبل على وصالها إلا «مع الخمر»؛ فيخلط «الجويرية البكر»، وهي خليط من أمرد ومن بنت، بالخمر، «المبرّدة بريح الشمال» («المشمولة» على ما يقول الشاعر) والصفاء «كالورس أو شعل الجمر»، ليستسيغ وصالها.
وتدوم القصيدة شعراً ورواية و»فيزياء»، ما دام الاشتباه أو التزويج، وما استمر. فإذا تواصلا وتجامعا فارتد هو رجلاً ذكراً، «غازياً» على ما يقول في البيت الأخير من القصيدة، وصارت هي إلى صفتها الأنثوية واستقرت عليها، فإذا بها «لجة من لجج البحر» و»غمر» و»قعر» تبدد المزاج والتشابه، ورجع كل جوهر إلى ماهيته الثابتة والمحكمة: فسكت الشعر، وانفض الخبر وروايته، وتمت القصيدة. فكأن مبنى الشعر وصفته الشعرية، ومبنى الخبر وروايته و»ميقاته» (أو زمنه)، واحدٌ لا ينفصل ولا يتجزأ. والاثنان، والقصيدة صورتهما، مبناهما على الاشتباه، أي على احتمال معان كثيرة ومختلطة. فإذا غلب عليها معنى واحد بطل الاشتباه، وتبدد، وحل المحكم، ونثره ويقظته، محل الاشتباه.
ويتصور الإبطال، في القصيدة، في تبديد حل الشبهات وانتفاء الكثرة من الدلالات: فلا اثر بقي لنهود الثديين، وتزويق الأصداغ، وطمّ الشعر، والخنث الغلامي، وغيّبته المناطق (ما تشد به المرأة وسطها) من لطف الخصر، وحسن الوجه، وقبول التليين، والسحر بالشعر، والإجابة، والإقبال على غير ميعاد… فهذه كلها، وهي سياقة القصيدة، تخصّص البرمكية كنحو ما تخصص الشاعر «الكلِف» بها زمناً. فيخرج الاثنان، الشاعر ومن يهوى، من العموم إلى الخصوص، ومن التسمية إلى الهوية الخبرية، من طريق التشابه ومن طريق ما يتفرع عليه من شبهاته وكثرة دلالاته. فإذا كُشف التشابه، وانجلى عن معان واضحة، آذن الشعر بالانصرام، ووقعت الرواية، ومعها استعاراتها ومجازاتها، في الكنايات التي لا تحتمل التأويل لأنها من باب التشبيه البسيط والمباشر. يقول أبو نؤاس:
فصحتُ أغثني يا غلام فجاءني
وقد زلقت رجلي ولجّجت في الغمر
فلولا صياحي بالغلام وأنه
تداركني بالحبل صرت إلى القعر
فيكتب المحقق في الهامش: «الحبل: كناية عن عضو الغلام». وجواز مثل هذا الشرح المعجمي للكنايات إنما تبعته على الشاعر، فهو من يحمل عليه ويستدرج إليه.
[ هجاء وأشباهه
والتخصيص من طريق التشابه أصلٌ في شعر أبو نؤاس وركن. والحق أنه أصل شعري، تولّد المعاني عليه، وأصل حقيقي يسم بميسمه الكائنات والحوادث التي يقع عليها الشعر ويتناولها.
فقارئ «نقائض» جرير والفرزدق، على وجه التمثيل، وهي من أبذأ شعر التهاجي والتعريض بالأمهات والآباء، لا يقع إلا على «العلجان» وقذارتها وضخامتها ويسر مباشرتها لمن أراد، إلخ. وأبو نؤاس لا يعفّ عن مثل هذه البذاءة، ولا يرتفع عن مثل هذا الإسفاف. فهذا فن، أو باب، من فنون القول وأبوابه. لكن النؤاسي لا يقتصر على مطالب الباب المعروفة والمكررة، وإن مرّ بها وتعرّض لها. فيقول في هجاء زنبور، ناسباً إلى نفسه مجامعة أمه، إن أم زنبور بعد الجماع تمسح ذكره «كأنه أصغر أولادها». ويقول في هجاء، مزعوم، لكاتب يلوط به إنه يمسح ذكره «كأنما يمسح رأس اليتيم». ونسبة مثل هذه الابيات إلى «الهجاء» على نحو ما تنسب «النقائض» إياها، قرينة على ضيق الأبواب المعروفة والسائرة عن الاتساع لمناسبة مثل هذا الشعر، وقرينة على نبوها عنه. فهو، أي هذا الشعر، يخرج عن المطالب الشعرية البسيطة، ولا يفترض شأنها مثالات عامة وواحدة لا يحيد عنها الشعر إذ يطرق هذا الباب. وليس اضطراب الإدخال تحت باب الهجاء، في المعرض الذي نتعرض إليه، إلا أمارة على تناول أبو نؤاس المثال المعروف على وجه يخالف المتعارَف والمألوف. فسمحُ المرأة الذكر بعد الجماع مسحَها أصغر أولادها ينم بانقلابها من اغتلام الشهوة وتغييبها الذكر في رحمها وأحشائها إلى برد الأمومة وسلامها وانفصالها؛ والاغتلام والبرد موضوعان على شيء واحد (وهي صفة التشابه). فإذا تناول أبو نؤاس الرجل عوض المرأة جعل رأس اليتيم محل المسح، وقلب قصور من يُلتاط به، ديناً وتكليفاً، إلى تمام شرائط التكليف في الوصي على الأيامى والقاصرين. وهذا ليس من «الهجاء» ولا من بابه ومطلبه، في شيء.
والتمثيل على التخصيص الشعري من طريق التشابه بأبيات مأخوذة من الثلث الأول من مجموعة الأشعار هذه والثلث الأول، إلى حوالى الصفحة الخامسة والخمسين، معظم أبياته و»قصائده» (أو مقطوعاته) قريب إلى فن القول التقليدي والسائر، وهو من سقط الشعر النؤاسي مثل هذا التمثيل لا يستوفي ما يمثل عليه.
ففي موضع آخر يتعقب أبو النواس استعارة الظبي للولد «الخماسي»، وهو الولد الذي شبّ ولم يبلغ، فيبدو له الولد، شأن الظبي، رأس الاستعارة، «سانحاً». فيجاري «الظبي السانح» مثال الاستعارة ويجري على عمودها المعروف. وهذا هو الوجه «الجميل« من الاستعارة، إذا جاز القول، والمراد أنه الوجه «الجميل» من تحقيق الاستعارة أو صرفها إلى الحقيقة. وهو ما يقف عنده قوالة الشعر والمتقيدون بمطالب أبوابه. وأما أبو نؤاس فيتجاوز المطلب، أو وجهه المطمئن، إلى تمام الاستعارة، أي إلى اختلاطها واثنينيتها المقلقة. فالظبي، الولد، أمكن الشاعر طوعاً «عنان قياده»، وعوض أن يؤدي التمكين والطوع إلى المتعة خال الشاعر الولد «ظبياً واقفاً ليس يبرحُ». ومثل هذه الوقفة من الظبي، الذي كان للتو «سانحاً» ومبادراً إلى التمكين من قياده، يسري فيها انسلاخ ناظر الموت من نفسه، وتسري رهبة فاقد ركن من كيانه، فكأن الفلاة، مرتع الظبي، ضمرت بعدما أخرجها «الوقوف» من مقدور الظبي ومن رغبته، فبقي هذا حبيس نظره الموت، وحبيس الخوف وطغيان الذكر «الغازي».
[ شهوة العين
فالمتعة الحق التي ينشدها عاشق المرد والغلاميات والخنث من المراهقين والأولاد والجويريات، وهي المتعة المناسبة غاية هذا العاشق حقيقة، هي متعة النظر إلى الشعر و»التليين» به وقوله. فالنظر، وليس عمل «النكاح« ولو وقعت عليه حيعلة، هو مستودع التشابه والتلبيس، وهو حافظهما وابو النواس إذ يطنب في الكلام على متعته وعلى حر البنات والأمهات. أو على فقحات الأولاد والغلمان، يقتصر «شعره» في هذه، اي في الحر والفقحة والحلقة، على فعل أو فعلين، وعلى اسم أو اسمين. وبديهة، ليس مبنى الشعر، ولا مبنى ما ينحو نحوه ويذهب مذهبه، على الفعل أو الفعلين ولا على الاسم أو الاسمين؛ فالفعل أو الاسم، بهذه الحال وفي هذا المعرض، يقومان بنفسهما ويكادان يتحرجان من العبارة أو الجملة التي يساقان فيها وينتحيان منها ناحية، فكأنهما الدال والمدلول جميعاً، وكأن دلالتهما اجتمعت فيهما فلا تدين الدلالة هذه بدلالتها ووقعها واقيستها إلا للكلمة نفسها (فعلاً أو اسماً). لذلك قلما حمل الشاعر على الافعال والأسماء هذه غير خواتم اشعاره وغير «شعاراته» و»حكمه»، ومعظمها محاكاة مقلوبة ومعكوسة لشعارات القوم وحكمهم. والكلام على مجون الحسن بن هاني أو على خلاعته وبذاءته، انما يقصد به مثل هذه الابيات والأشعار. وهي بلا ريب أكثر اشعاره شهرة وتداولاً على ألسنة الناس، ولعل بعض السبب في ذلك تعمد ابو نؤاس نظمها على بحور مشهورة ومتداولة «صبت» فيها معاني مخالفة هي المعاني السائرة والمقبولة من القوم على الملأ وجهاراً.
وعلى خلاف زعم «الحكمة» التخفّف من الوقت والمكان، وهما عمدة الحس والمحسوس، وأطراقهما، يقبل الشعر عليهما وينيط بهما عمله وشغله، والنظر، من بين الحواس، مبنى التلبيس والاحتمال، واستعاراته من أقوى الاستعارات تشابهاً وغموضاً. ويبعث النظر، أو شهوة العين، الشعر على مواضع وأمكنة لا يتردد اليها شعر المطالب المعروفة، أو الشعر الذي يدعو إليه «المسلطون». ومن هذه الأمكنة والمواضع الحمامات:
وفي الحمام يبدو كل مكنون السراويل
فقم مجتلياً فانظر بعيني غير مشغول
تر ردفاً يغطي الظهر من أهيف مجدول
فالحمام، على هذا، «مصوغ» من تمتع النظر أو كأنه هذه المتعة «صبت: فيه «من قرن إلى قدم»، على قول النؤاسي في شعر مثال أشعار على شاكلته، فالنظر موضوع على باد ظاهر، من وجه، وعلى مكنون مستتر، من وجه آخر. وقسمته هذه مبعث قيام وسعي فاجتلاء فنظر بالعينين. وشرط حسن المآل، إثبات النظر ما ينظره، هو الخروج من الانشغال. فالنظر ان لم يكن «غير مشغول» صرفه شغله او انشغاله الى معاملة الشيء كلاً وعملاً وأداء. والنظر «المشغول» بالشيء يقدم الشيء على النظر، فيما الشيء النظر، وهذا من معاني «الشغل». وأما الارتفاع عن الشغل والانشغال فصفة الشعر (والفن عامة)، وصفة النظر على وجه الشعر. ومثل هذا النظر، على هذا الوجه، يحضر ما ينظره ويرى اليه وهو لا شيء غير نفسه. فالردف المغطي الظهر ـ وهو لا يغطيه الا اذا رئي الاثنان من جهة مستوية هي جهة الردف ومستواه ـ مخطط منظر. وهو لا يتماسك الا بحركة خاطفة لا تستبقي من الحركة الا فكرتها المحض أو مجرد هذه الفكرة: فالأهيف مختصر المستدق والنازع طولاً، والمجدول يقتصر على العلائق ويطرح مادة يجدلها ويغلب عليها.
ومثل هذا التجزيء للمنظر يسلمه الى لذة ضربها من غير ضرب اللذات التي يستنفدها الباه و»شغله» و»فراغه». ولا يقصد بهذا حمل النؤاسي تعسفاً على ما لم يحمل هو شعره أو نفسه عليه. فهو من غير ريب، مدح «الفراغ على بيض غلام مرجرج الكفل»، ومدح «الجمع»، و»حلّ السراويل»، و»اللعاب» يسيل من الذكر عند البصر بالوجه الحسن، وتغريق «رمح البطن جوف الراح»، و»بعج» الفقحة، والصفان على أربع، والكتابة في الميم باللام.. لكن هذه المطالب والمعاني لا تستوفي كل المطالب والمعاني الشعرية النؤاسية، وليست الألزم بشعر الشاعر والأخص به، ولا تستقيم و»طريقته»، إذا صح ان للنؤاسي طريقة يجتمع عليها أخص شعره وأقواه نسبة اليه.
[ جنس ثالث
وعلى هذا فالعشق الغلامي، على النحو الذي يصوغه الشاعر شعراً مثال عملي وحياتي (وجودي، على المعنى الثقافي والعربي المتعارف) ومثال شعري وجمالي، جميعاً. وما يبعث الحسن ابن هانئ على الانتخاب والاشتهاء والعشق هو عينه ما يبعثه قول شعر نؤاسي يخصه وحده ولا يشاركه فيه أحد من الشعراء.
فالغلمان المرد المحتلمون أو يكادون والخماسيون، المراهقون الخنث من ظباء الدواوين وغزلانها و»نشيها» (منشئيها) وفرسها ونصرانييها ويهودها، والغلاميات المحيرات اللواتي يسألن: (فأبن لي أكعاب/انت أم انت غلام)، هؤلاء وأمثالهم وأولئك وأمثالهن، انما هم ملتبسون وملبّسون ومتشابهون؛ والالتباس والتلبيس والتزويج والتشابه والتجزئة حال من أحوال الكون، ووجوه يدرك الكون (والكائنات أو الأكوان) ويقال عليها، ومن جهتها وقبلها. فأبو نؤاس إذ يقدم أحوال الكون ووجوهها هذه على غيرها ينسب اليها قوة على الشعر ينفيها عن غيرها وينفي غيرها منها. وهو يعارض معارضة كثيرة الأنحاء والصيغ بين مرده وغلامياته وبين «الطمثات» كل شهر والنابح جروهن في كل عام، على ما يقول في النساء ـ وهو يطعن عليهن «جحرهن» البعيد القعر و»صدعهن» و»لجتهن» وأنداءهن.
فكأن التخصيص والإفراد لا يؤاتيان الا المراهقين والغلاميات، ولا يصح المدح بالفرادة الا فيهم وفيهن (وابو النواس يؤلف من الذكورة والأنوثة «جنساً» ثالثاً). فيمدح ابن خرداد فيقول فيه: (… أوحديّ الجلوس فرد القيام)، جامعاً بين الجمال وبين الفرادة وموحداً بينهما. ولا يتأتى مثل هذا الجمع ولا يصح الا على مذهب يرسي الافراد، الجواهر الفرد، على نفسها وينشئ منها معيارها وميزانها وليس من الصور الجامعة أو من المثالات المفارقة.
فالجميل، على هذا، هو البعيد من المثال والاشتراك، وهو البعيد من السوية والقياس. فـ»يمدح» ابو نؤاس من يعشقه بأنه:
ظبي أعار الزمان مقلته
كأنه في جماله وثن
والوثنية هي حمل الشيء على نفسه من غير وسيط. ويبالغ النؤاسي في مذهبه هذا فيوكل الى حبه، الظبي، وهو فرد، إعارة الزمان، وهو مدرك و»مقولة» وباب الى الكون وعقله وقوله، «مقلته» ـ والمقلة هذه تعاقبت اوصافها على شعر النؤاسي، فهي تارة قاتلة وتارة زانية وتارة ثالثة ماجنة وغوية. أما الوثن، على النحو الذي يعرض عليه في البيت، فلا ينعت الا بنفسه. وعلى خلاف الأطلال لا يسند الوثن الجميل الى الزمان وتقضيه، ولا الى التذكر، فسنده هو الآن المخيم والحاضر الغامر. فما لا علة له من غيره، ولا ميزان له الا من نفسه، هو الزمن الحاضر والماثل وقته ومملكته. وصدارة الحاضر والآن الزمن، موضوعة على النظر وعلى المحسوس عامة.
ويصف البعد من المثال الجمال كنحو ما يصف النفس، ويصح في المعاني صحته وصدقه في المحسوس. فيقول أبو النواس ان له «ماجناً غوياً»:
مموه الدين عسكرياً
يعرف بالفسق والنفاق
أما «الأترجة»، وهو الاسم الذي ينادي به محبوباً لا يعرف ما جنسه، فيصفها بالأستاذية في الرهز. والرهز في غير بيت من ابياته من صفات المرد، قبل ان يصفها بـ»سراقه»، وهي من صفات الجواري والنساء. وتشابهها جنساً علم على صفاتها المعنوية التي لا تقل شأناً عن الفسق والنفاق:
ويا خلابة خداعة للقلب سراقه
«ورخيم الدل» المعشوق «مجنوح الكلام»، أو مستعجمه ومختلطه، على ما يليق بالظباء والغلاميات والبرامكة ومن حسنهم حسن «الجن» أو كأنهم:
مجونٌ صب في صنم
مصوغ الطرف من سقم
على ما تقدم (الحاشية الخامسة عشرة)
[ ضد الخطابة
ويضطرب «قوم» الحسن بن هانئ هؤلاء ـ وهم «قوم» جمعهم الشاعر من تقطيع الأواصر والعرى ومن العدوان على المعايير «القومية»، العربية والإسلامية، والازراء بها ـ يضطربون على حدود العمر والجنس والدين واللغة والعبارة واللباس، فيحاكون اضدادهم وخلافهم على تلبيس مقيم؛ ولا يبدد هذا الالتباس الا الامتحان الأخير أو «العمل»، على قول الشاعر، وهو خارج الشعر وخارج الرواية والقصص، على ما مر وتقدم. ويتطاول الاضطراب، وهو اسم آخر للتشابه، الى الخلق نفسه ومادته: فـ»الغزال» النؤاسي ليس مخلوقاً «كخلق الناس من طين»:
ولكن صيغ من مسك
وأنواع الرياحين
ربما في جنة الخلد
مع الحور، بها، العين
ولا يعف الشاعر عن قسمة الليل والنهار، والحلم واليقظة، وقسمة التذكر والبصر، وإبليس والملك، والجميل والحق، والتخييل والادراك. فيحمل ابو النواس وجوه القسمة هذه كلها على الاصطناع والتعسف اللذين اثبتا الانسي ذكراً وأنثى وأخرجاه من الاحتمال والتشابه الى الأحكام. فأحد صبيانه يزني الناس به بعيونهم، ومقلتا الظباء والجواري الزنا بعض فضائلهما، وهو (الصبي) لو مر بالناس «نائمين لاحتلموا». فالصبي يتنقل بين النوم وبين اليقظة من غير حرج ولا احالة، شأن الناس، ولا شرط لجواز التنقل الا الاشتراك في معدن الاستهامة والشهوة والشعر. وعلى ذمة هذا الاشتراك يقول الشاعر لاحدى غلامياته (../فجودي في المنام لمستهام)، فلا يحجز بين المنام وبين اليقظة حاجز تعتد به الاستهامة ويعتد به الهائمون. ولعل امتياز الخمرة، موضوعاً عليه النؤاسي الشعر شأن امتياز المرد والغلاميات، مصدره خلط شاربيها الليل بالنهار، وخلطها هي في عقولهم وحسهم اليقظة بالمنام، والذكورة بالأنوثة..
وعلى هذا، فالمجانسة الشعرية مبناها على الحقيقة وكيفياتها. وليس على الشعر النؤاسي، وهذا هو السبب في نسبته النؤاسية وفي تخصيصه بها، الا تجنيس المتجانس حقيقة وخلقاً، أو قوله. فتنشأ عن هذا بديهة شعرية يقوم في مقابلتها، ونظيرها، ما تسميه رطانة اليوم «عالماً» شعرياً يسوي أشياءه وافراده، من كنايات ومجازات واستعارات و»صور» ومفردات وروايات وبحور، على شاكلة يختص بها هذا «العالم» ويبنى من غيره وسواه. فتتناول البديهة النؤاسية ما تتناوله على وجه الجناس (أو المجانسة) فكأن الجناس صفة الشيء في نفسه أو كأن المخلوقات سوية على اضطراب.
وبيض من زجاج الشا
م لا بيض الصفاح
وبسمر من ملاء
المسك لا سمر الرماح
فالعودة من الخطابة العربية، وتحجرها على استعارات بعينها حربية أو دينية (مثل: بيض الصفاح وسمر الرماح وغض الطرف عن الجارة وكؤوس المنايا وظبى المشرفيات والمناظرة في تفضيل عثمان او علي..)، هذه العودة تفك الاستعارات من عمودها ومثالاتها الثابتة. فالأبيض ليس اضطراراً لون الصفاح ولا السمرة لون الرماح، والمقلة لا يعيرها الولد للغزال والظبي وليست وقفاً عليهما فربما للزمان مقلة، والتصاوير للمنطقات من الجامات، وليست للطلول وبقايا الدار المقوية، والدر من الكلام قد يكون نثراً غير فصيح أو «مجنوحاً»، اما المشعر والركن والحرم فأسماؤها غير اسماء التنزيل والسنن والآثار، والديار ليست في شيء ديار دارم وبكر وتميم ولا البلدان بلدانها..
فاذا حمل ابو نؤاس الأعمال والكلام والاعتقاد والأخبار والاشياء والناس على التمويه والتزويج، اي على وجوه التشابه، أخرجها من حد السلطان، وهو حد العصبية والحرب والدين والتناسل وعمود الشعر الى حد «العيد» و»المنية» و»الأوحدية». وإخراج الأعمال والكلام من حد إلى حد، في أواخر القرن الثاني للهجرة وعشية الحرب الأهلية العباسية الاولى، ثورة عامة على أركان حضارة عربية إسلامية كانت بعيدة من التمكن يومها. فتقديم الأمين على المأمون تعلل بنسب الأمين العربي والقرشي، اباً وأماً، على حين كان المأمون لأم ولد. وكان إسلام الفقهاء يشحذ اركانه السنية واعتقاده قبيل اغلاق باب الاجتهاد. واذا صح وصف عمل ابو نؤاس، اليوم بـ «الحداثة»، وهو صحيح على زعمي، فالسبب فيه هو رفع التهجين الى مرتبة مدرك من مدركات العقل الكثير الأوجه وطرق العمل والموضوعات.
المستقبل