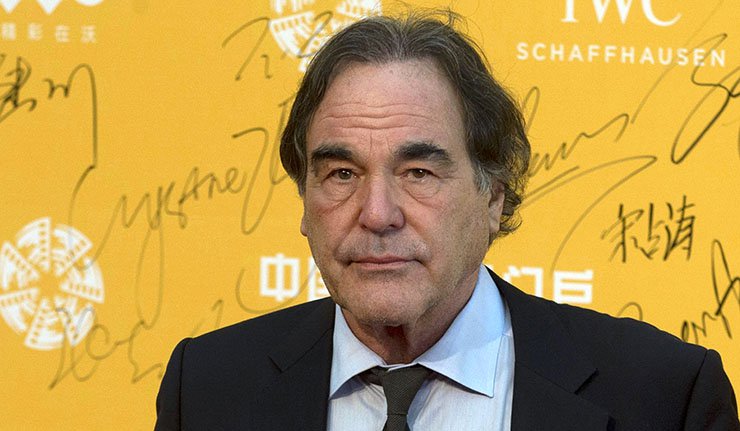فيلم ‘العودة إلى حمص’: عن التحديق الطويل والشجاع في عين الموت/ زاهر عمرين

‘ôالمدينة التي كنتُ أعبر طريق السفر من جوارها، إلى منزلي في دمشق سابقاً، دون أن أفكر مرة واحدة أن أدخلها، المدينة التي أصبحتْ أغلى ما أملك، المدينة الأسطوة خلفي، ولا شيء بعد اليوم يعوض هذه الخسارة’..
‘توقّفْ.. إبقَ بجانبيô عانقني مجدداً أطول فترة ممكنةô’
بهذه العبارات يفتتح المخرج طلال ديركي فيلمه التسجيلي الطويل ‘العودة إلى حمص’ ليروي خلال تسعين دقيقة قصة ثورة ومدينة، مستنداً إلى حكاية واحد من رموز الثورة السورية، المغني وحارس المرمى الأشهر ‘عبد الباسط الساروت’ وزميل دربه ‘أسامة الحمصي’ الناشط السلمي البارز، راصداً الحياة اليومية في حمص المحاصرة على مدى ثلاثة أعوام.
منذ المشاهد الأولى يحرر الفيلم نفسه من اللهاث وراء النتائج، ويلتفت للبحث في الأسباب، فالنتائج ماثلة أمامنا وجهاً لوجه: شوارع مهدمة، أبنية كاملة تحولت إلى أكوام من الباطون والإسمنت، حرائق تنبعث من شرفات المنازل. خراب ممتد بلا نهاية يذكر بصور ستالينغراد بعد الحرب العالمية الثانية.
كل تلك التفاصيل وغيرها كانت قد غزت شاشات الإعلام من قبل، لكن حدة الصورة وكثافة اللقطات وتتابعها السريع والمحبوك في فيلم ديركي، تتركنا أمام حقيقة قاسية واحدة: لقد صارت حمص مدينة أشباح.
من صور الدمار الحزينة ننتقل إلى بداية الحكاية، إلى شوارع المدينة التي تحتفل بالساروت ويحتفل الأخير بها. حلقات الجموع التي ترقص على إيقاع أغاني الحرية. حارس منتخب ‘الكرامة’ يعتلي الأكتاف بجذل، الأيادي تتشابك، صوت الطبل، كاميرا ‘أسامة’ الناشط الوسيم، تصور كل ذلك وتبثه إلى العالم.
صورة مثالية لثورة مثالية. ذلك ما نلمحه في عيون الناشطين وهم يرتبون أماكن التظاهرات، في حماسهم وحزنهم وهم يتحدثون عن شهيد سقط وهو يحمل لافتة كتب فوقها كلمة واحدة: ‘سلمية’، في غنائهم المسائي العذب، وفي أيدي الأطفال وهي تحاول الوصول إلى ‘باسط’ مغني الثورة النجم آنذاك.
لكن النظام لا يعجبه ذلك، يتدخل في المشهد ويبدأ عملية عسكرية شرسة في الأحياء الحمصية الثائرة.
يتوارى الساروت عن الأنظار بعد أن يصبح المطلوب رقم واحد في المدينة، يقتل أخوه، ويدمر منزل العائلة التي هُجّرت كلها. لكن ‘باسط’ يبقى متشبثاً بخياراته، فيما ‘أسامة’ مشغول برصد حصاد القناصين اليومي، شهداء الحواجز والمظاهرات الليلية.
تتوالى الأحداث بسرعة لتصبح المدينة تحت حصار محكم، ولتصبح محاولات الاحتجاج السلمي ضرباً من ضروب الانتحار الجماعي المحتم.
العالم أغلق عينيه وأذنيه عما يجري. علا صوت السلاح وخبت الأصوات الأخرى بفعل عنف النظام.
الساروت الذي كان يغني، صار يقاتل، لكنه بقي يغني كلما أسعفته فسحات الحياة التي تضيق أكثر فأكثر على الجبهات.
يترك الفيلم الساروت قليلاً، ليرافق ‘أسامة’ في مهامه اليومية المؤلمة. من معبر الموت إلى المشفى الميداني، هناك حيث نراقب عن قرب رجلاً مسناً يحطم كرسياً بغضب وهو يصرخ بألم مخنوق ‘تقبّل يا رب.. تقبل يا رب’. لقد مات إبنه للتو بين يديه بسبب عجز تجهيزات المشفى الميداني عن إنقاذه من رصاصة قناص غادرة. تسقط دمعة خفية من عين أسامة للمرة الأولى.
في مشهد يرصد مجزرة الخالدية في شباط 2012 للمرة الأولى، نرى من مكان عال أكفان الشهداء، مئات الجثث مكللة بالبياض، مصفوفة برتابة هندسية مستفزة.
يتوالى سيل ثقيل للقطات تنظر في عين الموت، تعاينه عن قرب وتقف في وجهه غير عابئة أو مكترثة، الصورة تبدو صارمة، متماسكة رغم فداحة الحدث، متماهية معه دون أن تخضع لشروطه. سرعان ما يسعفنا صوت المخرج مفسراً هذه الصرامة : ‘انتهى الحلم.. انتهى الحلم بثورة قوامها المظاهرات السلمية’. إذا فهي صرامة الواقع وقسوته مقابل احتمالات الحلم وتشوشه.
تتوالى المجازر والعمليات العسكرية في حمص، يصاب ‘أسامة’ بقذيفة هاون، ويقارب الموت، لكنه ينقذ في اللحظات الأخيرة ليعود لنشاطه الأول مكتفيا بالكاميرا سلاحا أوحد رغم كل السلاح المحيط به.
الساروت يصبح قائداً لإحدى المجموعات العسكرية الصغيرة المرابطة داخل الحصار، لتبدأ بعد ذلك معارك الجبهات والحصار.
يلهث الفيلم وراء إرادة الساروت التي لا تلين بين المخابئ والانفاق وممرات حرب العصابات، لكن رفاق السلاح يتساقطون شهداءً واحدا تلو الآخر أمام عينيه في المعارك وتحت القصف،ويعتقل أسامة على أحد الحواجز ليغادر الفيلم على عجل.
عند هذا المفترق، يصبح إيقاع الفيلم أقل حدة، وكأنه يحاكي اعتياد الشخصيات على الموت اليومي، وعدم اكتراثها بحلوله المفاجئ. ففي احد المشاهد، نرى عبد الباسط وحيداً وهو يحفر قبرا في إحدى الحدائق، قبراً سريعاً لرفيق سلاح استشهد للتو. صمت كثيف يلف المكان، لا يغزوه سوى صوت معول الساروت وهو ينهال بانتظام غاضب فوق التراب، يستمر ذلك للحظات طويلة، ذات الأصوات وذات التكرار الفج، رتابة تسمح لنا بتأمل فكرة الحياة والموت عن قرب كما لم يحدث من قبل، لكن هذا التأمل لا يستمر طويلاً، حيث يخرجنا منه صوت انفجار قذيفة هاون غير بعيد عن الساروت، يتشوش المشهد، يملأ الغبار المكان، وتهتز الكاميرا بعنف، يلتفت الساروت نحو المصور: ‘فيك شي؟’ ثم يتابع الحفر بذات الانتظام الرتيب القاسي، تاركاً إيانا أمام أسئلة جديدة.
‘تعبت يازلمة’ يعلنها الساروت ببساطته وهو ينام جالساً محتضناً سلاحه، توقظه رشقة رصاص بعيدة. يرن تلفونه، يجيب: ‘ ..أي خيتي، آني ع الجبهة، ما عندي تغطية… استشهد مدين’.. ينقطع الاتصال، يحل صمت ثقيل في المكان. حزن كثيف يغزو العينين المتعبتين، شعاع غبار سميك يسبح في خيط شمس خجولة تتسرب من فتحات البيت المهدم. شعرية بصرية خاصة ينطوي عليها المشهد، تتجلى بمتانة أعصاب الصورة وجمالية مفرداتها، مقابل إرهاق الشخصيةوإنهيارها الوشيك.
لكن الهمة لا تخبو. عبر الأنفاق الأرضية يمضي حارس المرمى ‘باسط’ إلى الريف القريب ليجمع الرجال ويخوض معركة فك الحصار. لكن ما الذي يمكن لبندقية أن تفعله في وجه دبابة؟ معركة قصيرة نعاينها عن قرب، كما لم يحدث من قبل، نعاين وجوه محاربيها الذين لا تنقصهم الشجاعة والإصرار. ونعاين عن قرب كيف يمكن للكثرة أن تغلب الشجاعة.
يصاب الساروت. تحفر الرصاصة عميقاً في ساقه، أصبع الطبيب تحاول استخراجها على ضوء البيل، يفعل المخدر ما لم يستطع أن يفعله السلاح من قبل بالساروت. ينهار كلياً، وبين الصحو وثقل المخدر ينفجر بغضب باك محدثا من التفوا من حوله: ‘ياشباب .. مشان الله لا تضيعوا دم الشهداء’.
يغيب الساروت، يلتقي عائلته ونلتقيها، يستعيد عافيته في الريف، يجمع بضعة رجال ويقرر العودة إلى داخل حمص المحاصرة عبر الطرق السرية والأنفاق من جديد.
في اللقطات الأخيرة من الفيلم، نراه متوسطاً رفاق سلاحه وهو يغني بروح عالية وإصرار استثنائي للثورة والحرية والكرامة، يغني وكأنه بدأ للتو، بدأ ثورة جديدة.
إلى جانب جاذبية الشخصيات نفسها التي يرصدها الفيلم عن قرب، بأناة وصبر طويلين، يمكن أن نلحظ منذ المشاهد الأولى بنية سردية متماسكة، قوامها مقاومة إغراء الحلول التقليدية التي تترك عادة لتصاعد الزمن الواقعي مهمة توليد الدراما. بالمقابل يقترح الفيلم سرداً بديلاً قائمة على إعادة تركيب الحدث وفق حركة الشخصيات ذاتها وتتالي حكاياها، فمرة يلتصق بشخصية الساروت،ومرات أخرى يقترب أكثر من أسامة فيكاد يرصد دقات قلبه على سرير الموت، لكنه في كل المرات يبدو متحرراً من عبء حركة الزمن مالئاً فراغاته بتعليق المخرج الصوتي، الذي ساهم أحيانا بدفع الفيلم خطوات إلى الأمام، خاصة في المشاهد التي تتطلب قفزات زمنية طويلة، وأحيانا أثقله بأحمال شعرية غير مبررة.
لكن الفيلم في كل الأحوال يقدم اقتراحاً سينمائيا يترفع الركض وراء تشويق لحظي صادم، متجنباً بذلك الفخ الذي وقعت فيه كثير من أفلام الثورة السورية، القائمة على الالتفات للدرامي المباشر مقابل تغييب للإنساني ببساطته وعمقه. فالفيلم رغم رصده شخصيات ‘بطلة’، إلا أنه يحافظ على مساحة نقدية منها، يرصد أخطاءها وعثراتها، دون إطلاق أحكام أخلاقية عليها، لتبقى مهمة الحكم الأخير عليها للمشاهد نفسه.
يدرك صانع الفيلم ألا مجال للمقولات الكبرى حينما يتعلق الأمر بخيارات الحياة أو الموت، كما أن شخصياته البسيطة والمنسجمة مع خياراتها لا تحتمل مقولات كبرى، لذلك نراه يكتفي برصد تفاصيل الحياة العادية لشبان يعيشون ظروف استثنائية، لكنهم رغم ذلك مصرون على السخرية من كل شيء والمضي في طريقهم. في أحد المشاهد يكتفي أسامة الذي استيقظ للتو من غيبوبة طويلة بزيارة قصيرة لمنزله الذي أحرق عن بكرة أبيه، يأخد منه فنجاني شاي متفحمين للذكرى ويمضي ساخراً. مشهد استثنائي يعكس التخفف من كل إعباء الحياة.
يبدو الفيلم من ناحية أخرى أشبه بجسر يملأ الفراغات بين أحداث زمنية يعرفها السوريون عن ظهر قلب، فبمواجهة مقاطع اليوتيوب المتشظية واللامنتهية، والمشوشة أحياناً، يقترح الفيلم بنية متماسكة، كما لو أنه يربط هذه المقاطع كلها مع بعض في حكاية استثائية، مقدماً رؤية شاملة غير وصائية وغير محملة بالأعباء السياسية، بل مكتفية بالارتكاز على بنية أخلاقية صلبة. في ذات الوقت يبدو متأثراً باللغة البصرية والسمعية لمقاطع الفيديو التي أفرزتها الثورة كالصورة المنخفضة الدقة أو لغة جسد حامل الكاميرا وتفاعله مع الحدث، قد يكون مرد ذلك، كما يذكر المخرج نفسه، إلى أن بعض مقاطعه صورها ناشطون ومواطنون صحافيون.
بالقدر الذي يعنى فيه الفيلم بالحفر في عمق شخصية الساروت، عبر رصد لحظاته اليومية منذ بدء المظاهرات إلى واقع تحوله إلى مقاتل، بقدر ما يحاول عبره رصد ديناميات تحول الثورة السورية من الحراك السلمي إلى التسلح كرد فعل على عسف النظام الأمني السوري.
إذن ليس موضوع الفيلم بجديد على أفلام الثورة السورية، التي نجح بعضها برصد جوانب من هذا التحول سابقاً، لكن فرادة الفيلم تبرز في هذه النقطة بالذات، فهو يقدم الإحاطة الأكثر شمولية ، حتى اليوم على الأقل، لقصة الثورة السورية، متجنباً إدعاء احتكار الحقيقة أو السقوط في فخ المباشرة التقريرية، مستنداً إلى لغة سينمائية متينة تمزج قسوة الواقع بحساسية السرد وشعريته.
ما يحسب للفيلم بجدارة هو اختياره من قبل مهرجان ‘إيدفا’ الدولي، النظير الوثائقي لـ ‘كان’ السينمائي، ليكون فيلم الافتتاح في دورته السادسة والعشرين، وهو الفيلم العربي الأول الذي يفتتح المهرجان منذ تأسيسه. هذا الاختيار سيمسح بلا ريب بوصول الفيلم إلى منصات عالمية مرموقة، وسيسمح بإطلاع جمهور واسع على ‘قصة الثورة السورية’ بعيداً عن طروحات الإعلام السريعة والاستهلاكية.
يذكر أن الفيلم تم إنتاجه في إطار مشروع ‘بلدي’ ـ شركة بروأكشن فيلم ـ سورية، وشركة فيناتا فيلمز ـ ألمانيا 2013.
*كاتب سوري
القدس العربي