“في البحث عن المتوحّش المثاليّ”..حين أضاءت الأنوار وامّـحـى شعب!/ الصحبي العلاني
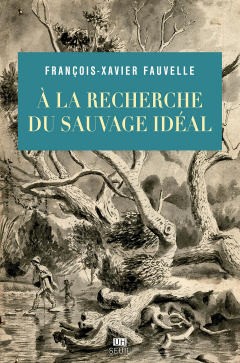
عندما نقرأ الدراسات الفكريّة المعمّقة أو نعود إلى المعاجم الاصطلاحيّة المتخصّصة أو نتصفّح الكتب المدرسيّة المبسّطة (كلاًّ في مقامه وحسب سياقه)، وعندما نسألها تِباعاً عن دلالات ألفاظ من قبيل “الإنسانويّة” و”الأنوار” و”العقلانيّة” و”الحداثة” وما شابهها وجرى مجراها من جليل المقولات وشريفها؛ فإنّها لا تسوق لنا – في معظم الأحيان – إلاّ ما يُحَسِّنُها في أذهاننا وما يجعلنا أميل إليها وأقرب إلى اعتناقها والتسليم بها.
ليس في الأمر – من حيث المبدأ – ما يدعو إلى الاحتراز أو ما يدفع إلى الحذر. فقد أضحت “الإنسانويّة” و”الأنوار” و”العقلانيّة” و”الحداثة” وغيرها من المقولات والمفاهيم عنواناً على الانخراط في العصر؛ بدليل أنّ معظم الأمم تتسابق في تبنّيها، وأنّ جلّ الشعوب تطمح إلى بلوغها، وأنّ غالبيّة الثقافات تحرص على تكريسها.
ولكنّ العمل الجديد الذي وضعه الكاتب الفرنسيّ فرونسوا غزافيي فوفال والذي أصدرته مؤخّراً دار سوي الباريسيّة للنشر (أغسطس/آب 2017) تحت عنوان “في البحث عن المتوحّش المثاليّ” لا يمكن إلاّ أن يُشكّل صدمةً عميقة تحمل القرّاء حملاً على مراجعة هذه المقولات، أو هي تدفعهم إلى الوعي بضرورة تنسيبها.. وذلك أضعف الإيمان! لا لشيء سوى أنّ التأسيس النظريّ لما صار يُعرف اليوم بـ”العصر الحديث” يُخفي – في الواقع وعلى الأرض – مآسِيَ شعوبٍ دفعت من لحمها ودمها ثمناً باهظاً حكم عليها التاريخ بعده بالتبخّر والامّحاء، وبالغياب والاختفاء!
ملاحظات أوليّة.. عن أفريقيا المنسيّة!
قد تبدو ملاحظاتنا السابقة عن “الصدمة” التي يمكن أن يُحدثها كتاب فرونسوا غزافيي فوفال في قرّائه، وعن “المراجعات” التي تستدعيها مضامينه، وعن “التنسيبِ” الذي تدعونا إليه محتوياتُه، من باب المبالغات الأسلوبيّة أو من قبيل الشطط في التقييم. ولكنّ الحقيقة غير ذلك تماماً. فلا بدّ لنا من الإقرار – بمنتهى التواضع المعرفيّ وبأقصى ما تفترضه فينا النزاهة العلميّة – بأنّنا مُقصّرون تقصيراً بالغاً في متابعة ما يصدر ضمن حقل “الدراسات الأفريقيّة”. وهو حقل قد يبدو في نظر الكثيرين حديث النّشأة، طارئا على الدراسات العلميّة الأكاديميّة لا يعود – من منظور التتبّع التاريخيّ للموادّ العلميّة التي صِيغَتْ في نطاقه – إلاّ إلى سنوات الثلاثين من القرن العشرين. ولكنّه في الحقيقة – وعلى عكس الرأي السائد – حقلٌ متجذّرٌ في اهتمامات الدارسين من مختلف المشارب.
ولأنّ مقامنا هذا لا يسمح بإفاضة القول في عراقة “الدراسات الأفريقيّة” وفي بيان أصولها المعرفيّة التي تعود – في تقديرنا – إلى ما قبل ثلاثينيات القرن المنصرم، فإنّنا سنقتصر على إشارة موجزة نعتقد أنّها كافية في الدلالة على ما نريد تأكيده. وملخّص هذه الإشارة أنّ القارّة الأفريقيّة كانت ضحيّة التناقض الصارخ بين موقعها الجغرافي، من ناحية، وتيّارات التاريخ الجارفة المتحوّلة التي اخترقت أراضيها من كلّ حدب وصوب، من ناحية أخرى.
ولتوضيح هذه الفكرة، يكفي أن نستفتي “الشيخ غوغل” عن “خريطة العالم” حتّى يُطالِعَنا بصُوَر عديدة نتبيّن من خلالها أنّ أفريقيا تتنزّل من الكرة الأرضيّة منزلة المركز. ورغم أنّ هذه المنزلة لا تعدو أن تكون “زاوية نظر اعتباريّة” في كوكب لم ينفكّ عن الدوران حول نفسه وحول الشمس، فلا أحد يستطيع أن يُنكر مكانة أفريقيا من التاريخ ودورها في مُجرياته، بدءاً بالنظريّة الشهيرة، نظريّة “الخروج من أفريقيا” (Out-of-Africa-Theorie)، تلك التي يُرجّح فيها أصحابُها أنّ البشريّة تدين بأصولها الغابرة إلى الإنسان الأفريقيّ الذي انتشر نسله عبر العالم، وصولاً إلى الصراع الذي يحتدم اليومَ في السرّ وفي العلن بين القوى الكبرى الراغبة في الهيمنة على موارد القارّة السّمراء، مروراً بسلسلة الحضارات العظيمة العريقة التي كانت أفريقيا مسرحاً لها منذ القِدم.
ولعلّ أهمّ نتيجة أدّى إليها هذا “التناقض” أو (على أقلّ تقديرٍ) هذا “الخلل” بين “أفريقيا/الوحدة الجغرافيّة”، من ناحية، و”أفريقيا/الشتات التاريخيّ”، من ناحية أخرى، أنّ مبحث “الدراسات الأفريقيّة” قد توزّع بين المباحث؛ تماماً مثلما تتوزّع دماء القتيل بين القبائل!
ومن هذه الزاوية بالذات، فإنّ الكاتب الفرنسيّ فرونسوا غزافيي فوفال – إذ يُصرّ على تقديم نفسه بصفته “متخصّصا في الدراسات الأفريقيّة” (Africaniste)- إنّما يريد أن يعيد الاعتبار لحقل من حقول البحث العلميّ أضاع وحدة موضوعه ومركز اهتمامه، في خضمّ الحقول المعرفيّة المجاورة له، تلك التي كان من المفترض أن تُـعَـدَّ فرعاً من فروعه ورافداً من روافده.. تماماً مثلما أضاع شعبٌ أفريقيّ ما، “مجهولٌ”، في لحظةٍ تاريخيّةٍ ما، “معلومةٍ”، كيانَه فتبخّر كأن لم يكن!
أن نكتب التاريخ بالأدب!
عبر كتابه “في البحث عن المتوحّش المثالي”، وعلى امتداد الفصول الخمسة التي شكّلت جوهر العمل – بالإضافة إلى الملاحق البيبليوغرافية والاصطلاحيّة التي وردت في الخاتمة – يصطحبنا فرونسوا غزافيي فوفال في رحلة تجمع بين الرواية التخييليّة/التاريخيّة والسيرة الفرديّة، وبين علم الآثار ودراسة الذهنيّات، وبين التاريخ والإتنوغرافيا… وهي رحلة يتدرّج بنا فيها، شيئا فشيئا، من الزمن الحاضر باتّجاه الماضي سعيا إلى جمع ما يمكن أن يقع بين يديه من أدلّة وشواهد تتضافر كلّها لإثبات حقيقة لا تعرفها إلاّ قلّة قليلة من المتخصّصين، وحتى الذين يعرفونها فإنّهم غالباً ما يتعمّدون تناسيها! حقيقة مفادُها أنّ شعباً من شعوب أفريقيا قد “اختفى” عن مسرح التاريخ في ظروفٍ “غامضة” (أو هكذا يُشاع!). ومن باب الوفاء “للذاكرة المطموسة”، وحرصاً على إحيائها، كتب فوفال عمله مقتفياً آثار هذا الشعب (أو ما تبقّى منه!) من أجل أن يُعيد بعض أطلاله إلى الحياة، (رمزيّاً على الأقلّ!).
ولبلوغ هذا الهدف، لم يسلك الكاتب الطريق السهلة، بل اختار – بمنتهى الوعي – أعسر المسالك! أي أن يكتب التاريخ “بالمقلوب”! فبدل الانطلاق من الماضي في اتّجاه الحاضر، وبدل أن يتقدّم بنا خطيّاً في مسار تصاعديّ يحكمه منطق التعاقب والتّتالي، اختار الانطلاق من الحاضر، أي من “نقطة النهاية” الثابتة المؤكّدة الماثلة أمام أعين القرّاء، ثمّ سار إلى الوراء القهقرى في ما يُشبه “العودة المستحيلة” إلى “نقطة البداية”، “نقطة الغموض”!
وبالرغم من غرابة هذا الاختيار المنهجيّ الذي يبدو – في ظاهره – مُجافياً لمألوف الدراسات التاريخيّة، فإنّ مقاصد الكاتب كانت واضحة تماماً (في تقديرنا على الأقلّ). فهو لا يريد أن يسرد “تاريخاً جاهزاً”، ولا يسعى إلى صياغة قراءة “ما بعد كولونياليّة” تؤول في خاتمة المطاف إلى ضربٍ من ضروب المصالحة الزائفة مع الماضي الاستعماري، عبر تبرير هذا الماضي تبريراً ينتهي فيه الفرقاء إلى القول: “عفا الله عمّا سلف، ولنبدأ صفحة جديدة”! بل إنّ هدفَ الكاتب الجوهريَّ يكمن في محاولته تجاوز “الحدّ المألوف” للكتابة التاريخيّة، أي تجاوز “الإخبار […] والنظر والتحقيق […] والتعليل الدقيق، والعلم بكيفيات الوقائع و[بيان] أسبابها العميق” (كما قال ابن خلدون يوماً ما) إلى مستوى آخر “أقصى” يتنزّل فيه “فنّ التاريخ” في عمق المأساة، أي – بشكلٍ ما – في جوهر الأدب. وهذا بالذات ما أكسب كتاب فرونسوا غزافيي فوفال “في البحث عن المتوحّش المثالي” طابعه الاستثنائي. فهو يخوض في مسألة تاريخيّة، ولكنّه يتناولها بعيداً عن دعاوى العلميّة الجافّة، والتجهّم الأكاديميّ المقيت، والحياد الإيديولوجي المصطنع.
ولهذا السبب، فإنّه يؤسّس رؤيته على ما لم نتعوّد أن تتأسّس رؤيةٌ تاريخيّةٌ عليه، حين ينطلق من مدوّنة روائيّة معاصرة، ونعني بذلك مدوّنة الكاتب الجنوب أفريقي جون ماكسويل كويتزي الحائز جائزة نوبل للآداب (2003)؛ وتحديداً من روايته “في انتظار البرابرة” (1980)، تلك التي تستدعي حتماً وبالضرورة روايةً له سابقة عنوانُها “في قلب البلاد” (1977)، مثلما تستدعي عملاً آخر شهيرا، ونعني به مسرحيّة “في انتظار غودو” لصمويل بيكيت (1906-1989).
عن التاريخ ومصائر البشر!
وبالرغم من أنّ هذه المدوّنة الأدبيّة لا تقيم مع التاريخ إلاّ علاقات عرَضيّة واهية، بل هي تتعمّد تحريفه والزجّ به في دلالات الفراغ والهاوية والمأساة، فإنّ فوفال قد انطلق منها لكي يلفت نظر قرّائه إلى العَمَى الذي قد يصيب أيّة ثقافة متى جعلت علاقتها مع الآخر قائمة على الخوف منه وشيطنته واعتباره مصدر الخطر الدائم. وهذا بالذات ما وقعت فيه الثقافة الغربيّة لحظة تعاملها مع من كانت تسمّيهم “أهل البلد” من سكّان جنوب أفريقيا الأصليّين.
وإمعاناً من فوفال في دفع قرّائه إلى الوعي بمأساويّة التاريخ كما اختار أن ينظر إليه وأن يكتبه، انتقل في الفصل الثاني من عمله إلى مجال آخر مجاور للأدب، هو مجال السِّيَر وتراجم الأعلام. فتوقّف عند حياةِ شخصيّة من أفريقيا الجنوبية اعتبر أنّها تلخّص عمق المأساة التي صاحبت هيمنة الرجل الأبيض على العالم في القرن التاسع عشر. والمقصود بهذه الشخصيّة امرأة وُلدت على الأرجح سنة 1789 (نفس السنة التي قامت فيها الثورة الفرنسية، ويا للمفارقة!).. امرأة حملت منذ نشأتها في القبيلة التي انحدرت منها اسم “سواتش”؛ ثمّ حين صارت في عداد العبيد اختار لها أسيادُها من المستعمرين الهولنديّين اسم “سارة”. وبشيء من الترخيم والمؤانسة أضْحَوْا يدْعونَها “سارتجي”!
وقد كان بإمكان “سواتش” أو “سارة” أو “سارتجي” (وما هي إلاّ أسماء لطمس الهويّة لحظة يُدّعى تعيينُها!) أن تقضي حياتها خادمةً مطيعةً في ضيعة أسيادها البِيض الهولنديّين إلى أن يتوفّاها الأجل. ولكنّ القدر كان يهيّئ لها مصيراً مغايراً من أبشع ما يكون ومن أفظع ما يُتصوّر، بل من آخر ما يمكن أن يخطر على بال أو يجنح به خيال! ففي سنة 1810، وحين بلغت عشرين عاماً ونيفاً من العمر، وخلال زيارة أدّاها إلى ضيعة أسيادها طبيبٌ جرّاحٌ يُدعى ألكسندر دانلوب، يحمل الجنسيّة الإنكليزيّة وينتمي إلى قوات التاج البريطاني، لفتت انتباهه الفتاة الأفريقيّة الشابّة بقوامها الاستثنائي!
وخلافاً لما قد يتبادر إلى أذهاننا، فإنّ ملامح القَوام الذي شدّ أنظار الدكتور دانلوب بعيدة كلّ البعد عن معايير عصرنا، معايير الرّهافة والنحافة، وحتّى عن المعايير التي كانت سائدة في أوروبا القرن التاسع عشر. فقد كانت “سارتجي” ذات عجيزة ضخمة وردفيْن ممتلئيْن وبنية جسديّة منفرطة. ومع ذلك، فقد فاتحها الدكتور دانلوب بعرض ما كان لها أن ترفضه: اقترح عليها الخروج من وضع العبوديّة ومعانقة الحريّة والانتقال معه إلى أوروبا. وما كان هذا العرض إلاّ إضماراً لشرٍّ بل إضماراً “لشرور” لا تُحصى ولا تُعدّ!
فقد كان العالم الغربيّ آنذاك مأخوذاً بحمّى الحفلات الغرائبيّة أو ما يُعرف في الإنكليزيّة بـ”Freak show”. وما إن وطئت قدما “سارتجي” أرض أوروبا، أرض الحريّة والتقدّم حتّى وجدت نفسها في خضمّ عروض السيرك فريسة للمشاهدين الفضوليّين المتلهّفين على النظر إلى جسدها الضخم الاستثنائيّ والذين كان بإمكانهم دفع مزيد من الأموال حتى يتمّ لهم السّماح بلمسها، كما يُلمس كائن غريب آتٍ من مكان مجهول.
وبقدر ما أثارت “سارتجي” فضول عامّة الناس (وهي التي اشتهرت في إنكلترا وهولندا وفرنسا تحت اسم “سارة بارتمان”، اسمها الفنيّ!)، أثارت أيضاً فضول علماء الأجناس وعلماء الأحياء وعلماء الفيزيولوجيا والأطباء. فقد رأوا فيها “الأنموذج المضادّ” أو “المثال النقيض” لحالة الرقيّ القصوى التي بلغها الجنس الأبيض! ولذلك فقد سمحوا لأنفسهم – باسم العلم – أن يأخذوا قالبا لها من الجبس استخرجوا منه نماذج لجسدها الاستثنائي، كما أباحوا لأنفسهم بعيْد وفاتها سنة 1815 (وهي التي لم تتجاوز ستّة وعشرين عاماً من العمر) أن يشرّحوها وأن يقسّموا أعضاءها عضواً عضواً وأن يُبقوها في مادّة الفورمول الحافظة وأن يعرضوا هيكلها العظميّ في المتاحف، وهي التي أُطلق عليها اسم “فينوس الزنجيّة” أو “فينوس السوداء” أو “فينوس الهوتنتوت” نسبةً إلى القبيلة التي انحدرت منها.
“في البحث عن المتوحّش المثالي” كتاب موجع مؤلم، صادم وفظيع، جاء ليكشف لنا عن قفا ما نظنّه خيراً كلّه، وعن المخفيّ في تفاصيل الذهنيّات ودقائق المفاهيم ومصائر البشر. وهو يعود بنا عبر فصوله الثلاثة الأخيرة إلى حدود القرن الخامس عشر حيث بداية القصّة، قصّة الشعب الذي انحدرت منه “سواتش” أو “سارة بارتمان”، شعب “الخوي خوي” (وهذا اسمه الأصليّ قبل أن يُطلق عليه المستعمرون اسم “الهوتنتوت”)؛ الشعب الأعزل الذي وجد نفسه في مواجهة الغزاة “العابرين في الماء العابر” منذ أن اكتشف الأوروبيّون الطريق البحريّة إلى الشرق عبر ما يُعرف بـ”رأس الرجاء الصالح” (وهذه التسمية أيضاً تسمية استعماريّة جاءت لتُلغي التسمية الأصليّة للمكان، “رأس العواصف”)، شعب وجد نفسه في مواجهة غزاةٍ من كلّ حدب وصوب: من البرتغال ومن إسبانيا ومن فرنسا ومن إنكلترا استباحوا أرضاً غير أرضهم وأخضعوا للعبوديّة شعباً حرّاً ظلّ يعيش على أديم أفريقيا قروناً مديدة مطمئناً إلى نمط حياته وأغانيه ورقصاته، إلى أن تمّ القضاء عليه بالحديد والنار حينا، والتهجير حينا آخر، وبالأوبئة التي لم ينجح الطبّ الأفريقيّ التقليديّ في إيجاد مَصْلٍ واقٍ منها فحصدت الفيروسات التي حملها الغزاة معهم في أجسادهم أرواحَ ما لا يُحصى من البشر أجداد “سارة بارتمان”، التي ربّما كانت ضخامة بنيتها شاهداً على امّحاء شعب من الوجود… شعب انطفأت علاماته وآثاره شيئا فشيئا، هنا في جنوب أفريقيا؛ حين انبثقت، هناك في أوروبا، شمس الأنوار… وما أقسى لهيبها على بعض الشعوب!
ضفة ثالثة





