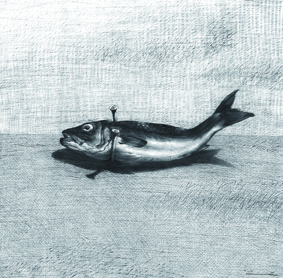في دمشق رأينا يهوذا متنكّراً بثياب المسيــح/ خليل صويلح

دمشق | دمشق اليوم هي جنَّة البرابرة، والأرض الخراب، ومنجم الألم، وليست «دومسكس» وفقاً لاسمها اللاتيني القديم «المسك». ماذا سيكتب ياقوت الحموي لو أعاد كتابة «معجم البلدان»، ألن يتردّد في قوله «ما وصفت الجنّة بشيء إلا وفي دمشق مثله»؟ وبماذا يجيب ابن جبير لو زارها اليوم؟ هل سيكتب بالطمأنينة نفسها «وأما دمشق فهي جنّة المشرق، ومطلع نورها المشرق، وخاتمة بلاد الإسلام متى استقريناها، وعروس المدن التي اجتلبناها. قد تحلّت بأزاهير الرياحين وتجلّت في حللٍ سندسية من البساتين، وحلّت موضع الحسن بالمكان المكين، وتزيّنت في منصتها أجمل تزيين»؟ تحت جذور أشجار المشمش والتفاح والجوز، في الغوطة اليوم، ستجد أيها المؤرخ، أنفاقاً للمسلحين، ومخازن للذخيرة، والرايات السود. وحين تعبر شارعاً في جوبر، أو داريا، أو المعضمية، لن تلتفت إلى الجثث المهملة منذ أيام، فالقنّاص، سيمنعك من الاقتراب. ستمضي كأنّك لم ترَ ما يلفت النظر. وعند الحاجز، ستتفقّد بطاقة هويتك، خوفاً من أن تكون قد أضعتها. سوف تنظر من نافذة السيارة إلى البيوت المهدّمة، من دون أن تتساءل عن مصائر أصحابها. هل هم مهجرون أم قتلى أم معتقلون، أم لاجئون وراء الحدود؟
البيوت التي نُهبت، وتحوّلت جدرانها الداخلية التي كانت مكاناً للصور العائلية واللوحات والمرايا إلى مجرد كوّات مفتوحة. كوّة تقود إلى كوة أخرى، مثل بيت الخلد. كوة في جدار تكفي المسلح لوضع بندقيته على الحافة كي يصطاد عدوه المفترض بأفضل الوضعيات تحكّماً. هذا الصباح، كُنت قد شاهدت شريطاً وثائقياً عن الحرب في كوسوفو، وإذا بالمشهد نفسه يتكرّر: مسلّح يطلق النار من كوّة مفتوحة في جدار مع فارق بسيط: لقد كان هذا الشريط مصوّراً بالأبيض والأسود، فيما نحن نعيش الحرب بالألوان، ربما كي نرى لون الدم بالأحمر، في الشوارع، وعلى الشاشات معاً.
الآن علينا أن نتدرّب على حربٍ إضافية، وأن نحصي ضحايا جدّداً، أولئك الذين ستحصدهم صواريخ «التوما هوك» العابرة للبحار بمداها المجدي، ودقتها في إصابة الهدف، وقدرتها الخارقة على التدمير، لكن كيف تلقّى المثقفون السوريون في الداخل خبرَ «الهدية الأميركية» المنتظرة؟
يجيب الروائي نبيل سليمان، في الوقت المستقطع من رياضته الصباحية في دروب قريته الساحلية البودي: «منذ زلزلت سوريا زلزالها، وقفتُ ضد التدخل الخارجي العسكري وغير العسكري، مهما يكن البرقع الذي يتبرقع به. والآن، أؤكد الوقفة ضد التدخل الأميركي الذي يُسمّى الضربة، وثمة من يسمّيه النعمة، وثمة من يسمّيه النقمة. لكن مهما تعددت الأسماء فالمطلوب واحد: حلّي عنا يا أميركا، حلّو عنّا يا أيها المتدخلون». من جهتها، تقول الإعلامية حنان يمق متهكمةً «أترقّب خطاب أوباما كما أترقّب موعد دورتي الشهرية لأتأكد أنني لست حبلى بالأوهام، ولأعرف إن كان هناك متسع في الأيام المقبلة للمشي مجدداً، من ساحة المالكي إلى غرفتي في حيّ العفيف التي لا شيء فيها ينتظرني». وتضيف: «أنصحكم بقراءة رواية «حفلة التيس» لماريو بارغاس يوسا مع المكسّرات والكولا، في انتظار الضربة الأميركية»، فيما يجزم زيد قطريب بأن ما ننتظره هو عدوان صريح «لأننا لسنا في مباراة كرة قدم، ولا مجال للتردد في ترتيب المواقف. أنا شخصياً ضد أميركا عندما تريد قصف سوريا، حتى لو كان من يَحكم دمشق هم الإخوان المسلمون. المسألة وطنية بامتياز، ومن الغريب أن يتورّط بعض مثقفي الخارج في التواطؤ مع الخطاب المتطرف بذرائع واهية، كما وصلوا أخيراً، إلى التهليل لهذه «الضربة»، كأنهم في حالة فصام كبيرة أو في حالة ثأر شخصي دفعت بعضهم إلى عدم التمييز بين النظام والبلد، أو بين النظام والدولة». ويضيف موضحاً فكرته «هذا المشهد سيقوم بإعادة صياغات جذرية للخطاب الوطني ومفاهيمه، وللأسف نحن اليوم نكرر ما حدث في العراق بكل بساطة، إذ نقوم باستيراد «جلبيين» (نسبة إلى أحمد الجلبي) جدد متوهمين أنّنا ندخل العصر الديمقراطي من بابه الأوسع». ويتساءل الناقد نذير جعفر: «كيفَ لي أن أصدّق أنّ تحالف فائض الثروة النفطيّة وفائض القوة الأميركيّة المتوحّشة والمتغطرسة عبر تاريخها الطويل يمكن أن يفتح أفقاً للتغيير في بلدي ويخدم مصالح شعبي؟ منذ ولدت حتّى اليوم، لم أرَ إلا الوجه البشع لأميركا والغرب في تعاملهما مع وطننا. من أين جاءت هذه النخوة والحرص على الشعب السوري؟ من أين جاءتهم هذه النزعة الإنسانية نحو بلدي وهم لم يفكّروا يوماً إلاّ في حماية إسرائيل وحقول النّفط والتغاضي عن الاستيطان والدم الفلسطيني المهدور؟» ويضيف غاضباً «لا أيها السادة، لم أفقد بعد عقلي ولست مستعدّاً للانضمام إلى جوقة المبتهجين بمقايضة وطن للثأر من نظام. مرحباً أيها الموت متى جئت، لن أقف مخدوعاً في طابور مَن ينتظر يهوذا الاسخريوطي في ثياب المسيح المخلّص». «لازم نعمل شي» يستعير الروائي نبيل ملحم هذه العبارة من شابة سورية قالتها في جلسة نقاش عقب الإعلان الأميركي عن ضربة لـ «قوات الأسد»، ثم يطرح سؤاله الشخصي: «لكن من نحن؟ أقصد جموع المثقفين، والنخب السياسية، سلطة ومعارضة، ذلك أنّ تداعيات المسألة السورية لم تدع لأحد أن يفعل شيئاً». يحاول صاحب «بانسيون مريم» تفكيك اللغم السوري، منذ لحظة انتشار كذبة شعار «واحد واحد، الشعب السوري واحد»، لافتاً إلى أنّ المثقف السوري كان وقتئذٍ منخرطاً في مهمة حصرية هي «تطييف المسألة السورية» حتى إلى ما قبل الاحتكام للبنادق. و«بالتأكيد لم يكن هذا حال سكّان سوريا، الذين يعرفون باليقين أنّ كرامة الخبز تعلو على استحقاقات العقائد واللاهوت، وقد انحشروا قسراً في لعبة الطوائف، وتقاسمت النخب صياغتها، بما أوصل الحالة السورية إلى التبعثر في زواريب طوائف وعشائر، وبما فتح بوابات الحرب الأهلية على البلاد وصولاً إلى التعبير الشائن «جيش الأسد». هذا الجيش إذاً، هو هدف الضربة الأميركية المرحّب بها من المعارضة، هو جيش في محترفيه واحتياطييه يزيد على 600 ألف عسكري سوري، ما يعني أنه يمثل ما لا يقل عن واحد من 15 من سكّان البلاد، ومجرد قبول تعبير «جيش الأسد» لا بد من أنّه يحمل في تلافيفه ذلك التطييف، وهو الهدف الأول والأخير من تعبير كهذا، وهو الحقيقة الوحيدة التي يتنكّر لها الجميع». ويختتم قائلاً: «الخرائط المخبّأة، أُخرجت من الأدراج، وما علينا إلا انتظار رسمها من جديد، وليس لدى السوري ما يفعله سوى أن يذرف دمه». ويقلّب التشكيلي نزار صابور كتابه اللوني «حارس الموت والحياة» ليتوقّف عند باب «نعوات سورية»، الفكرة التي دأب على تنفيذها، منذ عامين ونصف عام، محاولاً أرشفة الدم السوري المهدور، قبل أن يقول رأيه بخصوص الضربة الأميركية المرتقبة «كأن الدماء الجارية لا تكفي، وكأنّ صعوبات الحياة لا تكفي أيضاً. لا أستطيع أن أكون إلا ضد الموت من أي جهة أتى، سواء أكانت جهةً داخلية أم خارجية. إذا نُفّذت الضربة الأميركية، فستتفاقم مشاكل حياتنا بجحيمية أكبر. لا نحتاج إلى نعوات جديدة، وأشكُّ في أن الضربة ستحسم الأمر، أو أن توقف نهر الدم: كم من الموتى أيتها الديمقراطية الأميركية، أيها الشرطي الكبير؟». ويوضح التشكيلي ناصر حسين أنّ السيناريو الأميركي في العراق لجهة النهب والتدمير والقتل واللصوصية، يتكرّر مرّة أخرى في سوريا «بطابور مؤيديه من المثقفين، لكن السيناريو السوري أكثر خطورة، فما هو مطروح: تقسيم البلاد إلى عشائر ضعيفة منهكة جائعة ومتحاربة. لست سياسياً ولا خبيراً عسكرياً، لكني لا أتوقع الضربة الأميركية لسبب واحد، فنحن نقتل بعضنا بعضاً بكامل جنوننا». يتناول الشاعر سامر محمد إسماعيل المشهد بعدسة أخرى، إذ يقول «بإمكاني اليوم أن أتخيل بعد التهديدات الأميركية لبلادي مشهداً مشابهاً لما فعلته هالة الفيصل عام 2005 عندما قامت التشكيلية السورية بالتعري تماماً في ساحة «سكوير بارك» في نيويورك؛ كاتبةً على جسدها: «أوقفوا الحرب» احتجاجاً على الغزو الأميركي للعراق. ها أنا ذا أختار أسماء كثيرات من السوريات اللواتي يُقمن في بيروت، ودبي، وواشنطن، وألمانيا، وعمان والقاهرة، وإسطنبول وباريس للقيام بأنشطة من هذا النوع، لكنني أعود خائباً من هذه المقارنة، فجلّ من هنّ في بالي قد يتعرّين على الملأ، لكن شرط أن تكمل البوارج الأميركية رحلتها إلى الشواطئ السورية. لسن وحدهن مَن سيتعرين، أو تعرّين لذلك، بل إنّ هناك «رجالاً» قد تعرّوا فعلاً في بلاط السلاطين والملوك والشيوخ لتنطلق الطائرات الأميركية لضرب المدن السورية. وها أنا ذا أراقب هذا «الستربتيز» السوري، أراقب هذا الاستجمام السياسي من غير عاصمة غربية وعربية، أشاهد بأم العين كيف تباع الأوطان في مزادات علنية، وعلى كل شاشات المال النفطي، فلأميركا كما يقول محمود درويش «سنحفر ظلنا ونشخُّ مزيكا». بعد فيتنام، وهيروشيما وناغازاكي، وتشيلي_الليندي، والعراق، وأفغانستان، ويوغسلافيا، ها هم أحفاد الجلبي يقولون لنا إنّ الأسطول السادس هو سفينة الحب، تايتانيك الذي يموت فيها العشاق غرقاً من فرط الموسيقى».
أما الشاعرة ناهدة عقل، فاكتفت بإشارة خاطفة «علّمتني أميركا أن أخاف على وطني، كلما عزفت أسطوانة حماية المدنيين، وتحقيق السلام، من فيتنام، مروراً بالعراق، إلى اليوم، وعلّمتني أن أخاف أكثر، كلما لفظت عبارة «لدوافع إنسانية» في تبرير أفعالها الوحشية في العالم».
الاخبار