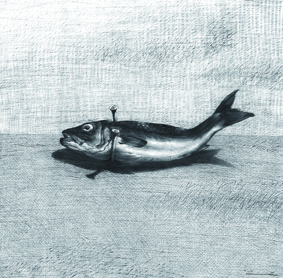“في دمشق” سوريانا التي نحبّ ونعشق/ جاد شحرور

رغم المشهد الدموي في سورية، وقساوة الواقع على أطفال تشرّدوا وتيتّموا وأمهات ترمّلن وعائلات تفككت، بسبب الأوضاع الأمنية التي فرضها النظام القمعي في سورية… إلا أنّ هناك محاولات شبابية تنبض بالأمل وتحاول تكراراً أن تنقل صورة نظيفة جميلة عن سورية التي نحبّ ونعشق، خاليةً من مرارة الأحداث السياسيّة. هكذا، استطاع المخرج السوري وارف أبو قبع أن يحيك من الضوء صورة تنقل سورية وناسها، “في دمشق”.
“بدأتُ التصوير عند بداية الأحداث، وكان السبب بعيداً كُلّ البعد عن الأحداث السياسية، وقد بدأ مع أولى التظاهرات التي كانت خجولة. نتكلّم عن شهري شباط/فبراير وآذار/مارس في العام 2011. بعد التصوير، سافرتُ إلى دبي، لمدّة شهرين ونصف، من ثمّ استقريّتُ في عمّان لسنتين وشهرين، ومن بعدها توجّهت إلى ألمانيا”، يقول أبو قبع في حديث لـ”العربي الجديد”.
وارف أبو قبع، من مدينة التل في ريف دمشق. يعيش في ألمانيا، وتخرّج من معهد الفنون الجميلة في جامعة دمشق، حاصل على إجازة في الـ Graphic Art. أمّا براعته في الصورة المتحركة/Motion Picture، فناتجة عن جهد شخصيّ وشغف لعالم الصورة. ويُعتبر فيلم “في دمشق” أوّل مشروعٍ شخصي موقّعٍ باسم أبو قبع.
هذه المشاهد الذهبية الدافئة التي تدغدغ مشاعرنا وتجعلنا نبحر في عمق نوستالجيا الوطن، تأخذ المُشاهد إلى عالم الذكريات بسبب الإضاءة ولون الصورة المائل إلى الألوان الترابية، والتي غالباً ما تدلّ على الحنين والشوق، بالإضافة إلى تقنية التصوير التي اعتمدت الـ Micro Photography، بالتوازي مع حركة الـ Rack Focus، أيّ الانتقال من عمق إلى آخر في الصورة. ومن أهم المؤثرات البصرية المستخدمة في الفيلم: “Color Correction Dust Effect، وطبقات من أنماط غرافيكية”.
كما استعان المخرج ببرنامج الـ Adobe After Effect ليقوم ببعض المؤثرات البصرية التي تتعلق بمسار الكاميرا، إذ أعطى الصورة عمقا في مساحة التصوير، وخلق حركة سلسة لمسار الكاميرا مع تحريك الضوء بما يتناسب مع اللقطة بهدف تقريب الصورة إلى الواقع. بالرغم من جو “الحلم” الذي يطغى على الفيلم من أوله إلى آخره، إذ يعتبر جزء لا يتجزأ من فكرة الفيديو ونصه. وربّما نحتاج في العالم العربي إلى شخص يذكرنا بدفء سورية، بثقافة هذه الأرض، وتاريخها، بشعبها الجميل.
يضيف أبو قبع: “لم أهتم بالمشروع عندما كنت في دبي، ولم أعطِه الوقت الكافي، لسببين: الأوّل هو رفضي أن أعيش في ظلّ الحنين إلى الوطن، والثاني انشغالي بأعمال حرة في مجالي. لكن عندما وصلتُ إلى ألمانيا، ضاعفتُ جهدي وأعطيتُ المشروع الوقت المطلوب لإنجازه، علماً أنّه لم يكن لديّ وقت محدد لإكمال الفيلم”.
ويتابع: “اخترتُ معالم تاريخية في دمشق، لأنّها جزء من حضارة هذه المدينة، مثلاً الجامع الأموي، الذي كان كنيسة، ومن قبل أن يكون معلماً مسيحياً كان يُعرف بمعبد جيبتور… هذه هي دمشق، يكمن جمالها في تاريخها وتنوع الثقافات التي مرّت عيلها. كنتُ محتاراً بين قصيدتين الأولى “هذه دمشق” للشاعر السوري الراحل نزار قباني، والثانية للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش وهي “طوق الحمامة الدمشقي”، إلا أنني اعتمدتُ الأخيرة، بسبب تشابهها وقربها للطرح الإخراجي للنص”.
هذا الواقع المرير أجبر أُمّاً سورية أن تجلس على رصيف الغربة تحت الشتاء، بينما كان بوسعها أن تغفو مطمئنة في منزلها وتستيقظ على دفء مئذنة الجامع الأموي… كما أنّه حرم عجوزاً من المشي في شارع القيمرية. وسمح لنظام قمعي أن يقصف دولته وشعبه في سبيل الحفاظ على كرسي السلطة.