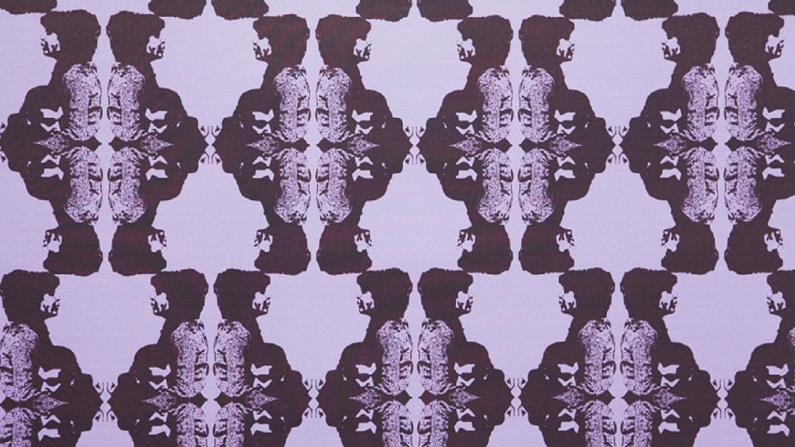قال أبي: لن يدعوكٍ تعملين ولا أن تعيشي بسلام/ تهامة الجندي

إقامتي في بلغاريا شارفت الانتهاء، كذلك مدّخراتي المتواضعة، وأنا على عتبة الانفصال عن زوجي، أحمل شهادتي بيدي، وأقف على أسوأ مفّترق طرق، وضعني القدر عليه، والضباب الكثيف يلفّ كل الدروب امامي. لم أُولد وفي فمي ملّعقة الذهب، أسرتي متوسطة الحال، انتعشتْ في فترات قصيرة، وعانتْ من انتكاسات كثيرة، وهي اليوم تعيش أصعب أوقاتها. أمي متقاعدة براتب خمسين دولارا، وراتب أبي يعاني من انقطاعات طويلة، جراء الأزمة المالية التي تتهدّد منظمة التحرير الفلسطينية بعد حرب الخليج الأولى، وعليّ أن أنتج حياتي الجديدة، من دون أن انتظر عونا ولا سندا من أحد.
كيف أبدأ وأين؟ سؤال يؤرّقني ليلاً ونهاراً، وتخذلني بصيرتي، هل أخاطر وأعود إلى وطني؟ «أياك والعودة، الأمن يطلبك» قالت أمي، حين اعتُقلت أختي غرناطة، وما من سبيل للتأكد من دقة معلوماتها، سوى أن أخوض التجربة بنفسي، وأنا لم أجرؤ على دخول سوريا منذ خمس سنوات. هل التحق بأبي في تونس، وأعمل في إعلام «منظمة التحرير«؟ هذا يعني أني سأحمل صفة سياسية، سوف تجبرني أن أقطع نهائيا مع بلدي، شئتُ أم أبيّتُ. هل أبقى في بلغاريا، أحاول انتزاع جنسيتها، والبحث عن عمل يطّعمني، لكن الوطن البديل في طريق تحوّله إلى الرأسمالية، يعيش الفوضى والغلاء والانفلات الامني، بحيث يبدو التفكير بالاستقرار فيه، ضربا من التهوّر. هل أغادر إلى الإمارات أو أي بلد أوروبي، وكيف لي، وأنا لا أملك سوى سعر تذكرة السفر، وشهادة دولة اشتراكية منّهارة، لم يعد أحد يعترف بها.
«شو هالآخرة يا فاخرة؟» وقطع حبل تفكيري رنين الهاتف، رفعت السمّاعة، وباغتني صوت غرناطة، مشتاقة قلناها معا، وبكينا، كنتُ أول من اتصلتْ به بعد خروجها من المعتقل، وقالت «بدك تجي، ونعيش هون سوا»، وكان ذاك كافيا أن أحسم أمري باتجاه العودة إلى سوريا. وطني أحوج إليّ من أي بلد آخر، وأختي أغلى الناس إلى قلبي. اعترض أبي على قراري: «لن يدعوك تعملي، ولا حتى أن تعيشي بسلام»، تحديّتُه، سأذهب، وأعمل «أنا بنتقد، وبعلّك كتير، بس ما اشتغلت بالسياسة متلك». قال: ستندمين.
حزمتُ ملابسي، وضعتُ في حقيبة يدي الألف دولار، التي أهداني إياها أصدقاء أبي بمناسبة حصولي على الدكتوراه، وفي مساء يوم تشريني من عام 1992، وصلتُ الى مطار دمشق الدولي. مددّتُ جواز سفري لموظف الأمن، أخذه وغاب، وبدأتْ ركبتاي ترتجفان من الخوف، ماذا لو اعتقلوني؟ صرتْ أتلفّت يمينا وشمالا، صور الرئيس تنظر إليّ، وتزيدني إحساسا بالعجز، وأنا أتخيل رحلتي في السجن، قلبي يضرب بقوة، أضمه بذراعي، أسند رأسي براحتي، وأزفر، هذه المشاعر أعرفها، أعيشها كلما وقفت على حدودك يا وطن. ولحسن حظي لم يتأخر الموظف، عاد مبتسما وسلمني الجواز.
خرجتُ من باب المطار، لفحني هواء دمشق، وأدركت عمق حنيني، ودت لو أغني، وأقبّل الأرض. قاطعني هجوم أختي ومعها خالي وبناته، تعانقنا، وانحشرنا جميعا في سيارة الخال، التي أقلتنا إلى بيته في «الجسر الأبيض»، وهناك استقبلتني المائدة العامرة بأشهى الأطعمة والحلويات، أكلنا وشربنا وتسامرنا وضحكنا حتى الفجر، بعدها أغمضتُ عينيّ، وغرقت بوسن لذيذ، وأنا موقنة أن قرار عودتي، كان أكثر قرارات حياتي صوابا.
شهري الأول قضيته عند خالي، مثل السائحات، دعوات ونزهات وجلسات تعارف. كان واحدا من أجمل شهور العمر، تجولتُ في دمشق القديمة والحديثة، دخلت أسواقها وحدائقها ومطاعمها، لم اكن أتوقعها بهذا الجمال، سحرتني بكل ما فيها، وقررت أن أهبها ما بقي من حياتي. بدأتُ رحلتي باستئجار غرفة بائسة في «ركن الدين»، سكنتها مع أختي، التي كانت قد وجدت لنفسها عملا في مكتب خاص، ريثما تستكمل أوراقها، وتستطيع متابعة دراستها لهندسة الميكانيك، التي قطعها السجن، وهي في السنة الأولى. وأنا بدوري رحتُ أبحث عن فرصتي في العمل، وأعود خائبة كل يوم.
بعد شهرين سافرتْ أختي إلى حلب، والتحقت بجامعتها، وأنا ضقتُ ذرعا بسكني القبيح، وهجرته إلى المزّة (فيلات غربية)، أرقى أحياء العاصمة. كان مُؤجّري من ألطف المُلاّك، وكان بيتي ضيقا وفقيرا، يلوذ بسطح إحدى البنايات، لكن إطلالتي كانت رائعة، شوارع نظيفة ومشجّرة، وفسحات الطوابق الأرضية خضراء، ملونة، مهنّدسة بالرخام وبرك الماء والشلالات، تفوح من أسيجتها روائح الياسمين ومسّك الليل، وما إن يأتي الغروب، حتى أغسل سطحي، وأجلس مع تبغي وقهوتي، اقرأ حينا، أراقب حياة الأثرياء عن بعد، وأخطط لغدي.
كانت جميع وسائل الاتصال مملوكة من الدولة، وكان التقدّم إلى الوظيفة الحكومية، يحتاج إلى صفة حزبية، وموافقة أمنية، وواسطة من العيار الثقيل، وقدر لا بأس به من المال، وأنا التي لا أملك أيا من تلك الشروط، لم أصدق أني بمؤهلاتي العلمية، وإصراري على طلب حقي، لن أستطيع خرق هذا الجدار.
تربيت على أن العلم هو بر الأمان، والشهادة الجامعية هي ضمان الحياة الكريمة، وكنت متفّوقة دوما في دراستي. دخلت كلية الاتصالات الحديثة في جامعة صوفيا، بعد تفكير طويل عن الأنسب لتكوني وميولي ومستقبلي. لم يكن دوامي منتظما، لكني اجتزت امتحاناتي بعلامات عالية، تدرّبت على طباعة الصحف وإخراجها بواسطة الكومبيوتر، واخترت الإعلام المرئي مجالا لاختصاصي في سنتي الأخيرة. كتبت اطروحتي عن الإعلام والتنمية الثقافية، وكنت أهتم بثقافتي، وأتابع آخر تطورات التقنيات الحديثة. لا يعقل أن لا أجد عملا في بلد تعوزه أدنى الكفاءات الإعلامية.
اتصلتُ برئيس القسم الثقافي في جريدة «الثورة»، قابلته، وعلى مكتبه وضعتُ مقالتي، قرأها باهتمام، وقّعها أمامي، وأرسلها للنشر، كان لطيفا للغاية، وقال: قلمكِ جميل، مقالتكِ ستُنشر بعد يومين، وأنتظرُ منكِ المزيد. انتظرتُ شهرا بطوله، ولم تُنشر المقالة، حاولت الاتصال به ثانية، ولم أنجح.
تواعدّتُ مع مدير التلفزيون، وذهبت إليه، ومعي صور مترّجمة ومصدّقة عن شهاداتي، استقبلني بحفاوة بالغة، وصادف أن كان من السلمية، يعرف عمي سامي، ويكن له مودة خاصة، قال لي: جئت في الوقت المناسب، نحن نستعد لإطلاق الفضائية السورية، اعتبري نفسك موظفة عندنا من هذه اللحظة، شكرته، وسألته، وماذا عن الموافقة الأمنية؟ أجاب: لا تقلقي سأتدبر كل شيء بنفسي، أيام معدودات وأطلبك لتوقيع عقد العمل. أخذ صور شهادتي، وجميع المعلومات للاتصال بي، وأرسل سائقه لتوصيلي إلى منزلي. لم يتصل بي، ولم أستطع الحديث معه ثانية، وتلاشت فرحتي.
التقيتُ مدير مكتب إحدى المجلات العربية، اتفقتُ معه على كتابة عدد من الموضوعات، وأحضرتها له بعد أسبوع، مقالة نظرية حول مفهوم الثقافة والمثقف، وعرض لمجموعة شعرية صدرتْ حديثا في دمشق، اطلع على المقالتين وشكرني، شربنا القهوة، تجاذبنا أطراف الحديث، وكان لطيفا، حتى ذكرت له اسم أبي، لن أنسى كيف انتفض، واتسعت حدقتاه، وكاد أن يقع من على كرسيه. فهمتُ أنه جبان، ومن عظام الرقبة، لن يجازف، وسيتراجع عن وعوده، ومن دون الكثير من الكلام ودعته، ولم أعد إليه.
ذهبتُ إلى وزارة الإعلام، وتركت عند سكرتير مكتب الوزير، طلبي للعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية، مرفقا بصور شهاداتي، ولاحظت أن الطلب بقي بلا رقم ولا ختم الوزارة. وأن الورقة التي قُدّمت لي لكتابته، لم تكن رسمية. كذلك لاحظت أن مبنى الوزارة مثله مثل باقي الدوائر الحكومية التي دخلتها، كان مهملا من الداخل، الرطوبة تأكل جدرانه، النظافة تعوز الأرضيات ودورات المياه، والمعاملات الرسمية تتكدّس بفوضى عجيبة على مكاتب الموظفين، وهم على الأغلب غير متواجدين في أماكنهم لاستقبال المراجعين. كان العداء واضحا بين الموظف ومكان عمله، وبينه وبين المواطن الذي يحتاج إلى خدماته.
بقيت ستة شهور أراجع مكتب سكرتير الوزير كل أسبوع، ولم أحصل على جواب لا بالنفي ولا بالقبول، أصّررتُ على الرد، وطلبتُ مقابلة الوزير، حينها استدعاني مستشاره يوسف مقدسي (رحمه الله)، وأفهمني بلطف شديد، وصوت خفيض، ان لا أُتعبَ نفسي أكثر بالمراجعات، ليس لي مكان شاغر في دوائر الإعلام، بحسب الأوامر العليا، لا لإشكال في وضعي، بل لأني ابنة خالد الجندي، ألد أعداء النظام. شكرتُ المستشار على صراحته، وخرجت أجر يأسي. حزمت أمتعتي من جديد قبل أن ينتهي عامي الأول في دمشق، وتنفد آخر أموالي، وانطلقت إلى مسقط رأسي في اللاذقية، على الأقل هناك بيت عائلتي المهجور منذ سنين، بإمكانه ان يؤويني.
قبل خروجي من دمشق، كان معارفي قد باتوا كثرا، وانتشر خبر توظيفي المتعثّر وجاءتني عروض من أناس لا أعرفهم، عبر أناس أعرفهم، لم أرتح لأي منها، وبعضها أشعرني بالسخط والحنق، لأني أحسست أنها مشبوهة، وتعزف على وتر حاجتي. أسوأ تلك العروض كان أن أشرب القهوة مع أحد مدراء الأجهزة الأمنية، لقاء إنهاء معاناتي. رفضت العرض، وطردت الوسيط من منزلي، مع أنه كان قريبي، وكنت أكن له الكثير من المودة.
أفضل العروض كان أن أسجل حوارات متلّفزة مع بعض الفنانين السوريين في القاهرة، لكني توجسّتُ. وأكثر العروض غرابة، جاءني من شخص كان مدعوما ومعروفا في أوساط المثقفين، دعاني إلى مكتب صديقه الفخم، ووعدني أن ينشر لي مقالة أسبوعية في صحيفة «تشرين»، لقاء ألفي ليرة سورية في الشهر (أربعون دولارا حينها)، مبلغ تافه، لكنه يساوي تقريبا راتب الموظفين المبتدئين، ومن دون تردد وافقتُ، ورحت أبحث التفاصيل، وقبل أن تكتمل فرحتي، فاجأني الرجل، أنه هو من سيملي عليّ أفكاره السياسية النيّرة، وأنا أصوغها، ويظهر مقالي موقعا باسمه، وبعد عدة شهور قد يظهر إسمي من حين لآخر. فقدتُ لباقتي، وقلت: اكتب أفكارك بنفسك، ولا تسرق جهدي.
المستقبل