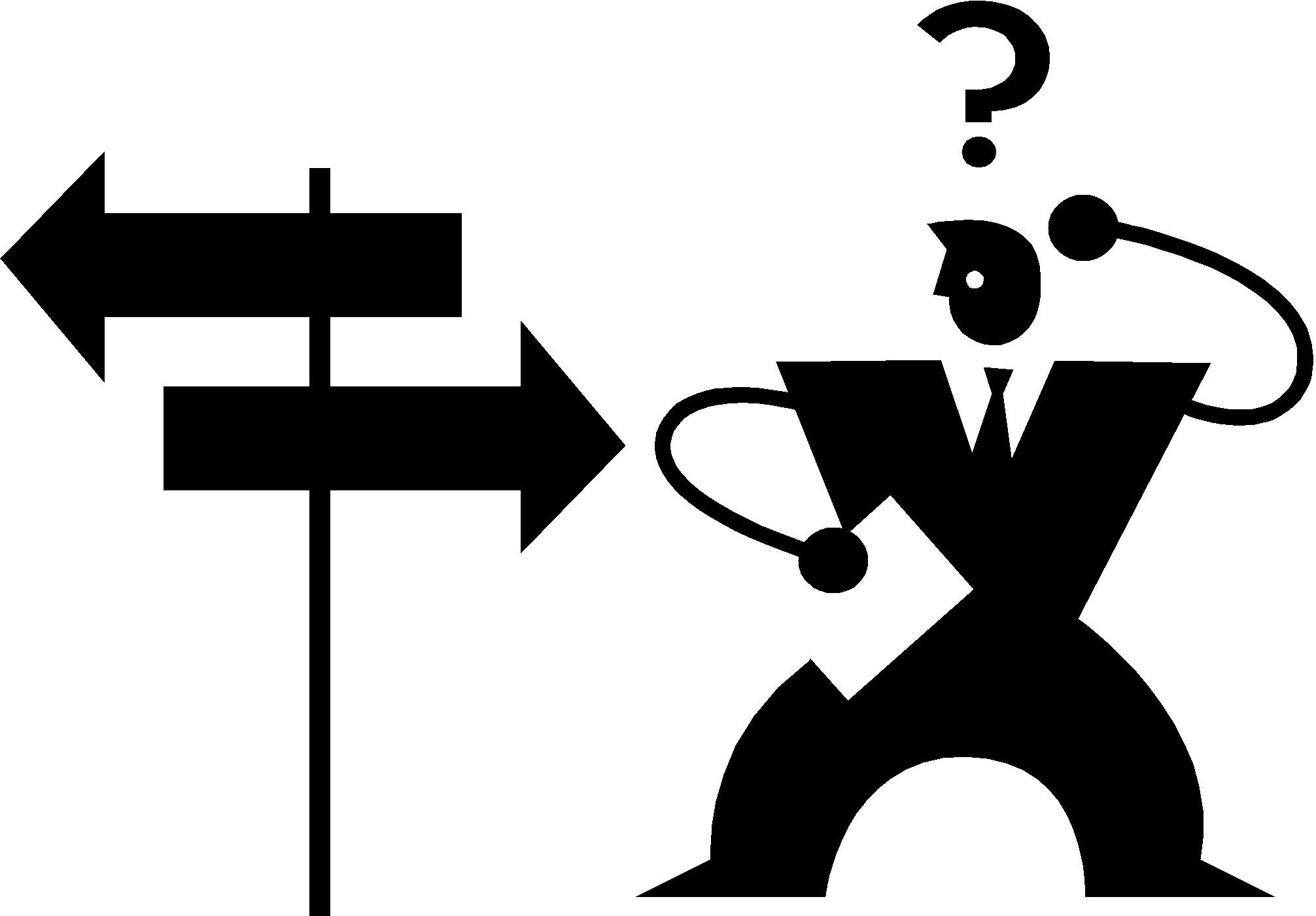قراءة نقدية للعلاقات الروسية العربية وتحولاتها في أزمنتها الثلاثة/ كريم مروة
أكتب بصفتي اليسارية، هذه القراءة السريعة للعلاقات الروسية العربية في الأزمنة الثلاثة، زمن الأمبراطورية الروسية والعصر السوفياتي والزمن الحديث؛ صفة هي الخلاصة التاريخية التي توصلتُ إليها من التجربة الاشتراكية في زمن ازدهارها والأمجاد المتصلة بها وفي زمن الأخطاء والارتدادات وعناصر الخلل التي قادتها إلى الانهيار من داخلها في روسيا السوفياتية وفي البلدان التي حملت اسم الاشتراكية بنموذجها السوفياتي. وهي قراءة نقدية في أساسها، وإلاّ فقدت معناها والهدف المبتغى منها.
عن العلاقات الروسية العربية في عهد القياصرة
أحد المراجع الذي اهتديت إليه عبر الانترنت يرى أن قرب روسيا من بلدان الشرق هو الذي مكّنها من إقامة علاقات مع المنطقة العربية في زمن الخلافة العباسية. لكنني لم أتمكن من معرفة التاريخ بالتحديد. وكان للمستشرقين الروس دور أساسي في إقامة تلك العلاقات. وتأسست في روسيا بفعل تلك العلاقات مدارس ومعاهد ومراكز أبحاث ومتاحف وسوى ذلك مما يقدم المعرفة بالعرب وبتراثهم الثقافي. وازداد الاهتمام الروسي بالعرب وبالشرق عموماً بعد انضمام عدد من البلدان الإسلامية في آسيا الوسطى إلى الأمبراطورية الروسية.
يقول الكاتب اليساري اللبناني يوسف مرتضى في كتابه “لبنان-روسيا صداقة لها جذور” الصادر عن “الدار العربية للعلوم”، استناداً إلى مراجعه الروسية، إن العلاقات الروسية مع العرب كانت بدأت في القرن العاشر، مع الرحّالة والحجّاج الروس لزيارة القدس. أما المستشرقون فبدأ اهتمامهم بالمنطقة العربية في القرن السابع عشر. وفي العام 1840 استُقدم الشيخ المصري محمّد الطنطاوي إلى روسيا لتعليم اللغة العربية في جامعة سان بطرسبورغ. وتتلمذ على يده كثيرون ممّن دخلوا في عالم الاستشراق الروسي. وفي العام 1882 بادر المستشرق الروسي فاسيني خيتروف إلى تأسيس “الجمعية الأمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية” بعدما نجح في إقناع الأمير سرجيوس عم القيصر قسطنطين بمشروعه. وصاغ خيتروف الأهداف الروسية المبتغاة من إنشاء تلك الجمعية في النقاط الآتية: تحفيز الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة، مساعدة المسافرين الروس إليها، تأليف الأخبار عن الأراضي المقدسة ونشرها بين الروس. وحدد في إطار الهدف الأول من تأسيس الجمعية: إنشاء مدارس من أجل أن يتعلّم ويتربّى فيها الأحداث في روح الإيمان القويم، بناء كنائس جديدة ومساعدة الكنائس القائمة، وتقديم المساعدة الطبية لسكان الأراضي المقدسة عامة من دون تفريق في الجنس والمذهب.
افتتحت الجمعية مدرستها الأولى في المجدل الفلسطينية في العام 1881. وفتحت في العام 1883 ثلاث مدارس في الرامة، ومدرستين في العام 1884، الأولى في كفر ياسين والثانية في الشحرة. وتوالى فتح المدارس الأرثوذكسية بعد ذلك لتشمل قرى فلسطينية جديدة، وصولاً إلى لبنان وسوريا. وبلغ مجموع تلك المدارس 114 مدرسة ضمّت 1500 تلميذ في العام 1914. واستدعت الجمعية إسكندر جبرايل كزما اللبناني الذي كان يدرس اللاهوت في موسكو للإشراف على سير عمل المدارس. كان ذلك في العام 1883، العام التالي لتأسيس الجمعية، التي قررت أن تنشئ في الناصرة تحديداً مدرسة للمعلمين. يذكر كزما في التقرير الذي ألقاه في اليوبيل الفضي للجمعية في العام 1906 أنّ المدرسة المشار إليها قد خرّجت في ذلك العام بالذات 120 معلّماً جرى تعيينهم في المدارس الابتدائية، وأرسل عدد منهم إلى روسيا لاستكمال علومهم في معاهدها.
ورغم أنّ الاهتمام الأول في تعميم المدارس الأرثوذكسية كان في فلسطين، فإن لبنان كان الهدف الثاني. فقد تمّ إنشاء 32 مدرسة في لبنان من أصل 114 في مجمل بلاد الشام، فلسطين وسوريا ولبنان.
رأيت أن الغاية من نشر المدارس الروسية الأرثوذكسية في تلك البلدان الثلاثة بدءاً بفلسطين بالذات كانت تتجاوز تأمين العلم للأجيال العربية، على أهمية ذلك ودلالاته. فالهدف كان تحويل روسيا بالتدريج إلى المرجع الأساس للأرثوذكسية في المنطقة والعالم. وكان لهذا الهدف بالذات هدف آخر يتمثل في تعزيز موقع روسيا في علاقات الصراع والتحالف مع دول أوروبا الكاثوليكية وفي الصراع مع خصمها التاريخي، السلطنة العثمانية.
غير أن نشر تلك المدارس كان قد تمّ في البلدان العربية قبل أن تتشكل كدول في أعقاب الحرب العالمية الأولى. أعدّت تلك المدارس الأرثوذكسية الروسية خلال ما يقرب من القرن ونصف القرن أعداداً كبيرة من الكفاءات العربية في شتى ميادين المعرفة. وبرزت من بين تلك الكفاءات أسماء لأدباء ومفكّرين تركوا بصماتهم على القرن العشرين كان من أبرزهم الأديب اللبناني الكبير ميخائيل نعيمة والباحثة الفلسطينية كلثوم عودة والباحث الفلسطيني بندلي حوزي. وأنجز الثلاثة دراستهم في المعاهد الروسية. وفي حين غادر نعيمة روسيا إلى لبنان ثم إلى أميركا الشمالية، بقي كلثوم عودة وبندلي حوزي في الاتحاد السوفياتي حتى آخر العمر. لكن نعيمة تميّز عنهما بأنّه روى تفاصيل حياته ودراسته وانطباعاته عن الفترة التي قضاها في روسيا في كتاب سيرته “سبعون” في الجزء الأول منه. وثمة عدد كبير من المتخرجين العرب في المدارس الأرثوذكسية في فلسطين ولبنان وسوريا وفي المعاهد الروسية ممّن ساهموا في تعميق العلاقة مع روسيا، من مواقعهم، خارج الصراعات والمصالح السياسية للأمبراطورية الروسية في تلك الحقبة من تاريخها.
يهمني أن أتوقف عند الأثر الكبير الذي مارسه الأدباء والفنانون الروس في القرنين التاسع عشر والعشرين في الثقافة العربية من أمثال بوشكين وغوغول وتشرنيشفسكي ودوستويفسكي وتولستوي وتشيخوف وآخرين. أشير إلى الرسالة التي وجهها الإمام محمد عبده في العام 1904 إلى تولستوي تضامناً معه ضد قرار الحرمان الذي اتخذته الكنيسة الروسية في حقه استنكاراً لمواقفه المبدئية في الفكر والسياسة. وللإمام محمد عبده شركاء من الأدباء والمفكرين العرب في العلاقة مع الأدباء والمفكرين الروس. يضاف إلى ذلك الأثر الذي مارسته الثقافة العربية القديمة في هؤلاء الأدباء الروس بالذات كما أشار إلى ذلك على وجه الخصوص الروائي الروسي غوغول في مقال له.
العصر السوفياتي
ازدهرت العلاقات الروسية العربية في العصر السوفياتي منذ بداياته في أعقاب انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية بقيادة لينين في العام 1917 حتى لحظة انهيار السلطة السوفياتية. وتمثلت أولى الإشارات المبدئية القيمية على تلك العلاقات في الموقف الذي اتخذه لينين فور انتصار الثورة باسم حق الشعوب في تقرير مصائرها، وذلك بفضح الاتفاق الذي حمل اسم الإنكليزي سايكس والفرنسي بيكو وثالثهما الروسي الذي فقد مكانه في الاتفاق بعد انتصار الثورة. وكان لينين يرمي من كشف ذلك الاتفاق فضح محتواه الاستعماري، من دون الدخول في موضوع تشكيل الدول العربية بعد سقوط السلطنة العثمانية في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. وكان تشكيل تلك الدول حدثاً تاريخياً مهماً، إذ هو أعطى العرب من خلال تلك الدول موقعهم في العالم حتى في ظل الانتداب الأجنبي، وهو انتداب استعماري، وصولاً إلى مرحلة الاستقلال.
كان همّ لينين الأساسي في فضح اتفاق سايكس بيكو تنبيه الشعوب العربية إلى المطامع الاستعمارية في بلدانها، مقدماً أول مثل لما كانت ترمي إليه ثورة أكتوبر في موضوع أساسي هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. وكان لثورة أكتوبر صداها في بلدان الشرق وفي أوروبا. إذ قامت ثورات في الصين وإيران وتركيا ومصر وألمانيا والمجر. لكن لأفكار ثورة أكتوبر قبل قيامها وانتصارها إرهاصات تمثلت في نضال البلاشفة تحت راية الاشتراكية منذ مطالع القرن العشرين، في أعقاب المؤتمر الثالث للحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي الذي عقد في العام 1903، وأدى الانقسام فيه إلى ولادة الحركة البلشفية بقيادة لينين. وكانت ثورة 1905 التي انطلقت من مدرعة بوتمكين في البحر الأسود على شواطئ مدينة أوديسا وفي شوارع موسكو ولينينغراد ومدن أخرى ضد ظلم القياصرة قد تركت تأثيراتها في مجرى الحوادث في روسيا، وفي أماكن أخرى بما في ذلك في بلداننا العربية. وربما تكون ثورة ليبيا بقيادة عمر المختار في العام 1911 وثورة المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي في العام 1914 قامتا تحت وهج تلك الثورة. إلاّ أنّ تأثير ثورة 1905، كان شديد الوضوح في مصر. فمن المعروف أن عدداً من ضباط وجنود مدرعة بوتمكين ومعهم مناضلون بلاشفة قد لجأوا إلى مصر، في الإسكندرية أولاً ثم في القاهرة. وترك هؤلاء تأثيرهم في صفوف المصريين واليونانيين والإيطاليين الذين كانوا يقيمون في الإسكندرية بأعداد كبيرة. وكان لهم دور في الحركة الشيوعية المصرية منذ البدايات.
يتحدث الدكتور رفعت السعيد أحد أركان حزب التجمع المصري والكاتب والمؤرِّخ للحركة الاشتراكية في مصر، عن أثر ثورة 1905 في مصر في كتابه “تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر”، متوقفاً بإسهاب عند العلاقة التي نشأت بين روسيا ومصر في زمن الثورة الاشتراكية وحتى قبل انتصارها، وأسست للعلاقة التاريخية مع البلدان العربية في زمن السلطة السوفياتية.
عندما أتحدث عن الثورة المصرية أفصل بوضوح بين وجهها السياسي المتمثل بالوفد بزعامة سعد زغلول، ووجهها الاجتماعي الذي برز في نضال العمال والفلاحين في المدن والأرياف الذي استمر عامين كاملين أسس خلالهما العمال والفلاحون ما صار يعرف بـ”جمهورية زفتي”! وتشير المعلومات التي جمعها الدكتور رفعت السعيد إلى أنّ للحركة الاشتراكية والعمالية في مصر تاريخاً يعود إلى مطالع القرن العشرين، تمثّل في تأسيس حزب عمالي ذي توجُّه اشتراكي وفي تأسيس نقابات عمالية. يضاف إلى ذلك ما تمثّل بعدد من كبار المفكّرين الذين حملوا راية الاشتراكية من أمثال سلامة موسى المصري وشبلي الشميل وفرح أنطون اللبنانيين اللذين كانا يقيمان وينشطان في مصر. وفي العام 1921 تأسّس الحزب الاشتراكي المصري. وكان سلامة موسى من كبار مؤسسيه. لكن الحزب سرعان ما انقسم في العام 1923، وأسس الشيوعيون الذين خرجوا منه الحزب الشيوعي المصري الذي كان أحد زعمائه حسني عرابي أول ممثّل عربي شارك في المؤتمر الرابع للكومنترن الذي عقد في موسكو في العام 1924، وأول عربي دخل مع رفاق له من الحزب الشيوعي المصري في العام ذاته في “جامعة كادحي شعوب الشرق” التي أسستها الأممية الشيوعية لتأهيل الكوادر الشيوعية الجديدة الآتية إليها من جميع البلدان.
بالنسبة إلى العراق أشير إلى ما ذكره لي الباحث والمؤرخ السوري الدكتور جمال باروت بأن مجموعة بولشفية كانت قد تأسست في شمال سوريا في العام 1920 عشية اندلاع الثورة السورية بقيادة سلطان الأطرش بين عامي 1925 و1927. لكن من أهم ما قام به البلاشفة، بعد تأسيس الأممية الشيوعية في العام 1919 بقيادة لينين، دعوتهم إلى مؤتمر لشعوب الشرق عقد في مدينة باكو عاصمة أذربيجان في العام 1920 شارك فيه ثلاثة من العرب لم أعرف إلاّ اسماً واحداً منهم هو إسماعيل حقي الذي لم يذكر في جدول أسماء المشاركين البلد الذي يمثّله بين العديد من البلدان التي شاركت في المؤتمر. وكان هدف المؤتمر التوجّه إلى شعوب الشرق لاختيار طريقها إلى الحرية وممارسة حقها في تقرير مصائرها، وفق ما أكّده لينين، قبل انتصار ثورة أكتوبر وبعد انتصارها، حول حق الشعوب في تقرير مصائرها.
كان لمؤتمر باكو المشار إليه أهمية كبيرة وأثر كبير في العديد من بلدان الشرق ومنها بلداننا العربية. وقد تركت الأممية الشيوعية بعد تأسيسها في العام 1919، لا سيما في المؤتمرات الثلاثة الأولى بقيادة لينين، تأثيراً بالغ الأهمية في العالم ومنها بلداننا استناداً إلى القرارات التي اتخذتها تأكيداً لحق الشعوب في تقرير مصائرها ولما قدمته من أفكار ومشاريع استناداً إلى مشروع ماركس العظيم لتغيير العالم. ساهمت الأممية الشيوعية منذ البدايات في تأسيس أحزاب شيوعية وهيّأت الشروط لنشوء حركات وطنية تحررية رأت في الاتحاد السوفياتي بلد الاشتراكية الأول سنداً أساسياً لها في نضالها من أجل تحررها وتقدمها.
أول من زار الاتحاد السوفياتي من العرب في العام 1921 كان الأمير شكيب أرسلان بدعوة من أنور باشا. ثم زاره في العام 1927 للمشاركة في احتفالات الذكرى العاشرة لانتصار ثورة أكتوبر رغم أنّه لم يكن شيوعياً. والأمير شكيب أرسلان هو واحد من كبار الشخصيات الوطنية العربية المعروفة.
بدأ تشكيل الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية في فلسطين أولاً وذلك في العام 1919. وكان اليهود الفلسطينيون هم المؤسسون للحزب بمشاركة عربية ضعيفة في بادئ الأمر. ثم تأسس الحزب الشيوعي في مصر في العام 1923، والحزب الشيوعي في لبنان وسوريا في العام 1924، والحزب الشيوعي العراقي في العام 1934. ثم توالى تأسيس أحزاب شيوعية في بلدان عربية أخرى. وكان ذلك يتم باسم الأُممية الشيوعية وبمشاركة مباشرة أو لاحقة من موفديها إلى هذه البلدان. ومع بداية تأسيس هذه الأحزاب بدأت تتطور علاقة من نوع جديد مختلف بين روسيا السوفياتية والبلدان العربية. وتشكّلت بقرار من الأُممية الشيوعية “جامعة كادحي شعوب الشرق” المشار إليها آنفاً. وكان أول من انتسب إليها بعد حسني عرابي ورفاقه المصريين الفلسطيني نجاتي صدقي في العام 1925 والجزائري محمود الأطرش في العام 1927. وكنت أنا من بين الذين التحقوا بها في أواخر العام 1966 بعد أن كان قد أعطي لها إسم آخر. وكنت مع جورج حاوي من جيل الشباب اللذين تم اختيارنا في مطلع ذلك العام بالذات في اجتماع للجنة المركزية بقرار من الأمين العام للحزب نقولا شاوي لنكون عضوين في أعلى هيئتين قياديتين في الحزب هما المكتب السياسي والسكرتاريا إلى جانب القياديين من الحرس القديم. أما الكومنترن، الاسم الذي اتخذته الأُممية الشيوعية، فكان أول من شارك في أعماله من العرب في المؤتمر الرابع في العام 1924 المصري حسني عرابي. وشارك في المؤتمر السادس في العام 1928 الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني فؤاد الشمالي. ومن الطرائف المتصلة بمشاركة الشمالي في هذا المؤتمر أنّه كان قد خرج من المنفى وتحرر من حكم الإعدام مع رفيقه أرتين مادايان بسبب دعم الحزب اللبناني للثورة السورية. الأهم من ذلك أنّ الشمالي كان طرح في المؤتمر فكرة استبدال اسم الحزب الشيوعي باسم حزب الشعب الذي كان شارك في تأسيسه في العام 1925 وانتخب أميناً عاماً له، فرفض اقتراحه استناداً إلى أن الأممية الشيوعية لا تستقبل في صفوفها إلا أحزاباً شيوعية. والمعروف أنّ الشمالي كان من مؤسّسي الحزب الشيوعي المصري مع اثنين من رفاقه هما أنطون مارون ورفيق جبور، وأنّه طرد من مصر بعد اعتقال رفيقيه وزملائهما المصريين من قادة الحزب في ظل حكومة سعد زغلول. ساهم الشمالي بعد عودته من مصر إلى لبنان في تشكيل الحزب الشيوعي اللبناني، ثم حزب الشعب. وفي المؤتمر السابع للكومنترن في العام 1935 شارك عربي ثانٍ هو محمود الأطرش الجزائري الذي انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للكومنترن. وتبعه في ذلك الموقع لاحقاً خالد بكداش بعد أن أصبح الأمين العام للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان.
غير أنّ العلاقات التي توطدت في المرحلة الأولى عبر الأحزاب الشيوعية بين السلطة السوفياتية والبلدان العربية لم تستمر في الاتجاه ذاته في المراحل اللاحقة. فهي اتخذت بعد الحرب العالمية الثانية أشكالاً أخرى تراوحت بين اتجاهين إيجابي وسلبي. إذ لم تعد الأحزاب الشيوعية هي الواسطة الأساس في تلك العلاقة. فقد دخلت على تلك العلاقة في الإيجاب وفي السلب قوى أخرى كانت السلطات في عدد من البلدان العربية صاحبة الدور الأول فيها، ولا سيما في المرحلة التي تلت وفاة ستالين في العام 1953.
كنتُ في مطالع شبابي في العام 1945 قد بدأت أمارس العمل السياسي قومياً عربياً رومنطيقياً. ثم تحولت في العام 1948 إلى الاشتراكية عندما كنت أُقيم عند ابن عم والدي الشهيد حسين مروّه لمتابعة دراستي في مدارس بغداد. حصل ذلك التحول في مسار حياتي تحت تأثير الصدمات والخيبات التي كان قرار تقسيم فلسطين الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947 أكثرها إيلاماً لي. وكتبت تحت تأثير تلك الخيبات، قبل أن أُعلن انتمائي إلى الاشتراكية، مقالاً في جريدة “الرأي العام” لصاحبها الشاعر محمد مهدي الجواهري تحت عنوان “لا بدّ من ثورة” نشره لي الجواهري في صدر الصفحة الأولى من الجريدة. وكان ذلك في كانون الأول 1947. سرعان ما قادني انتمائي إلى الاشتراكية إلى البدء في رحلة طويلة لم تنته، قمت فيها بزيارات متعددة إلى الاتحاد السوفياتي ابتداء من العام 1954، وتعرفت من خلالها إلى السمات المميزة للشعب الروسي العريق، كما تعرفت إلى الشيوعية عن قرب من خلال الإقامات الطويلة التي امتدت من موسكو إلى عواصم جميع الدول الاشتراكية.
أود أن أشير إلى موقف سوفياتي مهم بالنسبة لي كمواطن لبناني. ففي العام 1946 وفي أحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي جرت فيه مناقشة وجود القوات الفرنسية والبريطانية في سوريا ولبنان والطلب الموجه من قادة الدولتين بإخراج تلك القوات من بلديهما، استخدم المندوب السوفياتي فيشينيسكي الفيتو للمرة الأولى دعماً لسوريا ولبنان ضد استمرار وجود القوات البريطانية والفرنسية فيهما. وبموجب ذلك الفيتو تم إجلاء القوات الأجنبية في كانون الأول 1946 من لبنان وفي نيسان 1947 من سوريا.
أود أن أشير إلى أن موقف الاتحاد السوفياتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة من القضية الفلسطينية كان يقضي بإنشاء دولة ثنائية القومية من العرب واليهود، آخذاً في الاعتبار كثافة أعداد اليهود في فلسطين بفعل الهجرة خلال الحرب وبعدها. وإذْ رفض ذلك الاقتراح وتفاقم الصراع المسلح بين العرب واليهود بتشجيع من الانتداب البريطاني، اقتنع الاتحاد السوفياتي بمشروع تقسيم فلسطين بالاتفاق مع الدول الغربية: دولة فلسطينية عربية ودولة يهودية باسم إسرائيل. وحددت لكل من الدولتين الأراضي العائدة لها. وكان في مضمون القرار 81 لتقسيم فلسطين تأكيد لضرورة العمل بالتدريج لإقامة إتحاد فيديرالي بين الدولتين تخفيفاً لحدة الصراع وصولاً إلى إلغائه. وكان ذلك هو الموقف الأساسي للاتحاد السوفياتي في الموافقة على قرار التقسيم. إلا أن خطاب المندوب السوفياتي في الأمم المتحدة أندره غروميكو الذي ألقاه بعد صدور القرار قد أساء إساءة كبيرة إلى الموقف السوفياتي بتركيزه على إسرائيل ودعم الاتحاد السوفياتي لها، الأمر الذي جعل العرب يعتبرون الاتحاد السوفياتي هو المسؤول عن ذلك القرار. فاقم الأمر اتخاذ الأحزاب الشيوعية العربية موقفاً مؤيّداً لقرار التقسيم بطلب مباشر من الاتحاد السوفياتي، خلافاً لما كان صدر عن تلك الأحزاب من بيانات سابقة على قرار التقسيم مندّدة بتقسيم فلسطين، ومؤكّدة أن فلسطين دولة عربية من البحر إلى البحر. وصدر بيان حول هذا الموضوع وقّعته الأحزاب الشيوعية في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق. وعندما عرض البيان على اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان اقترح القيادي فرج الله الحلو التمايز عن الموقف السوفياتي بشأن القرار، مراعاة للواقع العربي ولكون الحزب كان أصدر قبيل قرار التقسيم بيانات ترفض التقسيم، ولكون فرج الله بالذات كان كتب مقالات مؤكداً ذلك الموقف برفض التقسيم. لكن فرج الله الحلو عاد ووافق على مضمون بيان الأحزاب الشيوعية المشار إليه. أما سكرتير الحزب في سوريا رشاد عيسى فاعترض بحزم على البيان وخرج من الحزب وظلَّ حتى آخر لحظة من حياته على موقفه من دون انزياح. في حين أنّ إميل توما القيادي في الحزب الشيوعي الفلسطيني عوقب ثم عُفي عنه بعد عودته من لبنان إلى فلسطين في العام 1948.
لم يعاقب فرج الله الحلو على موقفه في ذلك الحين بالذات. بل تأخر العقاب إلى مطالع العام 1950 من دون أن يشار إلى موقفه من قرار التقسيم. وفرض عليه أن يكتب رسالة نقد ذاتي حملت عنوان “رسالة سالم”، منتقداً ذاته ومواقفه كبورجوازي صغير. وجرّد لفترة عامين من الموقع الذي كان فيه نائباً لرئيس الحزب الشيوعي اللبناني وعضواً في المكتب السياسي في الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان.
تلك هي قصة قرار التقسيم التي رأيت من الضروري أن أُفرج عن معلوماتي حولها إراحة للضمير وللنفس. لكن المأساة في هذه القصة لا تكتمل إذا لم أضف إليها الجزء المتعلّق بموقف كان سائداً عند بعض القادة السوفيات، وهو موقف كان مليئاً بالوهم حول احتمال أن يلعب اليهود المهاجرون من أوروبا الشرقية من أتباع حركة “البوند” ذات الاتجاه الاشتراكي الماركسي دوراً إيجابياً داخل دولة إسرائيل. وهي حركة كانت لها أدوار معروفة في المرحلة الأولى من الثورة الروسية وحتى قبل قيامها. وكانت تلك الحركة على علاقات ودّ وخصام مع لينين. إلا أن هذا الموقف القائم على الوهم لم يعش طويلاً. إذْ سرعان ما بدأت القيادة السوفياتية بعد وفاة ستالين تمارس بالتدريج سياسة التحرر من المواقف السوفياتية السابقة في عهده ومن التباساتها ومن نتائجها المدمرة في العلاقة مع العالم العربي، وتأثير تلك المواقف في الأحزاب الشيوعية العربية في شكل أكثر تحديداً. أقول بمرارة، في ضوء ما آلت إليه الأوضاع في فلسطين منذ حرب 1948، يا ليتنا كنا وافقنا على قرار التقسيم، إذ كنا بذلك قد وفرنا على الشعب الفلسطيني خصوصاً وعلى سائر شعوبنا العربية في لبنان وسوريا والأردن ومصر الآلام والتضحيات الجسام والكارثة الكبرى التي تحمل اليوم اسم القضية الفلسطينية التي تستعصي على الحل!
في العام 1955 بدأت السياسة السوفياتية تتغير تجاه العالم العربي إيجابياً. وكان وصل إلى السلطة نيكيتا خروتشوف أميناً عاماً للحزب، معلناً تمايزه الكامل عن مواقف ستالين في أمور سياسية عديدة. وكان أول موقف تضامني مع العرب في صفقة السلاح التي وقّعها الرئيس جمال عبد الناصر بدعم سوفياتي مع تشيكوسلوفاكيا بديلاً من الدول الغربية التي لم تستجب طلبه. ثم توالت المواقف الإيجابية. ففي العام 1956، اتخذ الاتحاد السوفياتي موقفاً لافتاً تمثل بدعم مصر في تأميم قناة السويس وبناء السد العالي. تبع ذلك الموقف، الإنذار الشهير الذي وجهه رئيس الحكومة السوفياتية بولغانين إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لإيقاف عدوانها على مصر في العام ذاته وهددها بالتدخل العسكري إذا هي لم تنسحب من الأراضي المصرية. وكان بولغانين يستند في موقفه الحاسم ذاك إلى القرار الذي كانت اتخذته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأكثرية ساحقة تطالب الدول الثلاث بالانسحاب الفوري من مصر. وكان لافتاً في ذلك الحين موقف الولايات المتحدة الأميركية الذي كان إلى جانب القرار. ولم تمض فترة قصيرة حتى ظهرت دلالات الموقف الأميركي بإعلان مبدأ أيزنهاور الشهير الذي حلّت أميركا بموجبه في العالم وفي المنطقة العربية محل الدولتين العظميين بريطانيا وفرنسا. ومعلوم أن الدول الثلاث باشرت الانسحاب من الأراضي المصرية فور إنذار بولغانين.
في تلك الفترة بالذات بدأ يتقلص الدور القديم للأحزاب الشيوعية في العلاقة مع الاتحاد السوفياتي، إذ راحت تتوطد تلك العلاقة بين السلطة السوفياتية والسلطات القائمة، وبعض الحركات الوطنية والتقدمية العربية ذات المواقع الأكثر تأثيراً في المجتمعات العربية. تكوّنت في تلك الفترة أحزاب ذات توجّه اشتراكي مثل الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان بقيادة كمال جنبلاط في العام 1949، وحزب البعث العربي الاشتراكي بالقيادة المشتركة من ميشال عفلق وأكرم الحوراني في العام ذاته، وحركة القوميين العرب برئاسة جورج حبش ولاحقاً جبهة التحرير الجزائرية بعد حصول الجزائر على الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في مصر والاتحاد الاشتراكي في المغرب وسوى ذلك من الأحزاب الجديدة ذات التوجّه الوطني والتقدمي والاشتراكي. ثم تأسست في ما بعد حركة “فتح” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” و”الجبهة الديموقراطية” لتحرير فلسطين ومنظمات فلسطينية أخرى. وأعطى الاتحاد السوفياتي تلك الأحزاب بالتدريج اهتماماً أكبر من الأحزاب الشيوعية التي ظلّت في معظمها مرتبطة عضوياً بالاتحاد السوفياتي، تنفذ قراراته وتؤيد مواقفه من دون نقاش.
أذكّر بأن تغييراً جوهرياً كان بدأ يحدث في مواقف الاتحاد السوفياتي بدور من ستالين بعد وفاة لينين مباشرة. إذ تحوّل الاتحاد السوفياتي إلى سلطة دولة كبرى في طريق التكوّن ذات مصالح. وتحوّلت بالتدريج الأُممية الشيوعية بمؤسساتها التي اتخذت أسماء مختلفة، وهي تتوسع في العالم، إلى أداة حصرية في خدمة السلطة السوفياتية. وكانت الأحزاب الشيوعية التي تنتمي إلى الأممية الشيوعية تقوم بذلك الدور من تلقاء ذاتها باقتناع تام. وكان يشاركها في ذلك الدور، من المنتمين إلى صفوفها ومن خارج الانتماء كبار الأدباء والفنانين في العالم ومن ضمنهم أدباء كبار من بلداننا العربية. شيئا فشيئاً تغيّرت طبيعة العلاقة، التي كانت تربط روسيا السوفياتية بالبلدان العربية. وتغيّر بالتدريج الطابع الثوري الرومنطيقي القديم للأممية الشيوعية ذاتها.
أشير في هذا السياق إلى أنّ علاقة من نوع جديد كانت بدأت تنشأ في عهد خروتشوف ولاحقاً في عهد بريجنيف مع الأنظمة العربية التي تكوّنت بالانقلابات العسكرية في كل من سوريا والعراق ومصر والسودان وليبيا. وكان التنظير لتلك العلاقة يستند إلى ثلاث موضوعات نظرية من اختراع مفكّري السلطة السوفياتية في مقدمهم البروفسور بوليانوفسكي، الأولى موضوعة “التطور اللارأسمالي” التي تقول بإمكان الانتقال من النظام الاقطاعي إلى الاشتراكية من دون المرور الحتمي بالنظام الرأسمالي استناداً إلى واقع أن الطبقة العاملة كانت ضعيفة في تلك البلدان وأن الأحزاب الشيوعية كانت ضعيفة التأثير. الموضوعة الثانية تقول بوجود مجموعة من “الديموقراطيين الثوريين” في البلدان النامية ومنها بلداننا العربية، الذين جرى التنظير بأنهم هم الذين يمكن أن يقوموا بالتحول في اتجاه الاشتراكية من دون المرور بالنظام الرأسمالي. وارتبطت بأسماء وتوجهات بعضهم صفة قريبة من الإشتراكية هي التي صارت تعرف باسم التوجه الإشتراكي. أما الموضوعة الثالثة فكانت من اختراع المفكر ميرسكي التي تقول بأن للجيوش في بلدان العالم الثالث دوراً أساسياً في التغيير المشار إليه في الموضوعتين الأولى والثانية. وكان من النتائج التي ترتبت على تلك الموضوعات النظرية أن قادة الدول العربية الذين جاؤوا إلى السلطة بانقلابات عسكرية هم الأقرب إلى السلطة السوفياتية من الأحزاب الشيوعية. هؤلاء هم بالتسلسل جمال عبد الناصر وهواري بومدين وحافظ الأسد وجعفر النميري وحتى صدّام حسين ومعمّر القذافي. وحظوا جميعهم، بنسب متفاوتة، بدعم كبير سياسياً واقتصادياً وعسكرياً من الاتحاد السوفياتي. وتمّ ذلك، من الناحية العملية، على حساب الأحزاب الشيوعية التي كانت تعاني الاضطهاد من قادة تلك الأنظمة جهاراً ومن دون أدنى حساب لأي اعتبار، ولا سيما ما يتصل بتلك العلاقة المميزة التي كانت تربط أولئك القادة بالسلطة السوفياتية. فقدت الأحزاب الشيوعية في تلك المرحلة بالذات وفي ظل تلك العلاقة المميزة بين السلطة السوفياتية وقادة الأنظمة العربية الإستبدادية، عدداً من كبار قادتها وكوادرها تحت التعذيب، أخص منهم القيادي في الحزب الشيوعي السوري – اللبناني فرج الله الحلو الذي جرى تذويب جسده بالأسيد في دمشق عاصمة الجناح السوري من الجمهورية العربية المتحدة، والقيادي في الحركة الشيوعية المصرية شهدي عطية الشافعي. وظلَّ دور الأحزاب الشيوعية العربية ينحسر بالتدريج وصولاً إلى دخولها في أزمات وانقسامات جعلتها قوى هامشية. وعوقبت الأحزاب التي تمرّدت أو تمايزت بحدود معينة عن المواقف السوفياتية، بأشكال فظة مارستها أجهزة المخابرات وأدت إلى تقسيم تلك الأحزاب وطرد عناصر قيادية منها. وكان الحزب الوحيد الذي انتصر على الإرادة السوفياتية، برغم التدخل الفظ لأجهزة المخابرات، هو الحزب الشيوعي اللبناني في ثورته التجديدية في العام 1966 التي كنت أحد المشاركين في قيادتها. ورغم أن جيل الشباب تمكن من الانتصار فيها على مدى عام من الصراع الحاد مع المخابرات السوفياتية، فإن العقاب الذي طال حزبنا تمثل بتوجيه تهمة العمالة للمخابرات الأميركية إلى جورج حاوي نظراً إلى الدور الريادي الذي كان له في تلك الحركة. وكان سوسلوف وبونماريوف القياديان البارزان في الحزب الشيوعي السوفياتي، بطلي تلك التهمة الزائفة الرعناء. تمثل انتصار ثورة التجديد تلك في القرارات التي اتخذها المؤتمر الثاني للحزب في العام 1968، ومن ضمنها إعادة الاعتبار إلى جورج حاوي وعودته إلى مواقعه الأساسية في قيادة الحزب. وكان من أهم تلك القرارات التأكيد أن الحزب الشيوعي اللبناني هو وحده الذي يحدد سياساته ومواقفه في وطنه لبنان، وهو وحده الذي يحدد مواقفه من القضايا العربية. إلى ذلك، قرار يتعلق بالديموقراطية وبالطابع الإنساني في الإشتراكية وبحرية الفرد كأساس في الانتماء إلى الشيوعية. وحرص الحزب على إبقاء علاقاته مع الاتحاد السوفياتي كمركز أممي للحركة الشيوعية. تعامل الحزب الشيوعي السوفياتي مع القيادة الجديدة للحزب اللبناني على أساس تلك القرارات. واستقبل سوسلوف وبونماريوف بالذات في مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في موسكو، جورج حاوي بعد ثلاثة أعوام من ذلك التاريخ برفقة الأمين العام للحزب نقولا شاوي. هذا ما حصل في حزبنا. غير أنني كنت شاهداً على الموقف السوفياتي من بعض الأحزاب الشيوعية العربية والأجنبية ولا سيما الحزب الشيوعي السوداني في العام 1970 خلال مشاركتي في ملتقى الخرطوم الفكري الذي دعا إليه أحد وزراء النميري، وشاركت فيه جميع الأحزاب العربية في السلطة وخارجها من دون استثناء. إذ كان الحزب السوداني منقسماً بين فريق يشارك في حكومة النميري بدعم من الاتحاد السوفياتي وفريق آخر بقيادة الأمين العام للحزب عبد الخالق محجوب الذي كان معترضاً على سياسة النميري. وانتهى الأمر بذلك الصراع وبدور مباشر من المخابرات السوفياتية إلى تدمير الحزب السوداني في ذلك التاريخ.
إلاّ أنّ من المهم ألاّ ننسى الدعم الاستثنائي الذي قدّمه بلد الاشتراكية الأول للبلدان العربية في شتى المجالات. وأخص منها فتح أبواب المعاهد السوفياتية للطلاب في شتى مجالات التخصص، الذين بلغ عددهم عشرات الألوف. يضاف إلى ذلك ما قدمه الاتحاد السوفياتي من الدعم في المجال الثقافي. فقد كانت “دار التقدم” تنشر المئات من الكتب في شتى مجالات المعرفة. وكان للأدب وللفن السوفياتيين دور بالغ الأهمية في التأثير في الجيل الجديد من الأدباء والفنانين العرب. ونشأت مع الوقت نظرية جديدة في الأدب والفن هي ما صار يعرف بـ”الواقعية الاشتراكية في الأدب والفن”. كان من أبطالها ثلاثة أدباء كبار هم محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس في كتابهما المعروف، “في الثقافة المصرية”، الذي قدم له حسين مروّه زميلهما في الانتماء إلى “الواقعية الاشتراكية في الأدب والفن”. وكان من أكثر الذين تأثرت بهم أجيال الاشتراكيين في بلداننا وفي البلدان الأخرى، الأديب السوفياتي الكبير مكسيم غوركي ولا سيما في روايته “الأم”، وكذلك الشاعر ماياكوفسكي. يضاف إلى ذلك من الجانب الآخر اهتمام الكتّاب والباحثين السوفيات، وقبلهم الروس في زمن القياصرة، بالتراث العربي القديم وبالحوادث العربية الكبرى. وألّفوا العديد من الكتب كان من أبرزها في التاريخ القديم نسبياً كتاب لوتسكي، “تاريخ الشعوب العربية”. وتشكلت في البلدان العربية تعزيزاً للعلاقات مع الاتحاد السوفياتي جمعيات صداقة عربية سوفياتية، كان لبنان رائداً فيها، في مطلع الأربعينات خلال الحرب العالمية الثانية، رئيسها الأديب الكبير عمر فاخوري، ثم خلفه بعد وفاته في العام 1946 الطبيب والأديب الدكتور جورج حنا. كما تشكلت جمعيات للمتخرجين في كل البلدان العربية للهدف ذاته. لكن الدعم الاقتصادي والعسكري للبلدان العربية كان بلا حدود. وأذكر أن الرئيس جمال عبد الناصر استنجد بالاتحاد السوفياتي في أواخر الستينات من القرن الماضي بسبب نقصان مادة القمح. وكان الاتحاد السوفياتي قد استقدم من كندا صفقة قمح كبيرة فحوّلها بريجنيف فوراً إلى مصر تلبية لطلب عبد الناصر.
جميع ما أشرت إليه وتوقفت عنده من مظاهر ومستويات في العلاقة السوفياتية العربية إنما تفاصيل إذا ما نحن وضعناها في الهم الأساسي عند القيادات السوفياتية المتعاقبة في العلاقة مع البلدان العربية. فقد ظلَّ الاتحاد السوفياتي على مدى العقود نصيراً للقضايا العربية ومن ضمنها القضية الفلسطينية قدر استطاعته. فالدعم السوفياتي لم يكن وحده المقرر في هذا الأمر. فأصحاب القضية هم الأصل في كل عمل سياسي واقتصادي وعسكري لا سيما العسكري في الحروب بين البلدان العربية وإسرئيل من حرب 1948 حتى حرب 1973 مروراً بالعدوان الثلاثي على مصر وحرب 1967. المسؤولية عن الهزائم العربية في تلك الحروب إنما تعود للدول العربية أولاً وأخيراً. أذكر أنني كنت مع بعض رفاقي في قيادة الحزب الشيوعي اللبناني نناقش مع بونماريوف عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوفياتي خلال وجودنا في موسكو حول القضية الفلسطينية، حين قال لنا بلهجة صارمة رداً على سؤال أحدنا حول الموقف من احتلال إسرائيل لفلسطين بأنكم مخطئون إذا كنتم تتصورون أننا سنقف ضد حرب تقوم بها الجيوش العربية لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. والدليل على ذلك هو الدعم الذي قدمناه ولا نزال نقدمه لمصر وسوريا بالسلاح والخبرات العسكرية. وقد انهزمت هذه الجيوش في حروبها. هل نحن المسؤولون عن هزائمها؟ مثل هذه النقاشات وسواها التي كنت شريكاً فيها في لقاءات أخرى تمت مع عدد من القادة السوفيات أذكر منهم إلى بونماريوف، بريجنيف وسوسلوف وكرلنكو وشرنينكو وليغاتشوف ودوبرينين. جميع هؤلاء كانوا في مواقع أساسية في قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي.
إلا أن قراءة موضوعية اليوم للحقبة السوفياتية، تشير بوضوح إلى أن الدعم السوفياتي للبلدان العربية منذ عهد خروتشوف حتى عهد غورباتشيوف مروراً بعهد بريجنيف إنما كان من الناحية العملية دعماً للأنظمة الاستبدادية ولقادتها. لقد بددت تلك القيادات كل ذلك الدعم، إذ حوّلته لتعزيز مواقعها في السلطة وقمع طموحات شعوبنا في الحرية والتقدم. ما نشهده اليوم وقبل ذلك بعقود عن أحوال بلداننا العربية يؤكد ذلك. ولا أظنني بحاجة إلى الحديث عما آلت إليه الأوضاع في بلداننا في ظل أنظمة الاستبداد من تراجع وتقهقر وظلم واضطهاد وخراب وحروب أهلية.
العلاقات الروسية العربية المضطربة في زمن ما بعد الشيوعية
كانت السنوات الأخيرة من عمر الاتحاد السوفياتي بائسة. فقد بلغت الأزمة السياسية التي كان يعاني منها الحد الذي بدا للكثيرين، وأنا واحد منهم بحكم تجربتي ووجودي المتواصل في الاتحاد السوفياتي، أن الدولة السوفياتية كانت تسير بسرعة في الطريق إلى الانهيار. كان ذلك في عهد غورباتشيوف ومشروعه الوهمي في إعادة البناء، البيريسترويكا. لذلك بدأت البلدان العربية تفقد بالتدريج الدعم الذي كانت تتلقاه من الاتحاد السوفياتي. وكان البرهان الساطع على الخلل الذي كان يعاني منه الاتحاد السوفياتي موقفه الضعيف من الغزو الإسرائيلي للبنان (1982). إذ وصلت الوقاحة الإسرائيلية والضعف السوفياتي حد اقتحام إحدى الدبابات الإسرائيلية المدخل الرئيسي للسفارة السوفياتية في بيروت من دون رادع. وظلّ التراجع يتواصل عاماً بعد عام إلى أن انهار البنيان العظيم وأحدث انهياره زلزالاً بمستوى ما كان يمثله الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية العالمية في العالم على امتداد ثلاثة أرباع القرن. وتفرقت الدول التي كان يتشكل منها الاتحاد السوفياتي. وكنّا نحن العرب أكبر الخاسرين من زوال الاتحاد السوفياتي. وبقيت روسيا بعد انهيار الشيوعية وحدها تواجه تبعات الانهيار داخلياً وعلى الصعيد العالمي. وغاب العرب عن الهم الروسي في المرحلة الأولى في عهد يلتسين الذي كانت المافيات فيه تدمر الاقتصاد وكل ما كان يعبّر عنه موقع الاتحاد السوفياتي كدولة عظمى. وكان للمخابرات الأميركية ولشركاء يلتسين في الحكم في ذلك الحين دورهم في ذلك التدمير المنظم لروسيا ما بعد الشيوعية. لكن روسيا في عهد الرئيس بوتين بدأت تتغير ببطء في الاتجاه الذي يعيد روسيا إلى موقعها كقطب عالمي في شروط جديدة. غير أن المهمة كانت ولا تزال صعبة وبالغة التعقيد.
إن لنا نحن العرب دولاً وشعوباً، مصلحة أساسية في علاقات مميزة ومتعددة الجوانب مع الاتحاد الروسي بمعزل عن نوع النظام السياسي السائد فيه. فروسيا تظل الدولة العظمى الجارة لنا. كما تظل وارثة تاريخ مجيد من علاقة الصداقة التي لا تنسى. لكن روسيا اليوم التي نريد أن نراها دولة عظمى هي دولة عظمى لكن بشروط أقل مما كانت عليه في زمن الأمبراطورية وزمن الاتحاد السوفياتي. فهي لا تزال تدفع ثمن الانهيارات التي تلت سقوط النظام الشيوعي، في زمن حكم يلتسين والمافيات التي مزقت الاقتصاد الروسي وبددت ثروات الدولة، وحوّلت روسيا إلى دولة ذات اقتصاد ريعي. صحيح أن التاريخ يبقى هو التاريخ، والتراث يبقى هو التراث، والثروات في باطن الأرض وعلى سطحها تبقى هي الثروات. لن أتحدث عن القوة العسكرية فهي موجودة. لكنها في العصر الذي نحن فيه لم تعد لها الأولوية المطلقة كما كانت الحال في الزمن الماضي. فالاقتصاد، مرفقاً بالسياسة، هو سيد الموقف في عصرنا. فأين هو الاقتصاد الروسي اليوم وأين هي السياسة الروسية اللذان يعطيان روسيا المكانة التي هي للدولة العظمى في العصر العالمي الجديد؟!
حاول الرئيس بوتين أن ينهض بالاقتصاد. وهو لا يزال يحاول جاهداً. لكنه لا يزال في منتصف الطريق إلى الغاية المبتغاة. إلى الاقتصاد هناك السياسة، وهي في الزمن الحالي في روسيا في مستوى الوضع الاقتصادي، أو هكذا أراها من بعيد ولا سيما بالنسبة للقضايا المعقدة التي تواجهها بلداننا في زمن الثورات وفي زمن الحروب الأهلية التي يعيش فيها أكثر من بلد عربي.
أتساءل مثلما يتساءل الكثيرون ممن هم في الموقف الذي أنا فيه إزاء تأكيد مصلحتنا نحن العرب في العلاقة مع روسيا التاريخ والثقافة والمصلحة، ومع روسيا الحاضر، روسيا التي نريدها أن تكون دولة عظمى، ما هي طبيعة السياسة الروسية إزاء بلداننا في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها؟! الأهمية الأساسية لتساؤلي هذا إنما تعود إلى أن الموقع الذي نريده لروسيا كمصلحة لبلداننا ولشعوبنا لا ينحصر في تحقيق التوازن مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا فقط، بل أساساً في الدعم الذي يمكن أن تقدمه لنا روسيا في مواجهة القضايا المعقدة التي أورثتنا ولا تزال تورثنا إياها الأنظمة الاستبدادية التي دمرت ولا تزال تدمر بلداننا. فنحن اليوم، على وجه التحديد، بأمس الحاجة إلى دور روسي مميّز في العلاقة مع بلداننا وهي تواجه أزمة بنيوية بفعل الحروب الأهلية والأسباب التي قادت إليها والنتائج التي ترتبت عليها. وواضح أنّ الموقف الروسي اليوم من الأزمة السورية على وجه التحديد هو موقف مضطرب ومرتبك، أي أنه موقف غير مؤثّر في الحوادث المعقدة الجارية التي تعيشها سوريا منذ أربعة أعوام من دون أفق واضح حول النهاية المأسوية التي تزداد تفاقماً، وتدفع سوريا ويدفع الشعب السوري الثمن الباهظ لها لعقود طويلة. فالموقف الروسي المعلن من الأزمة في سوريا هو إلى جانب النظام بحجة أن المهمة الآن هي مواجهة التيار السلفي المتمثل بـ”داعش” و”النصرة” وسواهما. لقد أتيح لي أن ألتقي في العام الماضي مرتين مع نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف وهو صديق قديم. وسمعت منه وجهة نظر القيادة الروسية التي تعتبر أنّ المهمة الرئيسية اليوم في سوريا هي القضاء على التكفيريين. وهو موقف صحيح من حيث المبدأ. ويشير تطور الحوادث إلى تفاقم دور هؤلاء في البلاد، إذ باتوا يستولون على أقسام واسعة من أراضي سوريا ويمارسون أبشع أنواع القتل والتدمير. ويتحمل المسؤولية في ذلك منذ البداية حتى الآن النظام السوري، نظام الاستبداد الذي يريد أركانه الاستمرار في السلطة مهما كان الثمن، وهو ثمن باهظ، ولتذهب سوريا بعد ذلك إلى الجحيم! حجم التدمير والقتل والتهجير الذي يمارسه النظام يكمّل ما يمارسه “داعش” وأخوته وأخواته من وحشية.
سألت صديقي بوغدانوف، وشاركني في ذلك أصدقاء آخرون، عن مصلحة روسيا في دعم النظام السوري، انطلاقاً من اقتناعي بأن النظام السوري هو نفسه المسؤول عن الكارثة المتمثلة بوجود هؤلاء التكفيريين. واقترحت عليه أن تسعى القيادة الروسية إلى وضع حل لسوريا شبيه بالذي حصل في لبنان في نهاية الحرب الأهلية، أي في صيغة طائف ما تشارك في رعايته روسيا مع البلدان العربية وإيران وتركيا والأمم المتحدة وأميركا وأوروبا. وقلت له إنّ موقع القدم الذي تحتله روسيا على البحر الأبيض المتوسط من خلال القاعدة في طرطوس يمكن أن يتسع لو اتبعت القيادة الروسية سياسة مختلفة لمواجهة الأزمة السورية وشاركت الدول العربية ودول المنطقة والمجتمع الدولي في البحث عن حل من النوع الذي أشرت إليه. هكذا تؤسِّس القيادة الروسية لعلاقات حقيقية في كل الميادين مع المجتمع العربي دولاً وشعوباً وحركات وطنية وديموقراطية من كل الاتجاهات. وتستطيع روسيا في سياسة كهذه، أن تواجه الضغوط التي يمارسها عليها خصومها أميركا وأوروبا الذين هم شركاؤها في النظام العالمي الجديد. وتستطيع في الآن ذاته أن تنهض باقتصادها وتتحوّل من دولة ذات اقتصاد ريعي أو ما يشبه ذلك إلى دولة ذات اقتصاد عالمي كبير. وتصبح علاقاتنا معها أقوى وأكثر جدوى لمصلحة كلينا.
خلاصة لا بد منها
رأيت من واجبي أن أدلي برأيي في مسألة تخص بلداننا في علاقتها مع المجتمع الدولي من الناحية الجغرافية والتاريخية والسياسية الأقرب إلينا، أعني روسيا الجارة الكبرى للشرق الأقصى والأوسط والأدنى. وقد استندت في بحثي المتواضع هذا إلى تجربتي الطويلة في العلاقة مع روسيا القديمة والحديثة. فقد زرت الاتحاد السوفياتي في مطالع عام 1954 وأكثرت من الزيارات والاقامات الطويلة فيها، وتابعت بشغف دائم من موقعي الحزبي واليساري التراث الغني لهذا البلد العظيم. واستقيت منه الكثير لإغناء ثقافتي ومعارفي. وسأظلّ أسعى وأنتظر كي تستعيد العلاقات الروسية العربية مجدها القديم وتتجاوزها إلى ما هو أرقى وأغنى لصالح الأمّتين العربية والروسية.
النهار