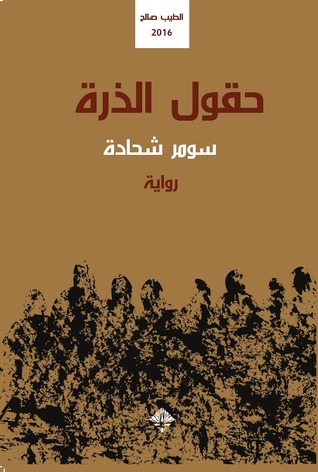“قطعة ناقصة من دمشق”: من يشتري هذا الألم؟/ نبيل سليمان
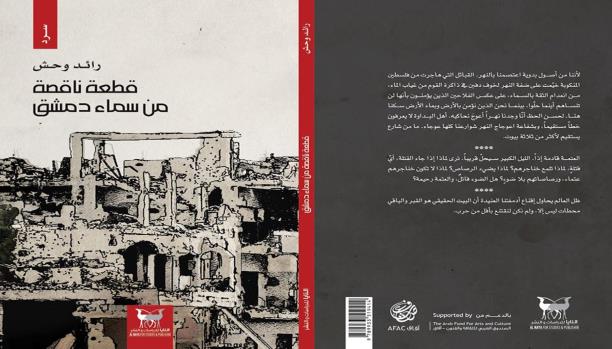
لم يفرق الزلزال الذي ابتدأ في سورية عام 2011 ولمّا يزل يتفاقم، بين فلسطيني وسوري، بل إنه ضاعف اشتراكهما في كل شيء منذ 1948. هكذا عرف مخيم اليرموك أو مخيم فلسطين أو مخيم خان الشيح من سوار دمشق، ما عرفت المدن والبلدات السورية من معارضة سلمية أو مسلحة، ومن موالاة أو معارضة، وبالتالي عرفت المخيمات المظاهرة والاعتقال والتفجير والاغتيال والرايات السوداء والتهجير والتدمير والبراميل المتفجرة والسيارات المفخخة والانتحاريين المكبّرين و… وقد آتى ذلك من الإبداع ما آتى كهذه السردية التي قدمها الشاعر الفلسطيني رائد وحش (قطعة ناقصة من سماء دمشق – 2016).
عيّن رائد وحش جنس ما كتب بـ (سرد). ومنذ السطور الأولى لا يبدو التجنيس كافياً، فهذا الـ (سرد) هو سيرة ذاتية بامتياز، وأدنى ما يؤكد ذلك أن صاحبها يظهر في الكتاب باسمه الصريح. ولعل الشاعر إذن في طريقه من الشعر إلى الرواية أسوة بـ (نزوح) الشعراء المتفاقم إلى الرواية.
في السطور الأولى أيضاً ما يجلو عنونة الكتاب، حيث رأى الكاتب في سماء دمشق، لدن نزوحه منها – وداعه لها، قطعة ناقصة من سمائها، حتى بدت السماء مفترَسة جراء كِبَر القطعة. ومن تداخل الحكايات القديمة في رأسه، يعلل الكاتب ما رأى، فالناقص من السماء هو حصته الدمشقية التي سيظل الناس يعللونها بالقصف، بينما سيظل يعاندهم بأن (غيابكِ) هو السبب. وهذه المخاطبة (لها) ستوقّع من حين إلى حين للسردية، فتلفحها بحنين ووجع شفيفين وحادين.
سيرة المخيم:
من سيرة المخيم تروي السردية أنه كان خاناً قديماً، فقد وظيفته كمحطة بين الأستانة ومكة، وبقي هيكله للدلالة على المكان الفلسطيني المؤقت. أما نبتة (الشيح) البرية التي سمّت المخيم، وكانت تجلبب المكان، فقد تبددت، بينما انتقلت أسماء المحلات التجارية من الأسماء الوطنية إلى الأسماء الدينية، أسوة باطّراد الأسلمة في الفضاء الفلسطيني السوري العربي الـ… وفي سيرة المخيم أيضاً أن ساكنيه اعتصموا بنهر الأعوج لأنهم من أصول بدوية. فالقبائل التي هاجرت من فلسطين المنكوبة خيمت على ضفة هذا النهر جراء خوف دفين في ذاكرة القوم من غياب الماء، ومن انعدام الثقة بالسماء، على العكس من الفلاحين. وأهل البداوة أيضاً لا يعرفون خطاً مستقيماً، لذلك جاءت، بشفاعة نهر الأعوج، شوارعهم عوجاء.
بفعل الحرب/ الثورة/ الزلزال عاد المخيم إلى بداوته، فصار بيت الراوي مضافة تعمر كل ليلة بالأسرة والأقارب والأصحاب والنازحين من جهات أخرى إلى المخيم. ويصف الراوي هذه المضافة بالديمقراطية، بخلاف المضافات البدوية التقليدية. وقد عاد القوم بدواً تجمعهم في التعليلة (اللقاء) القهوة وقناديل الكاز، والنار – إذ لا كهرباء – التي كتبت بداية المخيم وحدها، وستكتب نهايته وحدها أيضاً، فقد عاد القوم (ناريين جداً) في العشيات الحكائية، وفي كل يوم يحسبون أنها التعليلة – العشية الاخيرة.
حين زلزل المخيم وأخرج أثقاله:
لأنه النزوح إلى المخيم من مخيمات وأحياء أخرى، يذكّر الدكتور خالد في المضافة بنزوح أهل المخيم 1948 إلى الجولان، فنزوحهم 1967 إلى دمشق، والآن نزوح جديد، وفي الغد يصير الجميع وكالة غوث “لأننا صرنا كلنا فلسطينيين”. إنها لعنة فلسطين التي يتنبأ الدكتور خالد بأن العالم سيذوقها، ويندفع مخاطباً المضافة: “قولوا لي متى لم يكن في هذه الأمة نازحون أو لاجئون؟ في 2003 لجأ العراقيون، وفي 2006 تبعهم اللبنانيون. آلاف مؤلفة من أهالي الجزيرة السورية أجلاهم الجفاف قبل سنوات”، وهكذا، لن تترك الحرب البيوت في مطرحها، وستجعل المكان مكاناً آخر.
من جدته يأتي رائد وحش بحكمتها: مكتوب علينا بناء بيوت لا نسكنها. وشرح ذلك يأتي في نصيحة شركسي لوالد الجدة بألا يكمل بناء بيته في (البلاد – فلسطين)، وأن يحضّر الجمال للمسير القادم. وهكذا، نصح والدها اللاجئين بعد النكبة: لا تبنوا بيوتاً.
ويصوغ الراوي خلاصة النزوح واللجوء: في البدء (كان) الخيمة، ثم جاءت دور الطين، فالخرسانة والطابقيات، إذ البيوت مبنية للغياب “ونحن مبنيون للمجهول”. وهذه العبارة هي عتبة (الإهداء) في صدر الكتاب. ولقد نقل النازحون من المناطق المنكوبة إلى أهل المخيم خبراتهم في الوقاية، لكن أولاء لم يبالوا. وبعدما امتلأت المدرسة بالنازحين، نصبت لجنة الإشراف عليهم لأبناء عم الراوي خيمة في الباحة، هي شوادر قماشية لُفت حول مظلة التوتياء التي يستظل بها التلاميذ عادة. وعلى هذا النحو ترسم (السردية) لوحات للصراع في المخيم وخارجه، فإذا بداء الكَلَب يستعيد وهجه لأن السعار أصاب الكلاب جرّاء التهام الجثث المتراكمة في طرق الأمكنة الساخنة، وإذ بـ “الوطن سجين والشعب رهائن”، والفاشيون الجدد لم يكتفوا بجعل المدارس والمشافي سجوناً، ولا بتحويل البيوت التي يحتلونها إلى غرف توقيف، بل راحوا يجعلونها منصات إعدام، إذ لا فرق بين الطبيب والسياف، ولا بأس من أن ترش البيوت بدماء سكانها بدلاً من الماء.
عن القصف المدفعي يروي الراوي أنه بات إيقاعاً لساعة الكون، ساعة الموت. ويصم المدفعية بالكفر، فبسببها فوّت المؤذنون آذان الفجر، ما دفعه بكل الكفر والخوف والإيمان المفاجئ إلى سطح المنزل ليؤذن تحدياً للمدفعية. وعن الحواجز يروي الراوي الذي فقد بطاقته الشخصية (الهوية) فصارت العودة إلى المنزل كابوساً يرى نفسه فيه يدوّن بطاقات الناس ليعبروا البرزخ العسكري، فكل بطاقة هي صليب، وكل متراس هو وقفة على طريق جلجلة البيت، وكل واحد من الشعب مسيح نفسه، ولا خلاص، ويصب الراوي نقمته على المسلحين المتدينين الذين أمروا بكسر البطاقة الشخصية مما جرّ مصائب على من فعلوا.
قبل الحرب كان الشتاء يحكم بالعدل، فالجميع كالجميع؛ لدفئهم المنقل أو مدفأة الحطب. لكن شتاء الحداثة بدّل الأمر، حتى جاء شتاء الحرب فعاد بالشرعة الأولى: (غارات) جماعية على البساتين والمزارع بالفؤوس والمنشارات وصواريخ الحدادين والبلاطين تحولت إلى منشارات، والسيارات الزراعية التي كانت تستخدم لنقل الأسمدة والشتلات، باتت لنقل جثث الأشجار، والنساء عدن (حمالات الحطب)، وكما أباد اللاجئون الفلسطينيون غابات الحور والصفصاف والزيزفون على ضفة نهر الأعوج، جرفت قوات النظام صبار المزة حتى لا يختبئ ثمة الثوار، وأحرقت غابات اللاذقية بحجة إيوائها للعصابات.
لسان جديد:
لقد أنعمت الحرب على الناس بلسان جديد/ لغة جديدة. فالمرأة حين تهتف لزوجها: بدأ العرس، تعني: إطلاق نار أرعن، والأقارب حين يهتفون لأقاربهم: نشرنا الغسيل وطارت ثلاثة شراشف، يعنون: ثلاثة أكفان، وهذه العاصفة إرهابي، وهذا الثلج تكفيري… لكن (أبو طارق) في حيّ (الحجر الأسود) ما عاد يطيق هذه (الشيفرة)، فخلع الخوف كحذاء، ومشى شجاعاً بكامل حفاء القلب، وصار يحكي على هاتفه بلا تشفير.
من سمات اللسان الجديد أنه (نقدي). فحين تقضي جماعة مسلحة مجهولة على مصور، ينقل الراوي الخبر لذويه متسائلاً: هل مهمة الثورة هي تصفية هؤلاء الصغار الذين لن يغيروا مجرى الأحداث مهما ارتكبوا من أخطاء؟ وحين تظهر جثة ابنة الثلاث سنوات لا تعود مهمةً الصبغةُ الأيديولوجية للقاتل، ولا موقعه في السلطة أو الثورة. واللسان الجديد يهجو المجتمع كله: “نحن مجتمع لا ينتج نساءً”. وبالسخرية يحكم بأن الأشجار والحيوانات، ليس لها أن تتبنى الثورة السلمية، وهي بالذات من يجب أن تتولى الثورة المسلحة. ويتابع في سخرية مبطنة من الهياكل التي ظهرت خلال سنوات الزلزال، إلى أنه من حسن حظ الطبيعة أنه ليس في وسعها تأسيس هيئات ومجالس وتنسيقيات وائتلافات. وبخلاف ما تقدم، يتمنى لو أن في مكنتها تشكيل كتائب مقاتلة. وفي نقد الأسلمة تظهر حانة الأعرج المسيحي في المخيم الذي هجر خمارته، بعدما خُطِف أياماً، ثم ظهر تائباً. وقد حرم الإسلاميون بيع الخمر في المخيم، فتحولت خمارة كهف النسيان إلى بيت صاحبها. لكن الكحوليين سببوا (إرهاباً) للناس، ما قادهم إلى حملة لإغلاق الخمارة. وقد تقدم المخيم على دمشق بصمود خماراته فترة أطول، ففي دمشق قاد رأس المال الديني الحرب السرية على الكحول، واستولى على خمارة (فريدي) ذاكرة سكيري سورية، وجعلها محلاً لبيع الشاورما. وفي واحدة من التماعات (السردية) التي لا تنتهي، تأتي زبدة حديث الخمارات بأننا نتذكر الحياة آن زوالها، في لحظة تحولها إلى مرثية، والاستذكار والرثاء بحاجة إلى خمر للتغلب على المرارة.
شخصيات:
يرسم رائد وحش في سرديته شخصيات روائية بامتياز، لا تُنسى. فهذا (مسّوس) المجنون يحصل على قبعة شرطي، ويحقق حلم حياته، فيخرج إلى الشارع لينظم المرور، وإذا برصاصة معارضة ترديه بوصفه شرطياً من أعوان النظام. ويروي الكاتب أن المترجم صالح علماني حدثه عن مجنون في قصة، طموحه أن يتحول إلى شرطي مرور. وكان الصديق الكاتب أسامة الفروي قد جمعنا في جمعية المسلولين (أي المجانين) منذ سنوات، ووزع علينا صافرات، ووزعنا على ساحات اللاذقية لننظم فيها السير، وما كان في الجمعية من درى بقصة علماني ولا بمسّوس الذي سقط في منطقة تقاطع النيران بين النظام والمسلحين، وهو يصرخ بهم “توقفوا.. توقفوا.. الموت الذي تصنعونه لا يمكن أن يصير حياة”، لكأنه بصراخه يطلق رسالة سردية رائد وحش ضد العماء العميم.
وهذه هي القديسة حياة التي تتربع في (المضافة الديمقراطية) وتفتح ملفاتها السرية، وهي الأقرب إلى الزندقة، لكن الناس سموها القديسة. وكما تقدم (السردية) قصة حياة مسّوس، تقدم قصة حياة القديسة، وكذلك (الميجر) الذي يعلم الناس من دروس الحرب الإضاءة بالمازوت، بخلطه بالملح والحمض. أما دلال التي تركت عشاقها يكبرون في هواها المستحيل – ومنهم الراوي – فهي تسرق انتباه الجميع، بينما تسوّرها الدبابات وناقلات الجنود. وليس العسكري جمعة ولا الحمصي ولا اللاجئة العراقية بشخصيات تُنسى. لكن الامتياز الأكبر يبقى لشخصية الراوي/ الكاتب، من خوفه من السَّوْق إلى الجيش، ونجاته بفضل الفساد، إلى وعيه لجبنه كنتاج لكل مدخلات الخوف ومخرجاتها خلال سنواته الاثنتين والثلاثين التي عاشها محكوماً بالإرهاب الأمني والمجتمعي..
تلك هي بسطة (عربة) رائد وحش التي تذكّر بالبسطات الأمنية، وببسطة الحشاش الذي يتقنّع ببيع الخضار، وبالحكمة الكبرى: الحياة بسطة، أي عربة مثل عربة التونسي بو عزيزي. أما رائد وحش فقد عيّن سرديته بـ (بسطة كتابة) منادياً: من يشتري هذا الألم؟
ضفة ثالثة