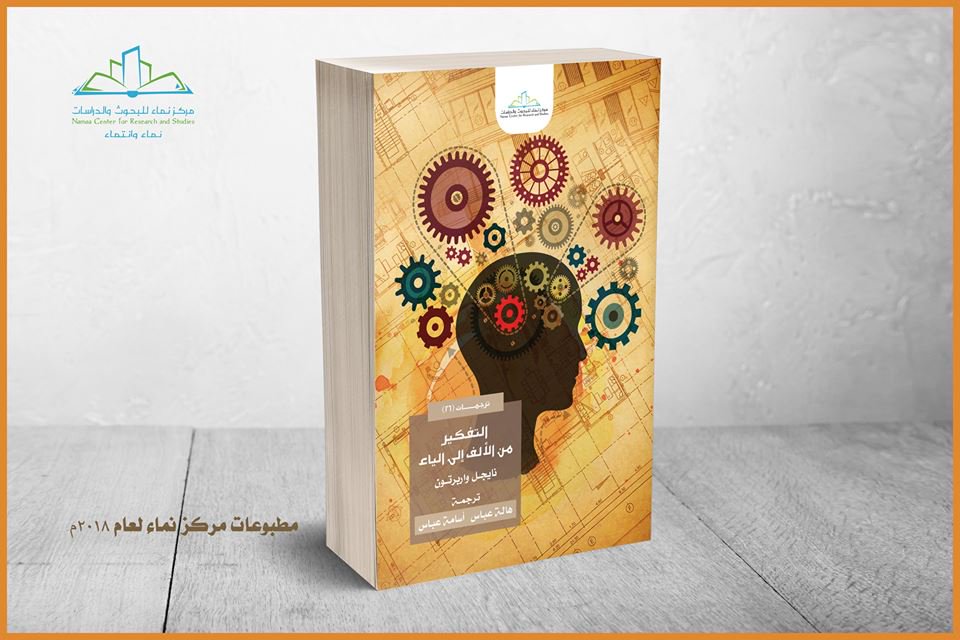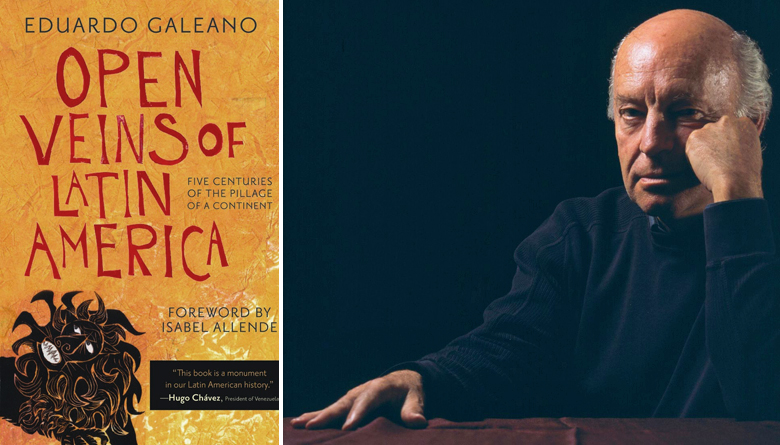كان نائما حين قامت الثورة/ عماد أبو صالح
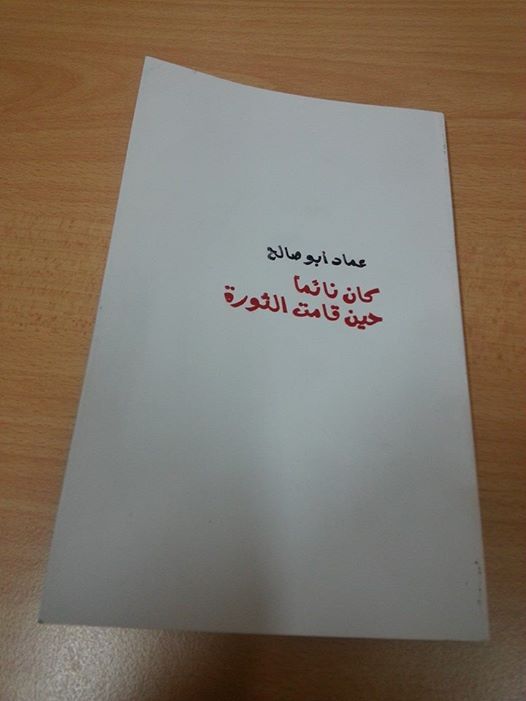
عماد أبو صالح… كان نائماً في سرير الشعر حين قامت الثورة/ محمد العباس
في «صورة الفنان شابًا» يقرر جيمس جويس، عبر بطله ستيفن ديدالوس «أن شخصية الفنان تكون في البدء صرخة، فترة انتداب ومزاج، وفي ما بعد حكاية واضحة وواسعة، وفي الأخير يمتلك النبل حين ينفصل عن العالم الخارجي ولا يرمز إلى شيء».
فالفنان – بتصوره «كالرب الخالق غير مرئي داخل العمل الفني أو خارجه أو جنبه أو فوقه، لقد صار نبيلًا من خلال الانفصال عن العالم الخارجي، وأخذ ينظف أظافره بلا اكتراث».
هذا هو حال ومآل وموقف عماد أبو صالح مما شهدته مصر من ثورة بموجتين. فقد (كان نائماً حين قامت الثورة) كما جاء عنوان آخر مجموعاته الشعرية. وفي الواقع لم يكن نائماً بقدر ما حاول أن يبدو متناوماً، حيث تفصح المجموعة عن ذات على درجة من الانتباه والنبالة إزاء ما حدث، تريد إيهام القارئ بأنها ذات أرّاخة، بعيدة بمسافة عن الحدث، وتكتب عن لحظة مغايرة.
بدون أي احتراز في استخدام مفردة (الثورة)، وبما يشبه رفع الستارة إيذاناً بعرض مسرحي تراجيدي، أو ما يُعرف نقدياً بالإيماءة الكبيرة، تُفتتح المجموعة، بعرض حكاية شعرية منثورة تؤرخ بمنطق استقرائي لتاريخ القتل في حياة البشر. قصة أخ يصفع أخاه الصغير (بكل غلظة الأخ الكبير). وفيما ينسى الأخ الصغير بفعل التراكم الزمني تلك الصفعة الأخوية، يظل الأخ الكبير مجروحاً بمشهد بكاء أخيه. يتذكر «الدمعة الوحيدة التي سقطت من عينه حارّة وحرة كلؤلؤة». يتألم لأنه تحسّس الخزين العدواني في داخله «لكن يدي لا تزال تؤلمني إلى اليوم». وكأنه يريد التطهُّر من منزعه القابيلي. إذ يبدو، حسب استنتاجه الشاعري «أن في كل عائلة، منذ بدء الخليقة، مشروع قابيل وهابيل». في ما يبدو مقدمة لرثاء مستوجب للبيت المصري، لكأنه يموضع نصه الدرامي على سجادة رجراجة من الحزن العميق، وفق مستوجبات القصيدة المُمسرحة، التي تحكم مفاصل المجموعة.
من خلال تلك الحكاية الإستهلالية البسيطة في تركيبها اللغوي، العميقة في دلالاتها، يفلسف الوجود الإنساني ليُسقط رؤيته التأمُّلية على الحدث المصري، فهو يكتب النص الشعري في طور الفهم والاستيعاب لما حدث وما يمكن أن يحدث، حيث لا تدفعه تجربة الحرب بين ناسه إلى النضوج الثوري الكاذب، بل جعلته مُقعداً في حالة من البلادة والذهول والسخط المكتوم. يختبر عافية خياله على حافة الواقع. وبموجب ذلك التدمير الوحشي للبراءة، صار يمارس التفكير بالكلمات الشاعرة، وعبر نصوص تعتمد في مجملها على حركة إيقاعية واحدة، وبنظام بلاغي واحد، حيث يرتد عميقاً في جوهر الإنسان «حواء بداية الخطيئة؟/ لا/ هذا خطأ/ حواء البداية الصحيحة». ولكن كيف؟ ليجيب بشيء من التنغيم المسرحي «كان آدم يعيش، كملاك، في الجنة. يحلم فيجيء ما يحلمه. لكن كان هناك، عند الله، ملائكة مثله بالآلاف. أرادته كائناً فريداً. لا يشبهه أحد، ولا يكرره أحد». وهذا هو مغزي ما سماه «مديح الخطأ».
إنه مجروح بلا شظية، بتعبير جيمس فنتن، الذي يحاول النأي بنفسه عن تعقيدات المشهد. وعلى هذا الأساس يعيد الوهج للكلمات المهجورة، كمفردة (الخطأ) مثلاً، حيث صار يمجّد الإنسان الخطّاء، بحيث تبدو النصوص مغمورة بعاطفة عضوية وليست موضوعية، فمن يخطئ – بتصوره «بريء. من يخطئ أكثر يصبح بريئاً أكثر، الذي لا يخطئ أبيض، معقم، نظيف. لا بقعة تدل على أنه كان عائشاً هنا، فوق التراب، وسط الناس. أعمى. ميت القلب. آلة».
وبمقتضى ذلك الاعتقاد البشري صار عماد أبو صالح يربي النبالة في نسيجه الشعوري ويتعامل مع جبل الأخطاء الصغيرة التي تنحت تضاريس آدميته. فهي – أي الأخطاء «ليست أحجاراً تعرقلنا حين نمر. هي تعطلنا لنمشي ببطء. لنفكر بطريقة أفضل. شموع تضيء الطرق. لئلا نندفع، مثل الثيران، إلى الهاوية. لئلا نضيع، كماء شلال، في المحيط». ليصل إلى نتيجة مفادها أن «الخطأ هو ألّا نقع في الخطأ». وهو بهذا المنحى أقرب إلى تشييد المفهوم، منه إلى نحت الصورة الشعرية. كما تتضاءل النزعة التصويرية في المجموعة أمام السرد والمسرحة والمشهدية وبناء المفاهيم.
وبعد فاصل إحمائي من (ذم الأشجار) ومديح العشب (لِحية الأرض). و(مديح الفراغ) ومحاولة احتضان (بصلة بحنان) وتقشيرها (طبقة وراء طبقة) للوصول إلى الفراغ بما هو (جوهر الوجود). يتأهب لـ (ذم الثورة). إيماناً منه – ربما – بمقولة غاستون باشلار بأن عدم الكلام هو مصدر عذابنا الأول، من خلال منظومة من اللوحات البانورامية التي تختزن مشاهد معتمة لما يعتبره جناية على الثورة «كان نائماً حين قامت الثورة/ لم يغادر سريره/ رغم أنه سمع الهتافات الهادرة/ من شباك غرفته/ نام بعمق/ كان وحيداً في البيت/ في الحي كله/ لا ضجيج بائعين/ لا صراخ أطفال/ ولا نباح كلاب/ وحيد/ وحر/ بينما الثوار هناك/ يشيعون جنازة الحرية»، حيث تفصح تلك المشهدية الحزينة عن إدانة للجموع الغاضبة التي تقتل بعضها بقابيلية شرسة، فيما يمارس هو نبالة التناوم ليسجل موقفه من خطأ لا يُغتفر. بنص ينسج نفسه بنفسه. من خلال التقاط العنصر الحي من كل مشهد يرتطم به بصره.
تلك هي اللافتة التي أراد تعليقها على واجهة المشهد الدموي، من خلال لقطة بانورامية شاملة، سرعان ما تتوغل في التفاصيل لتعميق الوجع «كان مكوماً في ركن/ قدماه حافيتان/ وملابسه ممزقة/ والدم يسيل من فمه/ عجوز/ نحيل/ لا يقوى/ ، أصلاً،/ على الذهاب للحمام/ جرفته الثورة إلى هنا/ ليصبح ثائراً رغم أنفه». وما أن ينتهي من تأمُّل (عجوز) تم تثويره بالصدفة، حتى ينتقل بعدسته إلى مشهد آخر يحتله (مناضل) وبالخطابية التقريرية ذاتها يسرد حيثيات الصورة وما وراءها من خفايا «وقف عارياً أمام عربة شرطة/ أحرقتها الجموع الغاضبة/ العربة نفسها / التي ركبها/ ، مقيد اليدين،/ حين كان شاباً/ انتظر هذه اللحظة كثيراً/ لكن حين جاءت/ لم يشعر بأي فرح/ على العكس/ فوجئ بحزن/ ينساب/ ببطء/ في كيانه كله/ وقاوم رغبة حقيقية/ في إطفاء ألسنة النار/ التي تأكل أغلى ذكرياته».
هكذا صار يشعرن المادة الخام للحدث، ليقوّض فجاجة الصورة التلفزيونية بكل احتقاناتها الجماهيرية والخبرية بعد اهتزاز اليقين مقابل التكوين النصي الذي يريد إقامته كمروية شخصية. وكأن منسوب الهابيلية فيه آخذ بالارتفاع لهول ما يرى. الأمر الذي يفسر انفتاح نصه على لقطة إنسانية تحمل الكثير من مفارقات الحدث الثوري باستعارات هادئة، ومجازات بسيطة، وإيقاعات أقرب إلى السكونية، وسخرية مبطنة، من خلال سرد سيرة (متشرد) يتحول على إيقاع الثورة إلى رقم صعب في معادلة الإنسانية «منذ طفولته/ وهو يعيش مشرداً هنا/ لا أهل/ لا عمل/ لا أمل/ تقافز من الفرح/ حين امتلأ الميدان بالثوار/ تنازل لهم عن غطائه الممزق/ ونصف سيجارة/ كان يشبكها خلف أذنه/ شعر بأنه صاحب بيت حقيقي/ يجب أن يحتفي بالضيوف/ حين رحلوا فجأة أحس بالألم/ بوحدة لم يجربها في حياته/ أطعمهم رغيفه/ وسرقوا منه/ نعمة العراء».
هذا هو منطق النائم الذي يرى كل تلك التفاصيل اليومية الدقيقة ويخضعها لتحليل شعري، أشبه ما يكون بالصراع الدرامي المكشوف الذي يحد من فاعلية الخيال. فهو يلاحظ حتى الباعة الجائلين الذين داستهم الأقدام أو دفعتهم الأكتاف المتزاحمة خارج مدار أرزاقهم. يستدعي لقطة لـ (متسول) كشاهد على هبائية الثورة، وكتأكيد على حس اللامبالاة الذي يحاول إيهام ذاته به (أنا مجرد متسول/ لكنني/ خدمت الثورة/ أكثر من الثوار أنفسهم/ كيف؟/ خدمتها بعدم مشاركتي/ بقيت جالساً/ ، على هذا الرصيف،/ أمد يدي للعابرين/ مددتها بحماس/ بإخلاص وخسّة/ بكل خبرتي في الوضاعة/ أنا لا أحلم بحياة أفضل/ ولا أهجر مهنتي/ يروح دكتاتور/ ويجيء دكتاتور/ وأنا ثابت في مكاني/ سلالتي طويلة/ لي أجداد في الماضي/ وأحفاد في المستقبل/ أنا الباقي/ أنا الخالد/ أنا الواقع في قاع الثورات/ أنا حارس الأمل/ في الثورة القادمة).
وبنظرة مفرطة في الواقعية حد التشاؤم يرسم بورترية لما سيكون عليه (بطل) من أبطال الثورة، بدون مونتاج أو توليف، ففي كل ثائر ينام دكتاتور كما يوحي التشريح اللفظي للنص (يا إلهي/ كم هو رائع/ هذا الشاب هناك!/ يتقدم الصفوف/ ويفتح صدره للرصاص/ يعالج الجرحى/ ويتنازل عن طعامه القليل للجوعى/ كأنه نبي/ أنا معجب به/ إلى كل طفل/ يخلم بأن يكون بطلا:/ تعلّم منه/ لتثور ضده/ ، بنفس طريقته،/ حين يصبح ديكتاتور المستقبل). وهو الأمر الذي يدفعه إلى (مديح الظلام) و (ذم الحرية) و (مديح العدم) و (ذم الحب) بمجازية تستمد طاقتها من صدمة الواقع. ومستدعياً سلالة من الشعراء كافافيس، لوركا، شيمبورسكا، ماياكوفسكي، كملاذ شعوري.
كمن تعرض لبرد فضائي، حسب تعبير شيموس هيني، يعيد صياغة خطابه الشعري (الثقة بالشعر) بنوازعه الإنسانية، ليؤكد – كعادته – على وفاقه الحميم مع الشعراء ليحاورهم بما يشبه العتاب، وبنبرة خافتة، في معنى الموت والديكتاتورية والعصيان. وكأنه بتلك البداهة والعفوية، واللغة النثرية المحكية، يستمد دعمه الحسّي والثقافي من مكان ما وراء الحدث. لتوطين المعنى اللامباشر في النص. وليعود في نهاية المطاف إلى مكمن الصراع الدرامي، أي إلى التسليم بوجود ذلك المزيج القابيلي الهابيلي في النفس البشرية التي لا فكاك من تناقضاتها واستعدادها الدائم لأن تكون قاتلة ومقتولة أيضاً، فيما يتغافل هو عن ذلك كله بالتناوم النبيل في سرير الشعر.
كاتب سعودي
القدس العربي
الرابط الأول
كان نائما حين قامت الثورة/ عماد أبو صالح
الرابط الثاني
كان نائما حين قامت الثورة/ عماد أبو صالح
صفحات سورية ليست مسؤولة عن هذا الملف، وليست الجهة التي قامت برفعه، اننا فقط نوفر معلومات لمتصفحي موقعنا حول أفضل الكتب الموجودة على الأنترنت
كتب عربية، روايات عربية، تنزيل كتب، تحميل كتب، تحميل كتب عربية