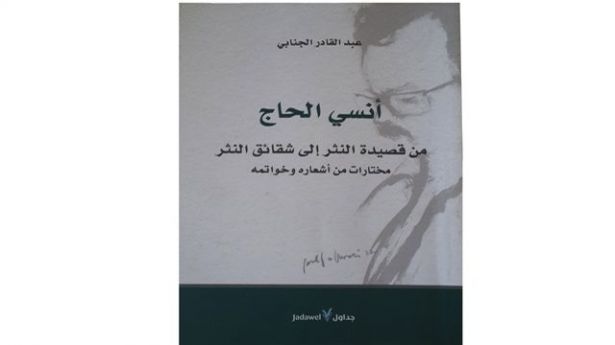كتاب – “متعة القراءة” لدانيال بِناك بين الفعل الحرّ والإرهاب التربوي/ شربل ابي منصور

يقول عباس محمود العقاد: “وإنما أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة في هذه الدنيا، وحياة واحدة لا تكفيني”. قولة العقاد تحضّ على القراءة التي تمنحنا فرصة عيش حيوات أخرى في متون كتب تفيض بتجارب أصحابها وخبراتهم وزبدة معارفهم، التي قد لا تكفي حياة واحدة لعيشها. أنطلق من هذه القولة لأبيّن فقط مدى أهمية القراءة في صقل الشخصية الإنسانية ولا سيما أننا نشهد نسبة تراجع كبيرة في هذا المجال.
مناسبة الكلام هي كتاب “متعة القراءة” لدانيال بِناك (نقله يوسف الحمادة، دار الساقي) يتناول فيه القراءة كفعل إرادي حرّ لا وسيلة تعذيب تربوي، منطلقاً من أن فعل “قرأ” لا يتحمل صيغة الأمر، إن لجهة السماح بالقراءة أو منعها، فهو فعلُ تمرّد. يتطرّق إلى أسباب ابتعاد الأولاد عن القراءة والجفاء الحاصل في هذه العلاقة نتيجة تحوّل القراءة فرضاً وواجباً وافتقارها إلى المتعة والحميمية. ويستعيد لذلك مرحلة الطفولة، وقتَ كان الأهل كل مساء قبل النوم يروون القصص والحكايات لأطفالهم. كانت هذه الأوقات من الأكثر سعادة ومتعة وتشويقاً في حياة الطفل، فهي “فتحت عينيه على التنوع اللانهائي للأشياء الخيالية، وعرّفته على فرح السفر العمودي، وزودته القدرة على أن يكون في كل مكان، وخلصته من سلطة الزمان، وجعلته يغطس في عزلة القارئ المسكونة بتعدد عجيب…”(19). لقد كانت هذه القراءات تحمل الطفل إلى عوالم خارقة يصبح فيها بدوره، كقارئ، حارساً للشخصيات المشاركة، فتجرده عن العالم. ولم يكن مطلوباً منه شيء، “كان يعود صامتاً من هذه الأسفار”، و”ما أكبرها من متعة للقارئ، متعة الصمت بعد القراءة”(19). لكن الانتقال الدراماتيكي يحصل في المدرسة فتصبح القراءة نوعاً من الاشغال الشاقة، إذ يطلب من التلميذ مطالعة كتاب يقرب من 500 صفحة في 15 يوماً وتلخيصه في خمس صفحات، ومهما بلغت اعتراضات التلاميذ إلا أن حكم الأستاذ مبرَم. وهل نعجب بعدذاك من تململ الولد ونفوره من القراءة: حجم الكتاب والسطور المضغوطة إلى درجة أن النار لا تتخلل صفحاته بسبب قلّة الاوكسيجين، الفترة القصيرة المعطاة لإنهائه على رغم عدد صفحاته الكبير، شفتا المعلم تتمتمان عنوان الكتاب. هكذا يتحول ثقل الكتاب إلى تلك الأثقال التي تشد إلى الأسفل (ثقل الملل، ثقل الجهد العقيم)، وتكون النتيجة الغرق. ولماذا دراماتيكي؟ لأن القراءة شكّلت، بالنسبة إلى الطفل، عالمه الخاص والآمن والمرتجى، فـ”كانت القصة المسائية تزيح عنه ثقل أعباء اليوم. وكقارب تخلّص من الحبال التي تشده إلى الشاطئ كان ينطلق مع الريح، وقد تخفَّف من كل أعبائه، وصوتنا كان تلك الريح” (33). طبعاً لا أحد لديه الجرأة لنقد هذه المناهج التربوية الشبيهة بوسائل التعذيب، لذا كان لا بدّ من توجيه أصابع الاتهام إلى مكان آخر، فوُجّهت اللائمة إلى التلفزيون، والسينما، والثقافة الاستهلاكية (مطاعم، ملابس، ديسكوتيك) ناهيك بالإلكترونيات ووسائل التواصل الاجتماعي. لا شك في أن وسائل اللهو والإلهاء كثرت في عصرنا وهي تبعد هذا الجيل من الكتاب، ولكن هناك أيضاً عدم ملاءمة البرامج المدرسية، عدم كفاية المدرسين، قلة المكتبات، ضآلة الحصص المخصصة للكتاب. يمكننا تجريم هذه المسبّبات الآنفة الذكر ولكن ليس حدّ الاتهام بالقتل المتعمد، إذ إننا لم نحسن فهم طقس القراءة الأشبه بالصلاة. لقد كانت القراءة المسائية تمحو صخب النهار فيعمّ صمت قدسيّ قبل أولى كلمات القصة، “لقد كانت القصة المقروءة كل مساء تحقق أجمل وظائف الصلاة، الوظيفة الأكثر تجرداً، والأقل صخباً، التي لا تعني إلا البشر: غفران الإساءة”(32). لقد فُقدت هذه الحميمية بين التلميذ والكتاب، ولم تعُد القراءة مجانية بل وجب أن تدرّ مردوداً وفائدة فوريين وفق ما تقتضيه العملية التربوية، وإلا اعترى التربويين شكّ في أنفسهم. كذا حال الأهل إن لم يبدِ ولدهم تجاوباً مثل سائر الأولاد، فتبدأ التساؤلات والاستفسارات: أهو يعاني مشكلة نفسية، عسر قراءة، أم إنه كسول؟ هنا يغيب عن بالهم أن كل ولد يتقدم وفق إيقاعه الخاص، وهذا لا ينمّ عن كسل أو مشكلة فيه بل بالتربويين.
يطرح دانيال بِناك سؤالاً جوهرياً: “ما الذي فعلناه بالقارئ “المثالي” الذي كانه في ذلك الزمن حين كنا نلعب فيه بأنفسنا دور الحكواتي ودور الكتاب في الوقت نفسه؟”، وهو هنا أقرب إلى تساؤل العارف، إذ يقرّ الكاتب بأننا (الأهل والمعلم) “كنا حكواتييه وصرنا محاسبيه”، ونضيف أيضاً جلّاديه. وهو يدعو إلى أن تتمّ القراءة بصوت عالٍ يجسّد الكلمات ويحييها “القراءة قيامة أليعازر، رفع بلاط الكلمات”(84)، وهي تشكّل فعل مقاومة، ومحاربة للموت، وأسلوب عيش “مثل كافكا الذي كان يقرأ لمحاربة مشاريع أبيه التجارية، وفلانري أوكنور وهي تقرأ رغم سخرية والدتها، وتيبودي وهو يقرأ مونتيني في خنادق معركة فردان…”(75). القراءة، إذاً، فعل تصالح، وإن دور الرواية في الأساس “رواية عطشنا إلى الأشياء”، والأهم أن تكون من غير مقابل.
يثور بِناك لحقوق القارئ، منها: الحق في عدم القراءة، الحق في القفز عن الصفحات، الحق في عدم إنهاء الكتاب، الحق في إعادة القراءة، الحق في قراءة أي شيء، وفي أي مكان، وبصوت عال، الحق في أن نصمت. القراءة، إذاً، فعل تحرّر، انعتاق، انخطاف، عشق، وأسبابها غريبة كغرابة الأسباب التي تدفعنا إلى العيش. يقول ألبرتو مانغويل صاحب “ثلاثية القراءة” إنه “حين ندعو القراءة بمجرد متعة فهو بلا شك وصف بخس في حقها، إذ إنها بالنسبة إليَّ مصدر كل المُتَع، هي التي تُضفي اللون على كل التجارب، وتجعل الحياة تُطاق، وتمنح الحوادث القدرة على الإقناع”. كتاب دانيال بِناك يحوي شخصيتين أو جانبين، جانباً إبداعياً ذاتياً أمتَعنا فيه الكاتب بأفكار نيّرة ومضيئة عن القراءة، وجانباً تربوياً تنظيرياً ناقداً للعملية التعليمية كثُر فيه السرد وتكرار أسماء أدباء بدت رتيبة وثقيلة الظلّ أحياناً ولم تُسعف النص مطلقاً. ولكن لا شك في أن هناك لمعات وومضات مشرقة في طيّاته. اِقرأوه.
النهار