لئلا ننسى أيقونة الثورة السورية/ عبده وازن
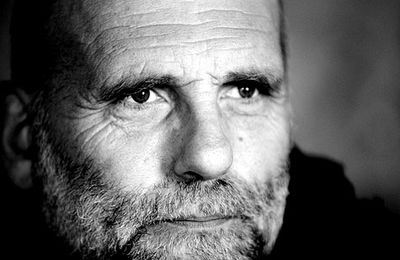
لولا التظاهرة التي شهدتها مدينة الرقة غداة اختطافه والأصوات القليلة التي ارتفعت في سورية «الحرة» والفاتيكان، مطالبةً بإطلاق سراحه، لكان خطف الراهب الإيطالي باولو دالوليو في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي على يد جماعة «دولة العراق والشام الإسلامية» في إحدى مناطق درعا، حصل بصمت وشبه كتمان وبلا ضوضاء أو ضجة. ولم تمضِ بضعة أشهر على اختفائه حتى نسيه أو كاد ينساه الجميع، لا سيما الغرب الذي لم يبالِ أصلاً باختطافه. أما رفاقه في المعارضة السورية فشغلهم عنه المأزق الكبير الذي يشهدونه، مأزق الانقسام والتشتت والصراع الداخلي، فقصروا في ملاحقة قضيته المعقدة جداً واكتفى بعضهم بكتابة المقالات. لكن المفاجئ أن الأشخاص «المرجعيين» الذين يتابعون مسألة خطف المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس اليازجي لم يذكروا اسم الراهب الإيطالي ولم يولوه اهتماماً وكأنه نكرة أو غير موجود. حتى حاضرة الفاتيكان، والرهبنة اليسوعية التي ينتمي إليها لم تسعيا إلى التذكير به وإلى طرح قضيته في المحافل الدولية. وكان هذا الراهب قصد منطقة درعا بغية لقاء الأصوليين وإقامة حوار معهم هو المتضلع في العلوم الإسلامية التي تخصص بها أكاديمياً، ثم لمفاوضتهم في قضية المخطوفين ومنهم المطرانان وبعض الثوار المسلمين. لكن الحوار الذي طالما حلم به وعمل له لم يؤت ثماره مع هؤلاء التكفيريين الذين يعادون حتى المسلمين المعتدلين والحقيقيين فخطفوه.
لعل كتاب الراهب باولو الذي صدر بالفرنسية أخيراً في عنوان «الغضب والنور – كاهن في الثورة السورية» (منشورات لاتيليه – باريس 2013) هو أشبه بالشهادة الحية التي يؤديها متطرّقاً إلى نواحٍ من سيرته الذاتية، وإلى حركة الحوار الإسلامي – المسيحي التي أسسها، عطفاً على تناوله بعمق، رؤيته اللاهوتية إلى هذا الحوار وإلى انتمائه – هو المسيحي – إلى الثقافة الإسلامية على طريقة معلمه لويس ماسينيون الذي أمضى جل عمره في بلاد الإسلام دارساً وموثقاً وباحثاً عن المخطوطات الدينية والصوفية وكان من بينها ديوان الحلاج الذي أبصر النور على يديه بعدما كان مبعثراً في المصادر. وعُرف عن الراهب باولو مقولته الشهيرة: «أشعر في طريقة ما بأنني مسلم»، هذه المقولة التي أرضت المسلمين لم تكن لترضي الظلاميين بتاتاً. ويروي الراهب كيف أنه سمع مرة في عام 1976 خلال شهر «الرياضة الروحية» على إحدى تلال روما، نداء غريباً قائلاً: «تلقيت نداء يدعوني إلى خدمة اللقاء الإسلامي – المسيحي». لكن هذا النداء كما يوضح، لم يكن دعوة إلى «الشرق الرومنطيقي»، بل إلى تأسيس حركة تُعنى بهذا الحوار.
في الكتاب الذي ساهمت في تدوينه الصحافية إيغلانتين غابيكس يالي – مثلما ساهمت في كتابه السابق «محب للإسلام، مؤمن بيسوع» (2009) – يبدو الراهب الذي لم يتضح مصيره حتى الآن كأنه شاء أن يكتب وصيته، وركيزتها ترسيخ الحوار وعيشه حقيقة وفعلاً وليس نظرياً فقط، عيشه يومياً و «تطبيقياً» كما يعبر، والسعي إلى تجديده والتجدد به ومواجهة ما يعترضه من حواجز وموانع أياً تكن. ولعله قصد أن يُعاش هذا الحوار في مناخ شبيه بالمناخ الذي رسخه في دير مار موسى الحبشي السرياني الكاثوليكي الرابض على جبل شاهق، وهو كان شرع في ترميمه بعدما وجده مهملاً ومهجوراً في الثمانينات من القرن المنصرم، وجعله موئلاً للحوار واللقاء وملجأ مفتوحاً أمام الجميع، مسيحيين ومسلمين وعلمانيين وحتى ملحدين. وسرعان ما أصبح الدير مقصد المثقفين وفسحة لهم ليتناقشوا ويتحاوروا ويختلفوا ويتفقوا… وجذب أيضاً زواراً كثيرين عبروا من هناك.
في الفصل الأخير من الكتاب وعنوانه «سورية في القلب»، يتجلى الطابع الحزين لهذه الوصية التي يمكن وصفها بـ «الوداعية». يقول قبل أيام من رحلته الأخيرة إلى سورية، بما يشبه الحدس المأسوي، إن الوقت ملائم ليكتب وصية تحمل خلاصة التجربة الطويلة التي عاشها في سورية. يقول: «أن أكتب وصية، بينما خطر الموت كبير، هو بلا شك ضرب من الترف، فالغالبية من مواطنيّ السوريين الذين قتلوا تحت صواريخ السكود، الروسية الصنع، أو براميل البارود المحلية، مواطنيّ الذين مزقتهم قذائف المدافع أو طلقات القناصة الذين ذبحوا بالسكاكين، أو الذين قضوا تحت التعذيب، ومنه التعذيب الجنسي، نساء ورجالاً، هؤلاء جميعاً لم يتح لهم هذا الترف في أن يكتبوا وصية». ثم يسأل: «ما الذي حدا بي إلى أن أعرّض نفسي للخطر في منطقة العاصي؟». الجواب ليس صعباً أو ملتبساً: الثورة من أجل الحرية والكرامة الإنسانية. ويعترف أن هذه الحرب الأهلية «تمزق روحي» وأنّ لا قدرة لديه على المكوث في موقف المشاهد، هو الذي يشعر بأنه ينتمي إلى الشعب الثائر الذي خانه العالم، بخاصة الغرب. وإذ يقر بأن الأمر يحتاج إلى تضحية يقول مجاهراً: «لقد خبرت فعل النزول إلى هاوية روحي بحثاً عن الأرواح تلك، وكذلك الأرواح الحائرة، أرواح الذين، حتى حين كانوا أحياء، لم تكن لديهم الرغبة في الثأر». ويبلغ حدسه مبلغاً في مقطع من الفصل الأخير يقول فيه: «واضح أنني أتمنى الموت كي أتمكن من تأكيد موقفي هذا، موقف التضامن والتوسط حتى النهاية. لكنني سأكون حذراً، ولن أعرّض نفسي للخطر عشوائياً، فأنا أقر بسيادة الله في حياتي، هو سيد الحياة والموت في وجودي. لكنني أرفض أن أعيش حياة تختلف عن الهبة الجوهرية، موتاً وحياة». إلا أن طيبة قلبه الذي لم يعرف الحقد، وسلامة طويته، وسماحته الكبيرة، جعلته ينسى قسوة الظلاميين وعماءهم وخلو قلوبهم من الرحمة، فوقع بين أيديهم ضحية بريئة.
عاش الأب باولو في سورية بين المسلمين والمسيحيين لكنه لم يعمد يوماً إلى التبشير ولم يدع أحداً، حتى الملحدين، إلى اعتناق المسيحية، بل كان يصر على الجميع أن يبقوا على دينهم كي يترسخ الحوار الحقيقي. لم يحمل باولو قبساً، ولو ضئيلاً، من تراث الاستشراق الغربي ولا من روح الحملات الأوروبية، بل كان همه أن يجمع بين مسيحيته والإسلام في سياق الانتماء الإبراهيمي. لم يكن يهمه أن يحتوي «الآخر»، بل كان يدعوه إلى أن يظل «الآخر» ولكن، في حال من الانفتاح والتآلف والاختلاف. وكان لا بد له من أن يستهل كتابه برسالة وجهها إلى «أوروبي شاب» قائلاً له: «أريد أن أهديك هذا الكتاب. آمل منك أن تكون ذا رغبة في الالتزام، مسلما كنت أم مسيحياً، مؤمناً، ملحداً أو في طور البحث عن نفسك». أما الدعوة التي وجهها، فهي «اكتشاف الرغبة في الخير المشترك». وعندما ينتقل إلى الكلام عن الأصوليات التكفيرية فيبدو على وعي بها وبحوافزها. فالظاهرة الأصولية التي تُسبغ عليها صفة الإرهاب كـ «القاعدة» مثلاً، هي في رأيه، تعبّر في قسط كبير منها، عن حال من الاضطراب العميق. وهي كما يقول، ولدت من شعور بالاضطهاد والرفض لديها، إزاء الداخل والخارج في آن واحد. أما ما تأخذه هذه الأصوليات على الغرب أساساً، فهو عجرفته وتعاليه وتفوقه التقني والاقتصادي الذي خوّله القدرة على احتكار السلطة والسيطرة على العالم «الآخر» وسط تواطؤ يهودي – مسيحي. لكن هذا الشعور لا يبرر برأيه «الانخراط في نظام إجرامي رهيب» ومتطرف ومسكون بـ «الحمى الأيديولوجية» وغايته مواجهة الغرب والعرب الذين هم من أصدقاء الغرب.
أمضى باولو، هذا الراهب الثوري، أكثر من ثلاثين عاماً في خدمة الحوار الإسلامي – المسيحي وعاشه عن كثب وفي قلب العالم العربي متنقلاً بين لبنان وسورية والأردن والعراق، وكان شاهداً على الجرائم الإسرائيلية في فلسطين وعلى الاجتياح الإسرائيلي مدينةَ بيروت (1982)، وعلى القصف السوري المناطق اللبنانية ومجزرة حماة، ثم على «ألوان» العنف والاضطهاد والخطف والقتل التي مارسها النظام السوري على المواطنين المعارضين. وبدا، وفق ما يروي في الكتاب، على بيّنة من التعذيب الذي شهدته السجون السورية، وملمّاً بأدوات هذا التعذيب مثل «الدولاب» و «التعليق» والاغتصاب. ويسمي كتاب مصطفى خليفة السجين الشهير، وعنوانه «القوقعة»، مرجعاً لفهم السجون السورية.
كتاب «الغضب والنور» هو كتاب سيرة ذاتية وروحية، سيرة نضال إنساني خاضه هذا الراهب الثوري الذي فتنه الإسلام مثلما فتنه المسيح، نضال من أجل ترسيخ الحوار الإسلامي – المسيحي. إنه أيضاً سيرة مثقف طليعي، التزم قضايا الحياة والعالم، من منطلق واقعي وتاريخي، ديني وحضاري.
تُرى هل ما زال الراهب باولو، الإيطالي الذي يسمي نفسه سورياً، على قيد الحياة؟ ما أغرب قدر هذا الراهب: أن يطرده النظام السوري من أرضه عندما علم بنزعته الثورية، وانخراطه في صفوف المعارضة، ثم أن يخطفه «الثوار» التكفيريون الذين صادروا الثورة النقية، ثم أن يتجاهل الغرب اختطافه وكأنه نكرة.
الحياة





