“لا للطائفية”.. ما دون الطائفية: محمد سامي الكيال
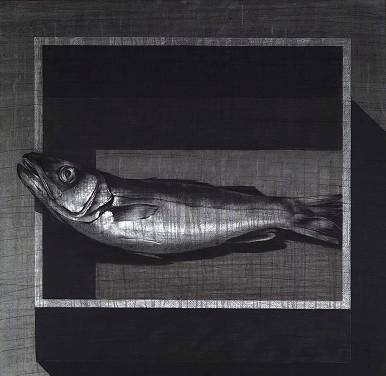
محمد سامي الكيال
كما في كل قضية كبرى وإشكالية ترافق المخاض الاجتماعي المؤلم، الذي تعيشه شعوب المنطقة، يبدو العالم المفهومي والرمزي للخطاب السائد (الثوري وغير الثوري، إذ لا فرق جوهرياً بين “الخطابين”) شديد الضيق والرثاثة، عاجزاً عن تمثيل الوقائع وصياغتها وترتيبها، في بنى فكرية ولغوية متماسكة، وعضوية في الحراك المجتمعي والتاريخي، فيغدو “الواقع” منفلتاً مشاكساً بربرياً متوحشاً وموحشاً أحياناً.. عبثياً دوماً. في حين يتقزّم الخطاب “العالم” إلى مستوى التمويه الأيديولوجي المبتذل، يعيد إنتاج السائد مهما أفلت منه المتحرك والمتغير.
ولعل عبارة “لا للطائفية” هي أشد الأمثلة تعبيراً عن التمويه الأيديولوجي، فما اتُفق على أنه ميثاق الحداثة العربية برفض الطائفية، وتجاوزها نحو آفاق أرحب (المواطنة أو “الشعب” أو المجتمع المدني) بات يفضح أكثر مما يخفي نظرة هذه “الحداثة” للبشر والمجتمعات والتكتلات الاجتماعية، نظرة تقوم بتطييف كل صراع وكل كينونة اجتماعية، ثم تدمغها في الخطاب الأيديولوجي بدمغة “لا للطائفية”. هكذا يتهرب الخطاب السائد من تحليل وقراءة وخوض معظم الصراعات الاجتماعية، بحجة طائفيتها، متمسحاً بسطح الخطاب الذي يظهره المتصارعون، يخرجها من السياق الاجتماعي إلى السياق العقائدي الطائفي، ثم يعلن رفضه لكل ما يحدث بحجة أنه طائفي بحت، وبالتالي “لا للطائفية”… أليست هذه الآلية الفكرية هي آلية العقل الطائفي بعينها (تحويل ما هو اجتماعي إلى صراع عقائدي ولكن “مرفوض” هذه المرة)؟!
لا يتطلب الأمر عبقرية خاصة كي يدرك المرء أن الخطاب “اللاطائفي” ينبني جوهرياً على نظرة طائفية للوقائع والمجتمعات، نظرة ترى البشر ككتل طائفية يستحسن ألا تتصارع، ويلصق أسباب الصراعات بـ”التخلف” و”الظلامية” التي تستدعي من غابر الأزمان صراعات المذاهب والكتب المقدسة، لا تاريخ ولا مجتمع وسياسة، هناك فقط “عقل ظلامي”، هو سبب المشاكل ويستحسن أن نتنصل منه. ليس صعباً كما قلنا فضح هذا، ولكن السؤال الأكثر صعوبة: ما الذي تموهه هذه الأيديولوجيا؟ أي مصالح ورؤى ونظرة للعالم وفئات اجتماعية تجد في هذا الإنشاء معرفتها الأنسب لبناء عالمها والدفاع عنه؟
“لا” الطائفية
تمتلك سردية “لا للطائفية” أرشيفاً ضخماً من الصور النمطية التي يتكثّف فيها قولها الأيديولوجي، ولعل أكثر هذه الصور كلاسيكيةً هي صور رجال الدين وزعماء الطوائف المتحابين المتعانقين. وبغض النظر عن التهكم الكثير التي بدأت هذه الصور بالتعرض له منذ فترة ليست قصيرة من الزمن، فإن ما تظهره وتبطنه أكثر بكثير من مجرد النفاق الذي ينضح منها، والذي ينصبّ عليه التهكم عادة، فهي تقوم على تثبيت وإظهار الرموز الطائفية في عملية “التآخي” الحاصل، أي أن عملية “إنكار” الطائفية تقوم على عاتق الرموز الطائفية بالذات، والبنى الطائفية التي جعلت من ممثلي هذه الطوائف شيوخاً وباشوات وزعماء، هي نفسها من ينتدبهم لتمثيلها في إظهار “السلم الأهلي”، وبالتالي فإن “لا للطائفية” التي يمثلها هؤلاء الزعماء هي تثبيت لنسق طائفي قائم، يجب أن يبقى متوازناً وليس إنكاراً له. هي إظهار لاستقرار السلطة الاجتماعية وقدرتها على تجاوز أزمتها المزمنة وليس العكس، إظهار للسلام في الطائفية وليس انتفاء الطائفية نفسها، بل يمكننا الذهاب إلى أبعد من هذا والقول أن صور السلام الطائفي هذه هي ما يؤكد وجود الطوائف وبناها وتماسكها وحضورها وأولويتها في الحدث الاجتماعي. عندما تحوّل كل علاقة وعملية توحد ووجود اجتماعي إلى صليب وهلال وعمامة فإن “لا للطائفية” هي ما يوجد الطائفية ويؤكدها بحضورها الدلالي والكياني المتسيّد اجتماعياً. هكذا، تغدو الصور النمطية لـ”لا للطائفية” هي أكبر أنشودة لتمجيد سلطان الطائفية! طبعاً كل هذا لا يستقيم من دون السلطة الدولة، التي تحافظ على الألقاب الاجتماعية والكينونة القانونية المفترضة للطوائف. هنا تغدو طائفية “لا للطائفية” هي خطاب الدولة القائمة ذاتها، وعلامة على ديمومتها واستمرارها.
في النصف الثاني القرن الماضي، ومع اكتمال ملامح مشروع “حداثة” الدول العربية، ظهرت إلى جانب صورة زعماء الطوائف المتعانقين صورة أخرى أكثر “تنوراً”، هي صورة المثقف “الوطني”، المتشنّج دائماً وأبداً ضد كل حديث أو ذكر للطائفية. في الواقع، يعكس كل هذا التشنّج “الوطني” مدى حضور الطائفية وإرباكها لوعي ذلك المثقف، والتأكيدات المتكررة على “الوحدة الوطنية” هي إضمار فاضح، إن صح التعبير، بأن هذه “الوحدة” تنبني على مكونات أولية هي المكونات الطائفية، التي يجب أن تبقى في حالة السلام والوحدة كي يستمر المجتمع والدولة. هي نظرة طائفية حتى النخاع لـ”الكيان الوطني”، والأهم أنها إذ تُخرج التعبيرات والتسميات الطائفية من اللغة المتداولة والمقبولة في الحيّز العام، حيّز الدولة ومجتمعها المدني والثقافة السائدة، تجعل خطاب “الوحدة الوطنية” و”لا للطائفية” هو السيد على المجتمع والوعي، الخطاب الذي يذكّر المجتمع دوماً بأنه طوائف تحتضنها دولة، يجب أن تحافظ دوماً على “الوحدة الوطنية” و”السلم الأهلي”. ويرفع هذه “الحقيقة” لمستوى التابو؛ هي المقدس الذي يجب أن يعيه الجميع ولكن من المحرّم ذكره، وإلا وقعت الكارثة وتفتت المجتمع والدولة… هكذا أُنتجت طائفية “الحداثة” العربية، آلية الهلال والصليب ذاتها ولكن من دون أهلة أو صلبان!
الأسوأ من ذلك، أن هذا “الفكر الوطني” قد منع، بسلطة الثقافة السائدة، الحديث الشعبي الشفوي عن ممارسات طائفية للسلطة من الوصول إلى مستوى الخطاب السائد، وأبقاه في خانة المحرمات “الظلامية”، واعتبر أي فعل اجتماعي للتصدي للممارسات “الطائفية” للسلطة هو الطائفية بعينها، الطائفية الخطيرة على “الكيان الوطني” والمؤدية لتفكيكه. هكذا غدت الممارسة الطائفية امتيازاً محتكراً للسلطة وحدها تحت سلطة تابو “لا للطائفية”. ولعل التاريخ الدموي لسوريا في السبعينات والثمانينات هو أكبر مثال على الفعل السلطوي الطائفي لأيديولوجيا “لا للطائفية”، الأيديولوجيا التي سكتت عن مجازر الدولة وعمليات الإبادة الجهوية، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من البشر، وتدمير المدن والقرى، وأدانت فقط بعض المقاتلين “المتطرفين” على الجانب الآخر، ووسمتهم وحدهم بالطائفية!
اليوم، ومع الانفجار الاجتماعي الكبير التي تشهده المنطقة العربية، بلغت أيديولوجيا “لا للطائفية” ذروتها المنطقية والاجتماعية وحضيضها في الآن ذاته، ربما مع حضيض وتفكك بنية دولة “الحداثة” العربية وخطابها وثقافتها، والمحاولات الحثيثة لإحيائها والحفاظ عليها وسط الطوفان الكبير. هنا بالضبط يتفق أنصار الأنظمة مع عشاق أيديولوجيا “الربيع العربي”: فلنحافظ على الدولة ولنكن ضد تفكك “الكيان الوطني”… وبالتأكيد “لا للطائفية”.
تمارس سردية “لا للطائفية” اليوم آليتها الأساسية برد الصراع الاجتماعي الداخلي والإقليمي الكبير إلى مفهوم “الفتنة”، فكل ما يجري اليوم من معارك تاريخية كبرى هو مجرد وعي مغلوط تبثه بعض الجهات “الظلامية”، وبذلك يستعير “اللا طائفيون” منطق وبلاغة مؤرخي القرن الثاني للهجرة الذين فسروا الصراع الاجتماعي الكبير في عهد الخلافة بفتن عبد الله بن سبأ وغيره. اليوم أيضاً لا أسباب للصراع سوى إيغار الصدور بـ”الفتنة” الطائفية، وبذلك يستقيل هؤلاء من أي دور في فهم أو المشاركة في هذه الصراعات ويكتفون بإدانتها ورفضها. ربما يظنون، لا شعورياً، أنهم بهذا يلغونها من وجود اللغة والمفاهيم “السليمة” و”الحقيقية”، فيوقفون بذلك فعل الزمن ويحافظون على عالمهم الاجتماعي والثقافي القديم، عالم الكيانات “الوطنية” التي صاغتها دول “الحداثة” و”لا طائفيتها”.. وكما هي العادة، فإن الممارسات التي ينعونها بالدرجة الأولى هي “الطائفية” الوافدة حديثاً على المشهد، وليس الممارسات العريقة للدولة والسلطة (وإن كان لا مانع من بعض الإدانة اللفظية العابرة).
بعد كل هذا ليس من الصعب أن نعرف أي مصالح وفئات اجتماعية تعبر عنها أيديولوجيا “لا للطائفية”، فتجميد الزمن وعبادة الدولة هي شيمة أبناء المجتمع المدني لدول حداثة الاستبداد، من المنتمين للفئات الوسطى والعليا، المرتبطين بالدولة وبحيزها العام السلطوي.
ولكن علينا في الختام أن نثبّت ملاحظة مهمة، أين هو الخطاب الطائفي البحت الذي يخافه الجميع؟ في الواقع، نجد أن الحالات التي وجد فيها خطاب طائفي عارٍ ووقح هي حالات شديدة الهامشية، موجودة دوما على أطراف الخطاب الاجتماعي العام وفي الحيّز المنبوذ من اللغة. في حين، لطالما هتف الزعماء السياسيون والدينيون للطوائف وممثلو السلطة والدول التي ثبتت كيانية الطوائف، لطالما هتفوا بخطاب “لا للطائفية”… ألا يحقّ لنا إذن أن نقول بكل بساطة، إنه على عكس ما يبدو للوهلة الأولى، فإن خطاب “لا للطائفية” هو خطاب الطائفية الأساسي والمركزي والرسمي الوحيد في مجتمعاتنا ودولنا، وأن “لا للطائفية” هي “لا” السلطة الطائفية؟!
أدنى من الطائفية!
ولكن من يأبه بآليات الخطاب الطائفي ومنتجيه إذا كان الواقع طائفياً حتى النخاع؟ هكذا قد يتساءل البعض، وكرد مبدئي نقول أن “الواقع” تكوين لا يفلت من الهيمنة والخطاب، هو معجون بالسلطة والمعرفة من السطح وحتى أعمق العمق..
دعونا إذاً نحاول تشكيل معرفة جديدة بهذا “الواقع”، فباستثناء لبنان التي يشغل فيها التطييف موقعاً مؤسساتياً في قلب الدولة والمجتمع المدني، يحفظ للطوائف كيانيتها ويعيد إنتاجها دوماً، فإن بقية دول الجوار، وعلى رأسها سوريا، تبدو بحاجة للكثير حتى تصل إلى ذلك المستوى “الراقي” من المأسسة الطائفية، هي ليست دولاً متقدمة متجاوزة للطائفية بل هي فعلاً دول ما دون طائفية، وتفتقر أساساً للحيز السياسي العام الذي يمكن أن يجعل الطائفية سياسةً عامة ويمكّنها من ترسيخ تقاليدها على مستوى العمل العام.
إذا نظرنا بعمق أكبر إلى واقع تلك الدول والمجتمعات نرى تشتتاً ورثاثة في البنيان العام مثيرة للشفقة حقاً، وندرك أن منظومة العلاقات والامتيازات والتحالفات والكوننة الاجتماعية هي أقرب لمنطق المافيات ولوبيات المصالح شديدة الصغر وضيق الأفق، هي أدنى من طوائف، إنها عُصَب مبعثرة تفتقر إلى السياسة والحيز العام، مرتبطة بتبعية ذليلة لدولة متغولة، لا يكرّس تغولها الوحشي إلا الحالة العصبوية التي تنتجها وتعيد إنتاجها في المجتمع. في سوريا مثلاً لا يوجد “سنّة” و”مسيحيون” و”علويون”، حتى لو تكرّست مخاوف الخطر الوجودي عند “الأقليات” أو الخطاب الطائفي السنّي ضد النظام. هناك فقط شبكة معقدة من التحالفات والصدامات والتهادنات مع الدولة تجريها مجموعات وفئات وميليشيات متفرقة ومتعارضة لم تصل بعد، ومن الصعب أن تصل في شرطها البنيوي الحالي، إلى خلق حيزها العام الطائفي والتشكل في كيانية طائفية.
إذاً ما حاجة سلطة قائمة على العصبويات الرثة لخطاب طائفي كخطاب “لا للطائفية”؟ فلنقل أن الطائفية والتهديد بها هي أيديولوجيا الدولة وثقافتها السائدة للهيمنة على رعاياها المشتتين بين العُصب، هي أسلوبها في إرساء استقرار مجتمعها المدني المرتبط بها عضوياً وإنشاء “الكيان الوطني” الذي لا يحميه من التمزق سوى وجودها الخانق.
ماذا عن الصراع الاجتماعي الكبير الذي يدور الآن في منطقتنا، هل هو صراع طائفي “ظلامي” كما ينذرنا أنصار “لا للطائفية”، مع الدعوة المتكررة لعدم الانجرار له والالتفات إلى ترميم وإعادة بناء دولنا و”وحدتنا الوطنية”؟ إنه صراع طائفي بمقدار ما تضخّ به الدول المتغولة، إلا أنه بين حشود “المتطرفين” و”الظلاميين” و”المتخلفين” من البشر، المشاركين في الصراع، يمكننا أن نلمح رغبة عميقة في المقاومة وسعياً حثيثاً للحياة، مقاومة منظومة السلطة و”لا طائفيتها” والتحرر منها، واستعادة الحق في إنتاج الجمعي المشترك والمقدرة على الخلق وإنشاء اللغة والتسمية والذات.
فلنناضل إذاً مع ناسنا لأجل الحياة…
المستقبل





