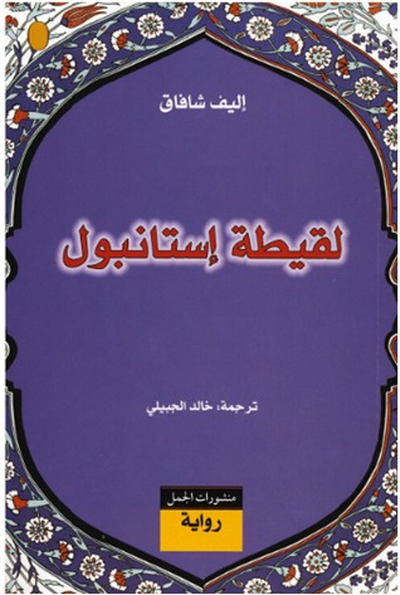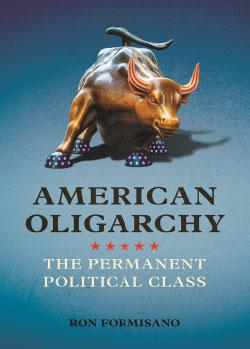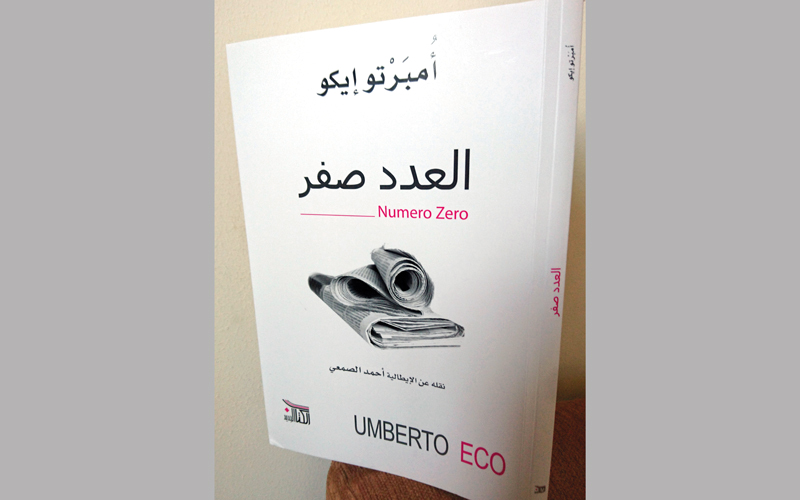لماذا يكذب السياسيون؟/ جمال شحيّد
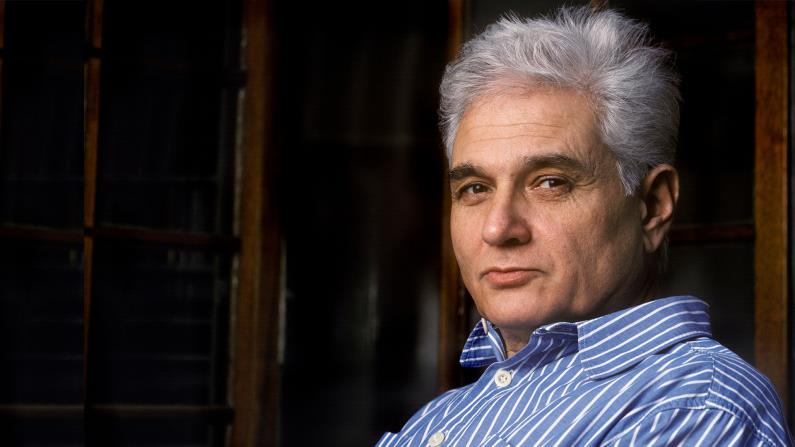
إذا ألقينا نظرة إلى المعجم العربي، لوجدنا أن مرادفات كلمة “الكذب” تعجّ في لغتنا الشريفة. ومنها: تمويه، خداع، تلفيق، تضليل، مراوغة، زيف، تزييف، غش، افتراء، افتئات، إفك، بهتان، تخرّص، دجل، تدجيل، فريّة، مخاتلة، اختلاق… ما يدل على أن حال الكذب بألف خير في ديار العرب. ولا تخْلو اللغات الأخرى من غنى في مفردات الكذب، الذي ورد تحريمه في الوصية الموسوية التاسعة التي حُفرت في لوحي العهد الجامعين للوصايا العشر.
وكثيرون هم الكتّاب الذين تناولوا الكذب بالتحليل، ومنهم القديس أغوسطينوس في كتابيه De mendacio [عن الكذب] وContra mendacium [ضد الكذب]، وموليير في مسرحية “الكذّاب”، وتصدى أيضاً للنفاق الديني في مسرحية “طرطوف”، وجان جاك روسو في “تأملات متنزِه متوحد”، وإيمانويل كانط في “النظرية والممارسة”، وأوسكار وايلد في “انحسار الكذب”. وحذا علماء النفس حذو سيغموند فرويد في تحليل الكذب لدى الأطفال. ولكن المسألة التي أروم طرحها تتعلق بالكذب السياسي الذي حلّله ديريدا بألمعية في كتاب “مقدمة في تاريخ الكذب”، وفيه استكمل ما أوردته حنة أراندت في كتابها “السياسيون والصدق” (1968).
للكذب أهداف كثيرة، منها إلحاق الأذى بالآخر والتخلص من المآزق. يقول روسو في كتابه “تأملات”: “الكذب المستخدم لمصلحة شخصية هو تدجيل، والكذب المستخدم لمصلحة الآخرين هو خداع، أما الكذب الذي يتوخى إلحاق الأذى فهو افتراء”. ويقول ديريدا في كتابه المذكور آنفاً: “عندما يكذب المرء، فهذا يعني أنه يبغي خداع الآخرين عن قصد”. وهو خرق لميثاق الثقة بين المتكلم والمُخاطَب. وهذا يذكّر بقول المسيح: “فليكن كلامكم: نعم نعم، ولا لا. فما زاد على ذلك كان من الشرير” (متى، 5، 37). وكان كانط يعتبر الكذب أكبر وصمة تصيب عقل البشرية، لأن الصدق هو حق من حقوق الإنسان.
ولكن رجال السياسة لهم رأي مغاير، تيمناً بقولة فولتير: “الكذب شر عندما يُلحق الأذى، وهو فضيلة كبرى عندما يؤدي إلى الخير”. وطبعاً هم يتبنون القسم الثاني من هذه الجملة. قبل غزو الأميركيين للعراق في 19 آذار/مارس، أكّد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن أن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل وأنه تحالف مع أسامة بن لادن، وأنه متورط في تفجيرات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وقبل بوش، كذب الرئيس روزفلت على الأميركيين بخصوص تعرّض البارجة الأميركية غرير Greer في بيرل هاربور في آب/أغسطس 1941 ليبرر إقحام أميركا في الحرب العالمية الثانية. وكذب الرئيس جونسون على شعبه عندما افتعل حادثة خليج تونكين عام 1964 ليعلن الحرب على فيتنام الشمالية. ولإثارة الذعر لدى الأميركيين ادّعى الرئيس كنيدي أن الروس سيطلقون الصواريخ على أميركا انطلاقاً من كوبا، علماً بأنه عقد مع السوفييت اتفاقاً سرياً يقضي بأن تسحب أميركا صواريخ جوبيتر من تركيا، مقابل سحب الروس صواريخهم من كوبا الذي عدّه انتصاراً لأميركا.
وإذا عدنا إلى التاريخ العربي لوجدنا كثيراً من الأكاذيب قد حوّلت مجرى التاريخ؛ ومنها ما حدث في تحكيم صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، والتي شطرت جسم الإسلام إلى سنة وشيعة.
ويعيدنا ديريدا إلى الأكاذيب الأوروبية، والفرنسية بخاصة. يذكر مسؤولية الدولة الفرنسية التي أرسلت، عام 1942، من المحافظات الفرنسية غير الخاضعة مباشرة للنازيين، عشرات الآلاف من اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية، من دون أن تمارس قوات الاحتلال النازي أية ضغوط على الدولة الفرنسية قي هذا الشأن. ووجد ستة رؤساء فرنسيين، وهم أوريول وكوتي وديغول وبومبيدو وجيسكار ديستان وميتيران، أنه لا يمكن ولا يناسب ولا يجب وليس من العدل بمكان أن يشوَّش الشعبُ الفرنسي بالإقرار بما حصل ولا بالاعتذار عنه. وحده الرئيس شيراك تجرأ واعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية عما حدث وبارتكابها جريمة ضد الإنسانية.
وحتى الآن، كما يذكر ديريدا، لم تعترف الدولة الأميركية بالجريمة التي ارتكبتها في هيروشيما وناكازاكي. وكذلك ما زالت الجرائم التي ارتكبت في فلسطين والجزائر وحرب الخليج وحرب يوغوسلافيا السابقة ومجازر رواندا والشيشان جرائم ومجازر لم تعترف بالمسؤولية عنها الدول والحكومات التي ارتكبتها. وحده رئيس الوزراء الياباني موروياما اعتذر – ولكن بكلمات ملطفة ومواربة – عن احتلال اليابان لمنشوريا وأجزاء من كوريا والصين وقتلها عشرات الآلاف من شعوب هذه البلدان. أما رئيس وزراء إسرائيل فأكد أن إنشاء ما سمّوه “دولتهم” تمّ بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الهاغاناه وشتيرن والمستوطنون بحق حوالي مليون فلسطيني هُجّروا وطُردوا من أرضهم عام 1948، مدّعين أن الدول العربية هي التي طلبت منهم المغادرة. ولكن المؤرخين الجدد في إسرائيل، من أمثال بني موريس وإيان بابيه وشلومو سِنْد… فضحوا هذه المزاعم واعترفوا بالتهجير القسري وبالمذابح التي ارتكبت بحق الفلسطينيين لترويعهم.
ويرى الباحث ألكسندر كويري (A. Koyré)، الذي يذكره ديريدا في كتابه، أن الإنسان السياسي المعاصر “يسبح في الكذب، ويخضع للكذب في كل لحظة من لحظات حياته”. وما الكذب إلا نقيض الصدق والحقيقة، فهو جرثوم ينخر جسم المجتمع الذي يسيطر عليه حكام كاذبون وبهاليل. وهذا يذكّر بالكتاب التنبؤي “خيانة المثقفين” (La trahison des clercs)، الذي كتبه الفرنسي جوليان بندا عام 1927، وما زال راهناً في أيامنا هذه بخاصة. وفيه يدعو المثقفين ألا يكونوا كلاباً تحرس الحكام، كما قال بول نيزان في كتابه العاصف “كلاب الحراسة” (1932) التي تلعق أحذية المسؤولين، بغية الحصول على عظمة فيها شيء من اللحم المنسي.
وماذا عن الكذب في بلدان العالم الثالث وفي البلدان العربية؟ إذا كانت وسائل الإعلام الحرة والاتصالات الحديثة في البلدان المتطورة تكبح جماح الكذب السياسي، فيضطر المسؤولون فيها إلى التفكير ملياً قبل أن يقدموا على خداع شعوبهم وباقي الأمم، نرى أن إغلاق باب المحاسبة في بلدان العالم الثالث يطلق أيدي الحكام الكذابين ليتمادوا في كذبهم من دون رادع يردعهم، فيزوّرون الحقائق كيفما طاب لهم. ألم يقل الراحل ممدوح عدوان ذات يوم إن حكومتنا الحكيمة في سورية تكذب علينا حتى في النشرة الجوية. ووقتها لم تكن موازين الحرارة متوفرة في الشوارع وعند الأفراد. وكان بعض الناس يصدّقون النشرة الجوية الحكومية التي تبثها قناتا التلفزيون الوطني الوحيدتان لدى المشاهد السوري قبل انتشار المحطات الفضائية.
البلدان التي تقيّد حرية الرأي، بتشديد الرقابة الإعلامية والفكرية، هي البلدان التي يكون قادتها “أكثر ميلاً، من نظرائهم في البلدان الديمقراطية، إلى إخفاء سياسة مثيرة للجدل عن شعوبها”، كما قال جون ميرشيمر في كتابه “لماذا يكذب القادة؟ حقيقة الكذب في السياسة الدولية” (الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016 عن سلسلة عالم المعرفة). ولا يلجأون إلى الكذب على شعوبهم أثناء الحروب فحسب، بل في كل وقت، وأحياناً بكثير من الغباء والسذاجة. أمّا الكذب والتزوير في مناسبات التصويت والاقتراع العام، فحدّث ولا حرج. أولاً يرفضون وجود مراقبين دوليين نزهاء؛ وثانياً يرفعون نسبة الفوز فتنتقل مثلاً من 15% (فعلاً) إلى 90% بالمئة وأكثر. ومن يريد الفوز في الانتخابات البرلمانية مثلاً، عليه أن ينال مسبقاً رضى الأجهزة الأمنية التي توفّر له النجاح بوسائلها الخاصة؛ وتطالبه من ثمّ أن يوقّع على كل مطالب ومشاريع السلطة. يذكر فواز حداد في رواية “تياترو دمشق”، أن حسني الزعيم الذي قام بأول انقلاب عسكري في سورية – وفتح بالتالي باب الانقلابات – نال 115% من أصوات الناخبين [وهذه ربما مزحة من فواز]، مع أن حكمه لم يتجاوز السبعة أشهر. وويل ثم الويل لمن يحتج أو يعارض هذه النتائج.
وعندما يستشري الكذب والخداع في دولة من الدول، يشعر المواطنون بالاغتراب ويفقدون الثقة بحكومتهم ويكفّون عن احترام قادتهم ويضعون نقطة استفهام على نزاهتهم وإخلاصهم. في البلدان النامية، الجميع يعلم بتفشي الفساد في أوساط السلطة، ويلمسون أيضاً هذا التفشي في متابعتهم لقضاياهم، إذ لا يستطيعون أن يكسبوا دعوى محقة إلا إذا رشوا القضاة، ولا يمكنهم الحصول على نتيجة إيجابية ومحقة لمعاملة من معاملاتهم إلا إذا أرفدوها بمبلغ من المال يقبضه الحاجب والموظف والمدير. عندما قيل لتشرشل إن الدولة البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية قد انهارت، سأل: هل القضاء والتعليم بخير. فقيل له: نعم. قال: لا تخافوا، بريطانيا بخير، رغم ما ارتكبه النازيون. في البلدان النامية، ومنها البلدان العربية، لا القضاء بخير ولا التعليم أيضاً. ما علينا إلا أن نرى بأم أعيننا المبالغ التي تدفع تحت الطاولة للقضاة [وأحياناً فوق الطاولة]، كي يبتّوا لصالح هذا دون ذاك الذي لم يدفع أكثر. أما في التعليم فما علينا إلا أن نتوقف عند كتب التاريخ والتربية القومية التي تشوه الحقائق وتقدّس الأنظمة الحاكمة، وتضفي على رؤساء البلدان صفة التقديس والألوهة. وفي التصنيفات الأخيرة لأفضل الجامعات في العالم، لم نلحظ اسم أية جامعة عربية.
يقول المثل الشعبي إن “حبل الكذب قصير”، إذ يأتي يوم وتنجلي الحقيقة. فبعد أن غزت أميركا العراق، تبيّن أن التهم التي اختُلقت لم تكن سوى ذرائع مبيّتة للانقضاض على العراق وتحطيم إمكاناته وزرع الفوضى فيه. الكذب، كما يقول ديريدا في كتابه المذكور آنفاً “يعني دائماً خداع الآخر عن قصد”. ومن واجب المثقفين أن يفضحوا هذا الكذب المعشش في صدور السياسيين.
في فرنسا، بعد محاكمة الجنرال اليهودي الأصل دريفوس متّهَماً بالخيانة العظمى، أعيد إليه اعتباره بفضل الاحتجاجات الصاخبة التي قادها بعض المثقفين، ولا سيما إميل زولا في مقاله الصاعق “إنني أتّهم”. لم يسجن زولا بسببه ولم يرسل إلى سيبيريا كما كان ستالين يفعل بالمعارِضين الذين أذاقهم أهوال “الغولاغ” الذي تكلم عنه الكاتب المنشق ألكسندر سولجينتسين. سيأتي يوم ستُسقط فيه الشعوب العربية ورقةَ التوت عن المسؤولين في ديار العرب، وهو قريب قريب.
ضفة ثالثة