ما أضيقَ العيش!/ محمد صابر عبيد
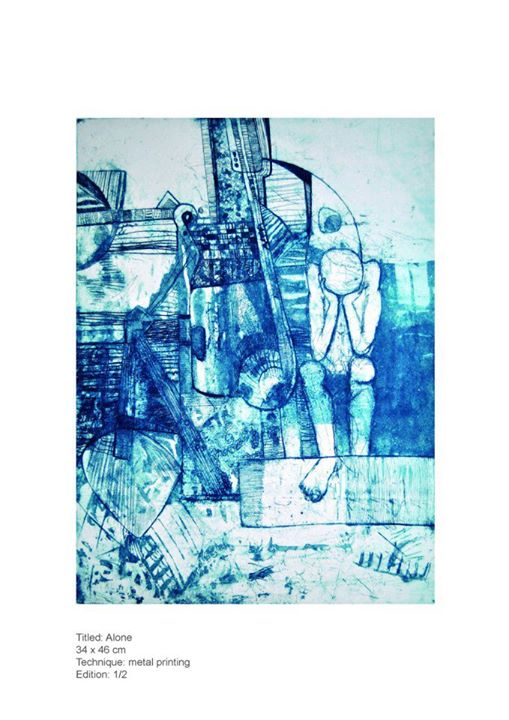
للّه درُّكَ أيّها الطغرائيّ وأنتَ تروي في “لامية العجم”، سفرَ غربتك بإيقاعه الذي يُرجفُ غابةَ الجسد ويهزّ قلعةَ الروح. فحين كان عالَم القرن الخامس الهجريّ مقسوماً عندكم على عرب وعجم، وسمّى قبلَكَ الشنفرى الأزديّ لاميّتَهُ بـ”لاميّة العرب”، ما كان عليك سوى تسميتها بـ”لاميّة العجم”، كي تحتكرا أنت والشنفرى الكونَ كلّه بلاميّتيكما، أمرٌ عجيبٌ أن يفّكرَ الشاعرُ بهذه الطريقة في غزو العالم تخييلياً. غير أنّ لاميّتكَ كانت عربيةً في غربتها ووجعها وحنينها اليائس، على الرغم من أنّها تضع استثناءً وهمياً ضرورياً هو “فسحة الأمل” قد لا يصمد طويلاً أمام ضراوة الأسى وعنف المحنة وشراسة الحظّ العاثر.
بحثتُ طويلاً وعميقاً عن فسحة الأمل تلك، وكلّما أوشكتُ أن أجد ظلّاً لها أو طيفاً صفعتني موجةٌ طاغية مسمومة قادمة من بحر الظلمات فتختفي تحت قسوة ضرباتها الظلال وتندثر الغمغمات ويضيع الأثر، حتى تيقّنتُ أخيراً أن لا فسحة أمل ممكنة ومتاحة إلّا في “لاميّة العجم”، فأعود لأقرأها من جديد علّي أتزوّد ما يكفي من السخرية والعزيمة اليوتوبية نحو نوبة جديدة من مغبّة البحث ومتاهته. وإذا كنتُ في كلّ قراءة لها أتلبّث طويلاً في الزاوية المهملة التي تمكث فيها زهرةُ “ما أضيق العيش” الذابلة، فإنّني أمرّ مرور اللئام على “فسحة الأمل” ولا أجد أحداً.
الزوراءُ التي سئمتَ من إقامتك فيها حيث لا ناقةَ لكَ فيها ولا جمل، هي الآن وبعد مرور قرون طويلة عليها غريبةٌ حتى عن نفسها، تركها الزورائيّون الأصلاء أصحاب “الله بالخير أغاتي”، وسكَنَها الأغرابُ المحتلّون الذين لا يجيدون اللهجة البغدادية الأنيقة المهذّبة المبهّرة المبغددة، ضاعت ملامحها العتيدة، وتعفّنت صورها التي التقطها بالأسود والأبيض المصوّرون الأرمن بكلّ حرفة ومهارة وبراعة، وتقصّف شعرها ذو الجدائل الطويلة التي كانت تهزم بالتفافاتها الأفعوانية المتموّجة مقصّات العالم وعيون الحسد، وشحبت وجوه جميلاتها الفاتنات التي طالما غنّى لسحرهنّ ناظم الغزالي ورضا علي ومحمد الكبنجي، وأدار كرخُها ظهرَه لرصافتها، ولم تعد مقاهي الزهاوي والمعقّدين وحسن عجمي والشابندر والبلدية وغيرها تقّدم الشاي السيلانيّ الزنكين الذي تملأ رائحته الأنوف والأزقّة والدكاكين والأرصفة، فتسكر على سفوح عبقه العصافير والبلابل وزوّار الإمام الكاظم والإمام الأعظم وشارع الرشيد. لم يعد فيها ما يحمل العاشقَ المتيّم على زيارتها كي يتموّن بأريج الحياة كما من قبل.
ما أضيقَ العيش. أي والله، ما أضيقه! قد تبدو هذه الجملة اليتيمة بسيطةً ومسكينة وشاحبة ولا حول لها ولا قوّة، لكنّها من أخصب ما عرفتُ من عبارات شعرية تخضلّ بماء الشعر حتى يسيل من شفتيّ مَن يتلفّظ بها لفرط حلاوتها الشعرية ومرارتها السيميائية. ما أضيقَ العيش حين تهبط مطرقة الضيق الهائلة على رأس “العيش” الصغير وهو يتناهى في الصغر آناً بعد آن، حيث لا خبز ولا تمر ولا ماء ولا كرامة ولا كبرياء. ما أضيقَ العيش، حين ترى بأمّ عينك وأبيها وجّدها ما آلتْ إليه الأحلامُ الكبرى والآمالُ الكبرى والمصائرُ الكبرى. فما من حلم كبير إلّا وقد سُحق تحت عجلات الوحوش الكاسرة وهي تلتهم الأخضر واليابس وما بينهما، برغبة جارفة في المحو والتنكيل والإذلال. وما من أمل كبير إلّأ وقد داسته سنابك الخيل الغازية بلا رحمة. وما من مصير كبير إلّا وقد تفكّك إلى شبكة من المصائر الصغيرة تلتفّ على بعضها بتفاهة ونذالة وحمق. فهل ثمّة عيشٌ أضيقُ من ذلك أيّها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد؟
كم كنّا نحلم بالوحدة العربية الكبرى حين كانت الطفولة والمراهقة وبدايات الشباب تزيّن لنا هذا الوهم وتنمّقه وتضيئُهُ بما تيسّر من أحجار التراث الكريمة، وتحرّض حماستنا البدائيّة على الهتاف بأعلى ما تتسّع له أفواهنا من أجل وطن عربيّ واحد، بعلم واحد، وسلام وطنيّ واحد، وعُملة واحدة، وضمير واحد، وكلمة واحدة، وجيش للدفاع واحد، وشرطة تتفانى في عملها من أجل أن لا ينام مواطنٌ عربيٌّ واحد وهو مهمومٌ أو مظلومٌ أو كئيبٌ، من الشام لبغدان، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان؛ وطنٌ واحد له جوازُ سفر واحد حين تقدمّه لموظف جوازات أيّ بلد في العالم يقف فوراً إجلالاً لكَ وله؛ وطنٌ واحد له سوقٌ واحدة، ولغةٌ واحدة، وبهجةٌ واحدة، وزيّ وطنيّ واحدٌ، تخترقه بسيارتكَ الشخصية العربية الصنع من المحيط إلى الخليج بلا خوف ولا خشية ولا تردّد ولا وجل؛ وطنٌ واحدٌ له عيدٌ وطنيّ سنويّ نغنّي فيه ونرقص، ونقذف أحبّتنا بالزهور وأبيات الشعر الغزلية التي يكتبها شعراؤنا خصيصاً لهذه المناسبة، نغتسل بالعطور ونشطف شوارعنا بأفضل أنواع الشامبو، ونحن ندوس صور المقبورَين سايكس وبيكو حين قسّموا وطننا العربيّ الواحد على أكثر من عشرين دولة.
لمَ لا، وموازنة دولتنا العربية الكبرى السنوية تتجاوز الف مليار دولار بكثير. لمَ لا، ودولتنا فيها آلاف العلماء والمفكرين والفلاسفة والمنظّرين والشعراء والقصّاصين والرسّامين والمخترعين والرياضيين والموسيقيين والعشّاق. لمَ لا، وحصّة المواطن العربيّ من المساحات الخضراء مئة متر مربّع أو يزيد، ومعدل القراءة السنوية للفرد العربيّ أكثر من خمسة عشر كتاباً. لمَ لا والدولة العربية أكبر مصدّر للقمح والفاكهة والخُضَر واللحوم والشحوم والكهرباء والماء والهواء والبرامج الإلكترونية والورود والكتب والجَمال والحبّ والخيال والإخلاص والصدق والعدل والتسامح والمساواة. لمَ لا، بعدما أصبحتْ دولتنا العربية المحروسة من دول العالم الأول؟
والآن… بعدما أُزيحَ عن أجسادنا المتكوّرة على أعضائها لحافُ الحلم الثقيل، وصحونا متأخرّين بعدما اندرستْ طفولتنا وأُزهقتْ مراهقتنا وولّى شبابنا وصرنا على تخوم شيخوختنا المبكّرة، صحونا على فجيعة كابوسنا المرير ونحن نترحّم على الشهيدَين سايكس وبيكو، فكم كان سقفُ خيالهما بخيلاً وضعيفاً ومحدوداً حين قسّما هذا الوطن التليد على عشرين دويلة فقط، في حين نحن بحاجة إلى أكثر من مئة دويلة وإمارة وكيان وووو. إذ كيف يمكن أن يكون العراقُ مثلاً بلداً واحداً من زاخو إلى الفاو، يا شيخ سايكس ويا بيكو أغا؟ ألم تعرفا أننا سنّة وشيعة وأكراد وتركمان وسريان وايزيديون وشبك وصابئة مندائيون ومكوّنات أخرى ستُخرج لكما رؤوسَها بعد حين من شقّ الأرض وأنتما ومن لفّ لفّكما لا تعلمون؟! ألم تعرفا أنّ الشيعة وحدهم بحاجة إلى أكثر من دولة وهم يختلفون في أشياء كثيرة لا يمكن لدولة واحدة أن تجمعهم بهدوء وسلام؟! وأنّ سنّة الأنبار غير سنّة نينوى، وسنّة ديالى غير سنّة تكريت؟! وأنّ الأكراد الصوران غير الأكراد البهدينان؟! وأن السريان لديهم خمسة اتحادات أدباء كلّ واحد منهم عدوّ للآخر؟! وأنّ التركمان والشبك فيهم شيعة وفيهم سنّة وفيهم بينَ بين؟! وعذراً لنقص معلوماتي في ما يتعلّق بأنواع الإيزيديين والصابئة المندائيين والمكوّنات الأخرى التي ستخرج بعد حين، ولكنّ الأمر سيكون واضحاً وهيّناً بعد أن تأخذ كلّ مجموعة حقّها في دولة مستقلّة قد لا تعترف بالآخر الشبيه وربّما تقاتله على عشرة أمتار أو أقلّ متنازع عليها من الأرض، وسيكون سهلاً على كلّ من يريد دولةً أن يحصل عليها في صدى حقّ تقرير المصير!
لعلّ السوريين واللبنانيين واليمنيين والليبيين وكلّ “بلاد العُرب أوطاني”، يعرفون أكثر منّي كم يحتاجون إلى دول كي يناموا قريري العيون على وسائد من الريش الملوّن وأسرّة من الحرير المطعّم، لا يزعجهم جارهم بلهجة ناشزة تختلف عن لهجتهم، أو أغنية قبيحة تختلف عن أغانيهم، أو تعلو من منازلهم رائحة طعام محيّر لم تتعوّد حساسيتهم الشميّة المرهفة عليه، أو يلعب أطفالهم بكرة يشمئزّون من لونها لأنه يفزّز رغبتهم البَصَريّة الغافية على لون واحد لا يسعهم تمثّل غيره، أو الاعتراف به أو احترامه، لكنّهم قطعاً يحتاجون مثلنا إلى دول كثيرة تنظّم أمورهم المتعسّرة، وتحلّ مشكلاتهم المستعصية، وتداوي جروحهم التي لا علاج لها. فلونٌ واحدٌ وبيئةٌ واحدةٌ ولهجةٌ واحدةٌ وشكلٌ واحدٌ ولباسٌ واحدٌ وصورةٌ واحدةٌ وهواءٌ واحدٌ وشارعٌ واحدٌ ومرآةٌ واحدةٌ، تتشابهُ فيها الوجوهُ والأقنعة والحركات والأفعال والتخصصات والنيّات في الصحو والمنام، في المكوث والقيام، كفيلةٌ استقرار الأمن وتحقيق رفاهية المواطن البليد والمحافظة على سلامة الأرض والمياه والسماء الوطنية من طمع الطامعين.
فليست العبرة في عدد النفوس وشساعة المساحة، بل العبرة في أنّ سكّان هذه الدولة يعيشون في جزيرة خاصة بهم، يتقاسمون فيها المناصب والحقائب الوزارية بلا مشكلات تُذكر، مثل أولئك المجانين الذين احتلّوا جزيرةً خاليةً من الحياة، وما إن وطئتْ قدمُ الأوّل منهم أرض الجزيرة حتى صاح صيحةً هائلةً هزّتْ أركان الجزيرة: أنا فخامةُ الرئيس، أعقبه فوراً دولةُ رئيس الوزراء، ثم تتالى أصحاب المعالي الوزراء واحداً بعد الآخر وهم ينتخبون الحقائب الوزارية السيادية والخدمية وغيرها حسب سرعة الوصول. وحين وصل الأخير لم يجد وزارةً شاغرةً، فاتجّه إلى حكومة التكنوقراط المؤلفة حديثاً بكامل طاقمها الوزاريّ قائلاً لهم: وأنا ماذا أفعل، أجابوه كلّهم بلسان واحد عاقل (غير مجنون) على الفور: أنت الشعب! إذ لا يُعقل طبعاً أن تتألف حكومةٌ وطنية من دون وجود شعب يصوّت لها لتخدمه وتسعى إلى إسعاده وتحضّره وتقدّمه.
فما أوسعَ عيش الحكومة المجنونة وهي تختال بمناصبها، فخورةً ومتباهيةً ونافشةً ريشها المدعّم بالأوسمة والنياشين الذهبية اللامعة، بعدما حصلت على حقوقها السيادية بجدارة واستحقاق وامتياز. وما أضيق عيش المواطن البسيط (المجنون الأخير)، صاحب الحظّ العاثر، الذي لم يبق له سوى منصب حقير تافه هو منصب الشعب.
النهار



