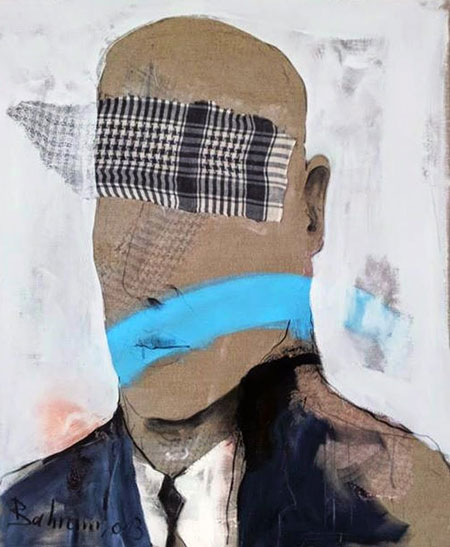ما الذي تكتبه القصيدة اليوم؟/ محمد بنيس

1.
يعيش القارئ، اليوم، مثلما يعيش الناقد والباحث، عبر العالم العربي، حيرةً أمام المشهد القاسي الذي يتقدم نحونا فيه الشعر العربي الحديث*. هذا المشهد له اسمُ هجران القصيدة، في الصحيفة والمجلة والكتاب، بل وحتى في المهرجانات والندوات والبرامج الإعلامية، مقابل الرغبة المتصاعدة في التطلع إلى الرواية، والسعي إلى تتبع أعلامها وأعمالهم. هو مشهد يقسو على العين التي أصرّت على الفرح بالقصيدة منشورة، أو يقسو على الأذن التي تعودت على الابتهاج بها مسموعة. يهجم على ما كان لكل منهما من متعة الشعر التي تتفرد بها القصيدة. وهو، في الوقت نفسه، يتطلب التأمل بدلاً من الإغراء بالامتثال الذي يمارسه الرأي العام، عندما يفضل الانسياق وراء ما له وجاهة في الأدب لدى العارض، ما يتقدم المعْرُوضَ ـ العرْضَ الأدبي. مشهدٌ غيرُ جديد في جميع الإمبراطوريات الشعرية القديمة الباذخة، التي تلتقي معها الشعرية العربية، وفي مقدمتها اليونانية والإيرانية والصينية واليابانية والهندية. فلنتأمل قليلاً.
2.
عرف الشعر العربي الحديث ثورة كبرى في إبدال بنياته. وهي اليوم ثورة ذات تاريخ، يتقاطع مع تواريخ معرفية وفنية، مثلما تحضر فيه رؤية نقدية للمجتمعات العربية وقيمها. ورغم أن التقليدية كانت لحظة البحث عن الذات في منبعها القديم، اعتقاداً في سلفها الصافي، الأصلِ السابقِ على كل أصل، فإن الرومانسية العربية هي التي جعلت من المستقبل لا من الماضي منطلقاً لبناء نموذجها الشعري. ومنذ الخمسينيات أصبحت للقصيدة العربية صلاتُ القرابة والحوار مع الشعريات الغربية للقرن العشرين، تعتمد معرفة بالأوضاع الشعرية المتجددة في الغرب أساساً، من خلال شعرية ت.س. إليوت، ثم من خلال كل من الشعريتين الفرنسية والأمريكية. وإذا كانت قصيدة النثر قد وضعت قدمها على عتبة القصيدة العربية في الستينيات، فإن الثمانينيات هي التي ستستقبل فيها القصيدة العربية مغامرةَ قصيدة النثر، مثلما ستعرف اللحظات الأولى من تجربة الكتابة.
3.
لنا اليوم من تاريخ القصيدة العربية ما يكفي من الأسئلة. ولنا أيضاً هذا المشهدُ الذي أخذ في التشكل منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وهو يستبدّ اليوم بوضعية القصيدة العربية. إنه الذي سمّيتُه بمشهد هجران الشعر نحو فنون السرد، وفي مقدمتها الرواية، التي أصبح صوتها مرجعاً في الرؤية إلى الأدب. المشهد القاسي لهجران الشعر في القديم، يختلف عما هو عليه الهجرانُ اليوم، من حيث إنه يحتضن الرواية، ويضيف إلى أبهاء استقبالها أروقة في بيوت الاستقبال، تتعدد إغراءاتها.
إذا كانت الشعرية العربية تلتقي في هجران الشعر مع الإمبراطوريات الشعرية القديمة الباذخة، فإن هذا المشهد يرافق فيه العالمُ العربيُّ، اليوم، بقيةَ البلدان والثقافات في العالم. ذلك هو زمن العولمة، الذي يُعلي من شأن الاستهلاك والإعلام، متمثليْن في الرواية. هي رواية مخصوصة، تلك التي أصبحت سيدةَ المعْروض ـ العرْض في واجهة المكتبات ومعارض الكتاب، بقدر ما لها الوجاهةُ في الملاحق الثقافية للصحف والبرامج الأدبية في التلفزات والإذاعات، وأيضاً في الدراسات الجامعية. رواية تستجيب لمنطق الاستهلاك في تناول موضوعات بأسلوب يتصالح فيه اليومي مع اللغة الإعلامية ويخضع لها. وفي دوّامة الجريان المتوثب الأنفاس نحو الرواية، بما هي الجنسُ الأدبي القابل للتداول، في النشر والقراءة والنقد، يصبح السؤال عن معنى الشعر وضرورته تحديّاً إن هو لم يكن يكاد يصبحُ غير ذي موضوع. ثقافتنا العربية، التي لم يتوفر لها بعدُ ما يكفي من الرسوخ، في أرضية مجتمعية وثقافية يهيمن عليها الدينيّ بقدر ما يطوح بها السياسيّ، تنفر من السؤال وتتبرأ من الانتساب إليه. وهو أيضاً ما تشجّع عليه العولمة التي توحّد العالم في ثقافة الامتياز والمنفعة.
لذلك فإن السؤال عن معنى الشعر وضرورته اليوم يصبح ممكناً حينما نربط وضعية الشعر العربي بوضعية الشعر في العالم. بل وأن نستلهم تاريخنا الثقافي القديم، فنرى إلى عالم اليوم في ضوء ما كانت عليه بغداد في العصر العباسي أو قرطبة في العهد الأندلسي أو مراكش في العهد الموحدي، من حيث كانت تمثل مراكز ثقافية دولية، فيها وعبرها تتشكل معارف وتتم مجالس الجدل والحوار. بهذا المعنى يصبح حوارنا حول مسألة الشعر العربي اليوم ممكناً وذا فاعلية معرفية عندما نمارس الحوار مع شعريات وإلى جانبها في مراكز ثقافية دولية، وأن نتجنب ما أمكن الفضاءات التي تشجّع على الانغلاق في التعامل مع وضعيتنا الشعرية.
4.
نعم، إن هذا الحوار ممكن، بل هو مطلوبٌ في العديد من هذه المراكز الثقافية، التي لا يزال لها من تاريخ السؤال، أو من القدرة على تلقيه وإعادة أنتاجه، ما يسمحُ بأن نقول إن هذا الشرط هو وحده الذي يجعل الحوار ممكناً. فالحوار حول وضعية الشعر العربي اليوم إما أن يكون معرفياً، كما كان في القديم، أو كما تحقق في لحظات مفصلية في الثقافة العربية الحديثة، أوْ لا يكون.
الحوار بالنسبة لي، في هذه الجلسة، محدّدٌ بتصور خاص للقصيدة هو الكتابة. أعني القصيدة بما هي كتابة، والحوار يبدأ من صيغة التساؤل عما تكتبه القصيدة اليوم. قصيدة وتساؤل على هامش السائد عربياً، ومن خلالهما أتناول تجربتي الشخصية في قصيدة الكتابة.
كنت أحد شعراء السبعينيات الذين جعلوا من شعراء الخمسينيات أساتذة لهم. كان بدر شاكر السياب أولاً ثم أدونيس لاحقاً، في مقدمة الذين رأيتُ فيهم شعراء التحديث. وهم تعلموا بدورهم من شعراء سابقين عليهم، مثلما تعلموا من الشعريتين العربية والغربية. كنت في اختياري وسلوكي منسجماً مع تاريخ الشعر والشعراء في العالم، لا فرق فيه بين قديم وحديث. هو أولُ درس فتح لي الطرقَ السرية للقصيدة. وفي قراءاتي للشعر الغربي، الملازمة لثقافتي الشعرية العربية، كما لعنايتي بالفلسفة والكتابات التي كانت لها وضعية الهامش في الثقافة الفرنسية على الخصوص، تعرفتُ على مسار مختلف للقصيدة، هو الذي عُرف في السبعينيات بتجربة الكتابة. وهو ما فطن إليه شعراء أمريكيون في الفترة ذاتها، في مقدمتهم جون أشبوري ولاحقاً شارلز برينشتاين، فكتبوا ما عرف في أمريكا بقصيدة اللغة.
كان أدونيس أسبقَ عربياً في التوجّه نحو الكتابة، ونحو التنظير لها مقابل ما كان يسميه الخطابة. وهو، في تنظيره للكتابة، أفاد من “كتاب المواقف ويليه كتاب المخاطبات” للنفّري، الذي كان عثر عليه سنة 1965 في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت، ومن كتابات فرنسية غير محددة، كما هو لديه الحال بالنسبة للمرجعية العربية. كتابات تنطلق من النص كممارسة على حدود الأجناس الأدبية.
5.
كانت صلتي بالشعر الفرنسي الحديث، منذ بودلير، تفرّعت وتشعّبت في اتجاهات متعددة، تبعاً لما كان متداولاً آنذاك في الثقافة الفرنسية ذاتها. وكان من أهم سمات تلك اللحظة الثقافية بروزُ لسانيات دو سوسير وكتابات جاك لاكان وموريس بلانشو وأنتونان أرطو وجورج باطاي، بارتباط مع ظهور كتابات رولان بارط وفرنسيس بونج وجاك دريدا وجيل دولوز وميشيل فوكو وترجمة أعمال الشكلانيين الروس. ثم إن لائحة كتّاب الهامش هي التي أصبحت تدلني على رؤية نقدية، لا ينفصل فيها الشعر عن الفكر ولا القصيدة عن المعرفة. هنا، وبعد قراءات تفاعلتُ فيها مع سلسلة من أعمال نيتشه وابن عربي وهايدغر، وجدتُني في حالة من النزوع إلى الرغبة في ممارسة القصيدة بما هي كتابة.
لا بد أن أشير هنا إلى أن كوني مغربياً، يكتب بالعربية، كان يفعل فعله في اختياراتي وفي ممارستي لكتابة القصيدة. فهمتُ الشعر من البدء في ضوء وظيفته الاستكشافية والنقدية، كما هي له في الشعر الحديث، عربياً وغير عربي؛ وفهمتُه أيضاً بمرجعيتي الثقافية المغربية ـ الأندلسية، بما هي مرجعية لم تعد تتمتع بأحقية التداول في الثقافة العربية الحديثة، ثم فهمتُه في قيمته المعرفية، كما توصلتُ إلى استيعابها من شعريات قديمة وحديثة. خصائص كانت تتبلور شيئاً فشيئاً في كتابة قصيدة شخصية، على هامش القصيدة العربية. كان همّي على الدوام أن تكون قصيدتي مفتوحة على استضافة تجارب شعرية، وعلى الحوار مع سواها. ومن أجل أن تتوفر على ما يؤهلها للحوار، كنتُ أتعلم كيف أتحرر ممن لستُ أنا في القصيدة.
6.
كنتُ سنة 1981 نشرتُ نصاً بعنوان “بيان الكتابة” لتوضيح ما كنتُ آنذاك أفكر فيه بخصوص الشعر. ثم تلاحقت النصوص النظرية كلما شعرت بفائدة كتابة إضافات جديدة، حسب الظرفيات التي باغتت الشعر العربي أو الأوضاع الدولية. نصوصٌ تتخذ من المغامرة مصدر الإقدام على كتابة القصيدة. “المغامرة” كلمة لا نجد لها ذكراً في لسان العرب. هي مصدر ميمي، يغلب على ظنّي أنها استعملت حديثاً كترجمة لكلمة aventure الفرنسية وadventure الإنجليزية. تم اشتقاقُها من فعل “غمَر”، التي يذكر ابن منظور أن من معانيه “علا وغطّا واستغرق”، ومنه اسم غمْر، أي ماء كثير مغرَّق بيّنُ الغُمورة، ويُجمع على “غمار”. والمُغَامر هو الذي يغشى غمَرات الموت. وهو اسم فاعل من فعل غامر. والغمْرة الماء الكثير، وهي الشدة. وغمْرة كل شيء مُنهَمَكُهُ وشدّتهُ، كغمْرة الهم والموت ونحوهما.
تتحدد دلالة المغامرة إذن في النزول إلى الغمْرة، الماء الكثير، الشديد، المنهك، حتى يعلوك الماء، يغطيك ويستغرقك. تنزل إلى الغمرة، وأنت تعلم أنه قد يكون نزولاً إلى ما فيه هلاكك. نزولٌ هو اختبار شدائد موقف الفناء، الموت. هذا المعنى يدلّ على التخلي عن المعلوم، المتداول، المتعاقد عليه، في ممارسة القصيدة كما في ممارسة الحياة. وبه تصبح المغامرة، في مجال القصيدة، علامة على الكتابة. فالانتقال من قصيدة التعبير إلى قصيدة الكتابة نزول إلى غمرة الفراغ، إلى غمرةٍ هي البطشة الكبرى. من الفراغ تأتي الكتابة، هبةً من الكتابة إلى الكتابة. لا هي هبَة سماوية ولا شيطانية. الفراغ، في كتابتي، مفهومي للكتابة، ليس نقيض الامتلاء. إنه فراغ خالص، لا بداية له ولا نهاية. لا سبَب ولا مُسبّب. فراغ عثرتُ في الكتابة عليه وأنا أتعرف، من جديد، على الصحراء وعلى شساعتها اللانهائية. لهذا أقول إن الكتابة تغادر هذه الثنائيات التي تعتقل القصيدة. فالنزول إلى الغمْرة معناه القبول بكتابة القصيدة كبناء لإيقاع، مفتوح على المجهول واللانهائي. يأتي أثناء الكتابة، لا قبلها ولا بعدها، ويصدر عن ذاتية مخصوصة لا تتشبّه بسواها ولا تخشى الغمْرة، المغامرة.
القصيدة، في مفهوم الكتابة، هي التي تكتب نفسها. أقصد على السواء كلاًّ من القواعد الداخلية التي تصبح بها القصيدة قصيدةً، أي منفصلةً عن السرد، ومن التفاعلات التي تتم بين العناصر البانية للقصيدة، لغوية وإيقاعية، بصرية وسمعية، تركيبية ودلالية. عناصر تبني عملاً معمارياً، له صفة الفضاء المسرحي والتأليف الموسيقي. القصيدة في الكتابة لا تسرد مشهداً يومياً أو غير يومي. لا تعبِّر. هي تركيب، وكل تركيب بناء. وما تتغياه هو غواية اللغة، حيث تصطدم بالمعلوم والنافع، لترحل نحو المجهول، الخفيف، الخفي، البطيء، غير النافع، ما لا يمثل قيمة في سوق التبادل، مثل أن تكتب عن الصحراء أو عن الأحجار. إنها تجربة اللانهائي في الكتابة، أي تجربة الهلاك في العلاقة التي تتصالح في اشتراطها ثقافة التقليد وثقافة العولمة مع القارئ، المستهلك، فيما الكتابة ينتظرها قارئ نقدي، يتجرأ على المغامرة بإعادة إنتاج المعنى، متعدداً ولانهائياً، في القصيدة.
7.
هجران القصيدة اليوم يتحقق بفعل الثقافة السائدة، ثقافة الاستهلاك والتواصل الإعلامي، التي لا تعرف ما يجب أن تفعله القصيدة أو ما ضرورتُها. وللهجران تسميات مختلفة، من بينها النفورُ من غموض الشعر، أو افتقادُ الحسّ الموسيقي، أو ابتعادُ الشعر عن قضايا الناس وعن حياتهم اليومية ولغتها. تسميات تتضاعف على يد نقاد في ثقافات مختلفة، وليست مخصوصة بالعالم العربي كما نتوهّم. وجهة النظر التي يدافع عنها هؤلاء النقاد هي التي يعتقدون أنها تتجسد في القصيدة التي تدّعي الكلام عن حياة الناس اليومية بلغة واضحة، مباشرة، ومؤثرة. إنها أيضاً تلك القصيدة التي تتغنى، عربياً، بنقد الواقع السياسي العربي. هي قصيدة التنديد بالأوضاع المؤسية، سياسياً واجتماعياً.
وجهة النظر هذه لا تعبأ بتاريخ القصيدة ولا بمغامرتها. لكن عليَّ أن أؤكد، أولاً، أنني أتفق مع هؤلاء النقاد في ملاحظة هجران القصيدة، ثم في تساؤلهم عن مصدر هذا الهجران. غير أنني أختلف معهم في الجواب الذي يقترحونه. وحجّة الاختلاف معهم هي أنهم لا يعرفون ما أصبح عليه فعل القصيدة اليوم وما ضرورتها.
كان ستيفان ملارمي، أحد أكبر شعراء الغرب في القرن التاسع عشر، كتب في قصيدته “قبر إدغار آلن بو”، “أنْ نعطي معنًى أصفى لكلمات القبيلة”. هكذا كان ملارمي ينظر إلى الشاعر وعمله. إن كلمات القبيلة المهددة بالذوبان في اللغة المحكية، أو اللغة اليومية الجافة، الباردة، تحتاج إلى ما يشعلُ جذوتها. ولا يكون ذلك إلا بإعطائها معنًى أصفى، ينقلها من الاستعمال المبتذل إلى المفاجئ، الصادم. لا تنازل في الاختيار ولا تردد. بهذا رأى ملارمي وظيفة الشاعر من أجل تثبيت ضرورة الشعر.
لكن شاعر اليوم لم يعد، للأسف، مالكَ اللغة ولا نبيَّها أو خالقَها. هو اليوم ممنوع من القصيدة، لأنه ممنوع من اللغة. فالمنطق الذي يستند إليه الداعون إلى هجران القصيدة لا يلتفت إلى ما يختفي وراء هذا الهجران، الذي هو أولاً، وقبل كل شيء، هجران اللغة. يمكن أن نرى التحريض على الهجران وتزيين الافتتان به في الخطاب الإعلامي، من خلال تفضيل لغة اليومي، الواضح، المباشر، الكسول؛ كما هو في استعمال لغة فضفاضة، بعيدة عن الدقة، متساهلة في البحث عن معجم وعن علاقات تركيبية شخصية، أي تجريد اللغة من طاقتها الحيوية، من إمكانية أن تكون، أيْ إمكانية أن تعمل على استدامة وجود اللغة.
كتابة القصيدة هي كتابة الشعر في زمنيته الكبرى، وهي، في الآن نفسه، اشتغال على الكلمات وعلى التركيب المفاجئ، الصادم للكلمات. بهذا المعنى تكون الكتابة نزولاً إلى الغمرة، الماء الكثير، المهلك. فالقصيدة تحوّلُ الزمنية الكبرى للشعر إلى حاضر مستمر، يتضمّنُ الماضي والمستقبل في آن. لا يتم ذلك إلا بمعرفة الشعر وتاريخيته، وبإدراك معنى الوعد بالميراث والضيافة؛ ميراثٌ قادم من الأزمنة البعيدة، وضيافةٌ للآخر، الغريب. لهذا تكون القصيدة عالماً من طبيعة شعرية، عالماً ليس صغيراً مقابل العالم الكبير. بل هي عالم مستقل بذاته، شعري، فيه وبه تعيد اللغة صلتها بالحيوي، متعةً ونشوةً، بما هو عالم مجهول لا يتوقف عن أن يظل مجهولاً. القصيدة في الكتابة تبتعد عن العالم الاستهلاكي والإعلامي، فيما هي تستكشف عالماً مختلفاً، خفياً، مجهولاً، غير نافع. هذه القصيدة تنقل العالم من مجافاة المعنى إلى العالم الذي يحفظ المعنى ويحافظ عليه في اليومي، في الحياة، أي في الذات والأشياء والكون. هكذا لا تتحول الحياة (والموت) إلى مجرد سلعة معروضة في سوق السلع، عرْضٍ للاستهلاك.
كتابة القصيدة في غمرة الزمنية الكبرى هي اعتبار المعرفة عنصراً بانياً للقصيدة. فعندما تحتضن القصيدة الميراث وتشرع أبواب ضيافة الآخر، فذلك هو المعرفة في القصيدة، معرفة تبني عالماً مستقلاً بذاته، مفتوحاً على الوعد باستدامة اللغة، لأنها تتأسس، عند ذاك، على وعد باستدامة الميراث والضيافة. أفق المعرفة هو أفق القصيدة العربية أقول، يقيم فيه الشاعر ويقاوم به الدعوات المتسرعة، التي تختزل الشعر إلى خطاب ذي وظيفة إعلامية، تبليغـية، لا مستقبل له لأنه لا ماضي له، ولا ذاتية له لأنه لا ميراث له ولا ضيافة.
وربما كان من المفيد، ونحن في جامعة كولومبيا، إحدى أعرق الجامعات الأمريكية، أن نستدعي ت.س. إليوت، المعروف بدراساته النظرية النقدية إلى جانب كونه شاعراً كبيراً. إنه خريج جامعة هارفارد، وصاحب رؤية للشعر تقوم على المعرفة، ومنها المعرفة بالشعر الأروبي، اليوناني وشعر دانتي، كما بنظرية الشعر الرمزي الفرنسي في القرن التاسع عشر، وفي مقدمته شعر كل من بودلير (مترجم إدغار آلن بو) ولافورج (مترجم والت ويتمان). كان لإليوت تأثير ذو قوة جارفة في الشعر العربي المعاصر، وبالخصوص من خلال قصيدته “الأرض الخراب” كما هي تسميتُها السائدة في الترجمة العربية. لهذه القصيدة حضور راسخ في شعرية القرن العشرين، رغم أن إليوت شاعر محافظ دينياً وسياسياً. والخصيصة المعرفية للشعر من بين ما تعلمته منه، سواء في مرجعيته الشعرية أو في بناء القصيدة لديه. ذلك ما أعنيه بالزمنية الكبرى، التي لا أظن من مصلحة الشعر العربي التفريط فيها، في زمن لم نعد متأكدين فيه من ضرورة الشعر.
هي إشارة سريعة لشاعر أصبح من أنْسابنا الشعرية، واستدعاؤه يفيد أن جوابنا عن هجران الشعر يصبح ذا معنى إن هو انتبه إلى تاريخ الشعر العربي الحديث. على أن الانتباه يصبح أكثر يقظة عندما ندرك زمنية السؤال التي تحكمها العولمة، في ظل شرائط سيادة ثقافة الهيمنة والتقليد عبر العالم العربي.
9.
هجران اللغة في خطاب الاستهلاك والإعلام تأبيد لخطاب العبودية. وما تكتبه القصيدة مقاومةٌ لخطاب العبودية في مختلف أنماطها، أكانت عبودية دينية أم سياسية أم أخلاقية. فالقصيدة توقد نار الكلمات عندما تنقل اللغة من الأدنى إلى الأقصى، من المعلوم إلى المجهول، من التقليد الذي يعتقلها إلى رحابة الإبداع خارج رقابة السوق، محلياً ودولياً، أو خارج رقابة الحاكم، فقيهاً أو سياسياً. وعند درجة الوعي بارتباط مصير اللغة بمصير القصيدة، في زمن العولمة الذي يلغي اللغة، يهجرها وينفيها، يتضح أن القصيدة ذات ضرورة يصعبُ تعويضُها أو دحضُها. بهذا الوعي النقدي أكتب قصيدة لا تستسلم لإغراء الرضا والقبول. أسمع امرؤ القيس ينادي عليّ، كما أسمع أبا تمام والمتنبي، في السفر المتجدد، قريباً من القصيدة، بعيداً عن القصيدة.
* نص المحاضرة التي ألقيت في جامعة كولومبيا بتاريخ 28 سبتمبر 2017 بدعوة من شعبة الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية.
صفة ثالثة