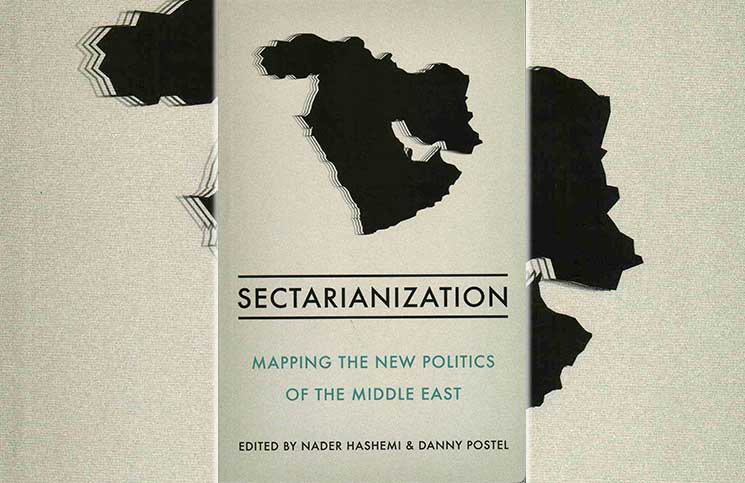ما لا يُستعاد /مريم شريف

الكتابة لاستعادة معنى الكلمات/ ضيف حمزة ضيف
تقدّم الشاعرة الأردنية الفلسطينية مريم شريف، نمطاً غير اعتياديّ لقصيدة النثر، فمن النادر أنْ تجد شعراً بالتوصيف المعاصر لشكل القصيدة العصري؛ محافظاً على هدوئه من ناحية، وقادراً على منحكَ هامشاً عريضاً من الدهشة، وشعوراً عزيزاً بالفقد من ناحية أخرى. ذلك أنّ التريث المستمر في تكوين قصيدة النثر، قد أوشكَ حقاً؛ أنْ يصبح طابعاً مزمناً لمجمل القصائد التي يقول بها شباب قصيدة النثر العربية. وفي الآن ذاتهِ هنالك طقس آخر، يعتمد على التسرّع في طرح اللمعة وطرد الدهشة، بحيث تغدو القصيدة متعجّلة في فرد ما لديها من تصوّرٍ وصور، بالشكل الذي يجعلُ ما فيها من المعنى مبدوءاً بآخره، وغيرُ مختومٍ البتة بأوّله.
قصيدة النثر، تشبهُ كثيراً التعرّف المبكّر على الدهشة الأولى التي تسبقُ الحب عادةً، فالنمط الذي تسير عليهِ؛ مجذوراً بالمقدرة على التأنّي بوصفها متحرّرة من الوزن والقالب الكلاسيكي للقصيدة. وفي الآن ذاتهِ، مقرونةً بالاعتقال العنيف للحظة الأكثر نضجاً في تركيب القصيدة ومسار تحرّكها ضمن مسار المعنى. القصيدة/ الجسم من هذا المنطلق هي الورطة الأولى، فيما الاستمرار فيها؛ هو النجاة من هذه “الجورة” الكبرى، التي يقعُ فيها نحّات قصيدة النثر بشكل عام.
في ديونها الأخير “ما لا يُستعاد”، الصادر مؤخراً عن دار “الآن، ناشرون وموزعون” بالأردن، حرصت مريم شريف، على تحقيق تلك المقاربة، ونجحت في الحصول على فائض الهدوء من العجلة المبكّرة في صناعة الصورة الشعريّة، وغاصت عميقاً بدراية لافتة في الوصول إلى الكمين الإنساني في القصيدة، بحيث تشكّل قصيدتها، مجالاً حرّاً للتواري خلف فقدٍ ظاهرٍ، وحيزاً بديناً لاستنطاق الصورة، بعيداً عمّا يعقدهُ الشعراء عادةً في قصائدهم، من استنطاقٍ عنيفٍ فيما يشبه الغلاكو الشعري للصورة التي ينتووّن من خلالها مفاجأة القارئ، غير هيّابين من تعثّر قصائدهم في اللحاق بنفس “الريتم” المتّفق عليه ضمنياً؛ بينهم وبين مجرى قصائدهم بشكل عام.
في سنة 1979، ألّفت الناقدة الأميركيّة ساندرا جيلبرت (Sandra Gilbert)، مع صديقتها الأستاذة الجامعيّة سوزان غوبار (Susan Gubar)، كتاباً شهيراً ومهمّاً عنوانه: “المجنونة في العلية” (The Madwoman in the Attic). يتحدّث هذا الكتاب الذي كان أحد الكتب المهمّة في كشف التهجير النسوي من الأدب، وشبّهتا واقع الأديبة في عالم تسيّطر عليه الذكوريّة؛ بالمجنونة التي يتم طردها من الباحة إلى العلية. وظلّ هذا الكتاب مغموراً في الاجتماع الأدبي العربي إلى يومنا هذا، رغم ما أحدثهُ من ضجة كبرى لم تنتهِ مفاعيلها إلى اليوم، في الأوساط الأكاديمية والنقديّة في العالم الغربي، فالنسويّات الناضجات طرحاً والعميقات فكراً، على غرار جوديت بتلر وغياتري سبيفاك وغيرهنّ، ما زلنَ يفكّرن في تفخيخ تلك العلية.
لكنْ وللحقّ، لا نزال نعيش مفاعيل هذا الكتاب إلى يومنا هذا، حيث تشكّلت عصاباتٌ نقدية ذكوريّة، تتعامل مع النصوص وفق “عقدة” الجندر، سواءً تلك النصوص النقديّة اللّائي تتماهين في تلميع صورة بعضهنّ، أو أولئكَ النصوص التي تسعى؛ إمّا لتجاهل نتاج البعض، أو العمل على “تقريع” البعض الآخر، بالاستناد إلى مدارس نقدية باردة.
في قصيدة “نقصان” تقول صاحبة “أباريق الغروب” (2002): “أفكر حين أسير بأثقالي/ وحين أصعد الأدراج/ نحو مكانٍ لا أحبّه/ أنّ الثبات ليس في قدميّ/ مكانَ الحقيقة/ مكانَ اليقين/ ذلك الذي مثلَ يدٍ تُناولني معجزةً/ ثم تغيب اليدُ/ كأنها كانت تلك الغيمة/ أو ذلك الجبل/ أو كأنها لم تكن، ربما تلك اللهفة التي لا يمكن خلخلتها/ الإنشاد نحو البعيد/ الإنشاد الذي لا يمكن أن يسمّى أسراً/ ما يجعلني بقلب مضطربٍ أفتح الباب/ دون أن يطرقهُ أحد/ ما يجعلني أتبع حفّة في الهواء/ وأبتعدُ مسافات/ دون أن أعرف أين أتدارك خطاي/ ثم أعود وفي أبعد اعماقي/ تغوص ضجّة النقصان/ العواصف المليئة بذلك الانشداد المضني/ المبهمُ/ كما لو أنه بابٌ يتربّع في هدوءٍ ما/ وَخَشْخشةُ مفاتيحهِ/ هي الصوت الوحيد بين الأرض والسماء/ وأنا السامعة الوحيدة/ لا أجد المفاتيح/ ولا أعرف على أي شيءٍ ينغلق الباب/ ثم، اليد الغيمة/ ثم التوق، والنقصان/ ثمّ/ لا شيء/ ذابت الجملة/ التي كانت/ ستكمل السياق..”
في هذه القصيدة تستعيد مريم شريف القلق الإنساني من جديد، وتحاول أنْ توظّف “المبهم”، الذي نجحَ في التغلّب على أحاسيس البشر بعد أن سيطر عليهم، ولم يتمكّنُ العقل بكل هيلمانهِ المعرفي، وجدارته في تبوّئه؛ المحرّكَ الأوحد للتاريخ كما قال هيجل، في محاولة اعتقالهِ، وتفسيره، فتأويلهِ، سوى تلك المقاربات الشحيحة التي ساهمت في التوصل المتأخّر إلى الضغطة الكبرى، تلكَ التي تصيبنا حالَ مصادفتنا هذا المبهم في المنتصف.
لكنّ وجه الذكاء هنا، يكمنُ في الارتباط العضوي الذي استعملتهُ الشاعرة في الربط بين المبهمِ والناقص، ذلك أنّ الانشغال بهذا الحيز؛ بقدر ما هو بسويّة واحدة قائمة على الفهم، بقدر ما هو متلاشٍ في السير المعرفي إلى متاهاتٍ؛ لا تفضي إلى مخرجٍ أو تنتهي إلى هدف.
وفي قصيدة “أُصدّق اللحنَ الخرافيّ”، تفتتح الشاعرة هذا القلق الملازم لها بالقول: “مثل فظاظة البْرقِ على الأرض الخالية/ لحظةُ اليقَظةِ تلك/ حين تلْمعُ في القلب/ آخرُ حقائق الليلةِ الماضية/ تلك التي أغمضتُ عينيَّ عليها/ قبل أن أنام/ وجهُك البعيد/ مرَّ بسلام/ موتُ الأمنية اليتيمةِ/ لن أتحسَّس ملامحي الآن/ غداً يذهبُ الموتُ يوماً أبعد/ بغد غد يومان/ وهكذا.. وهكذا”.
وكانت نهاية المقطع المُدرج، هي الافتتاح الثاني في قافية الانتهاء الأول من البحث عن “لحظة اليقظة”، تلك اللحظة المورقة التي تصدمها الأمنية بانسحاب الموت رمزياً على الورق فحسب.
“أُصدِّقُ اللحنَ الخرافيَّ لتلك الأغنية/ أُصدِّقُ الخشوع الذي يُصيبُ الهواء/ أُصدِّقُ ما يفعلهُ بقلبي المغنِّي الضريرُ/ أصدِّق يَدهُ المبصرةَ/ ولا أصدِّق الكلمات:”الأرض بتتكلّم عربي”.”
وكأنّ الشاعرة قد سلَمتْ أخيراً، بفكرة النقص المتوتر تحت جلد الكمال البشري، فأكملت ذلك النقصَ بالاستعاضة عن فقد حاسة بكمال أخرى، فأضحى المغنّي الضرير بيدٍ مبصرة، رغمَ أنّها لا تصدق الكلمات في نفس الوقت. ورغم أنّ هذا المقطع كان موجّهاً للمطرب سيد مكاوي، لكن الشاهد الدائم في القصيدة، أنّ ما تتمّ الاستعانة بهِ من واقع الحياة، غالباً ما يتحوّل إلى رمزٍ عبقريّ الدلالة في القصيدة، فالشعر هو دوماً ذلك الرهان الأكبر على الموجودات، والبناءُ على تحويل الرمز من غايتهِ الشفافة إلى مكوّنٍ حقيقي ومادي لمعنى يستحق أن يُرى.
تمتدّ صفحات الديوان، على غير العادة التي درجت عليها الدواوين الشعرية عادةً، إلى 287 صفحة. فالقارئ في هذه الحال سوف يغيّر رأيه في المدى الزمني الذي يأخذهُ منه قراءة ديوان في جلسةٍ واحدة سريعة ومقتضبة، بلّ إنّه سيجعل منهُ كتاب الجيب الملازم، يقرأ منهُ، ويعود إليه، دون أن يشعر بأنّه قد أعاد الدهشة، رغم أنّه لن يخسر الامتحان أيضاً.
إنّه ديوان للسفر، وكلّ سفرٍ يختلف عن الذي سبقهُ، وبالتأكيد؛ سوف لن يشبه الذي يليه.
عنوان الكتاب: ما لا يُستعاد المؤلف: مريم شريف
ضفة ثالثة