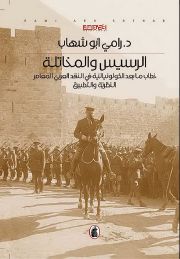“محطة فنلندا” لإدموند ويلسون: “الأبطال” بشر أيضاً/ ابراهيم العريس

لعل أطرف وأغرب ما في كتاب «محطة فنلندا» للناقد والكاتب الأميركي إدموند ويلسون، يكمن في أن قارئه الصبور – والمستمتع بالتأكيد على رغم صبره – يضطر لعبور أول أربعمئة صفحة منه، والوصول إلى نصف الدزينة الأخيرة من الصفحات، قبل أن يفهم سر عنوانه. اللهم إلا إذا كان القارئ من المتبحرين في دراسة تاريخ الحركة الاشتراكية وخفايا ثورة 1917 الروسية. ومهما يكن فإن قارئاً من هذا النوع الأخير لن يكون في حاجة إلى قراءة هذا الكتاب. وربما لن يحبّ أن يقرأه! وذلك بكل بساطة لأن إدموند ويلسون، إن كان لا يحمل هنا هراوة يخبط بها على رؤوس وأفكار رهط من المفكرين والمناضلين يؤرخ لهم ولأفكارهم في الكتاب، فإنه كذلك لا يحمل مبخرة يبخّرهم بها. هو يصف الأمور كما هي، كما عرفها وربما كما رآها أيضاً. وواضح أنهم لم يكونوا كثراً أولئك الذين كانوا، في العام 1940، عام صدور الكتاب، يقبلون تلك الموضوعية، ولا سيما بالنسبة إلى تاريخ الفكر الاشتراكي العالمي، الذي جعله ويلسون موضوعه في «محطة فنلندا».
هذا التاريخ هو ما يتابعه إدموند ويلسون هنا في سرد نادر المثال، وتعمّق في الموضوع لم يكن معتاداً. وإذ نقول هذا، لا بد من العودة هنا إلى العنوان لنذكر بأن «محطة فنلندا» هي محطة للسكة الحديد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، شهدت أول أيام ثورة 1917 وصول لينين، ليتزعّم الثورة، آتياً عبر أوروبا، في عربة قطار مقفلة، سمح له بها الألمان الخائضون الحرب ضد روسيا، للانتقال مع معاونيه وزوجته من سويسرا إلى روسيا. ومن هنا فإن المشهد الرئيس في الكتاب هو مشهد وصول الموكب إلى تلك المحطة. في الفصل الأخير من الكتاب تكون المحطة، إذاً، نهاية رحلة لينين كمناضل مضطهد، منفيّ. ولكن بداية رحلة الثورة الاشتراكية في بداية تحوّلها، أخيراً، إلى دولة. وطبعاً يبدو من الواضح لدينا هنا أن هذا التحوّل الأخير لم يكن هو ما يهمّ ويلسون، بل همّه كان تدوين المسار الذي أوصل لينين إلى هناك، ولكن بالمعنيين: أولاً مساره المباشر من غرب أوروبا إلى شمال شرقها الروسي؛ وثانياً، وهذا هو الأهم، مسار الفكر الاشتراكي كله، وعلى الأقل منذ أواسط القرن التاسع عشر، إلى ما يرمز إليه وصول لينين.
أما البداية فلم تكن، في الكتاب، مع أيّ من أولئك المفكرين الاشتراكيين المعروفين – هؤلاء سيأتون لاحقاً -، بل مع مؤرّخ الثورة الفرنسية جول ميشليه، وتحديداً في اللحظة التي اكتشف فيها كتابات الإيطالي فيكو. بالنسبة إلى ويلسون كانت تلك هي اللحظة حاسمة، حيث أن قراءة فيكو جعلت ميشليه، في كتاباته ولا سيما في تأريخه للثورة الفرنسية، يركز على تأرجح تلك الثورة – وبالتالي تأرجحه هو شخصياً – بين النزعة الوطنية والنزعة الاشتراكية. وهو تأرجح سوف يحافظ عليه ثلاثة من خلفاء ميشليه: تين ورينان وأناتول فرانس. ومن هنا يفرد ويلسون فصولاً بأسرها، تشغل القسم الأول من كتابه، للحديث عن هؤلاء، حديثاً يختلط فيه السياسي بالأدبي والإيديولوجي بالديني، ويصل إلى استنتاجات قد لا تسرّ معجبي هؤلاء كثيراً، ولا سيما منهم معجبو أناتول فرانس، لكنها تدمجهم في ذلك السياق الممهّد لظهور الكتّاب الاشتراكيين الحقيقيين، من أولئك الذين سيفتحون الطريق أمام مؤسسي الاشتراكية العلمية الذين مهّدوا الطريق للينين وتروتسكي.
إذاً، في الفصول الأربعة الأولى من القسم الثاني، يعود بنا ويلسون إلى ما يسمّيه «أصول الاشتراكية» فيتوقّف مع باييف، أحد قادة الثورة الفرنسية، كما أحد ضحاياها، ليستعرض معنا دفاعه حين كان رفاقه الثوريون يحاكمونه تمهيداً لإعدامه، معتبراً دفاعه هذا، واحداً من أول النصوص الاشتراكية في العصور الحديثة «دفاعه هذا، كما يقول ويلسون، الذي استغرق ست جلسات في المحكمة، وملأ أكثر من 300 صفحة، هو مستند قويّ يحرّك المشاعر. فلقد كان باييف يعرف أنه يواجه الموت، وأن الثورة قد قضي عليها بالفشل» لذلك استعرض الوضع من دون وجل. وهذا الاستعراض الذي ينقل إلينا ويلسون أجزاء كثيرة منه، من الواضح أنه يوفر لهذا الأخير الجوهر الأساس الذي يبني عليه كتابه ككل، الجوهر الأخلاقي. والحال أن هذا الجوهر هو ما يهم ويلسون هنا أكثر من أي أمر آخر. وفي هذا يكمن ذلك النفور الذي أحسه كثر من «اشتراكيي» القرن العشرين، إزاء هذا الكتاب، كما يكمن تناسيه في زمنه، حتى وإن كنا نعرف أنها كانت كثيرة تلك الكتب التي سارت على منواله لاحقاً، ليس لتستعرض الجانب الأخلاقي في الإرادة الاشتراكية كما يفعل هو، ولكن لتنسف الفكر الاشتراكي من أساسه، لكن هذه حكاية أخرى.
بعد باييف يصل ويلسون، ودائماً ضمن إطار «أصول الاشتراكية» إلى سان سيمون ففورييه وجماعيّتة وأوين الإنكليزي وكوموناته العمالية، فأونفانتان – الذي كان أحد أعمدة السان سيمونيين الذين قصدوا مصر أواسط ذلك القرن ومهّدوا لحفر قناة السويس -، وصولاً إلى الاشتراكيين الأميركيين اليوتوبيين. وهنا إذ ينتهي الكاتب من تفحّص أفكار هؤلاء، وغالباً بالارتباط بحياتهم ودائماً بالنزعة الأخلاقية التي حرّكتهم، يصل إلى ثنائي كارل ماركس وفردريك إنغلر مقدماً أجمل صفحات كتابه، وأكثرها لؤماً وحناناً، نقداً وتعاطفاً، في الوقت نفسه. فهنا لا يعود مؤسّسي الاشتراكية العلمية ومؤلف «رأس المال» ومكمّله، مجرّد مفكّرين صلبين، وعقلين علميّين جبّارين، كما اعتاد المؤرخون الماركسيون تصويرهما، ولا ذينك «النذلين» السطحيّين، اللذين اعتاد الطرف المقابل تأكيده للنيل منهما، بل يصبحان كائنين بشريين، متحمسين لأفكارهما يخطئان ويصيبان. ولئن كان إدموند ويلسون يتعاطف أكثر مع «طيبة» إنغلر وحسن أخلاقه وتفانيه في سبيل صديقه ودعمه المادي له ولأسرته البائسة، فإنه، حتى ولو أنفق صفحاتٍ لوصف عبقرّية ماركس وقوة الإقناع لديه وعظمة قدراته العقلية، لا يفوته أن يصف تصرفاته اليومية المتعالية الغضوب، وارتيابه في الجميع، وسخريته منهم، بما في ذلك أقرب المقربين إليه، من لاسال إلى باكونين. إن الصورة التي يرسمها إدموند ويلسون لماركس هنا ليست وردية على الإطلاق، لكنها مع هذا مبرّرة بفقر الرجل وتشرّده مع عائلة ألقي عبؤها على كاهله وهو المطارد من بلد إلى آخر ومن بوليس سيّء إلى بوليس أسوأ. ومع ذلك في الوقت نفسه، ينكبّ الرجل على كتابة مئات الصفحات والمقالات، ومتابعة كل ما يحدث في أوروبا وغيرها. ينضم إلى الثورات ويعارض ثورات أخرى. يشتم هؤلاء ويمتدح أولئك، شاعراً في عمق أعماقه، أنه لم يُخلق لذلك الزمن الكئيب!
أخيراً بعدما يصف هنا ويلسون كيف مات كارل ماركس على مكتبه ينتقل إلى القسم الأخير من كتابه وقد اقترب واقتربنا معه من تلك المحطة، التي سيصل إليها لينين بعد حين ليبدّل مع وصوله العالم. لكن لينين كان قبل ذلك، وكما يقول لنا الكتاب، جزءاً من عائلة أوليانوف ثم معلماً فناظر مدرسة خاض النضال السياسي. لكنه لم يخضه وحده بل مع آخرين. وكان في مقدمة هؤلاء الآخرين تروتسكي، النسر الصغير الذي يخبرنا ويلسون أنه عمل دائماً على أن يطابق التاريخ مع نفسه، على العكس من لينين الذي سعى إلى أن يطابق نفسه مع التاريخ. ولكنه كان كذلك، انتهى به الأمر، بعد سنوات المنفى والخيبة والجوع والتشرد، إلى أن يصل إلى محطة فنلندا ولو في ركاب «الأعداء الألمان». ولقد وصف أحد الثوريين وهو سوخونوف اللحظة الأولى لوصول لينين على ذلك النحو: «إن صوت لينين الذي جاءنا مباشرة من عربة السكة الحديد، كان صوتاً من عالم آخر». والحقيقة أن أهمّ ما همّ إدموند ويلسون، الكاتب والناقد وصاحب الكتاب الأدبي الشهير «قلعة آكسل»، في هذا الكتاب هو أن يقول لقارئه، ما الذي يوجد حقاً خلف ذلك الصوت، خلف تلك اللحظة المدهشة. أن يقول حقيقة الإنسان وضعفه وقوته، خارج إطار تلك اللحظات الكبيرة التي لا يصل إلى الناس العاديين سواها. ما أراد ويلسون قوله هو إن «الأبطال» هم «بشر» أيضاً.
الحياة