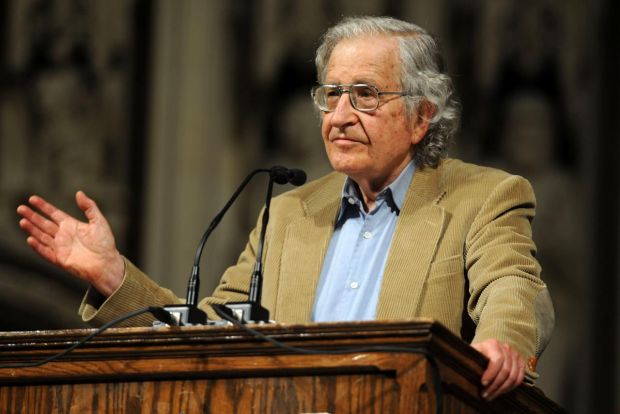مسائل إشكالية… فهل هي جانبية؟
نهلة الشهال
النظام السوري خسر في صورة تكاد أن تكون مطلقة المعركة القيمية والرمزية. فأقرب حلفائه يؤكدون، في أشكال مختلفة، وتلميحات لا تخفى حتى على غير اللبيب، أنهم مضطرون للاستمرار في دعمه لضرورات جيوستراتيجية تخص مصالحهم، أو، وفي أحسن الاحوال تخص رؤيتهم للصراع الدولي الجديد الدائر، والذي تحتل سورية (مع الأسف) واحدة من ساحاته، لعلها اليوم الابرز، وهي على كل حال الأكثر اشتعالاً.
بل يقول حلفاؤه كلاماً لا لبس فيه، على رغم تجنبهم التفاصيل، من أن الحال الراهنة لا يمكن ان تستمر، وأن الأمر يحتاج الى حل سياسي «يحترم ارادة الشعوب». وتحاول الاستطرادات التالية على هذا الاعلان الاستدراك، فتشير الى سلمية التغيير المنشود، بل قد تستحضر «فضائل» سياسية للسلطة السورية (تشبه في الكثير من الأحيان «الأفضال» التي تطوّق الاعناق). فهي هنا دعمت المقاومة في لبنان بوجه اسرائيل وأمدتها بالسلاح، وهي هناك حالت دون إطباق الوضعية الاستسلامية المهينة التي سادت قبل الانتفاضات في العالم العربي. وفي مقام ثالث، تذهب الامور الى جدل سقيم حول انخفاض سعر قارورة الغاز (أو ربطة الخبز) في زمن استقرار الحكم البعثي (ماذا يريد الشعب غير المرعى الوفير؟) مقارنة بسعرها اليوم، بعدما لم يعد من الممكن الاعتداد بـ «كهربة الريف»، علامة التقدم والإنماء والتخلص من «التخلف الفلاحي».
فهذا البند عَرَف تراجعاً صريحاً، منذ ما قبل تسلم بشار الاسد السلطة. حدث ذلك لمصلحة «تدابير» نيوليبرالية استهلاكية ونهَّابة، إذ لا يمكن الكلام عن نظام أو «نظمة» (system)، أي عن بنية وعلاقات ووظائف متماسكة، بل انحطت السلطة القائمة الى استنباط ورعاية «تدابير». وقد قام الرئيس الشاب بكل ما أمكنه لتعزيز هذا الاتجاه وتسييده. ومع أفول مخططات «كهربة الريف»، حدث ما كان متوقعاً، إذ زحف ملايين من الفلاحين المعطلين والجياع الى المدن، أو البلد القريب، لبنان، يعملون في أكثر الاعمال مشقة وبؤساً. ومع النيوليبرالية الشديدة الابتذال المنتصِرة، ذهبت أدراج الرياح الصحة والتعليم المجانيان: انهار مستوى خدماتهما المتواضع أصلاً. وإذ بقي القطاع العام لفائدة المعدمين حصراً، إلا أنهم وإن كانوا غالبية الشعب السوري، فوجود شريحة نقيضة لهم تجعل منهم «هامـشيين»، وغير منظورين. تلك هي قوانين السوق. في المقابل، ازدهرت المدارس والجامعات الخاصة (ومنها الاميركية والفرنـسية والبـريطانيـة الفاحشة الأقساط) وكذلك المستشفيات التي راحت شــيئاً فشـيئاً تقدم خدمات ذات قدرة تنافـسية في عـموم المنطقة، تتعلق بعـمليات التجميل مثلاً…
ولكن، هل هزيمة النظام السوري، القيمية والرمزية، أمر مهم أو مجدٍ؟ ما دام لم يزل يملك المدافع والطائرات، وما يكفي من جنود ليقصف ويدمر ويقتل ويشرد…؟ ماذا ستفعل الامهات الثكلى بهزيمته القيمية والرمزية؟ بماذا تفيد تلك الهزيمة الأمهات المهددات بالثكل؟ هكذا تتحول تلك الملاحظة، وهي شديدة الاهمية في السياسة، الى نوع من قلة الحياء بالنظر الى العذابات: خلال آب (اغسطس) المنصرم وحده، نزح مئة ألف سوري الى خارج البلد، يتكدسون في مخيمات الذل المتعدد الأشكال، وقتل 5400 إنسان في ذلك الشهر وحده. ويقولون «معركة حلب» الفاصلة آتية، بعدما دُمِّر بلا وازع ثلاثة أرباع حمص.
هل نسترسل؟ الهزيمة القيمية والرمزية للاتحاد السوفياتي، ومعه الافكار الاشتراكية، أمام «النموذج» الرأسمالي (على بشاعته!)، كانت العنصر الحاسم في انتهائه المادي والفعلي. وهي حدثت قبل هذا الانتهاء، مهدت له وأشّرت إليه. فلنتذكر تفاصيل سقوط جدار برلين. لقد كشف الانفضاض عن النظام الاشتراكي كما ساد، مبلغ أذى البيروقراطية النخرة، المصحوبة بفحش ومحسوبية «النومانكلاتورا» (أو النخبة المدللة)، والقمع المباشر، والتخطيط للسيطرة. كل ذلك مقابل التوق الى الحرية والابداع. الأخيران اصيلان كنزوع بشري، بينما الاوائل مهيمنون بما ملكت أيديهم. وهو صراع لم يتوقف يوماً، متخذاً اسماء متعددة. هل من عزاء إذاً لجموع السوريين اليوم، الذين لا يرون نهاية النفق (على رغم كلام بعض قادة المعارضة عن «غداً» بطريقة لا تقل وحشية عن كلام النظام).
هل يعزيهم ان يقال لهم إن الكتابة عن سوى سورية تكاد أن تصبح تمريناً مستحيلاً، على رغم كل محاولات الضبط الذاتي والعقلنة، والقول (الصحيح) إن العالم ليس سورية في نهاية المطاف، وعلى الكاتب والباحث ألا يفقد دائرة الرؤية الأوسع. تعود سورية في كل ما يُقرأ ويفتكر.
بل يضبط واحدنا نفسه متلبساً بالتفكير بـ «ما بعد المجازر»! منقّباً في تجارب المسامحة والغفران السياسي (وقد تعدت الـ36 حالة، أشهرها تلك الجنوب – افريقية). معلوم أن المسامحة نقيض النسيان، وأن لها أصولها الصارمة التي تجعلها ممارسة للعدالة الانتقالية، وشرطاً من شروطها في آن، بعيداً من الشكلية، واللفلفة، والامِّحاء، وتطييب الخواطر، وفرض فقدان الذاكرة الى آخر تلك الخزعبلات… وأن ابشع المجازر الممتدة انتهت في يوم من الأيام الى تأسيس هذه الآلية، ليتمكن البشر من استئناف حياتهم، وتضميد جراحهم الغائرة، والتعايش مع ندوبها. ولا شك في أن سورية ستحتاج الى مثل هذا.
عند هذا الحد، تتضح حقيقة ثانية تشبه تلك الاولى الخاصة بالهزيمة القيمية والرمزية للسلطة السورية: إن الانتقال الى التفكير بمرحلة المسامحة ليس نوعاً من الهرب من الفظاعة الراهنة، ولا هو تخفيفٌ من وطأتها، أو استخفافٌ بها. وبالطبع، فهو لا يخص «الرحمة»، ولا يدخل في نطاق مفهومها. بل، على العكس من ذلك كله، المسامحة مصاغةٌ تحديداً انطلاقاً من الإقرار بهول ما جرى! وبمعادلة صريحة، فالتفكير بتلك المرحلة ليس سابقاً لأوانه، بل علامة على «فوات الأوان»، على تحقق هزيمة السلطة القائمة، وعلى الحاجة التي ستطرح بحدة لإيجاد وسائل لرأب الصدع المجتمعي الفظيع.
من جهة أخرى، وكما قالت هنه أرندت، فالمسامحة هي «تأكيد على أن المستقبل ليس امتداداً طبيعياً للماضي». وأضافت مستخدمة لغة شبه دينية، إنها عمل «عجائبي»، لأن «انعدامه يجمِّدنا داخل فعل ملعون لا يمكن الافلات – أو التحرر – منه».
هناك بالطبع «الانتقاميون» الذين يظنون أنهم جذريون، وأنه لا بد من عقاب على منوال الجريمة الواقعة ومثالها، ويظنون أن لا شيء آخر يشفي غليل الضحايا. هؤلاء هم امتداد لتلك الجريمة وتأبيد خطير لها.
الحياة