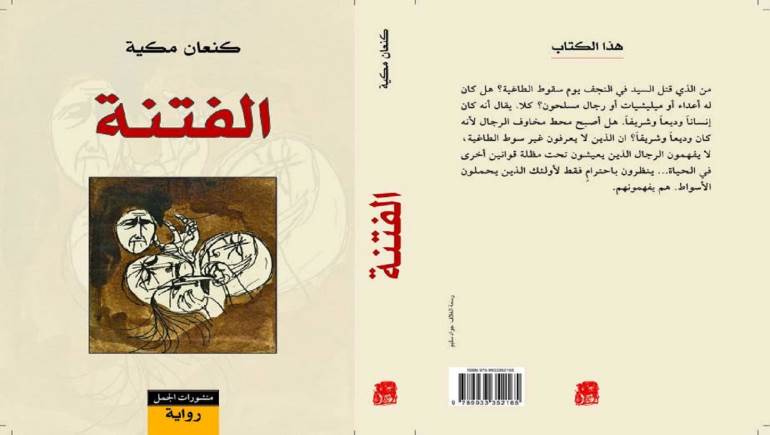“مستقبل الثقافة في مصر” لطه حسين: من زمن الأسئلة الحارقة/ ابراهيم العريس

في حوارات مطولة أجريناها في «الحياة» قبل سنوات حول واقع الفكر العربي ودوره في التصدي للكوارث التي نعيش، أجمع المفكرون العرب على ان الغياب الأكبر الملحوظ الآن هو غياب الفكر ودوره في حياة المواطنين العرب. لاحقاً مع بزوغ الربيع العربي الذي سرعان ما وُئد، تفاءل كثر بأن الفكر لا شك سيلعب دوره… أخيراً. لكن هذا لم يحدث، حتى الآن على الأقل حيث ان الفكر تحوّل عُجالات تلفزيونية أو مقالات صحافية سريعة ومتسرعة لا تعيش أكثر من دقائق قراءتها. من هنا يبدو لنا ان من الضروري على الأقل الرجوع بعض الشيء الى الوراء لعلنا نعثر على فكر مفيد لدى أجيال سابقة علينا. وهل ثمة من هو أجدر من طه حسين بإنجادنا؟ من هنا ها هي إطلالة على عميد الفكر العربي وبالتحديد كتابه الثاقب «مستقبل الثقافة في مصر» لمجرد التذكير به وبما يقول.
لعل واحداً من الأسئلة الأكثر حرقة التي يسألها بعض المتنورين العرب لأنفسهم هو:… ماذا فعلنا، نحن معشر العرب، بالاستقلالات التي حصلنا عليها خلال القرن العشرين؟ ونقول هنا «بعض العرب» ولا نقول كل العرب والسبب واضح: ثمة كثر من بيننا لا يرون لطرح هذا السؤال أي مبرر. فنحن – في رأيهم – في خير وربما في أمان أيضاً، طالما أننا نعادي العالم ونقف ضد العصر ونتمسك بالماضي ونجتر ثقافة الموت ونجعل كراهية الآخر وحتى الإساءة الى الأقليات في حيزنا الجغرافي الخاص، قانوناً وشعاراً لنا. إذاً، هناك من يطرح السؤال الشائك. بل هناك من بدأ يتساءل عما إذا لم يكن المستعمر القديم أرحم من بعض من أدار الأمور في بلادنا وألغى دور الشعوب وجعل القمع والتخلف نبراساً وتراثاً. أما طه حسين، الذي لم يتوقف، منذ خط أول حروف أول نص له، وحتى رحل عن عالمنا، عن الدعوة الى نهضة وتنوير يقومان على العقل والمنطق، فإنه جعل دعوته التنويرية تنطلق من هنا وتصب ها هنا، سواء أعبّر عن ذلك في نقد أدبي، أم تاريخ للشعر، أم بحث فلسفي، أم رواية أم سيرة ذاتية، أم حتى في عمل ميداني كأستاذ جامعي أم وزير للتعليم أم مؤسس لمجلات فكرية نهضوية، فإن المكان الذي كان الميدان الأكثر فساحة لنشر هذه الدعوة كان كتابه «مستقبل الثقافة في مصر». وفي إمكاننا أن نكمل هنا ونقول: لهذا السبب بالتحديد، هوجم هذا الكتاب ولا يزال موضع هجوم حتى اليوم. بل نضيف: إذا كان الضجيج قد أحاط دائماً بكتاب آخر لطه حسين هو «في الشعر الجاهلي» كونه مُنع أزهرياً وحكومياً، فإن الاضطهاد الحقيقي كان من نصيب «مستقبل الثقافة في مصر»، ذلك أن الجهات التي تهجمت عليه لم تكن رسمية تماماً. كانت أقسى من الرسمية: الرجعيات الفكرية القادرة على تأليب المجتمع أكثر من الرقابات الرسمية أو المؤسساتية.
لم يكن من المصادفة، أن يضع طه حسين كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» عام 1938، أي بعد فترة يسيرة من توقيع معاهدة 1936، بين مصر ودولة الإحتلال البريطانية، التي تتحدث عن الدستور والاستقلال وتعلن بدء إلغاء الامتيازات الممنوحة للأجانب، على حساب المصريين، في وطن هؤلاء. فهنا يبدو لنا، من خلال ربط توقيت ظهور الكتاب، بالحديث عن الاستقلال المصري، إن طه حسين إنما طرح على نفسه، وفي شكل مبكر جداً، السؤال المعضلة الذي يشغل الآن أذهان المفكرين العرب: ماذا نفعل بالاستقلال؟ بل إن طه حسين لم يسأل فقط، في ذلك الكتاب، بل أجاب أيضاً.
إذا كان هذا الكاتب، قد حصر تفكيره وكتابه بـ «القضية المصرية»، غير ملتفت كثيراً الى ما كان أقرانه من أهل الشمولية العربية أو الإسلامية ومن شابههم، ينادون به من حلول جامعة مانعة، فما هذا إلا لأنه كان واقعياً. وكان يعرف تماماً أن قروناً من الاحتلال العثماني ثم عقوداً من الاحتلال الغربي، لبلدان المناطق العربية والإسلامية، جعلت نمواً متوازناً وحلولاً شاملة للجميع، أمراً مستحيلاً. كما انه إذ التفت الى التاريخ القديم، رأى أن الجذور الثقافية المكونة لكل منطقة على حدة، لا تسمح، عند تلك المرحلة من التاريخ، باستلهام حلول موحدة، حيث أن توحيد الحلول في مثل تلك الظروف لمناطق تختلف جغرافياً واقتصادياً وتطوراً تاريخياً وذهنيات اجتماعية، معناه تأجيل كل حل. ولما كان الوضع في مصر، على الأقل، لا يتحمل مثل ذلك التأجيل في وقت كان الاستقلال قد أضحى برنامج عمل، لا حلماً وطنياً بعيداً، قال طه حسين: لنبدأ بالأقرب والممكن، لنبدأ بمصر ولنر بعد ذلك! طبعاً ليس المجال كافياً هنا لمناقشة هذه النقطة بالذات، غير أن ما لا بد من الإشارة إليه بوضوح هو أن تطورات العقود الأخيرة، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن طه حسين كان على صواب تام في اختياراته الجغرافية. وهو على أي حال أوضح ذلك حين، كي يتحدث عن حاضر مصر ومستقبلها وبخاصة مستقبل الثقافة فيها، وجد نفسه يعود الى مصر القديمة. مصر الحضارة الزاهية، التي شعت بنورها ذات يوم على جزء واسع من مناطق البحر الأبيض المتوسط، وأعطت للكون ما لم تتمكن مصر بعد ذلك من إضافته الى مسار هذا الكون.
في هذا الإطار رأى طه حسين أن مصر الراهنة -ومصر المستقبل- لن تصل الى درجة مثلى من الحضارة والرفاه لأبنائها إلا إذا قامت على الأسس الفكرية التي قامت عليها مصر القديمة (الفرعونية تحديداً)، في تواصل مدهش مع الحضارة الإغريقية العقلانية، كما في توازن خلاق مع حضارات العالم القديم التي كانت في أساس التجديد الخلاق في حياة وازدهار شعوب المناطق الثلاث التي تشكل استمرارية تلك الحضارات: الصينية واليابانية والهندية. ويبدو طه حسين واضحاً هنا حين يشير الى أن هذه الحضارات، على رغم ما أصابها من انتكاسات، تمكنت في الأزمنة الحديثة من استعادة المبادرة، من دون أن تسعى الى توسّع جدي ودائم في مجالها الجغرافي. من هنا رأى طه حسين أن على مصر اليوم أن تفعل الشيء نفسه. وإذا كان ثمة مجال حضاري راهن يمكن التواصل معه، ليس لأسباب أيديولوجية، بل لأسباب ثقافية وبراغماتية، فهذا المجال يجب أن يكون أوروبياً متوسطياً، من دون أن يعني ذلك أي اندماج سياسي، أو تبعية اقتصادية. بالنسبة الى طه حسين، المسألة مسألة ثقافية حضارية. وهي بالتالي ترتبط بالتعليم وبإعداد الأجيال الجديدة بجعلها مستعدة لدخول زمن العالم. ولأن هذا البعد الأخير هو الأساس والمنطلق الذي وضع المؤلف كتابه انطلاقاً منه ووصولاً إليه، حدّد أهداف التعليم بالنسبة إليه تبعاً للترتيب الآتي: إعداد الإنسان للتفاعل مع الثقافة المعاصرة، وبعد ذلك تعزيز مبدأ المواطنية عبر السعي الى توحيد التعليم ومناهجه، سواء كان هذا التعليم رسمياً، خاصاً أو أزهرياً، ما من شأنه أن ينتج مواطنين موحدي الأسس الفكرية، ثم أحراراً بعد ذلك في توجهاتهم ضمن إطار شعورهم المشترك بالمواطنية في دولة رعاية واحدة، وهذا الأمر يستتبع، بالنسبة الى مفكرنا، إعداد المناهج التعليمية في شكل علمي وعقلي بغية منع الدروشة والتخلف من السيطرة على عقول الناشئين. أما بعد ذلك فإن طه حسين يعالج مسألة أمية المتعلمين، من دون أن يطلق عليها هذا الاسم. إذ، بالنسبة إليه، لا يكفي نيل الشهادة لاكتساب عقل ماهر وفعال. لقد كان طه حسين يرى أن هذا الذي يعرضه في كتاب أراد منه أن يساهم في بعث عصور جديدة، هو الحد الأدنى المطلوب. لكن الذين هاجموا الكتاب، وفور صدوره، لم يروا الأمر على هذه الشاكلة، بل اعتبروه إضعافاً لمصر وإبعاداً لها من الوحدات المتعددة الافتراضية التي كانوا يريدون إدخال مصر فيها. وأوّلاً عبر إلغاء تاريخها!
على أي حال، لم تكن تلك، المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يهاجَم فيها طه حسين، ثم تدور الأيام، وتتوالى الأحداث والكوارث، لتؤكد أنه هو الذي كان على صواب، وأنه هو الذي كان حريصاً على مستقبل الشعب والوطن. وإذا كنا نرى هذا متجلياً في «مستقبل الثقافة في مصر» فإنه ماثل كذلك في كل صفحة كتبها طه حسين على مدى عقود بحث وكفاح وإبداع طويلة كان فاتحتها المنطقية، أطروحته عن ابن خلدون، التي وُضعت في فرنسا التي لا يزال من الصعب على كثر أن يتصوروا كيف وصلها وتعلم فيها ونهل من حضارتها، ذلك الريفي الفقير الأعمى الذي كانه طه حسين، فمكنه ذلك من أن يصبح واحداً من كبار المثقفين في مصر واللغة العربية، ثم من أن يصبح وزيراً تنويرياً، من المؤسف أن تجربته الرائعة مع الوزارة، لا تدرس كما يجب من جانب كثر من خلفائه من وزراء أيامنا، العرب.
الحياة