مقالات تناولت الموقف الأميركي من الأزمة السورية
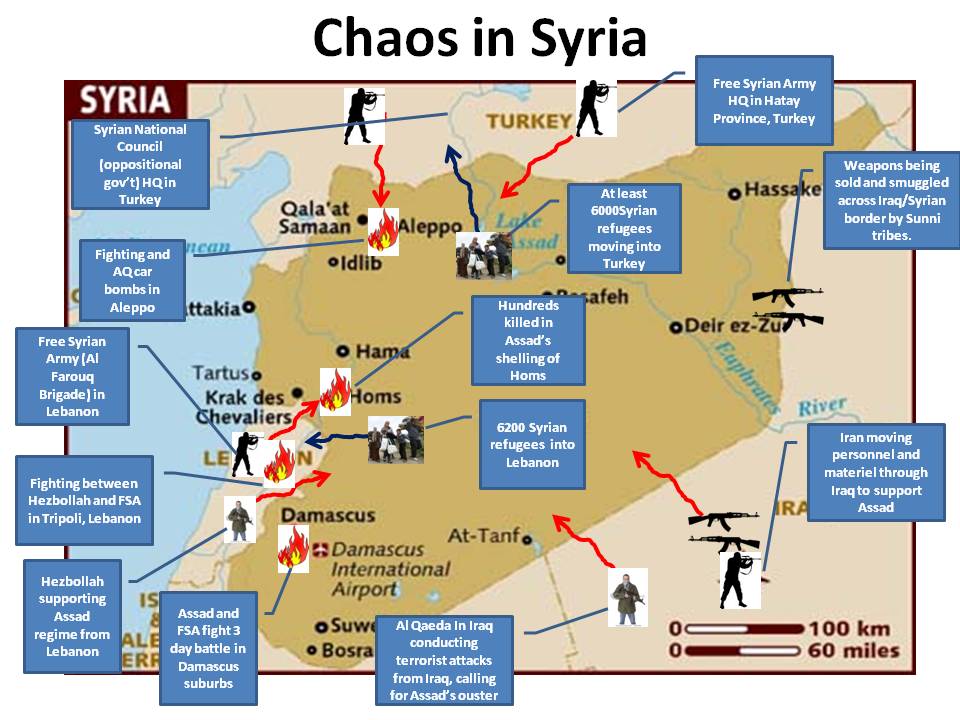
تخبُّط أوباما… أم تخبُّط المرحلة؟/ حازم صاغية
في انتظار أن تتضح نتائج زيارة وزير الخارجيّة الأميركي لمصر والسعودية، بات من المتفق عليه أن اهتمام رئيسه باراك أوباما بالداخل الوطنيّ يفوق كثيراً عنايته بالخارج الدوليّ. لكنّ الإشارات تتكاثر إلى أن المسألة باتت تتعدّى ذلك: فما نراه، وعلى أكثر من صعيد، هو حركة تراجُع تعصف بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة مع بعض أوثق حلفائها، من دون أن يطرأ أي تحسن على الأداء الداخلي لإدارة أوباما.
فقد سبق أن أُعلن من قبل عن تبني واشنطن سياسة اقتصادية فحواها تذليل الأزمة المالية عبر إنشاءات ومشاريع كبرى تقيم بنى تحتية، أو تجدد القائم منها، فيما تخلق فرص العمل المطلوبة. وغنيّ عن القول إن اقتراحاً كهذا ينبع من صميم العلاج الكينزيّ الكلاسيكي للأزمات، حيث تتوافر فرص العمل فيما يصار إلى إرساء أبنية صلبة للتقدم والنمو. لكنّ جهد الإدارة توقف على هذه الجبهة موجّهاً كل زخمه إلى برنامج الرعاية الصحية أو «أوباما كير». وهنا أيضاً، وكما بات معروفاً، لم يظهر شيء ملموس يمكن عدّه نصراً. وجاءت أزمة إغلاق الإدارة الأميركية مكاتبها وكفّ يد الحكومة الفيدرالية عن الإنفاق لترسم الحدود البعيدة لإخفاق أوباما الداخلي.
على أيّة حال، بقيت السياسة الخارجية مسرح الفشل الأكثر صخباً. فقد جاءت فضيحة التنصّت لتسيء، دفعة واحدة، إلى علاقات أميركا مع حليفات أساسيّات كألمانيا وفرنسا وإسبانيا، ناهيك عن بلدان أبعد كالبرازيل والمكسيك. وفعلاً كان للأمر وقع الفضيحة المطنطنة، خصوصاً إذا ما تأكّد أن أوباما كان، منذ 2010، على معرفة بالتنصّت على المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل، وأنه لم يحرك ساكناً.
قبل هذا، وفي منطقة الشرق الأوسط تحديداً، ظهر تنافر أميركيّ مع كل من السعودية ومصر وباكستان وتركيّا وليبيا وإسرائيل، لأسباب عدّة منها ما يتعلّق بإيران ومشروعها النوويّ ومنها ما يتعلّق بسوريا أو مصر. لكنّ بعضها، كما في حالة باكستان، يتصل بالطائرات من دون طيّار (درونز)، لاسيّما بعد مقتل محسود، زعيم «طالبان» الباكستانيّة، أو يتصل بمعنى السيادة الوطنيّة، كما في حادثة محسود نفسها أو في إلقاء القبض على إرهابيّ «القاعدة» أبو أنس الليبيّ، ولم يُعدم هذا التنافر تعابيره الحادّة أحياناً، ما استدعى الجولة الجديدة لجون كيري إلى الشرق الأوسط.
لكنْ بغضّ النظر عن مدى الخطأ أو الصواب في هذا الموقف الأميركي أو ذاك، أوحى تضافر الأحداث تلك بأن الولايات المتحدة وصلت في انكفائها إلى حد لم تعد معه تريد أصدقاء لها في العالم! وهذا يبقى غريباً في حالة أية «قوّة عظمى»، اللهمّ إلا إذا قرّرت، مختارةً، ألا تكون «قوة عظمى»!
ما من شكّ في أنّ هذا الاحتمال الأخير يبقى مستبعَداً جداً. إلا أن الواضح أن تخبّط إدارة أوباما، وهو لم يعد بحاجة إلى البرهنة عليه، لا يكفي وحده لتفسير ما يجري.
فهناك، أولاً، المزاج الانعزاليّ الأميركي الراهن الذي يلتقي حوله، لأسباب مختلفة، يسار الولايات المتحدة ويمينها الرافضان لكلّ «تورّط عسكري» في الخارج. وهذا ما يتساوق مع صعود نجم أوباما بوصفه الرجل «الذي سيُخرج أميركا من الحروب، لا الذي سيُدخلها في مزيد منها»، على ما درج القول.
وهناك، ثانياً، الميل الذاتيّ إلى الحدّ من انتصارات ما بعد الحرب الباردة، الشيء الذي لا يعود إلى رغبة في الاستغناء عن الانتصارات، بل إلى رغبة في التخفف من المسؤوليّات والأعباء التي تحفّ بها. فلقد تصرّف الرؤساء الأميركيّون منذ أواخر الثمانينيات، بمن فيهم الديمقراطيّ بيل كلينتون، كما لو أنهم يريدون أن يعتصروا تلك الانتصارات حتى النقطة الأخيرة. وهذا الواقع الذي صاغته نظريّة القوّة الواحدة والوحيدة في العالم ما لبثت تكلفته أن تكشّفت عن حربين في أفغانستان والعراق في عهد بوش. هكذا استقرّ الوعي السياسيّ الأميركي في محصّلته على «ضرورة» التسليم ببعض المواقع لروسيّا وربّما الصين أيضاً، واعتماد الشراكة مبدأً ثابتاً في تسيير شؤون العالم.
وقد عزّز هذا الاتجاه أنّ الحربين في أفغانستان والعراق اللتين قامتا تحت شعار «الحرب على الإرهاب» إنما رتبتا نتائج سياسيّة ليست في مصلحة الولايات المتحدة.
ثالثاً واستطراداً، هناك الانسحاب الأميركي من أفغانستان الذي يُفترض أن يُنفذ في العام المقبل. والحال أن عملاً كهذا يدفع بدوره إلى ترتيبات أمنية مع دول المنطقة، لاسيما منها تلك المجاورة لأفغانستان، بما يحاصر الآثار السلبيّة التي قد تنجم عن الانسحاب.
رابعاً، كشفت ثورات «الربيع العربي» للغربيّين مدى قوة الإسلام السياسيّ في نمطه الراديكاليّ. فحتى في ليبيا حيث تدخلت الولايات المتحدة وحلف الأطلسي لإطاحة القذافي، قُتل السفير الأميركي في حادثة بنغازي الشهيرة. أمّا المعارضة السوريّة فلم تكتف بإبداء العجز حيال تلك القوى المتطرّفة، بل تقهقرت عسكريّاً أمامها من دون أن تبذل الجهد المطلوب لمخاطبة الرأي العام الغربي وكسبه في مواجهة نظام قاتل كنظام الأسد. وهذا جاء كله معطوفاً على الدروس السلبية المستخلصة من تجربه العراق و«بناء الديمقراطيّة» فيه.
وأخيراً، يتوّج هذه الاعتبارات جميعها أن الولايات المتحدة غدت أشدّ اكتراثاً بمنطقة آسيا والمحيط الهنديّ ممّا بالشرق الأوسط. وهذا التطلع الذي لا ينفصل عن تحوّلات نفطيّة في الولايات المتحدة نفسها، لا يتعارض مع المهامّ التي لا تزال تعتبر جوهرية، مثل الحفاظ على المصالح الغربيّة (والجميع مستعدون لتأمينها في النهاية) وعلى ضمان حركة ناقلات النفط وأمن إسرائيل ومحاربة «القاعدة» وكبح انتشار أسلحة الدمار الشامل. لقد أوجزت العبارة المنسوبة إلى سوزان رايس، مستشارة الأمن القوميّ، هذا الميل الجديد، حيث «هناك مناطق أخرى (غير الشرق الأوسط) في العالم».
فهل الأمر يقتصر على «تخبّط أوباما» أم أنّ هذا التخبّط تعبير عن الطريقة المشوّشة في فهم التحوّلات الضخمة الجارية، والتي ربما تكشّف، بعد حين، أنها لا تحدث إلا المزيد من التخبّط؟
الاتحاد
مراجعات أميركية: التوقيت والدوافع/ عبد الوهاب بدرخان
مراجعة جديدة لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة العربية. خبر جيّد هذا أم سيئ؟ ليست المراجعة الأولى في تاريخ التدخلات الأميركية، والسوابق ربما تكون كما اللواحق. أزمات أغلقت على “زغل” كما تُقفل الجروح على جراثيمها لتركها تعتمل.
خيارات في الدعم أو العزل لم يكن معظمها صائباً. “ثوابت” مرتبطة بالمصالح لا تتغيّر، وتجارب للتكيّف مع المتغيّرات لا تتوصّل إلى ثبات. فكيفما قلّبت واشنطن الأفكار والمعطيات والنظرة إلى نفسها والعالم لا تلبث أن تبقى في مربّع سياسات تقليدية باتت متكلّسة… قد يُقال إن هذا تقويم متسرّع لتوجّهات لم تُعلن بعد، بل لم تنتهِ إدارة أوباما من درسها، أو أنه يتغافل عن أسس “جديدة” فعلاً لمجرد أنها غير مناسبة للعرب. غير أن المقدمات التي أصبحت في عمق ممارسات هذه الإدارة تشي بما سيأتي.
ينبغي التوضيح أن النيات الأميركية الرامية إلى “الانكفاء” أو “الانسحاب” أو “الاستقالة” من المنطقة ليست مرفوضة، بل مرحباً بها. لكن ما ينبغي نقده وحتى تجريمه هو طريقة تطبيق هذه السياسة ومضمونها وأهدافها. فبعد عقود طويلة أمضتها أميركا في حمل الحكومات على الارتباط بها، مع ما استتبع ذلك من ضغوط مورست وقيود فرضت، ومن سياسات دُفعت الحكومات إلى اعتمادها بأخطائها فقط لأن واشنطن أرادتها. ها هي أميركا تستعد، إذاً، لتوديع هذا النهج للشروع في آخر لا يخلو بدوره من الغوامض والمخاطر. أما القول بأنه يمكن أن يحفّز الحكومات على تفعيل استقلاليتها وقدراتها وقابليتها على المبادرة فينطوي على تداعيات إيجابية للانسحاب الأميركي المزمع، هذا إذا صدق.
واقعياً لا أحد يصدّق أن أميركا لم تعد راغبةً فعلاً في التدخل، كل ما في الأمر أن تجربتها العراقية قادتها إلى تغيير أساليبها. من ذلك مثلاً أنها تريد الاعتماد على أطراف دولية وإقليمية وإنابتها للقيام بأدوار تستنكف هي عن أدائها. ولعل الانسحاب من العراق يعطي نموذجاً لنمط التفكير الأوبامي، رغم أن تفاصيل الاتفاق وُضعت كلّها قبل أن يدخل أوباما البيت الأبيض لكنها صيغت في ضوء المصالح الأميركية والنتائج الفعلية للغزو، وإدارة سلطة الاحتلال للبلد. وما يعيشه العراق حالياً يعكس تلك النتائج، إذ أنه تُرك لمصيره وتحت رحمة حكومة (أو بالأحرى رئيس حكومة) تستمدّ قوتها (وحتى “شرعيتها”) من العِرابة المزدوجة، الأميركية – الإيرانية، ويُفترض فيها أن تعالج مشاكل تأتّى معظمها من الاحتلال، وهي غير راغبة في حلّها. فهذه المشاكل الملامسة يومياً خطر الحرب الأهلية هل هي مسؤولية أميركية أم أن المسؤولية انتفت فور الانسحاب، وهل أن تقاسمها مع إيران هو ميزة للعراق ومصلحة للعراقيين، وما الهدف من تسليم العراق إلى إيران، وهل يعني اعتراف أميركي مبّكر بانتشار النفوذ الإيراني، وفي أي استراتيجية يمكن إدراج هذا النفوذ؟
إلى ذلك، لا بدّ من التساؤل عن توقيت السياسة الأميركية “الجديدة” ودوافعها. ثمة ترابط في ما بينها، فبعد منع العراقيين من استثمار “إيجابيات” الاحتلال وانسحابه، يجري استثمار ظروف المراحل الانتقالية بعد انتفاضات “الربيع العربي” لاعتبار أن المنطقة العربية غرقت في مرحلة ضعف لن تنهض منها، وقد فاقمها الصراع بين التيارات الدينية والمدنية. وهكذا استنتجت واشنطن أن اللحظة حانت لـ “الانسحاب”، فالمنطقة فقدت أهميتها لأنها لم تعد تشكل أي خطر على إسرائيل، بعد دمار سوريا والعراق وتورّط مصر بمشاكلها الداخلية ولهاث إيران وراء تقارب مع أميركا للتخلص من العقوبات لقاء أي ضمانات تُطلب منها بشأن تدفق النفط ومحاربة تنظيم “القاعدة”. وإذا كانت واشنطن زادت توجيه اهتمامها بآسيا لمواجهة النفوذ الصيني المتعاظم، فلا بدّ أنها وضعت في حسابات استراتيجيتها هذه إمكان الاعتماد على إيران.
يبقى أن مراجعة السياسات تعتبر، على ما يقال، إن إقامة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من الأولويات. الأرجح أن هناك توافقاً أميركياً – إسرائيلياً على استغلال لحظة الضعف العربية لفرض تسوية “واقعية” (أي مجحفة) على الفلسطينيين. ورغم أن إسرائيل حليفة إقليمية تنوي أميركا اعتمادها في خدمة سياستها “الجديدة”، إلا أنها برهنت عجزها عن إقناع حليفتها بقبول نسبة إجحاف أقل مما تطمع به.
الاتحاد
الحكمة تدرك أميركا/ مصطفى زين
قيادة العالم معقدة وليست سهلة. هذا ما تعرفه وما توصلت إليه الإدارة الأميركية، بعد 12 سنة من الحروب المتواصلة. حروب استنفدتها مالياً وعسكرياً، على ما قال وزير الدفاع تشاك هاغل، الذي حدد شروطاً لبقائها في موقعها القيادي. أهمها ألا تقع الولايات المتحدة «فريسة الاعتقاد الخطأ بأنها تتلاشى. وأن تتجاوز الانكفاء» الذي تمليه عليها مرحلة ما بعد الحرب.
ربما لم يستطع الرئيس باراك أوباما، على رغم بلاغته، إيصال رسالته وتوضيح واقع بلاده بعدما أهدرت قوتها في احتلال العراق وأفغانستان والحرب على الإرهاب، وربما بسبب هذه البلاغة التي يقدرها الجميع، ويعتبرها البعض مجرد لعبة لغوية ولا يستوعبونها، فأتى وزير الدفاع ليوضحها ويوصلها إلى الأصدقاء قبل الخصوم. الأصدقاء الذين يلومون واشنطن على تراخيها في مواجهة حدث جيواستراتيجي مثل الحدث السوري، والخصوم في الداخل الذين نعتوا الرئيس بالضعف وبعدم القدرة على مواجهة التحديات وبالتفريط بموقع قيادة العالم. أما الأعداء، وهم كثر، ففسروا تراجعه عن شن الحروب مباشرة واستبدالها بالحروب الناعمة هزيمة، وراحوا يستعدون لتوجيه ضربة قاصمة إلى الإمبراطورية الأميركية المترهلة.
وزير الدفاع كان واضحاً. حدد الموقع والموقف من الأحداث. شدد على أهمية استخدام كل أسباب القوة، وليس القدرة العسكرية وحدها، فليس من دولة أخرى غير الولايات المتحدة «تملك القدرة والإرادة والإمكانات والتحالفات لقيادة المجتمع الدولي. وعلينا تعزيز هذه الإمكانات، ومعرفة حدود قوتنا واستخدام نفوذنا بحكمة».
«الحكمة» هي العنوان. وقد تجلت في الانسحاب من العراق والتحضير للانسحاب من أفغانستان. وفي التعاطي مع الأحداث في سورية ومع الملف النووي الإيراني، إذ مزجت إدارة أوباما، على ما قال هاغل، بين الديبلوماسية والاقتصاد والقوة العسكرية، وحشد الحلفاء «للمحافظة» على مصالحها.
منذ وصول أوباما إلى البيت الأبيض، وهو يحاول الابتعاد عن سياسة جورج بوش. وقد أثبت ذلك عملياً بالتحول إلى «الحرب الناعمة»، أي الحصار الاقتصادي واستخدام الطائرات من دون طيار لمحاربة الإرهاب، والديبلوماسية. لكن الحلفاء في أنحاء العالم لم يستسيغوا هذا التحول، فقد بنوا كل سياساتهم، خلال عشرات السنين، على أن واشنطن مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية للدفاع عن المصالح المشتركة وأصيبوا بخيبة أمل عندما انكفأت عن مواجهة إيران والنظام السوري، مفضلة الديبلوماسية على الحرب. وساورتهم شكوك، قد تكون في محلها، مفادها أن صفقة ما قد يعقدها البيت الأبيض مع إيران لتقاسم النفوذ معها في المنطقة، خصوصاً في سورية ولبنان وفي العراق. وكانوا يأملون في أن يسقطوا النظام السوري بالتعاون العسكري معها، كي يكون سقوطه ضربة قوية لطهران فإن لم تتراجع عن طموحاتها تصبح في مرمى النار. ودليل الأصدقاء على هذه الصفقة أن واشنطن وطهران تتقاسمان النفوذ في العراق وأفغانستان، منذ أكثر من عشر سنوات.
أما أعداء الولايات المتحدة فوجدوا في سياسة أوباما فرصة للقول إنهم انتصروا، وإن القوة العظمى لم تعد وحيدة في العالم، فقد نشأ حلف جديد ممتد من موسكو إلى سورية، مروراً بإيران. حلف تدعمه دول «البريكس». ويمتلك من القوة الاقتصادية والعسكرية ما يؤهله لخوض الحرب الباردة الجديدة، والحروب الموضعية بقيادة روسية لوضع حد للهيمنة الأميركية المستمرة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
رسالة هاغل إلى الأصدقاء والأعداء مفادها أن «الحكمة» أدركت الولايات المتحدة وستقود العالم من موقعها الجديد، بالتعاون مع الخصوم، إذا لزم الأمر. والمفاوضات مع إيران حول ملفها النووي خطوة مهمة في بداية هذا الطريق، ستتبعها خطوات (اقرأ صفقات) يجب أن لا تفاجئ أحداً.
الحياة
الإدارة الأميركية ومراحل صناعة الأزمة في سوريا/ عبير بشير
لا ندري، مدى دقة المعلومات التي تفيد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يلعب بالأيباد، ويتلهى بقراءة حسابه الشخصي على الفيس بوك في جلسات مخصصة لمناقشة الأزمة السورية تتم داخل أروقة إدارته، ولكن في كل الأحوال فإننا نصدق مثل هذه التسريبات، لأنها تأتي في سياق تفسير التواطؤ الأميركي ضد الثورة السورية منذ بداياتها الجنينية .
فقد كان واضحا منذ اليوم الأول للثورة، أن هناك أطرافا دولية جبارة لا تريد لهذه الثورة النجاح، وتحقيق اهدافها من دون الغرق في مستنقع الخراب الشامل . ومن رفع شعار سوريا ليس كمصر أو تونس او ليبيا، أراد وخطط ودبر بالفعل بأن لا تكون سوريا مثل هذه البلدان، وأن لا يتم فيها الحسم سريعا . بل عمل على تعقيد حبال الحل في سوريا وتشبيكها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من الفوضى العارمة واستحالة النصر العسكري لكلا الفريقين المتقاتلين . رفض هذا الطرف الجبار- التدخل حتى من باب تقديم أسلحة نوعية للثوار أو السماح لدول أخرى بتلك المهمة . وكانت الولايات المتحدة أول من ردد معزوفة التنظيمات الجهادية والخشية من أن يقع السلاح بيدها، حتى قبل أن يكون لتلك الجماعات وجود منظم على الأرض . وبالطبع لا ننسى المعزوفة الأميركية الأخرى بأن المعارضة السورية السياسية غير موحدة وكذلك التشكيلات العسكرية، وما دأبت وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون – على ترديده أن الإدارة الأميركية تريد أن تعرف مع أي طرف تتحاور ولمن ستسلم السلاح في إشارة منها أن المعارضة مفككة، وعليها أن تتوحد قبل أن يتم بت موضوع تسليحها -، وغيرها من المعزوفات .
ولكن العلامة الفارقة، هو أن حصافة هذا المنطق وسداد هذا الرأي يتنافى كليا، مع ما اقدمت عليه الأطراف الدولية وحلف الناتو من ضرب النظام الليبي، بعيد أيام من اندلاع الثورة، بمباركة الولايات المتحدة، وما أقدمت عليه الإدارة الأميركية من السماح بتسليم الثوار الليبيين أسلحة نوعية منذ البداية، حيث أنه لم يكن للمبررات والهواجس الأمنية المشروعة أي وزن لدى صناع القرار في الاتحاد الأوروبي وواشنطن. فلم يطلب من الثوار – الذين أتوا من مختلف مناطق وعشائر وقبائل ليبيا – التوحد قبل تقديم الدعم العسكري لهم، ولم تتساءل واشنطن وحلفاؤها عمن سيخلف نظام القذافي، وعن ماهية الجماعة السياسية والعسكرية التي تستطيع ضبط الأوضاع على الأرض في مجتمع عشائري غير متجانس وفي بلد مترامي الأطراف مثل ليبيا !!! ولم يتوقف المجتمع الدولي طويلا عند مصير الترسانة الصاروخية ومضادات الدبابات والطائرات ومستودعات الأسلحة والذخيرة للنظام الليبي بعد سقوطه، ولم يُخش من أنها ستصل حتما إلى أيدي مجموعات إرهابية سواء داخل لبيبا أم خارجها عبر تجار السلاح وهذا ما حدث بالفعل -، ولم يتساءل عن مستقبل التشكيلات العسكرية التي حاربت نظام القذافي وكيف سيتم دمجها والتعامل معها، وأخيرا لم تخف واشنطن من أن سقوط النظام الليبي سيجعل من ليببا مسرحا خصبا لتنظيم القاعدة- عدوها الأول – الذي ينتشر في شمال أفريقيا مع وجود وفرة وجودة في السلاح .
ولكن الجواب ببساطة شديدة، أنه كان هناك قرار دولي وقرار أميركي وقرار أوروبي بذلك، وقد كان ما كان، ولكن في الحالة السورية، فإنه لم يكن هناك منذ البداية قرار بسقوط نظام بشار الأسد، ولكن كان هناك قرار أميركي ببقاء نظام الأسد مع السماح لأطراف إقليمية بمشاكسته وإنهاكه . وفي هذا السياق يتحدث مدير المخابرات الأميركية، بأننا لم نكن يوما بعيدين عن الأزمة السورية، بل انخرطنا منذ اليوم الأول في عملية فرز السلاح القادم من جهات مختلفة، وكنا الجهة الوحيدة الذي تقرر لمن سنسلم السلاح وأي نوعية من الاسلحة يجوز الحصول عليها .
ونعتقد أن الموقف الأميركي من الأزمة السورية مر بثلاث مراحل مفصلية : المرحلة الأولى أو المرحلة المبكرة، بدأت قبيل اندلاع الثورة السورية، وعقب سقوط حسني مبارك، حيث تم عقد اجتماعات – تقييم موقف – لأركان الإدارة الأميركية، وتناولت الاجتماعات موقف الإدارة في حال تكرار سيناريو الثورة نفسه في سوريا، وكان القرار الذي اتخذ من عدد كبير من المشاركين، وخصوصا من أنصار اللوبي الصهيوني، أننا لن نتدخل، ولن نحاول إسقاط نظام الأسد، لأن بقاء الأسد في السلطة يمثل مصلحة استراتيجية لأميركا وأمن إسرائيل . ولكننا في كل حال سنرحب بأي حراك من شأنه خلخلة النظام السوري واستنزافه . في المقابل كان هناك تيار في الإدارة يحاول أن يقول ان هناك فرصة تاريخية لضرب الحلقة الأضعف وهي سوريا وإخراجها من معادلة الصراع مع إيران . ولكن على ما يبدو أن الرئيس باراك أوباما كان يميل بقوة إلى الخيار الأول، وعزز ذلك فوبيا التدخل العسكري الذي يسيطر على أوباما .
وهذا يفسر أن الولايات المتحدة دفنت رأسها في الرمل عند بداية الثورة وفي أشهرها الأولى، ولم يصدر عنها مواقف حازمة، ثم ركبت العربة الخلفية لقطار الحل الدولي، ولم تحاول قيادة القاطرة، حتى مشاركتها في مجموعات أصدقاء الشعب السوري، والمؤتمرات الداعمة للثورة السورية، وحتى التصريحات المنددة بجرائم النظام وأحيانا المطالبة برحيله، كانت من باب مسايرة الثورة والضحك على الذقون -، ونتيجة للضغوط الدولية والعربية والتطورات الميدانية وجرائم بشار الأسد .
ثم كانت المرحلة الثانية، حيث بدأت طلائع فيلق القدس الإيراني بالقدوم إلى سوريا، وبدأ رجال الاستخبارات الإيرانيين والخبراء العسكريين بالتوافد على دمشق، وكانت هناك معلومات استخباراتية مؤكدة عن تدفق قوافل الإمدادات العسكرية والاقتصادية من طهران إلى دمشق . بالتوازي مع ذلك، كان هناك موقف حازم من الكرملين بأنهم لن يسمحوا بسقوط الأسد حتى لو وصل القتال إلى شوارع موسكو، مرفقا بذلك بدعم عسكري واستخباراتي غير مسبوق . وفي الجهة المقابلة كانت هناك قوافل الجهاديين التي بدأت بالتناسل من كل حدب .
وهنا وفي هذه المحطة الفارقة، كان هناك رؤية وخطة – شبه إجماع داخل الإدارة الأميركية بأن الفرصة الذهبية قد حانت لاستدراج كافة الخصوم والأعداء إلى المستنقع السوري – من الحرس الثوري إلى حزب الله إلى الجماعات الجهادية إلى النظام السوري ومن ثم تصفية بعضها بعضاً من دون أن تدخل الولايات المتحدة بأي رجل وبأي طلقة. ولذلك فقد جلست الإدارة الأميركية تتفرج بينما يتم تسعير الازمة في سوريا -النظام يتلقى دعما غير محدود من إيران وروسيا بينما المعارضة تتلقى اسلحة من دول إقليمية والجماعات التكفيرية تنهال على سوريا . وحتى حينما يتم الضغط على باراك أوباما على وقع جرائم ومجازر بشار الأسد من خلال -الاتجاه الإنساني- داخل الإدارة الأميركية أو من خلال الإعلام الأميركي للتدخل العسكري في سوريا، فإن الرئيس أوباما يرد : لماذا علي وعلى إدارتي التدخل في سوريا بينما لا نتدخل حين حدوث مجازر في رواندا والفلبين ومناطق أخرى في العالم!!!.
المرحلة الثالثة والمفصلية، هي حينما قام النظام السوري بكسر الخط الأحمر الأميركي، واستخدام السلاح الكيماوي في وجه الأطفال والمدنيين، حينها وفي تلك المرحلة من الأزمة السورية، لا يستطيع باراك أوباما ولا يملك إلا أن يتدخل عسكريا وبقوة في سوريا لاعتبارات تخص الأمن القومي الأميركي والمصلحة الأميركية العليا . ثم كان ما رآه الجميع من إخراج لصفقة الكيماوي بين روسيا واميركا . ولكن من المؤكد أن هذه الصفقة تحمل في ملاحقها السرية ثلاثة عناوين رئيسية:
اولا، ضرورة بقاء جزء كبير من نظام الأسد في أي تسوية مستقبلية لأن في ذلك مصلحة إقليمية- لجهة ضمان الاستقرار في سوريا – ومصلحة روسية وأميركية مشتركة ولكن لكل منهما اسبابه .
ثانيا، غير مسموح لبشار الأسد بالانتصار، أي غير مسموح للأسد بالبقاء في موقعه كرئيس للجمهورية السورية لفترة قادمة، لأنه أصبح بالنسبة للولايات المتحدة انتصار الأسد وبقاؤه يعني أن تعلن طهران وموسكو وحزب الله انتصارهم في وجه أميركا .
ثالثا: إنه آن الأوان للعمل على محاصرة وتصفية الجماعات الجهادية، لأنها خطر على الجميع .
المستقبل

