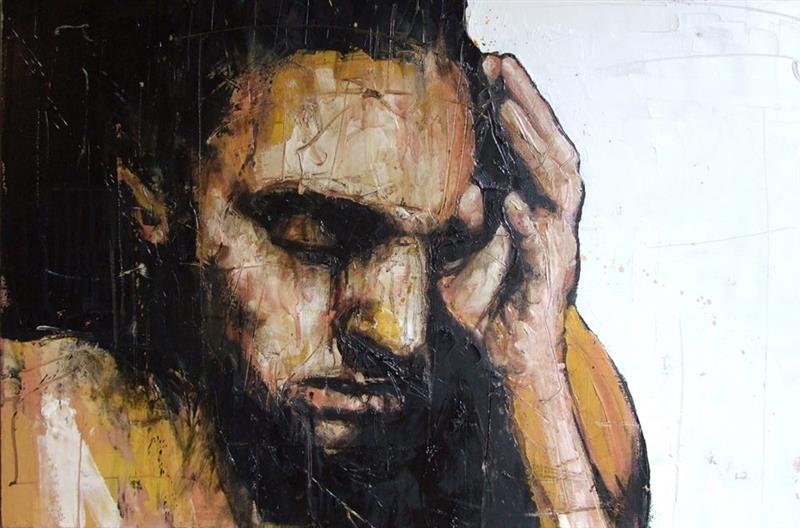مقالات عن رحيل محمد دكروب

محمد دكروب «السمكري» الذي أصبح في طليعة النقاد
عبده وازن
رحل الكاتب والناقد اللبناني محمد دكروب عن أربعة وثمانين عاماً. لكنّ هذه الأعوام لم تشعره يوماً بأنه شارف على الشيخوخة، ولعله استعاد الكثير من شبابه عام 2011 عندما باشر في إعادة الحياة إلى مجلة «الطريق» العريقة بعد احتجاب قسري دام ثمانية أعوام. وعندما صدر العدد الأول بعد فترة الانقطاع، بدا دكروب متحمّساً تحمُّس الشباب لما سمي الربيع العربي، ولكن من دون أن يتخلى، كعادته، عن نظرته النقدية إلى هذا الربيع، لاسيما بعدما دفعه بعض الأصوليات إلى الانحراف عن خطه الأول. وكعادته طوال أعوام رئاسته تحرير»الطريق» التي ناهزت الثلاثين، أكب دكروب وحيداً على تحريرها من الغلاف إلى الغلاف، من دون مساعد في التحرير ولا في الإدارة، متكئاً على صداقاته الكثيرة مع طليعة النقاد والكتاب العرب الذين كانوا يرفدونه بالمقالات والنصوص مجاناً، وكان هو بدوره يعمل عمل المتطوع مكتفياً بالكفاف. واللافت أن هذا الناقد العصامي الذي نشأ فقيراً وعاش فقيراً لم يول الناحية المادية اهتماماً، وكانت مثاليته تدفعه إلى العمل وكأنّ عليه رسالة يجب أن يؤديها في منأى عن أي منفعة مادية أو مصلحة شخصية. وسعى دكروب في المجلة الطليعية كما في كتاباته الأخيرة إلى مواكبة التحولات التي طرأت على المشهد السياسي والثقافي العربي وقراءتها على ضوء النقد الواقعي والتاريخي.
لم يكن يتهيأ للفتى الذي يدعى محمد دكروب، الفوال ابن الفوال، الذي لم يكمل الصفوف الابتدائية الأولى والذي تنقل بين مهن صغيرة، أنه سيصبح يوماً شبيهاً بالكتّاب الذين فتنوه ودأب على قراءتهم والتعلم على كتبهم متحيِّناً فرص المطالعة الشخصية والحرة. عمل دكروب في أعوامه الأولى تلك، بعد هجره «المدرسة الجعفرية» باكراً، جراء الفقر المدقع، سقّاء في مشتل زراعي وبائع خبز وترمس في السوق وبائع ياسمين في المقاهي وبنّاء… إلى أن انتهى به المطاف سمكرياً محترفاً. لكنه طوال هذه الأعوام لم يرمِ الكتاب من يده. وبعدما استهواه «القصص الديني» في المدرسة راح يقبل على قراءة سلسلة «روايات الجيب» المصرية التي كانت تنشر أعمال المنفلوطي المترجمة وروايات عالمية مقتبسة وملخصة وبعضها لتولستوي وديكنز ودوستويفسكي وبلزاك وسواهم… ثم انتقل إلى متابعة سلسلة «اقرأ» المصرية الشهيرة وعبرها قرأ كتباً أثرت فيه كثيراً، وهي لأدباء كبار مثل طه حسين وتوفيق الحكيم وإبراهيم المازني والعقاد ومارون عبود… لكنّ الحدث الكبير في حياته ومساره الأدبي تمثل في صدور مجلة طه حسين «الكاتب المصري» عام 1945، فكانت مرجعه الدائم ومدرسته الحقيقية التي تعلم فيها على مقالات كبار الكتاب المصريين والعرب. وكانت هذه المجلة نافذته على تيارات النقد الحديث والأدب الجديد، العربي والعالمي. وعبرها ترسخت علاقته بطه حسين الذي كان وظل مثاله، والذي وضع فيه وعنه كتباً مهمة، وكان يود قبيل رحيله أن يـــنهي كتاباً جديداً عن صاحب «الأيام» صبّ فيه كل مخزونه الثقافي والأدبي، لكن الــقدر حال دون اكتمال الكتاب.
استهل محمد دكروب مساره قاصّاً، وأولى قصصه نشرها الناقد رئيف خوري في جريدة «التلغراف» التي كان يشرف على صفحتها الأدبية، وكان عنوان القصة «أديب وسمكري» وفيها استوحى دكروب الشاب عالم الفقر الذي يحيا فيه وتجربته الشخصية في جمعه بين السمكرة والأدب. اما القصة الأولى التي نشرتها «الطريق» له في أواخر الأربعينات فكانت «خمسة قروش».
حينذاك كانت مسيرة الكاتب الشاب تشهد تكوّن مرحلة جديدة . كان تعرفه إلى أدباء طليعيين مثل رئيف خوري ومحمد عيتاني وحسين مروة ثم إلى كريم مروة الذي يجايله عمراً، حدثاً كبيراً في حياته، ولعله الحدث الذي رسم أمامه الطريق الذي سلكه وانتهى به إلى أن يكون لاحقاً واحداً من كبار النقاد لبنانياً وعربياً. وفي هذا الوسط الثقافي والوطني ترسخ انتماء الناقد إلى اليسار العربي وتحديداً إلى الشيوعية، فراح يكتب ويناضل على غرار كبار المناضلين في العالم. ومع أنه بدأ حياته اليسارية انطلاقا من موقف شخصي ومعاناة حقيقية، فهو شرع يقرأ ماركس ولينين وسائر المفكرين الشيوعيين متعمقاً في الفلسفة الشيوعية. لكنه كان شيوعياً على طريقته، حراً ومنفتحاً على أفق النقد الذاتي، الفردي والحزبي أو الجماعي.
عمد محمد دكروب إلى تصنيف بعض كتبه، مثل «وجوه لا تموت» و «الذاكرة والأوراق» في خانة «السرد التحليلي»، وهذه مقولة تفرّد هو بها، وهي تعبّر تمام التعبير عن ناحية مهمة من صنيعه النقدي الذي جمع فيه بين الأدب والنقد جمعاً وثيقاً ومتيناً وموحياً. وفي هذه الكتب أو النصوص كان يمارس النقد من منظور أدبي أو سردي إن أمكن القول. كان يؤدي دورين في آن واحد، دور الراوي ودور الناقد، وكانت المادة التي تتشكل تحت ضربات قلمه تجمع بين السلاسة اللغوية والإنشائية والنزعة الجمالية، كما بين الوعي النقدي والتحليل. أما في كتبه الأخرى ذات الطابع النقدي الصرف، ومنها على سبيل المثل «الأدب الجديد والثورة» و «خمسة رواد يحاورون العصر»، فكان يتكئ على منهج نقدي ومعرفي واضح، يؤاخي بين النزعة الانطباعية والميل الأكاديمي غير المغلق، عطفاً على الاجتهاد في التحليل والمقارنة. وكان ينتهي إلى خلاصات تفوق في أحيان أعمال النقاد الأكاديميين والمنهجيين. ولعله خير من درس أدب المقلب الثاني من عصر النهضة الذي كان على قاب قوسين من الحداثة. وقد كتب دراسات ومقالات مهمة جداً وحديثة، رؤيةً ومقاربةً، عن شعراء وكتاب من أمثال: أمين الريحاني، جبران، ميخائيل نعيمة، إلياس ابو شبكة، المنفلوطي، توفيق الحكيم، جماعة الديوان المصرية… وكتب الكثير أيضاً عن كتاب ومفكرين حديثين: طه حسين، عمر فاخوري، رئيف خوري، نجيب محفوظ، توفيق يوسف عواد، عبد الرحمن منيف، نزار مروة، سعدالله ونوس، عصام محفوظ، غسان كنفاني… ولم يقصر عمله النقدي على الأدب بل كتب عن المسرح والسينما مقالات مهمة.
كتب محمد دكروب الكثير، وفي أدراج مكتبه في المنزل مخطوطات كثيرة لم تنشر وتحتاج إلى من يعنى بها.
ولعل أجمل تكريم يمكن أن يحصل عليه هو نشر هذه المخطوطات، فهو -الذي عاش فقيراً ومات فقيراً (ولولا مبادرة الزميل طلال سلمان الكريمة لما كان تمكن من دخول المستشفى في أيامه الأخيرة)- يحتاج فعلاً إلى من ينظر إلى إرثه الوحيد الذي تركه، وهو مخطوطاته ومقالاته التي لم يتمكن من جمعها ونشرها.
في وداع أستاذ الأجيال… ناثر المعرفة والحماسة
سارة ضاهر
أصبح صاحب القلم هو الموضوع وهو محور المقالة. محمد دكروب، خانته عيناه. وقع. صمت. رحل عند الثالثة فجراً. ناقد وكاتب «شاب» مات في الرابعة والثمانين من عمره. رافقته طوال أعوام دراستي الجامعية ودرست عليه وتعلمت منه الكثير وأنا أكتب أطروحتي للدكتوراه في الأدب العربي.
باحث وناقد أدبي. كتب القصة في مطلع حياته الأدبية. ثم تحوّل إلى كتابة المقالة، والدراسة الأدبية، وبحث في ثقافة النهضة، كما في تاريخ الحركات النضاليّة التحرّرية اللبنانية زمن الانتداب والكفاح ضدّه. كتب في النقد المسرحي والسينما. وفي الفترة الأخيرة كان يركّز اهتمامه على تحرير مجلة «الطريق» وعلى كتاباته النقدية في مجال الرواية العربية والقصة. لم يكن محمد دكروب يوماً ناقداً أكاديمياً في المفهوم المغلق للنقد الأكاديمي، بل سعى إلى النقد العلمي الأدبي المدّعم بالمراجع والمصادر، والقائم على قراءة الأثر انطلاقاً من خصائصه الجمالية ودلالاته الاجتماعية واللغوية. فجمع بين الوعي النقدي الرصين والجاد وبين النص الذي لا يخلو من نزعة أدبية واضحة، ولعل هذا ما ميز تجربته عموماً.
في آخر مقابلة أجريتها معه في جريدة «الحياة» ذكر أنه يعيش أياماً غنية، متنوعة: «أبقى معظم وقتي في المنزل، أقرأ وأكتب وأستقبل الزوار، لكنني لا أستطيع، على رغم تواجدي في المنزل، إلا أن أتواصل مع المحيط ومع الأشخاص الذين أعرفهم، من خلال الاتصال بهم. بذلك أشعر أنني قريب منهم، أتابع كتاباتهم، وأعرف آخر إصداراتهم».
ولد محمد دكروب عام 1929 في مدينة صور. تلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة الجعفرية في صور لمدّة أربع سنوات فقط، وترك المدرسة قبل نيل الشهادة الابتدائية بسنتين، بسبب الأحوال الماديّة الصعبة. التحق بدكّان والده الذي كان يبيع الفول في «مطعم» صغير جداً. وبعدها عمل في «مهن» عدّة منها: بائع ترمس، بائع ياسمين، بائع خبز وفلافل، عامل بناء، سقّاء للعمال الزراعيين… ثم عمل سنوات في دكان أخيه السمكري فأتقن الصنعة جيّداً.
خلال فترة عمله تلك، كان يقرأ كثيراً: من مغامرات أرسين لوبين وشرلوك هولمز حتى ترجمات المنفلوطي الرومنطيقية ونظراته، فأدمن القراءة وانطلق يقرأ كل شيء. نزح إلى بيروت حيث عمل كاتباً للحسابات عند تاجر ورق، ومن طريق حسين مروة تعرّف إلى الشيوعيين في أوائل الخمسينات. التحق بالحزب، والتزم بمبادئه: «لو انتهت الشيوعيّة في العالم كلّه، يبقى شيوعي واحد اسمه محمد دكروب، لأن عقلي ماركسي ومن غير الممكن أن يكون غير ذلك».
انتقل إلى العمل في تحرير مجلة «الثقافة الوطنية» منذ عام 1952، وحتى احتجابها عام 1959. عمل في تحرير جريدة «الأخبار» الأسبوعيّة، و «النداء» اليوميّة، ثم تولّى التحرير في مجلة «الطريق» منذ أواسط الستينات، وصار رئيساً لتحريرها، مع حسين مروة، حتى عام 1989. وتولّى رئاسة تحريرها حتى آخر يوم في حياته، حيث كان يعدّ ملفاً خاصاً عن جريدة «السفير» في عيدها الأربعين.
من أبرز مؤلفاته: «جذور السنديانة الحمراء» 1974، «الأدب الجديد والثورة» (كتابات نقديّة) 1980، «شخصيات وأدوار/ في الثقافة العربية الحديثة» 1987، «النظريّة والممارسة في فكر مهدي عامل»، (بالاشتراك مع آخرين) 1989، «حوار مع فكر حسين مروة» (بالاشتراك مع آخرين) 1990، «خمسة رواد يحاورون العصر» (دراسات) 1992.
ولا تزال كتب عدّة تحتاج إلى بعض الإضافات والتعديلات، لكنّ عينَي محمد دكروب لم تسعفاه، على تحقيق ما كان يأمل أن يحققه وينجزه من هذه الكتب، أبرزها: «على هامش سيرة طه حسين»، «نحو تأصيل معاصر للرواية العربية / رؤى وتجارب… وآفاق»، «تساؤلات أمام «الحداثة» / في النقد الأدبي العربي الحديث»، «قراءات في ثقافة النهضة»… وهي عبارة عن ملفات مكدّسة فوق ملفات أخرى، على مكتب محمد دكروب، تحتاج إلى طباعة.
هو محمد دكروب. الرجل الطيب القلب. الصادق. الدائم الابتسام. المرِح الروح. عاشق الحياة. النظيف الكف. الواضح الفكر. كان إنساناً بسيطاً، منفتحاً، شاب الروح، يرحّب بالأجيال الجديدة ويمنحها فرصة التعلم والتدرّب. دعاني إلى الانضمام إلى أسرة الكتّاب الجدد في مجلة «الطريق». كنت أزوره دائماً في منزله المتواضع الكائن في الرملة البيضاء، الطابق السابع. وكان اللقاء يتحوّل لقاءات يشارك فيها كتاب لبنانيون وعرب أحياناً. نتسامر ونتناقش في مختلف قضايا الأدب وشؤونه.
هو محمد دكروب. ببساطته وحبّه وتواضعه. شكراً أستاذي. علّمتنا الكثير ومنحتنا الكثير. علّمتنا أنّ قيمة الإنسان هي في ذاته، في ذاته فقط. منحتنا الحبّ والرعاية والحرص على نتاجنا. وضعت بين أيدينا خبرة عقود في العمل الصحافي والأدبي والنقدي. ونحن نخطو أولى خطواتنا على هذه الطريق، وكَم كنا بحاجة إلى «إنسان» اسمه محمد دكروب، كما نحن الآن في هذه اللحظات. لم تغِب، ومن الصعب إلاّ أن تكون هنا، حاضراً دائماً بابتسامتك وحبّك. يرنّ الهاتف، تكون أنت: «وينك يا بنت! برد الأكل» وداعاً أستاذي…
..الدكروب
طوني فرنسيس
رحل محمد دكروب كما رغب، أو كما كان سيقول إنه يود الرحيل في ما لو طرح عليه السؤال. تمم غالبية واجباته الحزبية والدنيوية، ودع دمشق التي كان يعرفها ويحبها، وابتعدت القاهرة وبغداد وله فيهما تاريخ وأصدقاء، واختار الخميس في الرابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) اليوم الذي شهد قبل 89 عاماً ولادة الحزب الشيوعي اللبناني… ليرحل.
قبل أيام قليلة كان «الدكروب» كما يسميه الأصدقاء تحبباً يجول كعادته على مكتبات وصحف للقاء شركاء في شغف المعرفة والقراءة والاطلاع. ربما كان يبحث عن إضافات جديدة يقيمها في طبعة لاحقة لعمله التأريخي البارز «جذور السنديانة الحمراء»، وهذه ليست عادة مستحدثة، فالدكروب الذي أهدى حزبه والباحثين وهواة المعرفة عمله المذكور في عام 1974 بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس الحزب، أعد طبعة ثانية صدرت عام 1984، أضاف فيها وثائق جديدة لعل أبرزها ما يتعلق بدور التنويري الجريء خيرالله خيرالله، وفي الطبعة الثالثة الصادرة عام 2007 كانت الإضافة وجهة نظر حاول الباحث والناقد والمثقف محمد إبراهيم دكروب أن يضمنها مقدمة الطبعة تلك انطلاقاً من سؤال طرحه وفيه: «كيف يمكن أن أكتب هذا الكتاب لو كلفت الآن كتابته؟».
مرجعية السؤال كانت في الانهيارات والتغيرات التي شهدها العالم بعد زوال الاتحاد السوفياتي وبمجرد طرحه ظهر كم أن الدكروب، مرة أخرى، صاحب عقل منفتح وحس حيال ما يجري حوله. لم يتنكر لأحداث رواها ونقلها لكنه دعا إلى مزيد من اعمال العقل في ما آلت إليه تجربة قرن بكاملها.
أثار دكروب في حينه زوبعة من ردود الأفعال، إلا أنه بقي على ما هو عليه، باحثاً عن الجمال في الأحداث المؤلمة والحياة في ما يبدو أنه موت. لم يتغير الدكروب إلا في نظر الموتى، أما الأحياء فسيبقى حياً بينهم بحثاً ونقداً ورفضاً وقبولاً.
“السنديانة الحمراء” محمد دكروب متعلّماً على نفسه قارئاً على الطريق
رامي زيدان
مات محمد دكروب فجر أمس عن 84 عاماً بعدما ارتبط اسمه بكتابه الأشهر “جذور السنديانة الحمراء” الذي روى فيه فصولاً من تاريخ الحزب الشيوعي اللبناني. كان الراحل عصامياً، فحصّل ثقافته بنفسه، وارتبط اسمه بصحافة “سنديانته الحمراء”: “الثقافة الوطنية” و”الطريق”، وعرف ناقداً أدبياً أيام ازدهار النقد الأدبي في الربع ما قبل الأخير من القرن العشرين. حتى أيامه الأخيرة ظل دكروب في “طريقه” قائلاً: “طالما الطريق في خير، أنا بخير”.
مات محمد دكروب (من مواليد 1929)، الناقد والمثقف الشيوعي، الحكواتي والصحافي والعصامي و”النكتجي” الطيب الهادئ، وحافظ الذاكرة الثقافية اللبنانية والعربية. ارتبط اسمه بمجلة “الطريق” وقبلها “الثقافة الوطنية”، وكان ثنائياً مع المفكر الراحل حسين مروة الذي اغتيل عام 1987 على يد الظلاميين. لاحقاً قامت ثنائية أخرى بين دكروب وكريم مروة. لكن الأخير غادر قبل سنوات الخندق السياسي الشيوعي، وبدأ يهتم بشؤونه الثقافية.
المفارقة أن دكروب رحل في خضم احتفال الشيوعيين في الذكرى 89 لتأسيس الحزب الشيوعي، ليرحل من أناط بنفسه أن يؤرخ لهذا الحزب تأريخاً ثقافياً وأدبياً وحكائياً، في قصص لها شخصياتها في كتابه “جذور السنديانة الحمراء”. كأن الرجل مرآة لهذا الحزب، وربما يكون آخر “سنديانة” فيه، مع العلم أن “الرفيق” دكروب كان شيوعياً يرفض العمل التنظيمي، أو شيوعياً على طريقته، كما يقول.
قارئ على الطريق
تعلّم دكروب في المدرسة لسنوات قليلة. كان والده يبيع الفول والحمص، وعندما خفّ نظره، أخذ العمال يسرقون غلّته، فأخرج ابنه من المدرسة كي يساعده. لكن دكروب الابن ظل مواظباً على القراءة، والإطلاع على المجلات الثقافية، وقراءة الروايات. أحياناً كان يقرأ كتباً نقديّة وأخرى فكريّة. تعلّم الكتابة من خلال القراءة ومتابعته مفكري النهضة، من المازني الى طه حسين، وتعلم قواعد اللغة من بعض معارفه، منهم المربّي والمدرس زكي بيضون (والد الشاعر عباس بيضون). بعد تركه المدرسة بقي على تواصل مع بعض اساتذته، منهم جعفر شرف الدين الذي كان يصدر مجلة “المعهد”، وسمح له بالنشر فيها، فشكل هذا دفعاً وحافزاً لدكروب الذي أخذ يشتري اعداداً من تلك المجلة ويتأبطها ويمشي في شوارع صور. ربما بقي هذا السلوك حاضرا في حياة محمد دكروب حتى أيامه الأخيرة وإن بطريقة مختلفة. فهو بات مشهورا بين محبّيه وعارفيه بأنه يمشي على أرصفة شارع الحمراء ويقرأ في الطريق، كأن الكتاب جزء من تكوينه وجسمه وحياته ورفيقه الأبدي. والقراءة كانت عنده أقرب الى الصلاة والبعد الروحي في حياته.
إلى جانب الثقافة المحلية في مدينة صور، وهي ساعدت دكروب على التثقف والاطلاع وتكوين نفسه، جاءت الثقافة الشيوعية في الخمسينات، لتكمل تنامي شخصيته. فهو الناقد الأدبي الذي عمل سمكرياً في مدينته. وهو يروي أن أحدهم كان يقول له “أنت شيوعي قبل أن تصبح شيوعياً”. آنذاك كان يزعم أنه ينتمي الى القومية العربية، الى ان تعرف الى حسين مروة ونقولا الشاوي وفرج الله الحلو، فالتحق بالقافلة الشيوعية وبدأ يعمل في صحافتها. حين نشر قصته الأولى “خمسة قروش” في مجلة “الطريق” (1952)، التفتت إليه الأنظار، وأوكلت إليه مهمة رئاسة تحرير مجلة “الثقافة الوطنية” الأسبوعية: “إضافة إلى مهمات التحرير والطباعة، وجدتُ نفسي أحمل الأعداد مع رفاقي وأنزل لبيع المجلة في الشارع”، يقول. يعترف دكروب بأنه لم يشعر أنه أصبح من الكتّاب الا عندما نشر مقطوعات من النثر الفني ومقالات في النقد الأدبي في مجلة “الأديب” الواسعة الشهرة.
الأدب الملتزم
في البداية كان يكتب القصص القصيرة عن الأحوال الاجتماعية في مدينة صور غيرها. لكن عمله في مجلة “الطريق” وكتاباته النقدية سرقا منه شغفه الأول، فأخذ يكتب عن الشخصيات الأدبية والثقافية، لكن بطريقة قصصية. دائما كان يبحث عما يرى فيه صراعاً طبقياً يفضي الى العقيدة الشيوعية والبعد الإنساني والنهضوي في كتابات أدباء وكتّاب أسماؤهم معروفة. اختار الكتابة عن أمين الريحاني وجبران خليل جبران وطه حسين وغيرهم من البعيدين عن الحركة الشيوعية، مبرزاً دعوتهم إلى العدالة والحرية. لم تفت دكروب الإشارة إلى مواقف اتخذها بعض الكتّاب الشيوعيين وكانت أكثر صواباً من مواقف قياداتهم الحزبية (موقف رئيف خوري من قرار تقسيم فلسطين مثلاً)، وكان الموقف الرسمي الشيوعي من رئيف خوري ينطلق من “الجدانوفية الثقافية” الستالينية في تلك المرحلة.
عُرف دكروب في الأوساط الأدبية العربية بحكم عمله الصحافي ومقالاته النقدية التي صدرت لاحقاً في كتبه “شخصيات وأدوار في الثقافة العربية الحديثة”(1981) و”وجوه لا تموت في الثقافة العربية الحديثة” (1999). في أيام شبابه نشر مجموعة قصصية عنوانها “الشارع الطويل” (1954)، لكنها بقيت تجربته الوحيدة في الخلق الأدبي. في الأعوام الاخيرة قاده حبّه لأعمال طه حسين، صاحب “الأيام” و”المعذبون في الأرض”، الى إصدار كتابه “على هامش سيرة طه حسين” (2009). وكان لديه الكثير من المؤلفات يعدّها للنشر، وهو كان يضعها أمامه في مكتبه حيث يجلس وحيداً كأنه في جنّته. مكتبته الخاصة تحفل بأبرز المنشورات الثقافية العربية التي تشكل أرشيفاً مهما لمؤرخي الثقافة.
في سنواته الأخيرة شعر محمد دكروب بالضيق بعد توقف مجلة “الطريق” لفترة قسرية لأسباب مالية، خصوصاً بعد انفراط عقد الشيوعيين وتشتتهم. مع انطلاق ما سمّي “الربيع العربي” عادت المجلة الى الصدور في حلة جديدة، وفي مرحلة لاحظ دكروب أن سمتها دبيب الكسل في الوسط الثقافي، لكنه ظل يتمسك دائماً بالأمل والحياة.
في المرة الأخيرة اتصلتُ به أسأله عن أحواله، قال: “طالما “الطريق” (المجلة) بخير، أنا بخير”.
رحل دكروب فهل تبقى “الطريق”؟
رحيل سنديانة حمراء
حسن داوود
في نهاية أمسية كانت قد أعدّتها “دار المدى”، قبل نحو سنتين، تقرّر أن يُعاد إحياء ما كان أنجزه يعقوب الشدراوي في المسرح. كان الشدراوي ما زال حيّا، معانيا من إحدى جولات المرض لكّنه كان قادرا على إحياء تلك الأمسية التي انعقدت له. توزّعنا المهام التي كان على كلّ منا أن يقوم بجانب منها. محمّد دكروب إقترح أن يعمل على كتابة نوع من السيرة الفنّية للشدراوي، متضمّنة حوارا مطوّلا معه. كان دكروب في عمر الثمانين آنذاك وهو، في الشهور التي تلت، ظلّ يذكّرني بما تواعدنا على فعله: أين صرنا مع الشدراوي كان يقول، مرفقا ذلك بالنظرة التي تعني أنّ الرجل لم يبقَ لديه الكثير، وعلينا إذن أن نسرع.
كان في سعينا ذاك، الذي لم يكتمل، إعادة صلة بيني وبين محمد دكروب كانت قد اقتصرت على إلقاء التحيّة، من دون مصافحة أحيانا، في مناسبات كانت ثقافيّة كلّها. ربما لأنّ ما كان بيننا لم يدم طويلا إذ لم يزد عن لقاءات هي أبعد قليلا عن المشاركة في بعض السهرات والنقاشات. ثمّ أنّني، لسبب ما، لم أكن أعرف كيف يمكن أن نتعدّى تلك الرفقة القليلة فيما تفصل تلك السنوات الكثيرة بين عمرينا. هو كان عائدا لتّوه من موسكو بعد إقامة طويلة له فيها، وأنا، بل نحن، الشباب المحبّون للأدب آنذاك، كنا نستمع إلى مزجه بين ما حصّله من خبرة في الحياة وفي الأدب معا، وكلّ ذلك بسرد يغلب عليه الضحك والفكاهة. ربما كان ذلك في 1973 إذ أنّه كان يعمل يومها على إنهاء كتابه “جذور السنديانة الحمراء”، الذي أرّخ به للحزب الشيوعي اللبناني، ذاك الذي لم يغادره أبدا منذ أن انتسب إليه وهو بعد في مطلع شبابه.
مع أنّ شيئا كثيرا لم يتغيّر فيه، إلا ما يأتي به العمر من غلبة مظهر التأمّل على مظاهر الفكاهة. حين كنّا نراه في تلك السنوات الأخيرة كان أوّل ما يتبادر إلى الظنّ أنّه ما زال كما هو، أقصد مشهده في المناسبات التي يؤمّها ومرافقته لمن كان يعرفهم، وما زالوا أحياء، كما لتنقّله بين الأمكنة نازلا من سيارة السرفيس ثمّ مكملا الطريق مشيا على قدميه.
حين علمت بأنّه كُلّف برئاسة مجلّة الطريق فكّرت أنّه ربما قبِل بما قد يفوق مستطاعه. كان، في الأغلب، يقترب من ثمانينه آنذاك، أو أنّه ربما كان قد بُلّغَها كما قال شاعر قديم، وكان الوقت هو وقت صدور مجلّات جديدة يحرّرها أصحاب تجارب جديدة وراهنة. كان شديد الحماسة لعمله في الطريق رغم ذلك، يسأل من يلتقيهم إن كانوا قد اطّلعوا على العدد الأخير، راغبا في مناقشته معهم، وكان يعدهم بأنّهم سيقرأون نصوصا إستثنائيّة في العدد الجديد، الذي لم يصدر بعد.
ذلك أتاح له أن يبقى على صلة بالكتابة والكتاب، تلك الصلة التي ميّزت علاقته بالأدب التي كثيرا ما قيل إنّه انتسب إليه معتمدا على جهده الشخصي وعلى التحصيل من خارج مؤسّسات العلم والتعليم. من ذلك مثلا أنّ إسمه، محمد دكروب، لم يكن يذكر إلا وتستدعى معه أسماء أخرى. في فترة أولى كان ثالث إثنين هما حسين مروّه ومحمد عيتاني. هكذا كنّا نذكر الثلاثة معا، حتى قبل أن نعرف شيئا مما يكتبونه. وفي كلّ مناسبة لتكريم كاتب كان محمد دكروب هناك، حاضرا ومتكلّما. لمعرفته بالكتّاب نصيب وافر من حضوره الأدبي. ذاكرته اتّسعت لأجيال عديدة منهم، بل شملت معرفته الشخصيّة من نظنّهم الآن سبقوه إلى الوجود. كتابه “وجوه لا تموت”، هو المقلّ في إصدار الكتب، دالّ على عنايته بتلك المعرفة واحتفاله الدائم بها.
محمد دكروب:في وداع الذاكرة
المدن
لم يمر موت محمد دكروب مرور الكرام على “فايسبوك”. لرفيق السنديانة الحمراء أصدقاء كثر في العالم الإفتراضي، أصدقاء يتذكرونه لحظة مغادرته الحياة، التي عاملها كحزب، ورحيله عن الحزب، الذي التزم به كأنه الحياة. لدكروب أصدقاء ورفاق ينعونه، ويكتبون عنه في “بوستات” من الحزن والوجع وتعب الفقدان.
كتبت زاهرة حرب “وداعاً محمد دكروب…في الذكرى تغيب لتحيي الذكرى”، كما كتب ثائر غندور “رحل الرجل المحترم محمد دكروب، وهو مقتنع بأن حزبه لا يزال كما كان. هذا حقه كما أنه من حق الكثيرين أن يقتنعوا بأن الكثير من الأمور تغيرت. كل تحية لمحمد دكروب ولإرادته”.
وجاء في “ستاتوس” محمد أحمد شومان، “صفحة إثر صفحة، ننطوي، أو نطوي، ككتاب عتيق. الأديب محمد دكروب في ذمة الله”. وتحسرت خديجة أيوب على المناضل الراحل، كاتبة ً “يا أيها الراحل إلى جذور حمراء، حفرت عميقاً في تراب الوطن، وذاكرته. ماذا كنت ستقول، وستوثق أيضاً وأيضاً لمن يهدم بخبث جذور سنديانتك الثمينة”. وقد أخبر فائق الحميصي أنه “من كام يوم خبرني الصديق كريم مروة إن محمد دكروب وقع بالبيت والهيئة ما رح يقدر يدير ندوة يعقوب الشدراوي (24 تشرين) بالمجلس الثقافي، وطلب مني ان أحلّ محله…اليوم راح محمد، وأنا رح روح دير الندوة، بس ما بعرف مين عم بيحل محل التاني”. أما ديانا سكيني، فكتبت:” ثمة كتب استعرتها ولم أعدها بعد إلى مكتبتك، التي إسمها محمد دكروب. لا أعرف ماذا سيحل بها من بعدك… من سيرثها… من يستحق أن يرثها”.
وقد ترك رفاق السمكري الأحمر رسائلهم على “بروفايله” الخاص، حيث كتبت جمانة مرعي “محمد دكروب ذاكرة الحزب الشيوعي اللبناني ومؤرخ لحقبة حداثة لبنان، يا خسارة! الحداثة انهارت، ومحمد دكروب غادرنا!”. وقال سيمون نصار:” متت يا مْحِمَدْ ( ايه متل ما كنت الفظ اسمك وتقلي انت لبناني بكل شي الا بس توصل لإسمي بترجع فلسطيني)، مش مهم يا عزيزي، نكاية بالموت والأموات جميعا سأبقى احبك”.
وفي الإطار نفسه، كتب هشام خميس:”الطريق تفتقد مصباحها المشع، وداعاً محمد دكروب! صباح التاريخ المضيء”، أما محمد حشيشو، فبعبارات حزينة، كتب:”أي ثقافة وطنية وشعبية تعبر عن الناس وتربطها بالواقع، أي ثقافة تعبر عن وجع الفقراء ومشروع المثقفين الثوريين، أي “نداء” و”طريق” و”اخبار”، بدون قلمك وفكرك وحلمك ستبقى مساحات فارغة”.
وداعاً .. محمد دكروب
طلال سلمان
… ولكن لماذا تعجّلت الرحيل، وأنت عاشق الحياة حتى الثمالة، شاعر الجمال حتى التعبّد في محرابه، ظريف الحضور في أي مجلس، المشع ثقافة بقلبك الأكبر منك، ونحن لما ننهِ حوار العمر، بل عمرينا المتشابهين في نقطة الانطلاق من تحت الصفر بمسافة ضوئية، وفي المسيرة الممتعة في قلب الصعوبة، بينما الحب يعلّمنا كتابة الحياة ويأخذنا إلى الشعر والفرح والأمل المنشود؟!
لماذا سقطت من أيدينا في «الطريق» وقد كنت طريقنا إلى الأفكار والمبادئ، وأنت «السنديانة الحمراء» الأقوى من الزمن، الصامدة لعاديات الأيام وقد تجمّع في أفيائها جيلان بل ثلاثة بل أربعة ممّن درّبت على الارتقاء إلى ذرى المعرفة بتحطيم الأصنام وكسر الحواجز وإزاحة معوقات صعود الفقراء وصعاليك الأرض إلى القمة بعقيدة الإيمان بالإنسان.
لماذا، محمد دكروب، تركتنا «على الطريق» بغير رفيق يعلّمنا الحب، حب بسطاء الناس الكادحين خلف أحلامهم يسقونها عرق جباههم ونتاج عقولهم من أجل أن يكونوا من أرادوا أن يكونوه؟!
لماذا، أيها الشيوعي الأخير، تخليت عن رايتك التي رفعتها دهراً، وقاومت كل من حاول إسقاطها أو اختطافها لتشويهها أو الانحراف بها عن المسار الصحيح، وانصرفت منفرداً، معتلاً، مكسور الظهر، مضرج الرأس بدماء وحدتك، بعيداً عن قلمك الذي لم يتوقف يوماً عن رسم الدرب إلى الغد الأفضل؟!
لماذا غادرت أيها الأمي الذي علّم نفسه بنفسه، قبل أن تكمل المكتبة التي أنتجت بآخر ما كتبت عن المعلمين الكبار الذين أغنوا فكرنا بالثقافة وعلّمونا أن نؤمن بقدراتنا وبكفاءتنا وبأهليتنا لأن نكون في هذا العصر ومن أهله… إن مخطوطاتك تنتظر «المراجعة الأخيرة» قبل أن تدفعها إلى المطبعة، فلماذا قصّرت فلم تنجز مهمتك التي كنت تراها رسولية، وإن أنت تحدثت عنها بنشوة التلميذ الذي كتب فروضه المدرسية وأسقط خوفه من المدرّس؟!
لماذا أيها المؤرّخ لساكني وجداننا وناقل حوارهم مع العصر، أمين الريحاني وجبران خليل جبران وعمر فاخوري ومارون عبود وحسين مروة، ومهدي عامل قبل المفكرين والمبدعين العرب الذين قرأت نتاجهم تمهيداً لأن تعرّفنا بأفكارهم المنيرة… لماذا لم تكمل المهمة التي انتدبت نفسك لأدائها؟
با ابن الفوّال، بيّاع السمسمية، في صور، بيّاع الترمس في الخمارات، موزّع الياسمين على العشاق، عامل البناء، السقّا، السمكري وكاتب الحسابات عند تجار الورق، المتطوّع في جيش الإنقاذ من أجل فلسطين… كيف تغادر وأنت لما تنجز واجبك الوطني، وكيف تخلي موقعك في الجبهة وليس لك بديل؟!
أيها الصحافي تحت التمرين، الشيوعي بالإرادة، الكاتب بالرغبة، مطارد الموهوبين لكي يقولوا كلمتهم فتصحّح ما يخطئون فيه، أنت الذي علّمت نفسك بنفسك، ومحتضن الموهوبات اللواتي يقصدنك فتعطيهن من روحك وتفرح بتقدمهن وتوهج الأسماء الجديدة في عالم الكتابة الرحب، فيندمن أنهن قد عرفنك متأخرات عن زمنك، ويُسعدك أنهن أدخلنك إلى زمانهن، فأعدن قلبك إلى الخفقان وأنعشن روحك وبعثن التماعة الشباب في عينيك الصغيرتين اللتين تقرآن الأفكار والنيات قبل المشاعر وبعدها؟
أيها الشاب في الرابعة والثمانين بروحك التي لا تغادر العشرين، كيف استطعت الجمع بين كل مَن عرفت، وكل المهن التي مارست، وكل الكتب التي سطرت، وكل الصداقات الغالية التي ابتنيت بالحب.. وليس إلا بالحب.
أيها العاشق الذي ستفتقده الحياة وقد غببت منها حتى الثمالة، وستفتقدك كل الصبايا اللواتي أخرجتهن من خفرهن البدوي أو الريفي أو البلدي إلى عشق الحياة، وكنت تمنع غيرك من السلام عليهن لأنك لا تحب أن تشرك في «حبيبك» أحداً..
أيها الكاتب بفكره، معلّم ذاته، الممتلئ ثقافة وشغفاً بالجمال..
أيها الذي قلبه أكبر منه، وقلمه لا يكفّ عن تجديد ما لا يجوز أن يهمل من سِير المبدعين لكي تعرف الأجيال الجديدة أنها تملك كنوزاً من الفكر أنتجها الأجداد والآباء وليست متخلّفة ولا تليق بعصر الاكتشافات العلمية المذهلة.
أيها الإنسان الطيب الذي جاب نصف الكون يطلب المعرفة ليوزعها على الشغوفين بالعلم المندفعين على طريق التقدم بهمة المناضلين من أجل الغد الأفضل: سلاماً!
وداعاً محمد دكروب: الإنسان النبيل الذي أعطى كثيراً ومات فقيراً، إلا بصداقاته وكتبه وتلامذته الكثر ممن تعلّموا ولسوف يتعلّمون من «الطريق» ومن الذي حدّد معالم الطريق إلى المستقبل الأفضل.
رفيق عمري
كريم مروة
تستعصي عليَّ الكلمات وتضعف قدرتي على الكتابة في وداع رفيق عمري الطويل محمد دكروب. ذلك أن غياب محمد هكذا ومن دون إنذار وقبل أوان الرحيل أمر يعصر الروح. فعمر رفقتنا سبعون عاماً. وهي رفقة لم ينقطع أحد منا خلالها عن الآخر برغم اختلاف المهمات والاهتمامات التي شغلت كلاً منا واستولت على مسار حياته. لكن بعض تلك المهمات والاهتمامات لم تلبث أن جمعتنا في رفقة عمل حميمة على مدار سنوات عديدة كان معظمها في رحاب مجلة «الطريق». ولهذه المجلة خلال تاريخها الطويل في حياة محمد، على وجه الخصوص، وفي حياتي دور كبير في تكوين ثقافتنا. وهو دور ساهم محمد أكثر مني في إثارة النقاش على صفحاتها حول العديد من القضايا الفكرية والثقافية والسياسية التي كانت تشغل أهل الثقافة في العالم العربي. وهي كانت مدرسة حقيقية لكلينا ولأجيال عديدة على امتداد الأعوام الستين من صدورها. وكانت لمحمد في العامين الأخيرين من حياته إسهام بعناء متواصل في إغناء دور هذه المجلة في حياتنا الثقافية.
لمحمد دكروب في مسار حياتي منذ شبابنا الباكر مكان عميق محفور في الوجدان وفي العقل وفي الذاكرة يستعصي على النسيان.
في المراحل الأولى من رفقتنا الطويلة كنا نلتقي في دكان السمكرية، الذي كان محمد يتولى مسؤولية العمل فيه، للتداول في آخر ما كنا قد قرأناه في المجلات الثقافية العربية التي كانت مجلتا «الهلال» و«الرسالة» الأبرز بينها. كما كنا نتداول في ما كنا قد قرأناه في بعض الكتب لكبار الأدباء والمفكرين العرب. وكان جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة الأكثر تأثيراً على أفكارنا التي ساهمت في قيادتنا بالتدريج إلى الاشتراكية في أواخر الأربعينيات كل منا على طريقته.
كان محمد يجهد لكي يصبح روائياً. أما أنا فكانت تتبلور عندي الأفكار التي سرعان ما ساهمت في تحوّلي إلى العمل السياسي منذ وقت مبكر.
في مطالع الخمسينيات نضجت عند محمد الاتجاهات الأدبية التي قرر استناداً إليها في شكل متعسف الانكفاء عن كتابة القصة بعد أن كان قد كتب بعض القصص. وتوقف عن العمل لإصدار الرواية التي كان قد بدأ الإعداد لها في النصف الثاني من الأربعينيات. وفي تلك اللحظة بالذات بدأت مسيرته الأدبية في الصعود. وتكرست تلك المسيرة بتكليف قيادة الحزب الشيوعي له بإدارة تحرير مجلة «الثقافة الوطنية». وكان ذلك في عام 1952. وكان شريكه الأساسي في إصدار المجلة الشهيد حسين مروة. وكان لهما شركاء آخرون من الأدباء والمفكرين. لكن محمد كان هو صاحب الدور اليومي في العمل في المجلة وفي استقبال المثقفين وفي توسيع دائرة مساهمتهم في المجلة. ومن موقعه في مجلة «الثقافة الوطنية» دخل محمد عالم الأدب من الأبواب الواسعة، وصار شريكاً للعديد من الأدباء العرب في العديد من المؤتمرات الثقافية التي عقدت في سوريا وفي لبنان. كما كان من المساهمين في تحويل «رابطة الكتاب السوريين» إلى «رابطة الكتاب العرب».
التقيت مع محمد في أواخر الستينيات في المدرسة الحزبية في موسكو. وكان ذلك العام من حياتي وحياة محمد من أجمل أيام حياتنا في الجانب الشخصي وفي الجانب الفكري على حد سواء. لكن محمد بقي في موسكو بعد انتهاء الدراسة في المدرسة الحزبية لبضعة أعوام. وكان غيابه عن لبنان في تلك الفترة سبباً لانكفاء دوره في الحياة الثقافية. الأمر الذي جعلني أتطوع في مطلع السبعينيات في إقناعه للعودة إلى لبنان، فوافق. وكنا بدأنا نعد للاحتفال بالعيد الخمسين لتأسيس الحزب الشيوعي. وفور عودة محمد اتخذ قراراً ظل يذكّر باسمه، وهو مساهمته في الاحتفال اليوبيلي للحزب بإعداد كتاب عن المرحلة الأولى من تأسيس الحزب. وكان كتابه «جذور السنديانة الحمراء» أجمل هدية للحزب في يوبيله. وصدر الكتاب في صيف عام 1974. وابتداء من تلك اللحظة التاريخية بالذات بدأ محمد يصدر كتبه الواحد تلو الآخر معرّفاً فيها القراء العرب بسير وإبداعات عدد كبير من كبار أهل الأدب والفكر في العالم العربي.
الحديث عن محمد دكروب يبدأ لا ينتهي. وسيرته الغنية تغري بالكثير من الحديث عنه وعن تراثه الثقافي. لكنني أكتفي هنا في لحظة وداعه بالاشارة إلى السنوات العشر التي اشتركنا فيها بإعادة إصدار مجلة «الطريق» بين عامي 1993 و2003. وهي أعوام من أجمل ما التقينا معاً فيها بمهمة ثقافية لا تزال تشكل في حياتي نقطة ضوء ساطعة.
تلك هي بعض الكلمات التي أودع فيها رفيق عمري محمد دكروب والأسى يملأ قلبي وعقلي ووجداني.
أنت ذاكرتنا
يمنى العيد
الحلقُ ناشف، والكلامُ لا يأتي.
أربعون سنة وأكثر من الصداقة. من الكلام على الأدب والسياسة والوطن… ومجلة الطريق بيننا، مساحة بدأت فيها صداقتنا. فعرفت فيكَ إنساناً طموحاً، متواضعاً، قريباً من الناس، فرحاً برؤيتهم يقرأون ويفكرون ويبحثون.
كنتَ تصطحبني لشراء الروايات العربية الحديثة التي تنصحني بقراءتها. ثم تسألني:
ما رأيكِ؟
ثم مشجعاً:
اكتبي ما تقولينه لمجلة الطريق.
وكنتُ أكتُب وأقرأكَ يا محمد لأجدَ فيك ناقداً متفرِّداً بأسلوبك القريب من السرد، الحافظ لما تعجز الكُتب عن حفظه.
أنت ذاكرتنا يا محمد حتى عندما صرتَ تقول لي:
«عم بنسى يا يمنى.. بدِّي إجمع ما كتبت.. لديَّ أكثر من كتاب..»
[[[
منذ أيام وأنت لا تردُّ، كعادتك، على الهاتف لتقول لي:
«تعبان يا يمنى.. تعبان».
لماذا لا ترتاح يا محمد؟
وتردُّ عليَّ بصوتك المتعب:
«عليَّ أن أقرأ المواد لمجلة الطريق».
وتنتهي المكالمة بأمل أن نلتقي، حاملاً إليَّ، كعادتك، المجلة.. ووجهكَ مغمور بفرح يشبه فرح الأمهات بمولود جديد.
كيف؟؟
كيف رحلتَ هكذا يا محمد وتركتنا لغصّة الوداع!!
موته ليس مقنعاً
نصري الصايغ
موت محمد دكروب ليس مقنعاً. يعبر العمر بخفة اللحظة، كأن الزمن يجانبه ويتجنب روحه. هو دائماً على موعد ما. لا يتوقف أبداً عند عطب جسدي، تليه أعطاب، ينوء الجسم تحتها، ولا تصاب روحه بنأمة يأس. راهن هو، في الآن، عتيق هو، كرمز السنديانة الحمراء، ومقيم دائما في الأفق، وتعجب عندها وتتساءل: من أين لهذا الرجل كل هذا الشباب.
كان يمازحني، كلما سألته عن صحته. يبالغ في اعتداده الرجولي، وبرغم رجفة ترافق صوته، ما كانت ذراعه تلتوي ولا كان قلبه يتهدج ولا كان عقله يستقيل… كلما التقينا، حدثني عن مشروع. كلما انتابني يأس، وهو إدمان عندي، كان يضحك ملء عينيه. كأنه كان ينبهني وهو يسخر مني ومن هشاشتي، بأن «الموت ليس نعساً».
حزبي لا يكلُّ. يعرف أوجاع الحزبية ويتألم بابتسام. قلّما كان يجرِّح. كان من صنف الرهبان المؤمنين بالشيوعية، ولو من دون صلاة. حزبه أصيب، وظل هو متعافيا. الثقافة ضمرت، ظل منتجاً ومحرضاً. ولما أقفلت أبواب الثقافات والمجلات، افترش «الطريق» ودعا المفكرين والمثقفين والفنانين والإعلاميين لصحبة الحبر والكلمة. أعاد لـ«الطريق» دربها. لا تقفل الطريق، إلا إذا خلا الفكر من المغامرين، وبات المتسكعون أسياد الرقص بقدم واحدة.
موت محمد دكروب ليس مقنعاً أبداً. إذ لا يمكن أن تخلو الساحة من رجل، هو بعرف عدد كبير من عارفيه ومحبيه، «الحزبي الأخير» أو «الشيوعي الأخير» أو «الملتزم الأخير» أو آخر الذين يرون أن بإمكان الفقراء أن يكون لهم منبر وأن يكون لديهم أمل أو أن تبقى لهم قضية، تستحق أن نتألم من أجلها وأن نفرح بها.
ظلم كبير أن تصاب الحزبية في لبنان بهذه الخسارة. ظلم للعقائد أن تفقد ملتزماً حراً، ظلم للشيوعية أن يكون هذا الجندي آخر من التزم بالصف فانتظم والتأم وانسجم، على اسم بنّاء، وليس على نقّ هدام.
لم أكن شيوعيا، ولكني كنت حزبيا، آثرت حريتي على حزبيتي. بل فضلت فوضاي على انتظامي والتزامي. فشلت في أن أكون راهباً، عندما نذرت سنوات من عمري، كي أكون في السلك. كما فشلت في أن أكون حزبيا. أية فضيلة حلّت في محمد دكروب، ليبدأ مشواره الفذ، من السنكرية إلى المطبعة إلى الصف، إلى التصحيح إلى التفكير إلى الكتابة إلى السياسة إلى أن يصبح بذاته، ورشة تضج بالإنجازات. من يطيق أن تبلغ من العمر عتياً، وتبقى على موعد دائم مع العمل والأمل.
هذا نمط من الرجال الذين يكون موتهم خطأ فظيعاً. إنهم من نسيج رجال أرنست همنغواي في «الشيخ والبحر». تمر بهم العواصف، فيتمايلون كالقصب، وينتصبون كالسنديان. إنهم من رعيل سبقه فيه كثيرون من الرواد… فمن سيأخذ مكانه غداً؟
لا أحد؟
محمد دكروب… يُفتقد.. بعده فراغ لا يسده ركام في نفوس مدمرة وعقول بائسة… يفتقد، ايضا كصديق، لا يكف عن المرح والأقوال الملاح والاستعادات الغزلية البيضاء، واستحضار الرواد الذين عرفهم وكتب عنهم وأنصفهم.
لذلك كله… ألوم محمد دكروب كثيراً، لأنه مات.
ما يغفر له هذا الخطأ، أن لموته معنى، نفتقده في حياة كثيرين ممن ما زالوا على قيد الحياة.
لذلك كله نقول له: كلما تذكرناك، ابتسمنا لك، أيها الأخير الخميل.
جيل المعارك الأولى
عباس بيضون
في «خمسة قروش» مجموعة محمد دكروب القصصية تجولت في أزقة صور وتعرفت على ظرفائها وقبضاياتها ووجوهها في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. كانت المجموعة كصاحبها أنيسة سلسة فكهة. كانت بالتأكيد وثيقة اجتماعية بقدر ما كانت فناً رائقاً وأكثر ما حيّرني أن صاحب هذه المجموعة الواعدة لم يكمل في الدرب الذي سلكه بحرفة، فقد توقف محمد دكروب عن كتابة القصة التي كان مهيأ بطبعه وخبرته لها، وحين سألته عن سبب ذلك قال إنه أدرك بعد ذلك أنه لم يكن موهوباً بما يكفي لهذا الفن. وأنا الذي استمتعت بقراءة «خمسة قروش» وحدست أن لصاحبها استعداداً طبيعياً لكتابة القصة لم أقتنع بجواب محمد دكروب بل زادني حيرة، فقد كنت متأكداً أنه لو تابع في هذا الطريق لكان لنا محمد عيتاني آخر، ولوجد للجنوب من يترك لنا صورة حية عنه في أواسط القرن الماضي.
كان محمد دكروب ذاكرة هذا الجنوب. ذاكرة «صور» تلك المدينة التي ولد وعاش في صميمها. واحداً من الذين يتلقون فنهم قبل كل شيء من العمق الشعبي، بل ينقلون إلى الفن طرافة وبديهية وسليقة هذا العمق. لقد تكون محمد دكروب في هذا الصميم حيث كل يوم يحمل تجربة جديدة، كان أبوه علماً على الظرافة في صور، كادحاً وأنجب كادحاً، كأبيه صار محمد صاحب حرفة، وكأبيه كان قطباً في الأنس والظرافة. لكن محمد وهو يزاول حرفته كان يقرأ بوفرة، داخلاً بذلك في صلب هذا المناخ الثقافي الذي حمل أسئلة التنوير وأسئلة التحديث والدولة والاستقلال السياسي والاقتصادي والوحدة القومية والعدل الاجتماعي. التحق محمد مبكراً بهذا التيار ولا نعرف كم تنقّل فيه حتى استقر في الحزب الشيوعي. لم تكن هذه يومذاك سيرة تقليدية ولم يكن محمد دكروب تقليدياً. كانت الجواذب كثيرة وانحاز هو إلى الطرف الأقصى، إلى الموقع الأكثر راديكالية. كان محمد دكروب مصداق المقولة الماركسية عن المثقف الثوري، فقد جاء من الأوساط العمالية، كان يعمل بيديه وعقله في آن معاً وكان بين يديه وعقله تطابق واتصال. لقد تحولت تجربته الكادحة إلى أفكار وأطروحات وشعارات ونضال يومي. هكذا تحول محمد دكروب إلى أديب مقاتل، إلى مثقف عضوي، على حد تعبير غرامشي، وكان رديفه في ذلك وقرينه، أديب آخر جاء إلى الشيوعية من الحوزات الدينية هو الراحل الشهيد حسين مروة، حمله إليها ذات الانخراط في تيار التنوير وذات الأسئلة وذات العقل النقدي والاثنان أخذا على عاتقهما الصحافة النظرية والأدبية في الحزب وكانت يومذاك متجسدة في «الثقافة الوطنية» و«الطريق».
بعدما جرى على الأنظمة الشيوعية وبعد سقوط المعسكر الاشتراكي، كان من الطبيعي أن تهتز قناعات، وأن تذوي قناعات وأن يتحرر كثيرون من التزاماتهم وأن يبتعدوا عن مواقعهم، وليس في هذا أي شائبة، فما جرى زلزال تاريخي ومن الطبيعي أن تتزعزع أفكار ظلت على التزامها بما اعتبرته كتلة تاريخية وما حسبته مساراً لا ردة عنه. قليلون من المثقفين استمروا بتعب في الطريق وكثيرون وجدوا أنفسهم متحررين من أي التزام. من هؤلاء القليلين ظل «المثقف الثوري» محمد دكروب. لم يكن محمد متحجراً ولم يكن خشبي اللغة والعقل، كان عقله كمزاجه سلساً مرناً ليناً لكنه لم يرد أن يرتد عن طريق التزم به رغم معرفته وعورته ومشاقه. لكنه شاء أن يكون حراً فيه، هكذا عاد وهو في الثمانينيات إلى مجلة الطريق بشروطه هو. شاءها مجلة للفكر التنويري واليسار العربي. ونجح الثمانيني في ذلك. وكان في ذلك مفلحاً فالحاجة إلى مجلة لليسار المتزعزع المشتت المصدوم والضائع غالباً حاجة حقيقية. استطاع محمد دكروب في الطريق في الأعداد القليلة التي أصدرها ان يجمع حولها بل أن يسترد لها لفيف من هذا اليسار، واستطاع أن يخلق مجلة بشروطه هو، وهي شروط انفتاح وحرية وعقل نقدي.
هذا الثمانيني كان وهو في الرابعة والثمانين نفسه، أنس وفكاهة وحضور بديهة وألفة وشباب جسد وروح. غاب عني ردهة ولما لقيته في «السفير» منذ اسبوعين وجدت العمر قد ظهر في وجهه ولم يكن ذلك ملحوظاً من قبل. قال له زميل لم يستطع ان يمسك عبارته انه يبدو «مجعلكاً» وأجابه محمد دكروب لتوه «أما انت فمكوي» كان هذا جوابه المسدد الفكه. ظهر العمر في وجه محمد دكروب لكن طبعه وروحه ومزاجه بقيت هي نفسها. منذ أقل من أسبوعين التقيته وما خطر لي انه قد يكون اللقاء الأخير.
قد يكون محمد دكروب من أواخر جيل خاض المعارك الأولى في لبنان. جيل عمر بالأحلام والتطلعات. وناضل في سبيل انقلاب اجتماعي وجابه الوراثة السياسية وعمل على تأسيس أدب له واقعه وله مرجعه. تكريم محمد دكروب هو أيضاً شهادة على هذا الجيل الذي ظل بعض أفراده صبورين وحين انهار كل شيء لم يعيشوا كغرباء ولم تعقل الدهشة والرهبة ألسنتهم، ولم يحيدوا عن الطريق وإنما استمروا أشقاء وأخوة وأصدقاء ورفاقاً أحياناً وسط كل هذا الركام.
في تأريخه للحزب الشيوعي سماه محمد دكروب «السنديانة الحمراء»، بعد ذلك تشلعت السنديانات الأم وتقصفت السنديانات الأبناء، وما بقي سنديانات فردية، لعل محمد دكروب، وهو يناضل في الثمانينيات، إحداها.
سمكري الأحلام المستحيلة
هالة نهرا
أيّها الأصدقاء القدامى والجدد تعالوا…! (فقدْ) انصرف محمّد دكروب. ذلك الظريف الذي سمّيتُه «سمكريّ الأحلام المستحيلة»، لم يخبرنا بأنّ النهايات توْقٌ إلى النقصانِ لا ينقطع، والحياة أحياناً هزلٌ سَمِج. أرَّقتَني البارحة يا محمّد وثلجكَ الآن يحفر في القلب عروةً كأنّما لتعبرَني الأرض، وأنا لا أجد منفذاً إليَّ. تواري الملحاح العتيق اليوم سؤالٌ مضلِّلٌ. أُكوِّمُ كلّ ما فاتنا (مكرهَيْن) مؤونةً للضوء في مدى تسدَّلَ خلسةً من آهاتنا، وقهقهةٍ متقاعسة هنا أو هناك، لا فرق. «ألوووو… أَني جايي لَعِنْدِك تَنِسْمَع «كارمينا بورانا» وِنْناقش بموضوع حفلة مرسيل وشِغِلْ أسامة، وفي كمان كتاب حَرْزانْ بَدّي أَعْطيكِ ياه. مِشْ عاجِبْني المناخ بالوسط الثقافي والمسارح شبه فاضية ببيروت. حُطّي القهوة عَ النّار لَنْنِمّ شْوَيِّة عَ العالَم…». هذا «النمّام» الأنيس الذي تتأبّط ذراعه في السينما، ويحدّثك بصوت خفيض، كان مهجوساً بحوار لا ينتهي بين الأنا والأنا، والأنا والآخر، حول الفكر، والأدب، والحبّ، وواقع الفنّ والنقد في لبنان والعالم العربي، وقد أملَ بجيلٍ جديد من الكتّاب، لا سيّما «الكاتبات المنطلقات، بشرط أن يكنّ أيضاً جميلات أو باسقات في الموهبة والخفة، وبيسارٍ مغاير مُحدَث من رحم الحراك الشعبيّ الجارف في منطقتنا والعالم».
صاحب «وجوه لا تموت في الثقافة العربية الحديثة» (تقديم عبد الرحمن منيف)، لم يكن يرى إلى الأيديولوجيا بوصفها عقيدةً مغلقة وجامدة أو مقدّسة، ولطالما عبّر عن استيائه من لغةٍ وخطاب خشبيَّيْن، ومن قراءةٍ ومقاربات دُغمائية محنّطة، ومن ممارسات ضيّقة لا تشفّ عن نضجٍ ووعي ثوريَّيْن أو تغييريَّيْن. المناضل الرومانسيّ الحكّاء – الذي تميّز بالبساطة في السرد، وحافظ على علاقةٍ طيّبة واعدة بالعديد من الفنانين والمثقفين المخضرمين والشباب من المحيط إلى الخليج، على اختلاف مشاربهم وأهوائهم وانتماءاتهم – انحازَ إلى الجمالية والاحترافية والقيمة الإبداعيّة أوّلاً، وإلى إضافات يمكن أن يأتي بها بعضهم خارج الدائرة المطلّية باللون الأحمر. في الآونة الأخيرة، حاول في مجلّة «الطريق» أن يكون طاقماً بمفرده فأعيا، ومعه أعيت الحيلة كثْرة. اهتمّ منذ زمن بعيد بالمسرح الغنائي الرحباني الذي استحضرناه وألقيْنا محاضرات عنه إحياءً لذكرى منصور (وعاصي بطبيعة الحال) في «الحركة الثقافية – أنطلياس» و«الجامعة اللبنانية الأميركية»، والذي أصرّ دكروب أن يلمّ ما كُتب حوله مجمِّعاً أوراق الناقد الموسيقي الجادّ نزار مروّة في كتاب «في الموسيقى اللبنانية والعربية والمسرح الغنائي الرحباني» (الصادر عن دار الفارابي). كنّا سنُقدِم منذ أعوام على إصدار كتاب مشترك يحمل توقيعَيْنا لولا ذلك الاختلاف في الرؤى والتأطير والتصنيف بيننا على مستوى خصوصية وماهية هذا المسرح الذي أظهر محمّد عزماً ثابتاً على زجّه في خانة «الأوبِّريت»، فيما ينتمي في الحقيقة إلى ما يُعرَف بالـ«ميوزيكال». كم كنتَ عنيداً في الفترة الأخيرة، طفلاً على حافة الوقت يسابق المجاز. كم كنتَ كثيراً وحدك، ووحدك خذلتني في غياب كثيف يجوّف الصُّبح والكلام.
في ظلال السنديانة الحمراء
مسعود ضاهر
في الرابع والعشرين من تشرين الأول 2013، يوم الذكرى التسعين للإعلان عن تأسيس حزب الشعب، الوجه المعلن للحزب الشيوعي اللبناني،استراح محمد دكروب تحت ظلال السنديانة الحمراء التي عشقها مناضلا صلبا قل نظيره في صفوف الحركة الشيوعية العربية.
هل في الأمر صدفة أم أن حلمه قد تحقق فغادرنا بعد سنوات طويلة من النضال الشاق كان فيها محط إعجاب جميع من عايشه عن كثب وتعلم منه حب العطاء غير المحدود، وبعيدا عن الأضواء الخادعة؟
احتل تاريخ الحزب الشيوعي اللبناني حيزا واسعا من دراسات دكروب، فبدا الحزبُ، من خلال قلمه، حزبا متميزا على الساحة اللبنانية بعد أن انتزع بمقولاته النظرية، وتماسك مؤسساته، وثقافة مناضليه، احترام الكثير من القوى الوطنية والديموقراطية والثورية في لبنان والدول العربية والعالم.
الحزب الشيوعي اللبناني، كما عرفه منذ بدايات تشكل وعيه الثقافي والوطني، مدرسة تعلم فيها الكثير من المناضلين الأكفاء الذين لم تسعفهم أوضاعهم المادية أن يتعلموا في المدارس العادية. فكان فعلا حزب العمال والفلاحين وجماهير الكادحين والمثقفين الثوريين. وارتبطت نشأته بنمو الطبقة العاملة اللبنانية التي خاضت بجدارة معارك النضال الطبقي، السياسي، ومقاومة الاستعمار، الأجنبي، والنضالات المطلبية. فقدم قيادات بارزة في مختلف المجالات من أمثال المؤرخ الكبير يوسف إبراهيم يزبك، والنقابيين فؤاد الشمالي، ومصطفى العريس، والياس البواري، وكثير غيرهم.
تعلم هؤلاء في مدرسة الحزب النضالية وعملوا على تحويل المجتمع اللبناني تحويلا ثوريا لبناء المجتمع الاشتراكي. واسترشدوا بالماركسية ـ اللينينية من خلال دورات تثقيفية، داخل لبنان وخارجه، فنشروا راية الحزب الطليعي الذي كان أعضاؤه يستذكرون نشيد الحرية الذي أطلقه عمر حمد وهو يسير بقامة مرفوعة نحو حبل المشنقة التي نصبها جمال باشا لإعدام أحرار لبنان وسوريا عام 1916 في ساحة البرج في بيروت، وساحة المرجة في دمشق. ومطلع النشيد:
نحن أبناء الألى/شادوا مجدا وعلا
وما لبث الشيوعيون الأوائل أن أطلقوا نشيدهم الخاص الذي جاء فيه: عاش حزب الشعب فينا/ رغم أنف الظالمين/ وإذا ما عاش يروى/ بدماء الكادحين/لا نصارى لا يهود في الحمى، لا مسلمين/ لا دروز بل عهود/ بالتآخي أجمعين/ لا نريد الطائفية/إنها الداء الذميم/ فلتضم الشيوعية شعب لبنان الكريم
يبدو هذا الكلام القادم من جيل البدايات مع محمد دكروب ورفاقه مجهولا لدى الأجيال الجديدة من اللبنانيين. فالشيوعيون لم يحسنوا كتابة تاريخهم بأنفسهم، ولم يعملوا على ربط جذور السنديانة الحمراء بأغصانها الوارفة التي طالت ظلالُها جميع الأقطار العربية. وكانت أدبيات الحزب، ومجلاته، وصحافته، وتضحيات مناضليه قدوة لأعداد متزايدة في حركة الثورة العربية. واستشهاد أمينه العام، الشهيد فرج الله الحلو، على أيدي جلاوزة النظام العربي المأزوم، أثار موجة عارمة من الإدانة لأنظمة تسلطية استبدادية ملأت السجون العربية بأفضل النخب الوطنية والديموقراطية والثورية.
رسم محمد دكروب صورة مشرقة لنضال الشيوعيين اللبنانيين الذين قدموا تضحيات كبيرة عبر تاريخهم الطويل. وشكل كتابه «جذور السنديانة الحمراء» الذي أعيد طبعه مرارا، أفضل سجل علمي لتلك الانتفاضات، وذلك بالاستناد إلى وثائق الشيوعيين الأصلية، وما تضمنته الصحافة الحرة في لبنان. وأثبت دكروب، بالوثيقة والتحليل العلمي الرصين، أن كتبة التاريخ من المؤدلجين الطائفيين كانوا عاجزين عن طمس نضال الشيوعيين. فوثائق الأرشيف نفسها، الفرنسية منها والإنكليزية والأميركية تقدم صورة مشرقة عن تلك النضالات.
جذور السنديانة الحمراء
كان محمد دكروب بمثابة الغصن النضير في السنديانة الحمراء، والمثقف الشعبي المتميز بنشاطاته التي استمرات طوال أيام حياته عبر إنتاجه الغزيز في مختلف صحف الحزب ومجلاته، وفي إدارته لمجلة «الطريق» التي تألقت معه وتميزت بأعداد متخصصة شكلت إضافات نوعية للفكر الثوري على امتداد العالم العربي.
كان محمد دكروب أول من نبه إلى ضرورة كتابة تاريخ الحزب وفق أسس علمية سليمة تجعل من تاريخه مدرسة تتربى عليها أجيال جديدة متعاقبة من الشيوعيين. فكان صديقا للجميع، محبا للجميع، تسبقه ضحكة رائعة مقرونة بود عميق، رغم أنه كان مولعا بالنقد الإيجابي الصادق.
لعل أفضل ما كُتِب عن جذور السنديانة الحمراء تلك الكلمة التي خطها خليل الدبس في تقديم الطبعة الأولى واستمرت في الطبعات اللاحقة. وجاء فيها: «إن كتاب جذور السنديانة الحمراء هو عمل أديب أكثر مما هو عمل مؤرخ. لكنه عمل أديب اعتمد الحقيقة التاريخية، وبذل جهدا كبيرا ليصل إلى أكثر ما يمكن أن يصل إليه من وثائق. وقابل العديد من المناضلين الذين عايشوا الأحداث ليأخذ الحقيقة منهم مباشرة. واستخدم كل ما توافر لديه من حقائق تاريخية ليضع أثرا أدبيا فريدا من نوعه. غير أن التاريخ، بمعناه العلمي، ما زال لمن يضعه، وأملنا كبير أن ذلك لن يطول».
لم ينجز التاريخ العلمي للحزب الشيوعي حتى الآن. وقدمت ذرائع واهية لتبرير ذلك التقاعس. فالعقبات داخلية وموضوعية أكثر منها ثقافية أو مادية. لكن محمد دكروب بنى تاريخ السنديانة الحمراء على أرض صلبة. وما زالت أغصانها الخضراء عصية على اليباس، رغم أن بعض من تولوا القيادة الحزبية تحول إلى حطب على موائد عتاة الطائفيين ومبخرين لرأسمالية ريعية أفقرت اللبنانيين وهدرت كرامات بعض مثقفيهم.
كانت وثائق الحزب مبعثرة قبل أن يسارع محمد دكروب إلى جمعها في كتاب فريد في بابه يختزن عشرات الوثائق الأصلية من الضياع الأكيد. ورغم فترات البحبوحة التي شهدها الحزب وأطلق خلالها وسائل إعلام مرئية ومسموعة، لم يحقق قادته رغبة الدكروب في تأسيس مركز علمي للدراسات الماركسية في لبنان على غرار معهد موريس توريز للدراسات الماركسية في فرنسا وغيره من المعاهد الماركسية. ولم توضع نسخ مصورة من وثائق الحزب الأصلية في أمكنة يسهل الإطلاع عليها من جانب الباحثين المتخصصين.
كما أن مجلة «الطريق» التي كانت قبلة المثقفين الماركسيين والديموقراطيين العرب أهملت بالكامل فتوقفت عن الصدور لسنوات عدة إلى أن سارع محمد دكروب لإعادة إصدارها، منفردا إلى حد ما، لأنه كاد يختنق غما لغياب رفيقة عمره. ففي السنوات الأخيرة من حياته المديدة التي بلغت الخامسة والثمانين عاما، شكل مع «الطريق»، حالة من الوجد الصوفي لديه.
تنفس ملء رئتيه عندما عادت «الطريق» إلى الصدور بعد طول غياب. واستعاد حيويته بصورة مذهلة رغم آلامه المتعددة. وجدد البحث في جذور السنديانة الحمراء على أمل الاهتمام الجدي بتاريخ المناضلين الأشداء الذين دافعوا عن معتقداتهم بصلابة لا تلين، ومنهم من أمضى سنوات طويلة في سجون السلطة، فرنسية كانت أم لبنانية.
أدرك الدكروب منذ وقت مبكر أن شبيبة الحزب الشيوعي تعيش اليوم حالة ضياع في موسم كرنفالات زعماء الطوائف، والمتاجرين بالوطن، وسماسرة السياسة، وقادة الميليشيات الذين يهددون بتدمير لبنان على رؤوس اللبنانيين. وبنظرة ثاقبة إلى المستقبل عرف جيدا أن المثقف الشيوعي يجب أن يكون على الدوام من دعاة التجديد، وأن يكون منحازا دوما إلى البحث العلمي النقدي الأصيل عن الجذور الصلبة لسنديانة حمراء عصية على اليباس. وكان من أكثر المناضلين الشيوعيين الذين أبوا الانحراف عن الخط الوطني الذي يدافع حتى الرمق الأخير عن مصلحة الشعب اللبناني ضد زعماء الطوائف والمليشيات وسماسرة الثقافة النفعية.
كتب مؤرخو الطوائف تاريخ النزاعات الطائفية في لبنان. لكن الدكروب قدم سجلا رائعا لمن يرغب في معرفة تاريخ اللبنانيين، جميع اللبنانيين، أو بالأحرى «تاريخ الناس كل الناس» وفق تعبير فولتير.
فاللبنانيون يعشقون الحرية ويدافعون عنها. منهم من استشهد على أعواد المشانق، ومنهم من أمضى سنوات طويلة في سجون الانتداب ولاحقا في سجون بورجوازية تبعية وصفها مهدي عامل بالكولونيالية. فهي لم تعرف سوى السمسرة والصفقات المشبوهة، والربح السريع، وليست رأسمالية متنورة تشارك في الإنتاج وتطوير قوى الإنتاج.
عمل الدكروب بحرفية عالية في التأريخ العلمي لنضالات اللبنانيين. ونشر مقدمة نقدية هي من أجمل وأعمق ما كتب عن ظروف نشأة السنديانة الحمراء دون أن يتجاوز مرحلة الجذور التي دخلت عميقا في نسيج الفكر التقدمي والديموقراطي الحر في لبنان المعاصر.
وتضاعفت وثائقه ما بين الطبعة الأولى والثالثة. وأضاف إلى مراجعه أسماء كثير من المناضلين الذين فاته ذكرهم. ورغم شيخوخته وتقدمه في السن بقي قلمه متجددا، يبحث دوما عن كل ما هو أصيل ونقي في جذور السنديانة الحمراء، وما أكثرها، وهاجسه وصل ما انقطع بين تلك المرحلة والجيل الجديد من الشيوعيين اللبنانيين.
لطالما دعا الدكروب الحزب لكي يجدد نفسه وأساليب عمله ما دامت لديه القدرة على التجدد بعد الترهل المريع الذي اصابه في سنوات التشرذم وغياب الاهتمام الجدي بالثقافة والمثقفين. وكان يبادرني حين نلتقي بعبارة إنجلز: «يتقدم التاريخ من جانبه الأكثر سوادا». فأجيبه: «وهل هناك سواد أكثر من الذي نعيشه اليوم في لبنان الطوائف والميليشيات التي تهدد بزوال الوطن؟»
إن تجديد الحزب الشيوعي لنفسه مهمة أساسية على طريق إنقاذ الوطن. لذا بقي حتى آخر أيام حياته يحلم بتجدد الحزب على طريق لبنان الجديد. لأن «لحظة من الظلام لا تعني بأن الناس أصيبوا بالعمى»، حسب توصيف غابرييل غارسيا ماركيز.
وبقي حارسا أمينا للسنديانة الحمراء التي ضمته اليوم إلى صدرها. فغادرنا على أمل أن يبقى الحزب الشيوعي اللبناني وريث أفضل التقاليد الديموقراطية، والثورية، والإنسانية التي عرفها لبنان واللبنانيون. فالذهب يصقل بالنار، والأزمة الراهنة يمكن أن تنقي الحزب ممن تنكر لدماء الشهداء والمناضلين، وشوه سيرة المؤسسين الأوائل، وطرح أسئلة باهتة عن مدى الحاجة مجددا إلى حزب طليعي. ومنهم من روج لتبعية كاملة مع بورجوازية ريعية ملحقة بالإمبريالية الأميركية التي اختبر العالم جيدا زيف ديموقراطيتها في العراق، وفلسطين، ولبنان.
نستذكر محمد دكروب دوما كلمنا تعمقنا في كتابته العلمية عن تاريخ المثقفين الشيوعيين الذين أفنوا حياتهم دفاعا عن شعوبهم، وهو في عداد الكبار منهم. كان هاجسه الأساسي إعادة الاعتبار للحقائق التاريخية كما وقعت. ومن حقه أن يفخر بأنه كان أول من قدم تاريخ الشيوعيين بأسلوب علمي رائد. وكانت له مساهمات متميزة في مختلف مجالات النقد الأدبي. نشر الكثير من الوثائق الأصلية التي كان يمكن أن تندثر لولا جهده الدؤوب في البحث عنها وتحليلها بأسلوبه الأدبي الجميل، ووفق مزاجه الفني وطريقته الخاصة في رواية الأحداث، ومنتجتها، والتعليق عليها.
المؤرخ
لم يَدَّعِ يوما أنه مؤرخٌ، لكنني لم أتوانَ عن وصفه بالمؤرخ المبدع وفق المنهج الخلدوني المعروف: «التاريخ فن، في ظاهره خبر وتحقيق وفي باطنه نظر وتدقيق». فقد أعطى صورة فنية صادقة ورائعة عن سيرة المؤسسين والمناضلين الأوائل. وكان هاجسه الأساسي أن يفخر المنتسبون إلى الحزب الشيوعي اللبناني من الأجيال الشابة بجذورهم الفكرية النيرة. فهم أحفاد كوكبة مشعة من كبار مثقفي ومناضلي لبنان والعالم العربي . فحين يقرأون «جذور السنديانة الحمراء» يتعرفون إلى أسماء لامعة هي مصدر اعتزاز لجميع العلمانيين، والتقدميين، والليبراليين، والمناضلين من اللبنانيين الذين تخطوا حواجز طوائفهم إلى رحاب المواطنة اللبنانية الحقيقية، فشكل كتابه صلة وصل بين التقدميين اللبنانيين من أحفاد طانيوس شاهين، وشبلي الشميل، وفرح أنطون، ويوسف إبراهيم يزبك، وفؤاد الشمالي، وأنطون مارون، وإسكندر الرياشي، ورفيق جبور، وعشرات غيرهم.
اليوم نودع محمد دكروب بعد أن استظل السنديانة الحمراء في رحلة نضالية ثقافية نال فيها محبة الجميع واحترامهم. ولعقود طويلة ستستذكر الأجيال القادمة من المثقفين التقدميين إسم المثقف الكادح محمد دكروب بصفته الحارس الأمين لجذور السنديانة الحمراء التي اصبحت بفضله معلما بارزا في تاريخ لبنان واللبنانيين. إنه رمز رائع لمناضل شيوعي بارز قدم نموذجا فذا في التثقيف الذاتي، وفي النضال الدائم لبناء وطن علماني حر وشعب لبناني سعيد. وما زالت السنديانة الحمراء تكبر بفضل دكروب ورفاق دربه الأوفياء، وتبشر بمستقبل زاهر لأجيال قادمة من المناضلين فعلا حتى بلوغ التغيير الديموقراطي وتحقيق حلم اللبنانيين الأوائل بولادة «وطن حر وشعب سعيد».
محمد دكروب: أغمض عينيه على الحكاية
المثقف العضوي
بيار أبي صعب
لم يبذل محمد دكروب جهداً كي يكون مع الشعب، فهو ابن الشعب في كل ما فعل وقال وقرأ وكتب. ابن الشعب بحرَفيّته في التعاطي مع الكتابة والتفكير، في تعامله مع الشأن الابداعي، وجمعه بين السياسي والثقافي بعيداً من الجدانوفيّة. بعقلانيّته، وقدرته على الانفتاح والنقد والحوار. ابن الشعب في اجتهاده وبحثه الدائمين، هو الماركسي العارف أن المطلق نسبيّ بامتياز. ابن الشعب بستراته الداكنة البسيطة، بنظارتيه السميكتين لكثرة ما حاول أن يفهم العالم من أجل تغييره، بوعيه الجدلي وقدرته على الاصغاء المهذّب، والسجال الهادئ، واحترام الاختلاف.
ببسمته الطيبة السخيّة، وأسنان تحمل دمغة البروليتاريا. بالبيريه المستعارة من غافروش، صبي فيكتور هوغو السارح بين متاريس كومونة باريس يغنّي للثورة. بلهجته العابقة بزمن كان هناك عاصمة عربية اسمها بيروت، وفي المدينة فضاء عام يتسع للأحزاب والتيّارات والمشاريع والحركات الفنيّة، وفي الفضاء العام شوارع، وفي الشوارع ناس تحلم بالتقدّم والتغيير. تلك اللهجة المنمّقة الواضحة، تطعّمت مع الوقت بلغة المثقفين الذين اصطفوه شيخهم وقدوتهم. دكروب ابن الشعب بشبابه الدائم وانشغاله بالجيل الجديد والتجارب البديلة. ابن الشعب بوفائه للأفكار الكبرى، حين انفضّ عنها كثيرون تعباً أو يأساً أو استلاباً، أو غلبهم في النهاية «الوباء» الذي لم يتلقّحوا ضدّه جيّداً. ابن الشعب شيوعي حتى الرمق الأخير، فيما انصرف بعض الرفاق إلى مساوماتهم الصغيرة، ما إن بدا لهم أن رياح التاريخ غيّرت اتجاهها. مناضل منفتح على العالم، لم يعزله انتماؤه الحزبي في «طائفة» جديدة، ولم تحجب بصيرته غشاوة التزمّت الأيديولوجي… بل اشتغل على اعادة النظر بالدوغما، خارجاً إلى غير رجعة من دائرة العصبيّات العقيمة، والأصوليّات القاتلة.
حياة محمد دكروب على مستوى السيرة الشخصيّة والعامة، والصيرورة الفكريّة، والانتاج الأدبي، والبحث النقدي، والنضال الثقافي، والمعيوش الفكري، تصلح مادة لعمل أدبي أو سينمائي، لأنّها تختصر حكاية جيل مؤسس، وحكاية بلد، وحكاية مُثل سياسيّة كم نحتاج اليوم إلى استيحائها. حارس «السنديانة الحمراء» خير تجسيد لمفهوم «المثقّف العضوي»، لم يتنكّر لحظة لأصوله وطبقته، وقد عاش عمره متماهياً معها، مشتغلاً بأدواتها، معتنقاً قضاياها، مدافعاً عن حقوقها ومصالحها. لم يستسلم يوماً لامتيازات «المثقفين». كدنا ننسى كل شيء عن أبناء الشعب، عن الفقراء والمحرومين وضحايا الاستغلال، عن المساواة والحقوق. «تلك أضغاث أيديولوجية من زمن مضى»، برأي الراقصين على قبورهم، المتسابقين على الامتيازات و«الخيانات» القوميّة والطبقيّة، المتسلّقين على أنقاض المجتمع المدني، الباحثين عن الارتقاء على حساب القيم الانسانيّة، والمصالح الوطنيّة، وكل ما هو أساسي كي يحتفظ الانسان بإنسانيّته وكرامته. بوصلة محمد دكروب لم تضع يوماً جهة الجنوب. لم يغرق في وحول السياسة اللبنانيّة، ولم يقع في مطبّ «العلمانيّة الشيك»، ولم يتردد في الوقوف إلى جانب المقاومة الاسلاميّة في هذه المعركة المصيريّة ضدّ الاستعمار التي يشهدها العالم العربي.
الرفيق دكروب من زمن آخر، من طينة «جان دارك قديسة المسالخ» كما صوّرها برتولت بريخت. فهم أن تحقيق التقدّم والعدالة ثمرة جهد حقيقي وعمل دؤوب، ورحلة طويلة النفس، لا تعبأ بالموضة، ولا تتأثّر بالتحولات الموقتة والمطبات العابرة. «لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء»، فاعتناق القضيّة، يقتضي نكران الذات والجرأة على التمرّد والتجديد وكسر القوالب. محمد دكروب أيقونة الزمن السعيد، لكنّه ليس «دقّة قديمة» كما يظنّ أنبياء الليبراليّة. زمن طغيان الفرديّة، وعودة الاصوليّات، وموت الايديولوجيات، لا يغيّر شيئاً، بل بالعكس. هذا المثقف العصامي الذي بدأ حياته سمكريّاً، باق بيننا في الخندق، خلال السنوات المقبلة، حين سيكون على العرب أن يختاروا بين الارتماء على قارعة التاريخ، أو بناء دولة المواطن. الثوار المتشائمون سيتّخذون «تفاؤله الثوري» تعويذة وترياقاً، وسيكون معهم في معارك الحقوق والنضالات الاجتماعيّة والوطنيّة والقوميّة.
اليوم نقف بخشوع أمام النعش المكسو براية الكادحين. ونقول: انتهت مهمّتك أيّها الرفيق، ها قد صرت فرعاً في تلك السنديانة الحمراء.
الشغّيل الذي حرّر النقد من «الواقعيــة الاشتراكية»
حسين بن حمزة
مات محمد دكروب (1929 ــ 2013) أمس. مات شيخ الشباب والكاتب والناقد العصاميّ الذي ثقَّف نفسَه بنفسه. الفتى الذي ترك المدرسة باكراً كي يساعد والده في دكان الفول، ثم في العمل سمكرياً وبياعاً للترمس والورد، لم ينقطع عن شغفه بالقراءة والذهاب إلى صالات السينما في صور. من المدينة الجنوبية، أخذه الراحل حسين مروة إلى دكان لبيع الورق في بيروت، وعرّفه على قادة الحزب الشيوعي اللبناني، وعلى العديد من كتّاب ومثقفي العاصمة.
من تلك العجينة الحياتية والذاتية والماركسية، بدأ دكروب بكتابة قصص واقعية مخلوطة برومانسية تحاكي قراءاته في تلك الفترة من خمسينيات القرن الماضي. المجلات المصرية (وخصوصاً مجلة «الكاتب المصري» التي كان يصدرها طه حسين) والكتب الماركسية لاحقاً، جعلت تلك القراءات تبدأ باكتساب طبقات فكرية وثقافية وسياسية. التأثير المصري، وأثر عميد الأدب العربي بالتحديد، صنعا جانباً أساسياً في مسيرة دكروب، بينما قربه من الحزب الشيوعي اللبناني، ومن صحافة الحزب ومثقفيه صنع الجانب الآخر.
هكذا، ظل الشيخ الثمانيني مديناً لهذه التربية التي تطورت وانعطفت داخل محيطها نفسه وفي جوارها القريب. تربيةٌ يمكن القول إنها منحته انتماءً نهضوياً وتنويرياً، وجعلت جهوده النقدية والثقافية جزءاً مستقبلياً بمفعول رجعي من تراث مفكري النهضة في نهاية القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين.
صاحب «جذور السنديانة الحمراء» هو بالولادة سليل المدرسة اللبنانية التي ضمت بطرس البستاني واليازجي والشدياق، ثم توفيق يوسف عواد ورئيف خوري والعلايلي وحسين مروة وغيرهم. وهو بالميول الثقافية، سليل المدرسة المصرية التي ضمت طه حسين وسلامة موسى ويحيى حقي ويوسف إدريس وغيرهم. لقد استأنف دكروب مناخات هاتين السلالتين، وظلت مقالاته وممارساته النقدية تغرف من الاحتياطي الذهبي لتلك الحقبة النهضوية ومنجزات كتّابها ونبراتهم وأفكارهم التقدمية. عمله في مجلة «الثقافة الوطنية» (1952 ـــ 1959)، ثم في مجلة «الطريق» (تأسست عام 1941) التي ارتبط اسمها باسمه حتى رحيله، كان استمراراً لتلك التربية النهضوية من خلال علاقته بالأجيال اليسارية والتنويرية التي جاءت لاحقاً، والتي تدين بالكثير لـ «الطريق» وثقافة «الطريق» وسياسة دكروب في تحرير المجلة، التي كان يقول إنها «خليّته الحزبية» التي فضّلها على الاجتماعات التنظيمية.
اخترع محمد دكروب نصه النقدي ومزاجه في الكتابة. ومثلما كان «شيوعياً على طريقته»، كان ناقداً على طريقته أيضاً. صحيحٌ أن الميول الماركسية واليسارية ظلت تلمع في الفناء الخلفي لممارسته النقدية، إلا أن ذلك كان جزءاً من كتابة طيِّعة تنفر من التنظير البارد، وتحاول أن تتحرر من التعسّف الذي التصق بالواقعية الاشتراكية في طبعتها السوفياتية. كتابةٌ تنطلق من عناصر وجزئيات واقعية وأدبية وحياتية يجدها (أو يكتشفها ويطوّرها) في النصوص والمؤلفات التي كتب عنها، وفي حياة وسِيَر وأفكار أصحاب تلك المؤلفات. بهذا المعنى، كان دكروب راوياً وحكواتياً بارعاً في النقد، وصاحب «سرديات نقدية» كما وصفته الناقدة يمنى العيد، وكان في شغله شيءٌ من «السمكرة» التي اشتغلها في صباه كما قال عنه الراحل عبد الرحمن منيف. كان دكروب يصنع نوعاً من «الصحبة» مع الكتب والشخصيات التي يتناولها، ويصنع «صحبة» موازية مع القارئ أيضاً. كانت الكتابة عن الآخرين تتجاوز النقد إلى نسج بورتريهات تحضر فيها نصوص ومنجزات هؤلاء إلى جوار وقائع وتفاصيل من الزمن الذي عاشوا فيه، ومن صداقاتهم وتأثراتهم بغيرهم، ومن أسرار وأخبار كان دكروب نفسه شاهداً عليها. بورتريهات تحتمل السرد والحوار والفلاش باك والعودة مجدداً إلى السياق، ومزج ذلك كله بالتوثيق التاريخي والاقتباسات. كأن دكروب كان يعوّض توقفه الإرادي عن كتابة القصة القصيرة بعد صدور مجموعته اليتيمة «الشارع الطويل» (1954)، بتسريب موهبته المطويّة إلى مقالاته وكتاباته النقدية، ومنحها مذاقاً قصصياً وروائياً، مازجاً ذلك بالـ «الإمتاع والمؤانسة» بحسب عنوان كتاب أبي حيان التوحيدي. لقد حصَّل دكروب ثروته النقدية من القراءة ومن الخبرة الحياتية وصداقات مجايليه من المثقفين والمفكرين. ولعل الصداقة هي البطلة الخفية في أعماله، وخصوصاً في كتابيه «شخصيات وأدوار في الثقافة العربية» (1981)، و«وجوه لا تموت» (1999 ــ دار الفارابي). صداقةٌ مؤلفة من الكلمة والموقف والحلم بتغيير العالم والواقع. أغلب هؤلاء الحالمين الذين كتب عنهم دكروب رحلوا قبله، تاركين لديه حكايات معروفة وأسراراً مجهولة. بطريقة ما، يمكننا الحديث عن «شجرة دكروبية» مكونة من أسماء الكتاب والمفكرين والمناضلين الذين عرفهم أو قرأ لهم، إضافةً إلى الذين كتبوا في «الطريق». شجرةٌ يمكن أن تشبه تلك «السنديانة الحمراء» التي أرّخ فيها دكروب لنشأة الحزب الشيوعي اللبناني، لكنها شجرة بثمار مختلفة ومتعددة باختلاف هويات تلك الأسماء الموزعة على خريطة الوطن العربي كلها. شجرةٌ كان دكروب سعيداً بعودة حاضنتها إلى الصدور مجدداً بعد توقفها سنوات. كانت «الطريق» بيته وحلمه و«رفيقة دربه» تقريباً. انشغاله بإعادتها إلى الحياة كان يؤخر مشاريعه المؤجلة أصلاً. في لقاءاتنا الأخيرة معه، كان يتحدث عن وجود خمسة كتب مخطوطة لديه، لكنها تحتاج إلى رتوش وترتيبات بسيطة لتصبح جاهزة للنشر، منها كتاب «على هامش سيرة طه حسين»، الذي نأمل ألّا يتأخر نشره، مع كتبه الأخرى، بعد غيابه.
رحل ابن «الثقافة الوطنية» الذي تربى على فكر النهضة والماركسية، لكنه انضم إلى «وجوه لا تموت». لقد عاش برفقتهم طويلاً في الكتابة، وها هو في صورة نتخيلها بالأبيض والأسود يأخذ مكانه بينهم على مقعد الغياب الفسيح.
عاش طفلاً ومات طفلاً: الطريق إلى «الطريق»
إلياس خوري
قال حسين مروة في حواره المشوّق مع عباس بيضون إنّه ولد شيخاً ويموت طفلاً. مات أبو نزار طفلاً وهو يتلقى الرصاص في بيته. أما تلميذه محمد دكروب، فلم يبرح الطفولة مطلقاً، فعاش طفلاً ومات كما يموت الأطفال.
لا أدري لماذا أتى هذا السمكري من صور الى مجلة «الطريق» مصاباً بلوثة الكلمات. اكتشفه أنطون تابت عندما قرأ قصته القصيرة عن الفتى الذي يشعر بالبرد والجوع، فيسمع من خلال باب أحد البيوت صوت بيضة تقلى على النار، فيتدفأ بالصوت، ويشبع من أصدائه التي تغلغلت في روحه.
أتى به مؤسس «الطريق» الى المجلة، كي يكون دكروب أول مولود على يد هذه القابلة الأدبية التي أغنت الثقافة اللبنانية والعربية بروافدها التي لا تنضب. إنه الابن البكر الذي صار رئيساً للتحرير من دون أن يفقد شعوره بالبنوة. كان رئيس نفسه ومرؤوسها في آن. كان الكاتب والقارئ والمصحح والعامل. يشتغل كحرفي لا يرتاح، جاعلاً من أمه طفلته، ومن أبوّته لها شعوراً بأنه لا يزال ابنها الوحيد.
ارتبطت «الطريق» بأسماء كبيرة، أنطون تابت ورئيف خوري وحسين مروة وكريم مروة، لكن الاسم الذي التصق بها حتى نهايته ونهايتها كان محمد دكروب. الرجل الذي تخلى عن كتابة القصة القصيرة تحوّل الى روائي النقد ورفيق الروائيين والكتّاب وأمين سرّ الأدب اللبناني.
في زمن بنيوية مهدي عامل الماركسية، عاش الدكروب في مكان آخر، رأى في النقد باباً الى الحكاية، وفي الحكاية مساراً نقدياً. هكذا قام بقراءة الأدباء من خلال أدبهم. أي أنّه كتب عكس كل النقاد، فهو لم يقرأ النص من خلال حياة الكاتب، بل قرأ الكاتب من خلال حياة النص، فصارت دراساته _ حكاياته مرجعاً للمتعة والمعرفة في آن معاً.
هذا النوع من القراءة الأدبية الذي تفرّد به الدكروب لا تستطيعه سوى عيون الحب، فالرجل الآتي من الطبقات الفقيرة والمسحوقة، تعلّم من تجربته الشخصية والإنسانية معنى الحب الذي يرى في الوجه الواحد تعدده، والذي يكتشف الكاتب من خلال اكتشاف النص، جاعلاً من الروائي بطلاً في حكاياته التي أعاد الدكروب كتابتها.
وكما يفعل جميع الأطفال، فإنّ محمد دكروب لم يتخلّ عن أمه أبداً، كما أنّه لم يتخلّ عن جذوره الطبقية وانتمائه للشيوعية، رغم كل ما جرى في العالم وفي لبنان.
أمس، حين أغمض محمد دكروب عينيه لم يغمضهما على الموت مثلما نظن، بل أغمضهما على الحكاية. اليوم، يصير كاتب الحكايات حكاية لا تبحث عن كاتبها، ويتحول مكتشف المعاني الى معنى يرافق الأحياء ويتحاور مع الموتى.
كانت حكاية هذا الطفل الذي ولد في الطريق الى «الطريق» ممتعة وغنية وحزينة أيضاً، وهي ككل الحكايات الجميلة لا تنتهي حين تنتهي.
* روائي وناقد لبناني
انطفأ في عيد الحزب الشيوعي اللبناني
بدي قللو منحبّو كتير» تقول تاتيانا ابنة محمد دكروب، قبل أن يغلبها البكاء على الهاتف. قبل دقائق، كانت تتحدّث بفرح عن والدها وكيف أنّ ولديها تعلّقا به خلال إقامته في أيامه الأخيرة في منزلها، وكانت حفيدته السمراء هي مدللته لأنّ زوجته الروسية الراحلة سفيتلانا «كانت تحبّ السمراوات، وهو كان يحبّ الماما كثيراً» تقول تاتيانا قبل أن يأخذها الحديث إلى طفولتها ومناخ الحرية الذي عاشته في كنف الوالد.
حتى لحظاته الأخيرة، كان دكروب منهمكاً بتحضير العدد الجديد من مجلة «الطريق». كان ملف العدد عن جريدة «السفير» في ذكرى تأسيسها الأربعين. تقول هناء صافية من أسرة تحرير المجلة: «أرسلنا العدد الجديد إلى الطباعة منذ يومين، لكن سرعان ما أوقفنا الطبع أمس ريثما تقرّر إدارة التحرير ما يجب فعله إثر رحيله المفاجئ». كان دكروب قد دخل «مستشفى الساحل» في أوائل الشهر الجاري، بعدما وقع فأصيب في رأسه «لكنّه ظلّ بكامل قواه العقلية. وبعد عشرة أيام، عاد إلى المنزل قبل أن يعاني من تعقيدات استدعت إدخاله المستشفى مجدداً قبل يومين». صحيح أنّه بدا كمن اختار يوم رحيله في 24 تشرين الأول (أكتوبر)، وهي ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي اللبناني الذي نعاه بالأمس، إلا أنّه كان لا يزال يحلم ويخطّط لمشروعه الأحب أي «الطريق». تقول صافية: «كان يحضّر ملفاً خاصاً أيضاً بمئوية الأديب رئيف خوري في المجلة، إضافة إلى الورقة التي سيشارك فيها في الاحتفاء بذكرى رحيل خوري الذي يقيمه «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» و«الحركة الثقافية ــ أنطلياس» في الأونيسكو»الشهر المقبل». لم يلحق دكروب، صار هو مادة التكريم. «الحزب الشيوعي اللبناني» سيوجّه له تحية بعد غد الأحد خلال الاحتفال بالذكرى الـ 89 لتأسيس الحزب في قاعة «أريسكو بالاس» في بيروت. وفي أربعينيته، سيقام مؤتمر في «قصر الأونيسكو» يُدعى إليه أصدقاء الراحل من كتّاب ومفكّرين عرب.
* يوارى في ثرى «مقبرة روضة الشهيدين» في الغبيري عند الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، وتقبل التعازي بين العاشرة والرابعة في قاعة «روضة الشهيدين». كما تقام مراسم العزاء يوم الأربعاء 30 الجاري في قاعة «جمعية خريجي الجامعة الأميركية في بيروت» (ساحة الوردية ــ الحمراء)
أحزان الفايسبوك: منمشي ومنكفي الطريق
روان عز الدين
«هذا الثمانيني كان وهو في الرابعة والثمانين نفسَه: أنسٌ وفكاهة وحضور بديهة والفة، وشباب جسد وروح»، بهذه العبارة وصفه الشاعر عباس بيضون على فايسبوك أمس. استطاع محمد دكروب الحفاظ على روحه الفتية حتى النهاية. «شيخ الشباب» رحل أمس وهمّ الشباب اللبناني على عاتقه.
لدى شباب «اتحاد الشباب الديمقراطي» ما يذكرونه عنه. هم لن ينسوا الدفع الذي كان يمنحهم إياه، والنقاشات والحوارات والمحاضرات التي كان يقيمها على نحو دائم في مقرّ الاتحاد. وبعد حوالى عقد على إغلاق مجلة «الطريق»، لم يكن السبب وراء إعادة إطلاقها انحسار المجلات الثقافية في لبنان فحسب، بل أيضاً إصرار دكروب على إصدار مجلة تتوجه إلى الشباب اللبناني، مخصصاً فيها مساحة لنشر النصوص الشابة.
بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ 89 للسنديانة الحمراء، صار حزن الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، حزنين. حزن على ماضي السنديانة الحمراء الجميل، الذي لم يعيشوه، وحزن على أحد آباء هذا الحزب. يختفي هنا المعنى المجازي لكلمة أب بالنسبة إلى هؤلاء الفتيان، ليأخذ معنى حقيقياً وواقعياً لمسوه من الرجل الثمانيني.
هؤلاء الشباب الذين يواصلون جهدهم لاستعادة ماضي الحزب في «زمن الخيبة»، يعرفون التمييز جيّداً. لقد أجمعوا على فايسبوك وتويتر على أنه «الشيوعي الحقيقي وغير المزيف»، قبل أن ينشر البعض صورهم برفقته، وبعض الأغاني لوداع «صبحي الجيز» الشيوعي. أحد الشباب أراد أن يودعه من خلال الأغنية المذكورة، مرفقةً بجملة «محمد دكروب. عم فتش ع واحد متلك.. يمشي.. منمشي ومنكفي الطريق ». التعليقات الشابة بدت متأثرة وحاسمة. غرّدت إحداهن «اليوم سينضم اسمك إلى المبدعين والمثقفين الذين كتبت عنهم لتكون من وجوه لا تموت، وداعاً محمد دكروب». بدوره علّق الموسيقي ريان الهبر على فايسبوك «صاروا قلال اللي عطيوا كتير، محمد دكروب. فلّيت قبل ما نشكرك». وأضاف المدوّن خضر سلامة «المؤرخ الشيوعي والكاتب والصعلوك المشاغب: شوارع صور. مجلة «الطريق». صنارة الأدباء. أسماء الشهداء. الصحف العتيقة وكومة الكتب والعمر الذي لم يكبر يوماً على التغزل بالنساء والضحك. وداعاً يا دكروب». أما صفحة المفكّر الراحل على فايسبوك، فقد تحوّلت مكاناً أخيراً لوداعه، بعدما انتشرت عليها العبارات والأغاني والصور. حتى أيامه الأخيرة في المستشفى، كانت زيارات شباب «الاتحاد الديمقراطي» و«الحزب الشيوعي» تتوالى عليه. يتذكر هاني عضاضة من «اتحاد الشباب الديمقراطي» ما قاله له دكروب في المستشفى: بدا قلقاً على مستقبل الشباب «الذين تخلوا عن الكتابة والقراءة». هكذا، أتت وصيته الأخيرة لتلتقي مع وصية المفكّر الراحل حسين مروة «زيدوا ثقافتكم يا رفاقي، نظّموا أكثر عملية التثقيف، حتى تتزايد شعلة الضياء تأججاً وسط الظلام الذي يريد أن يطغى».
نافذة إلى الشارع الثقافي السوري
خليل صويلح
دمشق | كانت «الطريق» في نسختها الأولى، واحدة من النوافذ القليلة في الشارع الثقافي السوري إلى الثقافة النوعية. بين صفحاتها قرأنا بنهم أسماء الكبار، ومعنى أن يعبر النص السوري المغاير والمارق إلى بيروت، في وقت كانت فيه المجلات الثقافية السورية الرسمية حكراً على نصوص منتوفة الريش، ومشبعة بالرطانة، وعلامة حسن السلوك. «وصلت مجلة الطريق»، يخبرك المكتبي الذي يعرف زبائنه جيداً، بالكاد تحجز نسختك، وتلتهمها على عجل، ثم تعود إليها مرّة أخرى، تتأمل رنين الأسماء ونشوة الخطاب اليساري في صعوده سلّم الغد المشرق، ومعنى أن تكون ماركسياً حقاً.
فجأة احتجبت المجلة بصعود مجلات الزيت، واحتضار مجلة «الآداب» التي توقفت هي الأخرى كمحصلة لحصار الخطاب المضاد. لم أكن أعرف محمد دكروب عن قرب. مكالمة تلفونية واحدة ألغت المسافة بيننا، لجهة الهيبة منه إذ كانت سيرته كمثقف ماركسي شرس. واعدته في مقهى «الروضة» الدمشقي. كان يستعد لإصدار النسخة الثانية من «الطريق»، وقد طلب مني أن أكتب له «رسالة دمشق». اتفقنا على الفور. حماسته لمواكبة اللحظة العربية الجديدة، أصابتني بالعدوى، بالإضافة إلى هيبة «الطريق» التي كنت أتابعها قبل احتجابها، لكن «مرح» محمد دكروب كان السبب الأساسي لحماستي. هكذا تبخّرت أفكاري القديمة والجاهزة عنه، بخصوص «الواقعية الاشتراكية»، والماركسية المتشدّدة، فهذا الرجل كائن آخر، كائن طليق، من دون قيود إيديولوجية صارمة، كما توهمت. لفرط حماستي أيضاً، كتبت فوراً مقالاً بعنوان «المريض السوري: تمرينات شاقة على تعلّم النطق» في تشريح الحراك السوري، وظهر في العدد الثاني، بسبب خطأ في البريد الأول. على الهاتف كان سعيداً بنفاد العدد من المكتبات الدمشقية، فقارئ «الطريق» ما زال حيّاً. كان الرجل الثمانيني أكثر شباباً مني، أو على وجه الدقة، أقل يأساً. لذلك لم يتردّد في افتتاحية العدد الأول في أن يكتب «تستأنف هذه المجلة الفكرية العريقة مسيرتها في شقّ الطريق إلى المستقبل». المستقبل؟ أجل كان واثقاً بأن مجلته ستستعيد مكانها ومكانتها في واجهات المكتبات. نحن ـ وفقاً لما كتبه ـ أحوج ما نكون إلى «مجلة ديمقراطية تؤسس لزمن عربي جديد ومختلف». ديمقراطية محمد دكروب تعثّرت بعد خطواتها الأولى، فالطريق إلى المستقبل لم يكن كما توقّع، و«الربيع العربي» أزهر دماً وفتاوى ومقاولات. انكفأ الرجل وبدا اليسار الذي راهن عليه بقدمٍ عرجاء. أما فكرة التنوير، فقد انطفأت على يد فقهاء الظلام، فقرر الرحيل. وداعاً محمد دكروب، أيها الرجل النبيل.
إن العيد يوقد مصباحه للبحث عنك
مرسيل خليفة *
جاء محمد دكروب، ذلك السنكري الجميل، إلى الثقافة عن طريق الحزب. رغم ذلك، لم يكن حزبياً مطيعاً ومكلفاً بتطبيق خط سياسي متبع، ولا كان مكلفاً بالمساهمة في التناغم الثقافي الذي يرنو إلى السلطة (أي سلطة). كان يسعى إلى التضامن مع المقهورين والمعذبين ومن ثم التشكيك في المبادئ السائدة وتخريبها وإظهار كل ما هو مكبوت بفعل الاجماع الاجتماعي والثقافي من دون التنازل أبداً عن التميّز. لقد تمكّن محمد دكروب من الإمساك بحريته ومهما كانت التضحيات وتيسّر عندها الاحساس الحضاري بجمال هذه الحياة.
بعدما أصبحت عندنا الثقافة في هامش المشهد، أصرّ دكروب على أن يستعيد الطريق وعمل دون كلل، رغم ثقل السنوات، لإصدار المجلة ولو فصلياً. فحرمان المجتمع من البوح الحر سوف يؤدي عبر الوقت إلى صدأ الحساسية الثقافية. غيّر عمقياً في مسالك الرؤية وخلخل الثوابت التي تعرقل فعل الحرية. وبرؤيته لهذه الحرية استطاع وحده تحقيق معجزة الكتابة وعطّل على الحياة استسلامها، وأحدث اختراقاً بسيطاً وسط جمهور اضطهدته وسائل الاعلام. علّمنا محمد دكروب كيف نحمي الثقافة من الفضيحة ونحفظ للذاكرة حرمتها. وفي هذا الخندق الأخير، خندق الثقافة، حاولنا أن نرابط مع قليلين مدافعين عن تلك القيم وأن نصمد في وجه جرافة الانحطاط. أعود إلى الذاكرة، ذاكرة الحرب اللبنانية التي سرقتنا من طفولتنا وشبابنا. أتذكر حينما غادرت للمرة الأولى ذلك المعبر الذي كان يفصل بين المتقاتلين، كانت نظرة دكروب في استقباله لي لحظة المجيء إلى الغربية أشبه بحب خالص، كما لو كان ذلك الأب الحنون. لقد رافقني بنظراته التي أنارت الطريق. وعندما عبرت الجسر، كان ينتظرني على الجهة المقابلة حابساً أنفاسه. وما إن اجتزت الجسر حتى استقبلني بتلويحته الكبيرة وعناقه الصافي. حين أتذكر، تأخذني الرعشة. كانت الحرب في تلك الفترة قد امتدّت إلى معظم أرجاء البلاد، وكانت الرحلة من منطقة إلى أخرى سفراً مرعباً. وهكذا علّمنا دكروب أن الكتابة مثل الحياة وعلينا ألا نكترث بمن يضع أمامها ميزان الماضي لتلفيق الحاضر ومحو المستقبل أو تشويهه. ذهب دكروب إلى الكتابة بطريقة مغايرة، بتجارب تخرج على الطوق والطريق معاً وتخرج من تجربة الحياة الأكثر تأججاً واتصالاً بالمستقبل. بدايات غامضة تشير إلى ذهاب أكثر غموضاً إلى مستقبل لا يزعم الثبات ولا يتطلبه.
يا رفيقي ويا صديقي محمد. أعلم أنك مستاء من الوضع. لا بأس. ضع هذه الوردة على ياقة قميصك واتركها تعطّر أنفاس من يندسون بين ثناياك.
ستضيء ما لا يضاء من عتبات الحنين حينما يشدو البحر ويبكي طائر حيران بين مدينتين، بين صور وبيروت
أكتب عنك اليوم لأني لا أصدق موتك ولأني أحبك. يا محمد، إن العيد يوقد مصباحه للبحث عنك.
* موسيقي لبناني
جيل بضاعته الأمل
منى عبد العظيم أنيس *
سمعت عن محمد دكروب قبل أن أراه بسنوات طويلة. كان والراحل الكبير حسين مروة وراء نشر أول كتاب لأبي عبد العظيم أنيس وصديقه محمود أمين العالم «في الثقافة المصرية». ثم التقيته في بيروت الحرب الأهلية في الثمانينيات، وبعدها صرنا أصدقاء نلتقي كلما جاء الى القاهرة أو ذهبتُ إلى بيروت. عندما التقيته للمرة الأولى، كنت في زيارة طويلة نسبياً لبيروت للتعرّف إلى واقعها بعد الاجتياح الإسرائيلي، وكنت أقيم في فندق «البوريفاج» في الرملة البيضاء، نزيلة وحيدة لا يشاركني في الفندق أحد، رغم توافد رواد كازينو القمار ليلاً.
وفي هذا الجو الموحش، كنت أذهب يومياً الى شقة دكروب القريبة، حاملة وحشتي وأسئلتي الكثيرة عما يجرى في لبنان من حروب متعددة، لأخرج بعد ساعات من الدفء معه هو وزوجته الروسية وطفلتيهما أكثر اطمئناناً وأملاً في المستقبل. التفاؤل التاريخي كان بضاعة هذا الجيل من الشيوعيين العرب، ومحمد دكروب كان ماكينة أمل وشحذ للهمم. ترى، هل بقيت هذه الصفة معه حتى النهاية؟ كيف استقبل الربيع العربي؟ لطالما تمنيت أن أعرف ما الذي كان سيقوله أبي ورفاقه عن أيامنا الملتبسة هذه. رحم الله محمد دكروب رحمة واسعة بمقدار ما أعطى من جهده وحياته.
* صحافية ومترجمة مصرية
المثقف العصامي
عماد أبو غازي *
ظل دكروب حتى رحيله علامة من علامات الفكر العربي التنويري لها مكانتها الراسخة ودورها الذي ظلت تؤديه من دون كلل. رغم كل الظروف المحبطة في عالمنا العربي، ظلّ ممسكاً برايات الأمل وقيم العدالة والحرية والتنوير بطريقة جعلته أكثر شباباً من الجميع. على الصعيد الشخصي، عرفته في عام ١٩٨٨. ومنذ ذلك التاريخ وأشكال تواصلنا ممتدة حتى أيامه الأخيرة، حيث لم يتمكن من الرد على الاتصالات ربما بسبب تدهور وضعه الصحي. نشرت في مجلة «الطريق» واحدة من أهم كتاباتي عن الجذور التاريخية لأزمة النهضة وتحولت في ما بعد الى كتاب بفضل التشجيع الذي وجدته من دكروب.
تشجيع جمع بين فضائل المعلم وحنو الأخ الأكبر ودعم الصديق الذي لا أظن أنّ إسهامه في تاريخ الحركة الشيوعية العربية يمكن نسيانه. فقد أرخ لهذه الحركة ولا سيما في لبنان بنزاهة جعلته شاهداً أميناً على تحولات رافقت تلك الحركة عالمياً وعربياً. وأظن أنّ السمة الشخصية الغالبة في دكروب ترتبط بإخلاصه لمبادئه وهدوئه اللافت في قدرته على الحكم ببعض الأمور وهي سمات جنبته اتخاذ مواقف انفعالية وجعلته عقلانياً في أصعب الأمور. هذه العقلانية أكثر ما سنفتقده مع غيابه، الى جانب عصاميته كمثقف. صنع كل ما صنع استناداً إلى جهد شخصي، فهو أستاذ بلا أستاذه، لكنه ترك الكثير من التلاميذ الذين سيفتقدونه بشدة.
* وزير ثقافة سابق ومؤرخ مصري
قابضاً على جمر الأفكار
يوسف القعيد *
كلّما رحل عن عالمنا أحد كبار نقّاد الواقعية الاشتراكية، أشعر بنوع من اليتم بعد زحف عدد من الأفكار التي تواجه مفهوم الالتزام في الأدب بزعم أنّ الانحيازات لقيم الحرية والعدل الاجتماعي تأتي على حساب جمالية العمل الفني ذاته. وهي واحدة من الأفكار التي كشف محمد دكروب زيفها في مجمل إنجازه النقدي وفي حياته. إذ يصعب الفصل بين الحياة التي عاشها والأفكار التي بشّر بها. حتى نهاية حياته، ظلّ قابضاً على جمر الأفكار التي انحاز لها ولم يغيّر، ولكنه تطور وانحاز لأصوات وأسماء جديدة انعكس حضورها في كتاباته وعمله في الأعداد الأخيرة من مجلة «الطريق».
المؤكد أنّ ثقافتنا العربية خسرت دكروب في لحظة فارقة، حيث يتعرض عالمنا لهجمة أصولية شرسة تكاد تقتلع كل الأفكار التي ناضل من أجلها كمثقف متنور ومنشط سياسي احتفظ لسنواته الأخيرة بشباب يندر أن يتكرر. ومما يزيد من درجة الأسف أنّ الأجيال الجديدة من المفكرين والسياسيين لم تبلغ ما بلغه دكروب من رحابة فكرية، وإيمان بالتنوع. حتى إنّه يصعب أن تعرف أين ينتهي الفكر ليبدأ الأدب في حياته لأنّه صهرهما معاً في تركيبة إنسانية بالغة العذوبة.
لا أزال أتذكر الى اليوم نظرته الإنسانية الأكثر شمولاً لعطاء نجيب محفوظ الأدبي. كرّس ملفاً كاملاً في مجلة «الطريق» بعد فوز محفوظ بـ«نوبل»، واستطاع أن يتجاوز بهذا الملف النظرة التي شاعت في بعض أقطار العالم العربي وسعت الى تسييس الجائزة وربطت بين الحصول عليها والمواقف السياسية لصاحب «أولاد حارتنا». لكن دكروب بضمير الناقد كان أكثر بصيرة من الآخرين وأعطى لـ«الطريق» مذاقاً ميّزها عن المجلات المنافسة في ذروة عصر المجلات الفكرية والأدبية. وكنت أتمنى شخصياً ًلو أتيحت لي فرصة قراءة مذكراته لأتعرف أكثر إلى الظروف التي عملها فيها، ولا سيما بعد تعثر المجلة وعدم قدرتها على الانتظام في الصدور. وفي كل الأحوال، سيبقى دكروب في ذاكرة جيلي أقرب الى يد لم ينقطع العطاء عنها وامتدت إلينا جميعاً وباتساع أحلامنا.
* روائي مصري
تبقى يا رفيقي في الذاكرة والعقل والوجدان
كريم مروة *
يفقد العالم العربي بغياب محمد دكروب علماً كبيراً من أعلام الثقافة العربية. فاجأنا محمد بغيابه السريع قبل أوان الرحيل، وخسرتُ أنا شخصياً بغيابه رفيق تعامل ودرب، ورفيق حياة مشتركة في مهمات متعددة.
تعود علاقتي بمحمد إلى مطلع أربعينيات القرن الماضي، كنا في ذلك الحين نقيم في مدينة صور، افترقنا لفترات معينة من الزمن، كل منا في مكان بعيد في أرجاء الدنيا، ثم عدنا فالتقينا في لبنان وفي بيروت التي كانت بالنسبة إلينا كما قال ذات يوم الشاعر محمود درويش الخيمة التي كنا نستظلّ بها. اشتركنا في مهمات ثقافية في مراحل متعددة من حياتنا، كان أهمها وأكثرها جمالاً ومتعةً ثقافية ذلك القرار الذي اتخذناه في عام 1993 بإعادة إصدار مجلة «الطريق» بعد توقفها عن الصدور في العام الخمسين لتأسيسها. وكنت قد اشتركت معه في عام غيابها المشار إليه، في إصدار عدد وداعيّ للمجلة، جهد محمد خصوصاً بملئها بحشد من الكتابات القديمة التي ملأت صفحاتها السابقة. في هذا الإصدار الجديد الذي استمر عشر سنوات حتى 2003، كانت المجلة منبراً من أهم المنابر الثقافية في العالم العربي. جهدنا معاً محمد وأنا بإثارة النقاش على صفحاتها حول العديد من القضايا الفكرية والسياسية والثقافية، بين التيارات المتعددة الاتجاهات في العالم العربي، في ميادين الفكر، والأدب والفنّ. لكن أهمّ تلك النقاشات كانت تدور حول مرحلة ما بعد انهيار التجربة الاشتراكية، وكنا حريصين، كلانا، على حضّ الكتّاب والمفكرين على تقديم إسهاماتهم حول المرحلة الجديدة التي تواجه عالمنا العربي وتواجه على وجه الخصوص اليسار ما بعد انهيار التجربة الاشتراكية.
محمد دكروب في حياتي يحتلّ موقعاً خاصاً ساهمت فيه الأعوام السبعون من علاقتنا. ورغم طول العمر والمتاعب التي رافقت كلينا، فقد كنا حريصين على أن يظلّ القاسم المشترك في أعوام عمرنا، هو الأساس الصلب لعمق الصداقة التي ربطت بيننا. يصعب الحديث الآن عن محمد في هذه اللحظات التي اودّعه فيها، وبالطبع لا أدّعي أنني أكثر من سواي أشعر بالخسارة. الخسارة هي خسارة الثقافة العربية جميعها، فتراث محمد دكروب الثقافي الغني يشير إلى الموقع الذي احتلّه في هذا العالم الرحب الذي اسمه عالم الثقافة. وهو ما تشير إليه العديد من كتبه التي عرّف فيها القراء العرب بأعلام الثقافة العربية الكبار. لا أستطيع أن أقول لمحمد وداعاً، لا أحب كلمة الوداع، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بشخص من نوع محمد دكروب. ستبقى يا رفيقي وصديقي محمد دكروب دائم الحضور في الذاكرة والعقل والوجدان.
* كاتب لبناني
اللقاء الأخير/ سماح ادريس
اتصل بي دكروب الحبيب قبل أسابيع. وكالعادة عاتبني لأنّني لم أزره منذ مدة. سألني عن المناظرة الشهيرة التي أدارها سهيل إدريس بين رئيف خوري وطه حسين، متى نشرت، وأين؟ قلت: «يا لحسن حظّك! المناظرة أمامي لأنني أعكف على كتابة مداخلة عن رئيف في مؤتمر سيُعقد قريباً. المناظرة، كما جاء في كتاب «الأدب المسؤول» نشرتْها مجلة «الآداب»، وعقدت في نوّار 1955». ضحك، وسألني إن كنت أعرف ما نوّار؟ وقبل أن أجيب قال إنّه سيأتيني فوراً.
دخل دكروب معتمراً قبّعة رياضية. بدا لي في ذروة شيخوخته وصباه معاً. كان جسمه متهدماً، لكنّ القبعة كانت تظْهره ابنَ 16 ربيعاً. نزع قبعته ووضعها إلى جانب بورتريه لسهيل. قبل كل شيء طلبتُ إليه أن يشرح سبب ضحكته على التلفون. ردّ: «أتعرف ما نوّار؟». أعتقدُ أنّ نوّار هو اللفظ العربي لأيّار بالسرياني، أجبتُ. أكمل: «صحّ، ولكن بعض أبناء جيلنا، لفرط تهذيبهم، لم يستسيغوا لفظ أيّار لشبهه بـ… (عضو الرجل)، ففضّلوا نوّار، الدالّ على نور الربيع».
ككلّ جلساتي مع دكروب، المرح هو سيّد الموقف، ولو في عزّ الكلام الرصين. قضينا ثلاث ساعات، هي من أغنى ساعات عمري بالذكريات وتحليل الماضي والشخصيّات. كنتُ أعلم أنها لحظاتي الأخيرة مع صديقي العزيز، وربما كان يدرك أنّها لحظاته الأخيرة معي، فلم يفكّر أيّ منا في أن يختصر الجلسة. كان دكروب بالنسبة إليّ أباً ثقافياً، ومعلّماً، وصديقاً، ورفيقاً. وكانت جلساتنا، كلّها، مزيجاً مفعماً من الأبوّة والبنوّة والصداقة والروح الرفاقيّة. وبدءاً من العام 1992 أضيفَ إلى كلّ هذه الأبعاد بعدٌ فريدٌ في العلاقات الإنسانيّة، هو بعدُ الشراكة في مهنة رئاسة التحرير (هو في «الطريق» وأنا في «الآداب»). وإنّها لمهنةٌ أحسبُ أنّها أكثر أبعاد حياتيْنا عذاباً وجمالاً.
تحدثنا عن رواية سحر خليفة الجديدة التي محورُها أنطون سعادة. لم يكن، وهو الشيوعيّ، معجباً بأفكار الزعيم، لكنه لا ينسى تأثيره القوي في أوساط مؤيديه، ولا ينسى ــ بشكل خاص ــ أنه حضر ندوةً كان سعادة يتحدث فيها بفصحى متماسكة طليقة، وباعتداد بالنفس يقارب اعتداد الأنبياء. ثمّ عرّجنا إلى الأدباء والشعراء، فأبدى إعجاباً قويّاً بمحمود درويش، لا بشعره فقط، بل بجنونه وإخلاصه لعروبته كذلك، لكنه ركّز على «نقائه» الإنسانيّ منذ أن تعرّف إليه قبل عقود. لم يكن محمود «كذّاباً»، «مقطّعاً موصّلاً» شأنَ شاعر فلسطينيّ آخر هو… (الحذفُ منّي طبعاً). كما تحدّث عن غسان كنفاني، مشيداً بدوره في تقديم شعراء الأرض المحتلة إلينا، وخصوصاً عبر كتابه «أدب المقاومة في فلسطين المحتلة». وتحدثنا باستفاضة عن الصراع الناصري ــ الشيوعي. دكروب يرى، باختصار، أنه صراع كان يمكن تفاديه، ويحمّل الطرفين مسؤوليّة اندلاعه وتفاقمه. وهو يعتبر أنّ هذا الصراع كان من أكبر أسباب هزيمة المشروع التقدمي العربي.
لكنّ جزءاً غير قليل من جلستنا تمحور حول شخصيات «شيوعية سابقة». دكروب إنسان رقيق لا يحقد على أحد، ونقدُه لهذه الشخصيات أرفق من النقد الذي يوجّهه إليها شيوعيون حاليون بالتأكيد. غير أنّ اللافت أنّه لم يعتبرها خائنة أو مرتدّة، بل يشتبه في أنها لم تكن مخلصة في شيوعيتها أصلاً. المشكلة في رأيه ليست في حاضرها، بل ماضيها. هذه الشخصيات لم تكن شيوعية في الأصل، وحقيقتها هي ما عليه اليوم، لا ما انحرفتْ عنه بالأمس! وطبعاً تحدّثنا عن سوريا ومصر و«الربيع العربي». دكروب لا يشك في أنّ الأنظمة المهترئة (كلّها كذلك كما يرى) ينبغي أن تزول. بيد أنه لا يشك أيضاً في أنّ الثورات الحاليّة ناقصة ومبتورة، ولا تشكّل ــ بنسختها الأصولية المخلجنة ــ أملًا للشعب العربي المعذب. كثيرون هم السياسيون والأدباء الذين تطرّقنا إليهم في هذه الجلسة الممتعة. ثم استأذن مولانا بالعودة إلى منزله. أوصيتُ يوسف بأن يوصله إلى باب بيته. غادرني مولاي. عدتُ إلى غرفتي، فألفيتُ قبّعته إلى جانب بورتريه سهيل. وفي تلك اللحظة تحديداً، عرفتُ أنني لن أرى مولاي بعد اليوم.
* رئيس تحرير مجلة «الآداب» التي ستصدر إلكترونياً خلال شهور.
أنبل الشيوعيين العرب/ سيد البحراوي *
في تقديري أنّ دكروب أهمّ منشط ثقافي عربي عرفته، وهو أيضاً من أنبل الشيوعيين العرب الذين عرفتهم. كانت فيه خصائص لا تتوافر في الكثير من المثقفين والشيوعيين العرب. بالإضافة الى حسه النقدي، تميّز بمزاج إبداعي خصب مكّنه من التواصل مع قطاعات عريضة وأجيال مختلفة ومتنوعة من البشر بحثاً عن إمكانياتهم الحقيقية وسعياً لاكتشاف أفضل ما في الناس. وهي سمة نادرة بالفعل بالقياس الى تصحر واقعنا العربي بالذات على الصعيد الفكري. وقد انعكست كل تلك السمات على عمل دكروب في إدارة وتحرير مجلة «الطريق» وإشرافه على منشورات «دار الطليعة» في سنوات توهجها.
أذكر أن أوّل كتاب لي نشرته بفضل تشجيع دكروب في سلسلة «الفكر الجديد»، رغم تحفّظه على الطريقة التي كنت أكتب بها ولا يمكن لتاريخ النقد العربي أن ينسى دوره في تحفيز محمود أمين العالم، وعبد العظيم أنسي على نشر كتابهما الشهير «في الثقافة المصرية». وهو كتاب فتح طريقاً لم يكن مطروقاً في عالمنا العربي ولا يزال أثره قائماً الى اليوم. بالإضافة إلى تلك الموهبة، كان يمتلك رقة متناهية ودماثة خلق، حتى أكاد أجزم أنه من أرقّ البشر الذين عرفتهم، ويصعب تعويض شخص مثله لأنّ الأجيال الجديدة لم تكتسب هذه الصفات.
ومن زاوية تتعلق بعملي النقدي، أظنّ أنّ دكروب كان ناقداً مبدعاً بفضل بداياته في كتابة القصة القصيرة، وهي بدايات تبدو مجهولة لمن تابعوا سيرته. في حوار أخير معه، كشف عن تلك البدايات التي يمكن العثور على آثارها في معايير التذوق الفني للنصوص، وهي معايير لم تجعله ينطلق من نظريات صماء. وقد انعكس ذلك أيضاً في تعامله مع النصوص وتلقيها برحابة على عكس كثيرين من النقاد الملتزمين أو النقاد الأكاديميين سعياً لإقامة صلة بين القارئ والنص، وهو أمر لم يكن يجاريه فيه إلا الراحل علي الراعي الذي كان يدخل النص من باب الحب، لا من أبواب الكراهية.
* ناقد وأكاديمي مصري
رحيل الكاتب والناقد الكبير محمد دكروب
رحل محمد دكروب، الصديق والمناضل، والتقدمي، والتنويري. بصمت. لكن بدويّ الكبار. هذا الشخص الودود، عرف بعصامية نادرة، كيف ينتقل من مهنة “السمكري” الى أبرز الكتاب والنقاد اللبنانيين والعرب.
وقد أعانته مهنة “العامل” هذه (أيام يا عمال العالم اتحدوا (لينين))، الى شحذ شعوره بمعاناة هؤلاء، والفقراء، والطبقات المسحوقة، وصولا ًالى كتابة الالتزام. الالتزام “الحزبي” لكن المفتوح على مجمل الحساسيات والخيارات الأخرى. لم يختر البندقية للمقاومة، والنضال، ولا الحروب، بل اختار القلم. وهذا الأخير لم يكن يرفع ضد “الآخر” المختلف، بل دائماً على قرب وحميمية من الإبداع. من الظواهر الإبداعية، سواء في الشعر أو المسرح، أو الرواية أو النقد أو الفكر. كان شيوعياً ملتزماً على امتداد حياته (مثل الشاعر الفرنسي أراغون)، لكنه كان كذلك متوغلاً في التعددية، بصورها وتعابيرها الشتى. لم تُصبْه شمولية أو توتاليتارية (ستالينية)، أو حتى واقعية اشتراكية كما حدث مع المفكر الشهيد حسين مروة، بل شرع حياته على كل التيارات، وعلى النوعية النصية، وليس فقط على الوظيفة المباشرة على غرار ما قال مايكوكوفسكي وسواه “الفن في خدمة الثورة” كوسيلة محددة، محكومة بشروط الإيديولوجيا والسلطة وظروفهما، ومشاريعهما. قد يكون محمد دكروب آخر الشيوعيين (طبقياً، وثقافياً) لكنه من أوائلهم الذين حاولوا الخروج الى أفق أبعد من الالتزام المباشر، ومن التقوقع عن مجمل الاختلافات الكتابية والفكرية. وهذا ما عبّر عنه جلياً عندما أدار مجلة “الطريق” التي حررها من دورها “الحزبي” الى دور أرحب، ومن أحاديتها الى تعددية الإبداعات؛ تولى إدارة “الطريق” عقوداً، على الرغم من تعثراتها القسرية، والغريب أنه وفي الفترة الأخيرة، حاول تجديد هذه المجلة، وإدخالها في الزمن الجديد، أو في المرحلة التي نعيشها بعد سقوط جدار برلين والاتحاد السوفياتي وصولاً الى “ستالين” الجديد بوتين، وأتاح لأقلام لبنانية وعربية بالمشاركة في ملفاتها وصفحاتها، خصوصاً في بعض استعادات حية لمرحلة الخمسينات والستينات والحروب والأزمات والقضايا الجارية. فعل ذلك على الرغم من الإمكانات المادية المتواضعة، معتمداً، في توفير استمراريتها وتطورها على صداقات تطول الى كل القطاعات، وقد نجح في ذلك، علماً بأن الحزب (أو ما تبقى منه) باع مجلة “الأخبار” لتصير جريدة يومية. باع هؤلاء رمزاً من رموز نضال الحزب منذ تأسيسه، وكأنها عقار موروث، أو شقة مفروشة. محمد دكروب، ومن خلال إصراره على دور ثقافي في هذا الزمن الصعب، والمتصحر، نجح، أولاً في إدامة المجلة وتطويرها، وثانياً في الحؤول دون طرحها على المزاد العلني، لكنه، وهو في الخامسة والثمانين، وهو النضر الحي، الدقيق، الحالم، جعل هذه المجلة صورة أخرى مختلفة عن واقع الحزب التقليدية. صورته الالتزامية الإنسانية، والعربية، واللبنانية، غير الضيقة.
لكن الغريب والمحزن والمؤسف أنه رحل وبقيت المجلة مستمرة، وبقيت كتبه ودراساته النقدية والمسرحية والتنويرية أمامنا، وأمامه…
فوداعاً يا صديقي. صديق الأزمنة الناقصة، والحروب، والأمراض المذهبية، وقد نجوت منها، وعلّمتنا كيف ننجو، من أجل ولاء أوسع من كل أيديولوجيا. ولاء الإنسان لأرضه، ووطنه، بل ولاء الإنسان للإنسان.
بول شاوول/
محمد دكروب السمكري الشغّيل الذي صار أديباً ومناضلاً كبيراً
ع. ع.
مات صديقي محمد دكروب قبيل الفجر بقليل.
قيل لي إنه غادر في الموعد نفسه الذي يذهب فيه العمال والفلاحون وشغّيلة الكفاح إلى أشغالهم، في الأرض والمعامل والمصانع والمطابع ودور النشر والكتب والمجلات، ليصنعوا فجراً لائقاً بالضوء والبحبوحة والحرية. كنتُ أعتقد بيقين لا يتزعزع، أن هذا الرجل لا يمكن أن يشيخ، وهو المولود من زمان، من أواخر العشرينات الماضية في عام 1929. فمحمد دكروب، شأنه شأن السنديانات، التي تعمّر، وتتجدد، إذ تضرب جذورها في الأرض، لا بدّ أن يظلّ نضراً ويتسامق. لم أشعر يوماً أن هذا الرجل ثمانيني، وأن جذعه المكابر يمكن أن يتعرض للخراب أو للانتكاسة. فهو كان من هذه القلة النادرة التي لا تستكين، أو ترضخ للتقاعد، أو للقيلولة، أو تفكّر في تسليم “السلاح”، الذي كان نضالاً بالكلمة والعقل، من أجل الحرية والحق والعدالة والمعرفة والديموقراطية. لقد كان الدكروب حقاً، من هذه الندرة البشرية التي تصنع لنا شمس الفجر، ولهيب الكرامة الحرة، وهو السمكري الذي صار كاتباً بقوة النضال والكفاح والموهبة والإرادة. المناضل دائماً، العارف دائماً، المستقبلي دائماً، الشديد العزم دائماً، الصلب الإرادة دائماً، القوي الشكيمة دائماً، المبتسم دائماً، الفتى دائماً، العنيد، الليّن، الطيّب، الكريم، الشهم، الرحب، الناقد، الدارس، المجتهد، المواظب على إيقاظ النيام والكسالى واليائسين، الحامل “المسّاس” الذي يخز به الرجعية فيصيب منها مقتلاً، والمشدد العزائم الرخوة في الزمن البائس والصعب. ولد محمد دكروب عام 1929 في صور وتلقى التعليم الابتدائي في المدرسة الجعفرية في المدينة نفسها، ثم ترك المدرسة قبل الشهادة الابتدائية بسنتين، ليلتحق بدكان والده. عمل سمكرياً، وتقلب في أشغال عدة، ودرس على نفسه، وامتهن الصحافة والكتابة، في جرائد ومجلات لبنانية وعربية عدة، في مقدمها “الطريق”، مجلة الحزب الشيوعي التي عمل رئيساً لتحريرها، فكان خلال تلك الحقبات المتلاحقة حتى اليوم، علامة فارقة في تاريخ النضال والمعرفة. هذا الذي ترك لنا قصص “الشارع الطويل”، و”جذور السنديانة الحمراء”، الرواية التسجيلية الوثائقية لحركة نشوء الحزب الشيوعي اللبناني وتطوره، و”دراسات في الإسلام” بالاشتراك مع حسين مروة ومحمود امين العالم وسمير سعد، وكتاباته النقدية في “الأدب الجديد والثورة”، و”شخصيات وأدوار/ في الثقافة العربية الحديثة”، و”حسين مروة/ شهادات في فكره ونضاله”، و”قصة رواد يجارون العصر”، و”الذاكرة والأوراق”، و”النظرية والممارسة في فكر مهدي عامل. لقد ظل الدكروب يكافح بالكتابة والعقل حتى الرمق الأخير. وها السمكري الشغّيل الذي صار أديباً ومناضلاً كبيراً، يغادر قبيل الفجر بقليل. سلامي اليه. في 23 آذار 2008، نشر “الملحق” للدكروب هذا النص الذي يلقي ضوءاً ساطعاً على مسيرة هذا الرجل. نعيد نشره تعميماً للفائدة.
محمد دكروب بقلم نفسه
ندما بشّرني الصديق الكريم الدكتور عصام خليفة بأن الهيئة المسؤولة عن الحركة الثقافية في انطلياس قررت ادراج اسمي بين أعلام الثقافة المكرّمين، غمرني فرح عميق وشعور حقيقي بالامتنان. لكن الصديق العزيز طلب مني القيام بعدد من التدابير الضرورية ليتّخذ التكريم صفته الثقافية والعملية معاً. من جملة ما طلبه: تزويد الحركة ثبتاً كاملاً شاملاً يتضمن عناوين المقالات والدراسات وحتى القصص التي نشرتُها طوال حياتي الثقافية!
– لكن هذا الطلب مستحيل التنفيذ أيها الصديق!
قال، بما يشبه الكلام الجدي الحاسم: أنت قدّها وقدود!
قلت: وماذا أفعل حيال استحالة أن أتذكر المئات والمئات من عناوين الكتابات التي نشرتُها، وعشرات المجلات التي ضاعت وفيها بعض تلك الكتابات والمقالات التي نُشرت لي، وتلك التي نسيتُ أني كتبتُها أصلا؟
قال: ولو! أنت بالذات فيك تدبّر حالك. استعن بالرفاق الشباب، وبالأساليب والتقنيات الحديثة. مفهوم؟
– مفهوم، ولكن… إذا حدث أن توفقتُ قليلا بالعثور على بعض تلك العناوين، فهذا قد يملأ عشرات الصفحات!
قال بلطف يتضمن بعض التنازل: دبِّر حالك بأوسع ما يمكن من الشمول، ولكَ عدد غير محدود من الصفحات. وقذفني الصديق العزيز في بحر متلاطم الأمواج، وفي حيرة لا حدود لها! بدا أن الصديق عصام خليفة يحدّثني من قلب القرن الحادي والعشرين، قرن تواتر الوسائل التقنية الحديثة للتخزين الثقافي والاحصاء والأرشفة والتعداد، وجلب المعلومة ولو من شدق الأسد!
لم يكن في وسعي سوى أن أعود بالذاكرة الى السنوات الأولى لبدئي في الكتابة والنشر قبل أكثر من ستين عاماً، اذ بدأتُ بنشر بعض ما أكتب عندما كنت أشتغل سمكرياً، وأفكر في أشياء تشبه القصص وتشبه المقالات، على إيقاع طرطقة التنك وتصليح بوابير الكاز، وصنع النواصات التنكيّة… لقهر الظلام!
ففي دكان السمكرية هذا، كان يلتقي عصراً بعض الأصدقاء من الطلاب، فننسج معاً أحلاماً أكبر بكثير من انترنت ما، صغيرة الحجم، وأوسع بكثير من دكان السمكري نفسه، ومن البلد كله. أحلام تذهب بنا بعيداً، فتشمل مساحات بلدان وبلدان. كنا نفكر (وهذا سر سياسي يذاع للمرة الأولى) في أن نشكل جمعيات سرية عربية متشابكة، تعدّ نفسها لتحرّر – في القريب العاجل – البلدان العربية جميعها، من الاستعمار ومن التجزئة ومن التخلف، تحررها كلها، دفعة واحدة، وليس بالتقسيط، من أقصاها الى أقصاها، أي: “من الشام لبغدان/ ومن نجد الى اليمن/ الى مصر فتطوان”. وبالطبع: الى لبنان! ولا مساومة! كنا نسجل هذه الأحلام في مقالات حماسية جداً نرسلها الى الصحف، ولكن لم تنشر لنا منها في حينه ولو فقرة من مقالة واحدة، فلم نيأس.
في ذلك الزمان اذاً، أواسط الأربعينات من القرن الماضي، لم تكن قد ظهرت الانترنت لا في لبنان ولا في بلدان العالم. فلم يكن في استطاعة هذا السمكري الفتى تخزين فتوحاته الكتابية وعناوين أقاصيصه في جوف هذه الآلة السحرية المدهشة. لكن الذاكرة البشرية تحتفظ بملامح وأحداث وعناوين تتزايد غموضاً وتباعداً وضبابيةً مع الأيام، فيتلاشى بعضها وتبقى ملامح تأثيرات لا يدرك المرء سر احتفاظ الذاكرة بخيالات منها وبعض التفاصيل.
مما أتذكره، أني منذ أواخر الأربعينات تلك، بدأتُ أكتب ما يشبه القصص أو سرديات لأحداث من بلدتي صور الجنوبية، أصوّر فيها خصوصا معاناة الفقراء ومشكلاتهم الحياتية. وغامرتُ بإرسال بعض هذه الكتابات إلى جريدة “التلغراف” باسم صاحبها المقدام نسيب المتني، وكانت الجريدة تخصص في كل يوم اثنين أربع صفحات كبيرة لقضايا الثقافة والأدب، يشرف عليها الكاتب الكبير رئيف خوري. اختار رئيف من هذه الكتابات قصة كنت كتبتُها عن حياتي ومهنتي وآمالي، وغيّر لها عنوانها – الذي لا أتذكّر الآن ماذا كان – وجعله هكذا: “أديب وسنكري”. فرحتُ كثيراً بنشر القصة، ولَفَتني هذا العنوان الجديد لها، فصرتُ أفكّر في معنى هذا الدمج الرئيفي بين الصفتين: أن يصير السمكري كاتباً أو أديباً. ولمَ لا؟ وواصلتُ الطريق.
كنتُ، في ذلك الزمان، مهووساً بقراءة روايات الخيال العلمي، مغرماً بالابتكارات العلمية المستقبلية، وبالتنقّل السهل بين النجوم والكواكب والسموات العلى، ولكن لم يصادفني في تلك الروايات شيء يشبه الانترنت، مثلاً! على أني جرّبتُ، بنفسي، كتابة قصة في الخيال العلمي، واخترعتُ – داخل القصة طبعاً – جهازاً يتنبّأ بما بعد بعد الانترنت: تخيّلت جهازاً فيه شيء يشبه شاشة سينمائية صغيرة، وفيه أنبوب يوجّه شعاعه الخفي إلى رأس شخص ما، فينقل الشعاع إلى الشاشة صوراً لما يدور في دماغ هذا الشخص – فتاة غالباً وشاب أحياناً – ولكم أن تتخيّلوا ماذا يحوي هذا الدماغ من أسرار وأمنيات وأحلام ورغبات تنعكس كلها على الشاشة الصغيرة في صور ليست البتة أقل من فضائح فضّاحة.
هذه القصة أرسلتُها في حينه الى مجلة كانت تصدر في القاهرة باسم “قصص للجميع”. ويبدو أن هذا الاختراع العجيب أعجب رئيس تحرير المجلة فنشر القصة في مكان بارز، لكن نسخة المجلة التي نشرت القصة ضاعت، وضاع معها عنوان القصة. وكذلك فإن المجلة نفسها لم تعمّر طويلاً، فضاع إمكان العثور على نسخة من تلك القصة العجيبة، وضاع طبعاً ذلك الاختراع الرهيب.
فلو كانت الانترنت موجودة في ذلك الزمان، لما ضاع شيء من هذا كله. أتيح لي، في ذلك الزمان أيضاً، نشر أشياء في مجلة “العرفان” لصاحبها الشيخ المتنوّر أحمد عارف الزين، فكان يختار من خمسة أو عشرة مقالات، واحداً يرضى عليه وينشره، فيزغرد قلبي فرحاً. لكن الشيخ الطريف أحبّ أن يزركش واحداً من مقالاتي بتعليقات يضعها بين هلالين كبيرين في متن المقال نفسه. والمقال هذا فيه نقد لأوضاع الشباب وسلوكاتهم التي يبدو أنها لم تنل رضاي الكريم. وأتذكّر أني أوردتُ في المقال استنتاجاً سلبياً ما في حق الشباب، فعلّق الشيخ بقوله: “هذا غير صحيح يا أستاذ!”.
في مقطع آخر اتهمتُ الشباب جميعاً بالتخاذل، فعلّق الشيخ بقوله: “إذا كان ذلك كذلك، فكاتب المقال نفسه يُحسب في المتخاذلين”. واذ حكمت على الشباب بأنهم جيل ضائع، علّق الشيخ بالقول الفصل: “الضائع هو الكاتب وحده”.
والحق الحق أقول: إن هذه التعليقات أسعدتني جداً، لأن المقال هذا بالذات، صار حديث الناس في جنوب لبنان، وصرتُ رأساً في المشهورين، ليس بسبب قيمة فكرية ما للمقال، بل بسبب تعليقات الشيخ عارف الذي أحببته فعلاً ولا أزال أقدّر الدور التنويري لمجلته التي تجاور في صفحاتها ما هو تقليدي في الكتابة والمفاهيم، وما هو جديد وتجديدي وجريء أيضاً.
في أواخر الأربعينات صدرت في بيروت مجلة ذات نزوع تقدمي وديني ويساري معاً، هي مجلة “الألواح” للسيد صدر الدين شرف الدين، الذي سبق أن أصدر في العراق جريدة يومية شهيرة باسم “الساعة” حملت أوائل كتابات حسين مروة السياسية عندما كان في العراق، أُتيح لي أن أنشر مقالات قصصية قصيرة في مجلة “الالواح” هذه، ضاعت ايضاً بين جملة ما أضعته من مقالات نُشرت لي. لكني أتذكّر جيداً أن جريدة مصرية نشرت خبر صدور مجلة “الالواح” على الشكل الآتي: “صدرت في بيروت مجلة أدبية جديدة باسم “الألواح” وعلّقت: والله العظيم اسمها كده!”.
لعلي لم أشعر أني صرت، بالفعل، واحداً من الكتّاب إلاّ عندما بدأت مجلة “الأديب”، ذات الشهرة العربية الواسعة تنشر لي أشياء من كتاباتي: مقطوعات من النثر الفني، ومقالات حول بعض الكتب الجديدة، وأقاصيص منها ما هو واقعي جداً، يصوِّر حياة اناس الطبقة الدنيا في المجتمع، ومنها ما هو أسطوري جداً، أتخيل في واحدة منها عملية شعبية تنقل الناس من حياة الفقر والبؤس الى حياة يزدهر فيها كل شيء، الطبيعة وحياة الناس، فتتلوّن الدنيا بالسعادة والصفاء وكل أنواع الزهور. وكانت مجلة “الاديب”، في ذلك الزمان، مجلة للأدب الجديد والبحث التجديدي في العالم العربي، في رعاية صاحبها ألبر أديب، الطليعي في الشعر المنثور الذي سمّاه “الشعر الطلق” وكان أنيساً سمح النفس والذوق، يفتح صفحات مجلته لكل من يتوسّم فيه جديداً ما، حتى ولو لم يكن في المشهورين. وقد فاجأني ذات يوم بأن جعل واحداً من مقالاتي بمثابة افتتاحية للعدد. ولا تزال هذه المبادرة تفعل فعلها السحري في نفسي حتى يومنا هذا.
لا أزال أحتفظ بصور من بعض ما نُشر لي في “الأديب”، التي اعتز دائماً بأنني صرت مبكراً – واحداً من كتّابها. كانت مجلة “الأديب” محطة انطلاق فعلية لي، ومجاز عبور الى النشر في عدد من المجلات الأخرى، وكذلك الى بدايات العمل في الصحافة الأدبية الفكرية. فمع بداية الخمسينات، تناولني شيوعيو هذا البلد، وقذفوا بي الى خضم العمل الصحافي، قبل أن اكون مارست مهنياً هذا العمل، فكلّفوني تحرير مجلة ثقافية سياسية جديدة، باسم “الثقافة الوطنية”، وحتى قبل سيامتي عضواً رسمياً في الحزب الشيوعي اللبناني. وإذ انتسبتُ الى هذا الحزب، عَلِقت فيه، ثم تعلّقت به، منذ ذلك الزمان، حتى يومنا هذا، والى ما يشاء الزمان.
صدرت المجلة بين 1952 و1959، أسبوعية أولا، ثم شهرية فكرية ادبية، وانتشرت بصورة لا بأس بها في أنحاء العالم العربي عندما يسمح بهذا حرّاس الحدود وواضعو السدود، وكانت المجلة منبراً للفكر التقدمي التنويري اليساري وللأدب الواقعي الجديد.
على أن الانعطافة الاساسية لعملي في الصحافة الثقافية كانت في مجلة “الطريق” الفكرية، التي توليتُ مسؤولية تحريرها ما يقارب الأربعين عاماً، منذ العام 1965 حتى العام 2003، تاريخ التوقّف الموقت للمجلة. فلا بد، هنا، من بضع كلمات حول علاقتي بهذه المجلة الفكرية اللبنانية القيّمة. ذلك ان مسيرتي مع “الطريق”، طوال هذه المدة، ساهمت بشكل اساسي في إغناء تكوني الثقافي والمعرفي، وذلك، اولا، عبر إتاحة الفرصة امامي لإقامة علاقات خصبة مع الكثيرين من الكتّاب والمفكّرين والمبدعين العرب، الكبار منهم والشباب. وكذلك بإلزام نفسي ثانياً قراءة كل الدراسات والمقالات والأعمال الابداعية التي كانت ترد للنشر في المجلة من مختلف انحاء العالم العربي والعالم الأوسع: فقد أتاحت لي هذه القراءات الإلزامية والمشوِّقة معاً، ان اتزوّد، قيميّاً ونقدياً، المادة المعرفية والابداعية التي تحملها تلك الكتابات، ثم ثالثاً عبر دخولي، بدافع الرغبة او لضرورات التحرير، الى مناخات الكتابة في مجالات لم أكن دخلتُ فيها قبلا، واضطراري الى كتابة ما تتطلبه أعداد المجلة في هذا الباب أو ذاك.
استطاعت “الطريق” أن تستقطب عدداً كبيراً من الكتّاب والمفكرين العرب الذين دأبوا على تزويدها نتاجات قيمة لهم من دون أي مقابل مادي، بل دعماً منهم لمشروع “الطريق” الفكري والتغييري التقدمي. ولكن، على رغم أن هذه المجلة العريقة وصلت في انتشارها الى رقم كبير بالنسبة الى توزيع مجلة فكرية عربية، بحيث صارت توزع ما بين خمسة الى ستة آلاف نسخة من كل عدد، فإنها توقفت عن الصدور مع نهاية العام 2003. أما سبب هذا التوقف فهو فقط ان كل عدد كان يباع بأقل من تكلفته، وأن المجلة لم تكن تتلقى أي مساعدة او دعم مالي من أي جهة من الجهات “الداعمة”، فتراكمت عليها الديون، ولم تعد قادرة على متابعة مسيرتها التي نرجو لها ونعمل لتعود هذه “الطريق” الى متابعة الطريق. فالحاجة اليها تتزايد مع تزايد الضرورات الفكرية لوجودها.
في مجلة “الطريق”، تحديداً، أتيح لي ان أدخل جدياً في مجالات البحث والدراسة والنقد الأدبي وبعض الرؤى والآفاق في النظرية الماركسية التي لا أزال أستفيد جداً من أفقها الفكري والعملي، وبلا أي حدود تحدّ من هذا المسار، إن شاء الله!
عبر الفهرس العام لأعداد مجلة “الطريق”، استطعت أن ألبّي بعض ما طلبه الصديق العزيز عصام خليفة، فسجلت عناوين مئات المقالات والدراسات من دون الاستعانة بما خزّناه هذه المرة في جوف تلك الآلة السحرية التي اسمها الانترنت.
وأحب أن أهمس في أذن الصديق عصام: أني، فكرياً، أجهد أن أعيش في القرن الحادي والعشرين، أما تقنياً فلا أزال في أوائل القرن العشرين. وقد أظل تقنياً هناك الى أبد الآبدين!
كل ما قررت أن أفعله جدياً وعملياً، هو شراء دفتر كبير أسجل فيه عناوين كتاباتي، بكل دقة وأمانة، حتى لا يفاجئني صديق آخر بمثل ما طلبه مني صديقي الذي أحبه وأقدره جدا. وبهذا تكون الليستة جاهزة وإن غير شاملة وغير كاملة، بالتأكيد!
… وبعد، بماذا يشتغل محمد كروب الآن، وعلى ماذا، بعدما توقفت “الطريق”؟
وأنتم ترون اني قد بلغت من العمر عتياً، وأكثر: فإذا كنت قد ولدتُ في العام 1929 تكون سنوات العمر قد وصلت الآن (في العام 2008) الى الـ79 سنة (والله كريم كما يقال، وأنا استأهل كما اظن) اكتشفت انه تراكم لديّ عدد لا بأس به من الدراسات والمقالات التي تؤلف عددا لا بأس به ايضاً من الكتب يحتاج كل منها الى بعض التنسيق والتدقيق والتقديم والاستكمال، يصل تعدادها الى الـ15 كتابا، سيضاف اليها ما في خاطري من مشاريع أرى ضرورة ان أنجزها. أي: عندي ما يكفي من عمل يملأ سنوات لي مقبلة أرجو أن تطول كثيراً، بإذن الله والهمة للكتابة لا تزال موجودة، وكذلك المزاج، إضافة الى تشجيع الرفاق والأصدقاء والمحبات والمحبين، آمين!
النهار
محمد دكروب الفقير الذي امتلك ثروة من كلمات/ يوسف بزي
في زيارتي الأولى له في منزله، مطلع التسعينات، ظننت أني أدخل مؤسسة توثيقية ضخمة، أو أنني داخل أرشيف خرافي من النوع الذي كان خورخي بورخيس يحث مخيلتنا على تصوره. هذا المنزل المكتبة، الذي “ألّفه” محمد دكروب على امتداد عمر من جني الكتب وحفظها، وتكديس المجلات والوثائق وقصاصات الجرائد.. هو شبيه صاحبه، صورته الداخلية، روحه، فكرته عن معنى حياته.
بدا لي أن هذا الشيخ الأدبي، كرس حياته كلها من أجل تحصيل هذه “الثروة”، أن يدخر الكتب والأوراق، هو الذي ولد فقيراً واهتدى إلى الأدب سبيلاً إلى الغنى، وهو الذي عايش الجوع واكتشف في الكتابة والقراءة غذاء وشبعاً. كان مشهده جالساً هناك بين الرفوف العامرة بالمجلدات، محاطاً بآلاف الكتب، وأمامه أكداس الملفات والأوراق، تجسيداً لما كنت أتخيله عن أساتذة الأدب وكبار الأدباء، حسب ذاك التصور الرومانسي عن حياتهم ومنازلهم وصومعاتهم وخلواتهم ومكتباتهم. ربما محمد دكروب نفسه عندما كان مراهقاً مسحوراً بألق الحياة الأدبية، وبنجومية الشعراء والكتّاب في زمن الأربعينات، لم يفعل سوى التمثل بتلك الصورة الرومانسية عن بيوت الكتّاب. أن يُغرق نفسه بكل ما يتحصل له تجميعه من كتب ومنشورات، أن يغطي الجدران بالرفوف الممتلئة والمزدحمة بتلك المجلدات الضخمة.
ما من مرة التقيته، نهاراً أو ليلاً، على رصيف أو عند مدخل مسرح أو في قاعة، إلا وكان في يده ورق، كتاب، مجلة، ملف.. حتى وإن كانت يداه خاليتي الوفاض، كنت أشعر أن ثمة ثقلا في جاكيته بسبب حشوها بمطبوعة ما.
نادراً ما قرأت له نصاً أو مقالة، ذاك أني ركنت إلى إيمان مبكر، أو متسرع، برفض شيوعية الأدب ومقولتي “الواقعية الإشتراكية” و”الإلتزام” وهو أحد أعلام الثقافة في الحزب الشيوعي اللبناني. عدا تعجلي بالإفلات من تقاليد ثقافية، كنت أرى أن لا بد من الهروب منها كشرط لـ”كتابة مختلفة” أطمح وأقر اني إليها.
ما زلت أحتفظ بأعداد قليلة من مجلة “الطريق”، التي اقترنت باسمه وباسم حسين مروة. وفيها بعض من نقده الأدبي، الذي بدا لي سليل النقد الذي كان دارجاً في الثقافة العربية بزمن الخمسينات الإنطباعي والأخلاقي، أكثر مما هو يساري كما عند جورج لوكاش مثلاً. نقد يسعى لتبني “الموهبة” وتربيتها، أكثر مما هو تشريح وقياس وتحليل. هذا ما يبرر ربما الصلة الحميمة التي عقدها محمد دكروب مع مجمل الكتّاب، على اختلاف أجيالهم وميولهم وانحيازاتهم الفكرية. لم يتح لنا أن نفارقه، طالما أنه كان يرحب بكل ما يصادفه، ويتجنب كل سجال حاد، وكنا نعرف من أنواع ابتساماته، لا من كلماته، رأيه النقدي أو موقفه من تجربة أو نص.
أغلب الظن أن سلوكه الودود ونقده المتسامح، التشجيعي أو “التوجيهي”، يدلنا على تلك الثقافة التي ميزت الشيوعية العربية وأدباءها في الحقبات التي سبقت الستينات، حين كانت وكانوا أقرب إلى الأفكار النهضوية، التنويرية، التي تحارب الخرافات والأمية والجهل والمظالم الإجتماعية، وتبشّر بالتحضر والمدنية أكثر مما تبشّر بصراع الطبقات مثلاً أو بتعاليم “الواقعية الإشتراكية”. كان أدب الشيوعيين رئيف خوري أو إميل حبيبي منعقد الصلة بمارون عبود أو بأحمد فارس الشدياق أو حتى بمخائيل نعيمة وبطه حسين، أكثر بكثير من مكسيم غوركي وأشباهه. بهذا المعنى لا بد من تذكر القاص الشيوعي محمد عيتاني، الذي مثّل ذروة فن القصة اللبنانية المتناسلة من ذاك الإرث، والتي أضاف إليها واقعية سحرية، قبل “الواقعية السحرية” التي كتبها أدباء أميركا اللاتينية.
في بيروت أواخر الثمانينات، كنا نرى محمد دكروب كما لو أنه واسطتنا الحية بالتاريخ الأدبي، الذي انصرم مع اندلاع الحرب منتصف السبعينات، انصراماً عنيفاً فاقمه، لا بد، تبدل العالم والزمن وانقلاب الأجيال، وبدا أنه يستأنف نسق زمنه بقوة ذاك الأرشيف الذي يحويه دماغه وتملكه مكتبته، وبقوة حقيقة أنه يعيش معنا ويزاملنا ويشاركنا ويتابع معنا كل مستجد، مكتسباً في كل مرة ما يضيفه إلى ذاك الأرشيف، مذكراً إيانا بآبائنا في الأدب، بالسلالات التي ننحدر منها. وهو الذي ألّف كتباً عدة مزج فيها بين سيرة الأدباء وسيرة نتاجهم معاً كمؤرخ أو كقاص يستقصي “الأسباب” لا الحوادث، محاولاً استكشاف تلك الصلة بين الواقع الإجتماعي المتغير والتحولات التي تصيب التجارب الأدبية.
في ذاك الزمن، رحنا لحسن الحظ، نتماثل مع تلك التقاليد، أي أن نقتني، بهوس، الكتب والمجلات، أن نؤلف مكتباتنا، أن نزهو بالرفوف الممتلئة. أن تكون لنا مكتبة عارمة كمثل التي صادفناها حينها عند دكروب أو كتلك الأنيقة المتعددة اللغات عند بول شاوول، أو تلك الفوضوية الفائضة عند الياس خوري.
“الإدخار” هو سر محمد دكروب، أن يجمع ويلمّ ويحفظ، تماماً كما كان يفعل بفقر معيشته، أي أن يحصّل ما لديه ثقافةً وكتباً، بالتقشف. ومن هذا التقشف ذاته، حين ما عاد للحزب الشيوعي موارد كافية، في الفترة التي تلت سقوط الإتحاد السوفياتي، وانفراط عقد “جبهة الصمود والتصدي”، استطاع محمد دكروب أن يستأنف حاله، أن يعيد مجلة “الطريق” إلى الطريق بجهد فردي تقريباً، وأن يبقى في مكانه وبمساره، بعناد الإلتزام الأوسع من الإلتزام الحزبي والعقائدي. بقي هكذا شيخاً في الأدب والنقد، يسارياً محافظاً في السياسة والفكر.
ذاك المنزل المكتبة، كما محمد دكروب، حياة موقوفة على تلك الفكرة: الثقافة الآتية من قراءة الكتب، في ذلك العصر الذي سبق الأسلاك الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر. كأنه الورّاق الأخير.
المستقبل