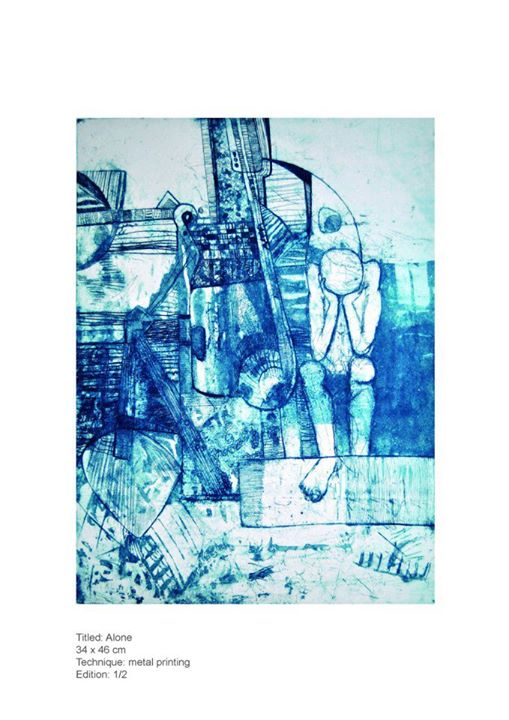ملحمةٌ عظيمة.. كأيامنا هذه/ سحر مندور

يشعر المرء بأنه محاصرٌ بالأبطال في عالمٍ عربيّ شائكٍ دامٍ. قسوة الموت والفقر تنتج النقيضين: عبثية وجود أبطال، وحتمية إيجادهم في آن. منهم المنقذ، المخلّص من الجريمة والقلق، قائدٌ صارمٌ يتوعّد ومتعاطف، على طريقة مصر. ومنهم الفارس الذي سيرمح بالفرس «بعد كبوتها»، على طريقة الدعاية الانتخابية لبشّار الأسد. ومنهم من وزّع الحلوى في الشوارع فرحاً بالمصالحة بعدما بهتت صفاتهم وأرخت القطيعة الدامية فجاجتها، على طريقة «أبوات» فلسطين وأمرائها المؤمنين. ناهيك عن لبنان الصغير وخصوصيته في حرق الأبطال كمرحلةٍ تسبق إعادة انتعاشهم (طيور الفينيق)، بطلٌ عائدٌ من سجنه في مواجهة بطلٍ عائدٍ من منفاه.. هما، وجميعهم، يصنعون الأجوبة الأمضى لسؤال الرئاسة الراهن في المنطقة. إليهم، يُضاف ملكٌ بحريمٍ هنا، وأميرٌ نهمٌ هناك، وطائفيٌّ شرسُ الفسادِ هنا، وانتخابٌ يليه انتخاب، وأزمةٌ وُلدت بينما أخرى تُنجز، …
هنا، في سيناريو كهذا، يوجد «أبطال». وتوجد أيضاً شعوبٌ، تريدهم.
الصورة العامة للأبطال
في سوريا، خرج فنانون يحكون عن أهمية الانتخاب كفعلٍ هو «واجبٌ وليس حقاً فحسب»، وكأن الواجب أرفع شأناً من الحق، وهو كذلك في بلاد «البعث». فحكى الفنان عن «العرس الديموقراطي» الآتي إلى البلد عبر انتخاباتها، بلا تردّدٍ أمام شلال الدم والحداد الذي أقل ما يقال فيه إنه لا يمهّد لعرس! كما تطرق آخرٌ إلى «أنا هيك بفهم الحرية، وكل مواطن سوري شريف هيك لازم يفهمها»، ولم يرفّ للفنان جفن وهو يعرّف الحريّة بنقيضها، علماً ان «رفة الجفن» قد تُفهم كتخاذل، فاستعاض عنها بوجهٍ مبتسمٍ حادّ، وعينين متقدتين شرراً، وشاربين مفتولين يستحضران الموروث العربي القمعي كله، بأبهى حلله. أما هذه الفنانة فها هي تبتسم لتوحي بالاطمئنان والثقة كأختٍ كبيرة، تستدرج الصوت إلى الصندوق باللين والهوينى. وتلك الفنانة ترسم على وجهها صموداً ما بعده صمود، من دون إهمال تصفيفة الشعر الرصينة التي تؤكد أن صاحبته قد كلّلت هذا الجمال برزانةٍ وعمقٍ إستراتيجيين. ناهيك عن الفنان الذي ارتدى علمه ليؤكد وطنيته فلا يشوبنا شكٌّ فيها!
أما في مصر فقد خرج «البطل» في حوارٍ تلفزيونيّ رئاسيّ، يحكي عمّا يسمح به ولا يسمح به، وهو ما زال مرشّحاً. «أنا مش هسمح لك تقول «عسكر تاني» لأنها توحي بمشاعر سلبية تجاه المؤسسة العسكرية. ثم، «الجيش مؤسسة عظيمة أوي، أكتر ما يمكن أن تتصوره المصريين» كردّ على سؤال حول آلية المراقبة على الجيش. «خدوا العربيّة (السيارة) إنتو التلاتة واشتغلوا عليها وادفعوا قسط للبنك»، كحلّ لمشكلة البطالة. و: «يللا يللا أنا عارف أنا بعمل إيه، أنا آسف بقى!»، في معرض وضعه حدّاً لمساءلة اقتراحه حول حلّ مشكلة البطالة. ألم يتعنَّ تجهيز أقواله عن الحلول للناس في بلدٍ يختنق بمصائبه؟ ألم يفكّر لوهلة بأن هذا الكلام قد يوحي للناس باستمرار عهد ما قبل الثورة، بوجهٍ جديد؟ أم انه على ثقة تامة بأن مبايعة الملايين له لن تتأثر بذلك، وربما هي تقوم في جزء منها على ذلك.
الناس يصنعون الأبطال
الميل إلى تبرئة الناس، الشعوب، من تهمٍ يوجهها المرء إلى السلطة، هو محاولةٌ لتخفيف وطأة المصيبة على الذات. لكن الواقع ما عاد يتسع لأدوات الأمل. والبطولة ليست طريقاً باتجاهٍ واحد. «أبطال» الراهن العربي أوجدوا لأنفسهم مسبّبات ومبرّرات لضرورتهم الماسّة، بقوّة السلطة أساساً، وبقوى أخرى كثيرة تترافق مع امتلاك السلطة. وفي المقلب الآخر، يشكّل مريدو «البطل» الأكثرية عند قياس أحجام التجمّعات الصلبة. وهم، إذ يدّعون لآرائهم الصوابية المطلقة، تراهم ليسوا أقل وعياً للحال من زملائهم في المواطنة المحتاجين إلى تغيير.
جماعاتٌ تذوب في هذا «البطل» أو ذاك، تلتحم فيه كأنها تحمي حياتها به، وهي بذلك تكون أيضاً تنتحر فيه. في مقابلهم، يظهر أفرادٌ ربما يكونون من أشدّ مناهضي هذا «البطل» أو ذاك، أو حتى النظام بأكمله، ومع ذلك، معظمهم يستخدم أدوات الموالاة في معرض المعارضة. كلغة واحدة تحكيها الأكثريات. اتهامات التخلّف، «القطيع»، ثم التكفير ضد التفكير، والتخوين ضد الاجتهاد، أمثلة سهلة نعرفهما جيداً، تسود المشهد العام، على اختلاف خنادقه، كما في المساحة خارج الخنادق: ماكينات إعلامية وصناعات إخبارية ضخمة، تبقى أمضى أدواتها أفواه الناس أنفسهم، أفهامهم، مخاوفهم، تباغضهم، توقهم للضرورة الماسّة تموّه الانحطاط اليومي، توقهم لتحديد عدوٍّ وبطل، الحاجة القصوى لتنفيس احتقانٍ في جسم عدوّ، استخراج الأبيض والأسود من تفاصيل الصورة، فتحديد موقع الذات الحاسم النهائي منها.. كأن الحياة الآن وهنا هي ملحمةٌ عظيمة. ملحمةٌ تموّه الخراب. وعظيمةٌ، تعطي المعنى. ملحمةٌ عظيمة إذاً، كأيامنا هذه.
الجماعات والأفراد يساهمون في صناعة الوضع العام، يتوزعون «أبطاله»، يستمرون في الانتظار منهم، ويستمرون في اليأس منهم، يقفون قبالتهم كتشكيلٍ يتكامل. يقطفون رضى، يقطفون غضباً، يصبحون كتلةً أقوى، يصبحون فرداً أعند، وأشياء أخرى يجدونها في الاندماج مع السياق العام، لا يتيحها الانصراف عنه نحو عناوين شائكة لا نألفها، ووجوهٍ أخرى لا نعرفها.
مفهومٌ أن معارضة الأنظمة مكلفة، ثمنها الدم والزنازين، ولكن، لم يتشكّل في مواجهة هذه الأنظمة انصرافٌ عنها. لم تتشكّل أكثرية تنأى بنفسها عن صنّاع حالها. وإذا كان السياق ساهم في وضع الشعوب حيث هي، فلا بد من ملاحظة أننا لسنا بغرباء عن ممارسة الظلم والجريمة أيضاً. مجتمعاتنا لا تسقط عليها الجريمة من السلطة فحسب، وإنما هي تنتجها بدورها، وبكثافة. تدافع عنها بصلابة، كقوانين ناظمة، ولا تتشكّل ضدها.
الجرائم الجامعة
لا يجوز أن نحاكم الأنظمة من مصر إلى لبنان فسوريا والعراق وفلسطين وسواها من بلادنا، بينما نربت على أكتافنا كضحايا مطلقين لهذه الأنظمة. في هذه الأنظمة أشياءٌ كثيرة منا. لم تأت من عدمنا. وبينما نقف اليوم لنحاسبها على ما تصنعه فينا، هل نراجع ما نملكه منها أيضاً، ونتشاركه معها؟ ولغياب الرغبة حتى بمساءلة الذات، ولاستشراء قوى الدفاع عن العادات والتقاليد والأعراف، يبدو كأن العدالة ليست ما نطلبه من الدولة، وإنما مجرد تغييرٍ في سياق النظام الحاكم، رفعٌ جزئي لظلمٍ مستتب: تعزيز حصّتي من الربح، لا العدالة الاجتماعية. الحريّة، «مثلما أفهمها أنا». الدين، كسطوةٍ عنيفة. الأخلاق، كجريمةٍ طاهرة. الإجبار، كحقّ. المنع، كحماية. الضرب، كتربية. الاغتصاب، كنتيجة. الإعدام، كعقاب. الكارثة، كاستراتيجيا…
في حكاوينا عن التغيير، يتضح أننا ما زلنا مجتمع الاعتداء، ولم تلفتنا بعد إمكانيات العدالة. بدءاً من «ربّ الأسرة»، نحن مجتمع يصون الاعتداء كوسيلةٍ لتحقيق شيءٍ ما، كالعنف الذي يؤمّن الطاعة. «نتناقش» في نسبة هذا العنف، ولكن لا يتماسك لنا نقاشٌ جدّي حتى في معنى هذه «الطاعة»، وما تطويه من السرير إلى الدولة.
بذلك، يولد لنا «أبطالٌ» بينما المجتمعات على هذا القدر من الإنهاك والتفكّك، في ظروفٍ على هذا القدر من الدموية في الفعل والعبثية في الخطاب. لن يحمل أي وجهٍ قياديّ وعداً بالعدالة، إلا «كما يفهمها هو». أمل العدالة ينتظر الناس، بينما الناس منصرفون لتناتش «الأبطال».
على باب هذه الأفكار، يقطن عميق القلق.
السفير