منجم سليمان عوّاد الذهبيّ/ د. مازن أكثم سليمان
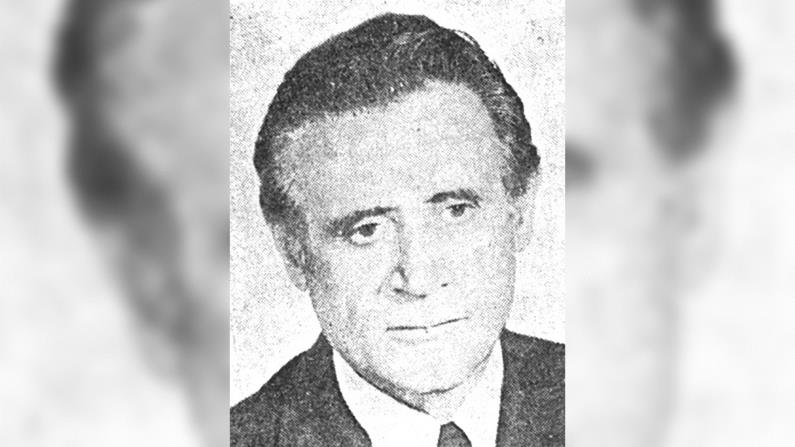
يحتفظ الأرشيف التّأريخيّ للشعر السوري بمكانة خاصة للشاعر سليمان عوّاد، من مواليد السَّلميّة (1922 _ 1984)، وإن كان كثيراً ما يعلو هذا الأرشيف غبارُ الإهمال وقلّة الاكتراث، وهو الأمر الذي ألمسه بعمق في حالة شاعر بحجم عوّاد وخصوصيَّتِهِ المُستمدّة من جوانب متنوعة.
تنقَّلَ سليمان عوّاد بين مدن سوريّة مختلفة، وزارَ رومانيا، والتحقَ مدّة سنة واحدة بالجامعة اليسوعية في بيروت لدراسة العلوم السياسية قبل أن يُغادرها، مُفضِّلاً الانغماس في عالم الشعر والأدب.
أصدرَ الشاعر ستة دواوين هي: (سمرنار _ شتاء _ أغانٍ بوهيميّة _ حقول الأبديّة _ أغاني زهرة اللّوتس _ الأغنية الزّرقاء الأبديّة)، وترجمَ قصائد ومختارات شعريّة لشعراء رومانيّين في كتابين هما: (شعراء من رومانيا وذئب البحر)، وله رواية مسرحيّة واحدة بعنوان: (من همجستان)، فضلاً عن مقالاته الكثيرة في الأدب والسياسة.
تنبعُ أهمّية سليمان عوّاد التّاريخيّة أوّلاً من ريادته لقصيدة النثر على مستوى سورية والوطن العربي، ذلكَ أنَّ قليلاً من المُهتمّين يعرفون أنَّهُ كتبَ هذه القصيدة منذ عام 1945، ونشر ديوانه الأوَّل (سمرنار) في مطبعة الجمهوريّة بدمشق عام 1957؛ أي إنَّهُ سبَق كُلاً من (محمّد الماغوط) و(أنسي الحاج) زمنيّاً بنشر قصائده النثريّة، لكنَّهُ لم يحز على الصَّدى الإعلاميّ والنَّقديّ الذي حازا عليه بوصفهِما كانا من نجوم مجلّة شعر البيروتيّة في تلكَ المرحلة.
وإذا كان الشاعر الحلبيّ (علي النّاصر) قد سبق عوّاد في الاقتراب من معالم (غير ناضجة نوعاً ما)، ومن إرهاصات نصِّيّة واضحة في مضمار كتابة قصيدة النثر منذ ديوانه (الظَّمأ) المنشور عام 1931، ثُمَّ في ديواوينه اللّاحقة وصولاً إلى ديوانه النَّثري (سريال) المُشترَك مع الشاعر الحلبيّ الآخَر (أورخان ميسر) والمنشور عام 1947، إلّا أنَّ هذه التَّجارب لم تُقدِّم اقتراحاً مُتكاملاً يتعلَّق ببنية قصيدة النَّثر المُتحرِّرة من وحدة الموضوع أو الغرض الشعريّ أو المرجعيّة المدرسيّة (وهو ما يدلّ عليه عنوان سريال مثلاً)، وهذا على العكس من الاقتراح النّاضج (إلى حدٍّ معقول) الذي قدَّمه سليمان عوّاد في ديوان (سمرنار) وكذلكَ في ديوان (شتاء) الصّادر أيضاً عام 1957، وهو الأمر الذي دفع الشاعر (اسماعيل عامود) إلى القول: “من يتحدَّث عن ريادة الشعر النَّثريّ يجب أن يُدرِكَ أنَّها تعود إلى سليمان عوّاد”.
من الضَّروري تماماً العودة إلى تجربة الماغوط لفهم تجربة سليمان عوّاد، والعكس صحيح أيضاً، ذلكَ أنَّ البِنية النَّصِّيّة التي قدَّمَها الماغوط في بداياته وسحرَتْ شعراء مجلّة شعر من جانب أوَّل، وهزَّت من جانبٍ ثانٍ فضاء الشِّعريّة العربيّة بجدَّتِها النّادرة في تلكَ الحقبة، قد ترعرعتْ وخرجَتْ بمعنى الكلمة من عباءة سليمان عوّاد بالذّات، وانتقلَتْ إلى سُلالة من الشُّعراء السوريّين والعرب تمَّ وصفهُم بـِ: (السُّلالات الماغوطيّة)، ولا أحد ينسى كيفَ وُصِفَ الماغوط عند ظهوره بـِ: (رامبو العرب)، ورفضَ هذا النَّعت فيما بعد.
كانت قصيدة سليمان عوّاد النَّثريّة خُلاصة (محلِّيّة/عربيّة) لتيّار حداثيّ غربيّ عريض يتقدَّمُهُ الثلاثيّ الفرنسيّ (بودلير ورامبو ومالارميه)، فتمثَّلَ سليمان عوّاد روح هذا التَّيّار، وانتقلَ هذا التَّمثُّل منه إلى تجربة الماغوط الذي اعترفَ غير مرّة أنَّ عوّاد قد سبقهُم إلى هذا الشَّكل، وقال في لقائِهِ الشَّهير في مجلّة النّاقد مع (يوسف بزي ويحيى جابر) في آذار 1991: “أذكُر أنَّ سليمان عوّاد كان ينشرُ وقتذاك، وعرَّفني على الأدب الحديث”، وهو يقصد الفترة المُمتدّة منذ أواسط الأربعينات حتّى مُغادرة الماغوط السَّلميّة لأوَّل مرّة إلى مدرسة خرابو الزّراعيّة في غوطة دمشق عام 1948، وكان عمره أربعة عشر عاماً، واستمرَّ بعد ذلك تواصله الشخصي والإبداعي مع عوّاد في السَّلميّة ودمشق.
لم يخفِ الماغوط تأثير عوّاد عليه، وذكرَهُ في أواخر حياته بصفته أستاذه الشعريّ، وقال بالحرف الواحد: “لولا سليمان عوّاد لما تعرَّفتُ على قصيدة النَّثر وكتبتُها”، ولم يكُنْ هذا التَّقاطُع العميق بينَ صوتي الماغوط وعوّاد خافياً على كثيرين من الكُتّاب والمُثقَّفين في سورية، إلى الحدّ الذي قالَ فيه البعض إنَّ الشّاعرين يكتبان قصيدة مُتشابهة، أو واحدة! فها هو ذا سليمان عوّاد يقول مثلاً: “كالرّيف أنا/أمنَحُ خيري بصمتٍ… وسُكون/كالرّيف/أحيا على أنوار الكواكب ونبل الإنسان/مُفكِّراً بالشتاء الإنسانيّ الكبير/الشتاء الأبديّ الذي لا يُريد أن ينتهي”، وها هو ذا يقول أيضاً بـِ (نبرة ماغوطيّة صريحة): “إنَّ قلبي كتاب مُضطّرب العبارات/ضبابيّ المعنى/الرُّؤى الصُّوَر/مُتناقض الخواطر والأفكار/إنَّ قلبي كتاب حياتي الفوضويّة المُشعَثة/كقصائد بوهيميّة/يصوغُها شاعرٌ من عالم التَّشرُّد والاضطّراب”.
لقد وضعْتُ عبارتِي: (نبرة ماغوطيّة صريحة) بين قوسين، كي أعودَ وأنقلِبَ عليها الآن بالقول: إنَّها لم تكُن نبرة الماغوط؛ إنَّما كانت في الحقيقة نبرة سليمان عوّاد وروحه الشِّعريّة الخاصّة التي تأثَّرَ بها الماغوط أعمَقَ تأثير، مُتشبِّعاً ببنيتِها ورموزها وجهازها الدَّلاليّ، وهو الأمر الذي أحدَثَ الالتباس عند بعض المُثقفين والنُّقّاد، فقلبوا المُعادَلة كما فعلَ النّاقد (محمّد جمال باروت) في كتابه الشَّهير: (الشعر يكتب اسمه)، حينما كتَبَ _مُخطِئاً في اعتقادي_ أنَّ عوّاد كانَ يدور شعريّاً في فلك قصيدة الماغوط!
ما من شكّ أنَّ الماغوط قد أخذ جمراتِهِ الشعريّة الأُولى من عوّاد، وتلقَّفَ نظريّات الشعر الغربيّ وفقَ رؤية عوّاد نفسه، ولا سيما في مُستوياتها الرومنسيّة الاغترابيّة أوَّلاً، والوجوديّة في بُعدها العبثيّ أو العدميّ ثانياً، وفكرة الحُرِّيّة المُطلَقة في مَنحاها البوهيميّ ثالثاً، ولذلكَ من الطَّبيعي أن يظنَّ قارئٌ ما للوهلة الأولى أنَّ القفلة الشِّعريّة الآتيّة لقصيدة عوّاد: (وجْدٌ حزين)، هيَ قفلة لقصيدة من قصائد الماغوط: “كُلّما نظَرْتُ إلى وجهي في المرآة/أخالُ أنَّهُ يُعاتِبُ روحي عتاباً كئيباً/على المُضايَقاتِ التي تُسبِّبُها لهُ/إنَّ وجهي حزين/وأزهارُ روحي الصَّفراء تلوي أعناقَها”.
وعلى هذا النَّحو، أقول إنَّ الجذر (العوّادي) مُتأصِّل في قصيدة الماغوط، ولا سيما في البدايات، لكنَّني سأظلُم الماغوط بالتَّأكيد إنْ توقَّفتُ عندَ هذا المُستوى من القراءة والتَّحليل، ذلكَ أنَّ الماغوط (التِّلميذ) قد سبَقَ عوّاد (الأستاذ) بأشواط بعيدة فنِّيّاً وتخييليّاً فيما بعد، مُتجاوِزاً سيادة النَّزعة الرومنسيّة الطّاغية في قصائد عوّاد، ومُعمِّقاً التَّعبير عن تجربة البرجوازيّة الصَّغيرة (سوريّاً وعربيّاً) عبر الدَّلالات السِّياسيّة الحادّة التي افتقدتها تجربة عوّاد الشِّعريّة إلى حدّ كبير، على الرغم من أنَّهُ قد تعرُّض للسجن والفصل من العمَل في إحدى المراحل، لكنَّهُ ظلَّ مُلتزماً بنمط من الصّوفيّة الحسِّيّة إذا صحَّ التَّعبير، ومُتكئاً على الطَّبيعة، وأقلّ قدرة فنِّيّة من الماغوط على النُّهوض بموضوعات الثَّورة والحُرِّيّة والبوهيميّة على حامل تخييليّ عريض، ولا سيما في منحى تخليق الصُّوَر الشِّعريّة المُبتكَرة، فضلاً عن مُجاوَزة الماغوط لعوّاد في مسألة (تبييئَ التَّجرِبة الشِّعريّة وتأصيلِها) سوريّاً وعربيّاً، في حين كان عوّاد أكثر تجريديّةً وترميزاً في قصائدِهِ: “أيَّتُها الأمواج أنتِ شاعر/وأنا.. شاعر/لقد جمَعتْنا الأيّام لفترة قصيرة/العالم كبير وواسِع/ ومع ذلكَ/فإنَّهُ لا يتَّسِع لروح شاعر”.
إنَّ ما أدعوه (الصَّوت الرّامبويّ) في الشعر العربيّ الحديث، والذي يتَّصِفُ بمخضِ (المجهول) و(التَّمرُّد) بالمَعنى الحداثيّ _وهو الأمر الذي كانَ أحد حوامل قصائد الماغوط اللّافتة_ قد تجسَّدَ بعُمق عند سليمان عوّاد، فها هوَ ذا يقول مثلاً في جزء من قصيدة (تشرُّد): “أحلمُ بعضَ الأحيان في ليالٍ/أمضيتُها مُتشرِّداً في الرّيف/أنامُ على البيادر/أشمُّ رائحة السَّنابل/أملأُ روحي بعبير البرِّيّة/والنُّجومُ تُزهِرُ في قلبي أغانٍ من أقحوان/أحلمُ في أمسياتٍ قربَ البحر/أتمدَّدُ على الرِّمال خيالاً مُجنَّحاً/مُصغياً إلى صخبِ الأمواج الأبديّ/والأنوارُ في السُّفن تنقلُني إلى شاطئٍ غريب/أستنشِقُ من خلالِ لُجَّتِهِ أريجَ/ البحرِ وشذى الأسماك/ وهيَ محمولة في الفجر النَّديّ/على قواربِ الصّيّادينَ/أحلمُ أن يكونَ لي جناحٌ/يطيرُ بقلبي حتّى آخِرِ العالَم/وعندَ نهاية رحلتِهِ/أستقرُّ في كوخٍ شاعريّ/في مَراعي القمَر”.. تُرى ألا يُذكِّرُنا هذا النَّصّ بالصَّوت الرّامبويّ، كما في مقطعه الشَّهير هذا مثلاً: “في مساءاتِ الصَّيف الزرقاء/سأمضي في الدُّروب/تنقرُني سنابِلُ القمح/أدوسُ العشبَ الدَّقيق/… لن أتكلَّمَ/لن أُفكِّرَ بشيء…/وسأمضي بعيداً/بعيداً جدّاً/مثل بوهيميّ/عبرَ الطَّبيعة/ سعيداً/ كأنِّي بصُحبة امرأة”؟
كذلكَ يبدو عوّاد وفيّاً لرامبو في موضوعة (تشويش الحواسّ) بغية اختراق المجهول، إذ يقولُ مثلاً في قصيدة (في أعماق المُحيط): “أنا لستُ بالصّاحي/لقد شربتُ حتّى ارتويتُ/حتّى تلاشيتُ صبابةً سديميّة/تذهبُ في غيبوبة ذاهلة/أنا لستُ بالصّاحي/لقد كرعتُ حتّى رثَّتِ الأقداحُ/آمِلاً أنْ أتخلَّصَ من عبوديّة التُّراب/ولكنِّي واخيبتاه!/لم أعثرْ إلّا على سراب/أنا لستُ بالصّاحي/ لقد تجرَّعتُ حتّى أنسى وجودي/وجودي السَّكران بالشَّقاء وخيبة الآمال/لم يبقَ لي في هذا الوجود/سوى أن أُودِّعَ الحياة/(…)/غايتي أن أستحيلَ على مرِّ السِّنين/طيراً بحريّاً أبيض الجناح/يُرافقُ الملّاحينَ عبرَ البحار/أو محارةً تحتضِنُ لؤلؤةً ناصِعة/ أو موجةً زرقاء/تُغنّي في أعماق المُحيط”.
لقد خطَّ عوّاد مع الضِّلعيْن الآخريْن (الماغوط واسماعيل عامود) في المُثلَّث الشِّعريّ السَّلمونيّ (نسبةً إلى مدينة السَّلميّة) تيّاراً لهُ خصوصيتُهُ داخلَ قصيدة النَّثر العربيّة، ويمكن وصفه بأنَّهُ تيّارٌ مُغايرٌ إلى حدّ كبير للرُّؤى التي قدَّمها أنسي الحاج في مُقدِّمة ديوانِهِ: (لن)، أو للكثير أيضاً من تنظيرات (أدونيس) حولَ ملامح هذِهِ القصيدة وصِلتَها بالحداثة الشِّعريّة، وهيَ المسألة التي تستحقّ دراسة تأصيليّة مُوسَّعة نظَريّةً ونصوصاً، ولا سيما فيما يتعلَّقُ باتّكاءات الحاج وأدونيس على كتاب (قصيدة النَّثر) للفرنسيّة (سوزان برنار)، وتقاطُع تيّار (عوّاد/الماغوط/عامود) مع بعض أُسسهِ ومفاهيمهِ، وانفصالهم عن أسسٍ أُخرى غير قليلة فيه.
أقولُ أخيراً، إنَّ هذِهِ المادّة تُشعرُني بالغبطة الشَّخصيّة بقدر ما تُشعرُني بالإحباط؛ إذ كيفَ يسقط من حساب النُّقّاد السّوريّين والعرب شاعر بأهمِّيّة سليمان عوّاد الرّياديّة تاريخيّاً وفنِّيّاً؟ وكيفَ تمرُّ عشرات السّنين من دون أن يُفكِّرَ أحدٌ في جمع أعمالِهِ الكاملة وطباعتِها؟
إنَّي أنتظرُ ذلكَ اليوم الذي أرى فيه مؤلَّفاتِهِ منشورةً، وأتمنّى أن يجيءَ الوقتُ الذي يُوضَع فيه عوّاد وأمثالُهُ من المُبدعين في السِّياق النَّقديّ الذي يستحقّونَهُ في مسار التّأريخ الأدبيّ والشِّعريّ تحديداً، ولكَم كرَّرنا بوصفنا سوريّين وعرباً حُلْمَنا أنْ نقرأ أعمال أمثال هؤلاء في مناهجنا المدرسيّة والجامعيّة.. ألا يستحقّ عوّاد بمنجمِهِ الشِّعريّ الذّهبيّ الغنيّ ذلكَ؟!! وهو المُحارِبُ الجَماليّ القائل: “سأُواجهُ الواقِعَ بكُلِّ حزمٍ وصلابةٍ وجُرأة/سأتحمَّلُ برجولةٍ كُلَّ طارئٍ وكُلَّ مسؤوليّة/مهما تكون النَّتيجة/سأقولُ للجميل أنتَ جميل/ وللقبيح أنتَ قبيح”.
*شاعر وناقد سوري
ضفة ثالثة



