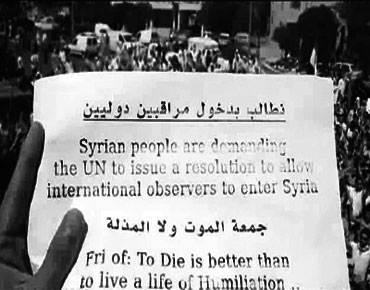من تصورات الديمقراطية إلى «النظرية الديمقراطية» في المجتمع؟/ ياسين الحاج صالح

في الإطار الثقافي السياسي العربي، والسوري بخاصة، ثلاثة تصورات للديمقراطية يمكن الاستدلال عليها مما هو متاح من كتابات في هذا الشأن: تصور إجرائي وتصور ثقافوي وتصور سياسوي. وهي تتوافق مع ثلاث تيارات ثقافية سياسية: إسلامي وعلماني وديمقراطي، تنحدر إلينا كلها من زمن ما قبل الثورات. ستعمل هذه المقالة على توضيح هذه التصورات وإظهار حدودها، مستفيدة مما أتاحته الثورات العربية المتعثرة من تجارب وخبرات.
تصور الإسلاميين الإجرائي
التصور الإجرائي للديمقراطية هو، أساساً، تصور الإسلاميين. ترتدّ الديمقراطية، حيث تُقبل هنا، إلى إجراءات للتطبيق، وبخاصة صندوق الاقتراع، بما يوفّر الإجابة المعروفة سلفاً على سؤال الأكثرية مع مَن، أو بالأحرى مِن مَن. الفرضية الأساسية للتيار الإسلامي هي الصفة الإسلامية الماهوية لمجتمعاتنا، وهو ما يتمخّض عن شيئين:
أولهما أن الأكثرية التي تقيسها صناديق الاقتراع هي الأكثرية الأهلية أو الدينية في مجتمعاتنا، والصندوق ليس غير وسيط سلبي لتحويل الهوية إلى أكثرية، والكيفية إلى كمية، وهو يصادق على ما هو معروف سلفاً، وليس امتحاناً غير مضمون النتيجة؛
وبما أن الأمر كذلك فإنه، ثانياً، لن تكون أية أحزاب أو تيارات أخرى أكثر من مجموعات ثانوية، موقعها في أحسن حال يحاكي موقع أحزاب ’الجبهة الوطنية التقدمية‘ في النظام الأسدي تحت قيادة ’حزب البعث‘ المفترضة للدولة والمجتمع. ولعلها تمثل هويات جزئية في المجتمع، «مِللاً»، تُقرّ بالدور القيادي المهيمن للحزب الإسلامي السنّي، الواحد تعريفاً. ومثلما تتحول «هوية الأمة» إلى أكثرية سياسية، يُفترض أن يتيح هذا التصور الإجرائي للديمقراطية تحويل «الذمية» إلى تبعية سياسية، و«المِلل» المعترف بها إلى أحزاب ملحقة. هذا تخريج عصري لنظام الملل، لا تقوم الديمقراطية فيه بغير دور شاهد زور على نفسها.
وبما أننا نتحرك في فضاء الهوية الثابتة، فإن هذا الوضع لا يبدو قابلاً للتغيّر. الحزب الإسلامي ليس حزباً يفوز مرة ويخسر مرة، بل هو يفوز دوماً، وينبغي تكييف الإجراءات الديمقراطية لضمان ذلك. وبما أنها مجرد إجراءات لا شخصية لها، فهي تقبل التكييف بسهولة.
الذاتية هنا والفاعلية هي للأمة، المعرّفة بالإسلام، والديمقراطية إجراءات شكلية، يُنتظر منها أن تعكس هوية الأمة واستمراريتها. والحرية هنا هي ليست حرية الإفراد، بل التحقق السياسي لماهيتنا الحقيقية، الإسلام.
الشعار العام هنا هو الإسلام هو الحل.
تصور العلمانيين الثقافوي
التصور الثاتي للديمقراطية هو التصور الثقافوي. الديمقراطية ثقافة هنا وليست مجرد إجراءات، وهي نتاج التنوير والحداثة والعلمانية والإنسانية…، وهذه تحولات تاريخية لا نستطيع أن نأخذ نتائجها ونترك مقدماتها، فإما أن تؤخذ كلاً أو تُترك كلاً. ومشكلتنا ليست في التعبير عن مجتمعاتنا كي تُحل بصندوق الاقتراع، إنها بالأحرى في تكوين مجتمعاتنا ذاته، أو بالأحرى في «صندوق الرأس» كما يقول جورج طرابيشي. أي في محتوى رؤوسنا و«نسيج عقليات»ـنا على ما يقول المثقف السوري نفسه.
من أجل الديمقراطية يجب أن تتغير عقلياتنا ونتخلص من «القدامة» و«الأصولية». العلمانية واجبة قطعاً.
وبينما يميل التصور الإجرائي للديمقراطية إلى تصور أن الاستبداد في مجتمعاتنا هو نتيجة غربة الحكام عن «الأمة» وتبعيتهم للغرب، يميل التصور الثقافوي، بالعكس، إلى أن الاستبداد هو تعبير عن تقليدية ثقافتنا وعن الذهنية الدينية. المشترك بين التصورين هو تفسير الواقع الاجتماعي والسياسي بالعقائد والأفكار.
ولا يُجيب التصور الثقافوي عن كيفية حدوث التحول الثقافي الذي يجعلنا أفضل تأهيلاً للديمقراطية، لكنه عند جورج طرابيشي يقترح حرمان الأميّين من التصويت في أية انتخابات حرة محتملة، وهو اقتراح يناسب ثقافة الفاشية، وليس «ثقافة الديمقراطية» (وهو عنوان الكتاب الذي نشر فيه طرابيشي نظريته عن «صندوق الرأس» أول مرة). والرجل يُلحّ على العلمانية بشدة، مفهومةً كجملة من قواعد مراقبة الدين والمجموعات الدينية ومنعها من النشاط السياسي، دون اهتمام يُذكر بنظام الحكم والأوضاع الاجتماعية والقانونية والاقتصادية… ما يفضي إلى جعل كل شيء آخر غيرَ مرئي في مجتمعاتنا، عدا الدين ودوره في الحياة العامة.
أنصار تصور الديمقراطية الثقافوي السوريون، مثل أدونيس وعزيز العظمة وآخرين، ليسوا متشدّدين في العداء للإسلاميين وحدهم، لكنهم على خصومة شديدة ومنفعلة مع معارضي النظام العلمانيين أيضاً. يوصفون بـ«الديمقراطويين»، أو «الشعبويين».
وموقفهم العام متعالٍ على الحركة الاجتماعية ككل، ومتنزّه عن العمل العامّ والصراعات الواقعية، وتوبيخي حيال المعارضين للنظام الذين لا يعرفون حقائق الأمور بقدر ما يعرفها الثقافويون.
وبينما ينسب الإسلاميون الذاتية إلى الإسلام، لا تصلح العلمانية التي يبشّر بها الثقافويون أساسا للذاتية لأنهم هم أنفسهم لا يعطونها مضموناً إيجابياً، يكتفون بجعلها رقيباً متجهّماً على محاولات الدين الإغارة على الفضاء العام. لعلهم لذلك بالذات وجدوا أنفسهم أقرب إلى نظم الحكم القائمة. يحتاجون إلى ذات، وليس لديهم سند فكري وقيمي إيجابي لظهور ذات مستقلة.
الشعار العام هنا هو «العلمانية هي الحل» (وهو عنوان كتاب للمثقف المصري المرحوم فؤاد زكريا).
تصور الديمقراطيين السياسوي
تصور الديمقراطية الثالث هو التصور السياسوي. المشكلة وفقاً لهذا التصور هي في الاستبداد، والحل هو النضال السياسي من أجل الديمقراطية، أي الانتخابات الحرة التعددية التي تتمخض عن أكثرية سياسية متغيرة. الديمقراطية هنا ليست مسألة إجراءات وصندوق اقتراع، ولا مسألة ذهنية وصندوق رأس، بل هي مسألة صراع سياسي واجتماعي.
والواقع أن الديمقراطية ليست قيمة إيجابية عند التيارين الثقافويين، الإسلامي والعلماني، ذاك الذي يردّها إلى إجراءات، وذاك الذي يمتعض من هيمنتها. هي قيمة إيجابية فقط عند «الديمقراطويين».
ويفترض هنا أنه إذا تخلصنا من النظم الاستبدادية، ربما تعترضنا صعوبات أمام التحول الديمقراطي، لكنها ليست من صنف مختلف عما يعرض في أي مجتمعات أخرى على الدرب الطويل نحو ديمقراطية مستدامة. وقلما يقال شيء واضح عن هذه الصعوبات، وعن خصوصيتها المحتملة في مجتمعاتنا.
والواقع أن الطابع الاختزالي للتفكير السياسوي بالديمقراطية لا ينبع من انحيازات فكرية وسياسية وقِيَمية سابقة لنشاطه السياسي، بل من أن تركيزه المفهوم على مركزية دور النظام السياسي، وهو مركزي جداً في سوريا، قاد إلى إغفال غير مفهوم للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والديمغرافية، والجيوسياسية، والثقافية من جهة؛ وإلى ضعف الانشغال بتصور مستقبلات تالية للتخلص من نظم الطغيان من جهة ثانية، وهو ما أدى إلى تضييق تصوره للسياسة ذاتها وقصرها على مسألة السلطة.
والميزة الكبيرة للتصور السياسوي للديمقراطية أنه مرتبط بالفعل بذاتية مميزة هي المنظمات والأحزب الديمقراطية، وبسجلّ معقول من الكفاح والتعرض للسجون، وحتى سقوط شهداء، ومن الأنشطة العامة، بما فيها أنشطة احتجاجية، وبانخراط أصحاب هذا التصور في العمل العام خلال سنوات ما قبل الثورة على نحو لا يقارَن بالثقافويين، ولا بالإسلاميين. الديمقراطية هنا قيمة إيجابية على نحو تصادق على الممارسة العلمية، بل هي قيمة مُعرِّفة لهذا التيار. وكان الروائي المصري علاء الأسواني يذيّل مقالاته قبل ثورة 25 يناير بما يستحق أن يكون الشعار العام للديمقراطيين: «الديمقراطية هي الحل»!
الأمر خلاف ذلك بخصوص الإسلاميين والثقافويين. فتصور هذين التيارين للديمقراطية تابع لهوية هذه التيارين وتفضيلاتهما العقدية الأساسية. ليس لدى الإسلاميين تفكير في الديمقراطية، تفكيرهم ينصبّ كلياً على الإسلام وصلاحيته الكلية الدائمة، وولاء الأمة الكلي والدائم له أيضاً. لكننا نستخلص التصور الإجرائي من نصوصهم، مثلاً من «ميثاق الشرف الوطني» الخاص بالإسلاميين السوريين (نُشر في أيار 2001)، ومن «المشروع السياسي لسوريا المستقبل» (نشر في أواخر 2004).
وبالمثل، نستخلص تصور الديمقراطية عند الثقافويين من نظامهم العام الذي يفسّر المجتمعات بالثقافة، مفهومة كعقلية أو ذهنيات، ويرهن التغير السياسي بتغير العقليات، ويخاف ويخوّف من «طغيان الأكثرية»، ولا يظهر انشغالاً فعلياً بقيم العدالة والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية.
تجربة الثورات
تجربة الثورات العربية تظهر بوضوح ما لم يكن غامضاً جداً قبل الثورات: إن التخلص من الطغيان شاق جداً، وهو بعد خطوة على درب متعرّج نحو أوضاع سياسية أكثر عدالة وحرية.
تقول تجربة الثورات إنه يمكن لإسلاميين يصلون إلى الصدارة السياسية بصندوق الاقتراع أن يجنحوا إلى أسلمة الدولة ومؤسساتها، وإصدار إعلانات «فوق دستورية» بصورة تُضعف الثقة الاجتماعية وتلغي الشرعية المتساوية مبدئياً للمجموعات السياسية الأخرى. تقول أيضاً إن التزام الإسلاميين التونسيين بالإجراءات الديمقراطية يمكن أن يكون إيجابياً في مرحلة الانتقال الديمقراطي المبكرة.
في الوقت نفسه، ظهر دعاة التصور الثقافوي للديمقراطية متحفّظين على الثورات، ومتشكّكين في كفاح الجموع، ومكتفين بالاستناد إلى ما تواجهه الثورات من مصاعب لتأكيد توجّهاتهم النخبوية المحافظة، دون أن ينخرطوا في الكفاح أو حتى في إنتاج المعرفة عن مجتمعاتنا، وهي تشهد انقلابات غير مسبوقة في تاريخها.
وبينما يرتفع الطلب على نقد الإسلاميين ومنظوراتهم السياسية والفكرية، فإن النقد الذي يوجّهه هذا التيار إلى الإسلاميين ليس تحررياً، ولا تحرّكه مطالب الحرية والمساواة والأخوة بين الناس. وهو حين لا يكون نقداً ماهوياً يعترض على هوية الإسلاميين وتعريفهم لأنفسهم، فإنه قلما يكون نقداً ديمقراطياً، يناهض المحمولات الاستبدادية والتمييزية في فكر الإسلاميين بقدر ما يناهضها في تفكير وممارسات غيرهم، بما في ذلك حين يكون الضحايا إسلاميين.
لكن رغم الهيمنة النسبية للفكرة الديمقراطية في سنوات ما قبل الثورة، ورغم أن الثورة تفجرت وتعبيراتها الأولى والأساسية تعبيرات ديمقراطية، تبدو المجموعات الديمقراطية أضعف بعد الثورة حتى مما كانت قبلها، ويبدو مطلب الديمقراطية أكثر غموضا اليوم.
ما الذي حدث؟ التيار الديمقراطي ضحية تعثّر الثورة أو فشلها. إنه القوة الأشدّ تماهياً بالثورة، وحين تلاقي هذه المصير الرهيب الذي لاقته خلال 44 شهراً الماضية، هذا ينعكس عليه أكثر من غيره.
لكن يبدو أن الثورة تشير بخاصة إلى وضع فكري غير مؤات للتيار الديمقراطي السوري، أو لمن يعرّفون أنفسهم كديمقراطيين، أعني تحديداً انفصال العمل الديمقراطي عن إنتاج المعرفة بالمجتمع. هذه نقطة تحتاج إلى تأمل خاص.
خلافا للتيار الشيوعي في جيل سبق، وللإسلاميين حتى اليوم، ليس لدى التيار الديمقراطي «نظرية ديمقراطية» في المجتمع. لم يكن الشيوعيون يدعون إلى الاشتراكية ويعملون من أجلها فقط، وإنما كانوا ينطلقون من التصور الماركسي للمجتمع، مع ما عرض عليه من تنقيحات لينينية: لدينا مجتمعات تسيطر عليها البرجوزاية التي يمكن أن توصف بأنها كمبرادورية أو تابعة أو طفيلية أو بيروقراطية أو صغيرة، وتواجهها طبقة عاملة وجماهير كادحة ومفقرة، ومهمة الشيوعيين هي توجيه سخط هذا الطبقات نحو البرجوازية وإسقاط نظامها السياسي، والتوجه نحو الاشتراكية بقيادتهم هم.
وما كان يعزّز من قوة هذه النظرية التي لم تكد تسهم الحركة الشيوعية المحلية في تطورها هو أنها تتجسد في معسكر عالمي كان مسانداً لكفاح العرب ضد قوى السيطرة الغربية.
ويصدر الإسلاميون عن نظرية في المجتمع ترى أن مجتمعنا إسلامي ماهوياً كما سبق القول، وأن الحكم فيه للإسلاميين استحقاقاً.
وبينما قد لا يكون حال الفكر الديمقراطي أسوأ من الحال الفكر الشيوعي من حيث المساهمات المحلية في تطويره، فإن القوى الدولية التي تتمثل فيها الديمقراطية لا تثير حماسات محلية قوية. في المحصّلة استنفد التيار الديمقراطي طاقته في مناهضة الطغيان والدعوة إلى الديمقراطية، دون جهد لتخيل المستقبل، ودون تطوير همّ في معرفة الواقع الراهن.
لدينا تالياً دعوة ديمقراطية، ومنظمات ديمقراطية، لكن بالكاد فكر ديمقراطي ذو شخصية. ليس هناك نظرية ديمقراطية في المجتمع تشكل العمق الفكري للتيار الديمقراطي. وهذا ما يسبغ على تصور الديمقراطية حتى عند هذا التيار طابعاً إجرائياً، مسقطاً على مجتمع مكتوم عن المعرفة. الإجرائية هي صفة أي تصورات اجتماعية أو سياسية تنفصل فيها عمليات التنظيم أو السياسة عن الإنتاج القيمي والثقافي.
نظرية ديمقراطية في المجتمع!
لكن هل هناك «نظرية ديمقراطية» في المجتمع أصلاً؟ أين نجدها؟
«النظرية» الديمقراطية في المجتمع هي المعرفة المفصلة بمجمل أبنية المجتمع، الجغرافية والسياسية والاقتصادية والدينية والديمغرافية والتاريخية والسيكولوجية والأنثروبولوجية…، إنها بعبارة أخرى الإنسانيات (التعبير الأشيع في فرنسا) والعلوم الاجتماعية (أشيع في أميركا). لقد تطورت الإنسانيات بالترابط مع دمقرطة الحياة السياسية في بلدان الغرب، ويبدو أنها متطورة بقدر معقول في بلدان مثل تركيا والهند والبرازيل بالتفاعل مع دمقرطة هذه البلدان.
المقصود في كل حال معرفة تتطور فيما يخصنا بتاريخنا الاجتماعي والسياسي، بجغرافية البلد وبيئاته الطبيعية، بوصف سكانه من حيث هيكل الأعمار وعلاقات الجنسين والريف والمدينة والتوزع الإثني والديني والطبقي، ومن حيث وصف المؤسسات العامة من الجيش إلى الجامعات، ومن الأجهزة الأمنية إلى المؤسسات الثقافية، وتاريخ الحياة السياسية والأحزاب السياسية، النظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية وتحولاتها… كل ما من شأنه أن يضع بيد المهتمين بالشؤون العامة سجلاً من المعلومات والتحليلات والمفاهيم يمكن أن يشتغلوا عليه، إضافةً أو تعديلاً أو نقضاً وتجاوزاً.
تمثيل السوريين في السياسة لا ينفصل عن تمثيل الوقائع السورية في المعرفة. وعموما تسير المذاهب التي تحتكر تمثيل الواقع أو تزعم أنها النسخة الوحيدة الصحيحة منه، تسير مع إنكار تمثيل السكان في أطر سياسية مستقلة. ومثلما تقبل معرفة الواقع المراجعة والتعديل والدحض، و«الثورة العلمية»، كذلك تقبل نظم التمثيل السياسي التغير والتحول والإصلاح، وربما التحول الجذري.
ويسجل البلد العربي الذي عرفت ثورته تقدماً معقولاً، تونس، حضوراً للإنسانيات من الأقوى عربياً، إن لم يكن الأقوى بإطلاق.
على هذا المستوى، نحن في سوريا في كارثة لا تقل عن الكارثة التي أحاقت بالمجتمع والثورة والبلد في السنوات الثلاثة ونصف الماضية. لا يكاد يكون هناك دراسات اجتماعية، أو حتى فضول للتأمل في تكوين المجتمع السوري ومساراته التاريخية ومصيره، أو حتى عمل نقدي على الإنتاج الثقافي القليل.
وذو دلالة أن الإسلاميين على عداء للإنسانيات التي تؤسس لثقافة مختلفة كلياً. وهذا ما يجعل الصفة الإجرائية لديمقراطيتهم مضاعفة: من جهة ماهوية إسلامية تسلب الديمقراطية شخصيتها، ومن جهة أخرى رفض للعلوم الاجتماعية، أي أنظمة معرفة المجتمع.
ولعل السمة الجوهرية للثقافوية العلمانية لا تقتصر على ضمور حسها السوسيولوجي فقط، وإنما كذلك نفورها من الإنسانيات لحساب ضرب من الدعوة الدينية المقلوبة. هذا مؤكد كملاحظة بخصوص الثقافويين السوريين، والأرجح أنه ليس بالأمر العارض. إنه متصل بتكوينهم كدعاة تنوير وحداثة.
في غياب تفكير منظم بأوجه الحياة الاجتماعية، ماذا نجد؟ نجد من جهة دعوات إيديولوجية تعرض نزوعاً نرجسياً، يتمثل في الثناء على الدعوة وأصحابها، ونجد من جهة ثانية الأهواء الشخصية المحددة اجتماعيا بهذه الدرجة أو تلك.
ولعل مما أضعف الثورة السورية وساقها في مسارب مخصوصة، منعزلة عن الكفاح العالمي، ضمور إنتاج المعرفة المواكب لها، وضعف إنتاج وتوضيح القيم أيضاً. كان لدينا فعل كبير جداً على الأرض، ومقابله فعل معرفي وقيمي محدود ومتناثر. وبينهما فعل سياسي ليس عاجزاً عن تنظيم الفعل على الأرض فقط، بل هو عاجز عن تنظيم ذاته. واللافت أن غير قليل من المثقفين فضلوا العمل بأدوات سياسية كسيحة، على العمل كمثقفين منتجين للوضوح المعرفي والقيمي.
وليس للقوى العلمانية التحررية من ميثاق جامع غير نظام علماني للمعرفة والقيم، كما يمكن أن يتجسد في الإنسانيات. الإيديولوجيات لا تجمع كما هو ظاهر، والعلمانية ذاتها كأيديولوجيا لا تجمع. الإنسانيات علمانية بطبيعتها، ولذلك يخاصمها الإسلاميون. هذا لأنها تكشف الدنيوي والبشري والتاريخي والمتحول وراء المقدس والمتعالي والثابت والنهائي. وهي بذلك تقيم حد المعرفة على المعتقد الديني، ولكن كذلك على العلمانية كمعتقد، وعلى الثورة أيضاً.
فوق أنها تحررية، الإنسانيات ثورية لذلك بالذات.
وهي ثورية جداً في حالتنا السورية اليوم. ليس لأنها فعل معرفي وقيمي لا يكف عن التطور والتجدد، ولكن كذلك لأن ولادتها مشروطة بنقد جذري للسلطة التي تمنع التقصي العام المستقل، وكذلك النقد الجذري للأيديولوجيات المحافظة، الإسلامية والثقافوية، ومؤهلة لإخراج التصور السياسوي للديمقراطية من مأزق ضيق الأفق السياسي.
هذا فوق أنها مؤشر على ظهور فاعل جديد وانضباط جدي، انضباط بـ«الموضوع»، وظهور ذات جديدة تنظر في نفسها وتعمل على وعي إشراطاتها الذاتية كشرط لوعي الموضوع. الإنسانيات مواثيق معرفة عالمية أيضاً، وهي تقترن بتنامي عالمية المجتمع (دنيويته وانخراطه في النقاش والتفكير العالمي)، وليس ديمقراطيته وحدها. وهي تصلنا بالعالم الذي يقطع صلتنا به الإسلاميون، والطغيان. وليس هناك قضية تحررية اليوم إن لم تكن عالمية.
ما عرفنا من عقائد منذ استقلال بلداننا يؤسس لأحزاب وتيارات أيديولوجية، ولانضباط بالعقيدة (يُنتج مناضلين)، وربما لمثقفين منعزلين (حزب مكوّن من فرد واحد، على غرار عبد الله العروي، وكثيرين غيره)، لكن ليس لظهور فاعلين علمانيين منضبطين ولمعرفة تتطور.
الإنسانيات هي الوعي الذاتي لمجتمع يتعلمن. وميزتها في النهاية أنها معرفة من تحت، وهي لذلك ديمقراطية. فيما العقائد والأيديولوجيات معرفة من فوق، وهي مضادة للديمقراطية في تكوينها الناجز هذا حتى حين تدعو إليها في مقالها.
موقع الجمهورية