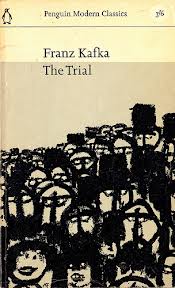من مسالخ الخراف إلى غبطة الراعي
سليم بركات
منذ توليك، يا غبطة الراعي، مقاليدَ الحضور السماوي في هِبة الأرض كيانياً، خامرني أن أكتب إليك شكوى سوريٍّ من خَبْط الحقائق. تأخرتُ. كان صديقي الشاعر الكلداني و. هرمز، الذي أدين له بتنضيد ما أكتب، على سفرٍ طويل فانتظرتُ أوبته. تأخرتُ. لكن يشفع لي أنني لم أستطع نسيان الأمر، ولن أنسى، كسوريٍّ، مسترجعاً من الوقت استهلالَ المستدْرَك المسيحيِّ، قريباً من الشكِّ، أو بَعْدَه: Quo Vadis (إلى أين أنت ذاهبٌ؟).
سأسوِّل للكلمات استتباعاً غريباً، توطئةً لرسالتي – رسالة السوري إليك، بالتذكير أننا دخلنا عام “الثعبان”، وفق تقويم ملَّة أرض يأجوج ومأجوج الأولى – أُمة الصين الحُوْص العيون، على أنقاض عام “التنين” المنصرم، من غير أن يأخذ التنين معه نفْثَ النار. سأسوِّل للكلمات استتباعاً طريفاً بتعريف الإنسان كَوْناً لم يبق بابٌ إلا فتحه للترَّهة، حتى “مطايا الجن”. وكي لا يكون استهلالي هذا متاهةً في القراءة، منذ رَكْلة كلماته الأولى، أجيز عَرْضاً خلْطاً من الواضح في “مصادر بكركي”، عن زيارتك “اللاسياسية” إلى عرين الأسد، ومن الواضح في تصريحك الواضح أن لا شيء يعدل إهراق قطرة دم. وقد أمزج مثاقيلَ الواضِحيْنِ باستعراضي أعوامَ الثعابين، والتنانين فُصِّلَتِ المداراتُ على كمائنها الأبراج، كي أنتهي بها، جميعاً، إلى مصبٍّ في معنى “مطايا الجنِّ” أوردتُه غامضاً على ما مُلِئت بها التصانيف بإضافاتٍ، أو تنقيصاتٍ، حتى احتكرها “حيوان” الجاحظ في متنه.
أين كانت “الكلمة”؟ – هو سؤال الغدر بالإيمان نستعيذ منه مُذْ كانت الكلمةُ وكان الله. لكن، في تنكيل الألم بالوجود، والاستغراق في تبويب الموجِع، يتعذر، أحياناً، لجمُ صرخة الشكِّ – الشكوى حاصلاً من الحيف لا يُطاق، يا غبطة البطريرك الجليل. لا تراجُعَ حتى لو جرَّدَنا الألمُ من اليقين سلخاً. سنقف مع “الكلمة”، التي لم يشأْها اللهُ أن تظلَّ غماماً من مرايا الأسماء تُعرَّفُ وتُعرِّف، فأرسلها جسداً هو جسده على صورة خيالنا الذي نحن فيه كما نُرى؛ وأوغل اللهُ أبعد فعلَّق الجسدَ إلى خشبة بجوارحَ نهبٍ للدم، من طوق الشوك الحديد إلى مسامير تثبيت القدمين صلباً.
أما من شيء يعدل إهدار قطرة دم، يا غبطة الراعي؟ لا يوافقك تاريخ “تكليف الجسد”، في اللاهوت، ما رأيتَ منه في تاريخ الناسوت بأرض سوريا. ثمَّة ما يستأهل أن يُسْتَحْضَر الدمُ. وإنْ رأيتَ، في العظة بدمشقَ الجرحِ، كراهةَ العنفِ مسلكاً إلى تغيير، فما يظنّ “تلخيص” التاريخ في قدموس الأمم، والمُعْتَقَد، ومُحْدَث الأمم والمعْتَقَد، إلاَّ أنَّ المسيحية أسَّستها حروبٌ لِتَدوْلَ، وأسست الحروبُ الإسلامَ لِيَدُوْل؛ وقِسْ، يا غبطة الراعي، على أشبار الدم يُقاس بها خلاصُ الأرواح في الأرض، لتصعد إلى السماء مختارةً عن طيب خاطرٍ إلهيٍّ بعد ترويض الأرض ذبحاً.
أنت لا تريد، يا غبطة الراعي، عنفاً إكراهاً بـ”عون الخارج” مسلكاً إلى تغيير، بل “سلاماً” إكراهاً على قدْر هوى “الداخل” بأهل الداخل. لكن ما يظنّه التاريخُ، في الكثير العميم من حاصله، قد لا يوافق “الأماني”. فالمسيحية عادتْ عُمرانَ معتقَدٍ من “هندسة” الخارج إلى الداخل، ووسَّع الإسلامَ وَسَاعةً “قَدَرُ الخارج” في تكلُّف الإخضاع والنشر. نحن، أيضاً، لا نريد حريةً على “ظهر دبابة” الغريب (بتكرار الجملةِ النفاق). لا نريد عودةً لأحد إلى بستانه المحترق في دبابة الأجنبي أو حقيبته. لكنْ يتحصَّل، يا غبطة الراعي، في تاريخ “المجد الشعريِّ” ذاته ما لا يُسْتَنْكَر (لن أستعرض أمثلة من تاريخ المسيحية، وتاريخ الإسلام استقوى الداخل فيه بخارجٍ على كراهةٍ، أو يأساً من خذلان العدل). فالسيد امرؤ القيس، أبو الشعر ممجَّداً، ارْتَثَّ النعالَ وشقَّها سيراً إلى الروم ليغالب بهم، فيُرجِعوه ملكاً إلى أرض أبيه على ظهر دبابةٍ بعيرٍ، أو فيل، لولا أن سُمَّ. وما في علمي، يا غبطة الراعي، أن معلوماً من النقد، أو مفقوداً مجهولاً، عيَّر أبا الشعر العربي – صَحَّ وجوده، أو كان تلفيقاً من جراءات المنحول القوية، بطِلابه غلبةَ الغريب على الأهل. وما في علمي، أيضاً، يا غبطةَ الراعي، أن تلميحاً في وعظك أُمةَ سوريا حضّاً على طاعة الولي بمحاورته، أفشى ذرةً من علمك بوجود “الغريب” سنداً لمقام الوالي الحاكم وغلبةً له على العامة. كان الإيرانيُّ في الصدر من مرمى بصرك إلى “رعية” سوريا. لم يحضر القسُّ باولو – صديق السوريين، الذي طُرِد، بل حضر القائم بانتداب خامنائي على بيروت ودمشق، وحضر التنين الروسي – طائراتهُ ببراميل من مصانع حرس الجحيم المذهبية، مدوِّمةً بمدافعةِ الأمِّ فيها عن الأرثوذكسية على باب دمشق. أم لم تسمع، يا غبطة الراعي، طائرات القتل في استحسانك اسمَ ذئب سوريا فصفَّقتَ له قويًّا، مُذْ أراك من الأمان في “بيته”، بقوة حرس طائفته، وحرس الفرس، فحجب عنك أشباح تسعين ألف قتيل، وملايين المشردين، وألوف الأسرى؟
يستطيع ذئب سوريا، يا غبطة الراعي، أن يدرِّب لضيفٍ كريم مثلك حجرَ الشارع ضاحكاً بتعازيم السحر الأبيض من نيرنجات البعث، ونيرنجات الأمن – العائلة. يستطيع “الإطمئنان” المدرَّبُ كفرُّوج مدرَّب رقصاً على صاجٍ محمَّى، أن يستنطقك عظةَ “الإصلاح” طلباً يكفي شعبَ سوريا (!). أإصلاحٌ بعد الزلزال الهول، يا غبطة الراعي؟ ما”الإصلاح”؟ سمعنا، نحن السوريين، قهقهةً في عظتك السياسية كقهقهةِ البراميل المبتَكرة بإلهام من “آيات الله” في ترويض الأمم. سمعنا في الحروف عن “الشأن الداخلي” عويلَ خيام المشرَّدين في شتاء تركيا، والأردن، والعراق، ولبنان، قرب الحِفاف الأخيرة من حزن الله، يا غبطة الراعي.
“الشأن الداخلي”؟ (!). كان القائم بانتداب خامنائي على سوريا ولبنان أمامك، في الصف المشرف على كلمات العظة مشمولةً برعايته، وإلاَّ كنتَ خرجت من صفِّ العظة إلى شرفة الشعب لم تبق من دولته سوى ما يستحصلُهُ “الكَرَم” الإيراني للأسد من دولةٍ بمالٍ للذبح، وفِرقٍ قنَّاصة للذبح؛ وما يستحصله السلاحُ الروسي للأسد من دولةٍ بمال الإيراني، وبـ”احتيالات” ابن خامنائي الجديد في العراق على مال العراق، وسماء العراقِ، لرفد “العرين” في دمشق بكيلوسِ حلفِ المذهبية.
إن كان على السوري أن يبقى “شأناً داخليّاً”، فلماذا تكون، أنتَ، يا غبطة الراعي، سندَ روح المسيحي السوري في حِلْفِ إذْعَاره من شريكه المسلم؟ لماذا البيعة لقاتلٍ في حماية المسيحي؟ ممن؟ أليس الأوجب أن تحميه مواطنيَّتُه كغيره، ويحميه، حُكمُ العدل فيه؟ مصانعُ الفكرة المبتذلة، أوَّلَ الثورة السورية بلا سلاح، من إعلام أساورة البعث، إلى إعلام أكاسرة الفرس العمامات، وأباطرة الكرملين. الخوف، الزمع، الفَرَقُ المستطار، ليس إلاَّ ما يحمله الإيراني من جبهة نصرته إلى الحليف المذهبي، سعيراً لتقويض الجماعات في سوريا نزاعاً. حليفُ الذئب السوري – الأسد، الذي ترى أن تتدبَّر “حظيرةُ” الداخل السوري للخراف أوجُهَ “رحمةِ” الذئب بها، هو الذي ابتكر عبقرية الخوف منذ ظهور إيران الإسلامية. لقد عرفنا، في مطالع حفظ السياسة للعدل، أو الإستنباء بأفكار العدل، قيامَ دول بنشر مُعتَقَدِها في تغيير الجماعات، يساراً ويميناً، على أن يكون الجذب إلى منهجها شاملاً للمجموع لا لفِرَقٍ بعينها: مناهج في الحرية الفردية، ومناهج في المشاعية، ومناهج في حكم الطبقة الأمّ للمقاليد، ومناهج في التشاركات، على تطابقٍ جامع، لكلٍّ منها، في رغبة تحصيل الأعمِّ من الأمم إلى خزْنة وحيها، بوعد الرخاء والرفاه.
إيران استثناء، في زعمي. لم يعد تأويلُ المصالح نفْعاً، وسياسةَ نفْعٍ، وإدارةً، وعمراناً، وصلاحاً عدْلاً، ليتسع وصفاً في غاية وجودها. بناءُ الشرحِ لن يقوم إلاَّ على علمِ نفسٍ جمعي: دولة من علم النفس، لا من السياسة. دولة تقود “رفاه” بنيها المحتمَل، بخزْنة مال الله فيها من نفط، إلى فقدان الدجاج على الموائد، قذفاً بسفن الأسلحة إلى تقويض المجتمعات. همُّ نفْسها إقامةُ “كونٍ” ألمٍ من أساس البناء على التكفير عن إثم من جناية الأسطورة، وهدْرُ منافع ملَّتها على حروبٍ حيث تقْدِر أن تنتج حروباً في أرضٍ، بتوسُّلِ الخيال الجمعي لعقلها الناظم مذهباً إلى “تطهيرٍ” منتظرٍ من شرِّ الذنب، أو محنة الإثم. دولةٌ من علم النفس البيمارستانيِّ قيامُ الرضا فيها أن يعمَّ الضررُ الآخرَ ليعمَّ اغتباطها، ويعمَّ التقويض ليعمَّ انتشاؤها، ويعمَّ البلاءُ لتستشيطَ متعةً كـ”قضاء الوطر”. دولةٌ حسْبُها من “القربى” المذهبية والتابعُ ـ آمينُ حتى انتحارها.
قِوامُ الدولة هذه إلقاءُ بزرتها حيث يصلح إنباتُ الخصومة، وفَقْصُ التناحر. لم توفِّر جاراً أقرب، أو أبعد، بدسِّ حرس “ثورتها”، وحرس مالها شغَباً. أنزلتِ المالَ الهدْرَ منزلةَ “جزية” تدفعها عن نفسها الشقية لتعميم “الشقاء” مذهباً بنكبات من حصادِ كربلاء كونية. أوْهَتِ الهيكلَ حتى كاد أن ينهار على مجتمعها سعياً إلى إلهيَّةٍ نووية قد تختصر بها طريقَ الجحيم.
حرسُ هذه الدولة، المنتدبون على لبنان ، يعيشون ـ يا غبطة الراعي ـ إلى جوارك رعاةً لشأن السياسة، والإمامة في توجيه صَلاة دولتك. منذ أُحكمتْ حيلةُ اختزال المدافَعة عن أرض سليبة، في لبنانك، إلى استبدال احتلالٍ إسرائيلي مدنَّس باحتلالٍ إيرانيًّ مدنَّس (المفاضلة لا تستقيم، هنا، إلاَّ على دَنَسٍ)، تعيش رعيَّتُك في ظلِّ عمامة المعتمد الوالي – الحزب الصلف، الأول في تاريخ “الشراكة المجتمعية” تباهياً بحماية من يغتالون الأهلَ الشركاء، ورعايةً للوعيد بذبح الخصوم ذبحاً دلالاً.
لم تقُلْ، يا غبطة الراعي، للحزب الإيراني في بيتك، أن يوقف دفع فِرقَ الموت إلى سوريا. قتلةٌ يؤججون الكراهيةَ لهم ولأنصارهم من مسيحيِّي “الجنرال” الهارب من الأسد. لم نسمع عظةً لك في شأن بلدك المحتل ظاهراً وباطناً، يا غبطة الراعي. بلدك ليس معافىً حيثما أدرْتَ تخصيصَ المعافاة على جارحةٍ فيه. لبنان تحت وصاية الوليِّ الفقيه بأمره تدوم النعمة للساسة وتُحتجب، وبأمره يُعدَم المتمردون على وصايته ووصاية سلاحه، وتُفتح الحدودُ وتُغلق للنازح السوري، الذي عضَّ بعضُكم على كرامةِ إكرامه نازحي حرب الولي الفقيه ـ المدبِّر تعجيلَ الحروب وتأجيلها في دارك، لا في داره. طائراته الإلهية بلا طيارين هي التي تحدِّد مسافةَ السماء الواجبة لأرواح “الشهداء المُحْتَكريْنَ” عبوراً، يا غبطة الراعي. أيلهمُك مسيحيُّ سوريا عظةَ “الهمِّ” على وجوده معافىً بخيال معتَقَده، ويخفى عليك الإرثُ المدمِّر استحدثتْهُ آلةُ المال الإيراني وسلاحه، على أشبار من صرح مقرِّك الجليل يكاد يحمل إليه، أو إلى صروحٍ تجاوره، مملوكُ الأسد سلالَ وردٍ متفجِّرٍ هبةً تُغبِطُ مدَّاحي الأسد على حماية المسيحي؟ أخوفك على المسيحي في سوريا؟ وماذا عن السوري الآخر، يا غبطة الراعي؟ أعليه قبولُ أبديةِ التوريث للحاكم إرضاءً لقلقك على المسيحي، يا غبطة الراعي؟
لقد اتخذتَ من المجريات السورية موقفَك المُعلن في صور الكلمات، والمُضمر في الحروف قبل استوائها كلماتٍ، مُذْ تولَّيتَ إمامةَ حلم الروح المسيحية بسعادةٍ في الله. حقُّك، كراعٍ من تكليف الروح الأعظم للملَّة، أن تتوجه بقلبك حيث ترى المسيحيَّ على الأحفة الدموية، أو حِفاف الحريق. وعليك، أيضاً، كراعٍ “في الله” الذي “هو الوحدة”، بحسب لايبنيتز، أن تلتفت إلى المُتَنَشَّأِ الأصل من إرث العلة، وحاصل المعضل الشقيِّ، حيث أوكلَ الأسدُ الأبُ الدولةَ إلى حِذْق التأصيل للقلَّة الطائفة في شأن الكوافِّ والعوامِّ من ملة سوريا، حتى استقرت رعايةُ “حقيقتها” دولةً على عائلةٍ برباطِ الحزب الديني لا ينحلُّ، أو ينفَلُّ، عن جَدْلِهِ من إيران الشيعة.
نضج “النشيد” الطائفي في ظلِّ نشيد البعث يُلقى صباحاً “تكريماً” للحياة، أكثر من أربعين عاماً (غدا بعض الأطفال فيها أجداداً). ذلك كان سماد الخوف، وسماد الكراهية، يا غبطة الراعي. ذلك ما أنَّقَ الفزعَ من الدولة إلى الشيطان، وأنَّقَ الفزعَ على المصلحة بالدولةِ الشيطانِ. فإن ذهبَ جنرالٌ لبناني (هارب من الأسد إلى الأسد)، قبلك، إلى سوريا، فاجتمع له، دفعاً من مناكبهم، خوارنةٌ وراهبات، في “بيعة” فقيرة، مضحكة، فما هو بفاتح، نكايةً من الأسد بالبطريرك الجَسور مار نصر الله بطرس صفير، طريقَ الشرق “السريع” لتمثيل المسيحية. أُوْهِمَ فعاد ملتهبَ الخيال الركيك بادِّعاء “حضانة” الظلِّ الكبير للصليب الشرقي بلا تحديد في امتداده (من لبنان إلى الصين، في الأرجح). وَهَا طُويَ الهُمرجانُ بالجنرال، الذي أعيد، بعد هزيمته، موعوداً بالرياسة، فلما خُذِل نَقِمهَا من كل خاذلٍ حتى تمجيد قتل المغتالين، وتحريض حزب إيران إلى “حسم موقفه” في تسليم الدولة، بقُضِّها وقضيضها، إلى عمامة الولي، مع حفظ الرياسة شكلاً لقبعته ـ قبعة الهارب، وذلك يكفي ثأرَه.
في العُرف أن المهزوم العسكريَّ “هزيمة نكراء”، حتى العار، يجرَّد من لقبه، وتمزَّق الأوسمة “النياشينُ” الرِّفعةُ عن كتفه وصدره بالمقصِّ إهانةً. لكن ذلك لا يستقيم في “الشأن الشرقي”: وزير الدفاع، الأسدُ الأبُ، هُزم في حرب مع إسرائيل فارتقى شأنه، بانقلاب، إلى رئيس “خالد”. الجنرال اللبناني هُزم، تاركاً خلفه رمزَ دولته – القصرَ للقاهر البعثي، وآل بيته أيضاً، هارباً بجلده. غفر له المنتصرُ فأعاده مُلحقاً، بوعْدِ رئاسةٍ خَوَلٍ من خَوَل الولي الفقيه، وتوريثٍ كراهيةٍ أصالةً عن الولي الفقيه ضد السُّنة على أشنع ما تحتمل الكلمات من عُريها، بأخلاقٍ من السمِّ الغاريقوني، مع تبشير بعنصريةٍ أين منها الكفرُ ضد السوري، والفلسطيني.
لم “توبِّخ”، يا غبطة البطرك، همجيةَ التنكيل بعلائق المجتمع من أمثال الجنرال الهارب، متضرِّعاً إلى حربٍ يأكل فيها حزبُ إيران كلَّ لحم. لكنك “وبَّخْتَ” من يرون، من السوريين، أنَّ الدم تكليفٌ بالحرية. و”زجَرْتَ” كي يرتدعوا عن “الخارجي” (الذي لا يشمل حُكْمُ توصيفه مالَ إيران، وقادةَ حرسه على جبهات حمص ودرعا، وسلاحَ الروسيِّ “القذر” استحدثْنا له النَّبذَ باللقب أسوةً بالأميركي القذر أيام فيتنام، وأوباما القذر اليوم)، وسألْتَهم أن “يخفضوا الجناحَ” لـ”حوار” مع مطايا الجن.
الأميركي يقايض الإيراني على انسحاب من أفغانستان بالنفوذ الإيراني في سوريا. يقايضها على البرنامج النووي – تخفيفاً من مزاعم الإسرائيليِّ استهوالَ النوويِّ – بحصار المُدَافع السوري عن نفسه طلباً لسلاحٍ، وبالحرية لسلاح روسيا يسوِّي المدنَ بالأرض. خسرت أميركا، بقذارة خططها لأهل العراق أرض العراق هِبةً لإيران، وها هي، بركالة المبالغة الكافرة في شأن “جهاديِّي” سوريا، تُطمئِنُ الإيرانيَّ، والروسيَّ، إلى لامزاحمةِ على دوريْها (حتى كتابة هذه المقالة). سَيْرٌ بمقايضات من الدم السوري على خسارة في العراق، وفشلٍ في أفغانستان. أمْ يزعم الأميركي أنه يستنزف إيرانَ في سوريا؟ إنه يستنزفها من جراح السوريين، يا غبطة الراعي كاستنزاف الأسدِ الدولةَ أرضاً وسماءً، تهويلاً بمصير المسيحيِّ، إذا انقضَّتِ “النَصرةُ” على الهيكل.
كيفَ ائتلفَ جَمْعُ هذا “الخوف” على المسيحي ومن ليس سُنيًّا، من دياركم إلى ديار العراق، حيث مزاعم ابن خامنائي – المالكي أن رحيل وحش سوريا هو الحرب “الكونية”؟ أكانَ وجودُ الأسد نهَّابةً في سوريا ضمانَ “نعيم” العراق متخماً برفاهةِ الآمن من فخاخ الأجساد المنتحرة، ونعمة “محو” المذهبية من سجلِّ الفرات؟ أكان وجود مستعبد سوريا الوحش ضمانَ رفاهية الحرية للسوريين يُخشى أن يُحرم منها المسيحيُّ برحيله؟ لقد جرى، يا غبطة الراعي، ترتيب التهديد رقيعاً: إما الأسد، وإما هربُ المسيحي. إما وحش سوريا، وإما الحرب من العراق إلى لبنان. إنه أمرٌ مهول لا ينتقضه أو يتنقَّصه سؤالٌ بريء: هل سألتَ رسولَ الحاكم جالساً في الصفِّ قبالة عظتك عن المفقودين المسيحيين، اللبنانيين، في الأقبية؟ لربما عليَّ إحالتك على نيتشه في “عظاته” الغاضبة طافحة من فلسفة الكفر بالغفران.
في كناشات “الترفيه الضروري” استرواحاً، والعلومِ الأصولِ من مصادر الإلهيات، أن اليربوع، والفأر، والقنفذ، والوَرَلَ، لا يصيدها الأعرابُ لأنها من “مطايا الجن”. لكنهم يصيدون النَّعام، والظِباء، بالرغم من أنها من مطايا الجن التي هي، في مقام المقاربة والتشبيه، سيارات الجن، ودراجاتهم الهوائية والنارية، يركبون ظهورَها انتقالاً بين أمصارهم الفلوات. في “الحديث” نهى رسول الإسلام “عن الصلاة في أعطان الإبل”، لأنها خُلقت من أعنانِ إبليس. والزعمُ كلُّ الزعم، بل التأييد ببراهين الصحراء، أن الحوش من الإبل هي التي سافدتْ أمهاتِها فحولُ إبل الجن. فالإبل ذاتها هي من نسلهم، ومن مطاياهم. ولربما أضفنا الشعراءَ إلى المطايا لولا خَفْضُ الإسلام بهم الرتبةَ إلى مبلغِ “كلاب الجن”، كما ورد في صحيح “الحيوان”. ولِمَ لا وهُمُ ـ الشعراءُ والجنُّ ـ على تصريفٍ في الاقتدار بالنَّظْم خطاباً؟ وقد سُقيَتِ المعارفُ الأصل بأنسابِ الأشعار أبياتاً مراقيَ ثقةً عن ألسنة الجن:
وقبرُ حرْبٍ بمكانٍ قَفْرٍ
وليس قرب قبر حربٍ قبرُ.
البيتُ منسوب إلى “دَنْهَشَ” ـ أبي الجن كآدم أبي البشر.
وأيضاً:
ومِنْ عضرفوطٍ حطَّ بي فأقمتهُ
يبادر وِرْداً من عظاءٍ قواربِ.
لم نعثر، في الأخبار الموصوفة، أن للجن مطايا من الجنسِ الإنسان. لكنْ يبقى أكيداً ـ في الأمهاتِ الجدالِ من مطالع التاريخ في الخَلق، عن الطبري، وابن كثير، ومَنْ أنسانيهِ الوقتُ ـ اتِّفاقُ العقول الأولية، ببعض الفروق، على كون ملكة سبأ بلقيس من نسل الجن، الذين لا يرقى شك إلى أنهم صنعوا القوارير، وأقاموا الحمَّامات للنبي داوود ذي المزمار. في الأكيد، أيضاً، تصديقاً على قران الجن والإنس، ما تدارسَهُ الشُّرَّاح من آية الكتاب “لم يطمثهن إنسٌ من قبلهم ولاجانٌ”، أيْ في المحتمَل، بل القطْع، وجودُ اتِّصالِ استنسالٍ، ومتعةٍ بين الجن وغيرهم بشراً وحيوانات.
لماذا أسترسلُ في ما يشبه الكشكول؟ كلمة “الحوار”، من عظتك، يا غبطة الراعي، في دمشق، نَحَتْ بي إلى شرودٍ كافرٍ من أمهات الشرود وآبائه. “حوار”؟! براميل حوار متفجرة، يا غبطة الراعي. تأسيس جيش من فِرَق الطائفة ملحقيْنَ بفرق من حزب إيران الذي في حظيرتك، يا غبطة الراعي. “حوار” بـ”سكود”، وبسطور من قتلى يرجعون إلى دياركَ فيدفنون “شهداء في مهمةٍ جهادٍ” ضد الشعب السوري، يا غبطة الراعي. “حوار” بقُوَّاد حرس خامنائي على الطرق السليبة بين دمشق وبيروت، يا غبطة الراعي ـ الطرقِ الخاصة بعتاد أمة فارس ومجاهديها ضد حلب. “حوار” من علم مطايا الجن، يا غبطة الراعي. “الحوار” اسمٌ آخر لتمجيد العبودية على طاولة القاتل. طلب “الإصلاح”، الآن، احتقارٌ لأرواح تسعين ألف قتيل، في الأرجح. “حوار” و”إصلاح”، من عظتك، تريد بهما “هداية” شعب في مسلخ، إلى استغفار القتلة عن سوء ظنه بأحكامهم الطاهرة في “تقنيات القتل”. قد تكون الأول، يا غبطة الراعي، يتوسَّل الغنمَ الغفرانَ للذئب بمعتَمَد من الوصايا: “أدرْ له خدَّك الأيسر”. الأمر، يا غبطة الراعي، ليس صفْحَ فردٍ عن إهانةِ الصفْع باستزادة الصفْع: الشعوب لا تدير خدَّها.
الشعب جسدُ الله. لستُ مؤمناً. لكنَّ كلاماً كهذا يفقهه كريمٌ في المقام مثلك. “الله هو الوحدة البدائية معبَّراً عنها في الوحدات الأخرى” ـ يقول لايبنيتز؛ أيْ: فينا، نحن البشر. كم من إلهٍ يُقتل في صورة سوري، كل يوم، ليرجع السوريون إلى طلب الغفران، أو قبول إصلاحٍ – ساطورٍ من قاتلهم؟ لا شيء يستأهل إهدار قطرة دم ـ أنتَ قلتها، يا غبطة الراعي. حبذا لو أشرت بيدك، آنئذٍ، إلى قنصلِ انتدابِ خامنائي – حاكم سوريا الجالس في صدْرٍ من مرمى بصرك، لا إلى المتمرِّد السوري على العبودية خمسين سنة. لكنها “المرآة والبزرة” مأخوذتَين على خطأٍ في التعبير، بنَسْخِهما، من قولةِ سبينوزا، إلى تصريفين في “حوار”، و”إصلاح” هرطقتين.
أهو تلابُسُ الوعي الديني بخطاب السياسة – “الوعي النفعيُّ للروحانية”؟. إنها العودة بـ”المضمون الكامن”، لاهوتيّاً، إلى معادل من “مضمون الخوف” الوضعي، يا غبطة الراعي. لربما – والغفرانُ لي إن تطاولتُ وما أنا بصانعٍ – لم تنظر إلى “الأزليِّ” في المادة كراعٍ لخيال الغفران، فألقيتَ التكفيرَ عن إثم “التمرد” على الجماعة، مُذ لم تُشِر في حواشي عظتك، أو متنها، أو هوامشها، بدمشق، إلى “مصنع الألم” للجماعة – وليِّها بسوطِ اللهب وكَلْبَتانِ الحدَّاد.
يريد البعض لنا – نحن السوريين – خلوداً للعبودية صاخباً، أو هادئاً، في “مملكة التوريث” الحديثة، لا يشبهه وصفاً إلاَّ بيتٌ من الشعر قيل، تخصيصاً، في طول عمر الشخصِ المُخاطَب:
لقد شابَ رأسُ الزمانِ
واختضبَ الدهرُ وأثوابُ عُمره جُدُدُ
شابَ الزمانُ ولم تشبِ العبوديةُ ظاهراً، وباطناً، مُذ تولى “البعث” أقدارَ حيواتنا، يا غبطة الراعي. هذا إنشاءٌ على ركاكةٍ من دَنَسِ الألم. فلْنجاوزْه إلى غرائبَ أن تُنسب حمايةُ المسيحي إلى قاتل. أحرّيةُ المسيحي عبوديةُ الآخر الشريك؟ أَسَلامُ المسيحيِّ قلقُ الآخر الشَّريك؟ ما المعنى، يا غبطة الراعي؟ ما قدسية الكلمة وشرفُ الله بإرغامٍ كهذا للحرية على قسمةٍ من قسمة الأرقام في جداول الحساب؟ أهي تجارةٌ بشرف المسيحية “المهان” تكلَّفها، مرةً، جنرالٌ هارب من الأسد إلى الأسد، جمع له الحاكم الدمويُّ خوارنةً وراهبات، فعاد إلى لبنان “مختالاً” بتمثيل الشرق مسيحييْنَ ومتنزَّهاتٍ، سوَّقه الغامزون من مقام بكركي وسيدها المقاوم البطريرك صفير؛ وتكلَّفْتَها إلى رعية من أرثوذكس دمشق، لا موارنة حلب. الجنرال لها، نعم. لكن لم نسمع صلصلةَ الموازين متناثرةً بين أقدام تجَّار الهيكل دفعَتْها يدُ الغاضب عن حقيقة الله، يا غبطة الراعي. أمِ الصامتون على عبوديةٍ يصدق فيهم قول الفارابي: “العوامُّ لا يشْكون كالخواصِّ، لأنهم تافهون في التصديق”؟ لقد صدَّقوا “حريةَ” العبودية فيهم، و”إصلاحاتِ” الذلِّ، و”حوارَ” المصالح على تجارةٍ أو حظوة. حبذا لو وقفتَ موقف “الشكِّ” لا غير، بعيداً عن “جاحديْنَ” مثلنا نعمةَ الوليِّ ابناً عن أبٍ، و”الشكَّاك أبصرُ بجوهر الكلام من أصحاب الجحود”ـ يقول الفارابي.
ما “جوهر الكلام”؟ أهو غيرُ دكِّ المدن بالطائرات، وعودة قتلى الحزب الإيراني اللبناني اللسان، في بلدك، “طاهرين” من جهادٍ ضد المدن السورية، وصولات حرس خامنائي في “محميَّاته” الإلهية، يا غبطة الراعي؟ “جوهر الكلام” ما يوقظ به الجنرال الهارب من الأسد إلى الأسد، على المنابر، في بيتك، من جحيم العنصرية، والطائفية، مدلَّلاً من حرس العمامات. أم هم حَرَسُ “الكأس المقدسة الثالثة”، وفرسانُها أقاموا للمسيحية، طحْناً لمواثيق الجماعة، في أرضك، فردوسَ العودة بالأرواح من الخنادق حول القدس إلى أجساد القتلى، تدبيراً لـ”انبعاثٍ” أين منه انبعاثُ لَعَازر؟ “كأسٌ ثالثة” من منبت الكشف على الأساطير فحْصاً كانكشاف السماء، في إيران، لصعود قرد إلى الفضاء عاد من رحلة الدعاوة غيرَ القرد الذي صعد (في الصور الملفَّقة عن علوم الفضاء الخامنائية)، وكطائرة الفقيه تقودها روحُ الخافياء غيرُ ظاهرةٍ، عُرضتْ مجسَّماً تلفيقاً من صناعات الفخر الحربية.
“كأسٌ ثالثة”، في خيال الراوية عن تاريخ الممكنات المعجزة، هي التي توارى بها يسوع، بعد العشاء الأخير، ليشرب منها، في الأعالي، إلى جوار أبيه أو جوار نفْسه. الكأس الأولى سقطت عن المائدة إذْ أنهى صلاته الصامتة مغمضاً، وفتح يديه فأصابها كُمُّ قميصه، فهوت هشيماً. الكأس الثانية مُلئَتْ كالأولى. أعطاها يسوعُ أُمَّه لترتشف رشفةً، فأمَرَّتْها أمُّه إلى المجدلية، فانزلقت من بين يديها، فهوت هشيماً. حطامُ الكأسين المفتديتين بفخَّارهما أمَّهما الكأس الثالثة، بتوثيقٍ لن يتحرى مدخلَه، أو مَخْرجَه، تقديرٌ للغايات، مُخبَّأٌ في “موضع الجحيم” ـ قبر آدم في كنيسة القيامة. أو ربما، بزعمٍ لن يتحرَّى مدخلَه، أو مخرجه، تقديرٌ للغايات، نُقِل هشيمُ الكأسين إلى جبل في سيناء – أمِّ صحراء التيه، وانتقلت من هناك إلى مراقي الجن في جبال الأحباش، تولاَّها رهبانٌ من معتَقَد المونوفيزية لم يَخَفْ آباؤها الحَرْم الكنسيَّ أسقطه مجْمَع خلقيدونة على عظام ديوسكورس – بطريرك الإسكندرية المؤسِّس، والراهب اليوناني أورتيخا.
ما شأن “الكأس الثالثة”، الموهومة المزعومة بـ”الشكوى” هذه؟ أهي كتدبير غير المسيحيين إقحاماتٍ خُلْسةً في شأن المسيحية “الداخلي” من أساطير اليقين؟ رابني، كريبة آبائكم من كل مشكوك في نسبه Apocryphaما رُويَ عن المجدلية وضعت منديلاً مبلولاً بدمعها هي على وجه مريم البتول، تخفي عنها البرهةَ الطاحنة من نزْع ابنها. ولمَّا عادت إلى البيت، بعد الصلب، اعتصرت المجدليةُ المنديلَ في وعاء: بضع قطرات، لا كثر. اضافت إليها ماءً. غَلَتْه. جمعتِ البخارَ بقشة مجوَّفة تنشَّقتْه بها ثم نفخته في حُقَقٍ (جمعُ حُقٍّ)، وبَرَاني (جمْعُ بَرْنية). أقفلت الحققَ والبراني، التي بيعت، إذ ذاك، حتى في أسواق صور، التي انتقلت إليها من قيسارية، وبيت لحم، والناصرة، حُققٌ وبراني فيها أنفاسُ باراباس. لصٌّ افتُديَ بابن الله من حظوظ أساطير اليقين. قبل أمدٍ من صلب يسوع مرَّت به المجدلية في السوق يعرض، على المارَّة، بضاعته: من يشتري أنفاسَ لصّ بأنفاسِ ملك؟ عرْضٌ مُلْغزٌ. ما معنى أن يبيع لصٌّ أنفاسَه في حُققٍ وبراني بما يعدِلها ثمناً أنفاسَ ملك؟ سألته المجدلية:
– أأنت مجنون؟
“لا، أيتها الجميلة”، ردَّ باراباس.
– ما معنى أن يبيع أحدٌ أنفاسَه؟ ما قيمة أنفاسك؟
“ستعرفين في ما بعد، أيتها الجميلة”، ردَّ باراباس.
– هل قايضك أحدٌ أنفاسَه بأنفاسك؟
“سألتُ أن أقايض أنفاسَ ملك بأنفاسي. أنتظرُ ملِكاً، أيتها الجميلة”، ردَّ باراباس.
لقد أُرِيْتَ، يا غبطة الراعي، مُنْتَجعَ استرواحٍ، واستجمام، في هواء مقفل من هواء دمشق، حيث استتباب النظام “المروريِّ” بإدارة من “السلم العنيف” عن يد “الاستقرار العنيف”، فغلَّبْتَ “الظنَّ” بالثائرين على تغليب “القَطْع” في الجريمة، فهوَّلتَ خروج “الدم” على العبوديةِ المُخْمل. “قطعية الدلالة” مصطلحاً في الأحكام، وفي التشريع، وفي الفُتيا الصحيحة السند قياساً، لم تُلْفتْكَ ببراهينِ الصور تراها، كلَّ يوم، لهاربين بأطفالهم من الطائرات في الأعراء إلى مطاحن الأرواح والعظام. أمْ رأيتَ في الثائرينَ “حِرَابةً” هي خروج فرقة على الجماعة “المستقرَّة”، الآمنة؟ ما الخمسون السنونُ خَلَوْنَ من “حرابة” الحاكم في حرية الناس، وتوارثهم خرافاً في الحظائر الحديد؟ ربما علينا أن نستخبر أنتيسثينيس Antisthenes مُطارحاتٍ في السخرية، أو تغليب الوجودِ الطبيعةِ حدًّا بين “الظنِّ” و”القطْع” على مذهب الكلبية Cynicism، يا غبطة الراعي.
ويلٌ للمغلوب (Vae victis). تلك صرختُنا.
النهار