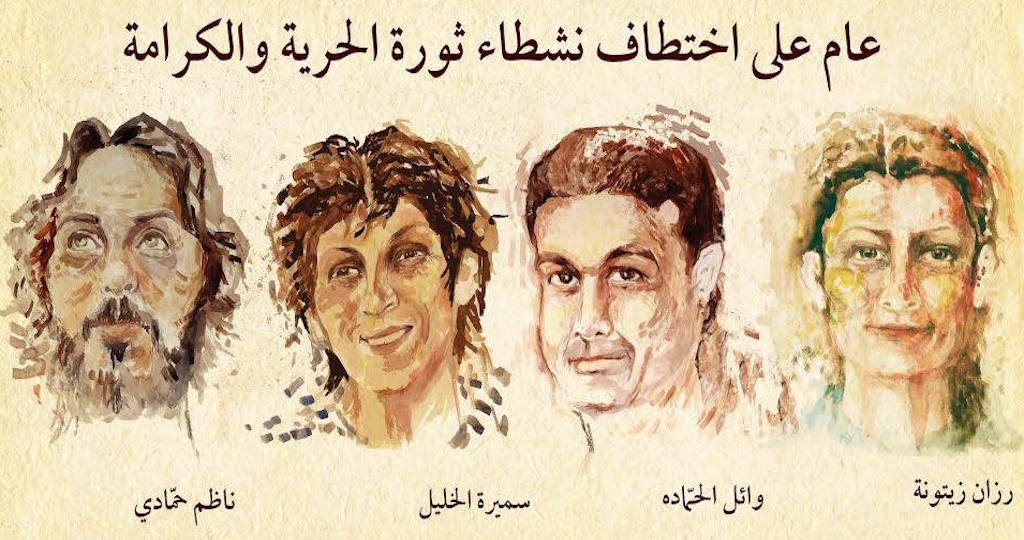مهجرو سوريا: العالقون في الفراغ/ عمر قدور

أن يشير بعض التقديرات الأولية إلى تدمير ما يقارب الأربعة ملايين بيت في سوريا فهذا ليس رقماً مجرداً، ويعني فيما يعنيه أن أزمة النزوح التي بدأت دول الجوار بالتشكي منها ليست سوى جزء من أزمة أكبر لا يرى العالم بقيتها المخبأة في الداخل بعيداً عن الإعلام، وبعيداً عن المنظمات الدولية الإنسانية. التقديرات الأولية أيضاً تشير إلى أن ثلث سكان سوريا أصبحوا لاجئين أو نازحين في الخارج والداخل، وباتوا في طليعة الأزمات الإنسانية العالمية بحسب تقارير الأمم المتحدة. ومرة أخرى لا توجد جهة قادرة على الإحاطة بأبعاد الأزمة لعدم القدرة على الوصول إلى كافة المناطق السورية أولاً، ولأن الوضع الميداني المتحرك يجعل الأرقام عرضة للتغير طوال الوقت تالياً.
منذ سنتين تعاطى السوريون مع مسألة النزوح القسري على أنها ذات طبيعة مؤقتة، ولم يكن النظام حينها قد أمعن في التدمير الممنهج للمناطق السكنية والبنية التحتية، لكن الوضع تفاقم أخيراً على صعيد الخراب لينذر بأن حل المشكلة سيأخذ سنوات طويلة، حتى إن توقف التدمير في القريب العاجل. فالآن ثمة مناطق عديدة دُمّرت بالكامل وهُجّر سكانها تماماً، مثلاً بلدة خربة غزالة في درعا وعدد سكانها نحو 25 ألفاً نزح سكانها جميعاً، ودمرتها قوات النظام. مدن مثل داريا ودوما في ريف دمشق، وأحياء بأكملها في مدينة حلب، لاقت المصير نفسه. الذين نزحوا من المناطق المنكوبة إلى مناطق قريبة منها اضطر قسم كبير منهم إلى النزوح ثانية إثر اندلاع المعارك في مناطق نزوحهم أيضاً، وهناك عائلات كثيرة نزحت للمرة الثالثة أو الرابعة خلال سنة أو أقل.
في المعارك الأولى، وعندما كانت قوات النظام تنجح في اقتحام منطقة محررة واستعادتها، كانت تصوّر الأمر على أنه عودة للأمن والأمان إليها، وخدمة لهذا التسويق الإعلامي لم يكن الاقتحام مصحوباً بتدمير جديد. إلا أنها منذ نحو سنة صارت تتعمد تدمير ما تبقى من تلك المناطق بعد اقتحامها، أي أن نهج النظام راح يرتكز على إبقاء السكان خارج مناطقهم وعدم العودة إليها كنوع من العقاب الجماعي. أحياء مثل الإنشاءات وباباعمرو في حمص سُوّيت بالأرض في أثناء المعارك وبعد انتهائها، وفقد أهلها أمل العودة إليها تماماً، حي الخالدية الذي وقع مؤخراً تحت سيطرة النظام دُمّر بالكامل أيضاً، ومن المرجح أن تلقى كافة أحياء حمص القديمة هذا المصير ليصبح غالبية السكان بلا أمل في العودة.
قد تتباين النسب مؤقتاً، فنحو 80% من سكان “درعا البلد” نزحوا منها، أما نسبة النازحين من “درعا المحطة” فتصل إلى نصف النسبة السابقة. ومن المعلوم أن أحياء درعا البلد تُعدّ مهد الثورة السورية، لذا كانت عُرضة لتنكيل أكبر. وحيث إن الأوضاع الميدانية في محافظة درعا عموماً تشهد كرّاً وفرّاً دائمين بين الجيش الحر وقوات النظام، يبقى الواقع الاجتماعي والسكاني متأرجحاً، فالمحافظة برمتها شهدت أكبر نزوح إلى الأردن، حيث يلاقي اللاجئون ما بات معروفاً من شظف في مخيم الزعتري في الأردن. بعض النازحين، احتجاجاً على ظروف العيش في المخيم، عاد إلى سوريا ليلاقي الحصار والتجويع من جديد. جدير بالذكر أن درعا أول مدينة تتعرض لحصار تام من قبل قوات النظام، ذلك الحصار الذي منع عنها تماماً الأغذية والأدوية وحتى حليب الأطفال، ثم في وقت لاحق تم التخفيف من إجراءات الحصار ما سمح بنزوح بعض العائلات إلى مدن أخرى في طليعتها دمشق، لكن الحصار عاد من جديد ليطبق عليها وليمنع تواصل عدد كبير من العائلات التي أصبحت موزعة بينها وبين دمشق.
الحصار لا يقتصر على حركة البشر أو دخول البضائع فحسب، هو حصار شامل. فالمحاصيل الزراعية التي كانت تُسوّق من درعا إلى دمشق لم يعد مسموحاً لها بالعبور، ما يُضطر الآن بعض المزارعين إلى بيعها لتجار كبار يستطيعون تهريبها إلى الأردن، مع أن الأخير كان سابقاً يورّد المنتجات الزراعية للسوق الدمشقية، أي أن مزارعي درعا محكومون بالبيع بأسعار زهيدة ليتمكنوا من المنافسة في السوق الأردنية. ولأن المحاصيل الزراعية تكاد تكون الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة الدولة، مع قلة المنشآت الصناعية أصلاً وتوقف الموجود منها عن العمل، صار تدمير المزروعات وحرقها في الحقول سياسة معممة لقوات النظام، بعد أن كانت تقوم بإتلافها على الحواجز المنتشرة بكثافة بين المدن والبلدات؛ ذلك لا يقتصر على درعا فقط بل هو نهج يشمل كافة المناطق الساخنة أو المحررة.
اللافت للانتباه في هذا السياق أن النظام لم يقطع رواتب الموظفين عنهم نهائياً، فسكان المناطق الشرقية من محافظة درعا (مثل معربة وبصرى) لا يزالون يقبضون رواتبهم من مدينة السويداء المجاورة؛ هذا لا بد أن يقتصر على الموظفين غير المطلوبين من مخابرات النظام، لأن التنقل بين المحافظتين يتطلب المرور بحواجز أمنية تدقق في وثائقهم وتُعرض المطلوبين للاعتقال. حتى في “درعا البلد” لا يزال الموظفون الذين لم تُعرف عنهم معارضة النظام يقبضون رواتبهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البلدات والقرى المحررة الأخرى، حيث يتم إرسال الرواتب عن طريق وسطاء! وبما أن الإدارات الحكومية مشلولة، وبعضها قد دُمّر أيضاً، يُطلب من الموظفين إثبات وجودهم ولو أسبوعياً من أجل المحافظة على رواتبهم.
في الواقع لم يوقف النظام صرف الرواتب لموظفي المناطق المحررة حتى الآن، كنوع من العقاب الجماعي أيضاً، باستثناء مدينة الرقة التي يُشاع أن النظام سيعود إلى صرف رواتب موظفيها بعد انقطاع. ففي القسم المحرر، وهو الأكبر من مدينة ومحافظة حلب، يلتزم الموظفون بإثبات حضورهم دورياً (كل أسبوع أو كل شهر مرة) ليحصلوا على رواتبهم، على رغم أن غالبية المؤسسات لا تعمل بما فيها المؤسسات التعليمية والخدمية والقضاء. هذا التساهل من قبل النظام سيكون مفهوماً عندما نشير إلى أن عدد الموظفين الحكوميين في سوريا يزيد على الأربعة ملايين، ويشكل القطاع الحكومي الثقل الأكبر في سوق العمل، ويكاد يحتكر قطاع الخدمات العامة بأكمله، لذا يتحاشى النظام تعزيز النقمة فلا يلجأ إلى هذا النوع من العقاب الجماعي. من جهة أخرى رأى النظام دائماً في الأجور التي يدفعها سبيلاً إلى شراء الولاءات الصغيرة، وقطع الرواتب عن المعارضين الأفراد الآن هو استمرار لتلك السياسة وإيحاء بأن من يقبضون الرواتب في المناطق المحررة يدينون له بالولاء، مع أن أغلبهم يصنّف ضمن ما يُعرف بالفئة الصامتة التي لا يمكن الجزم بموالاتها.
من المؤكد أن دفع الرواتب لا يرتّب عبئاً كبيراً على النظام، لأن القيمة الحقيقية لها مقارنة بالعملات الأخرى انخفضت إلى الخُمس خلال سنتين، أما القيمة الشرائية فقد انخفضت إلى أكثر من ذلك. يتضح هذا أكثر في المناطق التي تعاني من حصار خانق، فالغوطة الشرقية لدمشق محاصرة منذ تسعة أشهر؛ الحواجز التي تحاصر مدنها وبلداتها تلقي القبض على المعارضين وتسمح بمرور الآخرين، إلا أنها تمنع بتاتاً عبور أية مادة غذائية وعلى رأسها الخبز أو الطحين. في مثل هذا الوضع البائس، الذي يعاني منه نحو مليون شخص، لا يبقى من قيمة حقيقية للنقود بسبب عدم توفر السلع المطلوبة، أو الارتفاع الضخم جداً لأسعارها بحكم ندرتها. جدير بالذكر أيضاً أن قوات النظام تقوم بقصف ممنهج لمناطق الغوطة، حيث دمّرت كافة البنى التحتية والمنشآت الصناعية، ولم تنجُ المزروعات من القنابل الحارقة.
مناطق محررة قليلة جداً نجت من الكوارث التي ألحقها النظام بمثيلاتها؛ مدينة يبرود مثلاً لم تخضع للقصف المستمر الذي تعرضت له المناطق الأخرى، ويمكن وصف حالها بالاستقرار النسبي لذا لم تشهد حركة نزوح ملحوظة من سكانها. على العكس، استقبلت يبرود نازحين من مناطق أخرى مثل الرستن وتلبيسة، ولأهلها دور ملحوظ في إغاثة منكوبي المناطق القريبة وجرحاهم. عموماً يمكن وصف وضع يبرود بالاستثناء على عدة أصعدة، فتحرير المدينة أبقى على المؤسسات العامة فيها كما كانت من قبل، ولا يزال أغلبها يقوم بعمله المعتاد من دون اصطدام بين الجيش الحر والنظام. أما الإدارة المحلية للمدينة فهي إدارة مدنية بالكامل، وقد أصدرت في بداية شهر تموز/يوليو تعميماً تمنع فيه المظاهر المسلحة من البروز في المدينة، وثمة متسع للناشطين المدنيين ليقوموا بمشاريعهم، وهناك أيضاً مشاريع صغيرة تُعنى بتشغيل اللاجئين جنباً إلى جنب مع إغاثتهم. ربما تكون يبرود النموذج الجيد للمناطق المحررة الأخرى، فيما لو أتيح للأخيرة قدر قليل من الاستقرار بعيداً عن قصف قوات النظام.
على العموم، ومن دون إطلاق أحكام نهائية، تبدو المناطق التي شهدت حراكاً ثورياً مبكراً الأقرب إلى تقديم نموذج مقبول من الإدارة الذاتية؛ يتجلى ذلك حتى في التجارب التي لم يُقيّض لها الاستمرار بفعل اقتحام قوات النظام. مناطق مثل الزبداني في ريف دمشق أو خربة غزالة في درعا كانت تتجه إلى اقتراح حلول محلية للإدارة بعيداً عن المركز؛ في الزبداني قام الأهالي بانتخاب مجلس محلي مدني، بديلاً عن مجلس المدينة السابق المنتخب صورياً برعاية النظام، وكان المشروع المعلن للمجلس يؤسس لإدارة لامركزية متطورة تقوم على المبادرات الاجتماعية وعلى مبدأ التشاركية؛ هذا ربما ما عجّل باقتحام قوات النظام للمدينة، بالإضافة إلى وقوعها على خط إمدادات حزب الله لقوات النظام في دمشق. في خربة غزالة تم إنشاء إدارة ذاتية بالتوافق، عمادها مجموعة من شباب البلدة، وعلى رغم وجود بعض المتدينين بينهم إلا أنها كانت بعيدة عن الطابع الأيديولوجي، عيّنت الإدارة رئيساً وعناصر في مخفر البلدة من أجل ملاحقة السارقين، وأمنت عمالاً للفرن الآلي الحكومي الموجود فيها، بالإضافة إلى توزيع الإغاثات وتوزيع مازوت التدفئة شتاء حسب الأولويات التي بدأت بالمرضى، لكن التجربة أُجهضت مع اقتحام قوات النظام للبلدة ونزوح كافة أهاليها.
على العكس مما سبق كانت التجارب التي قدّمتها مدن أصبحت فجأة محررة، من دون أن تشهد حراكاً ثورياً ضخماً يمهد للتحرير، فمدينتا حلب والرقة على سبيل المثال كانتا تشهدان حراكاً متواضعاً من حيث العدد، وقبل نحو سنة من الآن كان إعلام النظام يجزم بموالاة حلب، وفي عيد الفطر الأول الذي تلى الثورة ذهب رأس النظام ليصلي صلاة العيد في الرقة إشارة إلى اطمئنانه من جهتها. يمكن الجزم بأن حلب والرقة شهدتا أسوأ حالات الفوضى إثر التحرير، وشهدتا أيضاً أسوأ انهيار للمؤسسات القائمة، وحتى أسوأ حالات السرقة لها من قبل كتائب تُحسب على الثورة. في الرقة مثلاً تم الاستيلاء على مبلغ 7 مليارات ليرة من المصرف الحكومي المركزي، ولم يعرف مصيرها أبداً. هذا مؤشر فقط على حال الفوضى التي سادت المدينة إثر التحرير. أما في حلب، التي يعدّها البعض العاصمة الصناعية والاقتصادية للبلد، فإن حجم التجاوزات أكبر من أن يحصى. إحدى الجهات التي شاركت في تحرير المدينة (جبهة النصرة)، مع أن مشاركتها لم تكن أساسية، سارعت إلى الاستيلاء على مخزونات حكومية أساسية في طليعتها مستودعات المطاحن الحكومية، وعلى رغم فرح أبناء المناطق المحررة بتوفر مادة الخبز بعد انقطاع إلا أن أحداً لم يسائل تلك الجهة عن مصير الأرباح التي حصلت عليها من بيع الطحين الذي هو أصلاً ملك عام. بعض المعامل الحكومية في حلب فُككت وبيعت خارج الحدود، والحراسة التي فُرضت على المعامل الخاصة تراخت فيها بعد ما أدى إلى سرقة قسم منها أيضاً. أحد الألوية تشكل على وجه السرعة واستولى على منطقة صناعية أخرى، وفرضت قيادته أتاوات كبيرة على أصحاب المعامل بذريعة حمايتها من السرقة. الإدارة المحلية لمدينتي حلب والرقة تسلطت عليها الكتائب المتطرفة من خلال ما يُعرف بالهيئة الشرعية، وهي هيئة غير منتخبة تمارس صلاحيات القضاء بموجب اجتهادات شرعية غير ممنهجة، ما أتاح المجال واسعاً لانتهاكات وتجاوزات عانى منها ما تبقى من السكان بعد النزوح.
لقد قدّمت الهيئات الشرعية أسوأ نموذج للمناطق المحررة، بل راحت تمارس تجاوزات النظام نفسه، وتزيد عليها من حيث التدخل في أساليب العيش الخاصة، من دون أن تقدّم نموذجاً محترماً في ضبط الأمن والسيطرة على الفوضى. بالإضافة إلى تدخلها “الشرعي” في خصوصيات العيش راحت الهيئات الشرعية تعتقل المواطنين المخالفين لها أيديولوجياً، ووصل بها الأمر إلى اعتقال شخصيات معروفة بنشاطها المعارض، وكأنها تتنافس في هذا المضمار مع دولة العراق والشام الإسلامية “تنظيم القاعدة” التي برزت إلى الواجهة مؤخراً. التنافس ذاته بدأ يبرز على صعيد المنافسة في التشدد الديني، وفي استعراض القوة على الأرض من خلال هيمنة الأقوى على المؤسسات الحكومية و”الغنائم”، وأيضاً في خطوة تذكّر بما درج عليه النظام من احتكار للفضاء البصري العام راحت هذه القوى تتنافس في كتابة شعاراتها الدينية والتنظيمية على الجدران، ما يُعدّ في أغلب الأحيان اعتداء على حرية المواطنين وتحذيراً أو وعيداً لهم إن خالفوا التعليمات.
لقد تبخرت الوعود التي قدّمتها الكتائب المقاتلة بتسليم السلطة في المناطق المحررة إلى هيئات مدنية منتخبة أو مُتوافق عليها، هذا ما حصل في حلب والرقة، بالتزامن مع شيوع الفوضى وانعدام الأمان. من بقي من السكان يعاني مرارات متعددة، فقوات النظام لا تتوقف عن استهداف المدينتين بالقصف العشوائي عن بعد، والخدمات شبه معطلة مع عدم وجود هيئات جديدة تشرف على إدارتها أو صيانتها عند اللزوم. العكس من ذلك حصل أحياناً، فإحدى كتائب السرقة استولت أخيراً على معدات وتجهيزات حيوية من مؤسسة المياه في حلب، هكذا في وضح النهار، ما ينذر بانقطاع المياه عند أدنى خلل. في مدينة حلب أيضاً، وبعد المثال الجيد الذي قدّمته بعض الكتائب المقاتلة في حرصها على الأملاك الخاصة بعيد التحرير جاءت الفوضى لتتحكم، وانتعش اللصوص العاديون الذين لا يجدون رادعاً أمامهم، فالبيوت التي سلمت من التدمير أُفرغت محتوياتها ولم تجد العائلات العائدة إليها ما يساعدها على الإقامة من جديد، وتحمل المستوى المتدني من الخدمات العامة بالإضافة إلى ذلك.
الوجه الإيجابي ربما في المناطق التي تهيمن عليها النصرة وأخواتها أن نسبة لا بأس بها من السكان الباقين لم تخضع تماماً، بل لعل التجارب المدنية الحقيقية التي غابت أيام سيطرة النظام تبدأ بالتشكل الآن. ثمة إجراءات أو قرارات اتخذتها الهيئة الشرعية في حلب وتراجعت عنها بضغط من الأهالي والنشطاء، وثمة قرارات مماثلة أيضاً تراجعت عنها الهيئة الشرعية في الرقة، إلا أن مجمل التجارب المدنية لم يصل إلى حد تطوير مفاهيم مدنية للإدارة، أو إلى حد القدرة على ممارسة الإدارة المدنية رغماً عن الكتائب المتطرفة. هذا عامل لا يشجع النازحين من أبناء هذه المناطق على العودة، والأمر لا يتعلق فقط بالجانب الأيديولوجي، فهو مرتبط أيضاً بحال الفوضى التي تجعل العودة والعيش الطبيعي
من الصعوبة بمكان.
من المحتمل أن الريف والمدن الصغرى “شبه الريفية” قد شكلت صمام أمان نسبياً لحركة النزوح الداخلي، خاصة مع وجود نسبة لا يُستهان بها من سكان المدن ذوي الأصول الريفية القريبة. الأرياف، التي يصفها البعض بأنها خزان الثورة، ولأنها أصلاً عانت من تهميش النظام، تمتلك مرونة أكبر في العيش بعيداً عن المركز. بسبب من اكتفائها الذاتي على صعيد السلع الضرورية تستطيع الأرياف والمدن البعيدة استيعاب حالات الحصار بما يفوق قدرة المدن الكبيرة، وتستطيع إغاثة المناطق القريبة على الصعيد الغذائي، مع تدني مقدرتها من حيث القدرة على الاستيعاب العمراني للوافدين. حركات النزوح كانت إلى المدن الكبرى أولاً، فدمشق وحلب استقبلتا الموجة الأولى من نازحي حمص، قبل أن يضطر أهالي حلب إلى النزوح. الرقة في ما بعد تحملت عبئاً يفوق طاقتها من النازحين، قبل أن يواصلوا مسيرتهم، إثر تحريرها، إلى الشرق والشمال قاصدين الحسكة والقامشلي، وهي مدن تسيطر عليها قوات الحماية الكردية بموافقة من النظام.
لفهم الواقع السوري الحالي لا بد من الإشارة إلى احتكار النظام لكافة المناحي الاقتصادية والخدمية العامة، وضمن هذا الفهم قامت قواته في العديد من الحالات باستهداف البنية الخدمية المملوكة للدولة أو بتعطيلها تماماً. خدمات مثل الكهرباء والماء والاتصالات أضحت بمثابة وسائل ابتزاز وضغط يستخدمها لإخضاع المناطق الثائرة أو للتأثير على معنويات السكان فيها. في الجهة المقابلة لم يمتلك بعض الكتائب المقاتلة الفهم الكافي للتمييز بين مؤسسات الدولة والنظام، ولم تجد الأولى من يدافع عنها بقوة ويحرسها بوصفها ملكاً عاماً للمجتمع، الأمر الذي أفقد المناطق المحررة جزءاً من قدرتها على الصمود وتوفير مقومات الحد الأدنى بعيداً عن تحكم المركز. على المستوى نفسه، لم تبادر تشكيلات المعارضة إلى اقتراح حلول وبدائل إدارية للمناطق المحررة، وباستثناء أعمال الإغاثة التي لا يعلو قسم منها عن شبهات الفساد لم تُصرف أموال بقصد إعادة تأهيل الخدمات العامة وإدارتها مجدداً. سيكون مؤسفاً القول هنا بأن تحرير بعض المناطق بقدر ما كان إضعافاً لهيبة وقوة النظام فإنه كان إضعافاً لصورة المعارضة، وهذا ما بدأ النظام بإدراكه مؤخراً ليزيد من استهدافه البنية التحتية وليوقعها في مزيد من العجز والارتباك.
حتى الآن لم تصل معاناة المهجرين إلى ذروتها، مع أن آخر تقارير الأمم المتحدة يشير إلى وقوع ثلث السوريين تحت خط الفقر وحاجة نصف هؤلاء إلى الإغاثة العاجلة. ما ساعد شريحة واسعة من النازحين على الصمود هي مدخراتها التي تتضاءل يوماً بعد يوم، فالمناطق الآمنة في سوريا تعاني اكتظاظاً غير مسبوق، والنازحون إليها، كما الأمر بالنسبة إلى المستأجرين القدامى، مضطرون إلى دفع إيجارات تفوق إمكانياتهم الحقيقية فقط من أجل العثور على مأوى. ما يُصرف على الإغاثة غير كافٍ لمعالجة أوضاع الشرائح البائسة الحالية، وستتفاقم الكارثة مع تدني المستوى الاقتصادي لشرائح أخرى قريباً. ما قيل في البداية عن روح التضامن والتكافل بين المناطق السورية أصبح رومانسية لا تمت إلى الواقع مع التدهور الاقتصادي الذي ينال من الجميع، وليس مستبعداً أن تصبح المناطق الآمنة مرتعاً لاضطرابات اجتماعية بين السكان الأصليين والوافدين بسبب الضائقة التي يعيشها الطرفان وانعدام الأمل في حل قريب يعيد النازحين إلى أماكنهم.
هو اقتلاع شامل لا هجرة مؤقتة؛ لعل هذا هو الوصف الأدق لحال المهجرين في الداخل والخارج. أغلبهم بات يدرك هذه الحقيقة من دون حيلة لمواجهتها، وطالما لم تتوافر الإرادة الدولية للحل في سوريا فإن اقتلاع الجذور المكانية والاقتصادية سيستمر، مرفقاً بملامح التطهير الطائفي في بعض المناطق. في الواقع لم تعد إرادة الحل كافية، ما لم تكن مدعومة بتمويل ضخم يعيد توطين المهجرين في مناطقهم الأصلية، ويعيد لهم أسباب الحياة، على أن تتم إعادة الإعمار هذه المرة بشكل يمنع أي سلطة مقبلة من احتكار أسبابها.
Kalamon: http://www.kalamon.org
كلمن