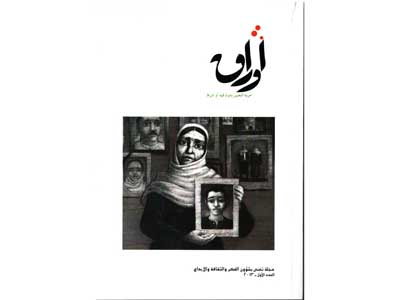موتيفات محمود درويش/ صبحي حديدي

في سنة 2012 نشر الباحث والأكاديمي الفلسطيني حسين حمزة، من مجمع اللغة العربية في حيفا، ورئيس قسم اللغة العربية في كلية دار المعلمين هناك عملاً فريداً في طرازه التأليفي، وبالغ الفائدة لقارىء محمود درويش (1941ـ2008)، الذي مرّت ذكرى رحيله السادسة يوم التاسع من آب (أغسطس) الجاري. وأعترف، في امتنان عميق للصديق حمزة، وعرفان بالجميل أيضاً، أنني ـ ومنذ أن تكرّم بإهدائي نسخة من كتابه، سنة صدوره ـ لم أتوقف عن العودة إلى فصوله وأقسامه، ليس لأنني أظلّ بحاجة ماسة إلى فوائد الكتاب العميمة، فحسب، بل، كذلك، وأساساً، لأنّ تقليب صفحاته كان متعة في ذاتها، معرفياً وجمالياً.
الكتاب عنوانه «معجم الموتيفات المركزية في شعر محمود درويش»، ومقاربته تنطلق من أنّ تجربة درويش الشعرية ترتكز على «محاور أساسية تنعكس في المكان، التاريخ، الأسطورة، الدين، الأدب والرموز الذاتية، التي أبدعها لتصبح دالّة عليه وعلى معجمه الشعري» كما يقول حمزة. المنهجية بسيطة، وذات فاعلية عالية في الآن ذاته: اعتبار أوّل، عماده الحضور الكمّي للرمز والموتيف (وهذا، في يقيني، يشمل الموضوع، والموضوعة، والغرض…)، بصرف النظر عن تبدّل الدلالات بين قصيدة وأخرى، واعتبار ثانٍ، ينهض على الحضور النوعي، الأمر الذي يساعد أيضاً على تلمّس سيرورات التطوّر في تجربة درويش.
والجداول التي يستخلصها حمزة في الكتاب تفيد بأنّ موتيف الموت هو الأكثر حضوراً في جميع مراحل درويش الشعرية، ضمن ارتباط مع موضوعات أخرى مثل الشهيد والمنفى والاغتراب، ولهذا فإنّ دلالته تغيّرت عند درويش: «من تمجيد له في مراحله الأولى، إلى تصوير مأساة الموت الجماعي، ومن ثمّ إلى محاورة الموت في المطوّلة الجدارية، وتحميل موتيف الموت دلالات إنسانية وكونية». الأكثر تكراراً، بعد هذا ـ وعلى امتداد المجموعات، من «عصافير بلا أجنحة»، 1960؛ إلى «لا أريد لهذي القصيدة ان تنتهي»، 2009 ـ هي موتيفات الأرض، والاسم، والبحر، والذاكرة. وهنالك، بالطبع، موتيفات تكررت في مرحلة، ثمّ غابت عن مرحلة لاحقة، وأخال شخصياً أنّ بعضها انتقل بالمفردة الأمّ إلى نطاقات تعبيرية أرحب، وأعقد، وأكثر ثراءً.
والحال أنّ دراسة الجداول هذه، في الاعتبارين الكمّي والنوعي، توفّر معطيات دراسية ثمينة، كما تثير أسئلة نقدية شائكة لا تبدو بديهية إلا للوهلة الأولى. على سبيل المثال، ما الذي يجعل موتيف «القدس» يغيب، نهائياً، عن مجموعات درويش الخمس الأولى، طيلة عقد كامل بين 1960 و1970؛ ثمّ يظهر، بقوّة (12 مرّة!)، في مجموعة «أحبّك أو لا أحبّك»، 1972؟ ولماذا، في مثال ثانٍ، يحضر موتيف «القصيدة» في جميع مجموعات درويش، باستثناء «محاولة رقم 7»، 1973، و»أعراس»، 1977، رغم أنّ المجموعتين اتصفتا بنزوعات تجريبية طاغية، حول فنّ الشعر تحديداً؟ أو، في مثال ثالث، لماذا غاب موتيف «بيروت» عن المجموعات التسع الأولى، ثمّ ظهر في المجموعات الخمس اللاحقة (1977 وحتى 1986)، وعاد فغاب نهائياً حتى رحيل درويش؟
تلك أسئلة لا يطرحها حمزة في كتابه، بالطبع، لأنها ليست من وظائف المعجم كما شاء تصميمه، وللقارىء، أسوة بالدارس، أن يستنبط خلاصاته الشخصية، على نحو حرّ، وذاتي أيضاً، بادىء ذي بدء؛ ومتحرّر من المسلّمات المسبقة، والأحكام القطعية، ثانياً، وتفاعلي مع النصّ، وإبداعي في فهم الإحصائية، ثالثاً. هنالك، إلى هذه المستويات الثلاثة، حقّ إغناء المعجم بموتيفات أخرى كثيرة لم يُدرجها المعجم، لأسباب شتى لا صلة لها بتواني المؤلف عن الخوض فيها، وإنما لأنّ النصّ الدرويشي عباب عظيم زاخر، حمّال الكثير الكثير من العناصر والعلاقات والدلالات والرموز. فإذا كان حمزة قد صنّف موتيفات الحمام والسنونو والهدهد، فهل هذا يجحف بالدوري والحسون والغراب، وبالمثل، هل يطمس أنهار النيل والفرات وبردى، ومدن بغداد وعدن ودمشق…؟
وليسمح لي الصديق حمزة أن أختم هذه التحية، في ذكرى صديقنا الكبير الراحل، بواحدة من دمشقياته الأحبّ إلى نفسي، هذه القصيدة/ الموشح، التي لا أجد حرجاً في القول إنّ دمعات ترقرقت في عينيّ درويش حين تلاها للمرّة الأولى، وكانت محض مسوّدة يومئذ، سنة 1993، في بيته الباريسي: «أمرّ باسمكِ إذْ أخلو إلى نَفَسي/ كما يمرّ دمشقيّ بأندلسِ/ هنا أضاء لك الليمونُ ملحَ دمي/ وههنا وقعت ريحٌ عن الفرس/ أمرّ باسمك، لا جيشٌ يحاصرني/ ولا بلادٌ، كأني آخر الحرس/ أو شاعر يتمشى في هواجسه».