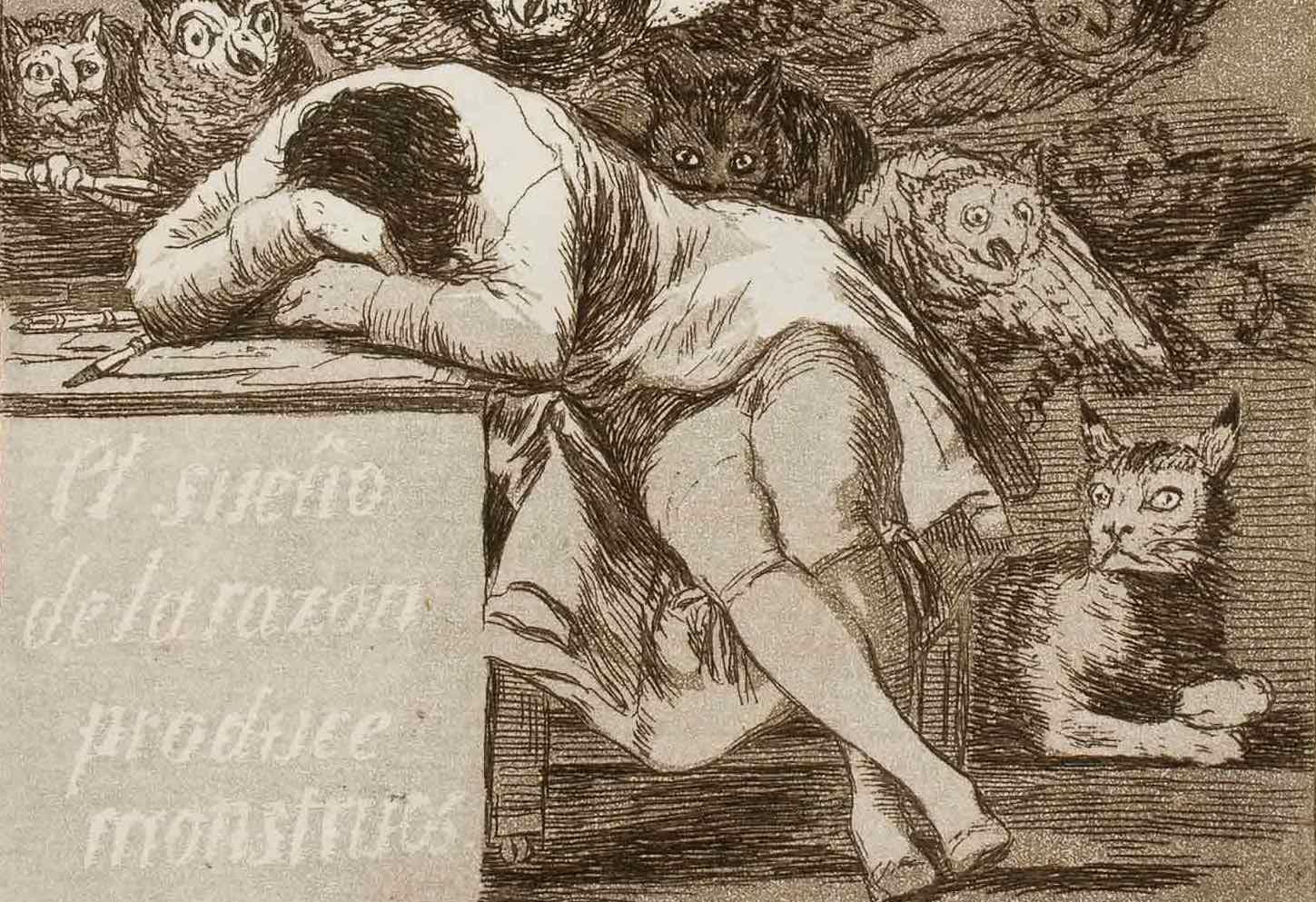ميدانية القاهرة- (مقدمة)

حسان خالد شاتيلا
بعد دقائق معدودات من سقوط الديكتاتور مبارك،
قال متظاهر من ميدان التحرير، وكان يجيب على سؤال
وُجِّه إليه من أحد الصحفيين لمعرفة ما ستنتهي إليه
ثورة 25 يناير: إن الجماهير تراقب الجيش.
مجهول
هاهو نمط الإنتاج الرأسمالي وقد وضع إحدى يديه بيد نمط الإنتاج الآسيوي، وأمسك بيده الأخرى بالاستبداد الشرقي، يجتاح شوارع تونس ومصر قبل أن ينتقل إلى غيرها من شوارع المدن العربية، حيث يَختلط أصحاب الدخل المحدود، والعمال، وشرائح واسعة من الطبقات الوسطى، فقراءً، وجُوَّعا، ومرضى، والعامة من عاميين وعوام على اختلاف انتماءاتهم، من عرب ومعاصريهم عبر التاريخ، البربر والأكراد -حسب لغة ابن خلدون – إلى المسلمين والمسيحيين بشتى مذاهبهم وفرقهم. وهاهو الشارع بحركته الاجتماعية التي ما تزال تقف عند عتبة العفوية الثورية، فإنها، بالرغم من أنها لم ترقَ بعد إلى مستوى التنظيم الثوري، إلا أنها تعيد بناء الطبقات والأمة في ما هي تعيد في الوقت نفسه السياسة إلى الجماهير، بعدما كانت الطبقة الحاكمة وأجهزتها القمعية وإيديولوجيتها البورجوازية، فَصلت ما بين الجماهير والسياسة لتحتكرها لنفسها بفضل أسلحتها الإيديولوجية القمعية من قانون، ودستور، وسلطات، وحالة طوارئ، ومحاكم، وأجهزة قمعية، ترتدي تارة لباس رجال القانون، وتكشف عن نفسها تارة أخرى برداء الأجهزة الأمنية، المخفية والمكشوفة. فبالرغم من أن العفوية كانت هي الطاغية حتى الآن على التنظيم الثوري لثورتي تونس ومصر، فإن الطبقة والأمة عادت لتظهر كل منهما بعدما خيِّل للتحريفيين، من يساريين وشيوعيين وقوميين وناصريين، أن عهد الثورة الجماهيرية قد انتهى. فالأمة – على حد قول هؤلاء – ممزقة، والطبقات الشعبية غابت من قواميس السياسة ومفرداتها في البرامج السياسية، وأصبح تعبير “النضال” من مفردات اللغة الخشبية ومخلَّفات ما بعد الاستقلال، وفَقَدَت الوحدة العربية والأمة العربية مكانها من وثائق التحريفيين الذين التحقوا بالأممية الثانية وأحزابها الاشتراكية الديمقراطية، واعتقدوا أن الجيل الشاب منقطع عن السياسة انقطاعا كاملا من جراء القمع وفسخ السياسة عن المجتمع بيد السلطة . وباختصار، فإن تعبير الثورة توارى عن الظهور في برامجهم السياسية، وأضحت “الثورة” محرمة، ولحقت التهم خبط عشواء بكل من ينادي بالثورة ويؤكِد على دور الجماهير الثورية.
وها هنا يكمن المعنى الصريح أو العلني للثورة في كل من تونس ومصر. إنها عودة السياسة من بابها العريض، السياسة المادية ومكوناتها من نمط الإنتاج، والثورة، والجماهير، والصراع الطبقي، والدولة، والحزب، ومناهضة الصهيونية والإمبريالية، والوحدة العربية، ووحدة المعاصرة التاريخية مابين العرب والبربر والأكراد، وذوبان الفوارق الدينية بفعل من السياسة بمعناها المادي ما بين المسلمين والمسيحيين على اختلاف مذاهبهم وفرقهم. عادت السياسة بالوحدة العربية محمولةً على أكتاف الجماهير في الشوارع التونسية والمصرية. إذ إن انتقال الثورة من تونس إلى مصر ليس من عمل الدولة، ولا هو سحر يتوهَّج بفعل روح تسكن في ما وراء الطبيعة. إنها الجماهير، وقد توحَّدَت من حيث مكوِّناتها الدينية والقومية وراء المطالب الشعبية، بعدما كانت منذ السبعينات تمزَّقت، هي التي تناقلت الثورة ما بين البلدين في ما كانت الحركة الاجتماعية للجماهير تُذوِّب العصبيات الدينية والقومية. وتَراها الآن تنتقل من تونس إلى مصر، قبل أن تشتعل من جديد في غيرها من المجتمعات، كما كانت تَتَنقَّل الثورات العمالية في القرن التاسع عشر ما بين فرنسا وألمانيا في عهد كومونة باريس في العام 1871، وثورة العمال في فرنسا في العام 1848، وثورة عمال النسيج في ألمانيا.
إن الحرب الثورية ضد الدولة وطبقتها الحاكمة هي التي انتقلت من تونس إلى مصر. والوحدة القومية ما بين العرب هي التي وفَّرَت ظروفا، وإن كانت ثانوية من حيث أهميتها، مؤاتية لانتقال الثورة من تونس إلى مصر. ذلك أن التحرر من نهب العولمة النيوليبرالية للثروة الوطنية والبشرية في هذين البلدين، وهيمنة الصهيونية والإمبريالية على القرار السياسي الرسمي للدول العربية، وطموح هذين الشعبين إلى ممارسة دور ثوري في حركة التحرر الوطني والفلسطيني، وتطلع هذان الشعبان إلى الوحدة من أجل تكوين قوة قادرة على مقاومة العولمة النهابة للثروات الوطنية، ودحر الإمبريالية المُهَيمِنة على القرارين السياسي والاقتصادي، والمطالبة بإعادة توزيع الثروة، ذلكم كله هو الذي حَمَلَ الثورة في البلدين إلى تناقلها ما بينهما. هذه المكوِّنات المادية للحركة السياسية الثورية هو الذي يوحَّد في عهد هاتين الثورتين العرب ومعاصريهم بكل قومياتهم ودياناتهم في حرب ثورية واحدة، بالرغم من أن لكل من الثورتين الاثنتين خصائصها. ولولا أن المعاصرة التاريخية ما بين العرب والبربر (ومن عاصرهم من أصحاب السلطان الأكبر) لم توحِّد ما بين القوميتين في حركة واحدة بفعل من الحركة الجماهيرية، لما نجحت الثورة التونسية، ما دامت الوحدة الوطنية والوحدة الشعبية حول المطالب المعيشية والسياسية شرط ضروري لقيام الثورة. ولولا وحدة الجماهير بمختلف مذاهبهم وفرقهم الدينية لما سقط الديكتاتور المصري.
إذا كانت المطالب الاقتصادية والاجتماعية والوطنية هي التي وحَّدت كل شعب على حدا، وراء المطالب المعيشية، فإن هاتين الثورتين، في تونس ومصر، ليست مجرد ثورة ديمقراطية وطنية حسب منطق البورجوازية وإيديولوجيتها، طالما لم تَحْمِل هاتان الثورتان شعارات إلغاء حالة الطوارئ، وانتزاع الحريات السياسية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتغيير الدستور، والطعن في الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة، واحترام حقوق الإنسان، ورفع أجور أصحاب الدخل المحدود، فحسب. وإنما ارتفعت في هاتين الثورتين الشعارات المطلبية الجماهيرية ذات الصلة الوظيفية، السياسية المادية، بالجوع والفقر والأمية والمرض والعطش والأجور، يحدوها الدافع إلى تغيير علاقات الإنتاج، وإعادة تنظيم قوى الإنتاج وإسقاط النظام. وهي، وإن لم تمس بملكية أدوات الإنتاج، فإنها، إذ هي ثارت ضد احتكار رجال الأعمال وعملاء الشركات متعددة الجنسيات وتوزيع الثروات ما بين السلطة وزبائنها من جهة، والملاكين الكبار من جهة ثانية – في ما الجماهير تعاني من أبشع أنواع الاستغلال – فإن هذه المطالب المعيشية هي التي شكَّلت الحامل للمطالب السياسية، من حريات سياسية وديمقراطية، إلخ. إن الجماهير لا تطمح إلى السلطة السياسية وسلطات الدولة إلا لأنها تريد الإشراف بنفسها على توزيع الثروة وتلبية الحاجات المعيشية للجماهير وقيادة حركة التحرر الوطني بنفسها.
وتَحمل الثورتان، وبوجه خاص المصرية، مضمونا تاريخيا ضمنيا لن يظهر من حالته الضمنية إلى العلنية الصريحة إلا بعد مرور الوقت، وذلك إلى جانب مضامينها الصريحة والتي ظهرت على يافطات المتظاهرين في شوارع مصر وساحاتها العامة، وعبَّرت عن نفسها عبر حناجر المتظاهرين. وكانت كومونة باريس تحمل معها ثورة أممية، معرفية طبقية، إلا أنها لم تكشف عن مضمونها المخفي إلا بعدما كشفت عن نفسها بعدما قضي عليها من قِبَل جيوش التحالف المقدس المجتمعة بالقرب من باريس في قصر فرساي، وذلك عندما انتقل أثرها التاريخي، وهو سياسي مادي، إلى ألمانيا، حيث أكَّدت للشيوعيين والاشتراكيين أن الطبقة العاملة هي حاملة الثورة، وإليها تنتقل المعرفة التي تخلَّصت من الفلسفة والحقوق والقانون والأخلاق من حيث هي إيديولوجية بأقصى وكامل معانيها، لتصبح من جراء الثورات العمالية في أوروبا ما يُعرف بالمادية التاريخية.
ولعل من أهم هذه المضامين التي ما تزال طي ما هو ضمني أو مطويٍ في ميدانية القاهرة أن اليسار العربي والأممي سيستمد، من اليوم وصاعدا، مرجعيته التاريخية من “الميدانية”، نسبةً إلى ميدان التحرير، بعدما كان اليسار العربي، الشيوعي منه والماركسي العربي القومي، يستمد مرجعيته التاريخية من كومونة باريس من حيث هي أول دولة شيوعية عمالية، أو من ثورة أكتوبر 1917، مصدرا للوقوف على التحولات المادية السياسية للتاريخ. لقد بات بوسع الشيوعيين العرب الذين كانوا يسعون إلى صياغة طريق عربي إلى الماركسية، أن يجدوا اليوم في الميدانية دليلا يقود إلى الشيوعية العربية. وللميدانية من حيث هي مصدر لليسار يَرجع إليه لاستمداد برنامجه السياسي ومبرراته النظرية، تاريخ. ولكل ثورة تاريخها. إن القفز ما فوق ما سبقها من ثورات مهدت للميدانية اليوم، من شأنه أن يضع أقدام اليسار في الفراغ. فللميدانية تاريخ. إن الماضي الثوري لمصر هو الذي يمد ميدانية القاهرة بوعي سياسي ثوري يتيح أمامها أن ترفع بعفوية شعاراتها المطلبية، وهي اقتصادية وسياسية واجتماعية وجيوإستراتيجية،. ذلك أن للميدانية تاريخ طويل من حالات العصيان والتمرد والثورات، وقد مهدَّت إليها أيامٌ تاريخية كانت الجماهير كَتبت أسطرها في التاسع من يونيو 1967، يوم خرجت الجماهير في القاهرة مطالبة بعودة الرئيس جمال عبد الناصر إلى قيادة مصر بعدما كان أَعلن عن استقالته من رئاسة الجمهورية على إثر هزيمة الخامس من حزيران. وللميدانية تاريخ يطوي مضامينه ووقائعه طالما تأتي الثورة دوما متأخرة وراء الأحداث التاريخية التي مهدَّت لها دون أن تُعلِن عن نفسها أو تكشف النقاب عن اسمها. من هذه الأحداث التي تتداعى بصورة عفوية عبر هذه الأسطر والتي مهَّدت لميدانية القاهرة، يظهر حريق القاهرة الذي سبق ثورة 23 يوليو 1952، وبناء النظام المصري البائد لجدار حديدي من أجل تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة الثورة، وثورة الخبز، واغتيال الخائن أنور السادات، وتأميم عبد الناصر لقناة السويس وما تبعها من عدوان ثلاثي، ومعاهدة كامب ديفيد التي خرجت بمصر من السياسة العربية لتتركها بين أيدي آل سعود، والنظام العسكري الاستبدادي في سورية، والذي سحق بدوره الثورة الوطنية الفلسطينية في الأردن ولبنان، وقضى على قوى التحرر الوطني والديمقراطية الاجتماعية والسياسية في كل من لبنان وسورية، وحَرَم الأكراد المقيمين في سورية من الجنسية وهجَّرهم بالقوة إلى المناطق القاحلة.
وميدانية القاهرة التي تأتي اليوم لتجدِّد كومونة باريس، وتشق طريقا أمام ثورة مستمرة متلازمة مع الديمقراطية، طالما تتعذر الديمقراطية ما لم تلازمها الثورة، وتَسْقط الثورة ما لم تواكبها الديمقراطية، والمثال السوفييتي يدلِّل على مثل هذا التلازم، خرجت الميدانية للتو من مصر إلى تونس لتكشف أمام الجماهير مضامين من ثورتها فات عنها وعيها أثناء الثورة التونسية. ألا وهو وحدة الجماهير العربية في البلدين، واندماج العرب والبربر في تونس بثورة مطلبية واحدة.
ومن مضامين ميدانية القاهرة والتي ما تزال مطوية في سياق التاريخ، أن ثورة الميدانية لا تقل أهمية على الصعيد العالمي، وبوجه خاص الاستراتيجي ، العسكري منه والدبلوماسي، من سقوط حائط برلين ما بعد نهاية الاتحاد السوفييتي. ذلك أن هذه الكومونة الجديدة تؤرِّخ أو تسجل، من الآن فصاعدا، لما سبقها وما سيلحق بها. فإذا كانت تجدد في تاريخ اليسار العربي والأممي، فننتظر، إذن، قليلا لنرى مدى ما تحمله الميدانية من تأثير على اليسار الأوروبي والأمريكي وفي أمريكا اللاتينية بعدما تكون انتقلت من القاهرة إلى فلسطين المحتلة والعرب والأكراد والأمازيغ. هاهي القيادة الصهيونية لإسرائيل والمتحالفة مع الإمبريالية الأمريكية الأوروبية اليابانية ترتعش فرائصها خوفا من عودة مصر إلى النضال التحرري الوطني. الأمر الذي يَنتَزِع من السياسة الأمريكية، إذا ما استمرت الثورة في مصر وانتقلت من حالتها العفوية إلى الحالة التنظيمية، كل منجزاتها التي نَجَحت في اختراق الدولة المصرية منذ وفاة القائد عبد الناصر. وليس خافٍ على أحد أن الثورة الجماهيرية في ما كانت تَكتب تاريخا متجددا لليسار، وتنبثق عنها الميدانية، فإن السلطة البائدة كانت تتلقى النصائح من واشنطن. وما تزال واشنطن تُشرف عن كثب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية التي تقود شؤون مصر في المرحلة الانتقالية، وتوجهها للحفاظ على مصالحها، وللحيلولة دون انقلاب مصر على إسرائيل.
وميدانية القاهرة، شانها شأن كومونة باريس التي خرجت من فرنسا إلى العالم، ما أن وصلت إلى ألمانيا حتى مدت اليسار بمضمونها الكامن والظاهر، وهو الصراع الطبقي. ميدانية القاهرة تَخرج أيضا بالوعي الثوري من مصر إلى اليسار العربي، وبوجه خاص السوري منه، طالما ينتمي كاتب هذه الورقة الماثلة بين أيدي القارئ إلى سورية. فلقد آن الأوان، في ما يعيش اليسار العربي والأممي ميدانية القاهرة، آن الأوان لليسار في سورية أن يحمل قارورة مولوتوف تحت يافطة التحالف اليساري أو الجبهة اليسارية المتحالفة حول برنامج سياسي يعيد إلى المجتمع السوري إنسانيته، ويعطي الجماهير برنامجا يقودها بالطرق الديمقراطية إلى سلطة تلبي احتياجاتها المعيشية، وتستجيب لتطلعاتها التحررية، ويعيد لسورية جولانها، ويسترد للعرب فلسطين المحتلة. إن الأحداث التاريخية التي تتلاحق في شوارع تونس ومصر، وهي مسلحة بالمطالب المعيشية والسياسية، وتحمل يافطات مسالمة بيد، وقارورة مولوتوف بيد أخرى، وتناهض القمع والهيمنة بكل أشكاله السياسية والإنتاجية، هي التي تَخرج اليوم من مصر إلى سورية، وهي نفسها التي تملي أفكارها على أحزاب اليسار في العالم أجمع.
الشارع هو مصدر البرنامج وقوانين الممارسة السياسية وأفكارها. وما لم يَستمد اليسار في سورية برنامجه من الشارع الذي لن يلبث يوما وأن ينفجر، وإن كان يبدو الآن في حالة من الثبات، فإن التحالف اليساري المنشود، وهو المرشح لبناء جبهة يسارية مسلحة ببرنامج جماهيري، وتشييد بالتالي جبهة أوسع من القوى الوطنية والديمقراطية، سيلحق به الشلل الكامل، وهو الذي يكابد الأمرين من الشلل النصفي، لتسبقه الثورة العفوية التي تواجه دوما، وحيثما كان، خطر سرقتها من البورجوازية والطبقة الحاكمة. لاسيما وأن هذه الأخيرة هي الأقوى بما تملكه من أموال وأجهزة إعلام وعلاقات دولية. إن مسيرة الثورة ونظريتها من حيث هي الدليل بالممارسة والفكر، تَنبت حيث يطأ الحدث التاريخي قدمه في الشارع. حري، إذن، بهذا اليسار أن يضع خلافاته النظرية ما بين قوسين، كي يقرأ ما تكتبه ميدانية القاهرة من نظرية للثورة مجبولة بطينة واحدة بتراب الشارع ونبضات الجماهير. ثمة هنا لبنة واحدة مجبولة بدون تمييز بالدم والنظرية الثورية والعرق والشجاعة والفقر والجوع والمرض والأمية ومناهضة القمع والتعذيب والهيمنة الطبقية للبورجوازية السياسية الحاكمة وحلفائها من العملاء والوكلاء والوسطاء والبرنامج الوطني التحرري والطبقي المناهض للاستغلال، ذلكم كله مجبول بحجارة الشارع وقارورة مولوتوف وضحايا الثورة والماضي الثوري الذي يجتاز حتى اليوم المخيمات الفلسطينية، والذي انقضَّت عليه الدولة البورجوازية أكثر ما مرة. ومنها على سبيل المثال الوحدة السورية المصرية، وحركة 23 شباط. فهل يَفتقر اليسار السوري بعدما توفَّرت أمامه كل هذه الحالات والأسباب التي تحثه على النهوض من نومه كي يوحِّد قواه في تحالف استراتيجي يساري في جبهة واحدة، ثم يوحِّد بالتالي القوى الوطنية الديمقراطية في جبهة واسعة، هل يفتقر إلى أسباب أقوى من هذه كي ما يتحالف في جبهة يسارية! إن الخلافات ما بين الماركسيين في سورية، من أساتذة جامعيين ومثقفين ما زالوا أسرى لماركسية الجامعات، مهما بلغت أهميتها في سلم المعرفة، فإنها تفتقد إلى المادية السياسية ما لم تأتي نظرياتها وبرامجها من حسها للشارع. إن الماركسية، وليس ماركس وإنجلز ولينين ولوكسمبورغ، في أزمة منذ بداية القرن العشرين، لأن المنادين بالثورة جعلوا من الماركسية أحرفا جامدة أو مقولات منطقية، وهي حجر يبكي ويحس، وشجرة يانعة خضراء، وليست فكرا جامدا ومقولات منطقية تملي نفسها على الواقع.
إن اليسار الثوري في سورية الذي كان ينادي، وما يزال، بالانتقال التدريجي والسلمي مرشَّح اليوم، ما بعد ميدانية القاهرة التي تدق أبواب سورية ولبنان، وتفتح الأبواب الواسعة أمام المقاومة اللبنانية والفلسطينية، من شأنها أن تشفي الشيوعيين القوميين اليساريين من الفكر الماركسي الذي يظهر عبر وثائقهم بمظهر الماركسية المعذّبة والمعتلة، والتي تبرر ما يكسو أفكارها وبرامجها من قمع، تتذرع بماضي الماركسية الكلاسيكية، وتعود إلى ماركس ورفاقه لتدفنهم مرة أخرى بدل أن تعود بهم إلى الواقع، حيث ميدانية القاهرة التي لا تقل من حيث أهميتها الثورية الشيوعية عن الأهمية الثورية لكومونة باريس، بدل أن تعود بهم من الماضي إلى الحاضر كي يحيوا من جديد مع منجزات الميدانية. عسى أن تؤذن ميدانية القاهرة بتخلي اليسار السوري، الشيوعي والقومي والناصري، عن الإيديولوجية الإصلاحية، فيثورا عما قريب على نظرية الانتقال السلمي التدريجي، ويدحضوا مزاعم السلطة التي تتعهد بإصلاح ليس له تاريخ، ويأخذوا بميدانية القاهرة، وما تحمله في طياتها من مضامين صريحة ومخفية.
لقد كشفت ميدانية القاهرة عن الصراع الطبقي في أوضح مضامينه. طبقة ضد طبقة، يمين ويسار، مُضطَهدين ومضطَهَدين تُسرق منهم قوة العمل، وعمال يتقاضون أقل الأجور أو يُرغمون على العمل بدون أجر بالتخويف والتهديد والإرهاب، كي يراكم أرباب العمل الثروات الضخمة بفضل فائض القيمة المسروقة من عمل العمال واحتياجاتهم في حاضرهم ومستقبل أسرهم. بل، وإن الصراع الطبقي امتد إلى الجيش. فالمجندون وضباط الصف والضباط، بخلاف الأمراء أصحاب الرتب العليا الممثَلِّين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كانوا سيرفضون إطلاق الرصاص على الثوار، لاسيما وأن كثرة منهم مجندون يمضون واجبهم الوطني في خدمة العلم. الأمر الذي حَمَل أمراء الجيش إلى الإعلان عن البيان رقم واحد بانتظار نجاحهم في إرغام الديكتاتور مبارك على الاستقالة، يحدوهم في ذلك الدافع إلى إنهاء الثورة قبل أن تنجح في تقويض النظام برمته.
إن مستقبل ميدانية القاهرة يُختبر على محك من الصراع الطبقي، وما ستحرزه ثورة 25 يناير من إنجازات جذرية ونوعية، إن في المكونات الإيديولوجية للدولة، من دستور وتشريع وقضاء وفصل ما بين السلطات الثلاث، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، أم في نمط الإنتاج الرأسمالي. غير أن الطبقة البورجوازية الحاكمة، وإن تنازلت لجماهير الثورة عن بعض امتيازاتها الإيديولوجية، فإنها ستقاوم بذكاء كل ما يمس بنمط الإنتاج الرأسمالي. ومن المرجح أن ميدانية القاهرة، شأنها شأن الثورات كلها، ستمر عبر متعرجات صعبة، وتواجه العوائق والعقبات والحواجز الأمنية والعسكرية والإيديولوجية، التي تريد قمعها، والحيلولة دون اختلال موازين القوى السياسية والطبقية لصالح الجماهير، وللحفاظ على نمط الإنتاج الرأسمالي، والحؤول دون عودة مصر إلى صف المقاومة العربية. لاسيما وأن موازين القوى في المجتمع المصري، بالرغم من أن الثورة تَستقطب أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل وشرائح واسعة من البروليتاريا الرثة والطبقات الوسطى، وأكثرية الشعب، مؤهلة خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي تسبق انتخابات شهر أيلول/سبتمبر المقبل، لسرقة الثورة من الجماهير، إن لم تستفد منها وتجعل منها ثورة بورجوازية لتوسيع ثرواتها في ظروف مستقرة تحت قبة البرلمان والدستور. إنها تستمد قوتها من الدولة وسلطاتها القمعية، إيديولوجية، وعسكرية، من جهة، ومن نمط الإنتاج الرأسمالي، من جهة ثانية. وهي بحوزة سلاح مرعب اسمه الديمقراطية التي تَكفل لها باسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني الحفاظ على كامل السلطات بيدها. والسياسة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والبورجوازية العربية لم ولن توفر جهدا كي تفصل ما بين الثورة الجماهيرية والديمقراطية، وتفرِّغ الديمقراطية الاجتماعية من محتواها الطبقي، وتفرِّغ في الوقت نفسه الثورة من محتواها الطبقي والتحرري.
وإن أخطر ما يهددِّ ميدانية القاهرة، أن الثورة العفوية لا تقوى على ترجيح موازين القوى لصالح جماهيرها ما لم تَنتقل من العفوية إلى الثورة المنظَّمة بقيادة تحالف يساري يَحمل برنامجا انتقاليا يخضع بدوره للتغيير والتعديل حسب ما تمليه الظروف الموضوعية. فما لم تنشأ هذه الجبهة اليسارية، فإن الثورة العفوية، وتعبئة الملايين، لن تقوى على بلوغ أهدافها الطبقية والوطنية التحررية. هذا، وإن لصناديق الاقتراع محصِّلات في الانتخابات العامة تختلف عن الميزان الطبقي، ما لم تُعبأ الجماهير بصورة منظمة سياسيا لخوض المعارك، الواحدة تلوى الأخرى على مسار من انتزاع السلطة من البورجوازية الحاكمة، إن بالطرق السلمية إذا لم تتخل البورجوازية عن ديمقراطيتها، أم بالطرق الحربية إذا ما تخلَّت البورجوازية في معركتها ضد الجماهير عن الديمقراطية لتأخذ بالفاشية أو الأصولية.
لقد التف الجيش بدهاء وذكاء على الثورة الجماهيرية اعتقادا منه أن ميدانية القاهرة ستنطفئ شعلتها بهدوء على المسار الانتخابي، وأن الديمقراطية والحريات ستلهي الجماهير الثورية عن مطالبها المعيشية ومناهضة الإمبريالية والصهيونية. غير أن ميدانية القاهرة التي رفعت شعار الديمقراطية من أجل الثورة، والثورة من أجل الديمقراطية، مرشَّحة للاستمرار بالرغم من أنها عفوية على طريق الثورة. لكنها لن تنجح في الجمع ما بين الثورة والديمقراطية في علاقة لا انفصال فيها، ما لم يتحالف اليسار الشيوعي واليساري، القومي والأممي، في جبهة موحَّدَة. والأرجح أن ميدانية القاهرة ستتمخض عن قيادات يسارية ثورية جديدة تقود الجماهير على مسار من الانتقال من العفوية إلى الثورة المنظَّمة، وتُرغم ما تبقى من اليسار الجامعي والثقافي على التخلي عن ماركسيته المدرسية واستمدادها من الشارع والمخيمات.
وأيا كانت النتائج القريبة والمرئية لثورة 25 يناير، فإن ميدانية القاهرة، وهي غنية بمضامينها المطوية، تسجِّل لمرحلة تاريخية جديدة، عالميا وعربيا. فهي تضاهي سقوط حائط برلين من حيث أهميتها التاريخية، طالما هي مستمرة وعينها على الجدار الحديدي في رفح، وجدار العار في فلسطين المحتلة. وهي مؤهلة لترجيح موازين القوى في الوطن العربي والعالم لصالح الجماهير واليسار، وتفكيك العصبيات القومية والدينية، واستعادة المجتمع للسياسة، وخلخلة الدولة في الوطن العربي، والانتقال إلى الشارع العربي والأممي، وتقليص دور دولة الملالي في إيران نفسها كما في الوطن العربي، وتعزيز المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق. ومن حيث هي تجدِّد الكومونة وثورة أكتوبر والثورة الألمانية بقيادة روزا لوكسمبورغ وثورة 23 يونيو بقيادة جمال عبد الناصر، وغيرها كثرٌ، فإنها تسجل لنهاية الأصولية، وعودة التيارات التحررية والثورية، ليس فقط لدى الجماهير العربية ومعاصري العرب عبر التاريخ من كردستان إلى جبال الأطلس، وإنما في العالم كله لأن ميدانية القاهرة تؤرِّخ من الآن فصاعدا لما سبقها من أحداث وما سيأتي بعدها.
نشر الموضوع في 2011 / 2 / 12 ولاهميته نعيد نشره