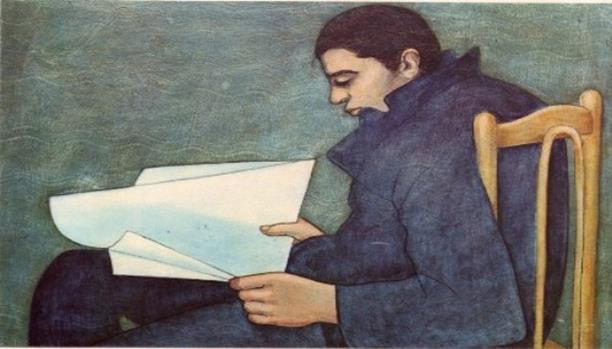نشيد البقاء «حارس الهوى»
أسامة محمد *
«إلى فدوى سليمان»
< حينَ يفتح «الساروت» ذراعيه على اتساعهما ويَفْرِد كفيّه… تستيقظُ ذاكرةُ الجَسَد… فيتذكر ضربةَ الجزاء.
حارسُ المرمى… ذكاءٌ وحساسيّة ومرونة و «ريفلِكس». والسرعة والارتقاء والقراءةُ والتوقيت. وميزات أخرى، أصعَبُها الهدوء الشديد والانقضاضُ الخاطِف… وأهَمُّها اتخاذ القرار… في كل جزء من كل لحظة. لا يطيرُ الحارس لِيَلمسَ الكرة بطرف إصبعه لأنها كرةٌ مطاطيّة… لا أحدَ يَعْرفُ مُخَيّلَتَهُ.
«قداسة البابا يوحنا بولس الثاني» كان حارس مرمى… وعاش جرائم النازيّة واستبداد الحكم العقائدي. وتَخَفَّى وزُجَّ أصدقاؤه في المعتقلات. واستقبل الفلسطينيّين وأدان الجدار العازِلَ. وتعرض لمحاولة اغتيال وهو يُحَيّي الجماهير. والتقى مع مُطْلِقِ الرصاص، وصفَح عنهُ. حين يبسط «عبدالباسِط الساروت» ذراعيه على اتساعهما ويفرد كفيّه يتَذَكَّرُ جَسَدُهُ ضربة الجزاء.
هكذا، يقف في المرمى حارس شباب سورية. وربما… حارس مرمى منتخب شباب الثورة.
حين يفرد حارس المرمى ذراعيه وكفيه… يُغْلِقُ الفراغ. ويجعل المهاجمَ أمام خياراتٍ أصعبَ.
تلك حركة الأُمَّهاتْ في الذودِ عن أبنائها.
لم يكن «عبدالباسط» يَدري إذ يبسط ذراعيه… أنَّهُ يَحْرِسُ الهوى والهواء… أبوابَ حمص «السباعَ وهودَ وعمرو». و «إنشاءاتِها وبيّاضَتها ووعْرَها»… أحياءها… وأمواتها.
«نشيدُ البقاء – سينما»:
تغيرت سورية. لم تعد كلمة «فيلم» حكراً على مشاهيرها ورَقَاباتِها ومَمَرَّاتِها الإجباريّة.
«نشيد البقاء» فيلمٌ سوريّْ «أندر غراوند – تحت الأرض» وفوقها… خرجَ من «حمص» على الهواء
«قناة العربيّة – الخميس 17 نوفمبر».
تبدأ العلاقة بين اللغة السينمائية والواقع من غياب اسم المؤلف… فعلى الشاشة السوداء… في المكان المحجوز لِـ (film by)… يظهر عنوان «نشيد البقاء»… ما يسمح لنا باجتهاد أن «نشيد البقاء» هو الاسم الحركيّ للمؤلف السينمائي.
وحين ينتهي الفيلم سيتّضح أنّ «نشيد البقاء»… هو السينمائي والفيلم والأبطال… في مدينة منكوبة اسمها «حمص».
فالصورة عدوّ النظام الأول. والمتظاهر عدوّه الأول والناشطون عدوّه الأول.
الصورة حررت الحكاية من استبداد المُسْتَبّد بالحكاية.
الحَاجَةُ أمُّ الاختراع:
الحاجة هنا هي «البقاء والحرّية وسورية الجديدة»… والاختراع هو «البقاء والحرّية وسورية الجديدة».
الحاجة السينمائية… تجعل الفنيّ ينسج جَسَدَهُ من جَسَدِ اللحظة. هنا حمص… لا يوجد معدّات صوت ولا إضاءة ولا حتى حامِل للكاميرا. ينحتُ الفيلم مجازاتِه بأظافره العاريّة.
والمجاز على الأغلب شهادةٌ على صِلَةِ اللحظة بسواها وانفتاحها على التعدد وربما إنقاذ نفسها من الدعائية والأحادية.
يبدأ المجاز من كتابة «نشيد البقاء» على الأسود. تليها كلمة «وَعْر» التي تنفتح على اسم حيٍّ حمصيّ شهير كما أنها «وَعْرُ» اللحظة الراهنة «وَعْرُ» البقاء في مواجهة القتل. و «وَعْرُ» حمص «وَعْرُ» إخماد التظاهر.
و «وَعْرُ» السينما في لحظة الموت المحتمل.
والحاجةُ أمّ الاختراع فقد أصبح حارس المرمى مغنياً مؤلفاً وصار صوته في الظلمة «يا وطنَّا يا غالي» صورةً وكوداً «سمع بصريّ» تلتقطه ذاكرة سورية الجديدة وترى به وفيه التظاهرات.
ثمة صراع يبدأ وعراً بين ذاكرتين صوتيتين بصريتين. فالأناشيد القومية التقدمية البعثية… بدأت تفقد استبدادها بالذاكرة الصوتيّة.
(هذا النصّ ليس مقالة عن الفيلم ولا نقداً سينمائياً… إنه عن حقيقة الحياة في حقيقة الصورة).
الفيلم ليلٌ ونهار. يتخفى كلٌ منهما في الآخر.
لَيْل
الليل الرمضاني ليلان: الأول… تظاهرات وغناء ومتعة. متعة البقاء رغماً عن الموت.
والليل الثاني مصفحات وأسلحة وجنود ومخابرات تتربَّصُ بالأوَّل.
ومُسَلّحٌ يُشعل السيجارة مستنداً على «تيراس» حاوية الزبالة «الفور سيزن».
في كلا الليلين لن تتعرف إلى شيْء من «حُمْص». فالإضاءة التي يَغلب عليها الظلام تنشأ من التخفيّ … تخفي السينمائي… وتَخَفُفِ الأدوات التقنية. لكنَّ هذا يرسم صورة حِسِّيَةً كليّة.
ففي ليلٍ بلا إضاءَة… تَتَخَفى التفاصيل… فتبدو المدينة خيالات أبنيّة وشوارع وكتل آليات وأسلحة… ينفذ نحوها من عمق الليل غناء المتظاهرين والساروت «يامو… يامو… يا أُمّْ الشهداء يا يامو».
أغنية الساروت «يامو» تستعير لحن الأغنيّة الأرمنيّة الشهيرة «نونيهْ» الذي سبق واستعاره دريد لحام في أغنية «يامو… ياستّْ الحناين يا يامو» في مسلسل (ملح وسكّر) أوائل السبعينات.
غنى دريد – غوّار «يامو» من ديكورات سجن (مخفر شرطة) على شاشة التلفزيون السوري. واستعار بَحّةً حزينة مُذْنِبَة مخاطباً أمّه مجازاً للأم في عيد الأم وروى شقاءها في الحَمْلِ والتربية وترقيع الجوارب.
قد تبدو «يامو» الساروت تحويراً كلماتياً «ليامو» دريد لحّام… فـ «ست الحبايب» صارت «أمَّ الشهداء». ويمكن النظر للتحوير هنا على أنّه التحوير الذي طرأ على حكاية «الأُمّْ» بعد 15 آذار. وحكاية تحوير الحياة إلى موت حكاية «51 طفلة استشهدت قبل أمومتها» و «102 شهيدة سوريّة» و آلافِ أمَّهَات الشهداء. والمجاز هنا أصيلٌ يبدأ من الخاص للعامّ. فأمّْ الساروت الحَقيقية هي أم شقيقه الشهيد «وليد الساروت». وبحّة الساروت بحّةُ شقيق الشهيد.
أما «السينوغرافيا» فقد تحررت من سجنين سجن التلفزيون وسجن الديكورات. السجنُ هنا أحياء محاصَرَة… شوارع وليل وخيالات. ومتظاهرون.
والكورال شباب واحتمالات مفتوحة على الشهادة والاعتقال والنصر.
…….. في الليل يستيقظ التَخَفِّي.
المستوى الأول من التخفيّ هو الظهور العلنيّْ لحارسِ المرمى في قَلْعَةٍ من تغطية دفاعيَّة مُبْتَكَرَة تَجْمَع (دِفاعَ المنطقة بمصيدة التسلل بالْ «مَان تو مَان»)… فحواها مُتَّحِدَة حماية «الصوت الحرّْ» بالأرواح. هنا يقف عبدالباسط ويبسط جناحيه مغلقاً الفراغ أمام «خصمٍ حَكَمٍ» قد يسدد ضربة الجزاء بالرصاص.
ويبدأ غناء الحريّة.
يصمت «الساروت» ليتنفسَ فيهدر صوت المتظاهرين «حبيبي ي ي ي – دُمْ تَكْ – عبدالباسط – دُمْ – حبيبي». المتظاهرون لا يخلطون بين واجب الثورة واللَّبَاقَة. فيعترفون لحارس المرمى بأهميته… فيعلو الصوت.
… والليلُ تخفٍ. والتخفيّ ناشطٌ لا نرى منهُ إلا صَوْتَه.
والليل مُسْعِفٌ لا نرى إلا تَنَفُسَه.
والليل صوت امرأة يحكي «حمصَ» ما بعد «درعا»… لكن ضرورة البقاء تُحَوِّر حِبالَه الأنثويةَ ليُصْبِحَ صوتَ رجلٍ أجشّ يبوح بأمومة تحمي البقاء. ليل حمص يشبه المنام… غرابة وقلق.
ورصاص ورصاص ورصاص.
… تتحرك الكاميرا في منامٍ هو شوارع «حمص» حيث فراغ وعتمة ولا أحد… وظِلّ دراجة على الأرض تتحرك بالكاميرا… «ترافيلينغ». سائق الدراجة يَرْجُو مُكالمةً هاتفيّة. ويشكو انقطاع الشَبَكَة. ثم صوت رصاصة بعيدة «أخّْ» يقول ظِلُّ الدَرَّاجة… ثم «رنين» ثم همسٌ من الموبايل «ثلاثة شهداء «…» بيب» ينقطع الاتصال… فيكمل السائق شكواه عن عبء وخطورة دفن شهداء اليومِ غداً. ويكمل حكايةَ الليل.
…
الليل حكايّة: عن مســعف يشــكو صعوبة دفن الجثامين. عن اغتيال الجــنازات وعن الاحتماء في حفرِ القُبور. عن النوم مع الجثامين بحثاً عن تحريرها بدفنها. عن اعتصام حمص الأول… عن مجزرة 17 نيسان… عن ســيارات قمامة ســـرقت الجثث والجرحى من الأرض. عن جرحى أعيدوا شهداء. عن الفساد والخوف. وعن الحلم بديموقراطية وانتخاباتٍ حُرَّة. عن حقّ التظاهر السلميّْ. عن المُتظاهِر «نضال قدسيّة» الذي فتح صدره لرجل الأمن وقال «اقتلني». فقتله.
في الصورة آلاف الثقوب في الجدران والنوافذ والزجاج مجازاً لجسد مدينة أو أحياء منها وأموات.
«نهار»
هنا حمص بعد 15 آذار.
يتكشف النهار عن جداريّة «سوريّة – لية».
«الجدارُ – الجداريّة» سورُ مبنًى رسميّْ. يَمْتدُ بلا نهاية… تَعلوهُ بلا نهايةٍ لطشاتٌ دهانيّة مُلَوَنّة.
في مرور الكاميرا المستمر فوق الجدار ستكتشف أن بقع الألوان كتاباتٌ «بعثيّة» طَمَسَها «دهانٌ معارضٌ» فَطَمَسَهُ «دهانٌ موالٍ» فعاد «اللون المعارض» ليستقر فوق ما قبلَه… كما لو أنّها حقبٌ جيولوجيّة.
…
بقعٌ من دهانٍ أسود بحجم كلمات مطموسة. تعلوها بقعٌ بالأحمر طَلَسَتْ كلماتٍ أخرى. ثم مشحة تركواز فوق الأحمر والأسود نفذت منها كلمة «ولا المذلّة».
ثُمَّ بقعٌ بالأسوَدْ مُبَقَّعَةٌ بالتركواز و «عاشت سورية» بالأحمر فوق التركواز. ثم ثلاث بُقعٍ ملَوَّنَة هربت منها «يا» نداءً أو شتيمة؟!
ثمّ «أنا سوري أنا موجود عفواً ديكارت» فوق التركواز. ثمّ… «لا للطائفيّة يا مرتزقّة».
جدار «حمصيّْ» لا ينتهي ملونٌ مُدْهِش جديد.
ثمة معركة بين ذاكرتين. تُصِرُّ الجديدة أن تؤسسَ لونها… فوق ما قبلها.
«ما قبْلَها» على الجدار الإسمنت المُسْبَقِ الصنع جملةٌ تَبدأ بِـ «لا يوجد شيء أغلى من حياة الإنسان». وتنتهي بِـ «سوى الوطن». «الوطن» كما تراه «سِوى» الفساد الأمني المُقَدَّس يمحو بـ الأحمر «الدمّْ» حياة آلاف السوريين.
هذا ما جعل الحماصنة ينهالون على كتابات الاستبداد بالأحمر والأسود والتركواز.
نَهار:
«لسنا عبيداً». يقول الساروت للكاميرا.
«قالوا إنني أمير سلفي وأنا لم أصلِّ سوى منذ البارحة».
(لو صُوِّرَ الفيلمُ البارحة لأجابت الصورة بدلاً عن الساروت. كما فَعَلَت منذ أيام حين وقفت «فدوى سليمان» إلى جانبه في «البيّاضَة». «فدوى» في أجمل لحظاتِها إذْ أنَّثَتْهَا الأنوثةُ قوةً وهَتَفَتْ لـ «دولةٍ مَدَنيّة» فَهَدَر الباسِطيّون «دولةً مدنيّة»).
يبتسم الساروت للكاميرا «حرّية وبسّْ».
ثم شاشة سوداء.
لا اسم للسينمائي.
أو أنَّ اسمَهُ مُتَخفٍ في الأسود.
كتبه بالأخضر.
نشيد البقاء الأبيَض.
حين تشرق الحريّة… ونشاهد الفيلم في صالة الكندي بدمشق… سنناقش السينمائيَّ عن اللغة والأدوات والصوت والبنيّة. هل كان يتمناها؟ هل كان يفتقدها أم يفتقد معرفتها؟
نحن لا نعرفه ولا نعرف.
وكما لا يقول المثل: «اللي ما بيعرف ما بيعرف… اللي بيعرف بيقول:… حريّة».
* سينمائي سوري