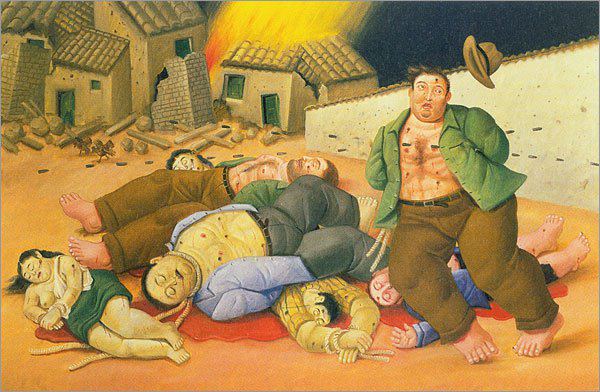نشيد الوجوه الغائبة/ فاضل الكواكبي

اللقطة الفوتوغرافية الأكثر رواجاً التي تحتفظ بها ذاكرة السينما العربية للفيلم الروائي المصري الاحترافي الأول «ليلى بنت الصحراء» (1927) لوداد عرفي وستيفان روستي، هي لقطة قبلة (سينمائية) بين بطلة الفيلم ومنتجته عزيزة أمير وبطله وأحد مخرجيه المسرحي والسينمائي والمغامر التركي وداد عرفي. لم تُتَح لأجيال من المشاهدين والنقاد مشاهدة هذا الفيلم بسبب اختفاء نسخه منذ الأربعينيات، لكن المعلومات عنه كثيفة ووفيرة وأغلب المشاركين فيه عاشوا حتى الستينيات بل والسبعينيات!
لعل القارئ قد انتبه إلى أننا وصفنا القبلة بـ «السينمائية» ولم نَسمها بميسمها الفيزيو ـ عاطفي «فموية»، وهذا عائد إلى أن التوصيف السينمائي للقبلة يردّنا إلى أصل إشكاليتها في العقل السوسيو ـ ثقافي العربي.
لقد ربط هذا العقل بين القبلة السينمائية والمشهدية الجنسية، ومثل هذا الربط قد خلق التباساً آخر هو ذاته الالتباس الذي نما بشدة في منظومة الإعلام العربي منذ السبعينيات وفي المنظومة القيمية للمجتمعات العربية منذ السبعينيات، وجعل الهجوم والموقف السلبي من المشاهد الجنسية المتزايدة باطراد في السينما المصرية منذ الستينيات يتناولان أيضاً القبلة السينمائية التي أصبحت الممثلة الممتنعة عنها مضرباً للمثل الإيجابي بوصفها «محترمة» أو «جادة» أو «ملتزمة»… إلى آخره من هذه الرطانة. ولعل القارئ المهتم يذكر كمَّ المواد الصحافية والميديائية التي تناولت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة إبان رحيلها، والتي ركزت على أن أحد أهم أسباب تميزها هو «التزامها» في خلط واضح للمفهوم الشعبوي الذي يدّعي التقدمية بالمفهوم المحافظ عند الطبقات الوسطى العربية الناكصة عن حداثتها منذ السبعينيات، وأحد أشكال هذا «الالتزام»، حسب هذه الكتابات، هو أن «حمامة» لم «تقبّل» في أفلامها، ولم تقدم «مشاهد مبتذلة» (ضمناً جنسية) في هذه الأفلام.
سادت هذه الرطانة في كتابات بعض الصحافيين والإعلاميين عن حمامة قبل وفاتها، وهذه الكتابات ـ كما هو هذا الرأي السائد ـ تدل على ذاكرة بصرية معطوبة وسوية حرفية شديدة الضعف، وتؤكد أن العرب ما زالوا أبناء للثقافة الشفوية الخالية من تراكم معرفي حقيقي.
إن لـ «حمامة» في الواقع «قبلات سينمائية» و «مشهديات جنسية» شهيرة، لعلنا نذكر بعضها في أفلام أضحت كلاسيكية مثل (صراع في الوادي، ليوسف شاهين 1955)، (لا أنام، لصلاح أبو سيف 1956)، (دعاء الكروان، لهنري بركات 1958)، (أريد حلاً، لسعيد مرزوق 1975) وغيرها.
قد تكون حالة فاتن حمامة مرتبطة بصيرورة شخصية – إعلامية خاصة، ولكننا في عودة إلى الصيرورة العامة للسينما المصرية نرى أن ظهور هذه السينما هو حالة حداثية دخلتها مصر في مجالات أخرى منذ منتصف القرن التاسع عشر، وبالتالي فإن «تبييء» فن السينما لم يكن بالإمكان أن يتم على حساب القواعد العامة لهذا الفن التي بدأ إرساؤها في الغرب الأوروبي والأميركي.
ورغم أن السينما المصرية بدأت تراكم خطاباً خاصاً بها إلا أنه كان خطاباً يتبنى الترسيمة العامة للأجناس السينمائية، كما أرسيت في الغرب، وهذه الترسيمة كانت تتضمّن القبلة السينمائية والمشهدية الجنسية ليس كحالات فيزيولوجية ولا حتى تسويقية بقدر ما هي شكل من أشكال الأداء المشهدي، وهو أداء مسرحي في جذوره ما قبل السينمائية تمّت إعادة تشكيله وفق مقتضيات اللغة السينمائية. وقد أنتج هذا التشكيل الجديد قبلة سينمائية كلاسيكية استمرّت بشكلها هذا حتى الستينيات.
السينما المصرية
لم يكن المجتمع المصري يظهر منذ العشرينيات أي اعتراض على مشاهد القبل. ورغم أن هذا المجتمع كان محافظاً على المستوى العام، إلا أنه كان يسير بخطى حثيثة نحو الحداثة بقيادة سياسية اجتماعية وثقافية ليبرالية وطنية (ممثلة أساساً بحزب الوفد ومثقفي وإعلاميي العشرينيات والثلاثينيات). وقد اكتفى السينمائيون المصريون بتبني وتبييء أشكال محدودة من الخطاب السينمائي السائد عالمياً وركزوا على خطابي الميلودراما والفارس مع استثناءات قليلة لما يُسمى بالخطاب الواقعي، وكلها كانت تحتوي على مشاهد قُبَل أضحت أيضاً كلاسيكية. ولم تختف هذه المشاهد إلا في النصف الثاني من الأربعينيات، فقد أصاب الليبرالية المصرية إبان الحرب العالمية الثانية نكوص شديد، وظهر لدى السلطات الحاكمة تشدّد تجلى ـ في ما يخص السينما والفنون عموماً ـ بقانون رقابي يميني متطرف ظهر في أواخر الأربعينيات غابت على أثره مشاهد القبلة والمشاهد الجنسية بشكل عام حتى العام 1952.
هذه الهستيريا اليمينية المشابهة للمكارثية والمطابقة لها زمانياً لم تستمرّ، فبعد وصول الطبقة الوسطى التقدمية إلى الحكم إبان ثورة 23 يوليو تغير قانون الرقابة بل والمناخ الثقافي والاجتماعي العام نحو مزيد من التحرر والانفتاح، وبدأ نهوض شديد في نوعية السينما المصرية، حيث استعيدت في هذا السياق حريات التعبير عن الحالات الحميمة عبر مجموعة من الأفلام التي أخرجها كبار من أمثال صلاح أبو سيف، توفيق صالح، هنري بركات، يوسف شاهين، عز الدين ذو الفقار، وغيرهم كثر… وبدأت ممثلات ذاك الزمان يقدّمن الجنس المشهدي بشكل أكثر احترافية وجرأة، كما استمر التأثر بالسينما الهوليوودية عبر اقتباس نموذج ممثلة الإغراء (هند رستم، هدى سلطان، برلنتي عبد الحميد)، لكن هذا التصنيف لم يخلق فاصلاً وهمياً بين هاتيك الممثلات وزميلاتهن الأخريات اللواتي أدّين أيضاً المشاهد الجنسية بجرأة رفيعة (فاتن حمامة، مريم فخر الدين، شادية، سعاد حسني، نادية لطفي وأخريات…).
لقد احتفظت القبلة السينمائية في أفلام تلك الفترة بشكلها الكلاسيكي، لكن تحوّلاً هاماً جرى على خطاب السينما المصرية في الستينيات ـ في النصف الثاني منها تحديداً ـ تم تحت تاثير التيارات والتجارب السينمائية الجديدة التي بدأت تسود في الغرب، حيث بدأ النهل من معين هذه التجارب في التعبير المغاير عن الحالات الحميمة وهو تعبير تخلّى عن الكلاسيكية لمصلحة حالة أكثر «واقعية»، لكن هذه الحالة لم تكن اقتباساً فيزيولوجياً للواقع بقدر ما هي حالة تتيح التعبير الحر عن المكنونات السيكولوجية والبصرية للإنسان.
وقد قدمت السينما المصرية منذ النصف الثاني للستينيات حتى منتصف السبعينيات أفلاماً شديدة الأهمية تمّ التعبير فيها عن حرية الجسد وتوقه نحو الانطلاق، ومن أهم هذه الأفلام: (فجر يوم جديد، ليوسف شاهين 1965، المستحيل، لحسين كمال 1966، قضية 68، لصلاح أبو سيف 1968، أبي فوق الشجرة، لحسين كمال 1969، زوجتي والكلب، لسعيد مرزوق 1970، الاختيار، ليوسف شاهين 1970) هذا عدا عن الأفلام الخفيفة التي امتلأت بمشاهد الجنس من دون ابتذال، لأنه جنس تقاطع مع حرية اجتماعية أصبحت سائدة في المجتمع المصري بكل طبقاته منذ الستينيات. وقد مثلت في هذه الأفلام أهم فنانات السينما العربية بما فيهن اللواتي كن يعتبرن ممثلات «ملتزمات»، وهن تحديداً بطلات المسرح القومي إبان ازدهاره في الستينيات (سناء جميل، سهير المرشدي، مديحة حمدي، سميحة أيوب)…
النكوص
استمرّ هذا السياق في النصف الأول من السبعينيات وأمثلته كثيرة، لكنه تزامن مع نكوص تدريجي للخطاب السينمائي الفني كان سببه الأساسي إلغاء القطاع العام في العام 1971 والحرمان الجزئي للسينمائيين اليساريين والشباب من العمل. وصل هذا النكوص إلى ذروته بقانون متشدد للرقابة ظهر العام 1976 بالتزامن مع التحول النهائي لنظام السادات عن بقايا النهضوية السالفة وتحالفه المستجد مع تيارات الإسلام السياسي، والخضوع المتزايد لتأثيرات اقتصادية وقيمية آتية من الخليج العربي ـ خاصة من السعودية ـ مما جعل السينما المصرية تعيش مواتاً حقيقياً على المستوى الفني منذ موسم 1976-1977، وترافقت هذه التغييرات مع اختفاء شبه كامل للمشهدية الجنسية ومحاولات فاشلة للعودة إلى القبلة السينمائية الكلاسيكية بشكل مخفّف. لكن السينمائيين المصريين استطاعوا أن يستعيدوا بعضاً من حريتهم منذ منتصف الثمانينيات مستفيدين من الشكل المؤسسي للثقافة المصرية الذي لا يمكن أن يخضع بسهولة للسيطرة الاقتصادية والقيمية الخارجية، ومن سوق واسعة تغنيهم إلى حد ما عن هذه السيطرة، مقاومين التأثير السلبي لطغيان رأس المال الخليجي على سوق إنتاج الدراما التلفزيونية، الذي تبعته سيطرة شبه كاملة على الفضاء العربي منذ التسعينيات (نلاحظ مثلاً ما تقوم به القنوات المموّلة خليجياً ـ والتي تملك أكبر مخزون من أفضل نسخ السينما المصرية ـ من مجازر رقابية بحق هذه الأفلام ـ خاصة تلك المنتجة بين العامين 1955 و1975 ـ محيلة إياها إلى شتات). أما السينمات العربية الأخرى فلها سياقات أكثر هزالاً وتعقيداً، لكنها تتقاطع في هذه السياقات مع أمها الكبرى المصرية.
ستظل القبلة السينمائية إضافة إلى معناها السينمائي ذات معنى رمزي، ولن يوقفها أي زحف للتخلف والتوحش الاجتماعي للإسلام السياسي.
(كاتب سوري)
السفير