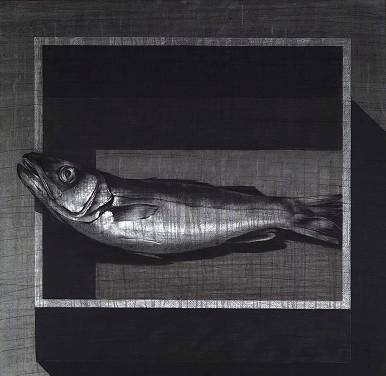نقاش هادئ مع ياسين الحاج صالح

سقوط الواقع السوري بين “الإيديولوجيا” و”الوضع الطبيعي”
ناريمان عامر
يتنقل الكاتب ياسين الحاج صالح بين فضاء النظام السوري المدعم بالإيديولوجيا، إلى الشارع السوري الذي تحيق به أخطار الوضع الطبيعي. منتقلاً من التوصيف ونقل الحدث إلى إعمال الأدوات المعرفية في تحليل المشهد السوري. ولئن كان الكاتب موفقاً في نقل الحدث إلا أننا نختلف معه في محاولته التحليل ونرى أن موضع الخلاف في ما نراه شكلاً من أشكال أزمة الثقافة العربية عموماً في ترنحها بين السماء والأرض.
فخلافاً لما ورد للكاتب في مقالته” في شأن النظام السوري وشركائه الأيديولوجيين” المنشورة في جريدة الحياة 30 آب 2011 ؛ والأخرى” الثورة السورية وخطر الوضع الطبيعي” المنشورة في جريدة “المستقبل” 18 أيلول 2011. نجد أن ما يحتكم إليه المشهد السوري هو الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي وليس الايديولوجيا أو” الوضع الطبيعي”.
لعله من الجائز القول إن مقولة “سقوط الايديولوجيا” التي عممت في العقدين المنصرمين عالمياً قد أرخت ظلالها على المنطقة العربية التي تعاني أصلاً من ضعف في تجذّر الايديولوجيا وبشكلٍ متفاوت بين الدول العربية. الأمر الذي أدى إلى تهدم على مستوى المشاريع الكبرى المطروحة في المنطقة العربية ونال من أبنيتها الهشة سلفاً. أما ما يخص الوضعية السورية فيصح التحليل الذي قدمه ياسين في تضييق مساحة التخندق الايديولوجي الداعم للنظام في سوريا، لتُختزل، وكما قال، إلى “أيديولوجيي الحداثية وأيديولوجيي الممانعة” كعنوان أساسي وهدف تنضوي تحته إيديولوجيات منقولة من المنجز الثقافي العالمي. كما يصح هذا التحليل في بلورة البنية الثقافية الإيديولوجية التي يحتكم إليها المشهد السوري” الثقافي”. لكن إلى أي درجة تؤثر هذه البنية الثقافية الإيديولوجية في المجتمع السوري؟ وإلى أي درجة تحقق حضوراً الآن وفي هذه اللحظة؟ وبالتالي إلى أي درجة تشكل سنداً للنظام السوري في صراعه من أجل البقاء؟
فتأثير الايديولوجيا بشقيها والتي تم طرحها في المقالة المذكورة، يشف فعله الخارجي إذا ما لاحظنا أداء النظام السوري الرافض للتعاطي مع أي مبادرة خارجية لا تخدم بقاءها. كما ينتفي فعله الداخلي إذا ما لاحظنا الإفلاس التي تعاني منه المعارضة السياسية القديمة بأيديولوجياتها المتنوعة، بل وإننا نرجح عدم جرأة هذه المعارضة على بلورة مشروع جدي بسبب معرفتها وإدراكها لعجزها عن أن تكون ممثلاً واقعياً للشعب السوري وهو عائد إلى عدم وجود حامل اجتماعي لإيديولوجياتهم المتنوعة! وما يراد توضيحه هنا، هو عدم القدرة، من قبل ومن بعد، على تجاوز الهوة التي تفصل بين الثقافة/ الايديولوجيا والمجتمع والشارع المنتفض إلى الآن، والقول بأن حملة الأيديولوجيات على اختلافها يبحثون عن موطئ قدم في هذا الحراك.
أما تشخيص ظاهرة “التسلح وطلب الحماية الخارجية” التي بدأت تميل إليها بعض الشرائح الاجتماعية المنخرطة في الحراك السوري بـ “الوضع الطبيعي” فهو شكل من الاحتيال على مفهوم الطبيعة البشرية، في محاولة تبرير الخطر المحيق بالحراك السوري، برده إلى الطبيعة البشرية وغريزة البقاء. ولئن كانت غاية الكاتب تبرير هذه الوضعية أمام آلة القمع السورية والتحذير منها، إلا أن النتيجة قد تكون في الخندق الآخر. ذلك أن رد شرور المجتمع إلى الطبيعة البشرية _ وكما استشهد هو نفسه بمقولة هوبز أو باستعارته “النفس الغضبية” عند أفلاطون_ كان شكلاً من أشكال تثبيت نمط اجتماعي! فأفلاطون نفسه قال: إن الطريقة المثلى التي يمكن أن نعين بها مقومات الطبيعة البشرية هي أن ننظر إلى صورة هذه الطبيعة في نظام طبقات المجتمع، قبل أن ننظر إليها في الفرد. وعلى أساس النظام الاجتماعي الذي كان معاصراً له توصل لتقسيماته المشهورة للنفس البشرية: الشهوانية، الغضبية، العاقلة. فلم يجد صعوبة بعد ذلك في البرهنة على أن في هذا المجتمع طبقة يجب أن يفرض عليها القانون فرضاً، وأخرى تتجه ميولها نحو إطاعة القانون، وثالثة عليها سن القوانين والتشريع. بينما هوبز الذي اعتبر أن أحوال الطبيعة وقوانينها هي والطبيعة البشرية في حالتها الفجة شيء واحد، توصل إلى أن في طبيعة الإنسان ثلاثة أسباب تدفعه إلى النزاع والمقاتلة، المنافسة: التي تدفع الناس للمغامرة ولو بالعنف بهدف السيادة على غيرهم. وسوء الظن: بدافع من الأمان والطمأنينة طلباً للحماية. وحب المجد: من أجل الشهرة وذيوع الصيت متجه نحو أمور هزيلة. هذه الأسباب هي التي تستدعي النزاعات والحروب بين الدول والحروب الأهلية. ليخرج من ذئبية الإنسان تلك، لتمجيد القوانين التي كانت سائدة في عصره، والتي يقبض عليها ويشخصها السلطان (الملك)! والجدير بالذكر أن المنافسة أول أسباب الذئبية، أخذتها الفلسفة الاجتماعية في القرن التاسع عشر وقلبتها رأساً على عقب. فبدلاً من اعتبارها مصدراً للشرور اعتبرت وسيلة للوصول إلى العمل المناسب لكل شخص! وبالتالي لم تكن فكرة “الطبيعة الإنسانية”، سوى محاولة تثبيت أو تغيير لـ” الطبيعة المجتمعية” باستخلاص الأسباب من النتائج! وهي عند ياسين تبرير من أجل التغيير! وهنا قد تكون مبرراً من طرف آخر لفرض “القانون” على “الوضع الطبيعي” في سبيل الدفاع عن حالة “فوق طبيعية”.
بين فضاءات الايديولوجيا السورية والشارع السوري المتحرك يسقط الواقع غير آبه بهما، حيث يتبدى أثر الثقافة بالمعنى الأنثربولوجي واضحاً للعيان. ونقصد بالمعنى الأنثربولوجي للثقافة: الثقافة من حيث هي مركب معقد من العادات والتقاليد والقيم والسلوك، تتبلور في شكلٍ اجتماعي معين، وتميزه عن غيره وتكشف عن الفروق بين الجماعات. وهي في الحالة السورية اختلاط بين السياسي والديني والاجتماعي والاقتصادي- ولعل العامل الديني هو الأكثر حضوراً- الأمر الذي أفرز تشكيلات اجتماعية متباينة من حيث تلقيها للحدث في الشارع السوري: مذهبياً لم يكن للمسيحيين كتشكيل اجتماعي أي تفاعل مع الحدث الثوري في سوريا بل اقتصر الأمر على بعض الحالات الفردية. موقف يعبر عن خوف من “إسلامية” جديدة قد تعمل على إقصائهم من مساحة الحضور المقبولة والناتجة عن حداثة النظام السوري الشكلية. طائفياً: تشكل الطائفة العلوية التشكيلة الاجتماعية الرئيسية المدافعة عن بقاء النظام السوري. وهي ترى بقاءها من بقائه، فهي ترى في دفاعها عن النظام السوري دفاعاً عن وجودها حتى البيولوجي منه! بينما يراوح تلقي الإسماعيلية للحدث بين اندفاعٍ تثيره الروح المتمردة تاريخياً وانكفاءٍ يحمل عليه خوف من تكفير سني أو اقتتال مع العلوية. وتلتزم الطائفة الدرزية كتشكيل اجتماعي الحياد، وذلك بسبب غياب المفهوم الجهادي من البنية الاجتماعية، والحسم المتواطأ عليه بالتخلي عن الصراع من أجل السلطة بحكم الأقلوية، واختزال النضال الوطني بالنضال ضد المحتل الخارجي. وعلى الرغم من خروج مجموعات من الشباب تتسم بالنخبوية العلمية والثقافية كحالة متمايزة نسبياً عن باقي المناطق، إلا أن صعوبة خلخلة البنية الاجتماعية الدرزية حتى الآن دليل على طغيان العامل الأنثربولوجي على الإيديولوجي.
تعتبر “السنّية” الحامل الأساسي للحدث السوري، لكنها ومع ذلك تشكيلة غير متجانسة. حيث تظهر العوامل الأخرى بشكل واضح: فبروز العامل القومي عند الكورد مثلاً يجعل تلقي الحدث مختلفاً ويتماشى مع أكبر قدر ممكن من المكتسبات التي تخدم القضية الكوردية. وبروز العامل الاقتصادي عند تجار دمشق وحلب يجعلهم خارج الحدث، وبروز بعض العوامل الاجتماعية التي من أبرزها الخوف من الجديد والمحافظة يستثني فئة أخرى. بينما تبرز حماة وجسر الشغور وإدلب وريف دمشق بقوة، مدفوعة بذاكرة دموية عن الحالة القمعية التي عانى منها التيار الإخواني السوري. تساندها درعا، ودير الزور والبوكمال ببنيتهما العشائرية وأخلاق النخوة. ويحتدم الصراع في مناطق التماس الطائفي ابتداءً من بانياس انتهاءً بحمص مروراً باللاذقية، حيث يزداد الاحتقان بين أغلبية تشعر بأقلويتها وأقلية لا تريد التنازل عن سيادتها. وتؤجّج هذا الاحتقان قوى مسلحة غير معروفة الجهة! وهذه الشريحة الأخيرة متوزعة بين قوى تصر على السلمية وأخرى بدأت بحمل السلاح.
وتبرز في هذا السياق أقلية سياسية هي من كل الأديان والطوائف مفارقة للانتماء ما قبل الوطني، مختلفة العقائد والإيديولوجيات، تسعى لتكريس العمل المدني، وتشكيل خطاب سياسي راق، ومنهجة الحراك الشعبي اتجاه الأهداف المشتركة. لكنها عاجزة حتى الآن عن الانخراط الحقيقي في الشارع المتحرك وعاجزة حتى الآن عن إنتاج خطاب سياسي موحد!
طغيان العامل الأنثربولوجي على المشهد السوري والتلون العصي عن الدمج يضعه أمام مأزقين: مأزق الهوية بوجهها الداخلي، ذلك أن الهوية الوطنية في سورية هوية مدمجة بالهوية القومية، والهوية القومية “السورية الصنع” تجد نفسها أمام تساؤلات بلا ردود علنية، بل وفي سبيل مطلب التغيير تم تجاهلها تماما من قبل الشارع السوري، الذي يحاول الآن تصنيع هوية خاصة لم تتحدد معالمها بعد. وهو ما يهدد ببروز تيارات ما قبل وطنية تحاول فرض تصوراتها، الأمر الذي يهدد السلم والتعايش الأهلي.
والمأزق الثاني: مأزق الهوية بوجهها الخارجي. ففي ظل العولمة لم يعد الشأن الداخلي في أي دولة مع حفظ الفروقات- شأناً داخلياً وفي إطار سياسة النظام العالمي التي تعمل على إنعاش الهويات غير المثمرة تاريخياً على حساب الهوية الوطنية. قد يشكل هذا التلون السوري الهائل عتلة سياسية للنظام العالمي في فرض هوية من الخارج ترعى ما يراه مناسباً لبلد يتمتع بأهمية جيوسياسية بالغة التعقيد، بلد طالما كان ضالا عن الطريق!
لكن الحدث السوري عابر للإيديولوجيات، مفارق للوضع الطبيعي. إنه محاولة تصنيع سياسية جديدة فتية متعددة الوجوه مختلفة الملامح ومن كل الأطراف، بالمعنى السياسي المعاصر: النتيجة هي من سيحدد الطريق الأصح!
المستقبل