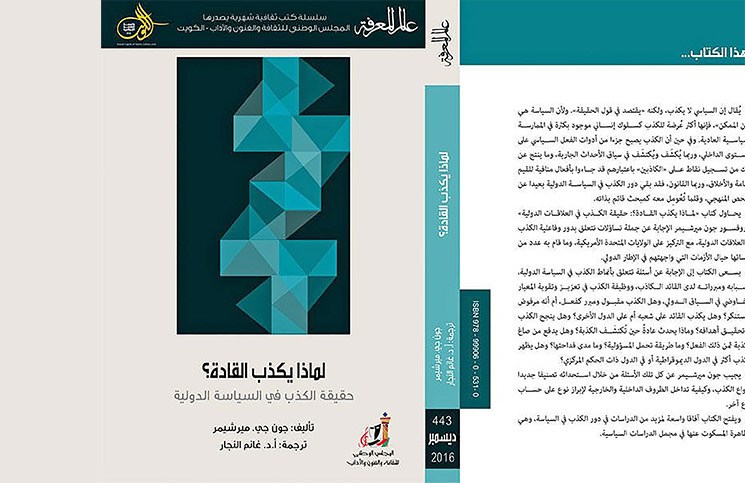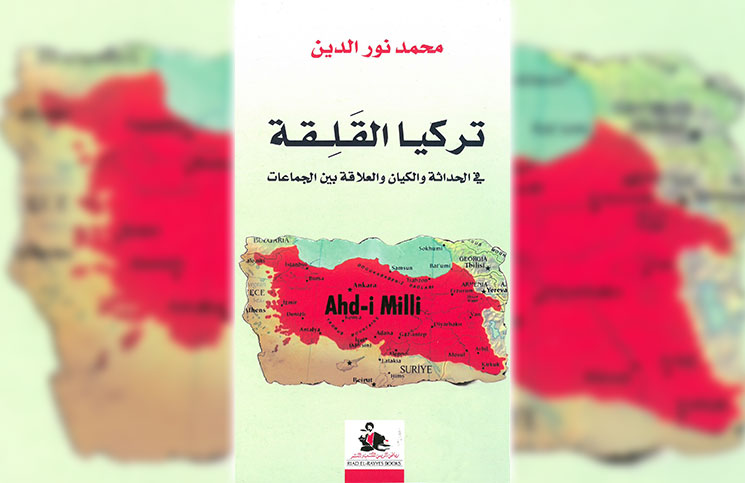هل الفصحى أصل الاستبداد؟/ رنوة العمصي

في كتابه “لماذا العرب ليسوا أحراراً”، الذي شرع يخط صفحاته الأولى منذ ما يقرب من أربعين عاماً، إثر هزيمة 1967 على وجه التحديد، يناقش الكاتب مصطفى صفوان العلاقة بين اللغة والاستبداد، عبر تقديم بعض مكونات الاستبداد وتحليل آلياته، متجاوزاً في ذلك البعد السياسي إلى الاجتماعي والثقافيّ. يستند صفوان في مقاربته تلك إلى كون اللغة إحدى أهم مكونات تشكيل اللاوعي الثقافي الجمعيّ، الذي يعدّ في عالمنا العربي حاضنة استقبال وعامل تعميق لعلاقة الاستبداد ما بين الحاكم والشعب، علاقة ترسّخت بُنيتها خلال قرون عبر ثلاثيّة “التأثيم والتجريم والتحريم”، تتحالف فيها لإخضاع المجتمع لسلطات الاستبداد السياسيّ وقوى الأصوليّات الدينيّة، التي يراها صفوان متحالفة على الإنسان ولو بدا أن بينها صراعات، فهي صراعات مصالح وتقاسم نفوذ.
ليست المناداة بضرورة استعمال الكتّاب والمثقفين العرب للّغة التي يفهمها الشعب، “اللغة العاميّة”، أو اعتمادها في المدارس، هي أبعد ما يذهب إليه مصطفى صفوان، وتعدّ النماذج التي اختارها لترجمات عالمية من اللغات الفصيحة إلى الشعبية، بمثابة أفكار يطرحها مباشرة أو يقاربها إلى ما يماثلها من نماذج، ابتداءً من نموذج ترجمة صفوان نفسه لمسرحية شكسبير “عطيل” إلى العاميّة المصريّة، وصولاً إلى ترجمة مارتن لوثر الكتاب المقدّس إلى اللغة الألمانيّة الشعبيّة.
يستعرض صفوان للتدليل على تلك العلاقة بين اللغة والاستبداد، نماذج تاريخيّة لدول ( كتلك التي قامت عند حوض النيل وفي العراق وفي أثينا)، كانت تفصل بين اللغة المستخدمة في الكتابات الإداريّة ووثائق الدولة والأدب والعلوم والدين، وبين اللغة الحية اليومية التي يستخدمها الشعب، مبيّناً أن اللغة الأولى كانت تتسم بطابع مقدّس أو أصل إلهي، فيما تعد الثانية بمثابة لهجة شعبية قاصرة، وعاجزة عن التعبير عن المعاني المركّبة أو الدلالات العميقة. ويعدُّ تبخيس لغة الناس ـ حسب رأيه ـ دافعاً لتبخيس الناس أنفسهم، ولامتناعهم عن التفكير، والنزوع إلى الاتكال، إنْ لم يكن إلى العبودية. يقول صفوان: “كانت الدول البدائية تميل إلى تشجيع الكتابة المنقوشة على الحجارة أو على المسلات، مع علمها أو بسبب علمها على وجه التحديد أن الشعب لا يستطيع قراءتها، ولأنها كانت ترغب في إبقائه على جهله. ولمجرّد كون النصّ مكتوباً، كان ذلك يعطيه وجاهة كافية لضمان خضوع الشّعب”.
وصفوان إذ يُسقِط هذه النماذج على الحاضر العربي، بما يحمله من أزمات تواجه واقع التعليم ومشكلات على صعيد الحريات الفردية، كالرقابة الفكرية الممارسة على الكتّاب والمثقفين وحتى تلك التحديات الآتية من الخارج كالعولمة، فإنه يعتقد بأن مهمّة كتّابنا ومثقّفينا ليست الدفاع عن ثقافتنا أو التنبؤ بمستقبلها، بل خلق هذا المستقبل. ويؤمن بأن الكتابة بالفصحى أو ما يسميه اللغة العالية أو المقدّسة نسبة إلى النص المقدّس، التي تغري نرجسيّة الكاتب، لا تعدو كونها فخاً ينصبه الكاتب لنفسه ويقع فيه، إذ يفصل بذلك نفسه عن محيطه وعن الشارع الذي يفترض أن يكون جمهوره، فيصبح وحيداً يسهل على السلطات استبعاده حال تجرأ ـ وحيداً ـ على معارضة ما هو سائد.
ليس هذا وحسب، بل يعدّ الكاتب التهكّم الذي يصوغه المثقفون في نصوصهم الفصحى حول فعل الاستبداد، تهكماً راضياً، بل ويصفه بالمتواطئ مع المستبدّ، لأنه ـ حسب تعبيره ـ نصٌ ميت، سبب مواته هو ذلك الحاجز ما بين الفصحى والعاميّة أو لغة الشعب.
في افتراض المؤلف أن الكتابة بالفصحى هي طريقٌ لتجهيل المجتمع العربي أو تذليله، أتساءل هل تعدّ الكتابة وحدها الطريق لتشكيل الوعي الجمعيّ؟ هل نكون بذلك الافتراض قد تجاوزنا بكثير من الإجحاف دور فنون كالمسرح والسينما والغناء وغيرها، قدمت للشارع العربي وللغته العاميّة البسيطة، وبتودّد جمّ، كثيراً ممّا كتب وقيل في الكتب أو لم يُقل فيها؟ التساؤل الآخر، إن كنا شعوباً لا تقرأ، فأين تكمن المشكلة، في اللغة أياً كانت عامية أو فصحى، أو في كوننا شعوباً أميّة أو لا تقرأ؟ ثم عن اللغة المحكية إن شئنا استخدامها لتقول النص المقدّس أو شبه المقدّس، هل سنضع لها قواعدها فنضمن سلامة النص، ونفرض عليها رقابة فتفقد حيويتها وقدرتها الحية على التجدّد والتغيّر دون رقيب أو حسيب، أم على العكس نترك لهذه القدرة إمكانية تغيير معنى النص فيصبح عائماً حسبما تحمل الدلالة من متغيّرات غير منضبطة؟ أخيراً، وهذا تساؤل راودني منذ الصفحات الأولى، إن نحن استثنينا عامل “العربية الفصحى” الجامعة لشعوب هذه المنطقة المتنوعة دينياً وعرقياً وطائفياً، من يكون حينها المقصود في كتاب “لماذا (العرب) ليسوا أحراراً؟”!
(شاعرة وروائية بحرينية)
العربي الجديد