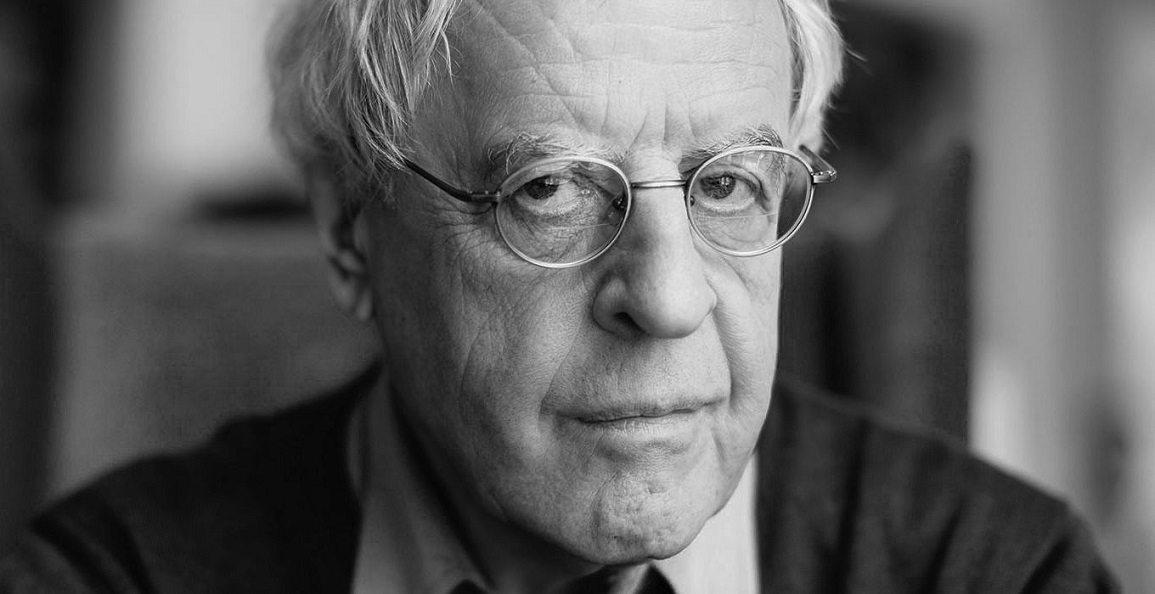وئام اسمٌ آخر لحمص/ حسّان العوض

سمعتُ باسم وئام بدرخان، للمرة الأولى، منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، من الشاعر الحمصي أنور عمران الذي التقى بها في أحد معسكرات صقل المواهب الأدبية التي كان يقيمها اتحاد الشبيبة في حمص سنوياً. يومذاك كان مذهولاً، وهو يحدثني عن فتاة تربط شعرها، وهي تخبره عن الكتّاب الذين قرأت لهم، والكتب التي أحبتها، وعندما سمعت أذان العصر استأذنته لتقوم للصلاة.
رأيتها للمرة الأولى. كانت في حديقة رابطة المتخرجين الجامعيين بحمص، حيث كانت تقدّم الشعراء في أحد مهرجانات الرابطة الشعرية. كانت طريقة تقديمها مختلفة عما اعتدناه. لم تكن تقدم نبذة تعريفية عن الشاعر وأعماله، ولا تقرأ مقطعاً من شعره، وإنما كانت تقرأ نصوصاً نثرية رفيعة اللغة، بصوتها الأنثوي المتفاعل مع ما تقرأ، بطريقة تتفوق بها على كثيرات من المذيعات المحترفات. عرفنا في ما بعد أن هذه النصوص من تأليفها.
هكذا اعتدنا على وئام مقدمةً لأمسيات الرابطة، وأحياناً المركز الثقافي، وأحببنا تقديمها الذي لم يكن استراحة بين أديبين مشاركين كما هي العادة، وإنما جرعة إضافية من الأدب الجميل الذي قد يكون أحياناً أجمل من أدب بعض المشاركين. صرنا نمزح مع وئام ونخبرها أنها ليست بحاجة لأمسية تشارك فيها، لأنها تستطيع بطريقة تقديمها أن تقرأ مما كتبت أكثر من أي مشارك.
تعمقّت معرفتي الشخصية بوئام فاكتشفتُ أنها ترسم كثيراً، ربما أكثر مما تكتب، وبأدوات مختلفة أيضاً: بقلم الحبر الجاف، الأزرق غالباً، على صفحات الدفاتر، المسطرة.
اكتشفتُ أيضاً أنها تخاف كثيراً من الأصوات العالية، خصوصاً المفاجئة منها، فيجفلها أي صفير أو قهقهة لشخص ليس في مرمى بصرها.
زرتها في بيتها مرات عدة، حيث كانت تقيم مع أهلها في حي القصور، الذي يعتبر من أقدم الأحياء التي بنيت خارج حمص القديمة، وقد نال اسمه من حسن تنظيمه وجمالية أبنيته. كان بيتها في الطبقة الأرضية، على محيط باحته الواسعة تتوزع أشجار وورود. هناك تعرفتُ إلى أبيها الكردي وأمها الحمصية.
* * *
قبل انطلاق الثورة السورية في آذار 2011 لم يكن لوئام بدرخان، كمعظم السوريين، أي نشاط سياسي. بعدها، انخرطت مع الثورة، كمعظم السوريين، تظاهراً وتصويراً. كانت الكاميرا رفيقتها الدائمة، ومعها كانت شاهدة على معظم الأحداث المفصلية التي تعرضت لها مدينة حمص؛ بدءاً من الحصار الذي فرضه الجيش السوري على حي بابا عمرو أواخر العام 2011 قبل اجتياحه لاحقاً. هناك التقطت صورها الأولى التي سرّبتها مع تعليقها الصوتي عليها إلى خارج سوريا حيث تم الإخراج والمونتاج، وهكذا أنجزت فيلمها الوثائقي الأول، “كنت في بابا عمرو”، الذي عرض على قناة “أورينت” باسمها المستعار سيماف، الذي يعني في الكردية ماء الفضة. بالطريقة نفسها أنجزت أفلامها اللاحقة.
الفيلم الثاني حمل عنوان “شارع الموت”، وقد أنجز قبل أيام قليلة من المجزرة التي وقعت في حي الخالدية فجر 4 شباط 2012. وعرضته قناة “العربية”. مكافأة الألف دولار التي صرفت للفيلم وزّعتها وئام على العائلات التي شاركت في الفيلم.
الفيلم الثالث، “حمص مقام الشوق”، عرض على “العربية” أيضاً، بعدما صوّرته في الفترة التي كان النظام السوري يباشر خطته للإطباق حصاراً على أحياء حمص القديمة بعد عجزه عن إخماد الثورة فيها. أما الفيلم الرابع، “الشهيد الحي”، فعرض على شاشة “كردستان تي في”.
قررت وئام أن تبقى في حمص القديمة مع الثوار والمدنيين الذين رفضوا الخروج. ببقائها، وبقاء القاص الحمصي فراس النجار، صاحب مجموعة “ليست هذه أيام الله”؛ لم يصمد سواهما في حمص القديمة من الوسط الثقافي الحمصي.
تحت الحصار الخانق لم يعد لوئام من إطلالة إلا صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، حين كانت تستطيع الولوج إليها بشكل متقطع لتكتب يومياتها، “يوميات حمص المحتلة” كما كانت تسمّيها، قبل أن تسمّيها “الذبيحة” في شباط 2012، ثم “المحاصرة” بدءاً من منتصف تموز 2012. إذ كانت وئام حريصة على تأريخ كل ما تنشره على صفحتها، ليس باليوم فقط، وإنما بالساعة والدقيقة أيضاً.
نشرت على صفحتها الصور الفوتوغرافية التي كانت تلتقطها للأحياء الحمصية، بشراً وحجراً، حتى غدت صفحتها أشبه بمعرض مستمر لأكثر من سنتين، يوثّق مآلات حمص تحت الحصار والقصف والتجويع والبرد. وكان تركيزها، ككل فنان حقيقي، على التفاصيل الصغيرة التي يعكس مصيرها الخاص المصير العام. صوّرت الشبابيك المكسورة والمخلوعة، والغسيل الذي لم يأت أصحابه للمّه، والسقوف المهدودة المتراصة بعضها فوق البعض، والأبواب التي لم يبق سواها واقفاً من البيوت، والمعاطف التي لا تزال معلقة على مشاجبها، والأحذية التي تنتظر أقداماً تنتعلها، والفناجين التي لم يعد يشرب فيها القهوة أحد، والمدرسة المدمرة، والمقاعد اليتيمة من الأطفال، والشرفات الوحيدة، والقناديل المطفأة، والشمس والقمر والغيوم والثلج والورود والأشجار والأغصان والأعشاب والقطط و…
كان للجوامع نصيب وافر من الصور، إذ طالما كانت هدفاً دائماً لأسلحة الجيش السوري، فرأينا التخريب الذي تعرض له جامع المأمون، وجامع القرابيص الذي أخذ اسمه من الحي الذي ينوجد فيه، وجامع سيدي خالد كما يطلق أهل حمص على جامع خالد بن الوليد الذي أعطى اسمه حرفياً لحي الخالدية المجاور، ومعنوياً لكل حمص، إذ طالما عرفت بمدينة ابن الوليد.
وكان لكنيسة أم الزنار في حي الحميدية العديد من الصور، وكذلك دير الآباء اليسوعيين الذي كان يعمل ويقيم فيها الأب فرانس الذي اغتيل فيه ودفن في حديقته. وقد بكته وئام بكاء شديداً بحكم الصداقة التي توطدت بينهما؛ فصوّرته وصورت قبره ورثته مراراً، ومما قالته فيه:
– لِمَنْ تركْتَ ما تبقّى من القلوب والشوارع والأزقة وحيدةً مثلي؟
– مَنْ سيفتح باب الدير للصباح بعدَكَ مثلك منذ الآن؟
– المَلّْيسَةُ بلا سُكَّرْ مَنْ سيُحَلِّي مرَّ كأسها بعينَيَّ في مساءات هذا الحصار الحزين؟
– الجوع الذي يقتلني على مهل مَن سيسألني كيف أروِضه بالكبرياء الهامسة ذاتها الآن؟
الأولاد الذين يبعثون على الأمل دائماً، في ظروف الحصار من جوع وبرد وخوف وألم حتى الموت ربما؛ لا بد أن يعنى بهم قدر الإمكان على أمل أن يكون مستقبلهم أقل تشوهاً؛ لذلك كانت وئام بدرخان تمضي معظم أوقاتها مع الأطفال: تلعب معهم، وتعلمهم القراءة والكتابة والرسم، وتصورهم، وتكتب عنهم، فأنشأت لهم صفحة على “فايسبوك” سمّتها “كتّاب عصافير الحصار الحرة” كانت تنشر فيها كتابات الأطفال ورسومهم وصورهم وهم فرحون أو حزينون أو نائمون وأحياناً موتى.
اختلقت شخصية سمّتها “حنظلة الحومصي” تعود لطفل حمصي محاصر اعتاد أن يوجه رسائله إلى الأشياء والأشخاص من دون أن ينتظر رداً، ومن فرط تهذيبه لا يبدأ رسائله إلا بكلمة “عمّو” أو “عميمي”. فهو كتب إلى أعمامه: التعب، النوم، المقعد، التابوت، القصف، الفران، الجيش الحر، الخبز، الصف، الموت، باسل أبو كاميرا، الصبح، الملاك، الصاروخ، الجوع، الزعل، الملح، العيد، الطريق، القهر، الحزن، الضمير، الحنين… إلخ.
لم تعد وئام تخشى الأصوات العالية كما كانت تفعل سابقاً، وذلك بعدما اعتادت على أصوات الرصاص والقذائف التي كان النظام الأسدي يمطرها. ظلت ترسم، ولكن بالفحم، على جدران حمص القديمة، أو ما تبقى منها واقفاً. ترسم وتكتب عليها وتصورها أيضاً.
أثناء وجودها في حمص، وكما هي طريقتها في إنجاز أفلامها الوثائقية السابقة، أرسلت وئام بدرخان ما صورته إلى المخرج السوري المقيم في فرنسا أسامة محمد. وقد نجم عن تعاونهما معاً فيلم وثائقي حمل عنوان “سيماف” استطاع الوصول إلى مهرجان كان هذه السنة.
في نهاية الأسبوع الأول من أيار 2014 اضطرت وئام بدرخان أن تغادر حمص وفقاً للاتفاق الذي أبرمه الثوار مع النظام، وقد خرجت مع آخر دفعة من حمص القديمة بعدما أمضت فيها سنتين، سمّتها أولاً: بابا حمصو على غرار بابا عمرو، ثم سمّتها “حمّوصتي” وأخيراً: ماما حمصو.
*عنوان المقال مأخوذ من منشور للناشط والصحافي الحمصي يامن حسين.
النهار