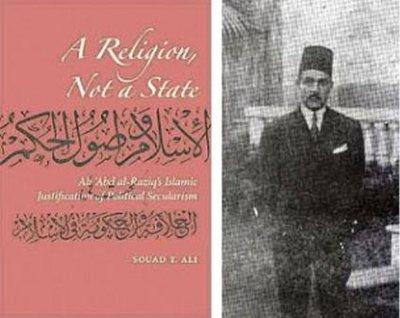«واقعية» حال العالم: انتصار «السياسي» وموت «المثقف»/ وائل مرزا

ثمة مشهدٌ عالمي يُظهر بوضوح تصاعد مأزق إنساني راهن، لا تلوح نهايته في الأفق القريب. في هكذا مشهد، نرى، وعيوننا ترفض التصديق، وقائع وأحداث لا يُفترض أن يسمح بها نظامٌ ثقافي وحقوقي وأخلاقي دولي، لو كان موجوداً حقاً: عالم تتحكم بمصيره، على طريقة المافيات، دولٌ و «قيادات» كبرى، سياساتٌ دولية تقوم على افتقار كامل للمنطق، اتساعٌ لدوائر التطرف والإرهاب وتغذية أسبابها بدعوى محاربتها، كمونٌ كبير لحروب مدمِّرة محتملة، إقليمياً ودولياً، مع أي خطأ، ممكنٍ دائماً، في الحسابات.
مقابل ذلك، يُطرح إغراءٌ مألوف يتعلق بالموضوع، وتُطلق نداءات تستخدمه على الدوام: ضرورة «الواقعية» عند التعامل مع ما يجري في هذا العالم. فهذا هو واقع الحال، وليس في الإمكان أحسن مما كان.
غير أن المسألة تحتاج الى تحرير، إذ تتعلق بمصير الإنسان، ومعاني إنسانيته أصلاً. تحريرٍ صارم لمعاني وشروط مصطلح «الواقعية». فهذا، وحده، ما يُخرج البشرية اليوم من المأزق النفسي والعملي الذي تجد نفسها فيه عندما يحاول إنسانها التعامل مع ذلك المصطلح، بخاصة في هذه الظروف الاستثنائية.
فالواقعية مصطلح ينبع ابتداءً من الصلة الوثيقة بالواقع، بكل عناصره وأبعاده ومداخله.
وأن تكون واقعياً يعني، أولاً وقبل كل شيء، أن تفهم الواقع حقاً. أي أن تحيط بتلك العناصر والأبعاد والمداخل التي تُكوّنهُ. ثم تستفرغ الوسع لامتلاك أقصى الشروط وأقوى الإمكانات التي تسمح لك بالتعامل مع ذلك الواقع، بما ينسجم مع مبادئك وقيمك، ويحقق مقتضياتها العملية في الحياة. هذا يتضمن، بطبيعة الحال، أن تدرك الحدود التي لا يمكن تجاوزُها، ولكن بعد أن تفعل المستحيل في فهم المداخل وإعداد وسائل استعمالها.
أكثر من هذا، من الواقعية أن تقف عند الحدود، ليس بسلبيةٍ بالغة واستسلام نهائي، وإنما بتحفزٍ وانتباه ويقظة ومتابعة لكلّ متغير. فتلك الحدود ليست صلدة على الإطلاق، وإنما تتصف بكثير من المرونة والسيولة، بحيث يمكن لها أن تتغير وتتبدل باستمرار.
أن تتحدى ما يجوز ظهورهُ، بشيءٍ من الجهد، وَهماً. وأن تحاول اختراق دوائر يُراد للبشرية أن تبدو مُغلقةً بإحكام. أن ترفض ما تعارف عليه الناس، فقط لأنه سائد. وأن تتجدد وتُبدع وتبتكر في طريقك ذاك.
تلك، باختصار، واقعيةٌ يفهمها وينطلق منها في تفكيره وممارساته من يحترم نفسه ومبادئه، ويبحث عن الاحترام في هذا العالم. وتلك منها مقتضياتٌ وشروط لا يصعب إدراكها والحركة بمقتضاها، حين يتوفر الحد الأدنى من الجدية والإرادة.
فهل يتصرف المثقفون في هذا العالم، ومعهم الحقوقيون والنشطاء والفنانون والكتاب، «التقدميون»، وفقاً لفهم الواقعية المذكور أعلاه؟ بخاصة حين يتعلق الأمر بالاهتراء المتزايد للقيم التي يؤمنون بها، وبالتجاهل المتصاعد لها من قبل أهل السياسة وأباطرة المال؟ وحين يتعلق بمحاولتهم لأداء دورهم، بتلك المعاني للواقعية، في مواجهة هذا الواقع؟ أم أن ثمة عملية استسلام كبرى يمارسونها بدعوى الواقعية؟
من هنا، يحق لكثيرين بأن يتساءلوا، في خضم الفوضى العالمية الراهنة: أين ذهبت مئات الأسماء العالمية من شرائح المثقفين والحقوقيين والفنانين التي ملأت سمع الناس وأبصارهم، وهي تتحدث عن كل المعاني التقدمية التي أرادت ترسيخها في الشرق والغرب على حد سواء؟
أين اختفى السادة الحاصلون على جوائز نوبل وغيرها، ممن كان الإعلام العالمي يحشر أسماءهم وإنجازاتهم في حلوقنا، ويُعمي بِصُوَرِهم أبصارنا، على مدى سنوات؟
وقد يكون السؤال الأكبر: أين الإعلام العالمي «الحر» الذي يعتبر نفسه نصيراً لقضايا الإنسان في كل مكان؟ والسلطةَ الرابعة التي تحمي المجتمعات من سلُطات العالم الثلاثة الأخرى، السياسية بامتياز؟
بشيءٍ من التجاوز، يمكن القول إن حال العالم اليوم تُعبر عن هزيمة منظومة الأخلاق والفلسفة والثقافة العالمية، وكل ما له علاقة بها من فنون وآداب وتعبيرات حقوقية وجمالية وإبداعية؟
يمكن تلك المنظومة المعاصرة أن تكذب على نفسها بالتأكيد.
يستطيع أهلها أن يكذبوا على الناس، ويأخذوا أبصارهم بعيداً مما يجري في العالم من مشكلات جذرية، باعتبارها، نهايةَ المطاف، أحداثاً هامشية لا يتوقف معها التاريخ.
كيف لا؟ ولمَ لا؟ وهم يؤلفون المسرحيات، وينتجون الأفلام، ويكتبون الشعر والروايات، وينشرون الكتب، ويُنظمّون المعارض، ويقدمون الجوائز، ويرسمون وينحتون ويُغنون ويرقصون في مواقع كثيرة من هذا العالم.
المخيف أن التكتيك ينجح عادةً في التاريخ البشري: بمثل هذه الطريقة يتم الهروب من علامات احتقان النظام الدولي، حتى تنفجر مشكلات الاحتقان المذكور بالجميع نهايةَ المطاف.
في مقدمة كتابه «أساطين الفكر» الذي يتحدث عن عشرين فيلسوفاً ساهموا في صناعة القرن العشرين، يعرض الكاتب والمفكر الفرنسي روجيه – بول دروا المفارقة بين الأمل الذي أثارته ثورة الثقافة في أوروبا مع نهايات القرن التاسع عشر بخصوص مستقبل البشرية، في مقابل الواقع البشع الذي فرض نفسه عليها، عملياً، خلال القرن العشرين.
«في النهاية»، يقول المؤلف، «اعتقدنا، من عصر الأنوار إلى عصر العلوم والصناعة، أن شعباً يُطور المعارف والفنون والتقنيات، يُفضي إلى تقدمٍ إنساني، وأخلاقي، واجتماعي، وسياسي. ها هنا كان الأمل الكبير: كلما أصبح البشر علماء، ازدادوا تحضراً. فهم مُسالمون بِحُكمِ ثقافتهم. الحرب العالمية الأولى هي التي بددت هذه القناعة: دمّرت أوروبا نفسها في خنادق الحرب، بتكلفة ملايين القتلى، على حين أنها كانت تُعد الأكثر تحضراً، وثقافة، وعلما، وفلسفة من سائر مناطق العالم. لقد أكد صعود النازية، والحرب العالمية الثانية، والمحرقة، أن كون المرء مثقفاً لا يمنع الهمجية. والشعبُ الأكثر فلسفةً في أوروبا – شعب كانط، وهيغل، وشيلينغ، وفيورباخ، وشوبنهاور، ونيتشه، وكثيرين آخرين – هو الذي سمح باللاإنسانية والجهل… حيثما التفتنا، لا نرى إلا مناظر الخراب… العلوم لا تكفﱡ عن اكتشاف مجالات جديدة. والتقنيات لا تتوقفُ عن صُنع سلطات جديدة. أما الشموليات والمجازر الجماعية فتُدمر السياسة والأخلاق».
صدر الكتاب بنسخته الفرنسية عام 2011، قبل أن يشهد العالَم، متفرجاً، على مدى أكثر من ست سنوات، مأساةَ في سورية لن يُكتب فقط أنها الأكبر في هذا العصر، بل إنها كانت شهادةً عملية على موت كل ما له صِلة بالتنوير الإنساني. لكن المسألة تجاوزت سورية في شكلٍ متسارع، وأصبحت تتعلق بوهمٍ يُدعى «النظام العالمي»، قد يمكن وَصفهُ بأي نعت، لكنه ليس «نظاماً» بالتأكيد.
فهل يتكرر المشهد الذي تحدّث عنه الكاتب الفرنسي خلال الشهور والسنوات المقبل؟
ثمة سيناريوات كارثية منشورة يطرحها بعض المختصين بالتفاصيل. لكنها تنزوي، على استحياء، في صفحات الكتب والمجلات العلمية، بقدرة قادر. فالوجه الآخر من هزيمة أهل النظام الأخلاقي والثقافي العالمي يتمثل في قدرة «السياسي» على تهميشهم وتهميش وعيهم في شكلٍ متزايد، إن لجهة إدراك دلالات العبَث العالمي الشامل المعاصر ابتداءً، أو لجهة البحث عن سبل مواجهة نتائجه قبل أن تؤدي إلى الفوضى الكبيرة.
هكذا يَهزم السياسي منطق الثقافة والأخلاق، وهكذا يسخر من أهلها، وهكذا يُعلن اهتراءها، ليزرع بذور عالمٍ بلا ثقافةٍ ولا أخلاق.
* كاتب سوري
الحياة