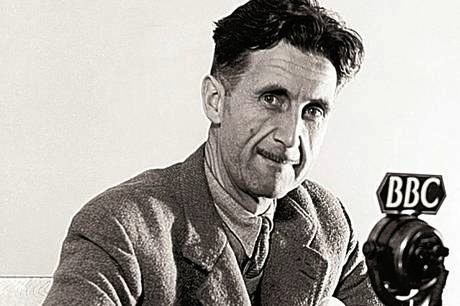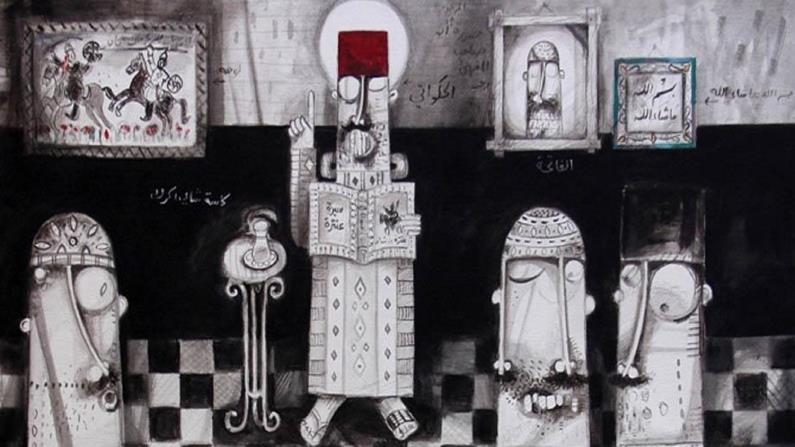وداعا سميح القاسم

سميح القاسم.. رحيل المغني المحارب/ عباس بيضون
بعد محمود درويش يتم برحيل سميح القاسم غياب الثنائي الذي أشرف على العالم العربي والشعر المعاصر من قلب فلسطين المحجوبة حتى ذلك الوقت. وكان صوت درويش ـ القاسم أكثر من قصيدة، كان صوتاً مجروحاً ومعذباً وصارخاً بقدر ما كان استذكاراً وهوية واسماً آخر وعنواناً لفلسطين. لقد ظهر ذلك الصوت قبل السلاح وكان بالتأكيد يحمل في طياته كل الكثافة وكل الزخم اللذين تكدست فيهما لا الذكريات فحسب، ولكن أيضاً الرعف والحنين والتواريخ الدامية والمضيئة وسلسلة الثورات والمعارك والبطولات المكسورة والحروب الخاسرة.
درويش والقاسم لا نظلم أياً منهما حين نقرنهما ببعضهما بعضاً فقد تواصل الاسمان كما تواصل الشخصان وكانا معاً وجهاً مزدوجاً ومتفارقاً لفلسطين التي غدت بدءاً من أواسط القرن الماضي ضميرنا وسرنا وجرحنا في آن معاً. لقد بدأ هذا التاريخ بخسارة مدوّية ومأساة وسيبقى هذا طابعه وستبقى هكذا دمغته وسيبقى ينزف ويكون نزفه وتكون تنهداته إيقاعنا ولحننا، ربما لهذا ظهر المغني قبل المحارب، ربما لهذا بدأت المرثية قبل الأهزوجة، ربما لذلك ورثنا هذا الجرح وأورثناه وتركناه ينطق ويتكلم عنا.
سميح القاسم الذي اهتدى من شيوعيته إلى فلسطينيته أو كانتا في الأصل واحداً، لقد بقي له وللعرب الباقين هذا الركن وذلك المعزل، وكان ينبغي أن يمر وقت كاف حتى يتحول هذا المعزل إلى دوامة وذلك الركن إلى معترك، وبالتأكيد كان لسميح القاسم وبقية الشعراء والكتاب الفلسطينيين الذين صدحوا من فلسطين الصيحة الأولى التي وصلتنا مدماة متقطعة وكان ينبغي أن يمرّ وقت قبل أن تمتلئ وتتّسق وتمور بالنياعة والنضارة وتغدو كونية وملحمية وتستعيض عن منفاها في وطنها بمنفى عالمي وتغدو الأرض بكليتها بلدها ومنفاها ويغدو الشتات أسطورتها وسِفرها وتغدو فلسطين معها ومعهم ايتاكا الجديدة ويغدو الشاعر عوليسها الجديد.
بقي سميح القاسم في فلسطين وهاجر محمود درويش قبل أن يرجع في عودة ثانية إليها. لكن الباقي ما كان له أن ينكسر وما كان لصوته أن يشحب ويخفت. لقد بقي تحت زيتونته وكان عليه أن يصدغها وأن يصرخ في وجه من يريد أن يغصبه إياها. كان عليه أن يشهر قصيدته كما لو كانت سلاحاً وأن يحارب بها ويُطلقها على المتربصين به. كان عليه أن يبدي أسنانه لا قلبه وحده، وأن يخيف ما وسعه أن يخيف، وأن يصرخ ما أمكنه أن يصرخ وحين كان وحده في الدرب، وحده في العزلة، كان يرفع صوته بنشيد المحارب، يواجه بكبريائه مَن يضعون أصابعهم في جرحه. كان يرفع رأسه من فوق مضطهديه. وظل دائماً في تخييل المعركة. كما ظل دائماً في ذكرى المواقع والأيام والحروب. تلك كانت تحييه في الذاكرة وتحييه في الخيال وتحييه في الواقع حتى لا يقتله القهر ولا تقتله العزلة.
كان له نشيد المحارب الذي يتحوّل أحياناً إلى أغنية نصر واستدعاء للمستقبل وأمل لا يشيخ وبشارة خضراء كالزيتون. بقي سميح القاسم في فلسطين حيث كان عليه أن يقاتل وأن يغني في المعركة وأن يهلل ويرتجز في وسطها. أما درويش فقد هاجر ليبحث ثانية عن ايتاكا ـ فلسطين وليغني خسارته وليحمل المرثية إلى ضفاف العالم.
كتب سميح القاسم كثيراً. ألّف ما يزيد على الستين مؤلفاً في الشعر والرواية والمسرح والمقالة والترجمة والرسائل. كان الحبر والحرف بالتأكيد حياته الثانية وكلما خط كلمة عربية كان يسترد بذلك هويته ويحيي فلسطين، يستردها بالكتابة ويستردها بالشعر ويستردها بالأغنية ويستردها بالنثر، وحين أصابه السرطان واجهه بكبرياء المحارب وشجاعة المحارب. لم يترك قلمه يسقط من يده ولم يخف من المرض بل حاول أن يخيفه هو الذي اعتاد منذ نعومة أظفاره أن يخيف ما هو أشد من السرطان وأقوى من الموت.
السفير
سميح القاسم… رحل وعيناه على غزة/ عبده وازن
لو كان له أن يكتب قصيدة جديدة عن المأساة التي يعيشها أهل غزة الآن لكتب بلا تردد، لكنه كان يعاني مأساته الشخصية مواجهاً المرض العضال الذي فتك بجسده بعد ثلاث سنوات من المواجهة. مات سميح القاسم وهو يردد مقاطع من قصيدته الشهيرة «أنا متأسف» التي كتبها غداة الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على غزة عام 2008 وباتت بمثابة نشيد يردده قراؤه الفلسطينيون حيثما كانوا، في منفى الداخل والخارج.
مات سميح القاسم قبل أن يكمل عامه الخامس والسبعين، مات في مدينة صفد القريبة من مدينته الرامة في الجليل الأعلى، في قلب الأرض المحتلة التي لم يغادرها بُعيد هزيمة 1948 وما تلاها من مآس، مؤثراً البقاء تحت سماء فلسطين والنضال من الداخل، بالقصيدة والروح والعصب. وكم كان يؤلمه أن يحمل كلما سافر، جواز سفر إسرائيلياً مثله مثل سائر مواطنيه في الداخل، وأن يرى أبناء طائفته، الدروز، مجبرين على الالتحاق قسراً بالجيش الإسرائيلي، مؤدّين إلزاماً خدمتهم العسكرية. وكم هاجم القاسم هذا القرار داعياً الشباب الدروز إلى التنصل منه. ولعل هذين الأمرين الشائكين كانا يزيدان من حدة غضبه على إسرائيل ومن حماسته في مواجهتها مواجهة سافرة، وصب حمم ناره على رموزها وجيشها الغاصب، وعلى وجودها القائم على أنقاض فلسطين. وكان لا بد له من المضي في التزام المقاومة بصفته واحداً من شعراء الأرض المحتلة، واحداً من أبرز هؤلاء الشعراء وأشدهم إشكالاً واختلافاً. وهذا ما وسم شخصه وطبعه وسلوكه كشاعر يكتب بحرية، متألماً وغاضباً وناقماً وساخراً ولكن بمرارة.
كان سميح القاسم غزيراً في كتابة القصائد والأناشيد وفي إصدار الدواوين التي تخطت الستين، وابتدع سلسلة من الأعمال الشعرية سماها «السربيات» ضمت قصائد له ذات نفس ملحمي، تدور حول مأساة الفلسطينيين المنفيين والمقيمين. كان القاسم أشد غزارة من رفيق دربه الشاعر محمود درويش، وقد جمعت بينهما منذ الستينات صداقة متينة توّجها نضالهما المشترك في الحزب الشيوعي ودخولهما سجون العدو عقاباً لهما على قصائد عاصفة ومواقف وطنية صارخة. لكنّ هذه العلاقة عرفت لاحقاً حالات من التوتر ثم ما لبثت أن استتبت وراحا يتبادلان رسائل صدرت في كتاب.
سميح القاسم شاعر المراحل والمدارس، بدأ ينظم الشعر العمودي ثم انتقل الى الشعر التفعيلي الذي هيمن على المشهد الشعري السياسي والنضالي، منتقلاً من رومنطيقية خفيفة إلى واقعية شبه إيديولوجية ملؤها الحماسة، فإلى نزعة رمزية وصوفية وحكمية استمدها من عقيدته التوحيدية. لكنه لم يستكن في مدرسة ولم يثبت على تيار، بل ظل يتنقل بين هذه الاتجاهات، معرّجاً على التراث العربي والحضارات والأساطير ورموزها، ومنفتحاً على الحداثة العربية والغربية عبر اللغة العبرية التي كان يتقنها ويقرأ فيها الأدب العالمي ويترجم من خلالها بعض النصوص المسرحية. ولم يتوانَ عن المساهمة في ترجمة قصائد للشاعر اليهودي المعروف روني سوميك.
عرف الشعر الثوري، الغاضب والناقم، الذي كتبه القاسم رواجاً عربياً كبيراً، وانتشرت قصائده شعبياً، ومنها على سبيل المثل «منتصب القامة أمشي» التي لحنها مارسيل خليفة وغناها، وما زالت الأجيال الجديدة ترددها بحماسة: «منتصب القامة أمشي/ مرفوع الهامة أمشي/ في كفي قصفة زيتون/ وعلى كتفي نعشي». ومن هذه القصائد قصيدة «تقدموا» التي يقول فيها: «تقدموا /تقدموا/ كل سماء فوقكم جهنمُ/ وكل أرض تحتكم جهنم…». لكن القاسم كتب قصائد أقل شعبية بل نخبوية موظفاً فيها ثقافته ووعيه الشعري ورؤياه الميتافيزيقية، معتمداً تقنيات أسلوبية جديدة مثل الكولاج والبناء المتدرج.
رحل سميح القاسم شاعر القضية الفلسطينية وعيناه مفتوحتان على مأساة غزة، متألماً وغاضباً بصمت. رحل من غير أن يهاب لحظة الموت المرير على سرير المرض العضال، هو الذي قال مرة: «أنا لا أحبك يا موت/ لكنني لا أخافك».
سميح القاسم قايض الدم بالدم وأضرم النار في الشعر/ محمد علي شمس الدين
لم يكتب سميح القاسم (1939 -2014) القصيدة الخافتة أو المائلة، كما فعل توأمه ونده في الشعر الفلسطيني محمود درويش بعدما زار الموت وعاد منه بالـ «جدارية». لم يكتب سميح بلهاث خافت ولغة تراوغ وتغامر في الموت كدرويش، رغم أن الموت طرق بابه بشبحه الأكثر توحشاً (السرطان )، منذ أكثر من عامين، بل قام وفتح له الباب، وأجلسه إلى جانبه وقدم له فنجان قهوة، وطلب أن يقرأ بخته ( طالعه ) في الفنجان. في ديوان «كولاج 3» (2012)، وهو من أواخر إصدارات الشاعر، روح دعابة سوداء قريبة من روح إميل حبيبي في «المتشائل»، الذي قال «ليس لدينا سوى ثقب صغير وعلينا أن نخرج منه». ولا أحد يعرف هذه الروح سوى الفلسطيني الذي في ضحكه حشرجة المعزولين في نفق محمّى، أو داخل شاحنة تائهة في صحراء في رمضاء وعليه أن يضحك لأن صراخه مهدور.
وحين يلتوي سميح لا تعرف هل يلتوي من شدة الألم أم من فرط السخرية. حين كنا في القاهرة، في ملتقى الإبداع العربي 2010، نظر إلي سميح بغرته الجميلة، وقال لي: أنا سميح الزرقاوي ( نسبة لولادته في الزرقاء من الأردن )، أحد أجدادي من القرامطة، وابني اسمه «وطن محمد». وأردف: وهو ما يغيظ الحواجز الإسرائيلية.
قلت له: أظن أنك تعود بأرومتك إلى عمرو بن كلثوم، صاحب «ألا هبّي …»، ففيك مثله نخوة عصبية، وتحد، وشعرك يتقدم كفيلق أو دبابة، وذكرت له قصيدته «تقدموا تقدموا»… وذكرت أن المؤسس الأول لشعر المقاومة، هو جدنا عمرو بن كلثوم، القائل: « ألا يجهلن أحد علينا…» قال: نعم، «ألا لا يجهلن»… وضحكنا معاً.
تمر الأيام، وتطرد صورة صورة ، وفي الأيام الأخيرة، وقد تجاوز العنف الإسرائيلي على غزة، حدود المخيلة، برز وجه سميح القاسم، من خلال الشاشة، وهو يقول: أمشي… وأمشي، إلى آخر الأغنية. لم أنظر إلى وجه سميح المهشم بالسرطان، بل أغمضت عيني على صورته الطفولية التي أحبها: فتى جميل نقي خطيب أليف ساخر ساحر. وحين كان يردد «وأنا أمشي وأنا أمشي» كنت أردد قوله في ديوان «الموت الكبير»: «أنا الغضب \ حديقتي تمتد من سري \ إلى أبعد ما في الأرض من أسرار \ حديقتي تنهار \ لذا فإنني \ سأجدل الإعصار».
صوت خاص
لم يكتب سميح القاسم القصيدة الخرساء، وهي أصعب أنواع الكلام، ولا القصيدة البيضاء، بل القصيدة المجروحة، و دمها يرشح من أطراف الحروف، وصوته يصعب أن نخطئه بعد مسيرته الطويلة، حتى ولو اشتبك أحياناً مع أصوات أخرى من شعراء المقاومة الفلسطينية، (معين بسيسو، محمود درويش، توفيق زياد، حنا أبو حنا، احمد دحبور…)، فثمة شحنة من الغضب مزروعة كلغم في أصل كل قصيدة، من ديوان «دمي على كفي» (1967) و«دخان البراكين» (1968)، حتى مجموعته الأخيرة «كولاج 3» (2012)، ولعل الشاعر قد رش شيئاً من النار على هشيم الكلمات المهزومة للشعر العربي، وعلى المناحات الطويلة، من ديوان «نهر الرماد» لخليل حاوي، إلى قصيدة «شعراء الأرض المحتلة» لنزار قباني، أي من خمسينات القرن الفائت حتى سبعيناته.
إن الشعر النقدي المبدع لهؤلاء الشعراء، ومنهم مظفر النواب، وأمل دنقل، كان يراوح بين الشتيمة المعبرة وينبش قبر الأمة العربية (البائدة ) والدعوة للانتحار احتجاجاً. ولعل قول خليل حاوي «ماتت البلوى ومتنا من سنين» يتردد مع قول نزار «يطأ الإرهاب جماجمنا، ونقبل أقدام الإرهاب»، مع قول مظفر «يا أولاد ال … هل تسكت مغتصبة؟» … ويعود خليل حاوي فيختصر المشهد برمته بقوله «عمّق الحفرة يا حفار…». هذا الشعر المعبّر عن الهشاشة التاريخية للأمة. كان في جانب منه لسان حالها. وكانت قوتها الكامنة والمستورة في الوجه الآخر المعتم للقمر، يسترقها شعراء آخرون مبدعون وإستراتيجيون مثل بدر شاكر السياب (مثالاً)، وجاء شعراء الأرض المحتلة ليتوسطوا المشهد. رش سميح القاسم على الهشاشة التاريخية العربية، شيئاً من النار، وحرك لسانها بخيط من الغضب، ثم حاول أن يوظف الموت على باب القصيدة والقصيدة على باب الغضب، والغضب على باب الانتقام، والانتقام على باب المظلومية.
واليوم، بعد أن اكتملت حياة سميح القاسم بالموت، فإنه بهذا الموت الجسدي، قد فتح كتابه (شعره) كتجربة من تجارب الشعر العربي الحديث والمعاصر تستدعي القراءة. وقراءة هذا الشعر الغزير والمتنوع أسلوبياً ولغوياً، تضعنا أمام تفاصيل وحوادث وأماكن معروفة، تقطعها بروق جارحة، على امتداد القصائد، فيظهر على أنه شاعر ينابيع للميثولوجيا أو للثيولوجيا أو للتواريخ المتنوعة التي يستلهمها، فهو على هذا الأساس شاعر ذو اختلاط عجيب، غنائي وسردي حكائي، واقعي، بالملموس والمحسوس وميثولوجي، يستعمل الأوزان الخليلية المغلقة أو المطلقة، كما يستعمل النثر السائر، والكلمات الأجنبية، ومقاطع من الكتب المقدسة من التلمود إلى العهد الجديد إلى القراّن.
ويؤسس بعضاً من سربياته (أي قصائده الطويلة التي تتقدم كأسراب) على أساطير متنوعة، تارة يأخذها من الميثولوجيا الإغريقية، أو من أوروبا في القرون الوسطى، كما هي الحال في سربية «كلمة الفقيد في مهرجان تأبينه (مؤسسة الأسوار، عكا 2000 ) أو يأخذها من الأساطير السورية والكنعانية. وهو يصهر كل هذه العناصر المتباينة في بوتقة القصيدة، ويستنبت من اليوميات القريبة والسياسات المعروفة الراهنة ما يشبه أسطورة الواقع الفلسطيني بكل تفاصيله الدامية والثائرة، يقدمها مشبوكة مع ما يستدعيه هو إلى ساحتها من أساطير وميثولوجيات وأديان. و هو في الكثير من أناشيده الدامية، شاعر ذو روح لوركية (نسبة إلى غارسيا لوركا)، نشأت قصائده واندلعت في بؤرة التوتر والغليان التاريخيين على أرض فلسطين، وشرارتها ذات برق صوري ولغوي مباشر أحياناً، ومجازي رمزي في أحيان أخرى، وهي ذات خطف وإلحاح في الخطف، من خلال ضغط الكلمات الكثيرة ودفعها في مجرى ضيق.
يقول: «إلى أين هذا الذهاب الإياب الحضور الغياب السراب الخراب العذاب؟» ويقول: تعبت علمت جهلت سألت أنا هملت أم سميح؟» (من ديوان كلمة الفقيد…).
التاريخ الفلسطيني شعراً
يكاد سميح القاسم، من شدة غزارته في الكتابة، يحول تفاصيل حياته وكلماته وأفكاره، إلى منظومات شعرية، يسرد فيها ما يرى، أو يقول ما يعيش.
ولعل الكثير من قصائده، يحمل سمة اليوميات الشعرية، يقول: «قري يا عيني مارست التاريخ \ قري يا عيني أدمنت التاريخ» … حتى لكأنه يخشى من محو الذاكرة الفلسطينية فيذكرها في أدق يومياتها وتفاصيلها. يقول:»القواد المتكئون على الأسطول السادس والسفراء الضباط التجار الوكلاء الخبراء \ كانوا ثقباً تتسلل منه الجرذان الأميركية \ والسلع الأميركية \ والنفاثات الأميركية \ وصواريخ الأطلنطي المعروفة والسرية» ( ديوان الموت والياسمين ). و هو في السرد حكائي، نثري، وغالباً ما يلجأ إلى ترويدات شعبية من الفولوكلور الفلسطيني… ما يقربه من لوركا في «الأغاني العميقة».
أخيراً نلاحظ أن طواعية الكلام تقرب القاسم من الجمهور العام، ويقترب في قاموسه من نزار قباني، لكنه في أحيان كثيرة، يظهر على أنه شاعر فنتازيا كلامية، ويخترط مآسيه بالسخرية… وبنيته الإيقاعية مركبة… ولعله من أجل هذه الفنتازيا بالذات، والسخرية، جعلته سلمى الخضراء الجيوسي، شاعراً ما بعد حداثي.
مات سميح القاسم وفتح كتاب شعره لنقرأه.
سميح القاسم آخر شعراء المقاومة في فلسطين/ فخري صالح
بعد رحيل راشد حسين وتوفيق زياد ومحمود درويش وسالم جبران، والآن سميح القاسم (1939- 2014)، تكون كوكبة شعراء المقاومة الفلسطينية، الذين تكرست ظاهرتهم في العالم العربي منتصف ستينات القرن الماضي، قد غادرتنا. صحيحٌ أن تلك الظاهرة الشعرية، التي انضوى أعضاؤها جميعاً في إطار حزب راكاح الشيوعي الإسرائيلي (لكنهم كانوا، ويا للمفارقة، مدافعين شرسين عن الوطنيّة الفلسطينية والانتماء القومي العربي)، قد أصبحت جزءاً من تاريخ الشعر العربي في القرن العشرين، لكنّ محاولة النظر إلى المنجز الشعري للصديق الراحل سميح القاسم تتطلّب تعيين موقعه في قلب تلك الظاهرة التي مثّلت بعد هزيمة العرب عام 1967 رافعة سياسية وشعرية للفكر القومي الذي تعرّض لامتحان صعب في ذلك الوقت.
والأهمية التي اكتسبتها ظاهرة شعراء المقاومة بعامة، وشعرُ الموهوبين المكرّسين من المنضوين في إطارها (ونخصّ بالذكر هنا محمود درويش وسميح القاسم اللذين واصلا الكتابة الشعرية وتطوير منجزهما والتجريب في دائرة الأشكال الشعرية، وكذلك حافظا على البقاء قريبين من نبض الشارع الفلسطيني والإصغاء للتحولات التاريخية التي ألمّت بالقضية الفلسطينية)، تتجاوز بعدها الفلسطيني إلى المحيط العربي الذي تلقّف هؤلاء الشعراء بلهفة، وبعد طول انتظار، بوصفهم بارقةَ أمل سياسية وشعرية، ربّما.
في المعنى السابق يمكن النظر إلى سميح القاسم كواحدٍ من أبرز شعراء الأرض المحتلة، وشعراء المقاومة الفلسطينية، إلى جانب محمود درويش وتوفيق زياد. تبرهن على ذلك مجموعاته الشعرية الأولى التي تلهب المشاعر، وتتحدى الاحتلال والعنصرية الإسرائيليتين، وتشدد على الانتماء إلى الأرض الفلسطينية والالتصاق بها، والإصرار على عدم الرحيل عنها، وتؤكد الانتماء القومي العربي للفلسطينيين الباقين على أرضهم عام 1948، كما تظهر في الوقت نفسه على تواصلها مع التحولات الشعرية العميقة التي ضربت جسد القصيدة العربية في نهاية أربعينات القرن الماضي.
هذا ما نعثر عليه في دواوين سميح التي ظهرت قبل هزيمة 1967: «مواكب الشمس» (وهي مجموعته الشعرية الأولى، 1958)، و«أغاني الدروب» (1964)، و«دمي على كفي» (1967)؛ وكذلك في دواوينه التي تلت الهزيمة وكرّسته واحداً من الشعراء الفلسطينيين والعرب البارزين على رغم حداثة سنه في ذلك الوقت: «دخان البراكين»، و«سقوط الأقنعة» ( 1969)، و«يكون أن يأتي طائر الرعد» ( 1969)، و«اسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الداخل» (1970).
لكن تجربة سميح القاسم الشعرية لم تبق أسيرةً لهذا البعد، المباشر والحماسيّ، بل الشعاريّ أحياناً، لظاهرة شعر المــقاومة الفلسطينية، بل رادت بحقّ أقاليم جديدة في الكتابة الشعرية يغلب عليها التجريب والتنويع على عدد من الأشكال الشعرية والتيارات والأساليب المختــلفة. فشــعر سميح، بدءاً من منتصف سبعينات القرن الماضي، ينتقل من القصيدة الغنائية إلى الخطابية المباشرة إلى البناء المركب وصولاً إلى النثر العادي، ما يجعل قصيدته غير مرهونة لتيار شعري تقليدي أو حداثي بعينه.
هناك إذاً عدد كبير من مجموعاته الشعرية، غزيرة العدد في العقود الأربعة الماضية، تعكس تجريباً متواصلاً في اللغة والنوع الشعري مثل «الموت والياسمين» (1971)، و«الموت الكبير» (1972)، و«مراثي سميح القاسم» ( 1973)، و«ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» (1976)، و«ثالث أكسيد الكربون» (1976)، و«أحبك كما يشتهي الموت» (1980)، و«الجانب المعتم من التفاحة، الجانب المعتم من القلب» (1981)، و«جهات الروح» (1983)، و«كولاج» (1983)، و«سربية الصحراء» (1984)، و«الشخص غير المرغوب فيه»، و«لا أستأذن أحداً» (1988)، و«الكتب السبعة» (1994)، و«خذلتني الصحراء: سربيّة» (1998)، و«ملك أتلانتس: سربيّات» (2003)، و«عجائب قانا الجديدة: سربيّة» (2006)، و«كولاج – 2» (2009)، و«هواجس لطقوس الأحفاد: سربية» (2012)…
ويمكن أن نلحظ في عناوين تلك المجموعات الشعرية ابتداعاً لأشكال شعرية وتسميات جديدة لأنواع غير مألوفة في الكتابة الشعرية العربية: مثل «السربيّة»، وهي شكلٌ شعري يقترحه القاسم يمزج فيه بين الشعر والسرد، والمراثي التي يبدو البعد التوراتيّ الإنجيلي حاضراً فيها بصورة لا تخطئها العين ، بل والقرآني (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم»). لكنه يعود في مرحلة سبعينات القرن الماضي إلى كتابة شعر الحماسة، مصدراً عدداً من المجموعات الشعرية التي تحمل عنوان «ديوان الحماسة» (الجز الأول 1978، الجزء الثاني 1979، الجزء الثالث 1981)، مذكّراً قارئه بدواوين الحماسة العربية التي تجمع شعر الفخر والحروب والنفس المقاتل، وكأنه يعود، لكن على نحوٍ أكثر تقليديّة، إلى سيرته الأولى في كتابة الشعر المقاوم، المباشر، التحريضي الذي ظلّ غالباً على منجزه خلال العقود الثلاثة الأخيرة من حياته الشعرية المديدة (منتصب القامة أمشي: مختارات شعرية، 2012).
سميح القاسم شاعر التراب الفلسطيني وكبرياء القضية (1939 – 2014) شاعر الفدائيين/ عقل العويط
مات سميح القاسم. ماذا يمكن أن يقال فيه، وشهرته تتقدم شعره وشعريته؟! أجدني أكاد أقول، بسببٍ من هذه الشهرة المدوّية، التي تكاد تسحب كل بساط من تحت التأويل النقدي: لا فائدة لأيّ نقد، أو لأيّ تحليل.
والحال هذه، لا شيء ينصف سميح القاسم سوى قصائده التي يردّدها الفدائيون، وهم ذاهبون في عملياتهم الفدائية، تحت الليل، في أول طلوع الفجر، وفي هندسات الخيال.
أستطيع أن أسمّي تلك القصائد “الخطيرة” أيقوناتٍ ثورية. وكما تضيء الأيقونات أمام المؤمنين، كانت قصائد سميح القاسم تهرع للانضمام إلى حيث قصائد شاعر المقاومة الفلسطينية الأول، محمود درويش، لتضيء معها، شقيقةً إلى جانب شقيقة، وإن على تفاوتٍ في المستوى بين الرجلين، الدروب المعتمة أمام الثوّار الذين أشعروا العرب أجمعين بكراماتٍ لطالما افتقدناها في كنف الاستبداد والتخلف والرجعية.
لا شيء ينصف سميح القاسم سوى غنائيات تلك القصائد، وما أضفته من لمعانات خلاّقة في العيون، وما أجّجته من كبرياءات مضافة في صدور الأمهات، وما زرعته من ابتسامات شعرية على شفاه الأطفال، يدندنون جميعهم في المخيمات والملاجئ، في الشوارع والأزقة، كما في المنافي، وبلدان الشتات، قصائده التي صارت أغاني ومعجزات تطلّ كعملياتٍ فدائية من وجوه الأيقونات.
هل يعني القارئ، وخصوصاً القارئ الفلسطيني، والعربي، ماذا يُمكن أن يقال في شعر سميح القاسم، نقداً، أو تحليلاً، لمعرفة مكانته في الشعرية الفلسطينية، تالياً في الشعرية العربية؟
لستُ أدري، كم يعنيه ذلك، في مثل هذه اللحظات!
لو كنتُ سميح القاسم، لكنتُ استمحته عذراً، ولكنتُ فضّلتُ لهذا الشاعر بالذات، بسببٍ من فلسطينيته، وبسببٍ من القضية، قضيتنا، بل بسببٍ من حبّي اللاحدود له لفلسطين، أن يختصر أعماله الشعرية الكثيرة، بقصيدة، بقصيدتين، بثلاث، بعشر، بعشرين. أكثر قليلاً، أو أقلّ قليلاً، لا فرق. لكن، ليس أكثر.
هذا مدعاته وذريعته، عندي، الاحترام الكامل للرمزية الأيقونوغرافية الثورية التي يجب أن ترافقه إلى مثواه الأخير. هذا حقّ له، بالطبع، لا يرقى إليه أيّ شكّ، ولا يعتوره أيّ التباس.
على أن سميح القاسم المجلّل برمزيته وهالاته، والذاهب إلى مثواه، في الرامة، أرضه الأولى، كان “شاعراً كبيراً”، فقط لأنه غنّى فلسطين، ولأنه كان، في أحد الأيام، شاعر فدائيين ومقاوِمين، في معنى ما.
هذا لأقول استطراداً، وبنوعٍ من التهيّب، بسبب المناسبة، إنه كان شاعراً. ولم يكن شاعراً كبيراً. قد يكون في هذا القول شيءٌ من ابتسار وتجنٍّ وتعسّف. ليس هذا هو القصد. حاشا.
له، ولمحبّي شخصه وشعره، ألف تحية، واعتذار.
لكني أقول باعتزاز، إن فلسطينه تتقدّم عموماً على شعريته، مع بعض الاستثناءات القليلة. واعتقادي أن هذه “الفضيلة” الفلسطينية المطلقة، عنده، تغفر للشاعر عدم تعالي الحنكة الشعرية، وموهبتها، إلى أن تتساوى بالرمزية الفلسطينية في قصيدته، هذه التي تعلو، بأشواط، على أيّ قيمة جمالية أخرى.
كان مقامه الشعري ليكون أشد رسوخاً، لو أن شعريته كانت موازية لفلسطينيته. لكن مثل هذا التوازي تنوء به الجبال العاليات، فكيف لا ينوء تحته شاعرٌ رقيق مثل سميح القاسم؟!
لهذا السبب بالذات، كم كان سميح القاسم ليكون فريداً في نوعه، لو أنه لم يكتب الكثير. لو أنه كان مُقِلاًّ. لو أنه تدارك كثيره بالقليل من القصائد التي جعلته يحضر برمزيته القصوى، مخترقاً الوجدان الجمعي للفلسطينيين، للفدائيين، وللحالمين بدحر العدوّ الصهيوني البغيض، الجاثم على أرض فلسطين.
ما لي ولهذا كله. فكل شيء يصغر الآن أمام قصيدة، قصيدتين، أو ثلاث له، أو عشر، يكفيه أنه كتبها، وأنها ستظلّ مقترنةً باسمه وبعطور ظلاله كلما عنّت فلسطين بالبال.
يجب أن نتذكر دائماً أنه صاحب هذه الكلمات التي ألهمت فدائيين كثراً، وجعلتهم يقتحمون الغمار في مواجهة العدوّ الخسيس: “تقدموا/ تقدموا براجمات حقدكم وناقلات جندكم/ فكل سماء فوقكم جهنم/ وكل أرض تحتكم جهنم”.
يجب، كلما أردنا أن نتخيّل صورة الفلسطيني الفدائي الثائر، أن نتذكر هذه الكلمات: “منتصب القامة أمشي/ مرفوع الهامة أمشي/ في كفّي قصفة زيتون/ وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي”.
سلامي إلى شاعر الفدائيين.
سميح القاسم شاعر التراب الفلسطيني وكبرياء القضية (1939 – 2014) الشعر عنده امتهانٌ للمقاومة/ رلى راشد
الارتباط بين التربة وبين الشغف، لعنة ونعمة. انهما لحَظّ وتعاسة على السواء أن يصير المرء صوت بلاده، أن يؤتمن على التحدث باسم مواطنيه جماعةً وفرادى. هبة فريدة هو البوح الجماعي، ومرض خبيث هي الخيبة من الجماعة أيضا.
بيد أنه لا مفرّ في شرقنا المصلوب والمسلوب من رغد الحياة اللامكترثة، في شرقنا المطأطئ الرأس منذ عقود، في شرقنا الذي تتهدده سيوف التطرف وقدر الإستعباد وهول الاحتلال، لا مفرّ من أن يقيم الشاعر في وسط أهله، أن يقترض كلماتهم ويتلوّن بوجعهم. فكيف اذا دمغ المرء بجرح سرمدي؟ يتفيأ سميح القاسم الراحل للتو، زيتونة فلسطين الوارفة، يجد تحتها راحته ويستطيع في جوارها أن يجعل رأسه يستريح.
من جيل المأساة يأتي، ومن هول الفاجعة الكبرى، ليستحيل عنوة ربما، رمزاً قومياً في السراء والضراء، فيكتب متحسراً على سقطتنا العميقة: “هنا… في قرارتنا الجائعة. هنا… حفرت كهفها الفاجعهْ. هنا… في معالمنا الدارساتِ. هنا… في محاجرنا الدامعهْ . نَبوخَذُ نصّرُ والفاتحون. وأشلاء رايتنا الضائعهْ”.
خمسة وسبعون عاماً من الإقامة الجبرية في أرض تنزّ وجعاً، أرّخها القاسم في الشعر والنثر والمسرح والمقال. كتَب مُدركاً أن عالمنا القريب هو منذ زمن في حال موت سريري، وأننا منذ زمن أيضاً نجترّ الحكاية عينها: نقع ونرتطم أرضاً ثم نحمل الصخرة من جديد ونعاود الصعود. في جوار القاسم، تبدّت القضية قومية ووطنية وعربية، وفي أعقاب الحقبة التي انتمى إليها، نستشرفها طائفية ومذهبية وضيقة وخانقة.
كانت فلسطين محور القول، بوصلة تجتذب الألباب وتحرّك العواطف. بينما صار الوطن اليوم فكرة مستحيلة وتوقاً موهوماً، مساحة تضيق بمن فيها وتسطو على كل من أو ما يتجاسر على أن ينمو في كنفها. لم تكن قصفة الزيتونة في كفّ مَن قاوَم، رمزاً لفلسطين وحدها. كانت رمزاً لحقبة نخشى أن تكون صارت خلفنا. كانت تلك مرحلة الأحلام الأخرى والطموح الآخر والإيمان الآخر.
مع غياب القاسم، ابن الرامة في شمال فلسطين، والمتنقل بين الناصرة وأقبية الإعتقال الاسرائيلي، ينفرط عقد العصبة الشعريّة المُقاوِمة. تسقط حبّاته. رحل محمود درويش، وها إن سميح القاسم ينطفئ. كان في تلك الثنائية الشعرية رذاذ التكافل العابر للأنانيات والتحالف المتجاوز للتحديدات. تمرين على استنباط مذهب التمرّد الخالص.
درامياً كان صوت القاسم ومتعدد التأثيرات بفضل النشأة بين جدٍّ فقيه علاّمة في شؤون الدين وجدٍّ علماني حداثي إلى أبعد حدّ. والحال، أن دهشة الاختلاف حتى تبدو في حاضرنا القريب ترفاً لا قدرة لنا عليه. فماذا يبقى لرحابة الشعر في ظلامية الرؤية؟ ماذا يصمد من حرية الإجهار في يوميات التزمت العربي القابض على أنفاسنا، يُحلّل ما يحلّل، ويحرّم ما يحرّم، وهل يسمح بأن يتكرر إجهار قاسم: “أنا لـم أحفـظ عـن الله كتابا. أنا لـم أبنِ لقـديسٍ قبـابـا. أنا ما صليتُ… ما صمتُ… وما. رهبت نفسي لدى الحشر عقابا. والدم المسفوك من قافيتـي/ لم يراود من يَدَيْ عَدنٍ ثوابا/ فهو لو ساءلتـَه عن مَطْمَـحٍ/ ما ارتضى إلا فدى النور انسكابا”.
عن واقعٍ بابليّ، كتب القاسم، وعن بابل يُظللنا سنستمر في الكتابة. نسأل مع رحيل القاسم عن أيّ نمط من الشعراء سنتحدّث بعد عقدين أو أكثر؟ أي كاتب سنرثي حين يصير الوطن مجرد فكرة مارقة، لا أساس يتكئ عليه ولا قيم يغرف منها؟ لم يعد بيننا كثيرون يحملون قضية، ذلك أن كثيرين جعلوا أنفسهم هم القضية. وهنا الطامة الكبرى.
كتب القاسم على نقيض انهيار هذا العالم، وعلى أنقاضه أيضاً. سميح القاسم أحد عرَب الداخل وأحد العرب المنبثقين من الداخل، ذلك أنه وعى حقيقة أمته التي راوحت في حدود القرن الرابع عشر ووعيه وأخلاقياته وهواجسه، على ما أعلن مرة، متحسراً على مجتمع يستهلك الحداثة.
لم يكن ممكناً لقصائده الأولى الغزيرة أن تكون أقلّ عدداً. ذلك انها كانت انعكاساً للكلمة الجماعية ولجريان الثورة في أوردة الشاب الثوري. تنقّت التجربة لاحقاً وتصفّت وصارت تتخذ شكل السربية تتشعب وتستطرد، لتنوب عن أولئك المَرديّين بالبؤس والهالكين بالموت المُبكر ومغادري الحاضنة الأسطورية غصباً عنهم. ربما يقول قائل إنه يؤخذ على القاسم عدم دخوله تجاويف توعّك اللغة، لكنه استعاض عنه بمحاربة لا تستكين وبتسلّل نادر بين أطياف المعيش.
الشعر عند سميح القاسم مكان يستبق إلحاحنا اليوتوبي، أحمَلَهُ صوت جوليا أو صوت مارسيل أو من حولهما.
الشعر عنده امتهان للمقاومة.
قصائد
طائر الرعد
ويكون أن يأتي
يأتي مع الشمس
وجه تشَّوه في غبار مناهج الدرس
ويكون أن يأتي
بعد انتحار القحط في صوتي
شيء.. روائعه بلا حدّ
شيء يسمّى في الأغاني
طائر الرعد
لا بد أن يأتي
فلقد بلغناها
بلغنا قمة الموت.
* * *
إقطاع
يا ديداناً تحفر لي رمسي
في أنقاض التاريخ المنهار
لن تسكت هذي الأشعار
لن تخمد هذي النار
ما دامت هذي الدنيا
ما دمنا نحيا
في عصر الاقطاع النفسي
فسأحمل فأسي
سأشُجُّ حماقات الأوثان
وسأمضي.. قُدماً، قُدماً، في درب الشمسِ
باسم الله الطيب.. باسم الانسان!!
* * *
في القرن العشرين
أنا قبل قرونْ
لم أتعوّد أن أكره
لكنّي مُكره
أن أُشرِعَ رمحاً لا يَعيَى
في وجه التّنين
أن أشهر سيفاً من نار
أشهره في وجه البعل المأفون
أن أصبح ايليّا في القرن العشرين
* * *
أنا.. قبل قرون
لم أتعوّد أن أُلحد !
لكنّي أجلدْ
آلهةً.. كانت في قلبي
آلهةً باعت شعبي
في القرن العشرين !
* * *
أنا قبل قرون
لم أطرد من بابي زائر
وفتحت عيوني ذات صباح
فإذا غلاّتي مسروقه
ورفيقةُ عمري مشنوقه
وإذا في ظهر صغيري.. حقل جراح
وعرفت ضيوفي الغداّرينْ
فزرعوا ببابي ألغاماً وخناجر
وحلفت بآثار السكّينْ
لن يدخل بيتي منهم زائر
في القرن العشرين !
* * *
أنا قبل قرون
ما كنت سوى شاعر
في حلقات الصوفيّينْ
لكني بركان ثائر
في القرن العشرين.
* * *
صوت الجنة الضائع
صوتها كان عجيباً
كان مسحوراً قوياً.. وغنياً..
كان قداساً شجيّاً
نغماً وانساب في أعماقنا
فاستفاقت جذوة من حزننا الخامد
من أشواقنا
وكما أقبل فجأة
صوتها العذب، تلاشى، وتلاشى..
مسلّماً للريح دفئَه
تاركاً فينا حنيناً وارتعاشا
صوتها.. طفل أتى أسرتنا حلواً حبيباً
ومضى سراً غريبا
صوتها.. ما كان لحناً وغناء
كان شمساً وسهوباً ممرعه
كان ليلا ونجوما
ورياحاً وطيوراً وغيوما
صوتها.. كان فصولاً أربعه
لم يكن لحناً جميلاً وغناء
كان دنياً وسماء
* * *
واستفقنا ذات فجر
وانتظرنا الطائر المحبوب واللحن الرخيما
وترقّبنا طويلا دون جدوى
طائر الفردوس قد مدّ إلى الغيب جناحا
والنشيد الساحر المسحور.. راحا..
صار لوعه
صار ذكرى.. صار نجوى
وصداه حسرةً حرّى.. ودمعه
* * *
نحن من بعدك شوق ليس يهدا
وعيونٌ سُهّدٌ ترنو وتندى
ونداءٌ حرق الأفقَ ابتهالاتِ ووجْدا
عُدْ لنا يا طيرنا المحبوب فالآفاق غضبى مدلهمّه
عد لنا سكراً وسلوانا ورحمه
عد لنا وجهاً وصوتا
لا تقل: آتي غداً
إنا غداً.. أشباح موتى !!
النموذج والأمثولة/ يحيى يخلف
رحل سميح القاسم بعد حياة حافلة بالشعر والكفاح وحب الوطن وحب الحياة، وعلى خطى نبضات ودقات قلب الأرض مشى في دروب الحرية، ونثر على الطريق صرخته وناره ورسائل عشقه وصدى غضبه واشتباكه مع المحتل مقرنا الكلمة بالممارسة، رابطا القول بالعمل، والإبداع بالفعل، محملا الكلمة أكثر مما تحتمل الحروف، وكعبد الرحيم محمود وإبراهيم طوقان وعبد الكريم الكرمي وغسان كنفاني ومحمود درويش ومعين بسيسو وعشرات غيرهم ضبط خطواته على خطى الفدائيين والمقاومين ولهب الكفاح المسلح والشعبي، فكان الشعر الفلسطيني جزءا من أدبيات الثورات الفلسطينية المتعاقبة، من ثورة 1936 حتى المقاومة الباسلة في غزة، وخلق مع رفاقه المبدعين في مطلع الستينيات من القرن الماضي ظاهرة فريدة في الأدب العربي هي ظاهرة أدب المقاومة، ظاهرة لم تكن موجودة بشكلها ومضمونها اللذين وصلا إلينا، فمثَل ذلك إضافة نوعية أغنت المحتوى الكفاحي والتحرري في الفكر والثقافة العربيين. تحلى سميح بسلوك اتسم بالبساطة، والخلق الكريم عبر فيه عن ثراء ثقافته، وعمق انتمائه، وصدق مشاعره، وحميمية آسرة حببت إليه قراءه وأبناء شعبه الفلسطيني والعربي، وأكد بسلوكه كمثقف أن السلوك في ذروة تجلياته هو التعريف الحقيقي للمثقف، كان سميح هو النموذج والأمثولة، توفرت في شعره كل العناصر الفنية التي حولت معظم قصائده إلى أغاني وأناشيد، وأيقونات، وصارت مسيرته الشعرية على مدى أكثر من خمسة عقود سجلا لمسيرة كفاح شعبه، ووثيقة سياسية واجتماعية ونضالية لكل المحطات التاريخية التي مر بها الشعب الفلسطيني. من الصعب الإحاطة بسيرة ومسيرة سميح في هذه العجالة، فإبداع سميح الشعري يحتاج إلى دراسات وكتب وليس مقالة مقتضبة، ولعلي اختم كلامي بما هو شخصي، فقد رافقت فترة مرضه التي امتدت ثلاث سنوات ونصف، وكنت شاهدا على صراعه الشجاع مع المرض، وقدرته على الصمود، وقوة الحياة في روحه، فقد ظل يتحلى بمعنويات عالية، وكان لديه تصميم على الانتصار في هذا الصراع، فمنذ أن اخبرنا البروفسور جمال زيدان الذي اشرف على علاجه قبل ما يزيد على ثلاث سنوات أن حالته خطيرة، وان أمامه ثلاثة شهور فقط قبل أن يودع الحياة، حاولت أيامها مع عدد من الأصدقاء إقناعه بسرعة إقامة حفل زفاف ابنه عمر التي تم تأخيرها بسبب مرضه، إلا انه رفض وأصر على أن يكون الحفل في نهاية الصيف القادم، أي بعد تسعة شهور، كنا نود إدخال الفرح إلى قلبه، لكنه أراد أن يوحي لنا انه سيعيش وينتصر على المرض، وبالفعل جاء الصيف، وأقيم حفل الزفاف، وتزوج ابنه عمر، وأنجب له بعد عام حفيدا وهو ينحاز إلى الحياة في مواجهة الموت، وخلال تدهور حالته في الآونة الأخيرة كنت أزوره، وكانت آخر زيارة في مستشفى صفد قبل ثلاثة أيام، وكان يومها في وضع مقبول، وعندما دخلت المستشفى وضعت على أنفي الكمامة التي يتعين وضعها لدى زيارة مريض يفتقر إلى المناعة، دخلت عليه وانحنيت لكي اقبل جبينه، فمد يده وانزل الكمامة عن وجهي، وأصر على أن يقبلني. كنت اشعر في داخلي بأن هذا اللقاء ربما يكون الأخير، وان حلاوة روحه هذه ناجمة عن مقاومته للموت، وفي جو مفعم بالحميمية سألني عن عائلتي وعن روايتي الجديدة التي سبق أن أخبرته إنها قيد الإعداد، وعن العدوان في غزة، وتحدثنا عن أولادنا وأحفادنا، وفوجئت به يطلب من ابنه وطن الذي كان موجودا، فوجئت بأنه يطلب من وطن أن يريني على هاتفه الذكي مقطع فيديو يظهر فيه وهو يداعب حفيده. (سميح الصغير) ابن ولده عمر، في مشهد رائع يعيد سميح الجد إلى فرح طفولي ما مر بذاكرة شاعر. رحل سميح ولكنه ظل (باق في الرامة) كما ظل أميل حبيبي، الذي أوصى أن يكتب على شاهد قبره (باق في حيفا)، الرامة التي عاش بها مع عائلته، كما عاش بها آباؤه وأجداده، سميح اختار منذ أكثر من عشرة أعوام مكان دفنه وضريحه. اختار أرضا على تلة قريبة من بيته، وأعدها لتكون قبره وحديقته، يطل منها على سهول وتلال فلسطين وطبيعتها الساحرة التي خلقها الله منذ الأزل، سميح يذهب هناك ليموت كما تموت الغزلان، لينام هناك مثل حبة قمح تغفو في باطن الأرض الطيبة والحنونة المجبولة بمسك الشهداء.
(كاتب وروائي من فلسطين)
القصيدة كسلاح/ أمير تاج السر
أول مرة سمعت باسم سميح القاسم، كان ذلك في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حين بدأت أتلمس طريقي في سكة القراءة الحقيقية، معتمدا على نفسي في ذلك بعيدا عن تلك الكتب التي كانت تنتقيها الأسرة وتوفرها لنا. كنت طالبا صغيرا، لكن يتملكني شغف القراءة بشدة. وكانت ثمة أسماء براقة مكتوبة على كل أغلفة الكتب التي كانت تنشرها دار العودة بيروت، تحت عنوان: هؤلاء تفخر الدار بوقوفهم على عتبتها الصغيرة الخضراء.
كان من أولئك: الطيب صالح ومحمود درويش، وعز الدين المناصرة، وأمل جراح، وسميـح القاسـم، كما أذكر، وهكذا قرأت ما تيسر من نتاج أولئك الواقفين على العتبة الصغيرة الخضراء. منذ أول كتاب قرأته للراحل الكبير سميح القاسم وهو ديوان قصائد سميح القاسم، كما أذكر، التمست حماسة تفتقد في أشعار كثيرين من شعراء تلك الفترة. كان سميح يكتب المقاومة شعرا، يتحدى شعرا، وينزف في ساحة النضال شعرا، وأي قصيدة من قصائده تعادل طلقة يطلقها جندي، وشخصيا كنت أتخيله في كثير من الأحيان جنديا يخوض الحرب وقد كان بالفعل مخلصا لقضيته ووطنه الجريح ومن الذين علموا الأجيال معنى أن تحب الوطن بصدق، ولذلك جاء بقاؤه في وطنه برغم كل الصعوبات، برهانا حقيقيا على ذلك الحب.
حقيقة تابعـت ما كتبـه سميـح فترة، وتابعـت ما كتبه العـظيم مـحمود درويش أيضا، وأرى أنهما كانا شاعرين حقيقـيين، كل يحـمل سلاحه الشعري، فقط يكمن الفارق في أي نوع من السلاح يحمله كل واحد منهما، وفي الوقت الذي اتسمت فيه قصيدة درويش بالزخرفة وكثرة الصور، والخيال المكثف، اتسمت قصيدة سميح بوضوحها، وانسيابيتها الخاصة، وتغلغلها في آفاق كل الفئات التي تقرأها أو تستمع إليها.
لقد كانت وفاة درويش من قبل صدمة كبيرة، واليوم أحس أن وفاة سميح القاسم صدمة أيضا، وخسارة كبيرة للشعر الفلسطيني والعربي، كلاهما كان ضلعا من ضلوع المقاومة الفلسطينية الهامة، بل كلاهما كان رئة تتنفس عبرها المقاومة، وطبعا نردد ما نعتقده صدقا، وهو أن الإبداع الجاد والراقي، يظل هكذا موجودا دائما، والمبدع الحقيقي لا يموت بل يظل حيا ما دامت الحياة لا تزال.
(كاتب من السودان)
شاعر الأرض وأثيرُها/ أنطوان أبو زيد
يوم كنّا نقرأ للشعراء الفلسطينيين، وعلى رأسهم محمود درويش، كنّا نحسب أنّ سميح القاسم كان أصغر عمرا من محمود. وأنّ الثاني كان يتلمّس طريقه الى النجومية بنشر مجموعاته الشعرية في بيروت، وكان لا يزال معتصما بأرضه فلسطين. ويوم شرعنا في التمييز الدقيق بين الشعراء هؤلاء، ونمضي في إثر نتاجهم الشعري، بعد استشهادهم (كمال عدوان، على سبيل المثال)، صرنا قادرين على التمييز بين كتابة محمود درويش الشعرية، التي تسعى إلى بناء نماذج ومثالات خارج ما درج عليه الأدب الملتزم والمنتمي الى اليسار من إرث بشري وعالمي، متوكّئا على ذاتّية تستوعب الثراء القادم اليها، وبين كتابة سميح القاسم التي حسبنا، ذات يوم ـ من أيام ضيقنا بالإرث الأدبي الملتزم ـ أنها صنو البيان السياسي الشيوعي، لفرط تطابق المثالات والنماذج التي أخرجها الشاعر، ولا سيما في بداياته (مواكب الشمس، أغاني الدروب، دمي على كفّي..) مع المضامين السياسية والإيديولوجية التي يحملها انتماؤه، هو الشاعر المناضل في سبيل تحرير شعب فلسطين من المحتل، ومن مستغلّيه الطبقيين بلغة اليسار الملتزم. ولكن هذا التصوّر الخاطئ والمبتسر عن الشاعر سميح القاسم وكتابته الشعرية ما لبث أن تعدّل، الى أن تكوّن لدينا الانطباع بأنّ القاسم هو القامة الشعرية الفلسطينية التي جعلت الأرض (فلسطين) الهاجس والمحور الأوحد الذي تتكوكب حوله كلّ الأساطير الذاتية والتراثية، في وجدانية غنائية تستمدّ طاقتها الدرامية، لا من ذاتية ممزّقة الوجدان والانتماءات والخيارات، كما هي الحال مع درويش، وإنّما من إعادة صوغ لآلام الجماعة الفلسطينية التي ينطق الشاعر عنها بلسانه هو. بل إنّ الذاتية البارزة في أعمال القاسم، والغنائية الصارخة فيه، إنما هما صنيعتا ذوبان الأنا، أنا الشاعر الكائن الملتزم الموجود والناطق بلسان الآخر والآخرين المقهورين، وتصعيدٌ للغة الشعرية المتوتّرة دوما، في سبيل حرية فلسطين وشعبها وكرامتهما.
لم تكن أشعار القاسم لتتقدّم الانتفاضة الأولى (تقدّموا) عبثا، ولن تكون قصائده، المضمّخة بنبرة مأساوية تحاكي الجلجلة الفظيعة التي لا يزال الشعب الفلسطيني، والانسان الفلسطيني يمضي في شعابها، لن تعود هذه القصائد، بعد مواراة شاعرها الثّرى في ترابها العزيز، أسيرة اليدين والعينين وحزن القلب.
(شاعر من لبنان)
صمت الحملان/ لينا هويان الحسن
لم أنس يوما صوتك، ذات مساء ممـطر في شتـاء دمشـقي ملبد بالغيوم.
يومها عاندتُ المطر وتناسيت محاضراتي الجامعية المسائية، وفي باحة المركز الثقافي الكائن بالمزة، تحت المطر حضرتُ الأمسية الشعرية لشاعر أغرمت به لخاطر قصيدة: «تقدموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم، وكل ارض تحتكم جهنم، تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا نستسلم…».
يومها كانت كل مقاعد المركز محجوزة، ورغم المطر الغزير اكتظت الباحة الامامية للمركز بالحضور ليسـمعوا صوتك وأنت تنشد قصائدك.
خبر رحيلك، جاء ليتواطأ مع أحزان شعوب عربية موزعة على خارطة من الدماء.
هل جاء خبر موتك ليذكرنا بآمالنا التي تشبه أعشابا يانعة، داستها الفيلة؟!
بينما، الفرح، يشبه عروسا، فجأة، امتطت جوادا طائشاً ورحلت.
يوم غنيتَ أحزان فلسطين شعراً، ربما لم يخطر في بالك أن ثمة شعوبا عربية بأكملها، ستُنحر وتُباد، من دون أدنى رفة جفن، والعالم يحمل لافتة كتب عليها «صمت الحملان». . تستغيث الضحية ويصمتُ صدى حوافر خيول «النشامى».
منذ ذلك اليوم الذي بَكَت فيه فلسطين لم يتوقف العرب عن النحيب، والتباكي. .
يموت الشاعر، لينطلق اسمه مثل الأساطير، وليشبه الحكايات القديمة.
وكل الكلمات التي نطق بها يوما، تصبح عميقة، فسيحة بلا حدود.
للكلمات وحدها مأثرة الرثاء، رثاء سميح القاسم أبهى رجالات الثقافة.
ألم يهتف يوماً أندريه مالرو قائلاً: «الثقافة هي كل أشكال الفن والحب والفكر والثقافة هي التي أتاحت للإنسان أن يكون أقل عبودية على مدى آلاف السنين؟»
لهذا الثقافة مخيفة، يهابها مسبقا كل من لديه نيات لاستعباد البشر.
وحدها الثقافة قادرة على تشييد عالم حقيقي واقعي لا ينتمي إلا إلى الإنسان.
بموت سميح القاسم خسرنا آخر الشعراء الذين تزوجوا فلسطين.
(كاتبة من سورية)
لا أقرّ طقوس الجنازة/ فارس يواكيم
لم ألتق مرة بسميح القاسم وجها لوجه، لكنني عرفت صوته جيدا. التقيته مرارا عبر التلفون. كنت قرأت أشعاره وسمعت قصائده المغناة، لكن صلة الوصل نشأت عبر ولده وطن القاسم. قبل نحو سبع سنوات، جاء وطن إلى ألمانيا متدربا في الإذاعة الألمانية، وعُهد إليّ به. اكتشفت موهبته بسرعة، ولما عرفت أنه من فلسطين، من سكان الجليل، سألته عن احتمال وجود قربى بينه والشاعر سميح القاسم، فقال: إنه أبي، فعلقت قائلا: «الآن أدركت دلالة اسمك»!
كانت المكالمات التلفونية على فترات متقطعة. أحيانا أنقل لسميح القاسم تحيات الذين يتعذر عليهم الاتصال به من بيروت. ومنهم صديق مشترك: الياس رحيّم. سألني»من وين نبشته؟ هذا شيوعي عتيق وكنا نلتقي في براغ وأحيانا بحضور محمد مهدي الجواهري». وفي مكالمة أخبرته أنني أكتب فصلا في كتابي «حكايات الأغاني» (منشورات رياض الريس) عن قصائده المغناة: «منتصب القامة أمشي (مارسيل خليفة) «ربما» (جوليا بطرس) «زنابق لمزهرية فيروز» (خالد الشيخ ورجاء بلمليح) فذكـّرني بـ «أحكي للعالم» وقد غنتها كاميليا جبران وريم بنـّا وزياد الأحمدية ودينا أورشو، وأخبرني أن عابد عازريه أول من لحن أشعاره (طائر الرماد).
وكانت آخر مكالمة قبل ثلاث سنوات ولم يكن أصيب بالمرض الخطير. كان الكلام في الأدب وفي شعره. استرجعت معه ديوانه «الكتب السبعة» (دار الجديد) وموضوع الموت المتكرر في أبياته «على الماء أمشي/وأحمل نعشي».. «سائر في النوم/ يستيقظ جيراني القدامى في القبور».. «أمشي على حرير/ يستيقظ الميت في السرير» فأحالني إلى مواضع أخرى في الديوان، وها أنا أختار مقطعا منها ليكون تحية الوداع:
«وداعا/ أنا ذاهب في إجازة/ فلا تؤنسوا وحشتي أيها الفقهاء البهائم/ لا تقتلوني/ بشبه البروق الرعود وشبه الأغاني المراثي/ أنا في إجازة/ فلا تقربوني/ ولا تلمسوني/ أقرّ كما تشتهون بأن وفاتي مكافأة للضريح الجميل/ ولكنني لا أقرّ طقوس الجنازة/ أنا أنتفي/ ولا أختفي». سيظل سميح القاسم منتصب القامة، مرفوع الهامة.
(كاتب من لبنان)
تقابل الفقراء في قصائدك/ وحيد الطويلة
ماذا نفعل الآن يا سميح، رشقنا محمود درويش من قبل بالحبر المضاء والمضيء، ليس سوى أن نرشقك بالزيتون الذي تعرفه تماما كنسغ أصابعك كطرفة عينك، ألست أنت من حفر اسمه على جذع شجرة لن تطوحها ريح ولن تحرقها نار.
النار لا تحرق أسماء الشعراء يا صديقي، نار العدو تحرق الأجساد والمباني والقلوب الصغيرة والشعارات لكنها لا تحرق الشارات ولا أسماء الشعراء.
كان قرارك ألا تخرج من الأرض، كتب عليك النضال، فيه ولدت وفيه كان خيارك وهكذا عشت، وعلى شاكلته وناره جاءت القصيدة، ربما الخروج يجعل الجملة أكثر إنسانية ويجعل الشعر أكثر رحابة لكن البقاء منحها ضرورة الحياة التي تستحقها وهذا فضلك، من منا يحتاج لأكثر من جعل البقاء في الأرض دلالة على وجودية القضية على حياتها وعلى حيوتيها، انها تأكل وتشرب وتغني كل صباح في وجه الأعداء، لذا كنت تغيظ الاسرائيليين بعدم تركك وطنك.
من زنزانتي الصغرى أبصر زنزانتك الكبرى. أنت سجين في زنزانة وهو سجين في وطنك.
كنت تناضل بالرؤى حين تقول: عراق يا عراق، ما اللغة الفجيعة، ما سنة وشيعة؟ وأنت يا عراق، أمانة الأعناق.
مأزق الشاعر أن يظل في أرض كهذي، وقيمة الانسان والشاعر والسياسي ألا يتعتعه أحد من موضع قدمه.
كسر لك النادل الفنجان بعد أن شربته دلالة على ألا يجوز لأحد أن يشرب منه بعدك، فنجانك المكسور الآن تشرب منه أرواح الأطفال والشهداء ثم ينتهي إلى الأنبياء ليطمئنوا.
هل أنت محرض؟ المباشرة تحريض، كنا نحتاج اليها وما زلنا حتى المباشرة في الحب تحريض على الحب.
تتذكر وأنت طفل حين كنت تغني مع قرنائك «شوفوا شوفوا سعدى الزناتي راكبه الحصان وطالعه ع راس القلعة»، تصعد الآن على رأس القلعة وستطرد ريح نضالك ومفردات شعرك كل الغزاة.
لا تقلق من غيابك الجسدي ستقابل الانبياء والفقراء كل يوم في قصائدك، وستعرفك الزيتونة تماما تلك التي تعرفها كإصبعك.. كوجهك، وستأخذ الجميع اليها ذات يوم.
(كاتب من مصر)
الشعر خلف متاريس المقاومة/ طارق العربي
شكّل سميح القاسم، مع توفيق زياد ومحمود درويش وراشد حسين وبعض رفاقهم في الستينيات، مركز الشعرية الفلسطينية في الداخل المحتل؛ المركز الذي دل عليه غسان كنفاني بـ”شعراء الأرض المحتلة” أو “شعراء المقاومة”، لاحقاً. غير أنّ الأقدار شاءت لـ”أضلاع” هذا المربّع المقاوِم أن تفترق، كلّ في سبيله وإلى مشروعه الشعري الخاص، الذي لا ينفصل بالتأكيد عن الصراع مع العدو الصهيوني، ولا ينفصل عن فلسطين حلماً وثقافة.
مثل محمود درويش، الذي انطلق في قصيدته نحو المعنى الإنساني الكلي والجامع للشعر، فعل سميح القاسم ذلك، وإن كان عبر شعرية مختلفة ومغايرة، حافظ فيها على النبرة العالية التي ميزت شعره، حتى في قصائده ذات النزعة الإنسانية والأسلوب المسرحي الذي عرف به.
وبهذا المعنى، يمكن القول إن القاسم كان متمترساً خلف لغته، منحازاً إلى بلاغتها التي تتطلب قدراً من المهارة وتستدعي درجة من السحر كي تكون إبداعاً. هكذا، ظل الشاعر الراحل حبيس مشروعه الشعري الخاص الذي وجد في مفردات المقاومة حياته ووجوده، وكان في هذا ظلم لشعريته التي جاءت واضحة في قصيدته “غوانتامو” أو في ديوانه “أشد من الماء حزناً”. ولعل هذه المجموعة الأخيرة، بلغتها وبنائها، واحدةً من أفضل مجموعاته الشعرية.
ترك الراحل خلفه سيرة شعرية وأدبية قوامها 70 كتاباً، ما بين شعر ونثر ومسرحية، تؤرّخ للتغريبة الفلسطينية التي واكب أحداثها منذ “ثورة البراق” والإضراب الشهير، حتى العدوان الحالي على غزة. أهم تلك الآثار، شعراً، كان “مواكب الشمس”، و”دمي على كفي”، و”سقوط الأقنعة”، و”لا أستأذن أحداً”. تضاف إلى ذلك مجموعات نثرية، أهمها “الرسائل” مع رفيقه الراحل محمود درويش.
علاقته بدرويش كانت عنصراً مهماً في مسيرته الشعرية. ذلك أنها شكّلت، في مرحلة ما، طريقاً للشاعر وقصيدته إلى خارج الوطن الفلسطيني المحتل، مثلما شكّلت لصاحب “لماذا تركت الحصان وحيداً” نافذة يطل من خلالها على الداخل الفلسطيني. هذا ما يستشف من الرسائل المتبادلة بينهما حتى سنوات متأخرة من منفى محمود درويش، قبيل عودته إلى البلاد بعد أوسلو، كما تدل على ذلك تواريخ الرسائل.
وتشكل محاولات القاسم في كتابة قصيدة الهايكو إحدى التجارب التي سعى من خلالها إلى فتح آفاق أخرى أمام قصيدته؛ إذ حاول إخراج لغته من سباتها واختراق المعتاد في كتابة شعر التفعيلة. كما دلّت هذه المحاولة على قدرته على الاتصال بالتجارب الشعرية الأخرى. ووفق هذه الصورة يمكن القول إن سميح القاسم أحد الذين اشتغلوا على تطوير القصيدة العربية بما لا يخرج عن ثابتها المعروف في الوزن والإيقاع، ما حافظ عليه الراحل حتى مجموعته الأخيرة “كولّاج 3″ (2012).
كما امتاز شعر القاسم أيضاً بالمطوّلات الملحمية التي تتكئ على الأسطورة والميثولوجيا الكنعانية والسورية، إضافة إلى ارتكازه على التوراة والنص القرآني، وكذلك الوقائع التاريخية والتفاصيل اليومية تحت الاحتلال، لتخرج تغريبتها وموسيقاها الخاصة، التي لا تبتعد عن موسيقى الحداء، بنفَس ملحمي خاص بصاحبها.
أما سياسياً وثقافياً، فقد لاحقت الشاعر العديد من التهم، بالتطبيع مرة، كـ”رثاء جنود صهاينة” سقطت مروحيتهم في افتتاحية كتبها لـ”كل العرب”، وبالوقوف مع الطغاة في مرات أخرى، كمديحه لحافظ الأسد وكتابة رثاء تبجيلياً له. لكن القاسم في المقابل ثبت على مواقف تقدمية ولم يخف توجهه القومي العروبي، وكان يوقن أن الموقف الأخير هو للقصيدة. هكذا، جعل من شعر المقاومة متراساً يحتمي به من كل تهمة تلاحقه، وكان موقفه دائماً مع المقاومة وحقوق شعبه.
سميح القاسم.. حيرة الشعر والخطابة/ علي أبو عجميّة
اكتسب الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 خصوصيّة كبيرة باعتباره المكان الأوّل في جُغرافيا الصراع العربي الصهيوني. وفي سياقه، كان الانفعال الطبيعيّ بفلسطين، وفي فلسطين، صادماً وشاملاً ومحمولاً على جميع وسائل الاشتباك، من السلاح الحيّ إلى الكتابةِ الحيّة. بهذا المعنى، ارتبطت تجربة سميح القاسم، من بداياتها، ارتباطاً حميماً بمشهديّة المكان. وكان الشاعر إذ تغرّبت أرضه فجأة، وتغرّب أهلوه تباعاً، يمنح، مع جمهرة من زملائه الكتاب والمثقفين، الفلسطينيين بطاقة وجودهم في أرضهم، بمنطقٍ يقع في سؤال الهُويّة من جهة، وأدوار المثقف من جهة ثانية.
ولعلّ صاحب “الموت الكبير” (1972)، الذي حظيَ بهالة كبيرة من الضوء، والشهرة الواسعة، كان مشغولاً بِتعريب الزمن؛ واثقاً بعُروبيّة المطالع، ما جعل قصيدته تنسحب إلى هذه المناطق، أو تتبلوّر فيها، بكامل خطابتها، وإنشادها، وشِعاراتها. في حين عمّقت قصائد قليلة أخرى فنيّتها، بنظرة إنسانيّة أكثر التفاتاً إلى هدأة الداخل منها إلى ضجيج الخارج: “أشدُّ من الماء حزناً /تغرّبت في دهشةِ الموتِ عن هذه اليابسهْ/ أشدُّ من الماء حزناً/ وأعتى من الريحِ توقاً إلى لحظةٍ ناعسهْ/ وحيداً، ومزدحماً بالملايينِ، خلف شبابيكها الدامسهْ”.
إلا أنّ الالتباس الذي تولّده حالة القاسم، لا سيّما في خضمّ الحداثة العربية، وتسارع حركتها، واتسّاع الفجوة بين الأيديلوجيّ الهجين، والثقافيّ المجرّد؛ التباسٌ كبير يصل إلى درجة وضع الشِعر كلّه على المحكّ، مفهوماً، ونتاجاً، في وقتٍ تكثر فيه الأصوات الداعية إلى خلاص الكاتبة من حُمولاتها الماضويّة. وهنا، تعود الأسئلة المطروحة حول نتاج صاحب “ديوان الحماسة” وكأنها أسئلة اليوم والغد، المبُرّرة في سياق الأثر، والقيمة.
على المقلب الآخر، وبين “سقوط الأقنعة” (1969) و”سأخرج من صورتي ذات يوم” (2000)، نجد تلك العناوين الكبرى لحالة الارتهان المزدوج للواقع العربيّ. فبين الأنظمة الحاكمة أو المتحكّمة، والاحتلال ونقائضه في الحالة الجمعيّة، والحالة الفرديّة، ثمّة سلسلة كبيرة من السنوات التي توالت الأقنعة فيها بالسُقوط، وتراكمت عبرها صور النكوصِ والرتابةِ والأمل. وعليها يظلّ الشاعر واقفاً، مُحرّضاً: “تقدّموا، تقدّموا”، في حين يكتب قريباً من موته “هواجس لطقوس الأحفاد” (2012)، و”كولاج 3″ (2012).
إلى أين يذهب شعر المقاومة، إذاً، في مشهد كهذا؟ وفي أي سياق تاريخي يمكن أن تقرأ العناوين الفلسطينيّة اليوم؟ وأيّ معنى تكريمي تمنحه القضيّة المستندة إلى الماضي، والمفتوحة على المستقبل، لرموزها، التي علتْ فأعلتها في جرحها العام؟
يرحل سميح القاسم؛ تاركاً لنا تلك الحكاية الشعرية المترجمة “أولاد في حملة خلاص”، لبيرتولد بريشت، ورسائله، ومحادثاته الشخصيّة جداً مع رفيقه محمود درويش. يرحل سميح القاسم، كأنّه ماهرٌ في إزاحة الموت. يرحل وهو يتنقل بين العروبيّ والمحلّي والأممي. يرحل وهو يجسر بين الشخصيّ والعام باللغة والغضبِ والحيرة.
* شاعر من فلسطين
سميح القاسم و”شرنقة القضية الفلسطينية/ محمد حجيري
غيّب الموت، أمس الثلاثاء، سميح القاسم (75 عاماً)، بعد “صراع مع السرطان”، حسبما جاء في بيان النعي. هذه العبارة التي باتت رديفاً للتراجيديا في حياة الانسان، إذ لا أحد ينجو من جحيمية هذا المرض الفتاك، صار لعنة في الحياة. لم يمنع السرطان سميح القاسم من السيجارة في سنواته الأخيرة، مع أنه كان يقول: “أنا لا أحبك يا موت.. لكني لا أخافك.. وأعلم أن سريرك جسمي.. وروحي لحافك.. وأعلم أني تضيق علي ضفافك”.
مع رحيل سميح القاسم، يمكن أن نستعيد ما كتبه أميل حبيبي في تقديمه لكتاب “الرسائل” بين محمود درويش وسميح القاسم، وأطلق عليهما اسم “شقّيّ البرتقالة الفلسطينية”. الأرجح أن الكثير من الأدباء والكتاب ساهموا في تكوين البرتقالة الفلسطينية ورحلوا، بدءاً من أميل حبيبي مروراً بتوفيق زياد وأبي سلمى ومحمود درويش وإدوارد سعيد، والآن سميح القاسم. هؤلاء صناع “صورة” الثقافة الفلسطينية في مراحل مختلفة، مع تفاوت واختلاف في تجربة كل منهم. فمحمود درويش استطاع تخطي مرحلة “الشعر النضالي” إلى آفاق أرحب وأوسع، بالمعنى الشعري والوجداني، وبقي توفيق زياد والقاسم داخل “شرنقة القضية الفلسطينية”.
والغريب واللافت أنه برغم مؤلفات سميح القاسم الكثيرة والمتنوعة، تعرّفه معظم وسائل الإعلام بأنه كتب قصائد معروفة، مغنّاة في أنحاء العالم العربي، منها قصيدته التي غناها الفنان اللبناني مرسيل خليفة: “منتصب القامة أمشي .. مرفوع الهامة أمشي… في كفي قصفة زيتون… وعلى كتفي نعشي، وأنا امشي وأنا أمشي”. ربما تكون هذه القصيدة من أسوأ ما كتب سميح القاسم، وإن كانت راسخة في الذاكرة والوجدان وساهمت بقوة في النضال وتمجيد النعوش، وهي من دون شك تدل على اللاقراءة عموماً ولاقراءة الشعر خصوصاً.
فأن يتم التركيز على قصيدة تعبوية لشاعر كتب نحو 70 كتاباً فهذه معضلة فعلية. وهناك نوع آخر من القراء (ربما منهم كاتب هذه السطور) يركزون على “لاطهرية الموت”، بمعنى أنه إذا مات شاعر أو روائي، فليس علينا أن نشرع في رثائه ومدحه والاثناء على عظمته لمجرد أنه رحل، وإن كان هذا هو السائد في العالم العربي. والقراءة النقدية للشخصيات، من دون عواطف، لها أيضاً سلبياتها، تتجلى أحياناً في تهميش البعض لكتابات الشاعر أو الكاتب، والتركيز على سقطة ارتكبها في حياته، مثل القصيدة التي كتبها سميح القاسم في رثاء حافظ الأسد العام 2000، عندما اعتبره “أسد العروبة”. كان عابراً وَقع هذه القصيدة حين ألقاها القاسم. أما اليوم، فالأمور تبدلت مع اشتعال الأحداث والحرب في سوريا، وما حملته من انقسامات وإفرازات ومجازر وانتهاكات. لم يعد هيناً التسامح مع مَن مدح حافظ الأسد أو أنجاله. وعلى هذا، وجدنا مغالاة في نشر قصيدة القاسم “الأسدية” في “فايسبوك”، مع أن معظم الشعراء العرب لديه سقطات، إما في مدح هذه الزعيم أو ذاك، أو في الولاء لتنظيمات فاشية، أو في الولاءات الطائفية من سعيد عقل إلى أنسي الحاج، ومن نزار قباني الى أدونيس. وهناك المئات ممّن تباروا في مدح الأسد ورثائه، منهم الجواهري وجوزف حرب، إلى جانب العديد من الشعراء المغمورين.
لا شك في أن سميح القاسم كان اسماً لامعاً في مرحلة من المراحل، خصوصاً في أوج القضية الفلسطينية والصراع المسلح والانتفاضات. وهو حافظ على اسمه، لكن شعره تراجع في السنوات الأخيرة، أو تراجع حضوره، بسبب تراجع وهج القضية الفلسطينية أولاً، وتراجع الشعر نفسه أمام الأجناس الأدبية الأخرى ثانياً. ومَن يستعيد كتابات نقدية عن سميح القاسم، يدرك مدى حضوره، على أن الكتابات نفسها لا تنفصل عن الايديولوجيا التي ينتمي إليها الشاعر أو التي كانت سائدة. فهو “شاعر المقاومة الفلسطينية”، وهو “شاعر القومية العربية”، وهو “الشاعر العملاق” كما يراهُ الناقد اللبناني الراحل محمد دكروب، والشاعر النبوئي، كما كتَبَ الدكتور إميل توما، وهو “شاعر الغضب الثوري” على حد تعبير الناقد المصري رجاء النقاش… إلى ما هنالك من تعابير متورمة لا جدوى منها.
نبذة
ولد القاسم في مدينة الزرقاء الأردنية في 11 أيار/مايو 1939 لعائلة فلسطينية من قرية الرامة، وتعلّم في مدارس الرامة والناصرة، وعلّم في إحدى المدارس، ثم انصرف بعدها إلى نشاطه السياسي في الحزب الشيوعي قبل أن يترك الحزب ليتفرغ لعمله الأدبي.
سجن أكثر من مرة كما وُضع رهن الإقامة الجبرية، وطُرِدَ مِن عمله مرَّات عدّة بسبب نشاطه السياسي. قاد حملات ضد التجنيد الذي فرضته اسرائيل على الطائفة الدرزية التي ينتمي اليها. أسهَمَ في تحرير صُحف “الغد” و”الاتحاد” ثم ترأس تحرير جريدة “هذا العالم” العام 1966، قبل أن يعود للعمل مُحرراً أدبياً في “الاتحاد”، ثم أصبح أمين عام تحرير مجلة “الجديد”، ثمَّ رئيس تحريرها. وأسَّسَ منشورات “عربسك” في حيفا، مع الكاتب عصام خوري العام 1973…
توزّعت أعمال سميح القاسم بينَ الشعر والنثر والمسرحية والرواية والبحث والترجمة. وتُرجم بعض أعماله وقصائده إلى الإنكليزية والفرنسية والتركية والروسية والألمانية واليابانية والإسبانية واليونانية والإيطالية والتشيكية والفيتنامية والفارسية والعبرية، ولغات أخرى.
سميح القاسم… المقاومة في زمن الشعر/ كريم مروة
خسر العالم العربي وخسرت فلسطين في غياب سميح القاسم علماً كبيراً من أعلام الشعر العربي الحديث. وخسرت أنا صديقاً من زمن كانت قد بدأت تتكوّن فيه علاقة من نوع فريد بين شعبين عربيين شقيقينن هما الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني، في كفاح توحدت فيه، في الصواب وفي الخطأ، مطامحهما في الحرية والتقدم. واحتلت الثقافة في ميادينها المختلفة في هذا الكفاح الوطني التحرري المشترك دوراً غير مسبوق.
كنت منذ مطالع ستينات القرن الماضي، أتابع بشغف وبتقدير كبير من خلال الصحافة العربية، لا سيما الفلسطينية التي كانت تصلني في مقر عملي في فيينا، ما كان قد ابتدعه سميح القاسم مع رفاقه الشعراء أبو سلمى وتوفيق زياد وكمال ناصر ومحمود درويش ومعين بسيسو من شعر حديث أطلق عليه ووثقه بإتقان الروائي غسان كنفاني في كتابه الشهير “أدب المقاومة”. وكان ذلك الشعر بامتياز شعراً فلسطينياً مقاوماً. وكان الشعراء الذين كان سميح القاسم واحداً منهم، هم أبطال ذلك الشعر المقاوم. وكان لذلك الشعر دور بالغ التأثير في كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية، لا سيّما في المرحلة التي انطلقت فيها الثورة الفلسطينية الجديدة في مطلع العام 1965. وسرعان ما انضم إلى هذه الكوكبة من الشعراء في الاتجاه ذاته الذي سلكوه عدد من رواد الشعر المقاوم من شعراء لبنان الجدد، وبالأخص منهم شعراء الجنوب.
في مطالع السبعينات تعرّفت إلى سميح بعدما كنا قد أصبحنا صديقين بالمراسلة ورفيقين بالهمّ الوطني الثوري وباعتبار المقاومة، كل منا على طريقته وبنوع سلاحه الثقافي، طريقنا إلى الحرية. اكتشفت فيه آنذاك من قرب ذلك النموذج الرائع من المثقف الذي كان يجمع في حياته بين سحر الكلمة التي يمتاز باستخدامها الشعراء في كل العصور وبين شخصية المناضل الشيوعي المؤمن بأن مستقبل بلاده في الحرية والتقدم والعدالة هو جزء لا يتجزأ من مستقبل البشرية برمّتها.
قرأت كل دواوين سميح القاسم أو هكذا يخيّل إليَّ. وقرأت كتاباته النثرية التي كان ينشرها في جريدة “الإتحاد” وفي مجلة “الجديد” وفي مجلات عربية أخرى. وقرأت ما كنا قد نشرناه له في صحافة الحزب الشيوعي اللبناني، لا سيّما في مجلة “الطريق”، من قصائد ومن مقالات وأحاديث. ورغم أنني لست ممن يعتبرون أنفسهم نقاداً ويشهد لهم القراء بذلك، فإنني كقارئ شغوف للشعر منذ مطالع شبابي أعترف بأنني كنت أعتبر سميح القاسم واحداً من رموز حركة الشعر الحديث، بأسلوبه هو بالطبع، أسوة بسواه من الشعراء، وبطريقته هو في اختيار مواضيع قصائده ومناسباتها ووجهته فيها، وذلك من موقعه كمثقف وكمناضل ثوري في اتحاد الوظيفتين من دون افتعال. وإذا كان من الخطأ في هذه اللحظة بالذات التوسع في الكلام عن سميح القاسم في الاتجاهات التي سلكها، لا سيّما في لحظة وداعه، فإنني لا أستطيع إلا أن أشهد بأن سميح القاسم قد مرّ بتعرجات كثيرة في العقود الثلاثة الأخيرة من حياته. وهو ما بدا لي من خلال ما توصلت إليه من قراءات له ومن اتجاهات كانت تحملها بعض قصائده وبعض مواقفه. لكن سميح لم يكن الوحيد في ما جرى له من تعرجات في حياته. إذ سبقه إلى ذلك أحد أساتذته الكبار الأديب والمناضل الشيوعي الروائي إميل حبيبي. وكعادتي في علاقاتي مع أهل الثقافة من رفاقي في الموقع الفكري والسياسي ومع الآخرين، فقد بقيت أميناً على العلاقة ذاتها قبل نصف قرن مع سميح ومع الآخرين. وقد أحزنني خبر وقوعه صريع ذلك المرض الخبيث.
وكنت أتحدث إليه من القاهرة وعمّان في أمور حرصت ألا يكون موضوع المرض واحداً منها. وكان آخر حديث بيننا في العام الماضي عندما كنت في عمّان. سألته متجاهلاً عن قصد وضعه الصحي عمّا إذا كان بإمكانه ملاقاتي في عمّان. فأجابني بحسرة ومرارة وبحب وشوق للقاء بيننا: “هل تتصوّر يا كريم أنني أنا القاعد في منزلي بانتظار آخر أيامي سأتمكن من ملاقاتك في عمّان؟”. طيّبت خاطره وحزنت. وبدأت غصباً عني أكافح ضد ذلك الزمن الذي سيعلن مجيء اللحظة التي فجعتنا البارحة في إعلان رحيله.
سيظل سميح القاسم بعد رحيله، إلى جانب من رحلوا قبله أبو سلمى وتوفيق زياد وكمال ناصر ومحمود درويش ومعين بسيسو وإميل حبيبي الرواد الكبار لحركة الحداثة في الشعر وفي الرواية وفي كل ميادين الثقافة، سيظل مع هؤلاء في تراثه وتراثهم نموذجاً رائعاً للدمج العقلاني بين دور المثقف ودور المناضل الثوري.
لوركا الفلسطيني بين بحر عكا وصحراء النقب/ خليل صويلح
دافع عن مساره الشعري المباشر بقوله «هناك سوناتا سيئة ومارش جيد»
دمشق | انهار أخيراً العمود الثالث في بيت الشعر الفلسطيني المقاوم. رحل توفيق زيّاد باكراً، ثم لحق به محمود درويش، وها هو سميح القاسم (1939ــ2014) ينهي المعزوفة بضربة مؤثرة. «شعراء الأرض المحتلة»، هكذا تلقينا الحصة الأولى لدرس النشيد، بانتباه وحماسة ونشوة، فتعرّفنا عن كثب إلى صورة فلسطين من جهة البرتقال والزيتون والبرقوق. رائحة ستهبّ على الدوام مع كل قصيدة تعبر الحدود والأسوار.
في غياب توفيق زيّاد، ومغادرة محمود درويش بلاده، بقي سميح القاسم في الداخل الفلسطيني «مثل السيف فردا»، بنبرة عالية لا تقبل المساومة، مازجاً الروح الكنعانية بالنشيد العالي في سبيكة شعرية تستدعي النفير، وبلاغة الأسلاف، وروح الرفض، إذ كانت قصيدته بمثابة وثيقة في تمجيد الجغرافيا الأم التي لطالما كانت بوصلته إلى الحرية. الشيوعي الذي انتهى عروبياً صلباً في زمن الهشاشة والمقاولات الوطنية، وصداقة الأعداء، شذّب نصّه من شوائب الوهم الأممي، وذهب «منتصب القامة» إلى مشتله الأول لإعادة ابتكار الحبق في حقول البلاد المدماة، فههنا قصيدة غير مياومة، إنما تمدُّ جذورها عميقاً في التراب، على هيئة وشم لا يزول. اوركسترا تزاوج بين الكمان والناي في حداء طويل، وبشارةٍ قادمة، كأن كل الهزائم والكبوات ومراتب اليأس، لم تثر غباراً في طريقه إلى الجلجلة، ولم تخفت صوته الناري في تأصيل النشيد الفلسطيني المقاوم.
كانت قصيدته وثيقة في
تمجيد الجغرافيا الأم التي لطالما كانت بوصلته إلى الحرية
هو سليل المنابر والهتاف والإيقاع، قبل أن تخلو المنصة من شعرائها الكبار، إذ لا مسافة فاصلة بين القصيدة والأغنية، حين اختار اسم «أغاني الدروب» عنواناً لمجموعته الشعرية الأولى (1958). وسوف تزداد شحنة الغضب، تبعاً لزمهرير الشعر والرفض. لهذه الأسباب سيكتب باطمئنان «دمي على كفي»، و«لا أستأذن أحداً»، إلى نحو 60 عنواناً آخر، تمثّل مسالك حبره الموزع بين أجناس إبداعية مختلفة، في مفكرة ضخمة للأمل بترابٍ آخر لا تدنسه أحذية الأعداء، وهوية راسخة لا يلوثها حبر المنفى والحنين. وسوف يدافع عن مساره الشعري الغارق في المباشرة بقوله «هناك سوناتا سيئة ومارش جيد». في وقتٍ لاحق، سيكتب سوناتات جيدة أيضاً، فليس كل ما كتبه القاسم تحت بند «شعر المقاومة»، أو في باب المديح، كما يأخذ عليه بعضهم. التاريخ الدامي لبلاده كان بوصلته المتحوّلة في أرشفة الألم العام وشجنه الشخصي، وقبل كل ذلك علاج الجرح المفتوح بملح الكلمات. هكذا تبزغ حداثة نوعية في منجزه الشعري الشاسع، جنباً إلى جنب مع روحه الهوميروسية الهائمة بين بحر عكا وصحراء النقب، كما يتجاور «ديوان الحماسة» مع عنوان نافر مثل «أرض مراوغة. حرير كاسد. لا بأس»، أو «كولاج». وسوف نقع على جوانب أخرى من سيرته في كتاب «الرسائل»، الرسائل المتبادلة مع رفيق روحه محمود درويش في تلك الحوارية المدهشة بين الوطن والمنفى، وبين الصلابة والحنين، والضمير والجرح، وكتاب الإقامة، وكتاب الهجرة. يكتب محمود درويش في إحدى رسائله: «لم يحدث في تاريخ السطو البشريّ، يا عزيزي، ما يشبه هذا السطو، كأن يرافق الطرد من الوطن بمحاولة الطرد من الوعي والهوية. كأن نعجز عن قول ما هو مقول في الواقع بطريقة لا تخرّب توازن الكرة الأرضية. فعندما يتحوّل الاحتلال إلى «وطن وحيد» للمحتلّ، تصير مطالباً بأن تعتذر عن كلّ سليقة، وبأن تبرز أناقة قتلك بخصوصية لا تؤذي سمعة الخنجر المغروس في لحمك».
ويقول سميح القاسم في رسالةٍ أخرى: «لسنا غصناً مقطوعاً من شجرة هذه الأمة. نحن حرّاس أحلامها وسدنة نارها الطاهرة». لاحقاً، سيسأله محمود درويش بنبرة يائسة: «أين قبري يا أخي؟ أين قبري»، فيجيبه سميح: «لا تسألني أين قبرك. ما دام هذا المهد قضية معلّقة فسيظل القبر سؤالاً محرجاً يتيم الإجابة». سننتبه إلى أنّ حديث الموت اقتحم نصوص القاسم باكراً، ألم يكتب «قرآن الموت والياسمين»(1971)، و«الموت الكبير» (1972)، و«إلهي إلهي لماذا قتلتني؟» (1974)، و«سأخرج من صورتي ذات يوم»(2000).
كأن حياة هذا الشاعر منذورة للنكبات، فمن الاعتقال في سجون الاحتلال، إلى الإقامة الجبرية، كان على وحش السرطان أن يداهمه في مبارزة طويلة. يسأله علاء حليحل في مقابلةٍ شاملة «ألم يكسرك مرض السرطان؟»، فيجيب: «لم انكسر ولكن التوى فيّ شيء ما، بلا شك، ولكن داخلي لم ينكسر». بهذه الإرادة الصلبة، عاش سميح القاسم حياته المتشظيّة بين برازخ كثيرة، وعبرت قصيدته الحدود بكامل غضبها وبلاغتها وروحها المتمرّدة. وسنتذكر ذلك المشهد الاستثنائي خلال زيارته دمشق قبل سنوات، حين وطأت قدماه مخيم اليرموك قبل نكبته الأخيرة، فعبرَ المخيّم محمولاً على الأكتاف مسافة سبعة كيلومترات، كأن أهالي المخيم كانوا يودون ردّ الدين له بقصيدة مماثلة. وربما في مثالٍ آخر، علينا أن نستعيد ما خاطبه به محمود درويش: «لو كان قلبي معك، وأودعته خشب السنديان، لكنت قطعت الطريق بموتٍ أقل». لكن هل هي المصادفة وحدها أن يرحل صاحب «كتاب القدس» في اليوم نفسه الذي رحل فيه الشاعر الأندلسي فريدريكو غارسيا لوركا؟.
اليوم يعود إلى الرامة… فلننتظر في «بيت الشعب/ رشا حلوة
عكّا | عند التاسعة والنصف من ليل الثلاثاء 19 آب (أغسطس)، رحل سميح القاسم في «مستشفى صفد» عن عمر ناهز 75 عاماً بعد صراع طويل مع السرطان. كنّا نعرف أنّ صحته تدهورت خلال الأيام الماضية، إذ نشر الكاتب الفلسطيني وصديقه عصام خوري الذي أسس معه منشورات «عربسك» عام 1973، عبر صفحته على فايسبوك تدوينة مفادها أنّ الشاعر يمرّ في أوضاع صحية صعبة، ويعيش بين الغفو والصحو.
بعد الدقائق الأولى على تأكّد الخبر، امتلأت صفحات فايسبوك وتويتر بنعي وتعازي محبّيه في فلسطين والعالم العربي، من أبيات قصائده، ومشاركة روابط لأغنيات من كلماته، وصوره وقصائده مسجّلة بصوته، منها تلك التي تتشابه في مشاهدها مع ما تعيشه غزّة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر عليها.
حزن على رحيل شاعرٍ آخر من شعراء المقاومة، ومشاركة قصيدته «خذني معك» التي رثى بها رفيق دربه محمود درويش الذي تزامنت ذكرى وفاته في التاسع من آب (أغسطس)، أي في الشهر نفسه الذي رحل فيه القاسم. تدوينات حزن خاصة لكاتبيها، وتغريدة: «الناس نيامٌ.. فإذا مات الشعراء انتبهوا!».
صباح أمس الأربعاء، نعى «الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين» الشاعر «أبو وطن»، وجاء في بيانه: «لقد ترك سميح القاسم إرثاً ثقافياً نعتزّ به، ونعلن انحيازنا التام له. كما ترك سيرة نضالية نفتخر بها، ونتعلم منها، وفي هذه المناسبة يتطلع الاتحاد، بل يطالب الجهات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي منظمة التحرير، بأن لا تلتفت فقط لتراث الراحل الكبير، وإنما لوصاياه التي سنجدها في كل جملة شعرية كتبها، وأن تولي ثقافتنا الوطنية المقاتلة ما يمكنها من الصمود، ويشحذها بمقومات الصمود والمزيد من المقاومة».
ستودعه جماهير
غفيرة اليوم في مسيرة تجوب شوارع القرية
كما نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الشاعر من خلال بيان جاء فيه: «سميح القاسم سيبقى في ذاكرة شعبنا الوفي الصامد المرابط يردد أشعاره الخالدة ويذكر له مواقفه الوطنية المنحازة لدماء الشهداء وأنات الجرحى والأسرى في سجون الاحتلال». أما وزير الثقافة السابق الكاتب يحيى يخلف، فكتب عبر الفايسبوك: «رحيل شاعر فلسطين وأبرز رموزها الثقافية سميح القاسم مساء الليلة بعد صراع مع المرض، نعزي عائلته ونعزي أبناء شعبنا من محبيه وقرائه، ونعزي الحركة الثقافية الفلسطينية والعربية».
غنّى العديد من الفنانين الفلسطينيين والعرب قصائد الشاعر، منهم: مرسيل خليفة، جوليا بطرس، ريم بنّا وغيرهم، بالإضافة إلى فرق موسيقية فلسطينية، مثل «صابرين»، و«يُعاد» و«العاشقين». وكانت ريم بنّا التي لحنت قصيدتيه «أحكي للعالم» و«ذات يوم» اللتين كانتا ضمن ألبومها الثالث «الحُلم» (1993)، قد كتبت عبر فايسبوك بداية بيتاً من قصيدة «ذات يوم»: «قتلوني ذات يوم، يا أحبائيَ لكن، ظلَّ مرفوعاً إلى الغرب جبيني»، ثم كتبت: «آب، شهر موت الشعراء، محمود درويش 9/8/2008.. سميح القاسم 19/8/2014.. من 9 إلى 19.. عاش شعر المقاومة». وبعد حوالى ساعة على خبر الرحيل، كتب الفنان الفلسطيني «محبوب العرب» محمد عسّاف عبر فايسبوك مقطعاً من قصيدة «غرباء»: «وحملنا.. جرحنا الدامي حملنا.. وإلى أفق وراء الغيب يدعونا.. رحلنا». وأضاف: «مع تجدد العدوان الغاشم على غزّة الحبيبة، فقد الشعب الفلسطيني شاعر الزيتون والأرض سميح القاسم، بعد صراع طويل مع المرض. نحن شعب يمضي رغم الجراح. لروحك الرحمة يا شاعرنا الكبير ولنا العزاء والسلوان».
سيبقى صاحب «أشد من الماء حزناً» حاضراً بين الناس، هو وقصيدته، كما حافظت قصيدة وأغنية «منتصب القامة أمشي» على حضورها على مرّ كلّ هذه السنين، فهي من القصائد التي تشبه الأوقات كلّها، وتشبه المكان بكامل تاريخه المستمر، كما شاعرها تماماً. فكيف يمكن أن تغيب قصيدة من قال، في ظلّ معاناته مع المرض: « أنا.. لا أُحبُّكَ يا موتُ.. لكنني لا أخافُكْ!».
وسيصل جثمان الشاعر عند العاشرة من صباح اليوم الخميس إلى «بيت الشعب» في قرية الرامة الجليلية، ثم ستشيّع جماهير غفيرة جثمانه في مسيرة تنطلق من «بيت الشعب» وتجوب شوارع القرية، عند الساعة الثانية عشرة والنصف، باتجاه الملعب البلدي حيث يُسجّى الجثمان لإلقاء نظرة الوداع. وعند الساعة الثالثة، تبدأ المراسم الرسمية للجنازة وكلمات تأبينية قصيرة. وربما عندها، سيُسمع في الصدى صوته، وهو يقول بيت القصيد، من القصيدة التي رثاه بها صديقه درويش، يوم قال له: «يُحبّونَنا مَيِّتينْ.. ولكنْ يُحبُّونَنا يا صديقي».
كديما، كديما يا أولاد الكلب، كديما/ مصطفى مصطفى
القدس المحتلة | متشعبة هي سيرة سميح القاسم. تشبه شجرة تين تضرب جذورها في بلاد الشام، غير مبالية بالخرائط والحدود المصطنعة. تنبسط ذاكرتها بين عين الأسد وشفا عمرو وحاصبيا ودمشق ونجران. اقتلاع وترحال من أيّام «السَّفر برلك» إلى كارثة فلسطين. في سيرته «إنها مجرّد منفضة»، يمزج القاسم تاريخه الشخصي بتاريخ عائلته، ويستعيد ولادته في الزرقاء الأُردنية عام 1939. وعودة عائلته إلى بلدة الرامة إبّان الحرب العالمية الثانية. يومذاك، كان التعتيم مفروضاً على القطار العائد إلى فلسطين، خوفاً من الغارات التي قد تشنّها الطائرات الألمانية. يحكي القاسم بسخرية أن محاولة اغتياله الأولى كانت في ذلك القطار، حين حاول أحد الركّاب قتله حتى يُسكت بكاءه وصراخه. خاف الرجل أن تسمع طائرات النازيين بكاء الشاعر الطفل، فتقصف القطار! بعد «محاولة الاغتيال» هذه، سيجرّب القاسم صوته في جوقة الإنشاد المدرسية في «دير اللاتين» في الرامة، وينشد مع زملائه أناشيد «موطني» و«بلاد العرب أوطاني»، و«يا ظلام السجن خيّم».
تجارب أولى على الإلقاء، يشحذ بها صوته الذي ظهر في مجموعته الأولى «مواكب الشمس» التي صدرت عام 1958. في ذلك العام، اعتُقل للمرة الأولى تحت الحكم العسكري الإسرائيلي. كان نازيون جدد قد سمعوا صوته وأصوات شعراء ومثقفين فلسطينيين أمثال محمود درويش وتوفيق زياد وإميل حبيبي وإميل توما؛ رفضوا الخضوع للحكم العسكري. يحكي القاسم بحميمية آسرة لحظة اكتشافه «شاعراً في الصف» و«الدرس الأوّل» في النقد الأدبي من أُستاذ اللغة العربية: «لا تذهب إلى القصيدة يا بُني، دعها هي تأتي إليك، وستأتي… لا تقلق». في «دير اللاتين» القائمة في بناء روسي قديم، سيحقق القاسم أيضاً «شعبية» مرموقة بين الفتيات القليلات في المدرسة، حيث لمع نجمه في الفرقة المسرحية.
كان في التاسعة من عمره حين وقعت كارثة فلسطين، وحين صاروا ينادونه «يا شاب!». يستمع إلى الحوارات التي كانت تدور بين الرجال في ديوان بيتهم. أسماء غريبة تتقافز مثل الجنادب: «ابن غريون وموسى شرتوك وموسى ديان». يستمع إلى الأحكام المطلقة عن «الزعامة العربية التي باعت القضية»، وعن أن «المسألة مَبيُوعة». أحكام تعبّر عن أسى ومرارة، لكنّ شبحها يُخيّم على الواقع السياسي العربي. سيرحل القاسم وإسرائيل ماضية في ذبح غزة وفلسطين، وسلالات النفط والغاز تتحالف معها، والشارع العربي ينتفض على الفايسبوك وتويتر ويصمت في الشارع.
ستبقى سيرة القاسم كوّة نطلُّ منها على الذاكرة الفلسطينية بآمالها وانكساراتها وتناقضاتها. تجربته مع رفاق آخرين في «الحزب الشيوعي الإسرائيلي» الذي خرج منه بعد ملابسات اتهامه بـ«الشوفينية القومية»، ما زالت موضع جدل ونقاش لن ينتهي إلا بتحرير فلسطين وطوي صفحة الكارثة واستعادة الذاكرة. في السنوات الأخيرة، أخذ عليه كثيرون صداقته مع رجالات السلطة الفلسطينية التي صارت نسخة مقلّدة عن «الزعامة العربية» التي باعت يوماً فلسطين، ومشاركته في فعاليات ثقافية نظّمتها جهات إسرائيلية. رغم هذا، سنتذكر قصائده التي كانت زادنا في لحظات تاريخية، مثل قصيدته الأبرز «تقدّموا.. تقدّموا»، وعنوانها الأصلي «رسالة إلى غزاةٍ لا يقرأون». قصيدة استهلمها من أطفال القدس المحتلة في انتفاضة عام 1987. رآهم القاسم يصرخون على الجنود الصهاينة بالعبرية «كديما.. كديما (تقدّموا.. تقدّموا) يا أولاد الكلب.. كديما».. فجاءت قصيدة مفخخة بعنفوان أطفال الحجارة وروحهم القتالية إلى الأبد.
سميح الحقيقي الآن نصنع نبوءته/ زكريا محمد
كانت أول مرة أسمع فيها باسم سميح القاسم بُعيد حرب حزيران 1967 مباشرة، ربما بعد شهرين أو ثلاثة من حزيرن الهزيمة. كنت في 16 أو 17 من عمري، عندما أبصرت في ظهيرة أحد الأيام ريان أبو بيح وقد وضع كوعيه على طاولة دكانه قرب الجامع، وأخذ يقرأ فقرات من كتاب بين يديه، مترنماً بصوت عال.كان الكتاب هو مجموعة «دمي على كفِّي» لسميح القاسم.
وكانت المجموعة قد صدرت عن «مطبعة الحكيم» في الناصرة في السنة نفسها، سنة الهزيمة، هزيمة عام 1967. وما زلت أذكر طراطيش الدم في اللوحة على غلاف الكتاب. ذلك أنني أخذت الكتاب من بين يدي ريان، وقرأت عدداً من قصائده. لا بد أنّ أحداً أحضر المجموعة من كفر قاسم. فمنذ أن كسرت إسرائيل باحتلالها الحدود بين الضفة ومناطق 1948، مستوليةً على ما تبقى من فلسطين، انفتحت الطريق من جديد وتعبدت بين قريتي الزاوية وقرية كفر قاسم. كانت الطريق قد اغلقت بين القريتين عام 1948. غير أننا سمعنا من بيوتنا صراخ الناس وهم يذبحون فيها عام 1956. أنا لم أسمع وقتها، لكن الناس الكبار في حينه سمعوا الصراخ المرّ لمن ذبحوا. بدأ الناس بالعبور في الطريق الذي أخذ يتعبد من جديد. كان أهل كفر قاسم المقيمون في قريتنا أول من فعل ذلك، ثم تبعهم الجميع. وأذكر أن والدي حمَّل الحمار بسحارتي لوز، وأرسلني إلى هناك كي أبيع اللوز. وقد بعته. كان عندنا حقل كبير من اللوز، لكن لم يبق شيء منه الآن. فاللوز شجر لا يعمر طويلاً. ومن هناك، من كفر قاسم، جاءت نسخة «دمي على كفي» التي سمعت في ذلك اليوم ريان يقرأ منها. قرأ ريان من المجموعة كلاماً بدا غريباً ومفاجئاً لمن تجمعوا حوله. لم يكن بالضبط مثل الشعر الذي يعرفونه أو يتوقعونه. وقد كان أيضاً غريباً بشكل ما بالنسبة لي. لم أكن بعد قد تعرّفت على الشعر الحديث، شعر التفعيلة، إلا من خلال نصوص قليلة في المنهاج الدراسي. وكانت النصوص قريبة في المزاج من النصوص القديمة. أذكر على الأقل شيئاً من نص واحد منها أظن أنّه كان للشاعر السوداني محيي الدين فارس: «وحدي هنا ما زلت أصعد، والليل تمثال مصفد، هجرته آلهة القرون، رؤى قياصره القديمة». بدا لي كلام القاسم جديداً، لكنه غير متماسك. ثمة خطأ ما فيه، ضعف ما. هذا هو الانطباع الذي في رأسي عن تلك اللحظات. ولعل الخطأ كان في ذوقي أنا. ثم صار سميح القاسم بعد ذلك بسنتين على كل لسان، بعد أن كتب غسان كنفاني عنه وعن محمود درويش في كتابه عن شعر المقاومة. والآن، وبعد هذا الزمن الطويل يرحل سميح، ويتركنا كي نتذكر، وكي نعيد ترتيب الأمور في أذهاننا. الموت فرصة مناسبة لإعادة ترتيب الأمور لإعادة الحساب. الموت هو القاضي الكبير، بل هو شيخ القضاة الذي يأمرنا بأن نعيد استجلاء الأمور والقضايا وحسابها من جديد. ولا يمكن الشك في هذه القضية، كان سميح القاسم جزءاً من وعي أمة بكاملها في نهاية الستينيات، وطوال السبعينيات على الأقل. لم يكن جزءاً من وعي فلسطين فقط، بل جزءاً من وعي امة بكاملها. ولا يمكن الاستخفاف بمن يكون هكذا أبداً. من يكون جزءاً من وعي أمة، فهو جزء من ذاتي، وجزء من وعيي لهذه الذات، مثله مثل محمود درويش. بالطبع، فتحنا نحن من جئنا بعد سميح طرقنا وآفاقنا. كانت طرقاً لا تلتقي مع طرق سميح إلا نادراً. وعلى عكس درويش الذي ظل حتى النفس الأخير يحاول أن يكتشف طرقاً جديدة، أصر سميح على طرقه. بل لعله توقف عن السير في الممرات الخاصة والواعدة التي فتحها يوماً، لكي يتمسك بالممرات الأكثر إلفة وعادية. لم تعد لديه طاقة على استكشاف طرق جديدة. رضي عن نفسه، ورضيت عنه في حين ظل درويش غير راض أبداً. كان يذهب مثل لصّ إلى نصوص اكثر الشعراء شباباً ويقرأها. كان يشعر بكل جيل يفقس من الشعراء ويحس بتهديده. أما سميح، فلم يكن يحس بأي تهديد. كان مؤمناً بذاته وراضياً عنها. لكن أنلومه على ذلك؟ أليس على كل واحد أن يرضى في لحظة من اللحظات؟ لست أدري. على كل حال، فقد رحل سميح عنا، تاركاً لنا تراثاً ضخماً مكوناً من عشرات المجموعات. وربما كان علينا الآن نحن أن ننقي هذه المجموعات. أن نستخرج ذهبها. فلن تظهر نبوءة سميح على حقيقتها إلا بجهدنا. علينا أن نصنع من كل هذه المجموعات مختارات تساوي ثلاثاً أو أربع مجموعات، ونقول: هذا هو سميح القاسم الحقيقي. هذا هو لهبه. وهذه هي ناره.
* شاعر وباحث فلسطيني
مثقّفو الداخل: فضله كبير في ترسيخ هويتنا/ رنا عوايسة
في ثرى الجليل الذي رفض أن يغادره، يرتاح سميح القاسم اليوم في بلدة الرامة. يرحل جسده ويبقى صدى صوته منادياً طائر الرعد «بعد انتحار القحط في صوتي.. شيءٌ روائعه بلا حدّ.. شيءٌ يسمّى في الأغاني طائر الرعد.. لا بد أن يأتي فلقد بلغناها.. بلغنا قمة الموت». سميح القاسم الذي يُجمِع كل من عرفه على تواضعه وإنسانيته وابتعاده عن «البرج العاجي» الذي يعزل فيه بعض المبدعين أنفسهم عن الناس خاطب موته قائلاً «أنا لا أحبك يا موت ولكني لا أخافك».
يعتبر سميح القاسم من الرعيل الأول لشعراء المقاومة كما سمّاهم آنذاك الأديب الشهيد غسان كنفاني. نشر مجموعته الشعرية الأولى «مواكب الشمس» عام 1958. وكان قد سبقه في إصدار ديوان للشعر المقاوم راشد حسين، وتلاه محمود درويش وتوفيق زياد، ليُشكلوا معاً ما اصطلح على تسميته «أدب المقاومة». يقول الشاعر سامي مهنا، رئيس «اتحاد الكتاب الفلسطينيين العرب» في الداخل المحتل إنّ «ظاهرة أدب المقاومة أدهشت العالم العربي في أعقاب النكسة. أفاق هذا العالم على وقع الهزيمة وسمع أصواتاً مجلجلة تقف أمام «الأسطورة الإسرائيلية» من داخل الأرض المحتلة».
ويضيف الكاتب والناقد أنطون شلحت إنّ «أهم ما في سميح القاسم أنّه كان أحد الأركان المتينة لظاهرة شعر المقاومة الذي أنتج في ظروف تعتبر الأدنى من حيث شروط الإبداع الأدبي بعد أعوام قليلة من نكبة 1948 وما ترتب عليها من مدلولات سياسية واجتماعية وثقافية بالنسبة إلى الشعب العربي الفلسطيني، وخصوصاً ذلك الجزء الذي بقي منه داخل الكيان الذي أقيم على أنقاض وطن هذا الشعب. وكان الاحتفاء بهذه الظاهرة بعدما اكتشفها العالم العربي عقب حرب حزيران 1967، احتفاءً ليس بعنصر المقاومة في هذا الشعر، بل أيضاً بالإبداع الصافي وبهاجس الحياة وبقدرتها على مخاطبة قارئ لا يساوم، ولا يرتطم بجدران ظرف عابر أو تقليد فجٍ».
أنشأ «الشبان
الأحرار» المناهضة للتجنيد الإجباري للشبان العرب الدروز
سُجن سميح القاسم مراراً في السجون الإسرائيلية على خلفية كتاباته الأدبية والشعرية ورفضه الالتحاق بالخدمة العسكرية القسرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المفروضة على الطائفة العربية الدرزية التي ينتمي إليها. أنشأ المجموعة التي أطلق عليها «الشبان الأحرار» تيمّناً بثورة الضباط الأحرار في مصر، وقد عملت على مناهضة التجنيد الإجباري للشبان العرب الدروز. ويُجمع عديدون على أن لسميح القاسم فضلاً كبيراً في ترسيخ الهوية الفلسطينية لدى الفلسطينيين في الداخل المحتل. إذ يلاحظ منذ بدايات شعره في الستينيات حين ساد الحكم العسكري الذي حاول طمس الهوية الفلسطينية ومحوها أنّ «سميح أعلن عن الهوية الفلسطينية وأسهم في ترسيخها. دور الثقافة هنا الذي ساهم فيه القاسم بشكل كبير، سبق دور السياسة والأحزاب السياسية»، كما يقول أنطون شلحت.
«لقد كانت المعركة الثقافية والأدبية جبهة وخندقاً أسهما في الثورة الفلسطينية. لقد كان شعر سميح القاسم ومحمود درويش وشعراء المقاومة الآخرون ممنوعاً خلال فترة الحكم العسكري، إذ نصبت الحواجز على مداخل البلدات العربية، وقام الناس في بعض الأحيان بتهريبهم من خلال الجرافات الزراعية إلى داخل تلك البلدات كي يتمكنوا من إلقاء الشعر لجمهورهم»، يضيف الشاعر سامي مهنا.
يعتبر أنطون شلحت أنّ ما يُميّز شعر سميح القاسم أن «جملته الشعرية عكست أكثر من أي شيء آخر غضباً ثورياً خضع لتحولات لم تَنه عن الأصل، وتحولت الى ما يشبه النبوءة الثورية. كذلك، فهي جملة تتميز بمتانة اللغة وبالنهل من التراث الشعري العربي القديم ومتمكنة من العروض الشعرية التي كان يعتبرها أهم معايير كتابة الشعر ولا تشكل قيداً عليه». ويرى الشاعر سامي مهنا أنّ «ما يميز شعره هو ارتكازه على الثقافة العربية الإسلامية، والمبنى الأوركسترالي في قصيدته. كما أنه من شعراء الحداثة القلائل الذين لم يقطعوا العلاقة مع القصيدة العمودية واستمر في كتابتها حتى آخر أيامه. لقد استطاع أن يصالح بين الحداثة والأسلوب القديم في الشعر العربي».
إضافة إلى المساهمات الأدبية والشعرية التي بلغت أكثر من 70 عملاً، فقد كانت لسميح القاسم إسهامات في المجال الصحافي والثقافي. ترأس تحرير مجلة «الجديد» التي أسهمت في إعلاء شأن القضية الفلسطينية، وخصوصاً قضية الفلسطينيين في الداخل. كما عمل في صحيفة «الاتحاد» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الذي انتمى إليه حتى أوائل تسعينيات القرن الماضي وفي صحيفة «كل العرب». الصحافي سليم سلامة الذي عمل مع القاسم في صحيفتي «الاتحاد» و«كل العرب» يعتقد أنّ «سميح القاسم هو آخر عنقود الجيل القيادي الذي أسهم في ترسيخ الوعي الوطني والاجتماعي، ومحاربة التعصب الاجتماعي والطائفي، لقد ترك فراغاً سنشعر به لاحقاً».
في حضرة الغياب وفي شهر آب، سيشيع آلاف الفلسطينيين شاعر المقاومة الأخير، ملتحقاً برفيق دربه محمود درويش وصدى صوته يقول «أسَمّيكَ نرجسةً حول قلبي، لو كان قلبي معكْ، وأودعتُهُ خَشَبَ السنديان، لكنتُ قطعتُ الطريقَ بموتٍ أقلّ».
كل الأزمنة العربية مناسبةٌ لموت شاعر/ صهيب عنجريني
دمشق | حسناً فعلتَ يا رجُل. لقد متّ في الوقت المناسب تماماً! ذات ثلاثاء عربي عادي، في منتصف الأسبوع. ليس ثمّة عطلة، ولا تراكم في الأنباء الواجبة النشر. سيكونُ من السهلِ أن تخصص لك الصحف صفحات وصفحات في اليومين التاليين. لا أحداث خارجة عن المألوف تدعو إلى الانهماك فيها، وتقليص مساحات نعيك. كل شيءٍ على ما اعتدنا: «الخفافيشُ وراء الصحف (…) وعلى واجهة الكتب وسيقان الصبايا».
و«ملءُ مدارج التاريخِ أفواج من الشهداء». حسناً فعلت، المشهدُ مناسبٌ تماماً. دمشقُ تضحكُ علينا، إذ نُصدّق أنها بخير. و«في بغداد نازفةٌ دماء شعبي من حينٍ إلى حينِ». القاهرةُ تجمعُ المُمثلين في فصول مُكررة من مسرحية باهتة. وغزة من جديد تحت النار. حسناً فعلت، المشهد مثالي، العالمُ العربيّ كلّه كـ «خليج جونية المنفرج كفخذي قحبة تنتظر رجال البحرية الأميركية». ويمكننا هجاء واشنطن كما نشاء: «في فيتنام مذبحة وأنت تُصدّرين / كعكاً وأدوية الى القمر الحزين/ وتكنسين على دم الجرحى الزبالة». كلّ شيءٍ مُناسب، ستجدُ الشاشاتُ فائدةً إضافيّة في استعادة بعض مما قلت، فنحنُ ـ كما المعتاد ـ في أمسّ الحاجة إلى البكائيات. ستُساعدُ في ذلك قصائدكَ المغنّاة، فالغناءُ ملائمٌ لحفلات العويل العابرة. سيكونُ سهلاً علينا نحنُ الكَتبةَ أن نجترّ المراثي ذاتها، مستعينين بك. كأن يدخل أحدنا إلى نعيك من باب «الدم الصهيل»، مٌستعيراً منها: «يا رائحاً للشام سلم على الحبيب». ويوسّع آخر العَدسة، فيصطاد من «تغريبة» قولك: «لأن البلادَ – دع الشعر – ليست تفكر في النازحين». وعبرها يردد كثيرون صرختك: «ولم يبق في الأرض غير الذين يحبوننا ميتين»، وكأنّ الأرض اتسعت لسواهم يوماً ما! حسناً، علينا أن نشكرك ونعترف، لقد تركت مفاتيح كثيرة للراثين. أنا أفكرُ مثلاً في عقد مقارنةٍ بيني وبينك. سأقولُ: إنّني مثلُك، شاعرٌ اشتغل في الصحافة. الأمر سهلٌ – كما ترى – في زمانٍ باتت فيه حيازة لقب شاعر أسهل من حيازة عقب سيجارة. وباتَت فيه «سوق الصحافة» مفتوحة على مصراعيها أمامنا، نحن الطارئين. ولن يكونَ صعباً أن أختتم بجملةٍ من طراز: «هذه ليست مرثيّة يا سميح». أتسألُ عن الآخرين الذين لن يحلو لهم تمجيدُك؟ لا تقلق، لقد اخترت التوقيت المناسب لهؤلاء أيضاً: محاكم تفتيشنا تخضرمَت، والمشانقُ جاهزةٌ في كل حين. وسيكونُ سهلاً عليهم أن يجدوا في مسيرتك ما يستوجبُ ذبحك. هل قلتَ يوماً إنّ هناك «سوناتا سيئة، ومارشٌ جيد»؟. دعني أبشّركَ إذاً، سنعزفُ في وداعك عشرات السوناتات الرديئة، وعشرات المارشات الأشد رداءة. لن يفاجئكَ هذا حتماً، فأنت تعي جيداً القيمة الحقيقية للزمان العربي الذي اخترتهُ ميقاتاً لموتك. ها أنتَ تبتسمُ ساخراً إذ أكرر قولي: لقد متّ في الوقت المناسب تماماً. ويخطر لكَ أن تشدّني من أذني صارخاً: كل الأزمنة العربية مناسبةٌ لموت شاعرٍ يا ولد.
بقيت بيروت دونه وتعرفه أزقة المخيم/ عبدالرحمن جاسم
«تقدموا: لا خوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع، غزة تبكينا، لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدامي للرجوع، تقدموا، من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة، تقدموا، يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب، يضج كل عصب، الموت لا الركوع، موت ولا ركوع، تقدموا».
أول من أمس، رحل سميح القاسم. لم تطفأ الأضواء في المخيّم، كما لم ترفع الأعلام السود. هكذا يرحل الشعراء بصمت في بلادٍ تحترف قتل الشعراء كما كان يقول صديقه القريب محمود درويش في إحدى قصائده. القاسم الذي عرفه الفلسطينيون العائدون في لبنان من خلال قصيدته الأقرب إلى قلوبهم «منتصب القامة أمشي» غازلهم كثيراً ولم يزرهم بسبب المنع الاسرائيلي، ومحاولته الوحيدة باءت بالفشل عام 2001. يعتبر القاسم من جيل الرواد للشارع الفلسطيني، سواء أكان ذلك شعرياً، ثقافياً، أو حتى أدبياً، وإن لم يحظَ بالشهرة نفسها التي حظي بها محمود درويش في لبنان. لكن ما يفاجئ كثيراً أنّ قصائد الشاعر الذي لم يغادر أرض فلسطين كثيراً يحفظها كثيرٌ من الأطفال، وتتردد في حناجر أطفال المخيم. قصيدة «تقدموا» مثلاً التي سُجن على إثرها ووضع بعدها في الإقامة الجبرية، تعتبر من أشهر ما يعرفه الفلسطينيون عنه ههنا. القصيدة الصاخبة الممتلئة ثوريةً، تستعمل كل عامٍ في الاحتفالات المركزية التي تقيمها معظم الفصائل الفلسطينية (حتى الإسلامية منها) داخل المخيمات في لبنان. القصيدة مباشرةٌ من دون أفعال مواربة (كالتي يستعملها درويش مثلاً). لذلك لم يكن غريباً أن يقرأها أغلب الأطفال الفلسطينيين على منصة كلما أرادوا المشاركة في إعلان موقفٍ مقاوم. في الإطار عينه، رسمت الكلمة مراراً على حوائط المخيم كشاهدٍ، رغم أن كثيرين لا يعرفون بأن صاحب القصيدة/ الكلمة هو شاعرٌ لم يأتِ يوماً إلى لبنان. لم تعرفه أزقة المخيمات إلا شاعراً، ولم يلحظه أيُ مارٍ. لكن مع هذا، فإن سألت أهل المخيمات عنه، وجدتهم يتحدثون عنه بصيغة العارف، حتى إنّ بعضهم يعتقد بإصرار أنه زار المخيّم، وقابل ياسر عرفات هنا في أحد المنازل.
القاسم الذي كتب مرثية لتل الزعتر نشرت آنذاك في إحدى الجرائد الفلسطينية، كانت شديدة الأثر على المخيمات (رفض لاحقاً إعادة نشرها والحديث عنها حتى خلال المقابلة على قناة «الجزيرة» القطرية التي تناولت حياته، ربما لأن تلك القصيدة حوت موقفاً سياسياً هاجم فيه الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي عاد وقابله ورثاه عند وفاته). تناقلها الكبار ككنز دفين، وكانت قصيدته قد نشرت قبل ان يكتب محمود درويش «أحمد الزعتر». يحكى يومها أنّ القصيدة نسخت يدوياً ووزعت على سكان المخيمات الأخرى، لأن الطباعة والنسخ الطباعي كانا مرتفعي الثمن. لذا، كان أسرع الطرق وأزهدها هو النسخ. نُسخت أكثر من 1000 نسخة يدوية كتبت بخط اليد من متطوعين فلسطينيين وكان الهدف إسماعها للناجين من المذبحة، كما للعالم بأنه ما زال هناك صوتٌ حي خلف كل تلك الدماء. قد لا ترفع أعلامٌ سوداء في المخيمات الفلسطينية لرثاء سميح القاسم ربما لأن الشعراء لا يرحلون، يبقون دائماً حيثما يريدون هم. ستظل كلماتهم تتردد في حناجر الأطفال كل عامٍ وفي كل مناسبة، وستظل كثيرٌ من الحوائط دليلاً وشاهداً على أنّ: منتصب القامة يمشي، مرفوع الهامة: ينتصر!
سيرته في سطور
«هناك سنلتقي في الجنة أو في الجحيم، الأكيد أننا سنلتقي». ودّع سميح القاسم الشاعر الراحل أنسي الحاج بهذه الكلمات. ولعلّه وحده كان يعرف أن اللقاء قد يكون قريباً إلى هذا الحد. تلقّى الشعر العربي ضربات كثيرة في السنوات القليلة الماضية، وها هو الحداد يلف القصيدة مجدداً مع انطفاء سميح القاسم بعد صراع مع مرض سرطان الكبد. من قرية الرامة الفلسطينية، بدأت رحلة القاسم عام 1939. أمضى مرحلة الدراسة الابتدائية في «مدرسة اللاتين» في الرامة بين 1945 و1953، قبل أن ينتقل إلى «كلية تيرا سانطا في الناصرة»، إلى أن نال شهادة الثانوية سنة 1957. بعدها سافر إلى الاتحاد السوفياتي، وهناك درس سنة واحدة الفلسفة والاقتصاد واللغة الروسية. أما المحطّة التالية، فكانت نشاطه السياسي في «الحزب الشيوعي»، قبل أن يترك الحزب ليتفرغ لعمله الأدبي كلياً، الذي سيصبح غزيراً في ما بعد، وسيجعل اسمه من بين أهم الشعراء الفلسطينيين المعاصرين إلى جانب محمود درويش وتوفيق زيّاد. إلى جانب العمل السياسي والأدبي المتنوّع، انخرط القاسم في العمل الصحافي أيضاً، فكان من مؤسسي صحيفة «كل العرب»، قبل أن يسهم في تحرير «الغد» و«الاتحاد»، و«هذا العالم» و«الجديد». كذلك أسّس منشورات «عربسك» في حيفا مع الكاتب عصام خوري سنة 1973، وأدار «المؤسسة الشعبية للفنون» (حيفا)، وترأس «الاتحاد العام للكتاب العرب الفلسطينيين».
ما قالته القصيدة/يوسف الشايب
رام الله | “أنا لا أحبك يا موت، لكني لا أخافك، وأدرك أنك سرير لجسمي وروحي لحافك.. وأدرك أنّي تضيق عليّ ضفافك.. أنا لا أحبك يا موت، لكني لا أخافك!”.. كانت هذه آخر كلمات أيقونة الشعر العربي سميح القاسم التي خطها بيده قبل رحيله بأيام، ونشرت كصورة على صفحته على الفايسبوك، قبل أن يخطفه من لا يحب، مساء أول من أمس، متواطئاً مع “الخبيث الذي لا يرحم”.
وتوالت ردود الفعل الفلسطينية والعربية، السياسية والثقافية والفنية، في نعي صاحب “منتصب القامة”، و”تقدموا”، وغيرها الكثير من القصائد الخالدة.. ونعى الرئيس محمود عباس، الشاعر الفلسطيني الذي غيبه الموت مساء الثلاثاء، بعد صراع مع المرض. وقال عباس في بيان له، إنّ القاسم “صاحب الصوت الوطني الشامخ، رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء، هو الذي كرّس جلّ حياته مدافعاً عن الحق والعدل والأرض”.
وفي الإطار نفسه، نعته اللجنة التنفيذية لـ “منظمة التحرير الفلسطينية”. وقالت حنان عشراوي رئيسة دائرة الثقافة والاعلام في المنظمة: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر نبأ وفاة أحد أبرز رموز الثقافة الإنسانية المعاصرة، الشاعر الكبير سميح القاسم، شاعر الوطن والثورة، عاشق فلسطين، وأحد أهم رواد المشروع الثقافي الفلسطيني الحديث”. وأضافت: “عاش القاسم مدافعاً عن الثقافة الوطنية الفلسطينية في مواجهة محاولات التبديد والطمس حيث حملت أشعاره ومؤلفاته في طياتها قضية ومعاناة وطموحات شعبه وبلاده، إلى كل أرباع الكون، وكل اللغات، لترسم صورة الإنسان الفلسطيني.
من جانبه، قال “المجلس الوطني الفلسطيني” على لسان رئيسه سليم الزعنون، إنّ رحيل سميح القاسم “خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني الذي كرس كل أعماله الشعرية في خدمة قضيته ونضاله العادل، وخسارة لا يمكن تعويضها لامتنا العربية”.
وقال: “سيبقى شعبنا الفلسطيني يقاوم ويناضل حتى يتحقق حلمه في العودة إلى وطنه وهو يخلد أعمال شاعر فلسطين ويستذكر قصيدته الخالدة: تقدموا. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ. ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا. مهما هددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا. لن تهزموا أشواقنا. نحن القضاء المبرم. تقدموا”.
وعلق “متحف محمود درويش” في مدينة رام الله نشاطاته لثلاثة أيام حداداً على روح القاسم، فيما نعت وزارة الثقافة الفلسطينية “شاعر فلسطين الكبير وأحد أبرز وجوهها الثقافية والشعرية، الشاعر المناضل سميح القاسم، الذي غيبه الموت بعد صراع طويل مع المرض”.
وأعرب “الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين” عن شعوره بفداحة الخسارة للحركة الثقافية في فلسطين، وفي الوطن العربي، والعالم الحرّ، برحيل هذه القامة الثقافية العالية، واستذكر “بمزيد من الفخر الدور الذي لعبه الشاعر الكبير، إلى جانب الراحلين توفيق زيّاد ومحمود درويش، في التأسيس لمدرسة المقاومة الشعرية، التي انطلقت شرارتها الأولى من داخل الدائرة الضيّقة التي أغلقها الغاصبون بالنار والحديد على ذلك الجزء العزيز والغالي من وطننا، وليكسر الشعراء الثلاثة، ومن جايلهم من مثقفينا هناك، تلك الدائرة السوداء محلقين في الفضاءات العالية”.
في حوار أجراه كاتب هذه السطور معه قبل قرابة شهرين، وبدأت “ذوات” (صحيفة ثقافية فكرية تصدر عن مؤسسة “مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث”) بنشره على أجزاء، استهجن القاسم حديث البعض عن نظمه قصيدة لرئيس وزراء الاحتلال الراحل إسحق رابين. وقالها بوضوح: “هذه إشاعة. على حد علمي، ذكرتُ رابين في الشعر العربي مرة واحدة في قصيدتي “يوم الأرض” عام 1976. قلت حينها “هل أوقفت الشمس على أسوار أريحا. أرضيت الرب القاتل لا نعلم. لكنا نعلم أن الشمس تسير على أعناق الشهداء. من بحر البقر إلى سخنين ومن المغرب لفلسطين فاسمع يا يوشع واسمع يا رابين. ما حصل وشُوه بهذا الشكل البذيء وتم الإدعاء زوراً وبهتاناً بأنني رثيت رابين، هو باختصار أنه عقدت ندوة عن العنف السياسي والأدب، وطلب مني أن أحاور بعض الشعراء اليهود. بالمناسبة قلتها مليون مرة أنا أحاور الشيطان شخصياً في سبيل قضيتي. نحن لسنا عنصريين ولسنا معادين لليهود كونهم يهوداً، فهناك يهود تقدميون أشرف من سماسرة وعملاء عرب. أنا أحاور الجميع. لقد سبق وحاورت “كهانا”. قضيتي عادلة وأنا قادر على الدفاع عنها، لذلك حين أدعى لحوار كهذا في ذكرى مقتل رابين، مكاني الطبيعي أن أكون هناك لأنقل صوتنا جميعاً. صوت شعب وأمة. لم تعينّي الجامعة العربية. وأنا، لمن أحب أو لم يحب، الناطق غير الرسمي باسم الأمة العربية كلها، وباسم الأمة الإسلامية كلها. هذه الإشاعات كلام صهيوني، فلا مصلحة لأحد بتشويه سمعتي أو سمعة محمود درويش أو غيرنا إلا الحركة الصهيونية الهادفة إلى تشويه رموز أدب المقاومة، وللأسف نجد من يكرر هذه الاتهامات وذلك لغياب “الثقة بالنفس”.
وقتها قال القاسم، وكان يرتدي بيجاما من “الستان” في منزله في قريته الرامة في الجليل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948: “رحلة الاحتلال وما يرافقها من شتات فلسطيني عابرةٌ، لأن القصيدة تنبأت بذلك. تشتتنا بين رام الله والرامة في الجليل أمر طبيعي في هذه المرحلة غير الطبيعية. هذه المرحلة غير الطبيعية عابرة لأن القصيدة الفلسطينية قالت لها ستكونين لها مرحلة عابرة. هذا ما قالته القصيدة، والقصيدة لا تشتغل بالتكتيك ولا بالخرائط ولا تفاوض. القصيدة تقول حلمها وجموحها بكل حرية، ولذلك فليس هناك شيء أكثر صدقاً من “القصيدة الصادقة”.
وتذكر القاسم “يوم ودعنا قيادة المنظمة في تونس. قلت لأهل تونس جايين نأخد البنت منظمة التحرير لعريسها الوطن”. وأضاف: “قلت بأن الدولة الفلسطينية قادمة، فرد عليّ أحدهم بأنني أهذي وبأن ما أقوله خيال شعراء، فأكدت بأنه ليس على الأرض أكثر واقعية من خيال الشعراء. وخيال الشعراء يقول بأن الاحتلال زائل لأنه باطل. الاحتلال يتعارض مع المنطق التاريخي ومع الوعي الإنساني ومع الأديان والشرائع السماوية والأرضية، ومع مهب رياح العصر الذي يرفض الاحتلال والعنصرية ونهب الأرض وبناء البيوت عليها للوافدين من كل أنحاء الأرض، ويرفض ما يسمى “الاستيطان”، وهو استعمار كولونيالي بكل معنى الكلمة. هذا ما قالته القصيدة الفلسطينية منذ بداية الصراع”.
نَظم الكارثة: من السرد إلى الميثولوجيا/ محمد علي شمس الدين*
سميح القاسم خرج من عصر المناحات الشعرية العربية تماماً في اللحظة التاريخية المناسبة، وهي اكتمال الهزيمة عام 1967، إذ سيبتدئ من القاع محاولة تسلق القمة. كان ثمة جوقة من المراثي العربية تصدح بأصوات متنوعة من أعماق الجزيرة الى شاطئ المتوسط، ومن أطراف النيل الى ثلوج صنين، ولماذا؟
نسأل ونجيب: لأن التاريخ العربي الحديث والمعاصر جاء ليكلّل سقوط بغداد بأيدي التتار، وسقوط الأندلس بأيدي الإسبان، وسقوط لواء اسكندرون بأيدي الأتراك، بتاج الشوك سقوط فلسطين. وبعد عشرين عاماً، سقوط الفتى المهر الأغرّ جمال عبد الناصر عن صهوة العروبة عام 1967. لا نستطيع فهم صوت شعراء الأرض المحتلة مثل سميح القاسم ومحمود درويش وتوفيق زيّاد من دون هذه الحاشية التاريخية. هذه الحاشية التي أصبحت متن الشعر العربي الحديث بكامله، وهو شعر سياسي بالضرورة حتى ولو تكلم الشاعر عن «لن» (أنسي الحاج) أو عن الكركدن (توفيق صايغ)، فالتاريخ ضاغط على لهاة الشاعر وضاغط على اللغة. وبرغم نكهة سميح الساخرة، إلا أنه في حقيقته ومنذ دواوينه الأولى مثل «مواكب الشمس» (1958)، و«أغاني الدروب» (1964)، وهي رومانسية متأثرة بمن سبقها مثل عبد الرحيم عمر، وعلي محمود طه، حتى الأخيرة «كولاج» (2012). هو شاعر حكائي يتناول مفرداته من الفم السائر للناس ومن الفولكلور الشعبي الفلسطيني، وكثيراً ما يلجأ إلى الأساطير والكتب الدينية، وينهل من كل ذلك مادته الشعرية، فيمزج بين حدين بعيدين، حدّ الحكي اليومي القريب الذي يسمّي الأشياء بأسمائها حتى لو كانت بالأجنبية فيقول مثلاً: «ونأخذ كي يستطيع الكلام ومعناه OK» (ديوان «هواجس لطقوس الأحفاد»)، وحدّ اللغة الأسطورية أو الدينية كما يفعل في قصائده الطويلة التي سماها «سربيّات».
ابتكر سميح مصطلحاً لنمط من القصائد كتبه بصيغة مطولات شعرية سماها «سربيّات» مثل ديوان «ثالث أوكسيد الكربون»، حيث يعرف السربية بقوله «هي تسمية مجازية للقصيدة الطويلة». أما ثالث أوكسيد الكربون، فيشتمل برأيه على عنصر سيكولوجي هو من العناصر المكونة للروح، أي أن الشاعر ينفث مع نفسه جزءاً من روحه، والسربية قصيدة طويلة متشابكة مؤسسة على أسطورة أو حكاية تاريخية، أو مقاطع من الميثولوجيا الدينية. وتتميز بالسرد الروائي وتشابك الأصوات وبناء قريب من البناء المسرحي. هذا هو الشكل. أما الجوهر، فهو إسقاط موضوع السربية على الواقع الفلسطيني. في مطولات القاسم ما يشبه المسرح في المسرح الذي غالباً ما لجأ إليه شكسبير في مسرحياته، فقد أسقط في ديوانه «كلمة الفقيد في مهرجان تأبينه» (2000) الأصل الشكسبيري لمسرحية «هاملت» على المسرح الفلسطيني، متخذاً من هاملت قناعاً شخصياً له، وهو يسأل: هل أنا هاملت أم سميح؟ وأحياناً يسأل: هل أنا سميح أم مسيح».
كذلك سربية «انتقام الشنفرى»، حيث يتقمص القاسم شخص أهم الشعراء الصعاليك في الجاهلية وأجمل غراب للعرب، وهو الذي انتقم من العشيرة بقتلها جميعاً. سميح القاسم هو الأقرب الى هاملت من حيث تفرّده بالدعوة الى الانتقام، وتفرّده بأنه يقول بمقايضة الموت بالموت والدم بالدم أكثر مما يدور في فلك المصالحات. إنه ينفرد في ذلك عن شعر محمود درويش، فهو شعر مصالحة «إنسانوية». ورغم النبض الإنساني في شعر سميح، إلا أنّه كموقف سياسي حاد جداً وواضح جداً، وهو أقرب الى رموزه التاريخية من أي شاعر فلسطيني آخر. وبإمساكه بأشباح هاملت وآلامه، يلعب في القصيدة تقنية المرايا: «أنا هاملت العربي اشهدوني/ أدرّب عقلي على أُحجيات الجنون/ أبي ميت لا يموت/ وأمّيَ أمي/ وملكي نهبٌ لعمي».
مات الصديق الجميل سميح القاسم حيث كان يقيم في «الرامة» من الجليل الغربي، ولم يكن الموت يخيفه. كان يكره الموت ولكنه لا يخاف منه. يقول في «كولاج 3» معاتباً السرطان: «اشرب فنجان القهوة يا مرض السرطان/ كي أقرأ بختك في الفنجان». سميح كان قريباً جداً من نفسي، وقريباً شخصياً أيضاً أكثر من سواه. عفوي وطفل وحرّ. نقي ساخر وساحر، وإذا كان «القرب حجاباً» كما يقول ابن عربي، فها هو سميح القاسم يبتعد قليلاً ليتركني أقرأ شعره.
* شاعر لبناني
سميح ومحمود: إشكالية الالتباس/ عبدالرحمن جاسم
لم يكن مستغرباً تلك العلاقة الملتبسة بين سميح القاسم (1939 ـ 2014) ومحمود درويش (1941 ـ 2008)، فهما لطالما تخاصما وتحابا، تقاتلا وتراسلا. ولا ريب في أنّ جناح البرتقالة الثاني (أو الأول) للشعر الفلسطيني، عرف ذات يوم بأنّ منافسه الأبرز فلسطينياً سيرحل بصمتٍ وهدوء ذات يوم، وستكون له (هو) غلبة وإن «زمنية» على الساحة الشعرية. لكنه مع هذا لم يكن سعيداً، فغياب المنافس لا يعني إلا أن الساحة أرضٌ بوار. هكذا صنّفها القاسم يوم رحيل درويش، فنعاه، ونعى الأرض التي استحالت بواراً بعد رحيل «شاعرٍ خاصب».
عاش القاسم حياةً مليئة بكل شيء، شأنه شأن درويش. وإن لامس محمود النجوم أكثر، فلأنّه طرد من فلسطين، وتجوّل وسافر، ومارس حياةً شخصيةً صاخبةً، وسياسية أكثر صخباً، نزق الشعر ونزفه، لذلك كان طبيعياً أن يحصّل شهرةً أكبر من شاعري فلسطين المجايلين له: توفيق زيّاد وسميح القاسم. كل ذلك لم يرهق سميح كثيراً، ولم يفكّر به أكثر، فهو في رسائلهما المشتركة التي عنوناها «الرسائل»، حكى كلام «الصديق للصديق» وليس الشاعر للشاعر فحسب. كانا مجرد فلسطينيين يتبادلان اطراف الحديث بعمقٍ وعلانيةً.
اعتبرت سلمى الخضراء
الجيوسي بأنّه «الوحيد الذي تظهر عليه ملامح شعر ما بعد الحداثة»
الشاعر المولود في الزرقاء في الأردن الذي واجه «الإسكات» منذ لحظات حياته الأولى حين كاد ركاب القطار العائد إلى فلسطين خلال الحرب العالمية أن يقتلوه ـ وهو إذ رضيع ـ لإسكاته خوفاً من طائرات الألمان، قال يومها: «حسناً لقد حاولوا إخراسي منذ الطفولة سأريهم، سأتكلّم متى أشاء، وفي أيّ وقت وبأعلى صَوت، لنْ يقوى أحدٌ على إسكاتي». وهو ما فعله بشكلٍ مباشر. لن يسكته أحدٌ بعد اليوم، سيرفع الصوت خفاقاً ضد الصهاينة في كل مناسبة، ما حدا بهم إلى رميه في أكثر من زنزانة ووضعه في الإقامة الجبرية مراتٍ عدة ومنعه من السفر مراراً. هذه العوامل أثّرت كثيراً في «شعريته»، وهو ما افتقده شعر محمود درويش بشكلٍ مباشر وفق ما يشير كثيرٌ من النقاد. الاحتكاك المباشر واليومي مع المحتل، يجعلك أكثر حدةً، ويقرّب شعرك من أذهان من تريد مخاطبتهم. ظلت قصائد القاسم قريبة المآخذ، وإن لامست جوهر الشعر نفسه. أما قصائد درويش التي أعقبت رحيله من فلسطين (وحتى عودته إليها لاحقاً وإن لم يدخل قريته أبداً)، فتبدو أكثر «حداثةً» حتى ليشير كثيرون إلى أنّ شعر درويش هو الأحدث بين معاصريه ولو خالفت الباحثة والكاتبة سلمى الخضراء الجيوسي هذا الأمر بوصفها سميح القاسم بأنّه «الشاعر الوحيد في الوطن العربي الذي تظهر عليه ملامح شعر ما بعد الحداثة». شعرياً، امتاز درويش بتقديره الصائب للمرحلة ربما بسبب تجواله بين العواصم سياسياً وثقافياً، وهو عنصر كان يغيب عن شعر القاسم لضلوعه في المواجهات اليومية المباشرة مع الصهاينة.
عرف القاسم الشهرة وإن بدرجةٍ أقل خارج فلسطين، فهو لم يخرج من هناك إلا مراتٍ قليلة وبصعوبةٍ بالغة، لكن من ينسى لقاءه بالرئيس السوري الراحل حافظ الأسد (ضمن وفد من دروز الداخل الفلسطيني في 8-8-1997) الذي أسر له بأن معظم جنود الجيش السوري يحفظون قصائده، وبأنها تُدرَّس ضمن المنهاج التعليمي السوري الرسمي. في الوقت عينه، كان درويش يأخذ المجد بكامله، يزور الرؤساء ويجتمع بالقادة ويؤسس لمرحلة شعريةٍ جديدة في الشارع العربي: كان النجم الوحيد للشارع الشعري في وطنٍ عربي بأكمله. قاعات تمتلئ حتى آخرها، فتيات يتهامسن لمجرد رؤيته، وفوق كل هذا قيمةٌ سياسية مرتفعة من خلال علاقةٍ أكثر من رائعة مع «منظمة التحرير الفلسطينية». لم يعرف القاسم علاقةً مماثلةً مع منظمة التحرير، فلقاءاته مع «الختيار» (أبو عمار) كانت صاخبةً دائماً، وعرفات كان مولعاً بالاستعراض: مرةً، حمل مسدسه والشاعر يلقي قصيدةً على المنبر، اقترب منه وقال بصوتٍ مرتفع: «هذا مسدسي صوبني به إذا أنا أخطأت». الشاعر المتوثب الذكي عرف كيف يتلقف الفكرة: «أنا أصوبك بكلماتي وقصائدي»، هكذا أجاب وهكذا انتهت القصة كما العلاقة مع المنظمة.
أما الجمهور، فتلك حكايةٌ أخرى مع القاسم. هي تلك العلاقة المباشرة مع المحسوس/ المسموع والمرئي/المشاهد، فالظهور الشعري المباشر يظل ذا أثرٍ كبيرٍ (خصوصاً في تلك المرحلة التي لم تكن تمتلك أياً من تكنولوجيا هذا العصر). كان وجود درويش بشكلٍ فعلي في بيروت (أو أي عاصمةٍ أخرى كعمان والقاهرة والرباط) يجعل الإقبال عليه أكثر من غيره، بسبب شعره وكاريزماه وجاذبيته، وبالتالي كان يسحب البساط من تحت أي منافسٍ مهما كانت أهمية «المُقال». لم يزر القاسم عاصمة الشعر العربي «بيروت»، ولم يقدّم أي أمسيةٍ فيها (رغم محاولات رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لإحضاره إلى بيروت عام 2001). في الإطار عينه، كرّس غناء مرسيل خليفة لمحمود درويش الشاعر الفلسطيني كأيقونة، ذلك أمرٌ لا شك فيه، حتى إنّ كثيرين ما زالوا حتى اللحظة مقتنعين بأن «منتصب القامة» هي لدرويش لا للقاسم.
إصدارات وجوائز
خلال رحلته الأدبية الغزيرة، أنجز سميح القاسم ما يقارب 80 مؤلفاً في الشعر والقصة والمسرح والمقالة والترجمة. عام 1958 أصدر باكورته «مواكب الشمس» (1958) لتليها «أغاني الدروب» (1964) و «إرم» (1965)، وغيرها من الدواوين التي شكّلت هويّته الشعرية المقاومة منها: «إلهي إلهي لماذا قتلتني؟» (1974)، «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» (1976)، و«لا أستأذن أحداً» (1988)، و«الكتب السبعة» (1994). وفي الرواية كتب «إلى الجحيم أيها الليلك» (1977)، «الصورة الأخيرة في الألبوم» (1979). أما نتاجه النثري، فقد اشتمل على مؤلّفات عدة أبرزها «عن الموقف والفن» (1970)، و«أضواء على الفكر الصهيوني» (1978)، و«الرسائل _ مع محمود درويش» (1989)، و«مطالع من أنطولوجيا الشعر الفلسطيني» (1990)، وسيرته الذاتية «إنها مجرّد منفضة» (2011). لاقت مؤلّفات القاسم رواجاً بعدما ترجمت قصائده إلى الإنكليزية والفرنسية والتركية والروسية والألمانية واليابانية والإسبانية واليونانية والإيطالية والتشيكية والفيتنامية والفارسية والعبرية… ومن بين الجوائز العالمية والعربية التي نالها: جائزة «غار الشعر»الإسبانية، «جائزة البابطين»، واستحقّ «وسام القدس للثقافة» من الرئيس ياسر عرفات مرّتين، وجائزة «نجيب محفوظ» المصرية، وجائزة «الشعر» الفلسطينية.
أحفاد امرئ القيس منهما نصيب/ جمال جبران
صنعاء | يقول يمنيون كُثر بزهو مُعلن: ونحن أيضاً لنا من سميح القاسم ومحمود درويش نصيب. كأنه جزء من الدم الفلسطيني الذي يسري في داخلهم، وعلى وجه الخصوص في جسد اليسار اليمني، والحزب الاشتراكي منه تحديداً. كان درويش كثير الذهاب إلى شطري اليمن، شمالاً وجنوباً، في حين كان صاحب «شخص غير مرغوب فيه» مختصاً بالجنوب لكونه المنتمي الشيوعي ويريد تواصلاً في جهات اليسار كلّه. وكان الجنوب وقتها، إلى ما قبل 1990، شيوعياً أصيلاً. هو سيل من الذكريات يجمع «شطري البرتقالة»، درويش والقاسم باليمن وما زال يطلع إلى سطح الأحاديث عندما تأتي سيرة الشاعرين. في بداية عام 1993 أتى شاعر «أرى ما أريد» إلى اليمن حيث أحيا أمسيات ولقاءات في الجهتين: صنعاء وعدن حين كانت الحرب الأهلية تقترب من بدايتها التي انطلقت بعد أشهر قليلة (صيف عام 1994 وانتهت بهزيمة اليسار أمام قبائل الشمال).
وقف درويش في صالة في صنعاء وقال: «كيف أقرأ الشعر وأنا بين يدي أحفاد أمرئ القيس»، بعدها ذهب إلى عدن والتقى بقيادة الاشتراكي، كأنها محاولة لفعل خطوات باتجاه غلق صفحة المواجهة والدخول في حوار، لكن ظهر أن كل شيء كان قد انتهى واتخذ الطرفان قرارهما. وقبلها بكثير، في منتصف 1988، لم يكن لسميح القاسم نصيب في أن يأتي إلى اليمن ومحمود درويش فيها. دعوة وصلتهما للمشاركة في مؤتمر للمثقفين العرب لدعم الانتفاضة.
نشرت رسائلهما في مجلة
«اليوم السابع» التي كانت تصل إلى اليمن بانتظام
كان درويش في باريس وسميح القاسم في حيفا. بينهما مسافات وبحر ولا بد من وصل الضفتين بشيء ما. لا بد من اختراع يصنع حلقة تحيي التفاصيل القديمة التي كانت بينهما في الوطن المُحتل؛ ذكريات الأيّام الأولى وحكايا الوقوف معاً في طابور الصباح المدرسيّ. استعادة لما مضى ووصف للحال التي وصلا إليها وما فعل البُعد بينهما. التقيا في «استوكهولم الباردة» واخترعا فكرة الرسائل، لكنّ الفكرة تاهت لعامين. ويعترف درويش بتقصيره لأنه «محروم من متعة التخطيط لسبعة أيام قادمة»، الفكرة ستُنشر مباشرة على صفحات مجلة «اليوم السابع» في باريس التي كانت تصل إلى اليمن بشطريه بانتظام. سيقرأ أهل البلاد السعيدة يومها رسالة من درويش لسميح معترفاً «كم افتقدناك في صنعاء… كم تمنّينا أن تكون معنا في صنعاء». قيل إن سبب عدم المجيء هو رفض سلطات الاحتلال منح تصريح خروج للقاسم، في حين أوردت أخبار أنّ صنعاء رفضت أن يدخل أراضيها بوثيقة سفر إسرائيلية. ومهما كان السبب، فإن سميح لم يأت في الحالتين، بينما أظهر درويش في رسالته «كيف أشرح للناس ما لا يُشرَح إلا بالسخرية. كيف أشرح لهم أن قانون الغيتو الإسرائيلي سيحاكمك، لو جئت إلى أرض العرب، بتهمة الاتصال بالعدوّ؟». ومع ذلك، لم يغفل صاحب «ذاكرة للنسيان» أن يسرد لأخيه ما كان في غيابه: «لقد نشر الإخوة اليمنيّون حسرتَك… وجاءني أكثر من أب يمنيّ مُطالباً بتحقيق رغبتك بمُداعبة شِعر طفلٍ يمنيّ. وظلّوا يسألون: لماذا لم يأتِ إلى صنعاء؟». وعليه، يبدو زهو أهل اليمن بانتماء سميح ودرويش إليهم مُستحقاً وفي أيديهم ما يؤكد ذلك.
القصيدة ترتيلة، والتراتيل لا تموت/ مايكل عادل
القاهرة | كيف للمذعورين من لفظ الموت أن يتداركوا أنهم أموات؟ وكيف لمن كتبوا القصائد أن يموتوا ويرحلوا؟ أو يتركوا قصائدهم تعيش بدونهم، أو يتركونا نعيش أمواتاً مذعورين من لفظ الموت الذي يقترب؟ كيف للغرباء أن يغتربوا وكيف لنا أن نغترب دونهم؟ من نحن ومن هم؟ من الذي كتب الآخر؟ أهي القصيدة التي تكتبنا أم صوت قرع الرصاص على أبوابنا وجدراننا الآمنة هو ما يكتب القصيدة ويكتبنا؟
أبى السرطان الغادر الذي نعيشه ألا ينتهي الشهر من دون أن يفقدنا توازننا، لم يتوانَ السرطان بكل أشكاله لحظة عن التمادي والتوغّل بيننا وبناء مستوطنات فوق أجسادنا الهشّة منها والصلبة.
الثلاثاء 19 أغسطس هو يوم قرع سرطان الاحتلال أبواب غزة مرة أخرى، وقرعت صواريخ المقاومة أبوابه، وظل سميح القاسم واقفاً بكتفه ملاصقاً للأبواب دافعاً إياها في الاتجاه المضاد، تلقى الضربات من الخارج إلى الأبواب ومن الأبواب إلى جسده الذي أرهقه وأعياه طول الانتظار. ولكن في هذا اليوم، كانت الضربات الخائنة أقوى من العضل والشحم والجلد والعظام. كادت الروح العنيدة أن تصمد بداخل الجسد ليس لشيء سوى العناد، ولكن استفزازات السرطان لم تثنها عن التحرر والمغادرة، لم ترجعها عن الانطلاق، لم تقنعها بالبقاء أكثر من ذلك. كأنما كُتب على سميح القاسم أن يواجه العدوان السرطان بكافة أشكاله. فقد واجهه 75 عاماً فوق أرض تُغتصب، منها ثلاثة في جسده متمركزاً في الكبد تحديداً.
المعاناة قصيدة، والقصيدة ترتيلة، والتراتيل لا تموت، وها هي معاناة القاسم تدركنا لتُخلّد نفسها بنفس الرنين العذب لكلماته، كيف نأسى لفقد مرتقب لما نعاين من جسد، وكيف للروح الرشيقة أن ترانا نبتئس؟ هل حملنا عزمنا أم أوهنتنا التجربة؟ نعلم ونعلم أنّ فقدان النظر للمعشوقين مؤلم، لكننا وقت الرثاء قد نبدو للروح عراة من الأسى، لكننا أيضاً لدينا عذرنا. واليوم لن ينعى سميح فؤاده، حيث البكاء حين يغنّى الآخرون، فاليوم قد غادر هواه من الزنازين التي بُنيت له، فاليوم يبكي الآخرون والقاسم شدا.
وابن الزرقا والناصرة وحيفا وكافة المدن اليوم طافت روحه فوق الجميع، تراقب الأهواء والنوازع التي لطالما راقبتها عيونه وتأملتها لتدوّنها في شطرات قصيدته. قصيدته التي لم تعتمد الصراخ يوماً لهجة رسمية ولم ترسم الشعارات بين حروفها لتبيعها بيعاً لمريدي الشعارات الرنانة. اليوم طارت روحه فوق الطائرات الصهيونية وقذائفها، وحلّقت ما بين غزّة وسيناء، أرض التيه التي ضرب بها الصورة في قصيدته «غرباء».
اليوم وقف سميح فوق سماء غزّة في انتظار أرواح بريئة في طريقها للانطلاق كل لحظة، يقف متأنقاً مبتسماً لكل طفل تغادر روحه الجسد ليصطحبه ويصطحبها إلى جنّات أصحاب القلوب الراسخة والوطن والتجربة.
اليوم ينتظر سميح ما فشل فيه المسعفون لينجزه. اليوم لن يدخل القاسم جنّات عدن وحده، اليوم سيصطحب العديد من الصحاب والرفاق في يده يرددون عن ماضٍ لهم:
«وحملنا جرحنا الدامي حملنا
وإلى أفق وراء الغيب يدعونا، رحلنا
شرذماتٍ من يتامى
وطوينا في ضياعٍ قاتمٍ
عاماً فعاما
وبقينا غرباء
وبكينا يوم غنّى الآخرون»
لم يُقرأ جيداً وكان هذا يؤلمه/ غسان زقطان
سميح القاسم منطقة خاصة في الشعر الفلسطيني والعربي، لم يعد ممكناً منذ نهاية السبعينيات حصرها في مصطلح «شعر المقاومة». المصطلح لم يأت من داخل الكتابة الشعرية الفلسطينية في الداخل، بقدر ما كان اقتراحاً سياسياً وصل من الخارج. ولعل إطلاقه على أيدي كتاب ثوريين مثل يوسف الخطيب وغسان كنفاني وقبل ذلك محمد البطراوي، هو ما سمح بتكريسه كهوية واصلت التصاقها بشعر الأرض المحتلة، وحددت معايير للكتابة مستمدة من مفهوم المقاومة نفسه وليس من بنية الشعر وغاياته.
هكذا تشكلت قائمة «شعراء المقاومة» التي ضمت تحديداً أسماء الشيوعيين أو الذين كانوا محسوبين على الحزب الشيوعي الإسرائيلي «راكاح» حينها مثل توفيق زياد وسالم جبران، وبالطبع القاسم ودرويش، فيما بقيت هوية شاعر مؤسس مثل راشد حسين محكومة بتلك المسافة بينه وبين الحزب، خارج الشرط «النضالي».
تغير شعر سميح وذهب الى مناطق أرحب وأسئلة وقلق جديد، بينما كان عبء المصطلح «شاعر المقاومة» يدفعه أحياناً كثيرة الى تمرد لا يخلو من الارتباك. منطقة سميح تكمن بالضبط في تلك النقطة، وفي محاولته الجمع بين احتفاظه بالصفة ورغبته في التجريب. لم تأخذه المغامرة الشعرية بعيداً. بقي محافظاً في مكان من تجربته على الصفة التي اقترحتها «السياسة» المتمثلة بالإيقاع والأداء الجسدي، ولكنه واصل التجريب. كان مجرباً بطريقته، ذلك التجريب المأمون المتكئ على قراءات كلاسيكية عميقة قادته في النهاية الى أشكال محافظة تماماً.
كان عليه أن يتحرّر من مفهوم الطائفة في إصرار معلن على عروبته التي حكمت خياراته
في النواة، كان عليه أن يتحرر من أطواق كثيرة أخرى، وأن يقطع شوطاً أبعد وأكثر تعقيداً، وهو ابن الطائفة الدرزية التي فرض عليها القانون الإسرائيلي التجنيد في الجيش، في سياق سياسته في تفكيك مكونات المجتمع الفلسطيني في الداخل. مقاومة سميح بدأت من هناك، مواجهة فردية تمس كل مكونات حياته وثقافته وذاكرته المبكرة وإصرار معلن على عروبته التي حكمت خياراته الشعرية والسياسية. كان عليه أن يواجه مفهوم الطائفة وأن يتحرر منه ويعترض عليه، وهو أمر بالغ الصعوبة والتعقيد، وأن يواصل ذلك ويذهب بعيداً في تلك المواجهة نحو هوية وطنية وقومية أوسع وأرحب من سياج الطائفة. هذا ما فعله سميح وحيداً وبدأب الوطني وعناد المقاتل وشجاعته، وهو أمر لم يكن مطلوباً من شعراء آخرين مثل زياد وجبران ودرويش.
كان عليه أن يتحرر أيضاً من تلك الثنائية المرهقة التي ربطته بدرويش، وهي ثنائية تم تسييجها ورعايتها سياسياً رغم الافتراق الفني واختلاف التجربتين الذي ظهر مبكراً. الرغبة العميقة بالانفصال دفعته في أحيان كثيرة نحو التمسك ببداياته في لحظات التوازي. كانت ثنائية قادمة من الستينيات ومن فترة محدودة ورافقته الى لحظة رحيله. أظن أنّ ذلك الربط بينهما كان عبئاً على الاثنين على نحو مختلف. محمود حاول التحليق بعيداً عن تلك البقعة، بينما سميح واصل الحفر في أرجائها. لكن الثنائية بقيت حية بعدما اكتسبت بُعد المقارنة، حتى بعدما لم يعد في مراحلهما اللاحقة ما يعزز أو يشي باقتراح التوأمة ذاك.
سميح لم يُقرأ جيداً، كان قراؤه قد أنجزوا قراءتهم له منذ وقت طويل وأنجزوا تنميطه، وكان هذا يؤلمه.
* شاعر فلسطيني
شعراء الأرض المحتلة»: أسطورة تنتهي برحيله/ مدحت صفوت
القاهرة | طرح رحيل سميح القاسم سؤالاً على الثقافة المصرية يخص مدى حضور شعره على الساحة الأدبية في مصر. مع انتشار نبأ الوفاة، أول من أمس، احتفت الصحف والمواقع بالشاعر الفلسطيني فجأة بعد تغييبه طوال العقد الأخير على أقل تقدير. المؤكد أنّ بقاء القاسم داخل الأرض المحتلة كان ذا تبعات، أشار هو إليها، مبدياً استعداده لدفع ثمن خياراته، وخيارات الدفاع عن أرضه ووجوده.
«الأخبار» طرحت تساؤلاتها على عدد من الشعراء والمثقفين المصريين المنتمين إلى حقب زمنية ومدارس فنية متباينة. بداية، أوضح الشاعر عبد المنعم رمضان أنّ حضور مَن سمّي «شعراء الأرض المحتلة» كان بارزاً أواخر الستينيات وبداية السبعينيات نتيجة لعقدة 67، وفي محاولة لاستعادة الروح العربية، إذ كتب رجاء النقاش وقتها كتاباً كاملاً عن درويش وسمى ابنه حينذاك سميح. وكشف صاحب ديوان «غريب على العائلة» أنّ ظاهرة شعراء الأرض المحتلة «انتهت بموت القاسم، كونها قرينة فترة تاريخية لم تعد شواغلها وهمومها مسيطرةً الآن»، معتبراً أن درويش خرج مبكراً من عباءة الأرض المحتلة ليكون شاعراً فلسطينياً إنسانياً، مشيداً بدور بيروت ومدارسها الفنية على صاحب ديوان «أثر الفراشة»، فيما بقي القاسم فلسطينياً فقط.
وتابع رمضان: «من أسباب غيابه عن الساحة المصرية، كتاباته التي تكاد تكون نتاج مرحلة فنية واحدة، ما دفعه نحو التجريب في الأشكال الفنية الأخرى ككتابة الرواية وكتابة ما سماه «السرديات» بحثاً عن شكل آخر». وعن علاقته بالقاسم، قال «لم تكن طيبة للأسف، سبق أن كتبت قصيدة عنه أصفه بالفقر والسطحية والسذاجة، كما أنّه خلال إحدى دورات «جائزة كفافيس» اليونانية، شن القاسم هجوماً على الشعراء المصريين؛ على رأسهم صلاح عبد الصبور، فكتبت رداً عليه بعنوان «هياج الدوبلير» منتقداً الثنائية في الثقافة العربية، واعتبرته دوبلير درويش». واستدرك صاحب «بعيداً عن الكائنات» «أحبه بقدر بقائه في الأرض، ولا أحب شعره بقدر ثباته عند نقطة غادرناها».
الشاعر محمود قرني يصف رحيل القاسم بالخسارة للشعر العربي والقضية الفلسطينية، فقد كان «نضال القاسم ودرويش من أهم الأسلحة المعززة للفضاء الإنساني والأخلاقي لقضية شعب مورست ضده أعلى أشكال العدوان». وأوضح صاحب «لعنات مشرقية» أنّ صوت القاسم ودرويش كان الأعلى من كل أسلحة المقاومة، ولعل حلول المقاومة ذات المرجعية الدينية لم يكن ليحدث لولا اهتزاز صورة الشاعر وتراجع قوته في الثقافة العربية. وعن سبب تراجع حضور القاسم، أجاب قرني «الشعرية الفلسطينية والعربية تواجه مأزقاً كبيراً بسبب ارتهان الشعر لشعار جذاب وأخلاقي هو شعار المقاومة. فالشعر يعتاشُ على أطر تقاوم فكرة التكيف والغرض وتقوض الذهنية المستقرة، فيما تضيف المقاومة للشعر صوتاً مجلجلاً، فأصبح لدينا نصوص كثيرة لكن خارج الشعر. وهو ما تتسم به تجربة القاسم الذي أدى مع درويش دوره المختار من قدر صعب وثورة عربية لم تكن بالت على نفسها». وذهب قرني إلى وجود جيل جديد في الشعرية الفلسطينية يدرك قيمة الأسلاف كما يدرك مأزقهم، ساعياً نحو تقديم نص مغاير يكون إضافة إلى القضية.
على صعيد آخر، رأى الشاعر الشاب عبد الرحمن مقلد أن القاسم واحد من أهم الشعراء العرب في العصر الحديث، مشيراً إلى أهمية رؤية الجانب النضالي ودور الالتزام الذي تبناه شعراء فلسطين، إذ استطاع الراحل مع بعض المبدعين مثل درويش وإميل حبيبي وغسان كنفاني وناجي العلي، أن يجعلوا القضية الفلسطينية قضية عالمية إنسانية، تكسب التعاطف الدولي. على المستوى العربي، تحولت قصائده الوطنية إلى أناشيد في التظاهرات، وخصوصاً نشيد الانتفاضة «منتصب القامة أمشي». وبالنسبة إلى تجربته الفنية، وصفها صاحب «مساكين يعملون في البحر» بالمتسعة والمتعددة، مضيفاً «من المهم أن تلقى الأضواء عليها، وعلى النقاد أن يعيدوا قراءتها». وطالب المؤسسة المصرية الرسمية بطباعة مختارات من أعماله، سواء النثرية أو الشعرية، ضمن مشروع «مكتبة الأسرة».
مواقف مثيرة للجدل
كان سميح القاسم من أوائل الشباب الدرزي الفلسطيني الذين تمرّدوا على قانون التجنيد الإلزامي الإسرائيلي، فأسس حركة «الشبان الأحرار» لمناهضة السياسات الإسرائيلية أواخر الخمسينات، إلى جانب عضويته في لجان: «المبادرة الدرزية»، و«حقوق الإنسان»، و«أنصار السجين» و«اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي العربية». وحين عمل مدرّساً في بعض المدارس الابتدائية العربية، أمر وزير المعارف الإسرائيلي بطرده على خلفية مواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي. هذه هي المواقف نفسها التي أدّت إلى سجنه مرّات عدة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية. ومن ناحية أخرى، فإن آراءه ومواقفه الثابتة المعادية للاحتلال الإسرائيلي، عكّرتها مشاركاته في «مهرجان القدس العالمي للشعر» الإسرائيلي في السنوات الماضية. وتزامناً مع الأزمة السورية، انتقل الانقسام بين السوريين إلى شخصية سميح القاسم، فاسترجع بعضهم مقابلتيه مع حافظ الأسد عام 1997، وبشار الأسد في 2000، كما لم تغب القصيدة التي أهداها إلى حافظ الأسد عن هذا النقاش.
هل وفته مصر حقّه من التقدير؟/ سيد محمود
القاهرة | بدا التعاطي مع خبر موت سميح القاسم لافتاً في مصر. تحول إلى مناسبة للرثاء والاعتذار، ولا أحد يعلم إن كان هذا الرثاء موجهاً للشخص أو للقيمة التي كان يمثلها. تداخل الشخصي والعام في تناول الخبر، وبعضهم ربط تراجع الاهتمام بشعر القاسم وسيرته بضعف الاهتمام الرسمي بالقضية الفلسطينية التي اختزل شعره في الدفاع عنها.
ومال آخرون إلى المقارنة بين النجومية التي رافقت محمود درويش حتى مماته، والحالة الباهتة التي عاشها القاسم في سنواته الأخيرة. قلة قليلة لاحظت أنّ القاسم لم ينتج شعراً في العقدين الأخيرين، وعاش مستنداً إلى ماض لم يخضع للفحص النقدي. الجيل الذي عرف سميح من أغنيات المقاومة التي غناها مارسيل خليفة وجوليا بطرس وفرقة «صابرين» في مرحلة تالية تغير، بينما لم يتغير شاعره. وحتى الأصوات الغنائية التي حملت شعره تطورت إلى آفاق متعددة، وباتت أميل إلى المغامرة والتجريب. لذلك خلقت لنفسها حياة جديدة مكنتها من العيش بسلام مع التجارب الغنائية الجديدة التي أفرزها واقع ما بعد الربيع العربي. ثمن لم يتمكن الشاعر من دفعه ومواكبة التحولات التي عاشتها قصيدة درويش الذي تخلّص مبكراً من الصخب، ولم يقبل العيش على فاتورة ماضيه أو الاستجابة لابتزاز الجمهور.
امتلك درويش ما لم يمتلكه سميح. كان على وعي بالنجومية ورسم صورة لعلاقته مع الجمهور وظلت قصيدته «أنيقة» على عكس قصيدة القاسم التي ظلت ملتصقة بالحجارة.
حصل على
«جائزة نجيب محفوظ» عام 2006
وبالعودة إلى الماضي، سنجد أنّ سميح القاسم ـــ دون بقية شعراء المقاومة ـــ هو الشاعر الذي لم تمنحه مصر ما يستحق في بداياته، مقارنة بما أعطته لمعين بسيسو ودرويش اللذين نالا منها أوطاناً بديلةً وقوة دفع رسمية وصكوك اعتراف لم تصل إلى القاسم إلا في وقت متأخر رافق خفوت قصيدته وتراجع الشعارات الداعمة لها. وحين حصل على تكريم اتحاد الكتاب و«جائزة نجيب محفوظ» (2006)، كانت الأشياء باهتة والأصوات مختلطة، ولم يحتفَ بها إلا من قبل الصحف القومية التي كان الشعار السياسي بيانها الوحيد للبقاء على قيد الحياة. في تلك الليلة، لم ينتبه أحد إلى مهارة سميح في التسامح مع الجميع إلا عدوه. لم يورط نفسه في مقارنة مع الشطر الثاني من البرتقالة كما كان يصف رفيقه محمود درويش، بينما كان صوت ضحكته أعلى كثيراً من نبرة الإيقاع في شعره. تلك النبرة التي قيدته ولم تعطه الأجنحة اللازمة للطيران في أفق جديد. لذلك كان من النادر أن تجد على صفحة شاعر شاب إشارة تخص سميح القاسم أو تسائل شعره. فهو لدى الغالبية نص ينتمي إلى الماضي ولا يعطل عربات المستقبل. نص أليف لأنّ صاحبه لم يكن مؤذياً ولم يتورط شأن أحمد عبد المعطي حجازي في حروب مع أحد، لأنه أراد أن يبقى سميحاً ومتسامحاً.
روحه عانقت بغداد… تحت شمس الله/ حسام السراي
بغداد | ارتبط اسم سميح القاسم لدى جمهور من القرّاء العراقيّين بقضية العرب الكبرى: فلسطين، حيث الجرح النازف الذي يمتدّ طوله من المشرق إلى المغرب، غائراً وعميقاً في ضمير كل إنسان عربي. وليس ببعيد اختيار اللجنة العليا للاحتفاء بـ«بغداد عاصمة الثقافة العربيّة 2013» صاحب «أغاني الدروب» لتكريمه في حفلها الختاميّ في آذار (مارس) 2014.
لكنّه بعدما عبّر عن سعادته الكبيرة، اعتذر حينها عن عدم الحضور بسبب «حالته الصحيّة». يومها قال: «بطبيعة الحال، أسعدني هذا الموقف كثيراً. وبغداد ليست مدينة أخرى أو عاصمة أخرى، فهي عمق حضاري، عربي وإسلامي متميز جدّاً. بغداد هي بغدادي الشخصية وحبّها متأصل داخلي رغم كل الظروف السياسية والتقلبات، فبغداد تبقى بغداد كما دمشق والقاهرة والقدس، عواصم في الروح والوجدان والحلم العربي الموحد، أتمنّى أن تستعيد نشاطها وموقعها الصحيح تحت شمس الله».
واختيار الراحل لمفردة «الشمس» في تصريحه عن بغداد، ربما هو استعادة لأيقونة شعرية خلّدها السياب في قصيدة «غريب على الخليج». رغم ما تبثّه على الأرض العراقيّة من حرارة وسموم، هي «أجمل من سواها»، حالها من حال الظلام الذي امتدحه رائد الحداثة الشعريّة (1926ــ 1964). والمعروف أنّ للقاسم مجموعة شعريّة باسم «بغداد» صدرت عن «منشورات إضاءات» (مطبعة الحكيم، الناصرة، 2008).
قصيدته «أصوات
من مدن بعيدة» مدرجة في المناهج الدراسية
وأمام كلّ قضية كيانية ندافع عنها، ضرائب لا مفر من إيفائها. القاسم شاعر «القضية الفلسطينيّة» و«العروبة»، وهذا الالتزام لا بدّ من أن يأخذ مأخذه من فنية الشعر وتحرّر الشاعر من قوالب تفرضها المواقف الكبرى، حين تبدأ سيرة الشاعر وتنتهي عند الموضوع نفسه، بما تحمله القصائد من حس ثوري يجعل مبدعها يفكر في الآلاف المغيبين وبالأطفال المضيّعين وبالأوطان المستباحة، فلا يمكن للبناء الفنيّ إلا أن يكون إطاراً لجميع هذه النكبات والانكسارات، حيث انكساراتنا نحن العرب جميعاً، ولا سبيل للغة إلا أن تنطق بأصوات المقهورين مثلما تقول قصيدته «أكثر من معركة»، فالعربيّ ــ الفلسطيني مجبر على خوض المعارك أو مجبول عليها، وخوفه مقيم من سكين الغدر! «في أكثر من معركةٍ دامية الأرجاءْ/ أشهر هذي الكلمات الحمراء/ أشهرها.. سيفاً من نارِ/ في صفِّ الإخوة.. في صفِّ الأعداء/ في أكثر من درب وعْرِ/ تمضي شامخةً.. أشعاري/ وأخافُ.. أخاف من الغدرِ/ من سكين يُغمد في ظهري..». لا مفر أمام الشاعر سوى الدعوة إلى القتال، أليس هو ابن لأرض مغتصبة، كما في قصيدته «أصوات من مدن بعيدة»: «يجيئون، قلت، على عربات قديمه/ تئن بأثقالها الخيل.. خيلُ الجريمه/ (يجيئون ليلا)/ فهاتوا الهراوات… هاتوا المشاعل/ من الغرب، قلت لكم، فافهموني/ وألقوا المسابح للنار/ ألقوا غبار القرون/ وقوموا نقاتل!..».
ولعلّ القصيدة المشار إليها هي نفسها الموجودة في مناهج الدراسة الاعدادية في العراق. ولا تتيح أجواء رثاء الرموز في الثقافة العربيّة أي مجال لإثارة أسئلة حساسة ومهمة عن سيرهم ومنجزهم، بطرح موضوعي وتقييم فني، منها عدم قدرة كثيرين منهم على الابتعاد عن الزعامات التقليدية والدكتاتوريات العربيّة.
أبعد من العوسج علّمنا ألا نساوم/ هناء محاميد
أقلّب بعض الصور، في الألبوم القديم وفي هاتفي النقّال، ها هو منتصب القامة يتلو علينا الشعر في أمسية لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، كنّا حينها طلاباً جامعيين نسير على إيقاع دروسه:
«يدك المرفوعة في وجه الظالم
راية جيل يمضي
وهو يهزّ الجيل القادم:
قاومتُ.. فقاوم!»
وها هو يقاوم أشرس الأمراض وأخبثها، ليحيا، في الصورة الثانية.
إلى أي مدى كنتِ واثقة بأن هذا الرجل الذي يمسك في قلبه وعقله المتوهجين أسرار البقاء، لن يفلت الحياة من سبحته، حتى اكتفيتِ في كل مرة التقيته بها بصورة تجمعكما على فنجان قهوة في مخيلتك فحسب!؟ أسأل اليوم نفسي أمام هذا الموت الأخرق، المتفاقم فينا، لمَ لا تملكين صورة ولو صورة واحدة مع الشاعر! هل أقول إن سميح القاسم هو شاعر؟ أو يجعل موت شاعر المرءَ يتيماً!
أذكر نفسي قبل أن يكتمل عقدي الأول أغنّي: قلبي قمر أحمر، قلبي بستان، فيه العوسج فيه الريحان.
ما هو العوسج؟ أكتسب كلمة جديدة في قاموسي الصغير، إذًا علّمني الشاعر كلمة، كلا إنّه معلم لما هو أبعد من الكلمة.
سميح القاسم وجيل آسر من شعراء المقاومة ولكن تحديداً هو وزيّاد ودرويش، علّمونا فلسفة لن يفهمها غير الفلسطيني، علّمونا أنّ الكفّ تنتصر على المخرز والجرح ينتصر على السكين، علّمونا أنّ ذات الكفّ تتسع لقصفة زيتون ليتسع الكتف في غمضة العين عينها لنعوشنا.
هؤلاء الشعراء كانوا بيننا، كانوا إخوة لبعضنا وآباء لبعضنا الآخر، رأيناهم في الجريدة وفي الاجتماع الشعبي وفي التظاهرة وفي السجن، وفي بيوتهم. هؤلاء هم أبناء بلدهم بكل ما يحمل التعبير من أفق، ولهذا أحببناهم.
ولهذا كفلسطينيين أحببنا سميح القاسم. ونشعر اليوم برحيل آخر قلاعنا الأدبية والفكرية الحصينة، بالخواء والفراغ والحسرة. ولا شيء يعوضنا عنه كما لم يعوضنا أي شيء عن فراق أحباء آخرين سوى فتات الذكرى المنثور في هواجسنا، ذكرى تحمل قبضته على مسرح يجول بالشعر ويصول بحكايات بلادنا وأشجارها وأثمارها وأسمائها، ذكرى تنصبّ علينا كزيت الرّامة الأخضر الحرّاق المعصور للتو كلما حظينا ـــ نحن القلائل هنا ـــ بالمرور أمام قريته في جليل فلسطين، ذكرى تتحايل على ذاكرة الأجيال اليافعة التي فتحت عيونها على شرور العالم ودموية العقيدة المظلمة وإله تُفتك العقول باسمه.
هل سنورِث تعاليمك أيّها الحيّ كما سنورِث ذكرياتنا الصغيرة بحضرتك؟! تقول إن اسمي كاسم أمّك، انتشي سروراً. تسألني أن أودّ التدخين، فآخذ سيجارة لا لأشعلها إنما لأحفظها وديعة بين أشيائي. وتخبرني لماذا ترفضُ أن تظهرَ على الشاشة خلف ضبابة الدخان. تعلّق خنجراً وصورة لوالدك بالأبيض والأسود على حائط منزلك، وصورة أخرى لك تعوم ببحر الناس في اليرموك. وثالثة لك ولمحمود درويش تحفظها في إطار صغير، ربما ليضمّ شبابكما الهادر. سمحتَ لي بتصوير الصورة وصورة أخرى تتقدّم مسيرة الى جانب إميل حبيبي وتوفيق طوبي وتوفيق زيّاد.. شكراً لك.
شكراً للحماسة التي غرَفْتَها من قلبك الوردة وزرعتَها فينا. أحاولُ تخيّلك الآن وأنت تقرأ حماستك على منبرٍ في السبعينيات:
«مهما طال الليل
نحن نُقصّر عمر الليل
فانهض فوق ركام الموت..
يا شعبي حيّ أنت!»
أتخيّلك الآن، حتى في مماتك تصدحُ، الآن الآن وطائرات أميركا وإسرائيل تقصف أعناق الأطفال في غزة، تصدحُ ملء الفضاء المتعب:
«يا عدوّ الشمس.. لكن.. لن أساوم
ولآخر نبض في عروقي.. سأقاوم».
رحل أنيقاً/ عبد الوهاب الملوح
آب شهر رحيل الشعراء، آخر الصيف وطلائع الخـريف يذهـب الشـعراء إلى حيث يكتبون قصائد للرياح الآتية من جهة النسيان، وهكذا رحل سميح القاسم شاعر المقاومة الذي وظََّف كل شـعره من أجل القضية الفلسطينية وكتب من أجلها أقوى البيانات والمقالات والتصريحات.
أيضا كان سميح القاسم مناضلا حقيقيا مؤمنا بالقضية الفلسطينية إيمانه بحقيقة وجوده كائنا يستحق الحياة، لذلك لم يترك أرض فلسطين، وظل يناضل في صلب الحزب الشيوعي، وقد كانت له نقاشات مطولة في هذا الصدد مع الراحل الكبير محمود درويش، الأخ الذي لم تلده أمي كما يحلو لسميح أن يناديه.
كانت هذه النقاشات حول النضـال من الداخـل أو الخـارج، وكـانت هذه الرسائل عبارة عن نصـوص أدبية بين الشاعـرين، بل أكاد أجزم أنها كانت أشعر وأبلغ من الكثـير من شعر سمـيح القـاسم الـذي لم تكن علاقته بالشعر جـمالية مهمـومة بالبحـث في تطـوير تقنيات الكتابة، بقدر ما كان الشعر وسيلة تعبيرية بالنسبة له وخادم قضية فقط.
لقد كانت هناك محاولات للراحل بحثا في ماهية الشعر وفي جماليته من مثل مجموعتيه ’’PERSONNA NONA GRATA’’ ومجموعة ’’كولاج’’ غير أنها تبقـى ضمـن مدونتـه التي بلغـت أكـثر مـن سبـعين مجمـوعة شـعرية مـحاولات لا ترقى إلى مستوى البحث الحقيقي في الشعرية وتقنياتها، فهـو عـكس فـدوى طـوقان وتوفـيق زيـاد ومحمـود درويـش وعـكس مريد البرغوثي الذين بقدر ما كان همهم القضية الفلسطينية بقدر ما حاولوا النظأي بالشظعر عن التوظيف الإيديولوجي الآني، وكانت علاقتهم بالشعر علاقة جمالية إبداعية.
جاءت مقارباتهم ذات بعد كوني مركزه الإنسـان الفلسـطيني والإنسـان عموما، بينما جاء شعر سميح القاسـم الذي خـلا من التجـريب ومن البحث اللغوي صدى لهمّ المناضل السياسي داخله، مناضل ملتزم حد العظم بقضية شعبه، وما الشعر بالنسبة له إلا وسيلة للتعبئة والتجييش وفضح أساليب المستعمر وكشف معاناة الشعب الفلسطيني.
لقد رحل الآن سميح القاسم في نفس الشهر الذي رحل فيه محمود درويش، في نفس الوقت الذي تعودت فيه إسرائيل صبّ قنابلها على الشعب الأعزل، في نفس الوقت الذي يتراجع فيه دور المثقفين العرب على حساب الانتهازيين السياسيين.
كان سميح فلسطينيا حقيقيا، قال حين رحل درويش ’’تخـليت عـن وزر حزني ووزر حياتي وحملتني وزر موتـك أنـت تركـت الحـصان وحيدا لماذا؟’’. رحلوا كلهـم الآن، رحلوا إلى حـيث لـن يكـتبوا ولن يغنوا ولن يرفعوا معنويات الحجر والشجر ولن يزرعوا الأمل في الطريق المعتمة. رحل سميح القاسم بعد كل هذا التعب غير أنه لم يسلم سلاحه ولم ينحن لأحد غير شعبه.
هكذا رحل أنيقا كما سبق وعبر عن ذلك قائلا: ’’وليأت الموت وأنا مستح مرتد ملابسَ جميلة ومرتبة، أنا أحب الأناقة حتى في الموت، أحبه أن يكون أنيقا ومرتبا وجميلا ونظيفا’’. رحل أنيقا من دون أن يتلوث بأي شيء ورحل كبيرا وهو يدافع عن شعبه.
(شاعر من تونس)
الأدباء في الأسر,,/بشار عباس
تأتي وفاة سميح القاسم ذات مغزى مفارق في معناها وتوقيتها للأسباب التالية؛ إذ عكس الشاعر في أدبه وسلوكه وحدةً وانسجاماً لديه بين التصوّر الوطني من جهة، وبين الفكر الذي حمله والشعر الذي أنتجه من جهة أُخرى، فكان صادقاَ، وكذلك بقي إلى يوم وفاته في 19 الجاري أوّل من أمس. أهميّة هذا الرحيل الآن أنّه من الممكن أن يُعيد طرح اسم الشاعر كأديب وطني في خضمّ من أحداث تحاول، وكثيراً ما تنجح في استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير: الطائفيّة بالوطنيّة، فينكمش الانتماء للجماعة الوطنية يوماً بعد يوم لمصلحة تمدد انتماءات بديلة لجماعات من نوع آخر، كجماعة الطائفة أو العرق أو العشيرة.
أمّا السبب الثاني، فهو: موقع الشاعر في قائمة أدباء القضيّة الفلسطينية، وفرادة هذه الظاهرة بمعانيها الأدبيّة والمجتمعية والسياسيّة؛ فالقضيّة لها وجود آخر موازٍ للواقع في عالم الأدب، يجعل ذلك النتاج الأدبي كشفاً جديداً في مجال تاريخ الأدبين العربي والعالمي، بوصفه مدرسة أدبيّة ترتكز مضامينها على تجربة النكبة وما تبعها عام 1948 الخروج الفلسطيني كما تصفه القواميس السياسية الغربية وموسوعة ويكيبيديا – الاغتيال الذي تعرّض له بعض هؤلاء الأدباء كان مقياساً حقيقياً لمكانة هذا الأدب وقوّة تأثيره وخطورته، فمنح هذا الاعتراف الدموي بأدب المقاومة ما لا يمكن للجوائز والمهرجانات على اختلافها أن تمنحه، واليوم مع رحيل الشاعر وعجز ذلك الأدب عن تزويد قضيّته بأسماء لها هذه القيمة، ليس في الشعر فقط بل في الرواية والأدب عموماً كما حدث من فراغ بعد رحيل غسان كنفاني؛ إذْ خسرت الرواية في الأدب الفلسطيني رائدها ونجمها فلم تتمكّن بعده من استعاضة اسم بمستواه، الأمر نفسه وقع في ما بعد كما يقع اليوم مع شعراء تركوا فراغاً ليس يندمل من بعدهم.
إنّ تفرّد هذا الأدب باعتنائه بظاهرة وطنيّة سياسية أدخل الشعرية العربيّة للمرّة الأولى في المضامين السياسيّة الوطنية على مستوى جماعي بما يُشكّل مذهباً أدبيّاً، وما خلا بعض الإضافات التحديثية في الأدب المهجري والناجمة عن تجربة الاغتراب، ثم تجديد السيّاب على مستوى الأسطورة وجمالية القبح ذات التأثيرات الغربية، بل حتّى مع تجديد أبي النواس الذي كان له أصول واضحة في الأدب الجاهلي، فإنّ التجديد الذي قام به أدب القضيّة الفلسطينيّة يحظى بأهمية مفارقة، وهو أدب من خلال وفرة نتاجه وعديد أسمائه ساهم بإيجاد قضيّتين فلسطينيتين تختلفان عن بعضهما البعض: فلسطين ما قبل أوسلو أي فلسطين النكبة والنضال والعودة وحصار بيروت، وفلسطين ما بعدها أي السلطة الوطنية والمعابر الآمنة.
إنّ خطورة هذا التحوّل في الواقع السياسي، والذي هو العنصر الفصل في تحديد هويّة هذا الأدب وملامحه، دفع الأخير إلى الانقطاع تماماً عن أصله ومراوحته بين أنموذجين؛ إمّا المواظبة على الاستقاء من الوضع الفلسطيني الذي بات الآن وضعاً «أدبيّاً» قديماً موجوداً فحسب على الورق، وإمّا إخضاع قصيدة أدب المقاومة الفلسطينيّة لعمليّة تستأصل مفرداتها وأدواتها وموضوعاتها التي إنّما تُشكّل هويتها، فتضع مكانها أدباً جديداً. هذه الإشكاليّة جعلت أحد روّاد هذا النموذج كمحمود درويش يهجر أدوات الأمس القريب ومضامينه، فيُسارع إلى الأجواء الإنسانية، الرومانسية التي تتعاطى الفلسفة أحياناً، ولكن مع الحفاظ على قرّاء الأمس بين ظهراني قرّاء اليوم الجدد، فظهر شعر جديد لمحمود درويش آخر، لا يجمعه بالشاعر القديم سوى الامتداد البيولوجي والاسم.
الشاعر سميح القاسم لم يُحسن القيام بتحوّل كهذا، ولم يتقبّل الوضع الجديد مضموناً لأدبه، ما يعني أنّه يتّفق في ثباته الشعري مع موقفه الوطني، وإن كان موقفاً كالسابق يجعله من الخاسرين أدبيّاً إذْ يعني وسماً لأدبه بـ«المرحليّة»، غير أنّ ذلك لم يزحزحه عن مسلكه الأدبي الذي رأى فيه أن يخسر أدبيّاً ويربح وطنياً.
الأنموذجان يُشيران إلى أنّ الأدب الذي ارتبط باسم المقاومة الفلسطينية، لم يعد على ما يُرام الآن، فنموذج درويش صاحب التحوّلات الكبرى، ونموذج سميح القاسم المُناقض له، يعنيان أن ذلك الأدب إمّا تحوّل فلم يعد كما كان، وإمّا توقّف في زمن سابق لا يُواكب المستجدّات، هذا قد يقود إلى إحياء مسألة لمّا تزل ماثلة وهي: كم كان من الخطورة أن تسود تلك المقولة الشهيرة في خمسينيات وستينيات القرن الفائت في أن الأدب انعكاس للواقع فحسب، لا يتدخّل فيه ولا يؤثّر عليه، وهي مقولة يقود الإيمان فيها إلى الاعتقاد أن الأدب لا كلمة له على الوضع سوى نقله وشرحه، فهل كان أدب المقاومة الفلسطينيّة كذلك؟
يُمكن أن نصف ذلك الأدب كمواجهة ثقافية حقيقية مُناهضة للبروباغاندا العالمية المضادة للحق الفلسطيني، الأدب العربي سيخوض حرباً لم يألفها من قبل، التصوّر التقليدي كان أن الشاعر والأديب عموماً ينهض واحدهما لشاعر أو أديب آخر، وليس لآلة جديدة عجيبة اسمها الإعلام. رحّالة الأدب يتعرضون للترانسفير الجماعي الآن ويضيع ملكهم معاً، وليس فرادى كسلفهم امرئ القيس الذي ضاع ملكه بمفرده، وأسراهم ليسوا أسيراً واحداً يُناجي حمامة حطّت على نافذة السجن، لقد ضاع ملكهم جميعهم معاً، وتعرّضوا للأسر معاً، في تجربة جماعية مفارقة نجحت في أن تمنح قضيّتهم الشرعيّة الأدبيّة الثقافيّة في مواجهة الشرعية التي تبتكرها الدعاية، فالاعتراف الذي تمنحه قصيدة جميلة أو رواية جيدة بقضيّة، لا يُضاهيه الحق المستند الى فنون الدعاية نظراً للفروق الجمالية والفنية والقيمية بين نوعي الاعتراف، وهذا يقود إلى نقطة البدء في مخالفة الرأي المتعلّق بوصف الأدب كانعكاس للواقع، لقد كان أدب المقاومة الفلسطينية فاعلاً في الواقع، لا يكتفي بالصدور عنه، بل كثيراً ما يقوده، فتكوّن كلماته مادّة لاصقة تجمع الجمهور الذي يقصده ذلك الأدب في شتّى أنحاء الشتات، فيقوم بوظيفة الكتب المقدّسة التي تربط معتنقيها بعضهم ببعض.
كل رحيل جديد لعلم من أعلام ذلك الأدب دون تعويض عنه من قبل المجتمع الأدبي الفلسطيني، يعني مزيداً من الخسارة للقضيّة التي أنشأتهم ونشأوا عليها، وعريا تامّا في مواجهة تبدو أنّها محسومة لمصلحة الطرف المضاد الآخر من الصراع ، الذي وإن كان الأقوى في الدعاية، غير أنّه لم يستطع ابتكار أدب أصيل كما فعل الفلسطيني، ببساطة لأنه سيكون أدب احتلال، والاحتلال لا أدب له، كما أن العمل الفنّي من شروط تعريفه أن يكون ذا مضمون معرفي إنساني، والاحتلال ليس من ذلك في شيء فلا يعود أمامه غير الدعاية، ولذلك يعني جمود الأدب الفلسطيني اليوم انتحاراً لقضيته، لأنّه مع انقطاع المصدر الأدبي للحق الفلسطيني،، لن يعود من الممكن ضمان ألا ينقطع وجود هذا الحق نفسه، فالقضيّة الفلسطينية لم تنشأ بفعل أحزاب، أو تيّارات سياسية فكرية، أو حتّى من أيديولوجيا ما؛ لقد نشأت على أوراق الأدباء الفلسطينيين، ومن حبر أقلامهم.
السبب الثالث الذي يمنح رحيل القاسم معنى مميزاً لا يتعلّق به كحالة أدبية فردية، بل بسلوك درجنا عليه في السنوات الأخيرة فبات عرفاً أو يكاد، ألا وهو الاحتفاء بالأدباء والشعراء سواء كانوا عرباً عموماً، أو فلسطينيين على وجه الخصوص، عندما يُغيّب الموت أحدهم، بينما يجب الاحتفاء بالشعراء وغيرهم من أبناء الكلمة، في حياتهم، كما في مماتهم.
(كاتب سوري)
السهل الممتنع/ محمود شقير
سأبدأ من لحظة فارقة. قبل يومين هاتفت سميح القاسم ولم يرد. كان هاتفه على غير العادة مغلقًا. هاتفت ابن عمه الدكتور نبيه القاسم، وسألته عن سميح. قال لي إنه الآن في المستشفى وحالته مستقرّة، لكنه لا يستطيع الردّ على الهاتف. مساء أمس، هاتفني نبيه وقال لي إن سميح القاسم في النزع الأخير. ورحنا نتحدّث عن ترتيبات الجنازة، وكان ذلك أمرًا بالغ القسوة. وقبل منتصف الليل بساعة أو أكثر قليلاً هاتفني نبيه وقال: لك طول العمر. وهكذا، غادرنا سميح في الشهر نفسه الذي غادرنا فيه رفيق عمره وصديقه محمود درويش، وهما معًا، مع كوكبة أخرى من شعراء فلسطين 48 وأدبائها كانوا وسيظلون علامة كبرى في مسار الحركة الثقافية المعاصرة للشعب الفلسطيني. فقد أثروا وما زالوا يثرون أدبنا برؤى فكرية وبمضامين وطنية واجتماعية وإنسانية، وبعناصر فنية مبتكرة أسهمت وتسهم في توسيع انتشار هذا الأدب، وفي خلق علاقات تفاعل أكيدة بينه وبين الأدب العربي الحديث، وآداب الشعوب الأخرى في هذا العالم. وحين نخصّص الكلام على سميح القاسم، فقد كان بحق واحدًا من أهم صانعي الهوية الوطنية الفلسطينية المعاصرة، بما أضفاه شعره ونثره على هذه الهوية من قيم نضالية ومفاهيم إنسانية تتأبى على ضيق الأفق والتقوقع والانعزال، وتتأبى كذلك على الاستخذاء والتراجع أمام سطوة العدو وممارساته ومحاولاته فرض الأسرلة على الجزء الباقي من شعبنا فوق أرض وطنه. كان سميح القاسم مجدّدًا في الكتابة وميالاً إلى التجريب والاجتهاد كي لا تبقى قصيدته حبيسة القوالب المألوفة، وكان ميالاً إلى الوضوح في مضامينه، مستلهمًا من أجل إغنائها أفضل ما في تراثنا وفي التراث الإنساني من قيم ومفاهيم، وكان يتقصّد البساطة والبعد عن التعقيد والغموض في أسلوبه، مستعينًا من أجل ذلك بلغة السهل الممتنع، وبالإيقاع المستمد من إيقاعات الشعر العربي على امتداد العصور، وكذلك بقدرته الأكيدة على تطعيم نصوصه الشعرية بالسخرية وبالتهكّم وتقزيم شأن الأعداء والحكّام المستبدين، وبميله الأصيل إلى إشاعة روح الأمل والتفاؤل في قصيدته، رغم ما يكتنفها من هموم ومن مآس ومن مجازر ومذابح تعرض لها وما زال يتعرض لها الشعب الفلسطيني على امتداد عشرات الأعوام والسنين. للشاعر الكبير سميح القاسم المجد والخلود.
(كاتب فلسطيني- القدس)
سهوب فسيحة لجناحي الشاعر/ نذير جعفر
«ورقاً سَيِّدي؛ أشتهي ورقاً للكتابة؛ كي أعيد الكتابة؛ إنَّ موتي دُعَابة».
لا، لم يكن خياراً عادلا: الهوية «الإسرائيلية» القسرية أو التهجير! بين هذين الحدّين وجد سميح القاسم نفسه يتأرجح وأبناء جيله على حبال النار ووقع الهزيمة المرّة التي منيت بها الجيوش العربية في (1948) و(1967)، ولم يتردد في حسم قراره بالبقاء والتشبّث بالجذور التي تمدّه بنسغ الحياة والإبداع، رافضا اقتفاء أثر صديق عمره محمود درويش الذي آثر الرحيل، وكان رحيله صدمة مؤلمة هزّت أعماقه بقوة وخلّفت فراغاً كبيراً بغيابه، لأن ما يربط بينهما كان أقوى من الشعر والحب والنسيان!
بين شروط الحياة القاسية التي فرضها الاحتلال والتوق إلى الحريّة بدأت المواجهة شعراً ونضالاً سياسياً وسجناً والتحاماً بالمقاومة وانتفاضات جماهيرها المتتالية، وتضامناً مع قوى التحرّر الوطني في العالم؛ ما جعل منه رمزاً وطنيّا وقومياً وإنسانياً، وجعل من قصائده أقانيم صمود تتردد على الشفاه في المدارس والساحات وميادين القتال، وتُغنّى في كل مكان.
وبقدر ما يغري تحول الشاعر إلى رمز فإنه يقصي خصوصيته الإنسانية وعالمه الداخلي وتفاصيل حياته اليومية الثريّة. ومن هنا تم تنميط سميح القاسم وفق ترسيمة أحادية، تختزل وجوده الإنساني، وصراعاته، وتناقضاته، وقوته، وضعفه، ونزواته، ومواقفه المتباينة إلى مجرد ألقاب عدة، بدءاً من شاعر المقاومة، وشاعر العروبة، وشاعر الحداثة، وشاعر الأرض المحتلة، وشاعر الانتفاضة، وصولا إلى قيثارة فلسطين، ومتنبي فلسطين، والشاعر القديس، وسيّد الأبجدية!
تلك الألقاب حجبت صورة الشاعر الحقيقية بوصفه إنساناً يحب ويكره ويتردد ويخطئ، وبوصفه شاعراً له ما له في التقاط جوهر قضية شعبه والالتصاق بها والتعبير عنها، وعليه ما عليه من تفاوت مستوى قصائده النائسة بين الخطابية المباشرة التي تُرضي المزاج العام وحشود التلقي الإيديولوجي، وتتكئ في نجاحها عليهما من جهة، وغير المباشرة التي تتألق في التجريب الفنّي على مستوى الصورة المبتكرة، والفكرة العميقة، والبعد الأسطوري والتراثي، والإيقاع الموسيقي المتنوع، والغنائية الساحرة من جهة ثانية، والتي لم تنل حقها من الانتشار والدراسة!
اجتمعت في تجربة القاسم أجيال من الشعر العربي عبر عصوره المتعدّدة، فترى فيه محاكاة لعمود الشعر في تجاربه الأولى، وخروجاً عنه في قصائد التفعيلة، وتجاوزاً له في التجارب اللاحقة التي تمزج بين الغنائية والنثر كما في «كولاج»، أو التي توظف المنجز البلاغي التراثي في سياق جديد كما في «كتاب الإدراك».
لكنه في كل ذلك، وطوال رحلته الشعرية، لم يتخلَ فنيّاً عن جماليات الغنائية، والإيقاع الموسيقي، وتوظيف تقنيات التكرار، والطباق، والمقابلة، ممّا سهّل وصول نصوصه إلى شرائح اجتماعية واسعة، وساعد على حفظها وتلحينها وأدائها، وهو ما لم يحظ به سوى عدد قليل من الشعراء العرب المعاصرين، في طليعتهم محمود درويش ونزار قبّاني.
كما لم يتخلَ على مستوى المضامين والموضوعات والأفكار عن القضية المركزية والمحورية في شعره المتمثلة في المواجهة بين أصحاب الأرض والحق في فلسطين والعدو الصهيوني الغاصب. وعبر موشور هذه القضية تتحدّد رؤية الشاعر ومواقفه السياسية عبر آرائه وقصائده التي تبدو مفارقة إلى حدٍّ ما لانتمائه التنظيمي والإيديولوجي للحزب الشيوعي «الإسرائيلي» والأحزاب الشيوعية العربية، قبل أن يغادر موقعه التنظيمي فيها. فتبدو دعوته للوحدة العربية وإيمانه بها قدسا من الأقداس، شأنها شأن عروبته وحرصه على استرجاع كل شبر مغتصب حيثما كان. ولعل هذا ما يفسّر تأييده وانحيازه وتمجيده لجمال عبد الناصر بوصفه قائدا قوميا عروبياً، وثناءه لأحمد بن بلة، وتثمينه لقدرات الجيش العربي السوري في لجم «إسرائيل» وتحطيم أسطورة جيشها الذي لا يقهر! وتعزّزت هذه القناعة لديه على أثر الزيارتين اللتين قام بهما إلى سوريا في العام (1997) و(2003) حيث قابل في أولاهما الرئيس بشار الأسد، وحظي فيهما باستقبال شعبي ورسمي حاشد. ومن هنا يبدو تصريحه لعلاء حليحل في الحوار الذي أجراه معه (2012) ونشر في (قديتا نت) غير مفهوم، فهو يقر بمقاومة وممانعة وعلمانية النظام السوري ويتمنى (قلبيا) بقاءه شرط تحقيق الديموقراطية، ويشكك في هذه الممانعة على أثر تدخل الجيش في الأحداث الجارية داعيا إلى التغيير!
كما تبرز نزعة القاسم الأممية والشيوعية في قصائده جنبا إلى جنب مع النزعة القومية، وهو ما نلاحظه في استنكاره لإعدام عبد الخالق محجوب في السودان، وتضامنه مع «هوشي منه» في فيتنام، ومختلف حركات التحرّر الوطني في أفريقيا.
ولا يخفي الشاعر في كثير من آرائه المبثوثة في زواياه الصحافية ومقالاته خطر الطائفية المستفحل في ظل تراجع المدّ القومي العربي وحركات اليسار، داعياً في إحدى تلك المقالات إلى تصنيع كمامات خاصة لمواجهة سمومها القاتلة.
من الصعب تتبع ودراسة نتاج شاعر مثل سميح القاسم في هذا المقام له ما يربو على (65) كتاباً ما بين ديوان شعري ورواية ومسرحية ومقالة، وإن تمّ التلميح إلى أبرز الثيمات الفنيّة والموضوعاتية في شعره، فإنه يجدر بقارئ هذه التجربة أن يشير إلى مغامرته الروائية المتمثلة في ثلاث روايات أو حكايات كما ارتأى أن يجنّسها بنفسه، وهي: «الصورة الأخيرة في الألبوم»، و«إلى الجحيم أيها الليلك»، و«ملعقة سم صغيرة ثلاث مرات يوميا». وربما كانت رواية «الصورة الأخيرة في الألبوم» أبرز تمثيل للثيمة الموضوعاتية الرئيسة التي تنضوي تحتها هذه الروايات الثلاث ومفادها أن التعايش ممكن مع اليهود ومستحيل مع الكيان الصهيوني الذي تمثّله «إسرائيل». وهذا يستدعي التفريق بين اليهودية كديانة والصهيونية كعقيدة.
فالشاب الفلسطيني «أمير» حامل الماجستير في السياسة يعيش عاطلا من العمل وعالة على أمه التي تتكفل بمصاريفه ومصاريف أخيه «علي» طالب الثانوية العامة، لذلك يقبل بفرصة عمل في مطعم عن طريق رفيقه «إبراهيم» متحمّلا ظلم وكراهية الآخر المحتل، وتشاء المصادفة أن يلتقي بـ«روتي» ابنة الضابط الإسرائيلي فتنشأ بينهما علاقة، ويكتشف من خلالها أن والدها يحتفظ بألبوم يضع فيه صور الفدائيين الذين يتم اعتقالهم وتصفيتهم على يده، وتخشى أن يكتشف أبوها علاقتها بـ«أمير»، فتكون صورتها أيضا بين تلك الصور التي يحتفظ بها في ألبومه السرّي الخاص!
وبقدر ما تتعاطف «روتي» مع «أمير» وأسرته على أثر زيارتها الودية لقريته وتعرفها إلى أمه وأصدقائه، فإنها تظل موضع اتهام، ليس بسبب تصرفاتها أو مواقفها أو ديانتها بل بسبب الظلم الذي تمارسه حكومتها على الفلسطينيين، وآخر صور هذا الظلم حرمان «علي» شقيق «أمير» من متابعة دراسته في كلية الطب مع أنه الأول على دفعته، ما يضطره للهروب إلى سوريا لكن حرس الحدود «الإسرائيلي» يقتله قبل اجتيازها، فيكون إحدى صور ذلك الألبوم كما يستدل من السياق، وباستشهاده يموت كل أمل بالتعايش.
يتم تخطيب/تسريد هذه الحكاية فنيا عبر تناوب ضمائر السرد: الغائب، والمخاطب، والانتقال المفاجئ بينهما: «فتح أمير عينيه على وسعهما دفعة واحدة، للحظات كان مندهشا من حدة انتقاله المفاجئ من النوم إلى اليقظة، ولكن لمَ الدهشة؟ فقد تعوّدت يا أمير على الاستيقاظ المفاجئ». وهي تقنية حداثية سبق أن وظفها غسان كنفاني بشكل أعمق وأوسع في رواياته، وتكاد تقتصر عند القاسم على الفصل الأول.
ولعل أبرز الهنات الفنية في هذه الرواية تتمثّل أولاً في ارتباك الحوار ومفارقته لمنطوق الشخصية ومستواها الاجتماعي، كما في حوار الأم وابنها الذي يدور بالفصحى: «هل تريد قهوتك؟ سأعدها حالاً. هل أنت مسافر اليوم أيضاً؟». مع أن الراوي يلجأ في غير موضع إلى العامية! وهو ما يؤكد على هذا الارتباك الفنّي. وثانياً في تطابق لغة الراوي مع لغة شخصياته غالباً دون مسافة فاصلة بينهما على الرغم من تباين هذه الشخصيات اجتماعياً وثقافياً!
ولعل هذه الهنات الفنيّة سمة عامة في كثير من النتاج الروائي العربي، وهي لا تقلّل من جماليات السرد ومتعة التشويق عبر تصوير عالمين مختلفين عقيدة ولغة تجمعهما الرغبة بالعيش المشترك الذي يحول دونه النظام العنصري الصهيوني.
كان لا بدّ من الاختزال، مع أن الراحل سميح القاسم قامة إنسانية وشعرية عالية عصيّة على الاختزال، والألقاب، سواء أكان في حياته الخصبة المتشعبة أم في علاقاته الواسعة مع مبدعين، وسياسيين، وزعماء دول، وثوار، أم في أسفاره إلى معظم أنحاء المعمورة وخروجه بتجارب نوعية ثرّة… فلنسمح له بالخروج من الصورة، ولنمنحه السهوب الشاسعة التي حرمها الغياب منها ليحلق بجناحي الشاعر في أمداء الكون اللامتناهية، ونستمتع باكتشافه من جديد دون رتوش.
(ناقد سوري)
مستدرجاً الموت../تمام علي بركات
التاسع من آب الجاري مرت الذكرى السنوية السادسة لرحيل «محمود درويش»، مرت كما جرت العادة، أماس شعرية تتلى فيها قصائده، مقالات تستحضر غيابه، برامج تلفزيونية تحييه لدقائق في صوته، لتعود وتدفنه في أصوات الآخرين وهكذا، مرت دون أن تنذر بأن رحيلاً باهظا آخر سيحمله قادم الأيام القريبة، رحيلاً سيعيد لتلك الذكرى ألق بطلها. كيف لا والراحل هذه المرة، أحد شطري البرتقالة «سميح القاسم « الرجل الذي أطل منذ مدة قريبة على قناة «الميادين» ليقول بأن جسده يذوي ولم يبقَ منه سوى القلب، وهذا ما قالته الصورة أيضاً، فصاحب (أغاني الدروب – 1964)، ظهر نحيل الجسد أصفر المحيا متقارب تجاعيد الوجه، وحده صوته بقي محتفظا بسماته القديمة، قويا وجريئا وواثقا.
19 آب 2104، أنهى «القاسم» نزاله مع مرض السرطان، كما أنهى أيضا نزاله مع الخذلان والخيبة، مغلقاً الضلع الثالث لمثلث شعراء المقاومة الفلسطينية، الذي جمعه بكل من الراحل الشاعر توفيق زياد – أشد على أياديكم، وصاحب «ورد أقل» في – «سجل أنا عربي» ومنتصب القامة أمشي، ثلاث قصائد طافت شهرتها بين الناس لثلاث شعراء فلسطينيين، كتبوا أشعارهم المقاتلة ضد الاحتلال الصهيوني، من داخل فلسطين، ونقلوا ببراعة مزاج الشارع الفلسطيني المقاوم ومزاج الجماهير العربية الغاضبة من تخاذل حكامها بحق قضيتهم الحقيقية فلسطين.
ستصبح قصيدة «منتصب القامة أمشي» التي لحنها وغناها الفنان «مارسيل خليفة» القصيدة الأكثر التصاقاً بوجدان الجمهور العربي المقاوم، الأكثر تعبيراً عن رغبة الفرد الفلسطيني والعربي بما يريد أن يكونه: إنسانا يحمل كرامته ودمه معا، وستصبح جرساً معلقاً يرن في الذاكرة، كلما استجد خطب يعتري الأرض المحتلة أو إحدى الدول العربية، جرسا يستنهض الهمم ويذكر بمفردات الحياة الكريمة التي تعني عند كل عربي مقاوم: إما حياة وكرامة أو مماتٌ يغيظ العدا.
تسع سنوات فصلت بين ولادة صاحب «مواكب الشمس» 11-أيار-1939 والنكبة الفلسطينية 1948، ليكبر الفتى وفي دمه تجري خيالات لمذابح سفكت فيها نظرات الفلسطينيين على عتبات بيوتهم وبياراتهم، ولخيوط فجر طويلة ومتقطعة تتكشف كل صباح عن نزوحات جماعية هرباً من الموت، تركت في وجدان القاسم طعنة لا تميت ولا تحيي، صور لأطفال شاردين خارج دروب النزوح، نساء متشحات بحزن قاصم للظهر، حملنه وبقج الفقر المعدة على عجل، رجال بقامات مائلة، أولموا للموت فتياناً كالزنابق، هم الغائبون الوحيدون عن مشهد الألم والخزي هذا.
تلك المقاطع القاسية والصور المؤلمة التي استقرت في جوانيات صاحب «كولاج»، مسته فداحتها وأهوالها على رقته، وأحالت سنين المراهقة لديه إلى عبء ثقيل الشغف، بين قريحةٍ لاذت بالشعر لتكافح الاحتلال، وعملٍ ميداني يتطلع إلى تحقيقه مع المقاتلين والثوار الفلسطينيين، فكان أن انتسب للحزب الشيوعي عندما صار الاتحاد السوفياتي بعد انتصار البلشفية، واحداً من أقوى بلدان العالم التي ترفع شعارات من قبيل الحرية والمساواة والعدل، ما جعل القاسم نصيراً لقضايا الشعوب المظلومة، إلا أن مزاولة صاحب «جهات الروح» العمل السياسي الحزبي، جعله يدرك فورا كم تبتعد أيديولوجيات الأحزاب المعقدة على لمعان شعاراتها، عن أيديولوجيته البسيطة: «عدو وأرض محتلة مقاومة وكفاح بجميع الوسائل حتى دحر العدو وتحرير الارض» أدار ظهره ميمماً وجهه نحو الشعر الذي احتوى غضبه وخوفه، حزنه وفرحه، أمله ويأسه، وهدأ من روعه، ليدله إلى طريقه: بالشعر أقاوم.
غزير هو النتاج الشعري والأدبي للراحل «القاسم»، إلا أن قصيدة «منتصب القامة» صارت هي العلامة الفارقة في نتاجه الأدبي كله، بعدما صارت من القصائد الأمثولة، كلمات صارت من مفردات الكرامة العربية بعدما جرت على لسان كل الأجيال العربية التي مجدت المقاومة ضد المحتل أيا يكن، ليغنيها ابن الجنوب اللبناني كما غناها ابن القدس، وليرددها ابن الجولان كما يرددها ابن لواء اسكندرون، كلمات صار صاحبها جزءا وجدانيا من وعي المقاومة وثقافتها.
مشى «سميح القاسم» كما أرادت قصائده: قامة منتصبة وهامة مرفوعة، بعدما اتكأ بمرفقيه: شعره وما بقي من حرائق القلب على وهن اللحظات الأخيرة، مشى من مرض جسده هذه المرة، خلعه عن كتفيه كعباءة رثة وقام منه إلى الموت، نهض من أثقال قلب الشاعر المهزوم، لا من مرض أو خلل في تجربته الأدبية عموما والشعرية خاصة، بل لان ما ناضل حبره لأجله طيلة عمره إن كان في سبيل القضية الفلسطينية خاصة وبالقضايا العربية والقومية والعالمية عموما، مات دونه، همدت مخالبه عن حروفها وجف حبره في عروقه وترملت قصائده، ولم يكتب له أن يرى فلسطينه معافاة من جراحاتها النازفة، لم يشم رائحة الهمم التي استنهضتها أشعاره لتحرير وطنه، تدنو من أسوار القدس، بل شاهد بأم عينه الذابلة، كيف بدا البعض من الذين ظنهم أهلا وأشقاء، بحفر الأنفاق تحت تاريخ فلسطين برمته، تحت اسمها وحجارتها وناسها وحتى أغانيها.
مات صاحب «دمي على كفي» وغزة تشطف دم أبنائها وأطفالها عن الإسفلت بعد العدوان الصهيوني الأخير عليها، لتكتب على الجدران وعلى القلوب، على الهواء والماء، على البندقية والرجاء: «تقدموا.. كل سماء فوقكم جهنم.. وكل أرض تحتكم جهنم؛ تقدموا.. يموت منا الطفل والشيخ؛ ولا يستسلم؛ وتسقط الأم على أبنائها القتلى؛ ولا تستسلم؛ لن تكسروا أعماقنا؛ لن تهزموا أشواقنا؛ نحن القضاء المبرم؛ تقدموا تقدموا».
نعم لم يمهله الزمن حتى يرى بيارات يافا وبحر حيفا وشوارع القدس العتيقة وكل المدن الفلسطينية، تعفي أجراس العودة من أشغالها الشاقة، وتمنح أصوات العائدين وضحكاتهم تلك الأجراس الهرمة إجازة تقاعد دائمة بسبب انتهاء مهمتها بعد تحرير فلسطين، لكنه شاهد كيف أينعت الكرامة والرجولة في غزة، اطمأن قلبه إلى أن إرثه بالنضال والكفاح ومقاومة المحتل ومقارعة الخطوب الجسام، في أيد أمينة.
«أنا لا أُحبُّكَ يا موتُ.. لكنّني لا أخافُكْ؛ وأدركُ أنَّ سريرَكَ جسمي.. وروحي لحافُكْ؛ وأدركُ أنّي تضيقُ عليَّ ضفافُكْ؛ أنا.. لا أُحبُّكَ يا موتُ.. لكنني لا أخافُكْ»!»
بهذه الكلمات الحاسمة خاطب صاحب «رماد الوردة» الموت، مستدرجا إياه إلى كهولته التي صارت عبئا على قلبه، ناصباً له فخاخا من التحدي والاستسلام بآن، وماذا يريد الموت أن يرى من شاعر إلا ذلك: تحدياً للطفه واستسلاماً لرحمته.
سميح القاسم نهض إلى الموت كما ينهض الرجال ليصافحوا الرجال.
(كاتب سوري)
زيتونة كبيرة/ محمد الأشعري
لم أعد أذكر من وصل إليّ قبل الآخر: محمود درويش أم سميح القاسم، لكني كنت دائما أتلقاهما كشاعرين يحيل أحدهما على الآخر عبر لعبة مرآوية. فالحقيقة أنني عندما أقرأ اللهجة العالية لسميح القاسم تطالعني في الآن ذاته اللهجة المتوارية لمحمود درويش. عندما أقرأ قصيدة سميح القاسم الضاجة بصوت القضية وتفاعلاتها ويومياتها أقرأ قصيدة محمود درويش المسكونة هي الأخرى بالقضية، لكن المسكونة أيضا بقلاقل المختلف: اللغة والخيال والتراجيديا الإنسانية المترتبة عن الاقتلاع والفقدان.
وقد كنت في بداية شبابي أجنح إلى المقارنة بين التجربتين الشعريتين لكل من درويش والقاسم، وأميل إلى الاعتقاد بأنهما معا ضروريتان للقضية، وضروريتان أيضا للشعر. ثم تصورت أنهما يقفان على طرفي نقيض، ولكن في نوع من المواجهة غير المعلنة، إلى أن بدآ ينشران في «اليوم السابع» رسائلهما المتبادلة، فكانت تلك الرسائل حينها اكتشافا حقيقيا خولت لنا أن نستمع إلى صوتين يشبان في الذاكرة وفي المشاعر الهاربة، ويضعان أسئلة دقيقة في المجال السياسي، ولكن أيضا في المجال الشعري.
ومنذ ذلك العهد وأنا أتابع ما يكتبه سميح القاسم وفي ذهني أنه تحول إلى شجرة زيتون كبيرة في فلسطين لا يمكن اقتلاعها، ولا يمكن ترويضها لتصير شجرة أخرى. أظن أن سميح القاسم سعيد اليوم لأنه أخيرا سيلتقي صديقه محمود درويش خارج المنافي.
(شاعر وروائي مغربي)
رمز المقاومة/ شعبان يوسف
تفجرت معرفتنا بشعراء الأرض المحتلة عموما في بداية عقد السبعينيات، وكان الناقد الراحل رجاء النقاش له فضل كبير في ذلك، عبر ما كان يكتبه في مجلتي المصور والهلال، ورغم أننا تعرّفنا الى ثلاثة شعراء دفعة واحدة وهم محمود درويش أولا، ثم سميح القاسم ثانيهما، وكان الثالث توفيق زياد، وكان سميح القاسم يبهرنا بأشعاره، وكنت أتفاعل مع أشعاره بشكل كبير، حيث انه يشكل مساحة خاصة ومختلفة عن المساحة العريضة التي تكونت في الساحة العربية، وكان أمل دنقل يمثل الجانب الأحدّ فيها، وكان عبد الصبور يمثل الجانب العاقل والمتأمل، وكانت بقية الأصوات مثل البياتي وحجازي وبلند الحيدري تأتي على ضفاف هؤلاء، وكان سميح بين رفاقه مثالا ـ آنذاك ـ للشاعر الذي ظل يقاتل شعرا ونثرا وسياسة في مواجهة الأعداء، وجها لوجه، من دون النزوع إلى الخروج الأبدي من الأرض، هذه الأرض التي تجسدت في أشعاره كثيرا، ولذلك فهو كان رمزا متعدد الصور للمقاومة، صورة الشاعر المقاوم الذي يعيش بين الذئاب ويتلقى كل دقيقة طعنات سيوفهم، ورغم ذلك فشعره ليس شعرا تقريريا، لكنه شعر ممزوج بروح التاريخ والأسطورة والمذاق الآخر، كذلك كانت قصائده عن السد العالي ونجيب محفوظ والنيل في ما بعد، قصائد آسرة، ليس لأنها قصائد تغني لما هو الأقرب للروح، ولكن لأنها قصائد تنطوي على النزوع الانساني الخالص، وخارج هذا الشعر المطرّز بالألوان والأحجار الكريمة، شعر ينطق فيه العالم كله، تبعا لما كان يحمله سميح من الانتماء للماركسية، التي انتمينا لها وغنينا معها، وكان سميح يجاهر بذلك دوما، وكانت تعجبني مجاهرته مثل رفيقه إميل حبيبي، ولم يختفيا تحت عباءات قومية داكنة، وكم كانت هذه المجاهرة تكلفه، وتدفعه لدفع فواتير باهظة، لكن كان هناك في الأرض من كانوا يحبون هذا الشاعر ويتعاطفون معه بكل ما يملكون من صوت وقلم، وكنا نتابع أخباره كأنه واحد من آل البيت الثوري العربي والمقاتل، واختلفت المصائر والاهواء وطرق كتابة الشعر، لكنه سيظل الشاعر الذي وقف طوال حياته في مواجهة أعدائه يقف أمام سيوف الخصم، إنه البديل عنا، كنا نردد قصائده، رغم معاظلة بعضها في البدايات، وكان البحث عنه وعن صوته الذي جاءنا بقوة متعة ما بعدها متعة، وقرأنا دواوينه منذ دمي على كفي حتى أشعاره الأخيرة، وكم كان يحزنني ويحزننا الخلاف الذي تحول إلى معركة بينه وبين رفيقه محمود درويش، وكم كنا سعداء عندما انقشع غبار هذه المعركة
(كاتب من مصر)
انشقاق شطري البرتقالة/ فجر يعقوب
علاقتي الحقيقية بسميح القاسم تعود إلى ثلاثة عقود، ودعنا من المنهج التدريسي الذي عرّفنا به في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فلن يكون هو محرّك البحث عن الكلمات في رحيله كما تفعل مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الأثناء. في تلك الأيام العاصفة التي تلت خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وانتقال مؤسسات فصائلها المكونة لها إلى عواصم عربية مختلفة، عملت في دمشق مع مجلة فلسطينية منتقلة حديثاً إليها، وكان لدي طموح الصحافي المندفع الذي يميز سني الشباب. وفي اللحظة التي تداعى فيها البعض لانشقاق المنظمة بفعل صراعات داخلية وإقليمية أرخت بظلالها على الكيان المعنوي للشعب الفلسطيني في مطارح شتاته، انقسم الفرقاء في السياسة وفي الثقافة أيضاً من حول هذا الكيان الشرعي، وصار على السياسي الفلسطيني البحث عن مكونات الثقافة التي يستدعيها لتخدم خطابه، وبطبيعة الحال كان على الرمز الأكبر فيها الشاعر الراحل محمود درويش أن يتحمل سهام هذا الخطاب بوصفه «الرمز اليميني المنحرف».
كان الخطاب برمته خادشا للحياء، إذ كيف يمكن لكَ أن تجمع بين شغفك بالشاعر الكبير، وقصائده التي تربيت عليها، وقرّبتها من فؤادك، ومكونات هذا الخطاب المتعثّر المشوّه الذي يفبركه المشرف العام على المجلة التي تعمل فيها سكرتيراً لتحريرها. كان عليه أن يفبرك أيضاً أن النصف الثاني من شق البرتقالة سيكتب للمجلة من فلسطين نكاية بشقها في المنفى. يا الله سميح القاسم سيكتب في مجلة أعمل فيها. هذا شرف كبير. ولم أعرف بحكم سنوات البراءة أن سميحا لم يكن له علاقة بهذا الموضوع، وظللت أداوم مدة عامين في مؤسسة الأرض التي كانت تتحصل على منشورات الأرض المحتلة، و«أنقش» قصائده بخط يدي بحضور مديرها ـ عطية مقداد ـ وكان ممنوعاً عليّ تصوير أي شيء آخر من جريدة الاتحاد، لسان حال الحزب الشيوعي الإسرائيلي، أو مجلة الفجر الجديد، لاعتبارات أمنية خاصة، لكن هذا أيضاً لم يمنعني من الحصول على كتابات أنطوان شلحت ورياض مصاروة وعلي الخليلي وآخرين من نفس المصادر ونشرها في مجلة المشرف العام، الذي كان يكيّف خطابه «المتوهج» مع كذبة انشقاق شطري البرتقالة.
(سينمائي فلسطيني)
ما يليق بالشعراء/ رفعت سلام
اكتمل سميح القاسم، وانغلقت الدائرة؛ خرج من النسبي، ودخل المطلَق، ليسمح لنا – من بعد – بالنظر وإعادة النظر في ما يتجاوز العابر، التفصيلي، الجزئي. فمن ها هنا، يبدأ الزمن في إسقاط الظلال والشبهات، فلا تبقى سوى القامة وحدها، لنكتشف ما غاب عن البصر والبصيرة في حُمّى الغرق في تفاصيل الآني والراهن. كان لا بد أن أغادر قريتي إلى القاهرة، ملتحقًا بالجامعة (1970) لأتعرف إلى سميح القاسم. فالقرية الصغيرة لا يصلها شيء من الحراك الثقافي المحموم آنذاك، وخاصةً في الشعر. وكان لا بد من أن ألجأ إلى مكتبة الجامعة، لأكتشف الأعمال الجديدة، الصادرة آنذاك ببيروت، لأبناء الحركة الشعرية الجديدة. هكذا، وقعتُ على أحد رفوف المكتبة متخمًا بأحدث هذه الأعمال آنذاك.. سميح القاسم، توفيق زياد، محمود درويش، السياب، نازك الملائكة، نزار قباني.. كان اكتشافًا باهرًا لي، ألتهمه كل يوم، لبضع ساعات بالمكتبة. و«شعراء المقاومة الفلسطينية» – حسب المصطلح الرائج آنذاك – كان الاكتشاف النوعي. هكذا، التقيت بسميح، لأول مرة، وأنا أنتقل من الكتابة «العمودية» إلى «التفعيلية»، خائفًا مرعوبًا من «المغامرة»! صوتٌ خاص، يمتد أفقيًّا على مدى خمسين عامًا، بلا قفزات مفاجئة، أو تحولاتٍ فارقة، أو مغامرات، يتطور داخليًّا تطورًا حثيثًا، لا يكاد المرء – من رهافته – أن يلمسه. لكنه يحافظ دائمًا – على مر الأعوام والدواوين – على جذوره وطابعه الأوّلي في مواجهة العالم بالشعر: القضية الفلسطينية، وهوية الفلسطيني في الوجود.. هو تماهي الذات في القضية العامة، التي تصبح القضية الذاتية، بلا ذاتية، كأنها بلا ذات خارجها، سوى صوته المجلجل، الراثي، الهجَّاء، الشَّاكي، المغنِّي، الحالم بما لم يتسع العالم له: استعادة الوطن المفقود. هكذا، أصبح صوت الحلم الفلسطيني، صوت الحلم العربي بفلسطين، يصَّاعد أحيانًا، ويخفت حينًا، بقدر تصاعد وخفوت الحضور الفلسطيني في ذاته، وفي الواقع العربي، بلا انفصال. تلك هي ضريبة اختيار الشاعر للتماهي بالقضية المركزية لوجوده، التي لا يملك من أمرها سوى القصيدة. أما وقد تفرق دمها بين القبائل الفلسطينية إلى حد رفع السلاح، فلم يعد لصوته المجلجل بالبشارة والتحدي – في ما مضى – إلا أن يخلد لما يشارف اليأس. وفي حالاتٍ فريدة، يبدو الموت كأنه «اختيار»، كأنه.. ذلك ما يليق بالشعراء. فذات أغسطس آخر منذ سنوات قريبة، اختار درويش الرحيل، ليلحق به سميح في أغسطس تالٍ، دون أن يشارف حلمهما الأبدي حافة التحقق، بل انتكس بأكثر مما كان يراود كوابيسهما. كأنه رحيل بمثابة رفض واحتجاج على ما جرى ويجري من التنكيل بالحلم الذي بشرا به ذات عُمر، وذات شعر.
(شاعر مصري)
الليلك الفلسطيني/ صقر أبو فخر
الليلك هو لون الحيرة والقلق، والكآبة أحياناً. ليس لوناً صافياً أو رائقاً هو، بل امتزاج الأزرق والأحمر والأصفر معاً، تماماً مثل سميح القاسم الفلسطيني العربي الذي يحمل جواز سفر إسرائيلياً ويرفض أن تكون هويته غير عربية. كانت «دنيا»، حبيبة الطفولة، ترتدي الثوب الليلكي عندما لجأت مع أهلها إلى لبنان في سنة 1948 فأورثته كمداً طاغياً، وكثيراً ما كان يراها في أحلامه عائدة بثوبها الليلكي، فيسكت وجيف قلبه. لكنه، في ما بعد، صرخ متحرقاً: «إلى الجحيم أيها الليلك»؛ حينذاك، انتصر على انقسام الهوية وانشطار الذات، وأنهى ألم الحيرة وباح بالحق: الليل الذي لك هو الليل الذي لي، وأرفض أن تكون فلسطين «لي ولك»… إنها لي وحدي. وسميح القاسم الذي ينتمي إلى عشيرة عربية موزعة في فلسطين وسوريا ولبنان، ويتحدر من فارس قرمطي هبط فلسطين من أرض الحجاز، مولود في قرية الرامة في الجليل في 11/5/1939، وهي القرية التي ولد فيها يوسف الرامي الذي أنزل المسيح عن الصليب ووضعه في القبر واحتفظ بالكأس الفضية المقدسة التي استخدمها المسيح في عشائه الأخير مع التلاميذ. وبهذا المزيج التاريخي واللوني، صار سميح إحدى سنديانات الوعر الراسخة منذ نحو ألفي سنة بالقرب من جبل حيدر، والممتدة جذورها في ذلك البهاء الدهري الأخضر.
[ [ [
سميح القاسم هو عصارة الشعر الوطني الفلسطيني الحديث الذي كان من رواده وأركانه عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) وابراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود، ثم سار في ركابهم راشد حسين وحنا أبو حنا وتوفيق زيّاد وسالم جبران ومعين بسيسو ويوسف الخطيب وهارون هاشم رشيد، وهؤلاء جميعاً انتموا إلى الشعر كخندق في معركة البقاء، وكملجأ ضد محو الهوية واندثار اللغة، فكانوا يخوضون معاركهم بما ملكت أصابعهم، أي بالشعر وسحر الكلمات. ولهذا ارتبط اسمه بالقضايا الوطنية وبمحمود درويش معاً، والاثنان كانا جناحي الشعر الفلسطيني، فالبدايات واحدة وإن افترقت المصائر. محمود درويش انفرد بتجربة المنفى التي، على الأرجح، جعلت شعره يرقُّ ويشفُّ ويتحول رحيقاً، ويصبح هو قديساً للفلسطينيين، وأيقونة لهم ومرمم جروحهم وواهب الأمل لديهم. وصار سميح القاسم رمحهم وصوتهم وأنفاسهم المكتومة.
[ [ [
تأثر في طفولته بالأناشيد الوطنية مثل «موطني» (وهو أجمل نشيد حتى اليوم، كتبه ابراهيم طوقان ولحنه الأخوان فليفل) و«نحن الشباب» و«بلاد العُرب أوطاني» و«يا ظلام السجن خيِّم» و«يا علم العُرب». وفي ما بعد ظل شعره مشحوناً بإيقاع الأناشيد. شعره بسيط ومباشر، ولغته واضحة، وقصائده مفعمة بالغضب والقوة والتحدي. لنتذكر قصيدة «رسالة إلى غزاة لا يقرأون» التي يبدأ مطلعها بعبارة «تقدموا تقدموا»، فهي من النوع البسيط والقوي في آن، لكن ليس من السهل أن يكتب غير سميح القاسم قصيدة على منوالها وأن يشحنها بومض مدهش من الحماسة. ومهما اختلفت الآراء في شعره، ومهما تصيد بعض الأقلام مقارنة مع شعر محمود درويش، فإن جواز سفر سميح القاسم، أي هويته، هو شعره أولاً وأخيراً؛ بمضامينه الوطنية والقومية.
[ [ [
كان سميح مرحاً وحاضر النكتة دائماً. ويروي أنه عندما ذهب إلى دوائر الأحوال الشخصية ليسجل ابنه البكر «وطن محمد» سأله الموظف، وهو يهودي عراقي: لماذا وطن محمد؟ وأين عيسى وموسى؟ فأجابه سميح على الفور: أنا لست وزيراً للاستيعاب مهمته إسكان الأنبياء والرسل. وحين وُلد ابنه الثاني اقترح على زوجته اسمين: «جليل» أو «جولان»، فقالت له: أخشى أن ننجب طفلة فتسميها «ضفة» أو «غزة». ولما ولد ابنه الأصغر اتصل به ياسر عرفات للمباركة، واقترح عليه اسم «علي» تيمناً بالشهيد علي أبو طوق، أو «أسامة» تيمناً بأسامة بن زيد أصغر قائد في الفتوحات العربية. هنا تناولت والدة سميح الهاتف وقالت لياسر عرفات إن اسم الطفل سيكون «ياسر».
[ [ [
كانت الدنيا لديه غير «دنيا» ذات الثوب الليلكي. «إنها مجرد منفضة». هكذا وضع عنواناً لمذكراته الجميلة والآسرة. إنها منفضة حقاً يتساقط فيها رماد الأيام وحطام الأحبة. وها هو سميح القاسم ينثال إليها وديعاً كحمائم الينابيع في الجليل، ويتناثر شعراً وجسداً وكلمات ويترك في هذه الدنيا عطراً لا يتبدد، وعناداً مشهوداً. أَليس هو الذي رفض التجنيد الإلزامي، وسار أولاده على منواله؟ أَليس هو مَن رفض مقابلة أنور السادات؟ أَليس هو من رفض «جائزة إسرائيل للإبداع» وقَبِلها إميل حبيبي؟ وظل رابضاً على مواقفه حتى «ذهب الذين أحبهم وبقي مثل السيف فردا».
آخر الشعراء النجوم../سامر محمد إسماعيل
ساعدت الغنائية العربية الممتطية صهوة الأيديولوجية والحقوق المُغتصبة على بروز سميح القاسم مع العديد من الأسماء الشعرية التي تبنت قالباً جاهلياً جديداً في قلب المجتمعات الحديثة بعيد الاستقلال في هذا البلد العربي أو ذاك، إلا أن شعراء فلسطين ومن لاذت موضوعاته بالحق الفلسطيني كانوا الأقرب إلى وعي الجمهور الجديد، فبعد عقود طويلة من فترة الشعر الرومانسي الذي تربع المهجريون على عرشه بدايات القرن العشرين، كان لا بد للقصيدة العربية من أن تخرج من التفخيم والبرجزة والترصيع والتكلف؛ نحو مجازاتٍ أكثر قرباً من القصيدة الشفوية التي تعد أصل الشعر العربي الكلاسيكي، وهي هنا تقترب من صيغة النشيد أكثر منها كنص يحفر عميقاً في اللغة وأحوالها وصياغة صورها وأصالة شعريتها. هكذا عادت من جديد ظاهرة الشاعر النجم إلى واجهة الثقافة العربية بعدما اختفت تقريباً منذ العصر العباسي مع المتنبي وأبي تمام وسواهما من مالئي الدنيا وشاغلي الناس؛ مقدمةً العديد من شعراء المنابر الذين وجدوا أنفسهم محاطين بجمهور يتلقى الهزيمة تلو الهزيمة، فالنكبة كما تسمى في التعبير القومي الدارج عن خسارة العرب لفلسطين، وتهجير شعبها من مدنه وقراه، ومن بعدها نكسة حزيران تركتا وشوماً لا تمحى في العقل والذائقة العربيين؛ لكنهما في الوقت ذاته أفسحتا المجال أمام ظاهرة الشاعر العراف، الشامان، الرائي؛ والذي كانت تُخصص ملاعب كرة القدم لجماهير أمسياته؛ إضافةً لحضوره الغزير على وسائل الإعلام، وتدريس قصائده الثورية الرافضة ذات النبرة العالية في مناهج المراحل الأولى من المدارس العربية كأدب ملتزم ومقاوم؛ فقصيدة القاسم التي يقول مطلعها: «خلوا الشهيد مكفناً بثيابه، خلوه في السفح الخبير بما به» إضافةً لقصيدته «تقدموا فكل سماءٍ فوقكم جهنمُ» كانت ولا تزال في قائمة القصائد التي حفظتها أجيال من تلاميذ المدارس في سوريا، بل إن قصيدة القاسم ظلت جنباً إلى جنب مع قصيدة محمود درويش هي المثال الأكثر نضارةً للتعبير عن الحق الفلسطيني، وعن الوجدان العربي المكسور، والمهشم، صحيح أن القاسم ظل وصيفاً أمام نجومية رفيق دربه، إلا أن صاحب «مواكب الشمس-1958» رغم تاريخه الطويل من النضال والاعتقال ودخوله أكثر من مرة إلى السجون الإسرائيلية، ورفضه مغادرة الأراضي المحتلة وانتسابه إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، ووضعه غير مرة تحت الإقامة الجبرية من قبل قوات الاحتلال، وترجمة أعماله إلى عدة لغات منها العبرية، ونيله مرتين وسام القدس من الرئيس الراحل ياسر عرفات؛ أقول رغم كل هذا ظل القاسم أقل نجوميةً من محمود درويش، ففيما انتزع صاحب «الجدارية» لقب شاعر القضية بامتياز ولسنوات حتى بعد مغادرته لفلسطين مبكراً وسفره إلى بيروت والقاهرة وتونس وباريس، ظل القاسم يكتب أشعاره من أرض موطنه؛ حائزاً العديد من الألقاب التي لم تجعل نجوميته تقترب إلى نصف النجومية التي حصدها صاحب «ورد أقل» الذي كان يكتب معظم خطابات ياسر عرفات؛ لا سيما بعد ترك درويش بيروت إبان الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي لها للقضاء على منظمة التحرير هناك وقواها المسلحة في لبنان، لقد ظل القاسم رغم غزارة نتاجه الشعري والأدبي عموماً بعيداً عن شعراء الصف الأول، وما كتاب «الرسائل – العودة – بيروت 1989» بينه وبين درويش سوى نوع من المماحكة المعلنة بين موهبة لا ترد وموهبة أثقلتها ألقابها المتعددة من مثل: «شاعر الغضب الثوري – الشاعر النبوئي – شاعر البناء الأوركسترالي – الشاعر العملاق» وغيرها الكثير؛ وذلك دون أن تجد مؤلفات صاحب «يا عدوّ الشمس» ذلك الصدى اللازم لها بين أوساط الجمهور العربي الذي كان يهدر برمي إسرائيل في البحر مردداً لاءات قمة الخرطوم-1967 الثلاث: لا صلح لا اعتراف لا تفاوض؛ فلم يكن لكتب القاسم الكثيرة في النثر والرواية والشعر والتوثيق هذا الوهج الذي نالته كتب شعراءٍ آخرين؛ حتى أن مواطنه عز الدين مناصرة البعيد عن كل هذا الضجيج الذي رافق كلاً من درويش والقاسم، تتمتع نصوصه بخصوصية شعرية عالية وموهبة نادرة تضاهي نصوص هذين الشاعرين وتتفوق عليها في الكثير من المواضع؛ فنجومية الشاعر هنا لا تعني إطلاقاً عدم مناقشة نصوصه نقدياً وفنياً كما حدث مع مجمل تجربتي القاسم ودرويش؛ ولئن غنى مارسيل خليفة ولحّن لكل من درويش والقاسم ومناصرة فهذا لا يعني أيضاً أنه ليس هناك أكثر من جيل شعري فلسطيني تم تهميشه وإهماله على حساب احتلال الشعراء النجوم لعرش القصيدة الفلسطينية المعاصرة – بالمناسبة ما الذي تشكو منه أشعار معين بسيسو أو غسان زقطان مثلاً؟ – لكن الغنائية والدرامية والملحمية وحاجة الجمهور إلى مخلّص تدعم دوماً أسطرة شاعر ودفعه ليكون لسان حال الجماهير سواء أراد ذلك أم لم يرده؛ وربما في كثير من الأحيان إنشاد الحشود قصائد تعبوية في مرحلة من مراحل المواجهة مع العدو؛ كانت تبدو للقاسم نوعاً من الريادة المستمرة عبر التنبؤ بلواعج الشارع العربي، لا سيما أن حياة الإنسان الفلسطيني حتى هذه اللحظة هي من أقسى أنواع الحياة، وأكثرها اغتراباً وقدرةً على تفتيق قريحة صوتية فجائعية يكون الشاعر مشجبها الفني والأدائي ورمزها المناسباتي المحبب. هذه العوامل ظلمت نصوص القاسم مثلما ظلمت نصوص درويش، بل حمّلتها ما لا طاقة لها به؛ لتزيد غربة الشاعر واغترابه، ولتنغص عليه صفو ذهنه وسليم سليقته؛ ولهذا نجد في أشعار القاسم ما يستحق المراجعة والوقوف عنده طويلاً كما في «ويكون أن يأتي طائرُ الرعد – دار الجليل – 1969» أو في « لا أستأذن حداً – درا الريس-1988» أو حتى في « سأخرج من صورتي ذات يوم – مؤسسة الأسوار-2000»، فقياس قامة من مثل سميح القاسم بقربه أو ابتعاده عن كونه شاعراً نجماً أم لا هو أكيد إجحاف بحقه؛ وإكمال لما حاول البعض تصنيفه ضمنه؛ وهنا أستطيع القول ابن بلدة الرامة كانت معظم نصوصه أقرب إلى الهدير منها إلى الهمس؛ إلى الصراخ أكثر منها إلى الغناء، وظلم كبير أن نطلق حكماً نهائياً على هذه النصوص أو ننفيها في قالب نصوص المقولات الكبرى؛ إذ كان لا بد في نهاية الأمر مما لا بد منه؛ كان لا بد من شعراء يستطيعون عكس عصرهم في قصائدهم؛ ومن يمثل كل هذا الدم الفلسطيني المسفوح سوى شاعر من مقام صاحب «دمي على كفي – الناصرة -1967» أو « منتصب القامة أمشي – منشورات الأسوار -2012»؟ الأغنية – القصيدة التي لا تزال تحرك الجموع فهل ما زالت تحركها؛ وهل ما زال هناك متسع لنجومية الشاعر في زمن الشارع وتسيد كائناته حتى على وعي النخب العربية؟ سؤال يصير محرجاً يوماً بعد يوم للكثيرين ممن حزنوا أو وجدوا وقتاً للحزن على سميح القاسم الذي لم يكن ليرحل هكذا، دون أن يشاهد في آخر أيامه ازدهار حفلات تقطيع الرؤوس بين بغداد ودمشق؛ فيما يزهق الدم الفلسطيني في غزة يومياً وبنفس إيقاع التواطؤ العربي؛ وذات الإذعان وغض النظر عن الجريمة الإسرائيلية الكاملة فوق أرض فلسطين؛ مرةً عبر تهدئة ومرةً عبر هدنة؛ ومرات عبر وساطة مصرية غامضة بين تل أبيب والقاهرة يتم فيها التأكيد على ثوابت كامب ديفيد! أجل لم يمت القاسم من أمرٍ قليل، بل إن ما شاهده في ساعاته الأخيرة من هذا الواقع العربي المرعب قرّب له الموت وحببه إلى نفسه الرقيقة؛ هارباً من حرب التلفزيونات العربية التي لا تتوقف عن كيل التهم لبعضها البعض؛ واستشهادها دوماً بتقارير عن المحطات الإسرائيلية؛ فيما الأنظمة العربية الراعية لها تواظب على تنجيد كراسي حكامها وملوكها؛ وهي تتفرج بدم بارد على ذبح طائرات الإف 16 لأطفال غزة ونسائها وشيوخها؛ مشهد يمكنه قتل شاعر برهافة القاسم؛ مشهدٌ مفتوح على نازحين جدد ووكالات غوث جديدة، ولفلسطينيين عرب جدد؛ مشهد تعوم فيه الأرض العربية بمخيمات جديدة، وحروب داخلية يتذابح فيها الإخوة، وتقام المتاريس بينهم في القرى والبلدات والمدن والأحياء والأزقة، ولهذا ربما رحل الشاعر في آب كصديقه الذي غاب عنا في التاسع منه عام 2008؛ فبعد ست سنوات يحق للقاسم أن يرى رفيقه هناك في الأبدية البيضاء؛ حيث لا تلفزيونات إسرائيلية ولا أمسيات حروب أهلية ولا جوائز أدبية..
(كاتب سوري)
امتحان الوجود والهوية/ ياسر سكيف
لم يذكر الشاعر الفلسطيني سميح القاسم يوماً إلا واستحضر ذكره, بالنسبة لي شخصيّاً, تلك العقائدية, التي ربّما كانت مُحبّبة يوماً, والتي استبدّت بالشعرية العربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي, ولم تنجح سوى قلّة ٍ قليلة ٍ من الشعراء في التفلّت من قيدها, وفي البحث عن أشكال وآليات جديدة للاشتغال الشعري. ولطالما أحسست بأنّ ما يشدني إلى القاسم وجداني أكثر منه فنيّاً, وإن كان من أدبيّ أغراني في تجربته فقد رأيته في روايته (إلى الجحيم أيها الليلك) رغم تواضعها في سياق جنسها الأدبي, أكثر مما رأيته في تجربته الشعرية. ففي هذه الرواية يُظهر القاسم جانباً, بقي حيياً, من الميل إلى المُغامرة الفنيّة. ولم يتبدّ هذا الجانب في شعره أبداً إذ بقي مستقرّاً عند عتبة المعنى الأداتي للفن عموماً وللشعر على وجه الخصوص, وهذا ما يعود في أسبابه, دون أن أقول جديداً, إلى امتحان الوجود المستمر, وامتحان الهوية المهدّدة في هذا الوجود. ذلك الامتحان الذي عاشه الشاعر في ظل الاحتلال, والذي جعل من تجربته الشعرية تنوء بحملها الأخلاقي على حساب الفني. وكأنما كان على القاسم ألا يتخطى الممارسة الوظيفية للأدب لأسباب ربّما أهمها الفهم الأيديولوجي القبْلي والمُحدّد لدور الأدب ووظيفته, يضاف إلى هذا انغلاق العالم الخارجي كعيش حواري مع الإنسان والفكرة. وعند هذه النقطة ـ السبب يحضر محمود درويش كنموذج على الجدلية التي تحققت بين الحرية كشرط وجود وبينها كشرط إبداعي. ولا أقصد الحرية التي تتحقق في الخلاص من قبضة الاحتلال فحسب, بل تلك التي تخص الانفلات من قبضة استبداد الأيديولوجيا أيضاً. وهكذا بقي نص القاسم أسير شعبويته التي جعلت منه صوتا ً جماعيا ً يصدره الفرد بالنيابة, وبالتالي تجرّد من ملمح الفرد الذي قد تتبنى الجماعة صوته, كما في تجربة درويش, وهذا ليس حكم قيمة على نص القاسم, إذ لا مساحة هنا لإحكام القيمة التي تحتمل الأخذ والرد, إنما هو توصيف فحسب لما يرشح به النص. نعم نص القاسم هو نص مقاوم, وهذا التقييم, كما نلاحظ, لا يأتي من الحقل الأدبي, ولكنه يؤكد على أنه نص مُغلق على ذاته الاجتماعية؛ بحيث لا يترك مجالا ً لقراءته بأدوات القراءتين الأدبية والفنيّة, بقدر ما يستدرج قراءته من حقول ثقافية أخرى. وبالتالي لا يمكن الحديث عن أية إضافة أحدثها القاسم في تجربته الشعرية, تلك الإضافة التي يمكن أن تستفز جهدا ً نقديا ً في الحقل الأدبي, وإن كانت هناك من إضافة فإنما إلى البعد الأيديولوجي في الأدب. ومن هنا أقول: إن القيمة التي يمكن أن تسجّل وتحتسب لسميح القاسم, في مسار الشعرية العربية, هي تاريخيّة فحسب, وليست فنيّة بأي حال.
(ناقد سوري)
تعبتُ من الحياة/ جمال الجمل
رحيل القاسم، ليس رحيلا لشخص، قال كلمته ومضى، إنه رحيل زمن.
وفي تصوري أن هذا الرحيل لم يحدث قبل ساعات داخل غرفة بيضاء في مستشفى، لكنه حدث في فضاء الزمان والمكان، حيث تغيرت المفاهيم، وتبدل القاموس السياسي والشعري، وتنحت قضايا وعناوين لتحل محلها قضايا وعناوين لاتلائم الشاعر اليقيني المقاوم
لقدر عاصرت موت يوسف إدريس قبل غيابه الفيزيقي بسنوات، كما اعاصر منذ سنوات موت الكثير من المبدعين والمفكرين والفنانين الذين يتنفسون من الماء إلى الماء.
سميح نفسه كان يدرك هذه المتغيرات، ويوقن أنه يمضي في طريق كيخوتة، فلا المقاومة التي تروج لها صحف وفضائيات، هي المقاومة التي تناولها سميح في اشعاره، ولا حتى فلسطين هي فلسطين.
الرفاق ذهبوا بأحزانهم وأحلامهم، ولم يبق من توفيق زياد وراشد حسين ومعين يسيسو، ومحمود درويش ايضا، إلا ما تسمح به الذاكرة العربية الآنية، وهي ذاكرة تفضحها اقتباسات شباب الأمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وركاكة المثقفين الذين يتصدرون المشهد، وهيمنة وزارات الثقافة، وشروط الناشرين الباحثين عن جمهور لا يقرأ، وإذا قرأ فإنه يتوقف أمام عشق راء، وصهيل الجنس بين ساقي جيم، والافخاذ السماوية المشاع، أكثر مما يتوقف عند قضية من القضايا التي كانت تشغل بال شعراء القضية.
لا اليسار هو اليسار الذي ناضل سميح من أجله، ولا العروبة هي العروبة، ولا الاستشهاد نفسه له ذلك الطعم القديم، ربما لهذا خاطب سميح نفسه وخاطبنا:
«يا أيها الموتى بلا موت
تعبت من الحياة بلا حياة
وتعبت من صمتي
ومن صوتي
تعبت من الرواية والرواة».
في أحد لقاءاتنا بالقاهرة، أخذنا الحديث عن طقوسه الخاصة جدا في الكتابة، وكان من أجمل ما قاله انه يحب الكتابة في الليل، وكل من حوله نيام، لكنهم يجب ان يكونوا قريبين منه، ليسمع صوت أنفاسهم.
وعندما سألته: لماذا؟
قال: لا أعرف، أحب أن اشعر بوجود الناس، لكنني لا أحب أن يقاطعوني ويشوشـوا تركيزي.
لا أعرف هل ذهب سميح لينام وتركنا نكمل الكتابة، أم أننا النائمون وسميح ذهب ليكتب؟
ما أعرفه أن سميح الشخص ذهب إلى حيث يذهب الاشخاص، أما الشاعر فيبقى متحررا من الأعباء والمشاحنات، وكما كتب يوما لنجيب محفوظ أكتب: طوبى للحرف الشامخ في الليل منارة/ والعار لأبراج العاج المنهارة».
(شاعر مصري)
الكتاب الأيقونة/ فتحي أبو النصر
ستفتقد الثقافة والفكر العربي والأممي شخصية نزيهة وصلبة وذات احترام كلي، بينما شكل تجربة شعرية بارزة لها طابعها النوعي المتفرد في المقاومة والعشق على مدى عقود. أتذكر الآن قصائده القديمة عن صنعاء وعدن (لأكثر من سبب ولأكثر من حنين أيضاً) مع أنها ضمن عديد قصائد صاخبة له غير متوافقة مع ذائقتي، ومع ذلك لا املك سوى أن أقدرها بدون تحفظ.. ثم انها أنتجت مرحلة ارتفاع النبرة المباشرة في الشعر العربي الحديث «وتسييسه».. مرحلة الستينيات خصوصاً وشيء من السبعينيات، وهي مرحلة لها خصوصياتها وظروفها الاستثنائية شديدة التأثير في مستوى النص بكل المقاييس. إلا ان سميح القاسم – نجح رغم كل شيء ولو بطيئاً مقارنة بدرويش مثلاً – في تطوير شعريته ورؤاه إلى حد مبهر. أما بشكل خاص وحميمي فإنني أعتز بتقديسي لرسائله مع محمود درويش متلاقحة مع رسائل الأخير له، والعكس. في حالة هارمونيكية متناغمة تصاعداً وهبوطاً وامتزاجاً وافتراقاً في إثارة المعنى وأبعاده داخل النقاش الفلسفي والجمالي والإبداعي والوطني والإنساني والعاطفي الخ. ذلك الكتاب الأيقونة الذي يخلف أثراً لا يمّحي في الوجدان والوعي ولا يستجدي تصفيق الجماهير التي تتلذذ باستلابها كينونة المبدع العميقة فقط! هناك حيث الإدهاش المتجلي والناضج لهمس غريبين كونيين عظيمين كسميح ودرويش. هناك حيث المرآة الحقيقية لذروة تجليات مبدعين كبيرين إنسانياً، وشاسعين في وعيهما بالذات والآخر، كما بفلسطين تاريخاً وهوية وجغرافيا وقضية ومصيراً، فضلاً عن تمجيدهما للإنسانية كهوية، وبالتفاصيل الصغيرة في هذه الحياة العابرة التي يجب أن نحياها كنشيد كرامة وسلام وحرية بكل أخلاقية قيمية يميزها اتساقها المكابد بأفقها الإنساني اللامحدود والمقاوم للشر وللهيمنة وللتوحش وللاستغلال واللاعدالة في هذا العالم.
إلى ذلك يقفز في خاطري الآن اعتزازه المتفوق بأنه من نسل القرامطة الذين هاجروا إلى الشمال واستقروا بفلسطين. فأتذكر روح جدنا علي بن الفضل الذي تعرض للتشويه الممنهج واللامعقول من قبل المعتوهين والحمقى الذين سطوا على التاريخ وزيفوه، كما اتيقن بالمقابل من ان الروح الأصيلة والواسعة للشيوعي الكبير سميح القاسم لم تأت من فراغ أبداً. سميح القاسم الذي كان «اشد من الماء حزناً» ونبالة بالتأكيد لا يموت .. لا يموت في ذاكرة الهم الفلسطيني على الإطلاق.
(شاعر وصحافي من اليمن)
أيام مع سميح القاسم/ ناجي ظاهر
اعادني النبأ المفزع عن رحيل الشاعر الصديق العزيز سميح القاسم، الى السنوات الاولى من حياتي مع الكلمة ومعايشتي لها. كان ذلك في أواخر الستينيات من القرن الماضي، يوم ارسلت قصة لي الى مجلة «الجديد» الحيفاوية، واضعا يدي على قلبي فهل سيقبل الشاعر المشهور محرر تلك المجلة في حينها ان ينشر تلك القصة، لا سيما وانها تعارضت نوعا ما مع كان ينشر آنذاك في المجلة من مواد سياسية، وتحدثت عن حب الام وحب المدينة.
وماذا سيكون موقفه؟ وتشاء الصدف ان التقي الصديق العزيز الراحل المرحوم نواف عبد حسن، في احد شوارع مدينتي الناصرة، فيسألني عما اذا كنت قد أرسلت قصة الى مجلة الجديد، فلا اجيبه خشية وتوقيا، فيرسل الي ابتسامة حافلة بالمودة مرفقا إياها بابتسامة من طرف فمه، ويطمئنني على أن قصتي ستنشر في العدد القريب من مجلة الجديد. عندها أسأله كيف عرفت هذا؟ فيبتسم مرة اخرى مرفقا ابتسامته هذه المرة بكلمات لا اتذكرها حرفيا الآن وقد مر عليها كل تلك السنوات، مفادها ان سميح القاسم سأله عني ومن اكون فأخبره انني شاب متأدب وفدت عائلتي عام النكبة من قريتها سيرين الى مدينة الناصرة للاقامة فيها، وقال لي ان سميحا قرر نشر تلك القصة لأنه رأى في صاحبها كاتبا مبشرا وموهوبا.
خلال علاقتي بسميح منذ ذلك العام حتى أيامه الاخيرة، تأكد لدي حادثا اثر حادث ولقاء تلو آخر، ان سميحا تعامل مع الحياة الادبية بشفافية، وأراد دائما ان تتفتح في بستاننا الف ومليون زهرة. كما ادرك ما لأهمية اعطاء من رأى فيهم اناسا موهوبين الامكانية لأن يعطوا ويعطوا بلا حدود.
في الفترات التالي وخلال سنوات وسنوات كان سميح رحمه الله، يسعى للتعاون مع كل من يرى فيه مقدرة على العطاء ودفع عربة ثقافتنا العربية الفلسطينية في البلاد، كل ما يحتاج اليه ويتطلبه للمزيد من التفتح والعطاء، واذكر بكثير من المودة انه طلب مني ومن آخرين في فترات تالية، ان نكتب عن كل من غادر عالمنا من فنانين وكتاب. فعل هذا معي يوم رحل الفنان اللبناني الذي اشتركنا في محبته حسن علاء الدين الملقب بـ» شوشو»، ويوم طالت يد المنون شاعرنا الفلسطيني راشد حسين الراحل احتراقا في لندن، في هذا الصدد لا اتذكر ان سميحا رد انسانا جادا عن بابه، وكان مقره في حي واد النسناس في حيفا، ملتقى للادباء والفنانين، هناك في مكتبه التقيت عددا وفيرا من فنانينا وكتابنا ممن لم اكن اعرفهم، بينهم الفنانة الممثلة بشرى قرمان رحمها الله، والشاعرة البارزة المرحومة فدوى طوقان ابنة مدينة نابلس التي توطدت معها العلاقة فيما بعد. وعندما توقف سميح عن تحرير مجلة الجديد انتقل ليدير المؤسسة العربية للثقافة والفنون من مكتبه في شارع الموارنة، واذكر بكثير من الدفء انه بادر في تلك الفترة لايجاد تمويل لاقامة مهرجان الفلولكلور الأول في الناصرة بالتعاون مع الصديقين فوزي السعدي مدير جمعية المهباج والشاعر سيمون عيلوطي، وقد انتدبني في حينها لتغطية وقائع هذا المهرجان أولا بأول لينشر ما اكتبه تباعا في صحيفة الاتحاد الحيفاوية التي عمل فيها سميح ايضا، محررا فترة مديدة من الزمن.
عندما انتقل سميح الى الناصرة ليعمل محررا لصحيفة «كل العرب» تواصلت العلاقة بيننا، واذكر انني قمت بزيارته اكثر من مرة في هذه الصحيفة، واشهد انه كان يفتح بابه لكل من طرقه، لا اتذكر انه اغلق ذلك الباب بوجه احد، وقد رافقته في هذه الصحيفة بنشري لعدد من المتابعات الأدبية الثقافية والفنية، بل انه اقترح علي اكثر من مرة ان اعمل معه والى جانبه، واذكر انني سألته في اللقاء الأول لي معه في مكاتب صحيفة كل العرب، عما اذا كان سيأتي من بلدته الرامة كل يوم الى الناصرة، فنظر الي مستغربا السؤال، فما كان مني إلا ان حذرته من الطرق وحوادثها، عندها ابتسم وقال لي لا تخف عمر الشقي بقي.. إلا ان ما حدث هو ان حادث طرق كاد ان يودي به وحدّ من حركته وقع له خلال تنقله بين بلدته ومدينتي.
مما اتذكره عن سميح، انني قمت قبل سنوات بالتعاون مع صاحب مجلة «الشرق» الفصلية الثقافية التي صدرت في شفاعمرو من السبعينيات الاولى، وعلمت للأسف انها ستتوقف في العام الجاري عن الصدور، اقول إنني قمت بالتعاون مع الدكتور محمود عباسي، امد الله في عمره، بتحرير عدد خاص عن سميح قدمنا فيه مادة ضافية عن سيرته ومسيرته، كما قدمنا فيه مجموعة اختارها هو ذاته من بين كتاباته، واذكر ان سميحا تعاون معنا الى اقصى حد ليصدر العدد بحلة انيقة تليق به وبالمجلة.
الشخصية الانسانية الحانية ميزت سميحا طوال عمر علاقتي به، واذكر مما اتصف به من سعة صدر وتفهم عميق لمجريات الامور، انني ضقت ذات يوم كما ضاق كثيرون سواي بالادعاء أن شعرنا في هذه البلاد اقتصر على ثلاثة او اربعة اسماء، فكتبت سلسلة من المقالات انعي فيها على هكذا حركة ادبية تتوقف على مثل هكذا كم من الاسماء، فما كان من سميح ألا ان قام بالثناء على تلك السلسلة من المقالات قائلا إنه يوافقني الرأي وان البلاد التي تتوقف عن تقديم الشعراء تشبه المرأة العقيم التي لا تلد الابناء.. وبلادنا والحد لله بلاد حباها الله بالكثير من القدسية والعطاء.
هذا عن سميح الإنسان المثقف المُحرّر المشجع لكل موهبة ثقافية يقتنع بها، اما عن سميح الشاعر، فان الحديث يبدأ ولا ينتهي، ولعلي اجد في هذه المناسبة المؤسية، مناسبة الحديث عن رحيله، فسحة للتحدث عن علاقته بصديقه وأخيه الذي لم تلده أمه، شطر البرتقالة الآخر، الشاعر المرحوم محمود درويش، فقد ظهر كل منهما في نفس الفترة، وقد اعطيا الكثير وأحبهما الناس، كونهما شاعرين مبدعين يثيرهما ما يثير الجميع من احداث سياسية جسام تمر بها بلدان العالم وبلادنا خاصة، وعندما غادر محمود البلاد في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، كتب إليه سميح قصيدة ملأى بالمحبة للارض والوطن، داعيا اياه للعودة لأنه لا توجد بلاد في الدنيا تتسع لنا مثلما تتسع بلادنا. واذكر ان هذه القصيدة نشرت في احد دواوين سميح الأولى واقصد به ديوان» دمي على كفي». بعدها جرت مكاتبات بين الشاعرين تلقتها صحيفة «الاتحاد» أولا بأول، ليقوم محررها الادبي في حينها الكاتب محمد علي طه بنشرها وليختار لها عنوانا لافتا هو « رسائل بين شطري البرتقالة»، واذكر انني عندما قام محمد علي طه بنشر هذه الرسائل كنت اعمل مساعدا له في تحرير الصفحة الأدبية في الاتحاد، بل اننا تشارونا معا في اطلاق عنوانها المذكر عليها، مع التشديد على ان طه هو من أطلق هذا العنوان اللافت عليها.
لقد رأيت دائما في سميح شاعرا مبدعا، واذكر ان ندوة اقيمت في الناصرة في أحد أيام ذكرى الارض السنوية، شارك فيها اكثر من عشرة شعراء قدموا من اماكن ومواقع مختلفة من بلادنا، وكيف تألق سميح بينهم وكأنما هو من كوكب وهم من آخر، مع الإحترام لكل من كتب وقرأ في تلك الندوة.
ايماني هذا بقدرة سميح وتمكنه من ملكته الشعرية والابداعية بصورة عامة، دفعني لترداد رفضي لأية مقارنة بينه وبين شطره الآخر، الشاعر محمود درويش رحمه الله، وكنت اتذرع برفضي لمثل هذه المقارنة، قائلا إننا لسنا بحاجة للمقارنة بين أي شاعر وآخر، لأن لكل من الشعراء في عالمنا الرحب هذا، عالمه الخاص به، بل اختلافه عن سواه وهو ما يميزه في عطائه. مشيرا الى ان لكل من شاعرينا قدرته المميزة في القول الشعري، وان المطلوب منا ألا نطلب من شاعر ان يكون نسخة من الآخر وإنما المطلوب منا أن نميز الشعراء باختلافهم لا باتفاقهم.
رحم الله سميحا، فقد اعطى الكثير وترك وراءه الكثير، وقد احسن رحمه الله بكتابته لسيرته الذاتية قبل رحيله بفترة وجيزة.. لتصدر في كتاب يمكِّن قارئه من معرفته اكثر. لقد عاش سميح القاسم حالته الشعرية حتى النخاع واعطى الكثير، لهذا سيسجل اسمه بحروف من المحبة في أعلى قائمة شعرائنا الاماجد في هذه البلاد السخية المعطاء.
كاتب فلسطيني
سميح القاسم قبل رحيله لـ«القدس العربي»: لا نملك القوة العسكرية للمواجهة إنّما نملك الحق التاريخي والوعي والثقة بالإرادة والرؤية
وديع عواودة
الناصرة – «القدس العربي»: في التاسع عشر من آب/أغسطس 2014 غيّب الموت الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، الذي ارتبطت أشعاره بالقضية الفلسطينية، وبذاكرة أجيال في المشرق العربي. رحل القاسم دون أن يعبأ بأضواء الشهرة، سعيداً بمكانته في فلسطين والشعر العربي المُعاصر. كصديقه ورفيق الدرب محمود درويش، اشتغل القاسم في الصحافة، اشتغل في السياسية وهجرها، امتهن الشعر ورحل في آب، وكلاهما كان لصحيفة «القدس العربي» تحية منهما قبل الرحيل، درويش نشر آخر قصائده، والقاسم فتح قلبه المُتعب من مرض السرطان.
اليوم، تنشر «القدس العربي» حديثاً خاصاً أجراه القاسم معها، هو الجزء الثاني من حوار نشرته الصحيفة في عددها الأسبوعي رقم (080714).
■ في سيرة الشعر والشعراء، هل من يخلف، يكمل الطريق شعراء المقاومة؟
ـ «لا خلافة في الشعر. وأنا ضد مقولة صراع بين الأجيال في الثقافة بل تكامل. من جهتي نعم أنا مطمئن للجيل القادم، لكن هناك ظاهرة خطيرة لدينا تتمثل بسرعة النشر والانتشار التي توهم الشاعر المُبتدئ أنه صار مشهوراً وهذا مطبٌ خطير. المشكلة الأخرى هي عدم التثقيف الذاتي. كنا نقرأ أكثر مما نكتب بكثير، لكن شعراءنا اليوم يعتقدون أنهم بلغوا القمة ولا أحد يبلغ القمة. إذ لا توجد قمم بل مواهب قابلة للتطور اذا ما نجت بنفيها من فخ الـ»فيسبوك» و»التويتر» والشهرة السهلة. كتابة الشعر موهبة ربانية وتكوين فسيولوجي سيكولوجي خاص، وتحتاج لتثقيف ذاتي وتحاشي الوهم. يقولون: إن قلت لي أنت في القمة، فأقول: الله يخليك أنا في الوادي تحت وأجرّب أن أصعد».
■ أين يكتب سميح القاسم قصيدته؟ أين يزورك شيطون الشعر؟
ـ «يميل الشعراء للحديث عن طقوس الكتابة وهذه ليست عندي، لكن هناك ظرفاً مريحا للكتابة يبدأ بعد منتصف الليل بعد نوم الجميع. وأفضل الكتابة في المطبخ حيث أحس بالألفة قريباً من الغاز وغلاية القهوة وسجائري معي. أخي محمود كان يستيقظ في الصباح ويستحم ويرتدي ملابسه ويجلس للكتابة. حبيبنا نزار كان يقول: لا أستطيع الكتابة إلاّ إلى ورق ملون. وأنا لا أستطيع الكتابة على ورقة فيها خطوط، تشلّني وتزعجني، كما أحب الكتابة بحبر سائل لأنني أسمعه وهو يلتقي بالورق واستنشق رائحة الحبر. ويذكرني بالقديم. لا حداثة حقيقية بلا أصالة حقيقية.
الاستحداث ضروري لكن هناك حداثة وهناك استحداث، والحداثة تنبع من ذاتك ومن تراثك وأصالتك ولذا قلت: «حينما تكون قصيدتي تكون الحداثة العربية». مع احترامي لأشقائي في سوريا ولبنان ممّن يعتبرون رموزا حداثيين لكنهم ليسوا كذلك بالنسبة لي.
■ أنت قلق على اللغة العربية في الداخل؟
ـ أنا قلق جداً على اللغة العربية من مؤامرة لتغليب اللهجات المحلية لضرب اللغة الفصحى أداة وحدة العرب. شكراً للقرآن الكريم مرة أخرى الذي يحفظ ماء وجه اللغة العربية وأخشى أن يتم التخلي عنها أمام غلبة العامية في مجتمعاتنا.
■ الثقافة العربية ما زالت الحصن الأخير؟
ـ طبعاًّ لأننّا مُشتتين بالسياسة، بالاقتصاد، واجتماعياً حيث تلعب الطائفية والقبلية دوراً قذراً. مفهوم العروبة الأمميّة التقدمية يحميها المثقفون فقط وأخشى سقوط هؤلاء في أوحال الإقليمية الطائفية والعشائرية.
■ سيرتك الذاتية خلت من قضايا معينة؟
ـ « طبعا ولذا أسميتها « الجزء قبل الأخير». هناك أمور لا تنشر. مثلاً علاقتي بالرؤساء العرب حيث يصعب دخولها لأنّ الوضع العام يتداخل مع الخاص، ومنهم اصدقاء لي ومن غير اللائق أن ننشر معلومات تضايقهم.
■ أحلام تحققت؟
ـ « هناك أحلام شخصية غير مهمة للشعب كالزواج وتزويج الأبناء والأحفاد. لكن للأسف الأحلام الكبرى لم تتحقق. حلمي الأول كان الوحدة العربية ولم يتحقق كما حلم تحرير فلسطين، ومناطق عربية أخرى عديدة.
■ أنت تغلب العامل الذاتي على المتعلق بالصهيونية والاستعمار ؟
ـ طبعا هذه ذريعة أصبحت مُعيبة. الاستعمار يُريدك عبداً فأين إرادتك أن تكون حُرّاً، والصهيونية تريدك قنّاً فأين إرادتك أن تكون سيداً؟ تعليق عيوبنا على الآخرين فيه شيء من الجبن وخيانة الذات والجهل والضعف والتخلف.
■ علاقتنا نحن بإسرائيل التي انتقلت من الاحتواء للاستعداء مُجدداً كيف تقيّم أدائنا نحن؟
ـ قادة إسرائيليون كُثر تحدثوا عن مُخطط تهجير العرب الفلسطينيون، «غولدا مائير» كانت تقول: (لا انام كلما سمعت عن ميلاد طفل عربي جديد في إسرائيل). وقتها علّقت عليها بالقول: لن تنامي.
إسرائيل شاءا أم أبت هي دولة ثنائية القومية اليوم وغداً. وإن لم يرضوا ويُقرّوا ويتعاملوا بحكمة وبعقل مع حقيقة وجودنا بوطننا ووطن أجدادنا الشرعي فقريباً أم بعيداً ستقوم دولة القدس العربية وعاصمتها فلسطين.
■ هل نحن نمارس السياسة كما يجب أم نصب الماء على طاحونة إسرائيل؟
ـ لا أحيانا نخدمهم بالمزاودات غير المسؤولة. العرب في إسرائيل أثبتوا عبقرية نادرة وهم أكبر فرقة مسرح في العالم. منذ النكبة نقوم بدور مسرحي رائع ويمكن لمسرح شكسبير أن يتعلم من فلسطينيي الداخل كيف بقينا في وطننا بذكاء وحنكة سياسية وللأسف يخرج من بيننا من لا يفكر من منطلق مصلحة شعبه، بل يفكر بنفسه بالدعاية والإعلام وبالعالم العربي وكأننا مدينين له. العالم العربي مدين لنا فهو أهملنا وضيعنا وهو الأم التي تركت طفلها بالسرير وهربت. ما حدا يزاود علينا من المحيط للخليج أو «يحملنا جميلة».
■ دورنا ينبغي أن يكون دور المشاغب؟
ـ العبقرية أننا لم ننم بل مارسنا حقنا في النضال وليس بقوانين اللعبة الإسرائيلية، ويوم الأرض يشهد، وهبّة القدس والأقصة تشهد، وفضح مجزرة كفر قاسم وإدخالها للوعي العالمي بل الوعي الإسرائيلي بقوانينا، والهدف البقاء في وطنك بكرامة رُغم مخططات الترحيل.
■ كيف نرد اليوم على الهستيريا العنصرية بالمواجهة أم بالانحناء أمام العاصفة؟
ـ لم نلعب يوماً قطف الرأس ولن يمارسها أبناؤنا. المقصود ليس انحناء أمام العاصفة بل التحصن الذاتي أمام العاصفة والتصعيد الإسرائيلي ليس من اليوم بل من 1948. نحن الفلسطينيون اليوم نحو 20 % من المواطنين ونضع الشوك بعيونهم.
■ ما رأيك بالقول إنه علينا عدم التلويح بمنديل أحمر؟
ـ إسرائيل تتعامل معنا كطوائف لا تعترف بنا كأقلية قومية، ودورنا المسرحي مستمر. جوهر المسرحية: هم نقيضنا ونحن نقيضهم وفرض علينا أن يكونوا هنا والعكس صحيح. الممثل البارع يمسك الشارع والرأي العام العالمي فالانتفاضة صارت كلمة عالمية ويوم الأرض معروف دولياً. الصهيونية تنتصر علينا إذا حولتنا لعنصريين.
■ كيف تنتهي المسرحية؟
ـ «لا يغير الله بقوم حتى ما يغيروا بأنفسهم»، فإذا غّيروا هم نُغيّر نحن. لم نكن مرة عنصريين ولم نرفض اليهود أو الأرمن أو اليونانيين بل حضنا كل الشعوب المحيطة بنا.
■ هناك من يقول إنّ فلسطينيي الداخل سيصبحون مركز الثقل هنا؟
ـ أول مظاهرة بعد النكبة من أجل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني خرجت من الناصرة لا في أي عاصمة عربية. إنّه صراع مكونات ومقوّمات. نحن لا نملك قوة لمواجهة الجيش الإسرائيلي إنّما نملك الحق التاريخي، الوعي، الثقة بالنفس، الإرادة والرؤية. لذا الشعار المناسب في الوقت المناسب هذا هو المفهوم الثوري للشعار الثوري. لا يعقل اليوم أن أرفع الشعار الذي رُفِعَ في الناصرة آنذاك: «تحرير فلسطين من البحر للنهر»، لأننا سنقمع محلياً ونحرّض الديموقراطيين اليهود.
■ هل ابتعدت القيادات عن الناس؟
ـ يبدو أنّ القيادات الجبهوية ابتعدت عن الجمهور بالمعنى السياسي والاجتماعي ولا يكفي أن تقول «أنا على حق وأنا تاريخي معروف»، ولا يعقل أن يصوّت الناس للتاريخ فقط، التاريخ كائن حي متطور.
■ كيف ترى الأمور بين اليوم والأمس؟
ـ للأسف الشديد المقارنة هي لصالح الماضي، لأيام إميل توما إميل حبيبي، محمود درويش، سالم جبران، سميح القاسم، صليبا خميس ومحمد خاص وعصام العباسي. وأرجو أن تستعيد «الاتحاد» عافيتها ومكانتها فهي أكثر من صحيفة بل هي آخر معالم فلسطين الثقافية من قبل النكبة وهي موروث شعبي أكثر ما هي موروث حزبي وعليها أن تبقى معلما شعبيا بتجديد نشاطها وتوسيع اشتراكاتها وتجدد كتابها…حرام والله حرام «.
■ سميح القاسم الشغوف بالحياة.. بأي مدى مسكون بهاجس الموت بعد مرضك؟
ـ لا أريد أن ادعي بطولة غير منطقية. مرض خطير كالسرطان يُهدّد الحياة تهديداً مباشراً لكن لديّ مشاريعي. مشاريع كتابة، أحفاد، بناء وسفر. بدون شك ضايقني المرض لكن بطبيعتي وأنا من برج الثور العنيد جداً قلت بلحظة بدعابة : إشرب.. إشرب فنجان القهوة يا مرض السرطان كي أقرأ بختك بالفنجان ..إشرب «. بعد الفحوصات الطبية لم يصارحني الطبيب العربي فقال مساعده الطبيب اليهودي بعد تردد : نشك أن لديك ورم؟ فقلت يعني: سرطان؟ فأجاب: نشك! عندها قلت: السرطان من ثمار البحر ولا أحب ثمار البحر، أحضر لي سمكة.. ففوجئ وقال: هذه أول مرة أسمع هكذا رد فعل. فقلت: لدي إيمان، فكل نفس ذائقة الموت وسأموت كبقية الناس،هذه قناعة إيمانية منذ طفولتي ورثتها من جدي وأمي ووالدي، وقد خاطبت الموت:
«أنا لا أحبك يا موت لكنني لا أخافك.. وأعلم أنّ سريرك جسمي، وروحي لحافك، وأعلم أني تضيق علي ضفافك. أنا لا أحبك يا موت لكنني لا أخافك».
هذا شعوري الحقيقي فأنا لا أحب الموت لأني أحب أن أعيش ولكن إن جاء فأهلا وسهلا وركبتاي لن ترتجفا هلعاً فساقيي ليستا من قصب.
■ سميح القاسم قلق من قصة تخليده في الذاكرة الفلسطينية؟ يحضرني مسلسل تلفزيوني حول سيرة محمود درويش والذي انتقدته أنت بشدة؟ هل أنت بمأمن من ناحية حضورك في الوعي والتاريخ؟
ـ لا أعوّل المسلسلات ومسلسل محمود إساءة له وللمقاومة ولأدب المقاومة ولفلسطين. أعول على حضوري في عمق هذا الشعب ومن هذه الناحية أنا مطمئن، وكما يقول المثل الشعبي : «حط إيدك على قلبك اللي بتحبه بحبك»، وأنا أحب هذا الشعب ولذا أنا متأكد أنه سيبادني حُبّاً بحُب.
وداعاً بهزّة عنق بائسة لكل الكلمات/ الياس لحود
في أعالي هذا الجبل الشديد الروعة والرسوخ والعذابات، أُطلّ على سميح القاسم الصديق المفارق المباغت قامةً عالية كالأشجار التي تموت واقفة في الحقيقة لا في الكلام.
أطل على وجهك في كل مكان حولي لأناديه بحزمه وعزمه وقوة كلماته ونبضاته، أن يتوقف لحظة ويجيل بأنظارك «وهو قادر على ذلك رغم الفقدان» من أي قمة عظيمة يريدها من هذا الجبل الشامخ الذي يشبهه لكي يرى ويسمع كم هي كبيرة وساحقة عذاباتنا ومواجعنا في هذه البلاد، القاتلة لشعرائها ومبدعيها الصادقين، والمتاجرة بتذكّرهم مقتولين مدفونين في ذاكرتها رأسمالاً مضنياً بدءاً من خير بلاد أخرجت للناس بالكلام الكثير والتاريخ الضئيل والقليل، وحتى خير قصيدة أخرجت للشعر وخير لغة اعطيت لبشر غير مبالين، من رئيس وعتّال وشاعر وقوّال ألخ… من أي قمة تريدها في هذا الجبل المعذب الشامخ من فلسطين …إلى فلسطين. بدائرة مؤلمة من العنق في كل الكلمات إلى العنق.
سميح القاسم، ووجهك أيضاً من بيروت والقاهرة وعمّان وكل مكان أجال فيه بأنظارك وأفكارك وكلماتك وأشعارك في كل الأنحاء راحلاً قبل الآن مبشراً رغم التشاؤم بصيرورة البقاء الخالد حتى في الفناء المحتم… وداعاً سميح القاسم.
٭ شاعر لبناني
مرثية.. لنجم سقط في الأفول/ محمد المحسن
الإهداء: إلى سميح القاسم..في رحيله القدري..
«مختلفون على كل شيء..لنا هدف واحد:أن نكون.. ومن بعده يجد الفرد متسعا لاختيار الهدف» (الشاعر الراحل خلف الغيوم سميح القاسم)
أيّها الموت:
كيف تسلّقت أيّها الموت فوضانا
وألهبت بالنزف ثنايا المدى
وكيف فتحت في كل نبضة من خطانا
شهقة الأمس
واختلاج الحنايا..
ثمّ تسللت ملتحف الصّمت مثل حفاة الضمير
لتترك الجدول يبكي
والينابيع،مجهشات الزوايا..؟!
* * *
سميح:
لِمَ أسلمتنا للدروب العتيقة
للعشب ينتشي لشهقة العابرين..
لٍمَ أورثتنا غيمة تغرق البحر
وأسكنتنا موجة تذهل الأرض
ثم رحلت؟!
فكيف نلملم شتيت المرايا..
نلملم جرحك فينا
وكيف نرمّم سقف الغياب
وقد غصّ بالغائبين؟
فهات يديك أعنا،لنعتق أصداف حزننا
وهات يديك إلينا،أغثنا
لننأى بدمائنا عن مهاوي الردى
فليس من أحد ههنا،سميح
كي يرانا..في سديم الصّمت،نقطف الغيم
ونزرع الوَجدَ
في رؤوس المنايا..
كاتب صحافي وعضو باتحاد الكتاب التونسيين
شاعر الخطاب والحماسة/ صبحي حديدي
بين الثلاثي، توفيق زياد (1029ـ1994)، وسميح القاسم (1938ـ2014)، ومحمود درويش (1941ـ 2008)؛ الذين نُسبت إليهم، وبالتالي تحوّلوا إلى مرجعية نصّية ودراسية لتعريف، الحركة الشعرية التي سيطلق عليها العالم العربي مسمّى «شعر المقاومة الفلسطينية» تارة، و»شعراء الأرض المحتلة» طوراً؛ كان القاسم هو الأغزر نتاجاً: بالكاد بلغ الثلاثين، حين كان قد أصدر ستة أعمال شعرية، أوّلها «مواكب الشمس»، 1958، المجموعة التي ستطلق سيرورة تأليف جارفة جاوزت السبعين عملاً، بين شعر ونثر ومسرح و»سربيات«…
أيضاً، بدا القاسم، أو هكذا بدأ في الواقع، الأكثر حميّة لتحميل القصيدة تلك النبرة الإيديولوجية الصارخة، الخطابية والمباشرة، التي لا تكتفي بإشباع حسّ المقاومة ضدّ المؤسسة الصهيونية، وتثبيت الهوية الفلسطينية، وامتداح أرض فلسطين، واستنطاق رموزها التاريخية والثقافية، كما كان ديدن قصائد زيّاد ودرويش. كان القاسم، في المقابل، لا يجد حرجاً فنياً، ولا غضاضة بالطبع، في أن يكتب قصيدة/ طلب انتساب إلى الحزب الشيوعي، فيمتدح ماير فلنر و»شيوعيين لا أعرف أسماءهم من أسيوط واللاذقية وفولغوغراد ومرسيليا ونيويورك وإزمير، ومن جميع المدن والقرى وأكواخ الصفيح والعرائش… المتشبثة بكوكبنا ـ بكرتنا الأرضية«.
وكان ـ من جهة ثانية، وعلى خطّ انحياز سار، في تلك الأيام، على النقيض العقائدي من التبشير الشيوعي ـ يقول إنّ عبد الناصر هو «مدرّس النضال/ في مؤتمرات السلم، عملاقاً/ وفي مكائد القتال»؛ أو يجزم، متفاخراً ومتكئاً على بلاغة حماسية عالية، ولعلها تبسيطية أيضاً: « مثلما تُغرس في الصحراء نخلة/ مثلما تطبع أمي في جبيني الجهم قبلة/ مثلما يُلقي أبي عنه العباءة/ ويهجّي لأخي درس القراءة/ مثلما تمسح وجه العامل المجهد نسمة/ مثلما يبسم في ودّ غريب لغريب/ مثلما يحمل تلميذ حقيبة/ مثلما تعرف صحراء خصوبة/ هكذا تنبض في قلبي العروبة«.
وثمة رأي يذهب إلى أنّ انغماس زيّاد في العمل السياسي المباشر، الحزبي أوّلاً، ومن قلب الكنيست الإسرائيلي ثانياً؛ وخروج درويش إلى مصر، ثمّ بيروت، حيث اتخذت تجربته الشعرية وجهة تطوير وتعميق مختلفة؛ قد دفع القاسم إلى مزيد من التعلّق بخياراته الأسلوبية هذه، فانكمش فيها وعليها، وبالتالي راوحت السوية الفنية لقصائده في مواقع ساكنة، لصالح النبرة الإيديولوجية والخطابية والسياسية. وثمة رأي آخر، أحمله شخصياً، يساجل بأنّ تطوير القصيدة، في الموضوعات كما في الأشكال (وشعر التفعيلة تحديداً، وحصرياً، للتذكير المفيد) لم يكن هاجس القاسم الأوّل، ولا حتى الثالث أغلب الظنّ؛ مقابل هواجس الذهاب أبعد، ورفع الصوت أعلى، وتشديد النبرة، في منسوب قصيدة سياسية مباشرة، آنية أو لحظية، تعلّق على حدث أو واقعة، وتهجو رئيساً أمريكياً مرّة، أو ترثي شخصية وطنية مرّة أخرى.
وهكذا ظلّت قصيدة القاسم عالقة في إسار وظيفي محدد، صار أيضاً محدوداً في محطات شعرية عديدة، يخدم السياسة، قبل أن يفي فنّ الشعر حقوقه الدنيا؛ ويزجّ بالقاموس الشعري، الذي كان يمتح من معين تعبيري خصب تماماً في الواقع، أسوة بزيّاد ودرويش، في شبكة دلالية ضيّقة وشبه قسرية، تقودها المترادفات التقليدية التي لا تطلق المعنى بقدر ما تثبّت الكليشيه. على سبيل المثال، حين شاء مارسيل خليفة (الذي لا تنقصه الحمية الإيديولوجية، غنيّ عن القول!) اختيار قصيدة القاسم الشهيرة «أمشي»، اضطرّ إلى تعديل السطر الثالث فيها (حيث الأصل يقول: «في كفّي قصفة زيتون وحمامة»)، فحذف «وحمامة»؛ ليس لأنها تعيق الجملة الموسيقية، على الأرجح، بل لأنّ الترادف بين الزيتون والحمامة لم يكن متوافقاً تماماً مع انتصاب القامة وارتفاع الهامة وحمل النعش على الكتف…
يبقى أنّ القاسم يرحل وقد صاغ، ويخلّف وراءه اليوم، ظاهرة شعرية وتأليفية خاصة، متميزة ومنفردة؛ الآن إذْ يلوح أنّ مآلات المشهد الشعري العربي المعاصر قد حسمت، ومنذ عقود ربما، ذلك الالتباس الكبير الذي اكتنف إطلاق مسمّى «شعر المقاومة«. وشخصياً، لا أتردد في وضع هذه السطور، من القاسم، في عداد أصفى، وأرفع، ما أعطت القصيدة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي:
أعطني إزميلك المسكوب من صلب المرارة
لم أعد أقوى بأظفاري
على هذي الوجوه المستعارة
هرّأتْ عظم أصابيعي النتوء الهمجية
في الوجوه الحجرية.
ناقد سوري
سيرة الكنعاني وكعب أخيل/ علي حسن الفواز
سميح القاسم اكبر من ذاكرة شعرية، واكثر اتساعا من حلم يركض كالساعات، لذلك كان يكتب بإفراط حتى يتخلص من وهم الذاكرة، وحتى لا يكون قريبا من شطحات النفري الباحث عن اتساع الرؤيا وضيق العبارة..
ما كان يصنعه سميح القاسم يليق بالشعراء الذين يرممون العالم من خرابه الوجداني واللغوي، اذ ظل يحشو قصيدته بالكثير من الغناء حتى لا تصدأ، مثلما ظل يهرّب قضيته الثورية من الوثائق والخطب والمشاجب ليتركها تمشي في الشارع العمومي، تمارس طقوس شجنها وانوثتها وغزلها، اذ تغوي حولها الكثير من العشاق والمغامرين، اكثر مما تصنع حولها عاصفة خانقة من الثوار الموظفين، والثوار(الكسبة) واصحاب الفقهيات التي لاتصنع وطنا او قبلة او غيمة..
استعادة سميح القاسم بعد رحيله لا تعني اعلانا علنيا عن موته، بقدر ما تعني اعادة قرائته بوصفه جزءا من سيرة الفلسطيني المهاجر، والمنفي، وسيرة البلاد التي تشبه صناديق السندباد القديم.. يكتب للسيرة او يغني لها لافرق، لانه من نمط الشعراء المغنين الذين يمسكون اصابع الموسيقى والقصيدة، ليمارسوا طفولتهم مع فلسطين المكان، وفلسطين التاريخ وقراطيس الرحالة، فلسطين الحاكية لاولادها اسفار المدن المسكونة بالبرتقال، والاساطير التي تركها الفينيقون والكنعانيون عند حافات البحر..
منذ ان كتب(مواكب الشمس) وحتى ماكتبه اخيرا(أرض مراوغة. حرير كاسد. لا بأس)و( سأخرج من صورتي ذات يوم) كان يصطنع للقصيدة وظيفة للشجن والغناء في آن معا، مثلما يضع تلك القصيدة بوصفها وعيا بالاشياء التي تحوطه، بدءا من يانكي المحتل الاسرائيلي، وصولا الى احلام الفلسطيني الطيب بالاطمئنان والحرية والسفر دونما انفاق او حواجز، وانتهاء بكتابه اغترابه الداخلي والوجودي الذي لم يفارقه، والذي ظل يساكنه مثل هاجس او سؤال فادح..
وجد القاسم في علاقته مع صديقه محمد درويش نوعا من التعويض، والمشاطرة في صناعة (الحلم الوطني) اذ تحمل القصيدة غناءها وقلقها وشغفها، لتكون الاقرب الى البندقية والى موجة البحر، فهو لايصنع قصيدته للتهييج القومي، ولا يقدم نصا في الاستلاب، قدر ما يدرك ان القصيدة الجيدة هي ذاتها الموقف الجيد من القضية والانسان.
كانا معا في المشهد، وفي تأمين ممرات سرية للقصيدة والافكار، لتمارس لعبة عبورها بعيدا عن اللصوص والرقباء، وقريبا من يوميات الفلسطيني المكسو بذاكرة الحرب، لتمارس هذه القصيدة بهجتها في اذكاء روح المعنى والوجود، وفي تلمّس التفاصيل واليوميات الغائبة، وحتى استعادة بعض ما تشح به الذاكرة، حيث الام والحبيبة الاولى والرعشات الاولى، وكل ما يمنح الفلسطيني احساسا بانه ذات الكائن الذي يحلم ويحب ويثور، وليس هو الكائن الذي اختزلته الثورة في يوتوبيا المصلوب والمطرود والمخدوع..
هذه الصناعة الشعرية هي اكثر امتيازات سميح القاسم حضورا في يوميات المشهد الفلسطيني في مرحلة مابعد هزيمة 1967، والتي وضعت الشاعر في الخندق وعند الحافة، لكنها ايضا دفعته لان يصطنع لحضوره الشعري امكنة اكثر حميمية، واكثر توهجا..
موت سميح القاسم وفي شهر آب- الشهر الذي مات به محمود درويش ـ يعيدنا الى العتبة مرة اخرى، لكي نقرأ القصيدة والسيرة، وحتى الذاكرة، ليس لاعادة انتاج المتحف الفلسطيني، بل لاعادة تحريك السياق المرعب الذي ترك الكثير من الشعر خارج الحقل والغابة والاصابع..
احسبه كان يعي موته، اذ كان يترقبه بعصا الحكيم منذ سنوات، وكأنه يقول انا الان بساق ثالثة…لقد عرف الموت ان جسدي بات يشبه جسد اخيل، مكشوفا من كعبه لاقواس النشاب، ماعليك ايها الموت سوى ان تقودني الى صديقي انكيدو لنكون معا هناك، حيث نتبادل الحكايات القديمة، ويكون الفلسطيني العالق فينا فينا اكثر اقترابا من الوطن الغائب، والحاضر والباعث على اصطناع سيرتنا الكنعانية التي لا تنتهي…
*كاتب عراقي
الشاعر القومي الرؤيوي/ فيصل القاسم
في عام الفين وستة، وبعد أسابيع على العدوان الاسرائيلي على لبنان، فيما بات يُعرف بحرب تموز، كنت ومجموعة من الاصدقاء بصحبة الشاعر الراحل سميح القاسم في مأدبة عشاء.
راح الجميع – بمن فيهم أنا – يكيل المديح لحزب الله وأمينه العام ويثني على بطولاته ومآثره العظيمة في مواجهة العدو الاسرائيلي وتلقينه درساً لن ينساه في تلك الحرب التي تفاخر بها العرب يومها من المحيط الى الخليج ورفعوا خلالها صور حسن نصر الله من طنجة الى جاكرتا.
لقد كان هناك اجماع بين الحاضرين وبعضهم اعلاميون مخضرمون على أن حزب الله وأمينه العام يمثل نهوضاً عربياً طال انتظاره في تحرير الأراضي المحتلة وبناء أوطان جديدة تقوم على الاستقلال الوطني والعزة والكرامة الوطنية والتحرر من نير التبعية للأجنبي.
ظل الحاضرون يتبارون بكيل المديح لحزب الله، بينما لم ينبس (أبو محمد) سميح القاسم ببنت شفة. بقي صامتاً يستمع بنوع من التأفف والامتعاض. ربما لم يرد أن يزعج الحاضرين، الذين تجمعوا للعشاء على شرفه.
لكن (أبا محمد) الذي لم يهادن احداً في يوم من الايام وتصدى بكلماته النارية لأبشع أنواع الطغيان، تململ في نهاية اللقاء، وقال: «اسمحوا لي يا إخوان أن أختلف معكم اختلافاً جذرياً حول حزب الله وتفاخركم ببطولاته. هذا الحزب يا إخوان ليس حزباً لا وطنياً ولا عربياً ولا قومياً كما تدّعون. وكان بودي أن يكون كذلك، لكنه مشروع ايراني يخدم اجندة قومية فارسية لا تمت للعروبة والقومية بصلة. ومخطئ من يعتقد أن الحزب يخدم اجندة عربية. والأيام بيننا أيها الاخوة. في يوم من الايام ستتذكرون قولي بأن الحزب يخوض معاركه لصالح ايران بالدرجة الاولى تحت شعارات عروبية وقومية زائفة«.
واليوم وبعد حوالى ثمانية أعوام على ذلك اللقاء مع سميح القاسم، كم عدد العرب الذين ما زالوا يعتقدون أن حزب الله حزب عربي قومي مقاوم، وكم عدد العرب الذين يعتبرونه جزءاً من مشروع توسعي استعماري ايراني في المنطقة بعد ان ابتلعت ايران العراق وتغلغلت في سوريا ولبنان واليمن والخليج ووصلت الى المغرب؟
رحمة الله عليك وإلى جنان الخلد أبا محمد.
٭ كاتب واعلامي سوري
حزن دمشقي/ شوقي بغدادي
ها هو سميح القاسم يرحل وراء محمود درويش بأمدٍ قصير وكأنّه كان حريصاً على اللحاق بصديقه ورفيق دربه بأسرع وقت، فيا لبؤس المرض القاتل يحرمنا هذين الشاعرين الكبيرين و فلسطين ما تزال بحاجةٍ إليهما أكثر من أي وقتٍ مضى، فغزة تحترق و الضفة الغربية تترنح و ترتج و اسرائيل غير عابئة بأحد و العالم يتفرج و يتأسف ….
أخطُّ هذه السطور على فراش المرض حزيناً مفجوعاً و دمشق حزينةٌ معي على سميح، أستعيد ذكراه الآن وأنا أنتظر الموت، و الموت يرفض حتى الآن أن يزورني، فكيف أبقى وحدي بعد رحيل معظم أصدقائي .
أتذكر الآن سميحاً و أنا أكاد أصرخ من الألم، أتذكر كيف أهداني وكنّا في الأردن معاً ذات مرة كوفيّةً فلسطينية فاخرة اشتراها أمامي من متجرٍ فاخر، قدمها لي على الفور و هو يقول :
البسها يا أستاذ شوقي مثلي فكلنّا الآن فلسطينيون ! فهل نحن حقاً فلسطينيون مثل سميح القاسم، هذا الشاعر المشتعل حماسةً باستمرار، الشاعر الذي لا مثيل له في توهجه الحماسيّ و شاعريته العنيفة ممن عرفت أو قرأت له من الشعراء العرب المعاصرين .
و أتذكر حين زار دمشق لأول مرة في حياته في أواسط التسعينات كما أذكر، و كيف طُلب مني شخصياً تقديمه في أمسيته الشعرية الخارقة التي أهدانا إيّاها، فقدمته بما يليق به و سهرنا بعدها سهرةً لا تُنسى تألّق فيها سميح أكثر من تألّقه على منبر المكتبة الوطنية الكبرى .
لم يبقَ يا سميح و يا محمود سوى خطواتٍ معدودات ألتحق بعدها بكما فأنا لم أعد أستطيع احتمال العيش وحيداً بعد رحيل سميح و محمود و بعد ما يحدث الآن من فظائع لا توصف في غزة أو في دمشق التي تكاد لا تنام إلا على أصداء دويّ الموت في غوطة دمشق الشرقيّة خاصةً .. الموت .. الموت .. لا شيء إلا الموت يا سميح .
٭ اديب سوري
سميح القاسم يرحل.. آب يُفتت الذاكرة وفي كَفِه قفصة زيتون/ يارا بدر
بيروت- «القدس العربي»: يرحل سميح القاسم وتبقى كلماته: (منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون، وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي). كلمات رددناها أطفالاً ويافعين في مناسبات الحزن والفرح المرتبطة بالقضية الفلسطينية والوجع الساكن في المشرق العربي. عن عمر بعمر الوجع تقريباً رحل القاسم (75 عاماً) والنيران تضرب في غزّة تقاوم الوجع، ودم على كلا الجانبين يسيل. معتقل سياسي سابق، وكاتب للنثر قصة ومسرحاً، وإن برز شاعراً.
عن سميح القاسم قالت الشاعرة السورية رشا عمران لـ»القدس العربي» في شهادة خاصة: «شكّل سميح القاسم جزءاً مُهماً من الذاكرة الشعرية العربية المرتبطة بالقضايا المصيرية الكبرى للعرب، بقصائده ذات البعد الوطني المقاوم التي كانت نموذجاً مُهمّاً لما سُمّي بالأدب الملتزم في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي. كلنا بشكلٍ ما تأثرنا بها، وكان لطريقة القاسم في إلقاء أشعاره ما يناسب تلك المرحلة.
شخصياً التقيته في مهرجان «المتنبي» في سويسرا قبل سبعة أعوام، كنا مجموعة من شعراء قصيدة النثر من ذوي الإلقاء المهموس وكان هو بإلقائه العالي يُحدّد الفرق بين جيلين شعريين عربيين، رحيله اليوم في هذه الظروف الاستثنائية في بلادنا ولاسيما بلاد الشام ربما هو بالمعنى الرمزي جزء من رحيل مرحلة ثقافية بكاملها كانت مسؤولة بشكل ما عن حالنا اليوم عبر تبنيها لإيديولوجيات لم تستطع التأثير كثيراًعلى المستوى التنويري للمجتمعات العربية المتكئة على الغيبي المظلم، بالمعنى الواقعي رحيل أي شاعر حقيقي هو نقص جديد في الأكسجين العربي».
أمّا الكاتب السوري وائل سواح فيقارب في شهادته التي خصّ الصحيفة بها حافة الإشكال السياسي الذي ارتبط باسم القاسم، ولكن بزخم الحالة الإنسانية وعمقها، فيقول: «مات سميح القاسم. كان في موته كما في حياته مثار جدل كبير. البعض تذكر شعره المقاوم في نهاية الستينات ومطلع السبعينات. آخرون لم يتذكروا سوى رثائه للرئيس السوري «حافظ الأسد» في قصيدة عمودية بائسة. ولكن في كل الحالات، وسواء اتفقنا مع شعره أو مواقفه السياسية من الأنظمة العربية أم لا، لا يمكن ألاّ يُشهَد للرجل بأنه قامة وطنية فلسطينية كبيرة. ولا يمكن أن ننسى المرحلة الذهبية عندما كان هو ومحمود درويش وتوفيق زياد يحركون ملايين العرب بقصائدهم المقاومة.
يا عدو الشمس إني/ لن أساوم/ وإلى آخر نبض/ في عروقي سأقاوم.
زياد رحل باكرا. درويش تعملق حتى طغى على المشهد بأكمله، أما سميح القاسم، فاكتفى من الوطن ببيت صغير ومكتبة كبيرة وحُبٍّ لا ينتهي لفلسطين. رحمه الله».
خلف حديقة سميح القاسم/ عبد الدائم السلامي
إن سيرة معاني سميح القاسم لا تحتاج منا إلى تذكير، فهي محمولة في قصائد طالت بقاماتها هامات السماء العربية، ومثّلت في ذاكرة الناس أيقوناتٍ باذخةٌ سيمياؤها الوطنيةُ والعروبيةُ والإنسانيةُ.
ومن ثمة، لا نخال هذا الشاعر سيفرح كثيرا بمديح نقوله فيه وإن كان من باب الحقّ. ونزعم أنه لو لم يتيقّن من كونه قد اكتمل في الأرض بكلّ أوجاعه وأفراحه وبجميع انتصاراته وانهزاماته في الحياة وفي الكتابة لَما رحل عن الدنيا، نقول هذا لإدراكنا حجمَ إصرار الشعراء على الحياة، ألم يكتب: «أنا لا أحبك يا موت/ لكنني لا أخافك/ أعلمُ أنّي تضيق عليّ ضفافك/ وأعلمُ أن سريرك جسمي/ وروحي لحافك/ أنا لا أحبك يا موت/ لكنني لا أخافك»، متحدّيا بذلك استشراء مرضه العضال في جسده، لا، بل ويدعوه إلى أن يشرب معه قهوة ليقرأ بختَه: «اشربْ فنجانَ القهوة/ يا مرض السرطان/ كي أقرأ بختك في الفنجان». لقد اكتمل سميح القاسم مشروعا شعريا رفد الشعرية العربية بمعين قوَّى فيها حضور أفهومات الوطن والمقاومة والممانعة وغيرها مما أُغرمت به قصائدنا العربية منذ ستينات القرن الماضي ومثّل فيها ثيماتها الأثيرة.
ولأنّ أثرَ مديح الأموات شبيه بأثر القدح فيهم وهم أحياء، فضّلنا أن ننظر إلى جهة أخرى من سيرة هذا الشاعر، وهي جهة علاقته مع الشاعر محمود درويش. والذي في رأينا أنّ الصداقة والأخوّة اللتيْن جمعت بينهما تُخفي ملامح «عقدة» شعرية لدى سميح من درويش، وصورة ذلك أنّ الشهرة التي نالها محمود درويش غطّت في كثير من الأحيان شهرة القاسم، وهو أمر نلفي له إشارات موحية في كثير من كتابات سميح القاسم أو حواراته. فهو يستثمر المُتاح من فضاءات القول ليُذكِّرَ بحميمية صداقته لدرويش، ولكنه يزرع في خلال ذلك بعض المعطيات التي تشي بكونه يرى في نفسه «الأب» الذي يحمي درويش و«المعلّم» الذي يُلهمه المعنى، على غرار قوله في حوار أجراه معه صحفي تونسي: «محمود درويش ليس صديقي اللدود وإنما هو صديقي العزيز وهو أخي الأصغر وهو تلميذي في الحياة والهم الإنساني وشريكي، وفي حياته كنت أداعبه وأقول له أنت أخي الأصغر». بل إنّ سميح يكشف عن كونه أكثر فهما للحياة من درويش، ولا أدلّ على ذلك من قوله: «محمود كان خجولا قليلا، ومحبا للسيدات الأكبر منه سنا، الناضجات، ومنطويا قليلاً ولا يشارك مثلا في حفلات الرقص، أما أنا فكنت أفضل أن أكون الراقص الأول في حفلات الرقص، مولع بالرقص الشعبي والصالوني» ، بل إن سميح القاسم يميل إلى الاعتقاد بأنه أوعى من درويش بعلاقة القصيدة بجمهورها العربي، حيث لا يني يذكر أنه هو مَن اقترح على درويش تغيير اسم «إيريس»، وهي حبيبة درويش الحيفاوية التي يصفها بكونها غير ناضجة فكريا وسياسيا، باسم «ريتا»، لأنّ «اسمها فيه إشكالية بالنسبة لنا كعرب فاقترحت عليه تغيير الأحرف فصارت ريتا، وقبل محمود ذلك».
كاتب عراقي
شاعر القضايا الكبرى/ ديمة الشكر
لسميح قاسم صورة الغياب والذكرى الحامضة قبل هذا اليوم في قلوب السوريين. السوريون هم أصحاب الحديقة الخلفية للحداثة الشعرية العربية.
فمن هذا المكان الذي يمكن وصفه برهين المحبسين – تيمناً بابن المعرّة «أبو العلاء» – ؛ الاستبداد والضحية، أتت أكثر الاقتراحات تنوعاً وأصالةً؛ ما بين غزليات نزار وقصائده السياسية، وتوتّر أدونيس النابِش دوماً في التراث، عاشق الصدمات والجدل (وإن كان عقيماً)، إلى اقتراحات سليم بركات التي تعلّم الخيال التواضع أمام سيل الصور الساحرة، وأمام تلك اللغة التي لا حدّ لجمالياتها، إلى المدلل الأشهر محمّد الماغوط، المتبرم ذو الصوت الجارح، والأكثر شطارةً في التقاط المفارقات، إلى سلسلة لا تنتهي من الشعراء السوريين، لكلّ منهم صوته الخاصّ، ومريديه من جمهور حقيقي لقراءة الشعر.
ولسميح قرّاء سوريون كثر، سميح الذي ارتاح كثيراً إلى صورته كـ»شاعر مقاومة»، ونظر إلى نفسه باعتباره منقذاً أبدياً، لا يتردّد في مخاطبة الجميع (وقد دمج الفلسطينيين والعرب معاً) بـ : يا «أيّها النيام». وقد ظنّ لوقتٍ طويل، أن في وسع القصيدة أن تحرّر الوطن (والتعبير لمواطنه الناقد الكبير فيصل دراج في وصف شعر معين بسيسو)، وكتبها وفقاً لهذا. قصيدة سميح بين بين، فلا هي كلاسيكية ولا هي حداثية. إنها القصيدة السردية بامتياز، تتعدّد شخوصها الموزعة في الغالب إلى خيّر وشرير، وإذ يترافق ذلك مع نزعة الشاعر في تصوير نفسه كمنقذ، مالت قصائده إلى استعمال الضمائر بصيغة الجمع : نحن وأنتم، لكأنّه ناطق باسم جماعة بذاتها في وجه جماعة أخرى. وإذ غدا سهلاً التعرّف إلى هاتين الجماعتين (الفلسطينيون والعرب من جهة، والاسرائيليون من الجهة المقبلة)، صار من الممكن له جذب -في بداياته خصوصاً-جمهورٍ من القرّاء (الذين تناقصوا على مرّ الأيام). ولعلّ هذا الجمهور أثّر بصورة حاسمة في نفسه، فرفع الكلفة بينه وبين قارئه إلى أن غدا يكتب وفي ذهنه قارئ يطرب لقصيدةٍ مُفحمة عن بطولةٍ ومقاومة تجيئان من ذاك البلد الصغير النحيل الأسير: فلسطين.
وارتاح القاسم أيضاً إلى أولى إنجازات التحرّر من القصيد (الشطرين المقفى)، وبقي هناك، غير قادر على التخفّف من مكر الجمل القصيرة في التحول بسهولة إلى أغانٍ مقفاة، ضاجّة بالرنين. وقد مكرت به القوافي وأخواتها من التجانس اللفظي بقوّة، هو الذي -كما قال في حواره الأخير في جريدة القدس- كان عاشقاً للرقص بأنواعه، لكنه بإصراره على خيارٍ مماثل، كشف مثالب الإيقاع المفتعل، ما حدا بغيره من الشعراء الممتازين إلى الابتعاد عن هذا الطريق الذي لا تفضي الخطوات فوقه إلى هدف جمالي وشعري معتبر. وإذ توضع اليوم قصائده في ميزان الشعر، فالظنّ أنه لا يربح أكثر من النغمات الحماسية، والصورة المحنطة لشعراء المقاومة. أمّا في الميزان السوري، فيلتحق سميح بقطار الشعراء الذين خيّبوا أمل أكبر جمهورية لقرّاء الشعر : الجمهور السوري، ابن الحديقة الخلفية للحداثة الشعرية العربية، الجمهور الذي يقرأ سميح، ثم ينظر إلى غزّة المتهالكة من التهديم والتكسير، ويرى ضحايا يشبهونه، ينهضون مثله من الركام، ويصرخون أمام شاشات التلفاز، فتختلط الأمور بين السوري والفلسطيني، بين غزّة وحلب. لكن الصوت الصارخ في قصيدة سميح ينأى عن المشهد. فلسطين في قلبنا أجمل من صورتها في قصيدته، فلسطين أخت سورية في اللفظ (سورية الجنوبية) وفي المقاومة والموت وكل الناهضين من الركام، وفي كل شيء.
ناقدة سورية
سميح القاسم : الإنسان أولاً
البيان ما قبل الأخير
علي مجيد البديري
لم يكن سميح القاسم مبالغاً في جوابه عن سؤال محاوره فيما يخص هيمنة البعد الإنساني على أبعاد الخطاب الأخرى في قصائده المقاومة، حين قال أنا مؤسس نظرية أنسنة العدو في الشعر مشيراً إلى نص قديم كتبه في بداية تجربته الشعرية عن جندي عربي يقول عن عدوّه: «بادلتُه تبغًا بماء».
لقد كانت حركة الإنسان في شعر سميح القاسم دائمة ، حتى حين تخفق الأشياء في محيطه في أن تكون فاعلة أو نابضة بالحياة ، فعبر الإنسان تمر الأمكنة وتتشكل ملامحها ، وهو من يمنح الزمن هويته ويرسم حدوده ، وتصير إرادته قطباً محركاً للحياة .. وفي بعض صور الاستلاب التي يعيشها الإنسان قسراً وظلماً تتعدى وظيفة الانسان في قصائده حدود تجسيد الألم ووحشية المحو التي يقاسيها وإبرازه لهذه المعاناة إلى فعل التغيير ، فهو الإنسان وما عداه أدنى منه وجوداً وفاعلية وحضوراً . وإن مساحة حضوره متسعة ، تبدأ من العلاقة مع الذات ، وتتوزع بين الآخرين والأشياء بلا حد أو نهاية . فالآخر متعدد ، ممتد يمتلك تاريخا ومدى يحدد هويته ، وكذلك الشيء. وإنسان قصائد القاسم يحاور مفردات هذا المحيط ويتفاعل معها.
حرصت قصائد سميح القاسم على الارتقاء بصوت الإنسان وإعلائه قوةً مؤثرةً , وفي الوقت الذي يقتحم الرعب القادم بصورة قوةٍ سلطوية وجودَ الإنسان محاولة مسخه وتعطيله وتجريده من إنسانيته ، يلجأ الإنسان إلى مقاومته بالأمل والحلم الجميل كأضعف أداة يمكن أن يستعملها الأعزل المحاصر ، فيرسم الحياة البديلة لواقع يحتضر ، و طالما نجحت مهمته في ذلك ، ولم يقف عاجزاً أمام هوة التضاد ما بين صور الموت / صور الحياة ، .. صورة الوطن المستلب تحاول أن تؤكد حضورها على الرغم من فعل التشويه والتنكير الذي يمارسه العدو .. يكون الوطن لساناً ناطقاً قبالة الإسكات ، على وفق دلالة يكون فيها فم الوطن ثباتاً واستمراراً عبر اللغة / الهوية:
«فإن طريقنا الممتد / الى أروع ما في الغد / يجوبُ مفاوز الميراث من مولدنا الماضي / ويصعد.. عبر انقاضِ / يقبّل كل نصب المجد بين مقابر الاجداد / ويتركها.. بلا ميعاد».
كلمة الإنسان تنفتح على وجوه المقاومة ، المقاومة بما هي تأكيد لإنسانيته ، فهي لا تعترف بالطارئ من الصفات والأحوال كالقومية والعرق والطائفة :
«في كفي دفء من كفك / في قلبي صوتك (إني في صفك)/ وهتافك (إني معكم يا إخوتي الشرفاء) / قسماً بالشمس / معاً سنفك من الأسر الدامي الشمسا» .
كاتب عراقي
سميح القاسم .. العروبي والحداثي/ أماني أبو رحمة
يمكنني القول إن خصوصية الراحل سميح القاسم تكمن في جملة قضايا. أولها أن الشاعر فضل البقاء في الأرض المحتلة ولم يغادرها حتى وافته المنية.
وأقول هذا ليس تعريضا بأحد فلكل دوره، ولكن وجوده في الداخل كان بالغ الأهمية ؛ إذ أن كل قصيدة تصدر له أو كل مجموعة شعرية كانت تذكر بأهلنا هناك ، خصوصا في مرحلة حاول الجميع النيل منهم أو تجاهلهم. الشاعر العروبي العملاق الذي لم يتنازل ولم يهادن ولم يتراجع عن مواقفه كان صوتهم الهادر.
صوت صمودهم وتمسكهم بعروبتهم وفلسطينيتهم ورفضهم للانتماء للدولة العبرية حتى لو اضطروا لحمل جنسيتها بحكم الأمر الواقع. الشاعر هنا كان صادقا في شعره وفي انتمائه. كان الشعر معاناته الخاصة ومعاناة شعبه الذين لم يخذلهم أبدا. كان جسر الجمال بين من بقوا وبين من هُجروا وبينهم وبين العرب والعالم كله . هذا فضلا عن أن وجوده في الداخل حماه من أي تورط في موقف سياسي من أي نوع. فبقي انتماؤه لفلسطين وحدها ولشعبها المحتل والمشرد. ومن ناحية نقدية بحتة كان القاسم أكثر الشعراء الفلسطينيين الذين كتبوا عن القضية أو كانت هي أهم موضوعاتهم ، كان أكثرهم ميلا إلى التجريب والتجديد. ففي حين أن درويش ، رفيق دربه وصديق صباه حتى افترقا حين قرر الأخير مغادرة الأرض المحتلة الى المنافي ، أقول في حين أن درويش حاول الابتعاد عن معظم تقنيات ما بعد الحداثة الادبية واحتفظ لنفسه بخط قصيدة السهل الممتنع، نجد أن القاسم أهم شعراء ما بعد الحداثة الفلسطينيين وربما العرب. كان مكثرا وفي الوقت ذاته كان مجربا، ففي كل مجموعة تغيير وتطور ملحوظ وتقانات وأخيلة وصور معجزة ورؤى استشرافية جعلت منه الشاعر الرؤيوي الأكثر بصيرة وصدقا والشاعر ما بعد الحداثي الاكثر فلسفة وعمقا وتجريبا. كان القاسم واسع الثقافة غزير المعرفة بالقديم والجديد على السواء. فوظف ثقافته وروحه الجميلة وموهبته لصالح شعره فكان بالفعل كما قال في حوار «الشاعر تصنعه قصيدته ولا شيء آخر». وبذلك استحق جملة ألقاب أطلقها عليه نقاد كبار جاء معظمها من هذه الزوايا تحديدا. وعلى الصعيد ذاته كان من الممكن لهذا التجريب والتعقيد احيانا أن يبعد الشاعر عن الجماهير فيتحول الى شاعر فلسفي نخبوي غير مقروء من العامة أومن القارئ بسيط الثقافة والمعرفة ولكنه، وبسبب التصاقه بشعبه وجمهوره، ولأنه يعلم أهمية أن يتداول العامة شعره الثوري المقاوم، كتب أيضا مجموعة من القصائد الغنائية الشفافة الجميلة، غناها فنانون معروفون فأصبحت كالنشيد الوطني للجماهير العربية. كل ذلك جعل من صاحب (منتصب القامة أمشي) قامة وطنية وفنية وانسانية عالية لا تضاهى .
عزاؤنا في الشاعر هو قصيدته التي ستخلده إلى الابد.
الشعراء لا يموتون. كل قصيدة تعيدهم الى الحياة كلما قرأها قارئ في أي مكان .
لروحه الرحمة وللشعر الخلود والتجدد والعزاء الجميل.
كاتبة فلسطينية
شعراء لبنان يودعونه: في أعالي قامتك الشعرية ترحل/ زهرة مرعي
من أعالي هذا الجبل الشديد الروعة والرسوخ والعذابات، أُطلّ على سميح القاسم الصديق المفارق المباغت قامةً عالية كالأشجار التي تموت واقفة في الحقيقة لا في الكلام. أطل على وجهك في كل مكان حولي لأناديه بحزمه وعزمه وقوة كلماته ونبضاته، أن يتوقف لحظة ويجيل بأنظارك «وهو قادر على ذلك رغم الفقدان» من أي قمة عظيمة يريدها من هذا الجبل الشامخ الذي يشبهه لكي يرى ويسمع كم هي كبيرة وساحقة عذاباتنا ومواجعنا في هذه البلاد، القاتلة لشعرائها ومبدعيها الصادقين، والمتاجرة بتذكّرهم مقتولين مدفونين في ذاكرتها رأسمالاً مضنياً بدءاً من خير بلاد أخرجت للناس بالكلام الكثير والتاريخ الضئيل والقليل، وحتى خير قصيدة أخرجت للشعر وخير لغة اعطيت لبشر غير مبالين، من رئيس وعتّال وشاعر وقوّال ألخ… من أي قمة تريدها في هذا الجبل المعذب الشامخ من فلسطين …إلى فلسطين. بدائرة مؤلمة من العنق في كل الكلمات إلى العنق.
سميح القاسم، ووجهك أيضاً من بيروت والقاهرة وعمّان وكل مكان أجال فيه بأنظارك وأفكارك وكلماتك وأشعارك في كل الأنحاء راحلاً قبل الآن مبشراً رغم التشاؤم بصيرورة البقاء الخالد حتى في الفناء المحتم… وداعاً سميح القاسم.
جودت فخر الدين: لسميح القاسم ذكرى طيبة في نفسي. فقد التقيته مرة في عمّان وترافقنا على مدى عدة أيام واكتشفت في شخصيته الدماثة واللطف والأنس. سميح القاسم من أكثر الشعراء العرب حماسة واندفاعاً للقضايا الكبرى، وفي رأسها القضية الفلسطينية. لقد ارتبط اسمه باسم محمود درويش ولكن كان لكل منهما عالمه الشعريُ الخاص. سيبقى سميح القاسم علامة فارقة في الشعر الفلسطيني والعربي.
زاهي وهبي: يمثل سميح القاسم صوتاً بارزاً من الأصوات الجميلة والنبيلة لفلسطين. حمل قضية وطنه وشعبه بشعره، وكان مثالاً للشاعر المقاوم للاحتلال، وفي الوقت نفسه مقاوماً لكل أشكال الخراب وكل اشكال التخلف. تميز شعره بنبرة عالية وصوت مرتفع، وبدعوة قاطعة وحاسمة للمقاومة والتصدي للعدو الإسرائيلي، ولعدم التخاذل والمساومة، وأكثر ما تجلى ذلك في قصائد مثل «يا عدو الشمس» و»تقدموا» وغيرها من القصائد الكثيرة التي كتبها سميح القاسم. عندما نتحدث عن سميح القاسم، فنحن نتحدث عن الشاعر الفلسطيني الذي شكل قيمة مضافة للقضية الفلسطينية، وحمل فلسطين وقضيتها لكافة أرجاء الدنيا. بالحديث عن سميح القاسم فنحن نتذكر محمود درويش وتوفيق زيّاد ومعين بسيسو وغسان كنفاني وكافة الكتاب الذين شكلت فلسطين ينبوعاً غرفوا منه، وكان حبرهم ممزوج دائماً بالمياه الصافية العذبة التي هي مياه الذاكرة، التاريخ، والحاضر المقاوم والمتصدي لهمجية الاحتلال الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه يمكننا القول أن شعر سميح القاسم العالي النبرة، ويدعو دائماً إلى المقاومة وإلى مواجهة المحتل، لكنه لم يتخل عن الجماليات الضرورية للقصيدة، ولم يتخل عن الصورة الشعرية الجميلة والعميقة. المجاز والاستعارات والتشابيه موجودة بقوة في شعر سميح القاسم. أعتقد أن سميح القاسم كان مدركاً لمسألة أساسية هي أن الشعر الذي يُكتب لقضية نبيلة ولقضية كبيرة بحجم القضية الفلسطينية عليه أن يرتقي وأن يكون زاخراً بالمضامين الانسانية والجمالية التي تميز الشعر عن كافة اشكال الخطابة أو أشكال التعبير المباشر. والملاحظ أن سميح القاسم وبنفس الطريقة التي قاوم فيها الاحتلال قاوم مرض السرطان الخبيث. فالاحتلال خبيث وكذلك السرطان، وهو قاوم خبيثين بأنفة وكبرياء وشموخ ولم ينكسر حتى الرمق الأخير. يرحل سميح القاسم جسداً ويبقى حاضراً في الكلمة والقصيدة والأغنية والرصاصة.
مروان عبد العال: رحل اليوم متنبي فلسطين الذي استحق عن جدارة لقب شاعر المقاومة الفلسطينية. شاعر الرفض وشاعر الأرض وشاعر العشق الذي يمضي منتصب القامة ومرفوع الهامة مثله مثل شعبه. كان الابن البار للرامة، للجليل ولفلسطين، وكان صوتها على مدى عمر كل هذه التجربة الكفاحية الطويلة للشعب الفلسطيني. إذ نودع اليوم مع كل ابناء شعبنا هذا الشاعر الذي حمل قيمة جمالية عالية ورفيعة، والذي لا شك أننا الآن وغداً وإلى الأجيال القادمة سنبقى نردد الكلمات التي كانت بمثابة رسالة قوية وتوازي الرصاص، والذي يعمل من أجل حرية هذا الشعب ومن أجل المقاومة. ولا شك أننا من الجيل الذي تعلم وهو صغير تلك اللكمات التي تشبه الصخر يحملها سميح القاسم ويعلمها لكافة الأجيال، ومنها «ربما افقد ما شئت .. معاشي.. ربما اعرض للبيع ثيابي وفراشي.. لكن يا عدو الشمس لن أساوم.. إلى آخر نبض في عروقي سأقاوم«.
الطفل الذي قاوم الموت بصوته ليهزمه لاحقا بشعره
تونس ـ من حسن سلمان: يبدو أن سميح القاسم الذي ارتبط اسمه لعقود برفيق دربه محمود درويش ليشكلا معا «شطري البرتقالة الفلسطينية» في كفاحهما المستمر لاستعادة الروح الفلسطينية والهوية المشتتة في أقطار عدة، قرر أخيرا الرحيل إليه ليبقى اسمه راسخا في ذاكرة الملايين الذين طالما رددوا قصيدته الأشهر «منتصب القامة أمشي«.
غير أن رحيل الطفل الذي انتصر على الموت باكرا بصوته ليهزمه لاحقا بشعره، ترك صدمة كبيرة لدى معظم المثقفين العرب الذين رأى بعضهم أن الأوطان تفقد بعض روحها برحيل أحد شعرائها، لكنها تُبعث من جديد بأصوات أخرى تجدد كينونتها التي تأبى الزوال.
زهور كرام: رحيل قيم ومعنى وهوية وطن
وقالت الأديبة المغربية زهور كرام إن الموت «قدر وجودي، قد يحدث ألم الفراق، ثم يندثر مع النسيان، لكن حين يحمل الموت معه رحيل قيم ذات علاقة بمرحلة، فإنه يصبح خسارة وجودية، لأنه يعني رحيل المعنى. وتكبر الخسارة حين تكون اللحظة التاريخية الراهنة تنزف التباسا«.
وأضافت لـ»القدس العربي»: «مع رحيل سميح القاسم نفقد من جديد مثلما حدث مع رحيل محمود درويش مجموعة من القيم الجمالية والإبداعية والوجودية. نفقد هذا الوصال الصوفي بين الإبداع والقضية، والذي جعل فلسطين هي القصيدة والقصيدة هي فلسطين، وحين كبرنا على إيقاع هذا الوصال، رمينا خلفنا كل الأوراق السياسية تلك التي تصاغ في أروقة المنظمات الدولية، وآمنا بالوصال انتماء ولغة وعشقا، ولذلك بقيت فلسطين صخرة راسخة في وجداننا وسؤالنا وذاكرتنا، لن يغير موقعها تبدلات أروقة المنظمات الدولية، وتخاذل الانعطافات التاريخية«.
ورأت كرام أن فلسطين «تقيم تاريخا وهوية وشعبا وحكاية وطن بقصيدة سميح ودرويش، وبوجداننا وعقلنا. تفقد القصيدة هذا التماهي المبدع بين الشعري والسياسي والوجداني والتاريخي. لأن سميح لم يكن ينظم الشعر كلمات، إنما الشعر قضية تختزل حكاية وطن. لهذا، نجد بقصيدته التاريخ « أتُراك تذكرُ ؟.. آه .. يا ويلي على مدن الخيام»، والطفولة والجغرافية وإيقاع الأغاني التراثية الفلسطينية والعشق والشموخ» منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي«.قصيدة بحجم الوطن«.
وأضافت «نفقد مع رحيل سميح القاسم هذا التماهي البليغ بين الشاعر والجمهور، أو بين القصيدة والمتلقي. تماهٍ بدأ يخفت حين غادرت قصيدة هذا الزمن الإقامة في القضية والسؤال. نفقد معنى القصيدة- الرصاصة، حين تتحول الكلمة إلى بندقية، يُرعب نظمها، وإلقاؤها العدو، ويصبح مولد قصيدة ، موطنا للقهر والتحدي. إنه رحيل قيم ومعنى وتاريخ الشعر العربي الذي ما خان القضية حين أقام فيها«.
يوسف رزوقة: منتصب القامة لم يعش ليشهد انتصارا فلسطينيا
وقال الأديب التونسي يوسف رزوقة «سميح القاسم شاعر كبير آخر يغادرنا في ذمة الخلود ليظل في القلب والذاكرة، كان شاعرا مقاوما ومناضلا امتلك أحقية حضوره عربيا، وأمكن له أن ينتصر لقضيته العادلة والتي ظلت في العمق منه سؤالا حارقا لا يني (لا يزال) يمثله في مصيره وحياته«.
وأضاف لـ»القدس العربي»: «غادرنا سميح بعد أن كان وظل منتصب القامة يمشي وهو عنوان مسيرته الذاخرة التي قاوم فيها الآخر والمهيمن وأمل أن يعيش انتصارا فلسطينيا لكن الموت حق فاجأه في فترة حرجة وظل صوته يتجدد في أقرانه من الشاعراء الذين بكوه بعمق لأنه كان شاعرا صادقا وكبيرا في رؤيته لقضيته العادلة«.
صقر عليشي: درويش انتبه.. جاءك النصف الآخر من البرتقالة
وقال الشاعر السوري صقر عليشي «هاهو سميح القاسم يمضي أيضا… أحد أصوات فلسطين القوية والتي افقنا على الدنيا ونحن نسمع دويها في نزال مستمر مع المحتل الشرس، وشكل – فيما شكل- جزءا مهما من ذاكرتنا الشعرية المقاومة، تجربته أكثر ميلا إلى الصوت الجهوري من الصوت الخافت، وكأن قربه من هذا العدو الشرس والتحامه الدائم معه لم يترك له فسحة للهدوء، وللكتابة بشكل اخر، كان محاربا وشاعرا في آن معا«.
وأضاف لـ»القدس العربي»: «رحل سميح القاسم أحد الحراس الكبار للحقيقة، أحد رموز الصدق والوجدان، أحد الذين حاربوا بالشعر، أحد الذين تركوا ضوءا على هذه الأرض. محمود درويش انتبه… جاءك النصف الآخر من البرتقالة«.
زهور العربي: رحل صاحب الحرف المقاتل فلا تخونوه ايّها الشّعراء
وقالت الشاعرة التونسية زهور العربي عن سميح القاسم «إنّه آخر الشعراء العمالقة يترجّل ، نجم يأفل ونحن في أمسّ الحاجة اليه، فماذا بقي للقصيدة ؟ وهل سيجود الشّعر بمثل القاسم؟ لكن يبقى عزؤنا الوحيد انّه رحل «منتصب القامة مرفوعة الهامة» ولم تحنه الخطوب ولا تردّده على السّجون ولا توقيفه عن العمل ولا الاقامة الجبريّة عن عقيدته النضاليّة المتأصّلة فيه«.
وأضافت لـ»القدس العربي»: «كانت التهمة الوحيدة لسميح «حرفه» الرّصاصة الحيّة الثّاقبة التي كانت تصيب دائما مرماها فتطلق الحناجر وتفكّ عقال الفكر وتوحّد صفّ الشّعب وفي المقابل تقضّ مضجع الكيان الصّهيوني المغتصب«.
وأشارت إلى أن سميح رغم تفرّغه التام للثّقافة لم تفارقه السّياسة فـ»حرفه سياسة وتألّقه واصداراته المختلفة بين النثر والشعر المسرح والجوائز التي حصدها كلّها ذات طابع سياسي«.
نصري حجاج: آب.. شهر الوجع الفلسطيني
وكتب المخرج الفلسطيني نصري حجاج على صفحته بموقع فيسبوك «حين يموت شاعر/ نحزن على الكلمات/ التي تُركت تنتظر على عتبات بيته/ أو على الرصيف/ أو في حدائق الوحي/ أو في دار للأيتام/ مرتعشة القلب/ خوفاً من فراغ العالم/ من الشعراء«.
ووصف صاحب فيلم «كما قال الشاعر» الذي يوثق مسيرة الشاعر الكبير محمود درويش، شهر آب/أغسطس بأنه «شهر الوجع الفلسطيني»، مشيرا إلى أنه في ذات الشهر سقط مخيم تل الزعتر في بيروت (1976) ورحل رسام الكاريكاتير المعروف ناجي العلي (1987)، كما رحل اثنان من كبار شعراء المقاومة محمود درويش (2008) وسميح القاسم (2014).
وداعا أبا وطن/ صالح الرزوق
من أهم الأصوات الشعرية التي ظهرت في فلسطين يأتي صوت المرحوم سميح القاسم الذي وافته المنية من أيام.
لسميح القاسم دور متميز في الانتقال بحساسية الشعر العربي من المحلية إلى العالمية و من طور الاعتماد على الذات و المكونات أو الينابيع لطور تكوين الينابيع.
لقد اتسمت فترة سميح القاسم بالغليان و مساءلة الذات و البحث عن معنى ما نسميه «مشروعا شعريا».
و فرض ذلك مواجهة عدة تحديات جسيمة. أولها يمثلهالجيل السابق أو جيل النكبة، و من رموزه إبراهيم طوقان الذي له وظيفة واحدة و هي استنهاض الهمم و التحفيز و ذلك بأسلوب إيقاعي لا تنقصه أخلاق الفرسان و المغامرين.
كان اتجاه التصعيد عند طوقان و أبناء جيله انتحاريا. و تحركه رضة الفطام أو الخوف من الابتعاد عن « أمه الأرض»، مهد الطفولة و الحضن الدافئ. و أضيف أيضا الابتعاد عن صورة الأم الطيبة التي يشكل تفكيكها في الخيال أو ذهن المكونات نوعا من النوستالجيا و الألم و المكابدة.
وأنا لا أرى فارقا ملحوظا بين هذه الروح الانتحارية نتيجة ضياع الأرض ( كناية عن الوطن) و بين الكبت المرضي الذي يتفاقم عند شعراء لديهم عقدة تثبيت من أمثال جون أشبري. فكل قصائده نحيب و بكاء صامت على الخميلة التي التهمتها أوبئة مجتمع صناعي ربوي.
و كانت مهمة سميح القاسم تتلخص بتجاوز هذه المحنة و بإعادة اكتشاف الطبيعة الإشكالية لوجود يتبدل شئنا أم أبينا.
لقد حاول سميح القاسم أن يتعامل مع تبديل الموضوع بتبسيطه، و بتبديل موقع الذات من هذا الموضوع.
و قد فرض عليه ذلك إعادة تعريف معنى السقوط في الفجوة و تفكيك عناصر الموجودات ثم صياغتها: كل على حدة. بحيث كل عنصر يكون موضوعا لذاته.
و لمزيد من التوضيح: لقد حاول أن يضفي شيئا من الوعي على استقلالية الأجزاء. و عليه نظر للعالم كوحدات مغلقة و مترادفة. و قاده ذلك لدمج عدة أساليب شعرية في إطار قصيدة لها مضمون عضوي، كما فعل في (كولاج ) و في (جهات الروح).
و عن ذلك يقول الشاعر اليمني عبدالله العذري في مقدمته لكولاج: إن بعض النماذج الجديدة تستعمل جمع عدة مواد مختلفة الصفات و الأغراض في العمل الواحد. و يضيف: إن أحد الشعراء العرب الذين عاشوا في القرن الثالث الهجري لجأ لهذه الطريقة في الشعر و النثر. و قد صنفه النقاد القدماء في باب « الحماقات». ص١٠.
و من نافلة القول إن هذا الأسلوب ( استثناء المركز من الطغيان على الأطراف من خلال التنويع في البنية ) انتشر منذ وضعت الحرب الثانية أوزارها، و لا سيما في الفن التشكيلي و العمارة الحديثة. لقد تحولت وحدة الكل لترادف الأجزاء. بمعنى أن اللوحة الواحدة بدأت تستعمل عدة مصادر ( ميديا مختلفة). ففي لوحات الفنانة الهولندية غيتا باردويل مثلا أو لوحات الصربية ناتاشا سكوريك تتآزر طوابع البريد و الجص و الخشب و ورق الصحف و المعادن في صناعة الصورة النهائية للوحة.
لقد جدد المرحوم سميح القاسم بنية القصيدة العربية. فقد فكك مفهومنا الكلاسيكي للحداثة و أعاد صياغته ضمن رؤية متعددة المراكز، ليس فيها غالب و لا مغلوب. و لا ترفض القديم بأساليب حداثة مكفهرة و مشاكسة. بالعكس لقد أعاد للقصيدة العمودية تألقها من خلال عمليات التحويل و الإنضاج و التطوير.
لا شك أن محمود درويش لعب دورا هاما و رياديا في تفتيح براعم الشعر العربي. و لا سيما بعد حصار بيروت. فقد تحول من كتابة القصائد لكتابة القول الشعري. و اعتمد لتحقيق ذلك على تبديل العلاقة بين الصفة و الموصوف و الإسم و المسمى. و أجاز للألوان أن تتجاور ضمن علاقات تشكيلية يحركها منطق نفسي.
و قل نفس الشيء عن توفيق زياد الذي وافته المنية في أعقاب معاهدة أوسلو مباشرة. فقد تخصص بالاضطرابات الصوتية و الألسنية. و تحول الشعر معه لنوع من الأفازيا، لقد كانت توجد في إيقاعاته فراغات و هي متكررة بحيث أن غياب الصوت و إيقاعه يكون له معنى، مثل الصفر في الرياضيات. إنه مع بقية الأعداد له قيمة و معنى و لكن بمفرده لا يدل على شيء.
غير أن ميزة سميح القاسم ( الشهير بلقب أبو وطن) هي في تأصيل الحديث و القديم. و في صياغة قصيدة ذات تاريخ نفسي و دلالي . وفي إنتاج قصيدة جوهرية مصدرها التصورات و المشاعر و ليس التراكيب و الصور والمرئيات.
و كما أرى إن أعماله و لا سيما التي ظهرت في الثمانينات و ما بعد لها دور ريادي لا يقل بالأهمية عن منجز السياب في قصائده الحركية التي نقول إنها قصائد تموزية.
…..
سميح القاسم شاعر المقاومة والسلام/ أحمد الظفيري
قال روزنتال: «إن الحياة التي تخلو من الشعر لهي حياة غير جديرة أن تعاش«.
لقد تبوأت مجموعة من الأدباء الفلسطينيين موقعا متقدما بين مجمل الكتاب والمبدعين على امتداد الوطن العربي، وساهمت في دفع القضايا الفكرية والفنية. بل كانت وما تزال رائدة في إعلاء شأن الكلمة الحرة، فبرزت أسماء لامعة في سماء الفكر والفن. أما في مجال تجديد وتطوير الشعر الحديث فقد كان لسميح القاسم ورفاقه دور رائد في دعم وتدعيم هذه الحركة.
وسميح القاسم هو الشاعر الذي أعطى الشعر صفوة الروح والعمر، فانتصبت القصيدة شجرة عطاء لا ينضب..
حمامٌ مقيمٌ على سطح داري
غمامٌ جديدٌ على شُرفات النهارِ
سلامٌ على غضب العمرِ
يوماً فيوماً وشهراً فشهرا وعاماً فعاماً
سلامٌ على قرحتي وليالي انتظاري
سلامٌ على نكبتي وعلى نكستي وانكساري
سلامٌ على فرحتي بانتصاري
بخفق الخطى العائدات إلى البيت
في تعتعات الطريق وعزف المسار
وبعد المزار
لقد شهدت حالة مابعد 48 في الأدب الفلسطيني حالة جديدة ، فالشاعر الفلسطيني ولا سيما سميح القاسم كان يراوح دوما بين السلام والمقاومة ، وبما أن سميح القاسم ينتمي للفكر الماركسي الذي يؤمن بحق الحياة ويحاول أن ينشر السلام على الأرض فنحن نلاحظ أن مقطع قصيدته يراوح ما بين «الحمام / والسلام / والغمام» إنه يعزز فكرة السلام من خلال كلمة «مقيم» فهذا الحمام الدال على السلام هو على سطح الدار/الوطن ، على الرغم من وجود «الغمام» الذي هنا يكون معاكساً لوجود الحمام …فسميح القاسم يتخذ من المقاومة طريقاً للسلام «سلام على غضب العمر» وانتظار الفلسطيني وحلمه بالعودة لا ينتهي ، إن سميح القاسم ينطلق في حالات هذا النص من الاية « سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا» فالسلام يوزعه القاسم على المقاومة ، والسلام ، والعودة .
لم يكن الشاعر سميح القاسم سياسياً ولم تكن قصائده بيانات سياسية ، لكنه كان يغادر بعض الأفكار التي تشرب بها شعراء اخرون ، ولاسيما افكار «المقاومة العربية ، والتضامن العربي» فهو يؤمن بأن المقاومة هي فلسطينية فقط ولم تعد تعني أحداً اخر ، لاسيما بعدما أصيب الجسد العربي بالتشرذم والتشظي ، ولهذا أصبحت دعوات السلام كوابيس تؤرقه في ظل التقدم الصهيوني والنكبات المتواصلة للشعب الفلسطيني :
ليغن غيري للسلام
ليغن غيري للصداقة ،للأخوة ، للوئام
ليغن غيري..للغراب
جذلان ينعق بين أبياتي الخراب
للبوم..في أنقاض أبراج الحمام
وهنا نرى الرؤية الجديدة في مفهوم الشاعر، فكيف يغني للسلام والأخوة مع الغراب والبوم الذي احتل الأنقاض ، واقترنت صورها بصورة المحتل التي لازمت القاسم طيلة حياته…إن الخراب هو الفعل الحقيقي للاحتلال ولم يعد من الممكن أن يغني الشاعر للسلام مع الغراب الذي احتل أبراج الحمام ، فالموقف ينبع من ضمير الشاعر، ومن ينزف شعره من الضمير لا يمكنه إلا أن يقف الموقف ذاته.
لقد رحل سميح القاسم ، والغربان ما زالت حتى هذه اللحظة تحلق فوق أبراج الحمام وتهدم ما يمكن تهديمه منها، ولهذا لن تهدأ روح القاسم الطاهرة ، ستبقى تحلق فوق أراضي فلسطين، فوق أراضي أهله ، حتى يعود لها أهلها وتنجلي عنها أقدام الغزاة…فسلام على سميح القاسم يوم ولد ، ويوم يموت، ويوم يبعث فلسطينياً حراً.
كاتب عراقي
صديق المتنبي وأبي تمام/ محمد علي طه
سميح القاسم شاعر عملاق قدم قصائد ومجموعات شعرية هامة للأدب العربي والأدب العالمي. يمتاز أنه من مؤسسي شعر المقاومة الفلسطيني مع محمود درويش وتوفيق زياد. كما أن نفس العروبة كان يتجلى في قصائده فهو شاعر عربي بل هو شاعر العروبة وكان مؤمنا بالوحدة العربية وعدوا لدودا لدويلات سايكس بيكو.
في قصائده الاخيرة خاصة كولاج والسربيات ظهرت عنده الحداثة وما بعد الحداثة وكان يدخل كلمات اجنبية من لغات اعجمية مستغلا اياها لتقديم الفكرة خاصة الفكرة الساخرة.
هناك لون اخر لدى سميه وهو الشعر العمودي وظهر في ديوان الحماسة الأول والثاني والثالث وهي قصائد وطنية قالها في مناسبات وطنية كأول أيار، هبة القدس والأقصى،يوم الأرض وزيارة دمشق وغيرها. هذه القصائد تكاد تذكرك بالمتنبي وبأبي تمام بمحافظته على اللغة العربية المتينة والقاموسية وسميح كان من المحافظين ومن المتبحرين بالبحور الشعرية فلا يمكن ان تجد عنده خطا عروضيا في مجموعاته الشعرية الستين بفضل كونه متمكنا جدا بالعروض.
٭ شاعر فلسطيني
سميح القاسم في بيروت/ معن البياري
لم يزر سميح القاسم بيروت، دعي إليها غير مرة، لكنه لم يتمكّن من القدوم إليها. زار عواصم ومدناً عربية عديدة، ووجد فيها حفاوةً ومحبة كثيرتيْن. لا مناسبةَ للإتيان على بيروت، في هذا المطرح، سوى أن هذه السطور تنكتب فيها، وأنني وجدت في اهتمامها بالشاعر الكبير، في صحافتها وتلفزاتها وأهل النشاط الثقافي فيها، مع وفاته، ما يؤكد بديهيةً، يحسن التنويه دائماً إليها، موجزها أن هذه العاصمة العربية، مع كل التراجع الحادث فيها على غير صعيد، تبقى رئةً أولى للثقافة العربية، وأنها مهما تقلبت عوادي الزمن فيها، ومهما قضمت الركاكة والرثاثة من مساحات العقل والجمال والوداعة فيها، تظل قادرةً على حماية نفسها مما يُراد أن تؤخذ إليه من تفاهةٍ، ومن عروبةٍ منقوصةٍ ومضروبة. والقول، هنا، إن السعة الوفيرة للحريات الفردية والإعلامية في لبنان تتيح مساحاتٍ لكل تعبيرات الانسحاب من الوجدان العروبي الجامع، ولكل ازورارٍ في المجال العام عن الرابط القومي مع الأمة العربية الواحدة، لكنها حيويّة المجتمع المدني، ويقظة نخبةٍ فيه، دؤوبةٍ وجديةٍ ومثابرة، تيسّر مضاداتٍ لتلك الممارسات ومصدّات لها.
لبنان البلادولة، على ما وصفه عنوان مقالةٍ افتتاحيةٍ لرئيس تحرير صحيفةٍ بيروتيةٍ بارزة، وقعت عيناي عليها مع صعودي إلى الطائرة اللبنانية التي أخذتني إلى بيروت، طراز خاص من الأوطان، تحبّ فيه، وأنت زائرُه الشغوف به، تعايش ناسِه مع الأزمات المركبّة فيه، والاستسلام للقناعة العريضة فيه عن البلد ساحةً لهبوب رياح الآخرين فيه. وفيما ناسٌ فيه يشرّقون وآخرون يغربّون، فإن سميح القاسم يجد له حصةً بين الجميع، ليس فقط باعتبار واقعة وفاته مناسبةً للإضاءة الصحفية على شخصه وسيرته ومنتوجه، بل ثمّة فيه ما يزكّي الانتساب إلى فضاء وطني، محلي وقومي، لا يمكن للبنان أن ينبتّ عنهما. وهذه الفضائيات اللبنانية، من مختلف التلاوين والخيارات، تعطي الرجل مساحاتٍ للحديث عنه، باستضافة المختصين والعارفين بالشعر والثقافة وبفلسطين، وهذه الجرائد تفرد صفحات وملاحق للخوض في السمت القومي الذي كان سميح القاسم يحرص عليه، مثقفاً مهجوساً بمناهضة الاحتلال الإسرائيلي، وهو آخر من مضوا من شعراء المقاومة الفلسطينية في طورها الذي ذاع، قبل أزيد من خمسين عاماً.
لا نتحدث عن هندوراس أو ناميبيا، حتى يُستغرب الانشغال الإعلامي اللبناني، الثقافي منه والعام، بسميح القاسم، فلبنان بلد عربي، ومن منابره وصحافاته ودور النشر فيه كانت أولى إطلالات الشاعر الكبير العربية على قرائه خارج فلسطين. ولكن، يحسنُ تثمين الحقيقة الأوضح، وهي أن هذا البلد يبقى، على الرغم من كل العطب العربي الغزير، ومن كل التردّي الظاهر فيه، يبقى الأقدر على تظهير الوجه الأكثر نضارةً في المطارح العربية، وعلى تعيين وجهة البوصلة الأصلح تأشيراً، في غضون كل هذه المتاهات قدّامنا. وفي الوسع أن يقال هذا كله، وغيره، فيما الذي يقترفه حزب الله في سورية ضاعف من تعقيد هذه المتاهات. وفي الوسع أن يقال، أيضاً، إن سميح القاسم، عندما تخصّص له، في بيروت، أكثر من ندوة في أندية وتجمعات ثقافية، وفي عدة تلفزاتٍ محلية، فذلك مما يعني أن مقادير العافية في هذه العاصمة العربية وفيرة، وأنها تحافظ على مرتبتها الأولى عاصمةً للثقافة العربية، من دون حاجتها إلى موسمية اليونسكو إياها.
كولاجات سميح القاسم الشعرية، ومشهدياته وسردياته المسرحية وملحمياته في كتبه التي اقتربت من السبعين، تجد لها، هنا في بيروت، من يحفل بها، أكثر مما يحدث أن ينتبه إليها في عواصم عربية أخرى. وليس تحفظاً على غواية جلد الذات إياها، أقول إن بيروت باقية على مقادير رائقةٍ من حرارةٍ خاصة، من حيث الانتباه إلى الشاغل الثقافي، وإلى المتاريس الوجدانية الواجبة لصيانة الناظم العميق لتفاصيل الثقافة العربية ورهاناتها، في الراهن والمستقبل، ومن حيث الانتباه إلى فلسطين، وسميح القاسم من عناوينها الباقية
العربي الجديد
هكذا أودعوا سميح القاسم جبل حيدر/ ناهد درباس
الرامة (فلسطين)
كأنما هي لوحة فسيفساء استجمعت نفسها اليوم في وداع سميح القاسم. أطياف وألوان النسيج الفلسطيني عبرت كل أشكال التقسيم والعزل إلى قرية الرامة في الجليل، المقابلة لجبل الجرمق، لتشييع الشاعر الذي رحل مساء يوم الثلاثاء الماضي 19 آب/ أغسطس عن 75 عاماً ومثل عددها كتباً.
جنازة الشاعر مختلفة، ولا أحد يستطيع رثاءه مثلما فعل بنفسه، فصاحب الكلمات المسجّى في تابوت خشبي كان مركز الحدث. وقصيدة “كلمة الفقيد في مهرجان تأبينه” رافقت المشيعين بصوت عالٍ أثناء التأبين، ولقد طاف جثمان القاسم من “بيت الشعب” الى ساحة ملعب كرة القدم حيث تم تأبينه والصلاة عليه.
ترك القاسم إنتاجاً واسعاً ومتنوعاً، أساسه الشعر، ولكنه أنتج أيضاً في الرواية والمسرح والمقالة والترجمة فأورث قرأه أكثر من سبعين كتاباً، آخرها كان سيرته الذاتية “إنها مجرد منفضة” التي صدرت في نهاية عام 2011 عن دار “راية” في حيفا، وكتبها بعد أن اكتشف إصابته بمرض السرطان أيامها.
عند سفح “جبل حيدر” في قرية الرامة رقد جثمان سميح القاسم، على قطعة أرض يملكها وكان خصصها لمماته منذ سنوات، ليشرف ويتابع أمور الدنيا كما في حياته.
صورة القاسم ترحب بك في مدخل قرية الرامة، وعلّقت صوره على جدران بيوت عديدة من القرية. الآلاف وصلوا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة: سياسيون محلّيون وكتّاب وموكب يمثّل السلطة الفلسطينية وموكب جماهيري من الجولان السوري المحتل دخل مع الاعلام السورية وطاف ساحة المعلب مردداً رثاء جنائزياً.
وما بدا لافتاً في الجنازة هو العدد الكبير من رجال الدين من مختلف الطوائف؛ فإلى جانب رجال الدين الدروز الذين أقاموا الصلاة على الراحل، حضر عدد كبير من رجال الدين، المسلمين والمسيحيين. مشهد لا يتكرر كثيراً في الجنازات.
قرية الرامة أعلنت الحداد لمراسم الجنازة و”لجنة المتابعة للجماهير العربية” طالبت “المجالس العربية” في “السلطات المحلية” بالحداد لساعة واحدة خلال تشييع جثمان القاسم. العلم الفلسطيني رافق الموكب الجنائري كما كان في استقبال المشيعين عند وصولهم إلى الرامة.
لم يغب الشاعر محمود درويش عن موكب الجنازة، إذ ذكر “نصف البرتقالة” في أكثر من كلمة تأبين. فالقاسم ودرويش شاعران صديقان ترعرعا في الجليل معاً ولوحقا من قبل السلطات الإسرائيلية في شبابها، وظلت مساراتهما تتوازى وتتقاطع. وإن كان محمود درويش لم “يحظ” بأن يدفن في قريته البروة ودفن في رام الله.
أجمع المتحدثون في كلمات التأبين على رسالة القاسم الشعرية والوطنية والقومية، وندائه الى وحدة الشعب الفلسطيني، ومن تحدّثوا إلى “العربي الجديد” من رفاقه وزملائه لمسنا لديهم أثر شمائله الشخصية: تواضعه على المستوى الشخصي والدماثة وحس الدعابة.
مشاعر كثيرة مختلطة تنتاب المرء وهو يرى اجتماع الشمل الفلسطيني في وداع الشاعر والأقوال فيه وحوله. ويبقى صوته في “كلمة الفقيد في حفل تأبينه” أكثرها تأثيراً. وداعاً سميح القاسم.
أخي سميح/ حنا أبو حنا
أخي سميح،
ما كنت أحسب أني سأرثيك وأقول مع أحمد شوقي في رثاء الشاعر حافظ إبراهيم:
“قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء”
يا من شمختَ سنديانةً رائعةً وملأت الفضاء أنغاماً تحتضن الحبّ والإباء والتحدي!
أخي، هل تسمح – وأنت السميح – أن أعود بالذاكرة إلى شيء من الماضي، إلى الحديقة التي نبتت دوحتك فيها.
أخي، أنت تعلم أن لنكبة شعبنا أبعاداً شتّى، فقد شُرِّد الأدباء والشعراء في العاصفة ثم انقطعت الصلة مع العالم العربي وبقينا أيتاماً. ولم يبقَ هنا سوى عدد من الأدباء والشعراء لا يتجاوز عدد أصابع اليدين وهم في مطالع العشرينيات.
وكان الحكم العسكري الذي يكمّم الأفواه ويخنق المعلمين والتعليم ويشنّ هجمة “ثقافية” شعواء عبر دور النشر والصّحف والمجلات وصحف الأطفال! بل إن “بن غوريون” ناقش مع طاقم خاصّ أمر إلغاء تعليم العربية والتعامل معها في المدارس العربية!
لم يكن بدّ من التحدّي والتصدّي دفاعاً عن ثقافتنا بل السعي إلى ازدهارها.
كان أحد الشعارات في الاجتماع الذي عقد في حيفا سنة 1951 لإصدار مجلة “الجديد” أن نرعى أجيالاً جديدة من الأدباء والشعراء تتصدّى للحملـة وترعى أنفاس الكرامة والإباء والتحدّي. كان احتضان المواهب الواعدة أمراً رعته المهرجانات الشعرية والندوات الأدبية وغَيرة عدد من المعلمين المخلصين.
كان توفيق زيّاد ومحمود درويش وسميح القاسم وراشد حسين وشفيق حبيب وعيسى لوباني وآخرون. وأنت تعرف هذا الاحتضان. وقد امتاز هؤلاء الشعراء بالروح النضالية والصمود والريادة في مجال الشعر، وخلّفوا تراثاً رائعاً لحدائق الشعر العالمي.
وكم يحزنني اليوم أن أراجع أسماء من فارقونا بعد أن حلّقوا في سماء الإبداع وغرسوا في هذه الأرض رياض الكرامة والتحدي.
مرّة أخرى – عليك السلام يا طيف سميح الذي لحق بحبيبه محمود وبالإخوة الأباة الخالدين.
* شاعر من فلسطين، اعتبره شعراء المقاومة أستاذاً لهم.