وداعا غابرييل غارسيا ماركيز
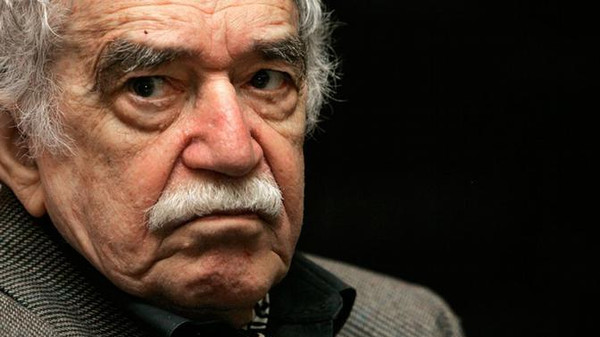
رحيل غابرييل غارسيا ماركيز… روائي أميركا اللاتينية وساحرها
بيروت ـ وكالات
أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الحداد لمدة 3 ايام على وفاة الروائي العالمي غابرييل غارسيا ماركيز.
وتوفي ماركيز، صاحب رواية “مئة عام من العزلة” والحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1982، أمس الخميس في مكسيكو سيتي عن 87 عاماً.
ورحل ماركيز في بيته في مكسيكو سيتي كما قال مصدر مقرب من عائلته، بعد أسبوع من عودته إلى البيت من المستشفى حيث كان يعالج من نوبة التهاب رئوي.
وأكد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وفاة ماركيز، الذي يشكّل بالنسبة لكولومبيا جزءاً لا يتجزّأ من هويتها.
وكان ماركيز، الذي يعرف لدى الملايين بلقب “غابو”، يعيش برفقة زوجته مرسيديس بارشا في المكسيك منذ فترة بعيدة في أجواء منعزلة لم تكن تخلو من مشاركات نادرة في بعض النشاطات الثقافية.
ويعتبر الكاتب الكولومبي، الذي بدأ عمله مراسلا صحافيا، واحداً من الكتّاب الأكثر احتراماً وتأثيراً في جيله، وقدّم مساهمة كبرى في إغناء فن السرد الروائي في العالم.
وكافح لسنوات كي يصنع اسمه كروائي على رغم أنه نشر قصصاً ومقالات وروايات قصيرة عدة في الخمسينات والستينات أشهرها “عاصفة الأوراق” و”ليس لدى الكولونيل من يكاتبه”.
وحقق اسمه كروائي على نحو ملفت للانتباه في روايته “مئة عام من العزلة” والتي نال شهرة كبيرة بعد نشرها مباشرة في عام 1967، وباعت أكثر من 50 مليون نسخة في أنحاء العالم وأعطت دفعاً لأدب أميركا اللاتينية.
وفي الرواية، التي نال عنها جائزة نوبل للآداب، يمزج ماركيز الأحداث المعجزة والخارقة بتفاصيل الحياة اليومية والحقائق السياسية في أميركا اللاتينية. وقال ماركيز إنه استلهم الرواية من ذكريات الطفولة عن القصص التي كانت ترويها جدته التي يغلب عليها التراث الشعبي والخرافات، لكنها قدمت أكثر الوجوه استقامة.
وولد ماركيز في السادس من آذار (مارس) عام 1927 في بلدة أراكاتاكا في مقاطعة (ماغدالينا) الكولومبية، والتي أصبحت النموذج لبلدة ماكوندو، البلدة المحاطة بأشجار الموز على سفح جبل سييرا نيفادا في “مئة عام من العزلة”.
أرسل غابرييل إلى مدرسة داخلية في بارانكويلا، واشتهر هناك كونه صبيًا خجولاً ويكتب قصائد ساخرة و يرسم رسومًا هزلية، ولقب حينها بين زملائه بـ «العجوز» كونه كان شخصًا جادًا وقليل الاهتمام بالأنشطة الرياضية. وعلى رغم شغفه بالكتابة، إلا أن غارسيا ماركيز استمر في دراسة القانون عام 1948 إرضاءًا لوالده.
وخلال زيارة لوالديه في مدينة سوكر الكولومبية، تعرف غارسيا ماركيز الى ميرسيدس بارشا، وكان حينها لايزال طالبا، ثم تطور التعارف الى وعد بينهما على الزواج، وهو في عمر 13 سنة، وحين أنهى دراسته في عام 1958 تزوجها وبعد عام واحد انجبا ابنهما الاول رودريغو، الذي أصبح فيما بعد مخرجًا سينمائيًا، وبعد ثلاث سنوات، انجبا ابنهما الثاني غونزالو، مصمم غرافيك مقيم في المكسيك.
أحيا ماركيز، سحر أميركا اللاتينية وتناقضاتها المجنونة في أذهان الملايين، وأصبح رائداً للواقعية السحرية وأحد المدافعين الرئيسيين عنها، وهي تقوم على مزج عناصر خيالية في تصوير الحياة اليومية التي جعلت الاستثنائي يبدو روتينياً إلى حد ما.
ويقول ماركيز إن هذا الأسلوب يجمع بين “الأسطورة والسحر وغيرها من الظواهر الخارقة للعادة”.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية عند منحه جائزة نوبل في عام 1982، إن ماركيز “يقودنا في رواياته وقصصه القصيرة إلى ذلك المكان الغريب الذي تلتقي فيه الأسطورة والواقع”.
وبيعت أعمال ماركيز، أكثر مما بيع كل ما نشر بالإسبانية باستثناء الكتاب المقدس. إذ بيعت أكثر من 50 مليون نسخة من روايته “مئة عام من العزلة”، التي ترجمت إلى أكثر من 25 لغة.
ومن أعماله المشهورة الأخرى “خريف البطريرك” الصادرة عام 1975، و”قصة موت مُعلن” عام 1981، و”الحب في زمن الكوليرا” التي صدرت عام 1986، ومن كتبه الحديثة “عشت لأروي” و”ذاكرة غانياتي الحزينات”. وترجمت معظم أعماله إلى لغات عدة منها العربية.
وتعتبر العزلة الموضوع الرئيسي لعدد من أعمال ماركيز، وليس فقط “مئة عام من العزلة” الذي يعتبر من أهم الأعمال في تاريخ اللغة الإسبانية. وحمل خطاب قبوله جائزة نوبل للآداب عام 1982، عنوان “العزلة في أميركا اللاتينية” وقال فيه إن “تفسير واقعنا من أنماط عدة، وليس من خلالنا نحن، يجعلنا فقط نشعر في كل مرة وكأننا غرباء عن عالمنا، ونصبح أقل حرية وأكثر وحدة في كل مرة”.
الكلمات الأخيرة لغابريل غارسيا ماركيز
بيروت – “الحياة”
كتب الروائي غابريل غارسيا ماركيز رسالة وداع الى القراء ووضع فيها وصيتة إلى الناس حين ادرك أن الموت قريب بعدما علم أنه مصاب بالسرطان، وهنا نص الرسالة:
“لو شاء الله أن يهبني شيئا من حياة أخرى، فإنني سأستثمرها بكل قواي. ربما لن أقول كل ما أفكر به، لكنني حتما سأفكر في كل ما سأقوله. سأمنح الأشياء قيمتها، لا لما تمثله، بل لما تعنيه. سأنام قليلاً، وأحلم كثيراً، مدركاً أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة ستين ثانية من النور.
سأسير فيما يتوقف الآخرون، وسأصحو فيما الجميع نيام. لو شاء ربي أن يهبني حياة أخرى، سأبرهن للناس كم يخطئون عندما يعتقدون أنهم لن يكونوا عشاقاً متى شاخوا، من دون أن يدروا أنهم يشيخون إذا توقفوا عن العشق. للطفـل سأمنحه الأجنحة، لكنني سأدعه يتعلم التحليق وحده. وللكهول سأعلمهم أن الموت لا يأتي مع الشيخوخة، بل بفعل النسيان.
تعلمت منكم الكثير أيها البشر. تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل، غير مدركين أن سر السعادة يكمن في تسلقه. تعلمت أن المولود الجديد حين يشد على أصبع أبيه للمرة الأولى فذلك يعني أنه أمسك بها إلى الأبد. تعلمت أن الإنسان يحق له أن ينظر من فوق إلى الآخر فقط حين يجب أن يساعده على الوقوف.
تعلمت منكم أشياء كثيرة، لكن قلة منها ستفيدني، لأنها عندما ستوضع في حقيبتي أكون أودع الحياة.
قل دائماً ما تشعر به، وافعل ما تفكر فيه. لو كنت أعرف أنها المرة الأخيرة التي أراكِ فيها نائمة لكنت ضممتك بشدة بين ذراعي ولتضرعت إلى الله ليجعلني حارساً لروحك. لو كنت أعرف أنها الدقائق الأخيرة التي أراك فيها، لقلت “أحبك” ولتجاهلت، بخجل، أنك تعرفين ذلك. هناك دوما يوم الغد، والحياة تمنحنا الفرصة لنفعل الأفضل، لكن لو أنني مخطئ وهذا هو يومي الأخير، أحب أن أقول كم أحبك، وأنني لن أنساك أبداً.
لأن الغد ليس مضموناً، سواء لشاب أو مسن، ربما تكون في هذا اليوم المرة الأخيرة التي ترى فيها أولئك الذين تحبهم، فلا تنتظر أكثر. تصرف اليوم لأن الغد قد لا يأتي ولا بد أن تندم على اليوم الذي لم تجد فيه الوقت من أجل ابتسامة، أو عناق، أو أنك كنت مشغولاً كي ترسل لهم أمنية أخيرة. حافظ بقربك على من تحب، أهمس في أذنهم أنك في حاجة إليهم، أحببهم واعتن بهم، وخذ ما يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات، مثل: أفهمك، سامحني، من فضلك، شكراً، وكل كلمات الحب التي تعرفها، لن يتذكرك أحد من أجل ما تضمر من أفكار، فاطلب من الرب القوة والحكمة للتعبير عنها وبرهن لأصدقائك ولأحبائك كم هم مهمون لديك.
قل ما تشعر به وافعل ما تفكر فيه.
الحياة تمنحنا الفرصة دائماً أن نفعل الافضل.
يجب أن تندم على الوقت الذي لم تجد فيه فرصة لابتسامة”.
ماركيز … “والسبق” العربي/ عبده وازن
يتباهى بعض الناشرين العرب في أنهم باتوا يسبقون الدور الأجنبية في نقل بعض الكتب الى العربية ولا سيّما الروايات الصادرة في أميركا اللاتينية. حصل هذا السبق أكثر من مرّة وصدرت كتب كثيرة في ترجمتها العربية قبل أن تصدر مثلاً في الترجمة الفرنسية أو الانكليزية أو الألمانية. وقد تكون “مذكرات” غابرييل غارسيا ماركيز التي صدرت لها ترجمتان عربيتان بعيد صدورها باللغة الأم، واحدة في دمشق وأخرى في القاهرة، خير دليل على السبق الذي بات يحرزه بعض الناشرين العرب في حقل الترجمة العالمية. وقد سبق الناشران العربيان هذان الناشرَ الفرنسي الذي أصدر للتوّ الترجمة الفرنسية للمذكرات.
إلا أنّ الظاهرة هذه ليست سليمة على رغم طابعها “الايجابي” الذي يتجلّى في سرعة الترجمة والنشر. فالدور العربية في معظمها لا تلتزم قوانين الترجمة ولا تدفع الحقوق للكاتب ولا لناشره الأول. وهذه البادرة تسيء الى الكتاب مقدار ما تسيء الى الكاتب نفسه ليس ماديّاً فقط بل معنوياً أيضاً. فالترجمة والنشر هنا يصبحان نوعاً من القرصنة التي كثيراً ما تسيء الى حركة النشر وحركة التأليف وربّما الى “معنى” القراءة بدورها. ولا يحتاج الناشرون العرب الى من يذكّرهم بميثاق النشر العالمي وما يفترض أو يقتضي من شروط.
وإذا ظنّ المترجمون العرب أنّهم أسرع في الترجمة من نظرائهم الفرنسيين أو الانكليز وسواهم فهم مخطئون حتماً. فحركة الترجمة في أوروبا والتي استطاعت أن تتفوّق على مثيلتها في الولايات المتحدة الأميركية وفق بعض التقارير، تشهد حالاً من الازدهار اللافت لا من خلال مرافقتها آداب الشعوب بسرعة وجدّية فقط وانما عبر الالتزام الثقافي الذي تعتمده مؤدّية خدمة حقيقية للكاتب والناشر والقارئ في آنٍ واحد. فالترجمة ليست مجرّد نقل نص من لغة الى أخرى مقدار ما هي حوار ثقافي بين لغة وأخرى، بين كاتب وقارئ وبين ناشر وجمهور. وقد وجب احترام الترجمة حتى التقديس” في أحيان كونها عملاً نبيلاً لا يقل إبداعاً عن الكتابة نفسها.
سبق الناشران السوري والمصري إذاً الناشرَ الفرنسي في ترجمة مذكرات غابرييل غارسيا ماركيز وعنوانها “عشت لأروي” وحققا “ضرباً” تجارياً لا ثقافياً على رغم أنهما لم يروّجا لهذه الترجمة. ولولا بعض المقالات التي صدرت في صحف ومجلات عربية لما علم القارئ السوري والمصري بها أولاً ثم القارئ العربي الذي غالباً ما يجهد للحصول على كتاب صادر في بلد “شقيق”. أما في باريس فبدا صدور “مذكرات” ماركيز أخيراً حدثاً ثقافياً وأدبياً عظيماً يخصّ القراء قبل أن يكون فعلاً تجارياً يخصّ الناشر. فالإعلانات عن “المذكرات” ملأت الصحف والمجلات، واحتلت اغلفة الكتاب وصور ماركيز واجهات المكتبات وبعض اللوحات الاعلانية في المترو والشوارع. ناهيك بما خصّصت له الصحافة من صفحات ومقالات بدت كأنها تحتفل به احتفالاً من غير أن تتخلّى عن الموضوعية والرأي النقدي.
لم تتأخّر الترجمة الفرنسية عن الصدور إلا لما يتطلّب فعل النشر من انجاز للعقود واحترام للحقوق ووضع خطة للترويج الإعلامي والتوزيع… فالناشر الفرنسي يعلم تمام العلم ماذا ينشر أو كيف عليه أن ينشر كتاباً مؤلفه هو ماركيز صاحب “مئة عام من العزلة” هذه الرواية وصفها ميلان كونديرا، في مقال له كتبه حديثاً في مناسبة صدور “المذكرات”، بالعمل “الباهر” و”التخيل الحر”، وقال ان “كل جملة فيها تبرق بالفانتازيا، كل جملة فيه مفاجأة ودهشة”. أدرك الناشر الفرنسي – على خلاف الناشرين العربيين – أن كتاب “المذكرات” حصيلة سنوات من الصمت والانقطاع، عاش فيها ماركيز تجربة المرض الذي ظلّ غامضاً ولم يعلن عنه صراحة. أدرك الناشر الفرنسي أيضاً أن حياة ماركيز وأعماله البديعة تتقاطع في هذا الكتاب وأن المذكرات تنسج ما يشبه الوثيقة التي تشهد على كولومبيا في تاريخها الحديث، سياسياً واجتماعياً و”بشرياً”، وعلى تقاليدها وعاداتها… من خلال ذكريات ماركيز الشخصية التي لا تقل طرافة وسحراً عن أجوائه الروائية.
ترى هل علم الناشران العربيان أن “المذكرات” نفدت فور صدورها في كولومبيا والمكسيك وبعض العواصم الأميركية – اللاتينية، وأن ناشرين “قرصنوها” للفور وأن حراسة شديدة أقيمت حول أحد المستودعات في مكسيكو خشية أن تسرق النسخ؟
قد يحتاج الناشر العربي الى من يذكّره ببعض الكتب التي ينشرها من دون أن يعلم أنها كتب مهمة وأنها قد تدر عليه المال الذي يطمع به إنْ هو عمل على ترويجها لا كسلعة فقط وانما كقيمة ثقافية وأدبية! أما قضية حقوق الكاتب والناشر الأجنبي فهي باتت مدعاة لليأس ولم يعد الكثيرون من الناشرين الغربيين يهتمون لهذه القضية في العالم العربي بعدما أيقنوا أنّ من العبث أن يطالبوا بحقوقهم!
لكن روائياً مثل الطاهر بن جلّون لم يتوان في احدى ندوات مهرجان أصيلة الأخيرة عن فتح النار على بعض الناشرين السوريين الذين قرصنوا كتبه وترجموها على طريقتهم من غير إذن ولا التزام بميثاق النشر!
هل يستحق المترجمان والناشران، السوريان والمصريان، التهنئة على “السبق” الذي حققوه جميعاً في “قنص” كتاب ماركيز أم أن قضية القرصنة بلغت ما بلغت من فوضى و”فلتان” حتى أضحى أي كلام عنها ضرباً من العبث واللاجدوى؟
صلاة ماركيز/ محمود الريماوي
المرض يسبّب الألم بالطبع لكنه قد يتسبب لصاحبه بمشاعر أخرى، بالاهانة مثلاً كما كان يقول يوسف الخال. ربما كانت هناك مبالغة في ذلك: فالجوع أو الانتهاك أو التعذيب الجسدي هو الذي يلحق الاهانة، فيما يبقى الشعور بالكرامة مسألة معنوية، أما كرامة الجسد فينال منها الإكراه أو الحرمان من الحاجات الأساسية كالطعام والشراب، أو الراحة أو الحرية. ولا يعرف المرء هذه الأيام أية مشاعر تنتاب غابريل غارسيا ماركيز بعد أن تم اكتشاف خلايا سرطانية في غدده اللمفاوية. انها مشاعر قوية وأليمة لا شك ولم يسبق له أن عاشها، وهو الصانع البارع الذي تتشكل مصائر أبطاله بين يديه بسيولة أخّاذة، ثم أمام أنظار ملايين القارئين في العالم بمختلف اللغات. فهؤلاء انما سحرتهم دائماً تلك الواقعية التي ارتبطت بسحر موهبة ماركيز الذي كان يسابق تجار المخدرات في تشكيل صورة بلاده كولومبيا، مع ارتباط اسمه ببلدين جنوبيين هما المكسيك وكوبا.
أية حكاية هذه التي تبلغ ذروتها بمرض أليم قلما يبارح جسد وروح صاحبه، تلك هي الحكاية التي يتوقف عندها هذه الأيام غابريل ماركيز، وهو الذي كان يسأل مزيداً من الوقت كي ينجز مذكرات هي الأعظم بين ما كتب حتى الآن كما قال، وهو الذي إذا قال شيئاً في مجال الإبداع فعله.
سوف يصلي ملايين من محبي أدبه الرفيع لكي ينجز ما وعد ولكي تمضي حياته الى نهايتها وعلى النحو الذي يحب لها أن تكون. ومع صلاة هؤلاء فانهم هم، لا هو، سوف يستشعرون أنهم المادة الحيوية لرواية لم تكتب بعد، وتطوف في خاطر صانعها الذي يقرن الكتابة ليس فقط بالعمل بل بما يشبه العبادة. ألم تقترن الكتابة في الأصل ومجازا بالخلق، فقد كانت بلاده وقارته وشعوبها موجودة من قبل ودائماً… لكن إشعاع حضورها لم ينبثق إلا في أدبه وأدب قلة من أقرانه المجيدين.
وأمكن له بالتالي أن يعيد “خلقها” وأن يقرب صورتها وما وراء الصورة وما على ضفافها، الى جمهرة عريضة قل نظيرها من قراء ومتذوقين، بمن فيهم الذين انشغلوا بمفاهيم الحداثة وما بعدها، فإذا بهم يصطدمون بنمط من كتابة عضوية جياشة بالتصاوير والرؤى والأحلام، بعناصر الطبيعة وظواهرها وقواها الخفية، كما بالكنيسة وكبار السن ورموز السلطات، وقبل كل شيء بالحب الذي يرتقي الى مستوى التدين. ولدهشة ماركيز فإن رواية حياته تتجه هذه المرة ولأول مرة وجهة لم يتوقعها ولم يخترها، وسيكون من الصعوبة بمكان السيطرة الناجعة والتامة عليها، ولربما اسعفه ذلك أكثر في التعرف على أبطاله الذين أطلقهم، ولعله يستحضرهم مرة أخرى ويستحضر معهم حياة شخصية سريعة عاشها وكأية حياة بشرية مليئة بالصعوبات والاكتشافات والمسرات، لكنها تصطدم هذه المرة بمنعطف يفضي الى متاهة حيث يصعب التوقف والتقدم على السواء، كما يتعذر التراجع الى الوراء.
أما الأطباء الذين حلم بهم ماركيز، أولئك الذين عالجوا أبطاله المرضى، فلسوف يملأون حياته بألوانهم البيضاء ومستحضراتهم وأجهزتهم بلطفهم وسوطتهم ثم بسحابات الصمت التي تغشى ملامحهم: أطباء ينذرون بالمرض أكثر من الصحة ويتولون مقاليد سلطة لا قبل لأحد بمناهضتها أو إدارة الظهر لها، خلافاً للأطباء الفكهين الذين ملأوا رواياته وكانوا يثيرون العطف، وأحياناً الشكوك، أكثر من مرضاهم.
أما أشد الأمور قسوة فالحيرة الوجودية بين أن يكتب هذه القصة، أو ينصرف الى سرد مذكراته، أو يدع هذه وتلك لكي يعين جسده على رد العدوان البغيض عنه، أو يقوم بمعاونة الأطباء ومساعديهم لتنظيم دفاعاته ضد الزائر الثقيل الذي تسلل الى جسده السبعيني كرؤيا قاتمة.
انها خيارات عسيرة قد تهدد صاحبها بمئة عام من عزلة بيضاء، وسوف يشق عليه أن يتخير أحدها ويشيح بوجهه عما عداه. أما قراؤه الذين قضوا أسعد أوقات حياتهم في التمتع بثمرات إبداعه فانهم يكابدون، مع شيوع النبأ، مرارة حياة ما ان تفارقها الخرافة في موضع حتى تتسلل من موضع آخر. فالحياة أقصر بما لا يقاس من الموت باحتساب موت المولود قبل ولادته وبعد مماته، لكن الحياة ذاتها هي الشرط لادراك هذه الحقيقة.
ماركيز في كتابه “نزوة القص المباركة” : . الإمساك باللحظة التي تولد فيها الفكرة !/ بندر عبدالحميد
يأخذ السيناريو شكل العمود الفقري في الأفلام السينمائية والتلفزيونية عموماً، وهو يعتمد على القصة أولاً، وقد اكتشف الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز متعة توليد القصص من أفكار غير مكتملة، تُطرح في جلسات ورشة عمل من مجموعة من الهواة والمحترفين في كتابة السيناريو، وكان اهتمام ماركيز بالسينما قد أخذ شكلاً واضحاً منذ أن درس السينما في إيطاليا في الخمسينات، لمدة عام، وانصبّ اهتمامه على طاولة المونتاج – بعيداً من المحاضرات المكرورة – لأن هذه الطاولة هي الأقرب الى عملية التفكيك والتركيب في العمل القصصي، قبل أن يأخذ شكله كسيناريو جاهز للتصوير، سينمائياً او تلفزيونياً.
قام ماركيز بإدارة ورشات لكتابة السيناريو في المكسيك وكوبا، وصدرت وقائع أعمال ورشتين في كتابين، الأول بعنوان “كيف تحكى حكاية” والثاني بعنوان “نزوة القص المباركة”. وصدر الكتاب الأول في العام الماضي، بينما صدر الكتاب الثاني حديثاً – وكلاهما بترجمة صالح علماني – في سلسلة الفن السابع، عن المؤسسة العامة للسينما بدمشق.
آلية عمل الورشة
وفي كتاب “نزوة القص المباركة” طرحت مشروعات سيناريوهات مختلفة من المشاركين العشرة الذين ينتمون إلى كل من كولومبيا وبنما والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وكوبا وإسبانيا، وكالعادة كان أكثرهم من النساء، وكان ماركيز حريصاً على وضع بعض الملاحظات حول آلية عمل الورشة، وأكد على ضرورة استعداد المشاركين لتوجيه الإنتقادات الجريئة وتلقي “الصفعات” الكلامية بروح طيبة، كما أكد على أهمية نسيان الموضوعات المطروحة بعد الخروج من الجلسات المحددة.
يفتتح ماركيز أعمال الورشة بأفكار واعترافات، حيث يؤكد أن علاقته بقيادة ورشات كتابة السيناريو تحولت الى حال إدمان، وإذا كان الشيء الوحيد الذي يتقنه هو رواية القصص، فإنه لم يكن يتصور أن المشاركة الجماعية في روايتها ستكون اكثر امتاعاً: “وأعترف لكم بأن سلالة الحكواتية – اولئك الشيوخ الموقرون الذين يرتلون حكايات ومغامرات مشكوك بها من “ألف ليلة وليلة” في الأسواق المغربية – هي السلالة الوحيدة غير المحكومة بمئة عام من العزلة، ولا بلعنة بابل..”.
ويتصف عمل الورشة، كما يرى ماركيز، بمتابعة عملية الإبداع، خطوة خطوة، مع قفزات مفاجئة، والدخول في التفاصيل، مع محاولة الإمساك باللحظة الدقيقة التي تنبثق، أو تولد، فيها الفكرة، في ما يشبه حالة الصياد الذي يرصد من منظار بندقيته اللحظة الدقيقة التي يقفز فيها الأرنب، فالقصة تولد في اللحظة المناسبة، أو المفاجئة، ولا تُصنع، وولادتها تشبه كسر قشرة البيضة لخروج الفرخ الصغير إلى مسرح الحياة.
بين الموهبة والخبرة
وفي مجال كتابة القصص التي تتحول الى سيناريوهات للسينما او التلفزيون ثمة كيفية لتركيب القصص وتوليدها، فالموهبة لا تكفي وحدها، فالذين يملكون الإستعداد الفطري للقص يحتاجون الى الثقافة والتقنية والخبرة، والناس عادة ينقسمون بين من يعرفون كيف يروون القصص ومن لا يعرفون ذلك، وقد يكون للوراثة والظروف المنزلية في طفولة كل شخص دور في تكوين موهبة القص، ويشير ماركيز الى تجربته الشخصية، فيقول ان نصف تكوينه الأدبي اخذه عن أمه التي لم تسمع شيئاً عن الخطاب الأدبي، ولا تقنيات السرد، ولكنها تعرف كيف تسدد ضربة مؤثرة في حكاياتها، فالقصص تشبه ألعاب الأطفال، وتركيبها يشبه تركيب هذه اللعبة او تلك، والطفل الذي يجد نفسه امام مجموعة من الألعاب المختلفة يبادر الى محاولة اللعب بها كلها، اولاً، ولكنه سيختار لعبته المفضلة في النهاية.
لعبة الحاوي
ان التعامل اليومي مع القصص غواية، او نزوة مباركة، تتلبس صاحبها في كل ساعات يومه، حينما يكون وحيداً، او حينما يتحدث مع الآخرين، ولكن هل يمكن نقل هذه النزوة الى الآخرين، من خلال تبادل التجارب؟
ان الروائيين في قراءتهم للروايات يعمدون الى تفكيك كل رواية لمعرفة تركيبها، والقارئ العادي لا يستطيع ان يتعلم هذه العملية في صفوف الدراسة الجامعية، وإنما من خلال العمل في ورشة مفتوحة، يكتشف فيها لعبة الحاوي، ولعبة اختلاق القصص وصياغة قواعد اللعبة.
ويرى ماركيز ان كتابة القصص، او روايتها قد جعلت منه رجلاً حراً، حيث انه ليس مرتبطاً بأي شيء آخر، وليس ملتزماً بشيء حيال الآخرين، وتظل نزوة القص تعيش معه حتى حينما يتحدث عن امور اخرى، او يجيب عن اسئلة حول مشكلة طبقة الأوزون، او مسارات السياسة في اميركا اللاتينية.
حرية التخيّل
إن كاتب القصة التي تتحول إلى سيناريو يقوم بعمل إبداعي، ولكنه محكوم في الوقت نفسه بما سيفعله آكل اللحم البشري – المخرج الذي يستحوذ على القصة، ويفرض عليها وجهة النظر النهائية، ليقدمها في عمل سينمائي أو تلفزيوني، يحمل بصماته الخاصة، ويحدد الإطار الذي ستصل فيه هذه القصة إلى المشاهد، وليس القارئ، فالمشاهد ليس لديه خيارات في استقبال الصورة التي تعرضها عليه الشاشة، أما القارئ فإنه يتمتع بحرية تخيل الوجوه والأمكنة والإضاءة والألوان، ولهذا السبب لم يسمح ماركيز نفسه بنقل روايته الشهيرة “مائة عام من العزلة” إلى السينما، لكي لا يحرم القارئ من تخيلاته الخاصة لأجواء هذه الرواية وأحداثها وشخصياتها.
الإثارة في الواقع
يتذكر ماركيز حادثتين واقعيتين مثيرتين، الأولى هي حادثة تحطم طائرة في خليج غوانا نارا في البرازيل، حينما زار الرئيس الأميركي أيزنهاور مدينة ريو، وكانت الطائرة المنكوبة تحمل الفرقة الموسيقيةالتي رافقت الرئيس، وقد غرقت بكل ركابها، ولكن الآلات الموسيقية طفت على سطح الماء، وانتشرت في الخليج، وكان هذا المشهد النادر مثيراً، ويمكن أن يكون أرضية لقصة سينمائية.
أما الحادثة الثانية، فهي محاولة اغتيال الجنرال ديغول، وقد تحولت إلى رواية كتبها فريدريك فورسيت بعنوان “يوم ابن آوى” وتحولت الرواية إلى فيلم سينمائي مثير، وتتمركز الإثارة في الترتيبات الدقيقة التي أنجزها شخص بمفرده لاغتيال الجنرال عندما يلقي خطابه، وحينما جاءت اللحظة المناسبة كان كل شيء جاهزاً بتفاصيله الدقيقة، ولكن الجنرال أحنى برأسه بشكل غير متوقع في اللحظة التي انطلقت فيها الرصاصة، ولم تكتمل الجريمة، ومات الجنرال ديغول بعد سنوات وهو في سريره، يشاهد أخبار التلفزيون، وهذه هي المفارقة التي تحمل الإثارة.
الحقيقة التي لا تُصدّق
طرحت في لقاءات الورشة أفكار ومشروعات متعددة ومختلفة، يمرّ بعضها في شكل عابر، يثير بعض التداعيات والأسئلة، قبل أن يختفي، لتظهر أفكار ومشروعات ساخنة تستقطب اهتمام المشاركين، كما هو الحال في فكرة “القصة الحقيقية التي لا تُصدّق لرجل مقيت” التي طرحتها “اليزابيت” وتقول: إن الشرطة قامت بتفتيش بيت جوزيه كارلوس ألفيس، في مدينة برازيليا، عام 1993، ووجدت تحت فراش سريره ثمانمئة ألف دولار، كان بينها ثلاثون ألف دولار مزيّف، وكان جوزيه اقتصادياً مشهوراً، وموظفاً كبيراً يتحكم بميزانية البلاد، وهو أستاذ جامعي أيضاً، وفي فترة الديكتاتورية العسكرية في البرازيل لم يكن أحد يستطيع أن يعطي رأياً أو يتساءل حول الميزانية العامة، ومع ذلك كانت هناك لجنة للميزانيات برئاسة جوزيه نفسه، صار النواب في ما بعد يطالبونها بتنشيط الإصلاحات في ولاياتهم، وبسبب أهمية نفوذ جوزيه وافقت الحكومة على تعيينه مستشاراً للبرلمان بعد أن أجبرته على تأجيل تقاعده، ومدّدت له الخدمة.
كان السبب الأول وراء تفتيش الشرطة للمنزل هو اختفاء زوجة جوزيه، وتأخره في الإبلاغ عن الحادث، ولكن هذا الحادث يصبح ثانوياً، أمام الفضائح التي كشفتها التحقيقات، حيث تورط أربعون نائباً وثلاثة حكّام ولايات وأربعة وزراء سابقين ووزيران في الحكومة الجديدة، ومن بين النواب سبعة من أعضاء لجنة الميزانية التي يديرها جوزيه كارلوس ألفيس. ومن المصادفات الغريبة أن هؤلاء السبعة كانوا من قصار القامة، وقد أطلق عليهم الناس بعد فضيحة الفساد إسم “الأقزام السبعة” وبينهم جواو ألفيس الذي كان يرسل حقائب الدولارات إلى جوزيه كارلوس، وكان قد حرّك في حساباته المصرفية مبلغ ثلاثين مليار دولار، بينما كان جوزيه يشتري كميات كبيرة من أوراق اليانصيب ليغسل بأرباحها أمواله التي لا تحصى.
المسلسلات الثعبانية
إن صناعة المسلسلات التلفزيونية والإذاعية الطويلة في أميركا اللاتينية تخفي وراءها أسراراً مثيرة، وكانت هذه المسلسلات المشحونة بالعواطف موضوعاً للمناقشة في إحدى الجلسات، وقد أعطاها ماركيز إسم المسلسلات الثعبانية.
تقول غابرييلا، التي تعمل في مطابخ المسلسلات المكسيكية، انها وزملاءها اضطروا الى اضافة مئة حلقة الى مسلسل “ماريا ببساطة” بعد بداية بثّه، لإرضاء المشاهدين، بعد أن تعاظم إعجابهم بالمسلسل قبل أن ينتهي بثّه. ويذكر ماركيز ان مسلسل “الحق بالولادة” لفيكس كايغنت كان يضم شخصية تدعى “دون رافائيل”، وقد طلب الممثل الذي يؤدي دور هذه الشخصية في المسلسل بزيادة أجره، بعد أن وصلته أصداء الإعجاب بالحلقات الأولى، فقام كايغنت الذي لا يخضع للضغوط بجعل هذه الشخصية تصاب بانحباس الصوت، وحيث أن هذه الشخصية تحمل سراً كبيراً وخطيراً فقد ارتفعت اصوات الجمهور تتساءل: متى سيتكلم دون رافائيل؟ ولكن هذا الصمت استمر حتى اتفق كايغنت مع الممثل على مقدار الأجر، وكان كايغنت يقول: “انني انطلق من قاعدة تقول: ان الناس يريدون البكاء، وأنا أعطيهم الذريعة لذلك”.
وتساءل احد المشاركين في المناقشة عن كمية الأمتار المكعّبة من الدموع التي أريقت في بوغوتا مع بث مسلسل “الحق بالولادة”، وقال ماركيز: انه لا يتجرأ على حساب الكمية التي أريقت في أميركا اللاتينية كلها، في فترات بث المسلسلات، أو عرض الأفلام.
اللحظة المناسبة
طرح “غوتو” مشروع قصة سيناريو، عن حادثة واقعية حصلت له، فقد سافر منذ سنوات مع أسرته للإصطياف في أحد المنتجعات البرازيلية، وهناك تعرفت العائلة على زوجين لطيفين جداً، ونشأت بين العائلتين بداية صداقة، وبعد فترة سافر غوتو الى بوينس إيرس لدراسة السينما، ثم لحق به والداه في زيارة له، وكان يسكن في فندق، وقرر والدا غوتو الإتصال بالزوجين اللذين تعرفا عليهما في المنتجع، فجاء الزوج بيتر بمفرده، وقال انه قد انفصل عن زوجته، وأنه يعيش وحيداً في شقة من غرفتين، واقترح ان ينتقل غوتو من الفندق ليعيش معه، ولكنه يحتاج الى شراء “صوفا” لينام عليها في الصالة، وهذا ما حدث، ولكن بيتر طلب من غوتو ان يغيب عن المنزل في الفترة من الظهيرة حتى الساعة العاشرة ليلاً، بحجة ان هناك طبيبة نفسية تستخدم الشقة كعيادة في هذه الفترة، فوافق غوتو، وصار يعود الى المنزل في الحادية عشرة ليلاً، وفي إحدى المرات عاد غوتو الى المنزل في الموعد المألوف، وحينما فتح الباب رأى مشهداً غريباً لا يخطر له على بال، وكان ذلك كافياً لكي يترك البيت ويسكن في مكان آخر.
نظرية داروين مقلوبة
تبدو نظرية داروين حول تطور القرد الى انسان مقلوبة في مشروع قصة “حول لاتطور الأنواع” الذي طرحته البرازيلية اليزابيت، فقد رأت – في الواقع او في الحلم – في حديقة حيوان قفصاً ضخماً، في داخله غوريلا، كانت تلك الحديقة جزءاً من مدينة ألعاب في نيويورك، وكان الغوريلا يجلس على حجر، متخذاً هيئة الإنسان المفكر، وحينما يمر بجانبه السائحون يقفز ليمسك بقضبان القفص ويبدأ بالصراخ، وكان في صراخه يردد كلمات محددة، هي اسماء مدن برازيلية، وهذا ما أثار دهشة اليزابيت وحزنها وخجلها معاً، حيث خطر لها ان هذا الغوريلا كان مواطناً برازيلياً ولكن ما هي المراحل التي مرّ بها قبل ان يتحول الى غوريلا في نيويورك؟!
أوديب في كولومبيا
اقتصرت احدى جلسات الورشة على مناقشة سيناريو فيلم “اوديب عمدة” الذي كتبه ماركيز، وأخرجه خورخي علي الذي حضر الجلسة، وساهم في المناقشة، وفي هذا الفيلم حاول ماركيز إسقاط مسرحية “أوديب ملكاً” لسوفوكليس على كولومبيا، أو العالم. وذكر ماركيز انه قرأ هذه المسرحية وهو في الثانية والعشرين من عمره، حينما بدأ حياته كصحافي وكاتب قصص، أي قبل نصف قرن، وقال: ان هذه المسرحية كانت اول هزة ثقافية كبيرة في حياتي، كنت اعرف بأنني سأصير كاتباً، وعندما قرأت ذلك الكتاب قلت لنفسي: هذا هو النمط من الأشياء التي أريد كتابتها.
ويمكن أن نتذكر ان هناك اكثر من خمسة وعشرين اقتباساً معروفاً عن هذه المسرحية، وكان بازوليني ابرز المخرجين السينمائيين الذين قدموا “أوديب” في اسقاط عصري، ولكن ما جدوى تقديم عمل أدبي كلاسيكي في ثياب عصرية وإلى أي مدى يمكن للمؤلفين والمخرجين أن يضيفوا ويحذفوا، في الأسماء والأحداث والعلاقات المعروفة بين الشخصيات؟ هذا ما يحاول ان يجيب عنه المخرج السينمائي خورخي علي الذي يبدو منسجماً مع ماركيز، حيث يقول: “كم من المرات يذهب احدنا لمشاهدة “هاملت”، على رغم انه يعرف ما سيحدث؟ قد يذهب احدنا لمشاهدة “عطيل” وهو يعرف ان عطيل سيقوم في المشهد الأخير بخنق ديدمونة، ولكن ما أهمية ذلك؟ فما يريد أحد مشاهدته هو كيف يحدث ذلك، وبأي أسلوب، وبأي طريقة يتصرف الممثلون، وما هي العناصر الإخراجية الجديدة التي تدخل اللعبة..؟!”.
إن الوباء الذي يعم البلاد في مسرحية سوفوكليس يتحول الى المجازر التي تحدث في كولومبيا في سيناريو ماركيز الذي لا يرى أملاً قريباً في الخلاص، بينما يحتفظ خورخي علي في ذاكرته بأرشيف من الصور التي بثتها وكالات الأنباء عن كولومبيا” إنه أرشـــيف مليء بالجثث، بأجساد مهجورة في الممرات، في مدرجات القرى بعد هجمات حرب العصابات.
رسالة إلى غابرييل غارسيا ماركيز/ ربيع جابر
< لن يقرأ الرجل هذه الرسالة. حظه طيب. عمره 82 عاماً ويحيا بين أوروبا وأميركا وساعة الصباح لا يفتح جرايد عربية. بلى، يهوى الصحافة، ومنذ سنوات تملّك صحيفة في كولومبيا. لكنه لا يتقن العربية الى ذلك الحد. أبناء العالم الثالث ينقسمون على لغات كثيرة، أكثر من 72 لغة، ولا نعلم ماذا يجمع بينها. لن يقرأ هذه الرسالة. الثغرة الوحيدة التي يجوز من خلالها أن تبلغ هذه الرسالة صندوقه البريدي اسمها حماقة الآخرين: ان يدخل مجهول على الخط ويحمل هذه الكلمات اليه مترجمة.
عمره 82 عاماً ولم يعد يهتم بالرسائل. قال انه وضع القلم من يده وهذا يعني أنه كفّ عن الكتابة. هل يصدق نفسه؟
بين شهر وآخر يعود الواحد منا الى”مئة عام من العزلة”1967 ويقرأ عن الحياة في ماكوندو. هو يقرأ وماركيز يكتب من أجله. لا يكف عن الكتابة لحظة هذا الرجل، أحقاً يظن أنه اعتزل الكتابة؟ أمس، يوم الاثنين 6 نيسان/ ابريل 2009، كتب مرة أخرى”مئة عام من العزلة”.
كان في الأربعين من عمره عندما نشر ذلك الكتاب. الطبعة الأولى من”مئة عام من العزلة”نزلت الى المكتبات أثناء”حرب الأيام الستة”. بلى، حزيران يونيو 1967. كان يفتح جرايد بوغوتا وبوينس أيرس؟ هناك نُشرت الطبعة الأولى كي يقرأ شيئاً عن روايته هل فعل ذلك؟. قرأ عن الحرب في الشرق الأوسط ودخن عدداً من السجائر. ماكوندو حقيقة وحروب الشرق الأوسط أكذوبة؟ كان يغرق في غيمة تبغه وفي تلك الأثناء نفدت الطبعة الأولى من الرواية. قال انه تفاجأ. وناشره أيضاً تفاجأ. ولا بد من أن القراء تفاجأوا أيضاً. ماكوندو باغتت الجميع. هذا العالم الحقيقي والخيالي. ما الخيال وما الواقع؟ ماركيز لا يقدر أن يميز بين الاثنين.
كانت روايته الرابعة. لعلها الخامسة. هل تخيل وهو يذكر أوريليانو بوينديا في”ليس لدى الكولونيل من يكاتبه”1961 أن هذا المحارب الخرافي سيظهر من جديد بعد سنوات قليلة في رواية عن عائلته وأهله وأولاده؟ هذا كولونيل آخر، ليس عجوزاً، ويقدر أن يعتبر نفسه إحدى أهم الشخصيات الروائية في تاريخ الأدب. هو يصنع الأسماك المذهبة أو يشنّ 32 حرباً أهلية صغيرة ونحن نعتبره ما نشاء. أين تكمن القوّة الغامضة لهذه الرواية؟ في بناء القرية الأسطورية ماكوندو؟ في الشخصيات التي تتحرك أمامنا كأنها حاضرة على كوكب الأرض كما لن نحضر أبداً؟ في الحكايات التي تتوالى محبوكة بفنٍ لا يضاهى؟
كيف يكفّ ماركيز عن الكتابة؟ حتى لو سكت عن الكتابة وهو في الأربعين، حتى لو لم يسطر”خريف البطريرك”1975 و”سرد أحداث موت معلن”1981 و”الحب في زمن الكوليرا”1985… حتى من دون هذه الكتب كلّها لم يكن أحدنا يقول انه ساكت. الرجل يتكلم معنا بلا توقف، هل كفّ عن التدخين؟ كافكا هجم المخلب على رقبته من دون أن يشعل تبغاً. وماركيز؟ عمره 82 عاماً لكنه ثابت الى الأبد في سن الأربعين. أو ما قبل الأربعين. كتب”مئة عام من العزلة”في عام واحد 1966. في شهور؟ في 15 شهراً؟ في 7 شهور وحسب؟ قد يعطينا جواباً، لكن هل نصدق؟ كيف يصدق القارئ رجلاً كتب كل تلك الروايات؟
في أي لحظة هاجمه الفرح اللانهائي وغمره كالطوفان؟ بينما جوزيه أركاديو يمد يده ويقبض على ريبيكا؟ بينما 16 رجلاً يحملون الاسم ذاته أوريليانو تطاردهم الرصاصات وتخترق صلبان الرماد في جباههم؟ متى شعر أنه يرتفع على موجة خيالية والصور تهجم عليه من حيث لا يعلم: وهو يكتب عن جوزيه أركاديو الثاني ناهضاً من بين الأموات في القطار الليلي الذي يترك ماكوندو بعد المذبحة؟ لعل هذه الصفحات ? بينما الرجل يعود تحت المطر، مصدع الرأس وفي شعره الدم اليابس ? أجمل صفحات”مئة عام من العزلة”. عندما يدخل مطبخاً، مضطرباً كشبح، يقول للمرأة اسمه. كي يتأكد أنه موجود. تسكب له القهوة بلا سكر وبينما يشربها هل شربها؟ نعرف أننا أحياء. هل نحن أحياء؟
بعد المطر الذي يتساقط أربع سنوات وأحد عشر شهراً ويومين يخرج أوريليانو الثاني كي يتفقد ماكوندو. في تلك الساعة يكتب ماركيز من أجل قراء عرب لا يعرفهم لا يعرفونه:”الذين نجوا من الكارثة كانوا سكان ماكوندو من قبل أن تهزها عاصفة شركة الموز. رآهم جالسين وسط الشارع يعرّضون أنفسهم لأشعة الشمس وما زالت على أجسادهم خضرة الطحلب ورائحة الحبس التي بللها المطر، غير أنهم كان يبدو عليهم الفرح لأنهم استعادوا أخيراً قريتهم التي ولدوا فيها. وعاد”شارع التركو”الى ما كان عليه من قبل، شارع العرب وأخفافهم، والأقراط في آذانهم، أيام كانوا يجوبون العالم يبدلون الببغاوات بالألعاب، حين وجدوا في ماكوندو زاوية صغيرة من الأرض يرتاحون فيها من عناء رحيلهم التاريخي. كانت البضائع في البازار خلال سنوات المطر تتساقط كاليخنة وتتبرقش البضائع المعروضة على الأبواب بالطحالب. والواجهات عاث فيها دود الخشب، والجدران تآكلت رطوبة، لكن عرب الجيل الثالث كانوا يجلسون في المكان نفسه، وفي الوضع نفسه الذي جلس عليه آباؤهم وأجدادهم، صامتين، لا يهزهم الخطر، ولا ينال منهم الزمن ولا الكارثة. ظلوا كعهدهم بعد وباء الأرق وحروب العقيد أوريليانو بوينديا الاثنتين والثلاثين، لا يتبدلون في حالتي الحياة والموت. لقد أظهروا قوة روحية عجيبة أمام بقايا طاولات اللعب، وعربات باعة المقليات، وبسطات إصابة الهدف، والشارع الصغير الذي كانت تفسر فيه الأحلام ويُقرأ المستقبل. ولما سألهم أوريليانو الثاني، بطريقته المرحة المألوفة، عن أية وسيلة خفية استخدموا كي ينجوا من الكارثة، وماذا صنعوا كي لا يموتوا غرقاً، أجابوه واحداً بعد الآخر، من باب الى باب، وهم يرسلون اليه الابتسامة الذكية نفسها، والنظرة الحالمة نفسها، الجواب نفسه من دون أن يتفقوا عليه، قالوا له: كنا نسبح”.
في هذا المقطع نعثر على أسلوب ماركيز”المرح المألوف”وهو يتألق: بضربات سريعة يرسم شارعاً وعالماً كاملاً وطقوس”عرب الجيل الثالث”الذين استقروا في احدى زوايا ماكوندو ليرتاحوا من”عناء رحيلهم التاريخي”. كيف تبدل هذا المقطع وأثره فينا بعد 11 أيلول سبتمبر 2001؟
هل كتب ماركيز تلك السطور”من أجل قراء عرب لا يعرفهم ولا يعرفونه”؟ هذه جملة للمحو. في سنته التاسعة والثلاثين على هذه الأرض كتب الرجل ? ليس من أجل أحد ولكن حبّاً بالكتابة – 400 صفحة يصعب أن تقع في هوّة النسيان. في سنته الأربعين رأى الصفحات مجموعة بين دفتي كتاب. الرواية التي كانت خيالية وغير موجودة وكامنة في أعماقه خرجت منه، وهو يقعد الى طاولة الكتابة، ثم غادرت الغرفة الموصدة الى الناشر، الى المطبعة، الى أنوار العالم. صارت موجودة. بعد مرور هذه السنوات الطويلة هل يتذكر ماركيز تلك اللحظة الأولى، وهو يكتب تلك الجملة الأولى في بداية الكتاب:”بعد سنوات طويلة، وأمام فصيل الإعدام، تذكر الكولونيل…”. بينما يكتب الجملة الأولى هل كان يتخيل أين ستأخذه الفصول، هل كان يعرف الكلمات الأخيرة في الكتاب:”… فالسلالات التي قدر لها القدر مئة عام من العزلة لا يمنحها القدر على الأرض فرصة أخرى”.
عمره 82 عاماً الآن. كيف يقطع الوقت، ماذا يقرأ؟ قصص بورخيس،”حياة تيديو أيزيدورو كروز”،”الموت الآخر”،”التحدي”،”بيدرو سالفادورس”؟ يكرر قراءة”يوميات سنة الطاعون”؟ يقرأ”بيدرو بارامو”،”سور الصين العظيم”،”لعبة الحجلة”،”آنا كارينينا”، دانتي،”جبل الروح”،”الإلياذة”، شكسبير، و”العهد القديم”؟ ماذا يتذكر بينما يقرأ للمرة التي لا يعرف رقمها كتاباً قديماً طالما أحبّه؟ هل يفكر في الوقت ومرور السنوات؟ هل يتذكر قرية الطفولة والجدّة التي تشبه أورسولا تعجن وتخبز في الفرن الحطب خبزاً وحلويات؟ كيف مرّت الحياة؟ ماذا يتلاشى وماذا يبقى؟ بين اسبانيا والمكسيك وكولومبيا كم خطاً رسمت خطواته؟ أقام زمناً في باريس، كيف يتذكر تلك الأيام؟ قال في مقابلة في الثمانينات الخيالية للقرن العشرين إنه يعلم أنه مقروء في اللغة العربية، مع أن أحداً ناشراً لم يتصل به ويأخذ حقوق الترجمة والنشر! هل كان مبالياً؟ أم كان يداعب القراء الخياليين؟”مئة عام من العزلة”موجودة في العربية، في أكثر من ترجمة. وكذلك أعماله الأخرى. هل يهمّه الأمر؟
هذه رسالة لن يقرأها. هل يحبّ الكلمات المتقاطعة؟ يقص الشبكة من الجريدة ويتسلى بها في ساعات الصباح؟ يحبّ المشي والرياضة؟ ينزل ويسبح ظهراً في البركة المستطيلة؟ عندما تمرّ شخصياته أمام عينيه، ساعة القيلولة الحارة، هل يمدّ يده ويستوقف الكولونيل بوينديا؟ انتهت حياة الكولونيل يوم رجوع السيرك والغجر الى ماكوندو. كان النمل الطيّار يملأ الجو. قبل أن يلفظ الروح، وحيداً تحت شجرة في مؤخرة البيت، استعاد ذكريات قديمة. كانت عزلته شبه كاملة. وماركيز؟ يحيا ماركيز بين عدد لا يحصى من القراء. هؤلاء خياليون، لن يقعدوا معه الى مائدة واحدة، لكنهم يعرفونه. ما يربطهم خيالي أيضاً. في أراضي الأدب الغامضة تمتد الحياة، ثرية ومتشعبة، الى ما لا نهاية.
رحيل ماركيز: ساحر الرواية/ اسكندر حبش
رحل «غابو» (اسمه المستعار الذي أطلقه عليه أصدقاؤه)، ومعه تغيب صفحة كبيرة من أدب أميركا اللاتينية. لم يكن غابرييل غارسيا ماركيز، اسما عاديا في تاريخ الأدب العالمي، بل عرف كيف يكون الأدب بأسره. عرف ابن كولومبيا، الذي أخلص للكتابة (ولا شيء سواها)، كيف يُغيّر وجه الكتابة الروائية بما سميّ «بالواقعية السحرية». السحر هنا، لم يكن سوى استعادة لتاريخ العادات والتقاليد، ليضعها مجددا في قالب آخر يبحث عن حقه في الحياة، وعن حقه في كتابة التاريخ الذي لا يسيطر عليه «اليانكي» (مثلما كان يردد دائما).
هل لذلك لم يعاند رغباته، بل استسلم لها، حتى وان جعله هذا الأمر يتخطى الحدود مرارا وتكرارا؟ فالخطوط الجغرافية، بالنسبة إليه، أمر «مجهول» تمام الجهل، إذ غالبا ما نراه ينتقل من مكان إلى آخر، حاطا رحاله هنا وهناك، ليرتاح قليلا، أو ليستعيد أنفاسه. في أي حال، مهما يكن من أمر، وكما صرح ذات يوم في أحد أحاديثه الصحافية «لن تجدوني صباحا في أي مكان». أعتقد على العكس من ذلك. أن تكون في الأدب، يعني أن تكون في كل مكان. يكفي فقط أن نقرأ غابرييل غارسيا ماركيز لنكتشف كم أن الحياة واهية في كثير من الأحيان، وأن الكلمات هي مكان الإقامة الحقيقي.
من «مائة عام من العزلة»، الرواية التي جعلت اسمه حاضرا دوما، إلى القول إن «العزلة لم تعد ممكنة» (بعد إصابته بالمرض الذي قضى عليه)، تبدو المسيرة مليئة بالترحال والهجرة والنضال، لكن أيضا المليئة بالكتابة. لقد عرف كيف يجعل من كلّ لحظاته، لحظات سعادة للآخرين، قبل أيّ شيء آخر: فالأدب بالنسبة إليه، لم يكن سوى هذه المشاركة مع الآخر الذي ينتظر الكلمات. والكلمات كانت صعبة في كثير من الأحيان. بدأ كتابة المقالة الصحافية، ثم القصة القصيرة، ومن بعدها الرواية والسيناريو السينمائي. وفي ذلك كلّه، بقي ماركيز مخلصا لكلّ مبادئه: على الكتابة أن تغير الحياة.
قد يبدو مشروعه صعب التحقيق، لكنه استمر في هذه المنطقة التي تقنعنا أن ثمة حبا يأتي «في زمن الكوليرا». أي ثمة أمل ولا يمكن للحياة أن تبقى أسيرة الوهم، وإن كان بدأ بالوهم حين اعتقد أن الاشتراكية ستلف العالم وأن الامبريالية زائلة. الأهم في ذلك كله، أن الكلمة بقيت، وأن تاريخ أميركا اللاتينية يقرأ عبر رواياته من «ليس لدى العقيد من يكاتبه» إلى «خريف البطريرك»، و«من مائة عام من العزلة» وصولا إلى «وقائع موت معلن». عديدة هي الكتب التي جعلتنا نعيد اكتشاف التاريخ، أي نعيد اكتشاف ذواتنا. أليس الأدب هو هذا الرهان على أننا نعيش الحياة؟
يرحل ماركيز، ومعه تنطوي سيرة كاملة. يبدو أن العالم بأسره بدأ يطوي الكثير من حقباته. لكن ما يطمئننا، أن الأدب سيبقى حاضرا. يكفي أن نعيد قراءة ما كتب.
ماركيز صديق العرب ورمز الوحدة الوطنية في بلد ممزق/ بشير البكر
آن لهذا الفارس أن يترجل. فبعد مسيرة حافلة من الأدب والصحافة والمواقف السياسية المنحازة دوماً إلى الشعوب المظلومة والقضايا العادلة، رحل عنا ماركيز تاركاً خلفه أدباً إنسانياً خالداً .
كولومبيا التي لا تزال تعيش شبه حرب أهلية وتجاهد للخروج منها في عملية مصالحة عسيرة، تبكي رحيل كاتبها الأعظم غابرييل غارسيا ماركيز. أمة بكاملها في حداد، حكومة ومعارضات، سياسية ومسلحة ، ولكن ليست كولومبيا وحدها في مأتم، بل كل أمريكا اللاتينية .
لقد كان صاحب “مائة عام من العزلة”، و”الكولونيل الذي لا يجد من يكاتبه” و”الحب في زمن الكوليرا” وغيرها، كاتب أمريكا اللاتينية كلها. ولم تستطع حالة الانقسامات التي تعيشها القارة، حديقة واشنطن الخلفية، أن تمنع كتبه من اكتساح مكتباتها والولوج إلى قلوب ملايين القراء المتعطشين إلى الحرية، التي نادى بها سيمون بوليفار، ولم يستطع تحقيقها في حياته .
وخلافاً لحالة “القُطريَة” التي تسود في أدبنا وثقافتنا العربيين فقد كان غابرييل، الهارب من بلده والمقيم في المكسيك، هذا البلد الكبير المضياف الذي منح اللجوء والضيافة لمئات من كتاب أمريكا اللاتينية الهاربين من ديكتاتوريات قاتلة موالية لواشنطن، يكتب من هناك وتتلقف كتبه ومقالاته كل أمريكا اللاتينية .
من الصعب، بل من المستحيل، كما يقول الكاتب المكسيكي الراحل كارلوس فوينتس، وكان صديقاً لماركيز، الحديث عن أدب مكسيكي أو كولومبي أو أرجنتيني أو بيروفي، بل الصحيح الحديث عن أدب أمريكا اللاتينية بجزئه المكسيكي والأرجنتيني والبيروفي وغيره .
وإذا كانت رواية “مائة عام من العزلة” منحت لصاحبها جائزة نوبل، وجعلت النقاد يتحدثون عن الواقعية السحرية، فإن غابرييل غارسيا ماركيز لا يخفي أن الكثيرين من عمالقة الأدب في أمريكا اللاتينية أثّروا فيه، وفي مقدّمتهم المكسيكي خوان رولفو والأرجنتيني خوليو كورتثار وخورخي لويس بورخيس وجورج أمادو وغيرهم .
عاش ماركيز،الذي اشتهر بوفائه لأصدقائه، ولعل من أهمهم الزعيم الكوبي فيديل كاسترو، مسافراً ومترحلاً على الدوام. ويعترف بأنه تعرف على القضايا العربية، وخصوصاً فلسطين، في باريس، إبان فترة ثورة الشعب الجزائري من أجل تحقيق استقلاله. وكانت سحنته التي تشبه سحنات الجزائريين تثير شبهات الشرطة الفرنسية، فكان يُعتقل معهم، وهناك تعرف إلى بعض الوطنيين الجزائريين الذين تعلم منهم الكثير عن هذه الشعوب التي تعيش مصيراً واستعماراً يشبه حالة شعوب أمريكا اللاتينية. وهناك في باريس، ربحت القضية العربية والفلسطينية مُناصِراً ظل معها على الدوام. لكنّ السياسي العربي المنهمك في السلطة لم يُكلف نفسه عناء تكريم الرجل، كما فعل الكيان الصهيوني مع جان بول سارتر وغيره، فأصبحوا يتبنون سياساتها .
نقرأ للكاتب الكولومبي داسّو سالديفار في كتابه البيوغرافي: «غارسيا ماركيز، سفر إلى الينبوع» الصادر عن دار «لوغراند ميروار» البلجيكية، فصولاً مشوّقة تتحدث عن المرحلة الباريسية في حياة غارسيا ماركيز وإقامته في شارع «كوجاس»، في الحي اللاتيني، الذي أطلق عليه اللاجئون المنحدرون من أمريكا اللاتينية اسم «قبيلة كوجاس» الأمريكية اللاتينية، حيث تأثر ماركيز كثيراً بثورة الجزائر، وتقاسم السجن مع المواطنين الجزائريين، فقد كانت سحنته توحي للشرطة الفرنسية بأصول مغاربية! وفي هذا الإطار يقول داسّو «لم تكن حرب الجزائر تحتل الساحة الإعلامية بعدُ، ولكنها كانت واقعاً مُهدِّداً لغابرييل غارسيا ماركيز لسحنته العربية (رأسه يشبه رؤوس العرب)، وقد دفع الثمن، إذ لدى خروجه من قاعة سينما ذات مساء، اعتقد رجال الدرك الفرنسيون أنه جزائري، فأشبعوه ضرباً ونقلوه إلى مقر الشرطة في “سان جيرمان ديبريه” مع جزائريين حقيقيين، حزينين وذوي شوارب مثله، وتلقوا هم أيضاً الضربات. وكي يُهدِّئوا من ضيقهم أطلقوا العنان طول هذه الليلة لترديد أغاني الفرنسي “جورج براسانس”. فارتبط ماركيز بصداقتهم، وبالأخص بالدكتور أحمد طبّال الذي نجح في تحسيسه بقضية وطنه. في هذه الحقبة أنجز غابرييل ماركيز العديد من الريبورتاجات عن حرب الجزائر وعن حرب قناة السويس” .
والذي يكتشف حجم الشهادات وتنوعها في حق الرجل يكتشف حجم الخسارة التي منيت بها الثقافة العالمية، على الرغم من أن غابرييل غارسيا ماركيز كان مريضاً ومتوقفاً عن الكتابة. فمن الرئيسين الأمريكيين، السابق بيل كلينتون، الذي “يعتز بصداقته لماركيز خلال عشرين عاماً” والحالي باراك أوباما، ومن رئيس كولومبيا اليميني إلى الفارك، المنظمة الثورية المسلحة، ومن كل رؤساء أمريكا اللاتينية إلى رؤساء العالم أجمع، إلى مواطنته المغنية شاكيرا جاءت الإشادة بهذا الرجل وأدبه ومساهماته .
والحقيقة أن الإشادة المكسيكية، إضافة إلى الإشادة الكوبية، أكثر قوة وصدقاً، فقد منحته المكسيك فرصة قلما وجدها في بلد آخر. وقد عبر الرئيس المكسيكي الحالي بحق عن الأمر حين قال: ” إن كتاباته جعلت الواقعيةَ السحريةَ الأمريكية اللاتينية كونيةً، فأثّر في ثقافة زمننا”، وأضاف أن هذا الكاتب المولود في كولومبيا “جعل من المكسيك “بيته”، مُثرِياً حياتَنا الوطنية” .
وقد شكّل رحيل ماركيز فرصة لمصالحة تاريخية بينه وبين ماريو فارغاس يوسا عملاق الأدب البيروفي، إذ كانت قطيعتهما انكساراً كبيراً في أدب أمريكا اللاتينية، وكانت مَعارِضُ الكِتَاب في المكسيك كل سنة تمنح الكثير من الأمل لمصالحة تأبى أن تتحقق. فقد فرقت السياسة الكوبية بين الرجلين، اللذين كانا يساريين معاً، في حقبة من تاريخهما، فظلّ ماركيز وفياً للثورة الكوبية، رافضاً أن يُدلي بأي تصريح علني ضد انتهاكات كوبا لحقوق الإنسان، مفضلاً التدخل الشخصي لدى كاسترو، في حين أن الثاني انشق وحارب الثورة الكوبية وتبنّى الليبرالية السياسية وترشح لرئاسة البيرو لولا أنه فَشِل فربح الأدب وحصل، هو الآخر، على جائزة نوبل. وقال يوسا: “إن روايات غابرييل غارسيا ماركيز ستعيش بعد موته، وسيفوز بِقرّاء في كل مكان من العالم” .
وفي مايخص القضية الفلسطينية فإن ماركيز نشر عام 1982 بيانه الشهير عن مجزرة صبرا وشاتيلا، وندد فيه بالعمل الإجرامي بحق اللاجئين الفلسطينيين، وفي العام 2002، وحين اقتحمت القوات الصهيونية المدن الفلسطينية في الضفة وأعادت احتلالها، أصدر بيانه الناري الذي يدين فيه المجرمين الصهاينة، والذي يندد فيه بمواقف الكتّاب والمثقفين الصامتين في العالم لخوفهم من أن يوصموا بمعاداة السامية، وقال في نهاية البيان، لكل هؤلاء أقول أنا غابرئيل غارسيا ماركيز أوقّع على هذا البيان منفرداً.
جميع حقوق النشر محفوظة 2014
غابرييل غارسيا ماركيز.. العمالقة لا يموتون
باريس – أنطوان جوكي
“مئة عام من الوحدة والحزن لموت أعظم كولومبي في تاريخنا”، صرّح رئيس كولومبيا البارحة فور وفاة أحد أكبر عمالقة أدب أميركا اللاتينية، غابرييل غارسيا ماركيز. تصريح جاء بعد دقائق قليلة من إعلان قناة “تيليفيزا” المكسيكية أن الكاتب الذي كان قد بلغ السابعة والثمانين من العمر توفي في منزله في مكسيكو محاطاً بزوجته وابنيه، بعد معاناته في أيامه الأخيرة من إلتهاب رئوي.
من مواليد مدينة أراكاتاكا الكولومبية (1927)، لا شيء في طفولة ماركيز يفسّر عبقريته اللاحقة في الكتابة والسرد. لا شيء.. باستثناء عناصر من سيرته الذاتية نعثر عليها في معظم أعماله. فجدته التي ترعرع في كنفها كانت تصدّق بالأشباح والتنبؤات، ونتعرّف إليها تحت ملامح شخصية أورسولا بوينديا في “مئة عام من العزلة. وجدّه “بابا ليلو” الذي روى لحفيده مئات المرات قصة المجزرة التي قام بها الجيش الكولومبي بحق عمّال “شركة الثمار المتحدة” المضربين؛ يحضر بدوره مع هذا الحدث في الرواية المذكورة.
أما والده، غابرييل إيليجيو، ووالدته، لويزا سانتياغا ماركيز، المتيّمين ببعضهما بعضاً، فكان عليهما مواجهة رفض والدّيّ لويزا لعلاقتهما كي يتمكنا من عقد قرانهما، وهو الموضوع الذي استفاد منه لاحقاً في رواية “الحب في زمن الكوليرا”.
درس ماركيز الحقوق في مدينة بوغوتا الباردة التي شعر داخلها بالغربة، بعيداً عن موطن ولادته. وفي تلك الفترة كتب قصته الأولى “الاستقالة الثالثة” التي صدرت في صحيفة “إل إسبكتادور”. وفي مدينة كارتاجينا حيث انتقل لمتابعة دراسته، أخفق في الحصول على شهادته، لكنه اكتشف شغفاً جديداً، الصحافة، فبدأ في الكتابة مع صحيفتَي “إل يونيفرسال” و”إل هيرالدو”. وفي هذه المدينة أيضاً التقى كتّاب مجموعة “”بارانكويلا” وقرأ جميع أعمال فيرجينيا وولف وجايمس جويس وويليام فولكنر الذين شكلوا مصدر وحي كبير لنصوصه اللاحقة.
في العام 1955، صدرت روايته الأولى “أوراق في العاصفة” التي تظهر فيها للمرة الأولى قرية “ماكوندو” الخيالية والنموذجية. لكن، على أثر التهديدات التي تلقاها بسبب مقال شكّك فيه بالموقف الرسمي من غرق السفينة الحربية الكولومبية، “كالداس”، اضطر ماركيز إلى الاستقرار في أوروبا حيث تابع عمله الصحفي كمراسل. عملٌ سيمنح رواياته تضاريسها الخاصة.
وبعد عودته إلى أميركا اللاتينية، وجد هذه القارة أكثر حيوية من أوروبا، فعمل في كاراكاس داخل صحيفة “مومِنتو”. وفي تلك الفترة، استوحى من هروب الرئيس ماركوس بيريز جيمينيز إلى جزيرة سان دومانغ، لكتابة رواية “خريف البطريرك” (1975) التي جدد فيها النوع الروائي المرصود لفضح الطغاة. وفي العام 1959، زار كوبا وتعاطف مع القضية الثورية، فأسس وكالة إعلامية كوبية، “برينسا لاتينا”، وعمل فيها من نيويورك حتى عام 1961، علماً أنه لم يتوقف عن دعم حركة كاسترو، صديقه.
لكن يجب انتظار استقراره في المسكيك كي يعرف ماركيز شهرة أدبية كبيرة، مع نيله جائزة “الأكاديمية الكولومبية للآداب” على رواية “الساعة الشريرة” عام 1962. وبين عامّي 1965 و1966، كتب تحفته الأدبية، “مئة عام من العزلة”، التي صدرت عام 1967 وتغنى بها صديقه الكاتب البيروفي ماريو فارغاس لوزا في دراسة تعتبر إلى حد اليوم من أفضل التحليلات التي نالها هذا العمل، قبل أن يختلف الصديقان على حب زوجة فارغاس لوزا.
ومع هذه الرواية، أطلق ماركيز تياراً أدبياً جديداً هو “الواقعية السحرية” التي تقوم على مزج مثير لفصول من تاريخ أميركا اللاتينية مع أساطير وخرافات يتم استخدامها كعناصر واقعية، ضمن أسلوب شهواني واستحضاري. ويسرد ماركيز في هذه الرواية قصة عائلة بوينديا في قرية “ماكوندو”، مستعيناً ببنية زمنية دائرية حيث قصص سفاح القربى والموت تعود إلى ما لا نهاية حتى اللعنة الأخيرة.
وستعرف هذه الرواية نجاحاً نادراً تنبأ بنجاحات أخرى مماثلة، مع نص “خريف البطريرك” الذي هو كناية عن قصيدة نثر طويلة، ورواية “أخبار موت معلَن” التي كتبها ماركيز على شكل ريبورتاج. ولا عجب بعد ذلك من نيله جائزة نوبل للآداب عام 1982 على “رواياته وقصصه التي يختلط فيها الخرافي والواقعي داخل عالمٍ تتحكم به مخيّلة غنية، عاكساً حياة قارة بكاملها وصراعاتها”.
وبعد الجائزة، أصدر ماركيز رواية “الحب في زمن الكوليرا” (1985) التي سرد فيها قصص حب مقهورة، ثم رواية “الجنرال داخل متاهته” التي تناول فيها المرحلة الأخيرة من حياة سيمون بوليفار. ورغم مرض السرطان الذي ضرب رئتيه عام 1992، وخضع بسببه لعملية جراحية خطيرة، إلا أن ذلك لم يخفف من نشاطه الكتابي، فأصدر رواية “عن الحب وشياطين أخرى” (1994) التي استعاد فيها جميع موضوعاته المفضلة، ثم “يوميات اختطاف” (1997)، وهي رواية وثائقية حول ستة رهائن في قبضة عصابة تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.
وعلى أثر تشخيص سرطان ليمفاوي لديه عام 1999، قرر ماركيز إصدار سيرة ذاتية “عشتُ لأروي”، تبعها ديوان قصصي رائع وأخير، “ذكريات عاهراتي الحزينة” (2004).
لم يبالغ الرئيس الكولومبي الحالي بقوله البارحة في نعي ماركيز: “إن العمالقة لا يموتون”، فبترسيخه أدب أميركا اللاتينية في تاريخها المعاصر، وعدم تردده في مقاربة العنف الذي يهزّها، ضمن توظيف بارع لفولكلورها الذي تناوله من وجهات نظر مختلفة وبطرافة وأسلوب فريدَين؛ أثار هذا العبقري إعجاب جميع كتّاب أميركا اللاتينية الذين أتوا بعده، فتأثّر معظمهم بأعماله قبل أن يتحرروا مؤخّراً منها، لكن بدون أن ينكروا دينهم الكبير له.
رحل «بطريرك» أميركا اللاتينية: غابرييل غارسيا ماركيز عاش ليروي/ خليل صويلح
عن 87 عاماً، انطفأ «غابو» أمس في منزله في مدينة مكسيكو، مُنهياً السطر الأخير في مسيرة أحد أعظم الأدباء في القرن العشرين. صاحب «نوبل» (1982) نقل مناخات أميركا اللاتينية إلى بقاع العالم، فاستحق لقب أكثر الكتّاب بالاسبانية شعبية منذ ثرفانتس!
«عشتُ لأروي» (2002) العبارة التي اختارها الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز (1927 ــــ 2014) كي تكون عنواناً لمذكراته، تكفي لاختزال حياته الاستثنائية. لن يضاهيه أحد في رواية الحكايات. طوال ستين عاماً، لم يتوقف عن إهدائنا شخصيات مدهشة، لا تتوانى عن القيام بأكثر الأفعال غرابة، من دون أن نحسّ بلا معقوليتها.
شخصيات سترافقنا على الدوام، كما لو أننا نعرفها عن كثب، أو يصعب تخيّلها إلا كما صنعها هذا الساحر. قبل أن يُصدر مذكراته، كُنّا نظن أنّ مخيلة ماركيز وحدها هي من تكفّل برسم ملامح هذه الشخصيات، وإذا به يفاجئنا بأنه اكتفى بوضع اللمسات النهائية لخرائط دروبها، فها هي النسخ الأصلية من شخصياته تعيش حياتها الحقيقية خارج مجاله المغناطيسي للسرد، ويعزّز هذه الفكرة بقوله «الحياة ليست ما يعيشه أحدنا، وإنما هي ما يتذكّره، وكيف يتذكّره ليرويه».
لكن هل سيغيب ماركيز حقاً، أم أنّها واحدة من ألغازه الكثيرة التي أودعها في كتبه التي لا تخلو مكتبة أحدنا من كتاب واحد على الأقل منها؟ لن نتفق كقرّاء بالطبع على إجابة حاسمة عن سؤال من نوع: أين تكمن عبقريته الروائية؟ سيفضّل كثيرون تحفته «مائة عام من العزلة»، الرواية التي وضعته في سجل «نوبل» للآداب (1982)، وآخرون سيجدون في «الحب في زمن الكوليرا» (1985) أيقونتهم الخاصة، فيما سيدافع بعضهم عن رواية صغيرة بحجم كف اليد هي «ليس لدى الكولونيل من يكاتبه» (1961). ولكن ماذا بخصوص «الجنرال في متاهته»، أو «خريف البطريرك» (1975)، أو «قصة موت معلن» (1981)، أو حتى قصصه القصيرة التي أودعها في كتابه «عن الحب وشياطين أخرى» (1994)؟
ربما لم تعد الواقعية السحرية التي أبحرت خارج ضفاف الكاريبي في خمسينيات القرن المنصرم، إلى كل بقاع العالم، بالألق الذي كانته في العقدين المنصرمين. لكن ماركيز ظلّ يدهشنا إلى آخر سطر كتبه، قبل أن يتوقف عن الكتابة في سنواته الأخيرة بسبب المرض والشيخوخة وداء النسيان قبل أن يرحل ليل أمس في المكسيك.
الآن، حين نستعيد شريط حياته، سنتوقف مليّاً أمام ذلك الشاب البائس الذي اهتدى إلى الرواية بالمصادفة، إثر قراءة «المسخ» لكافكا. أثارت الجملة الأولى في الرواية لديه ارتعاشة غير مسبوقة «حينما استيقظ غريغوري سامسا ذات صباح، بعد أحلام مضطربة، وجد نفسه وقد تحوّل في سريره إلى حشرة هائلة». هذه الجملة أقنعته بيقينٍ تام بأن يهجر دراسة القانون ويتجه إلى كتابة القصة، قبل أن يغرق في سحر «ماكوندو»، المدينة المتخيّلة في روايته الأولى «عاصفة الأوراق» (1955)، وهي النسخة التجريبية من «مائة عام من العزلة» التي استغرق في التفكير بها 19عاماً. كما سنجد شخصية والده موظف البرق في «الحب في زمن الكوليرا»، إحدى رواياته النفيسة التي استعاد خلالها قصة حب والديه. ليست الواقعية السحرية إذاً، وعاءً أسطورياً أو خرافياً لمجازفات الروائي التخييلية، بقدر ما هي حقيقة ملموسة تفرزها تناقضات الحياة في أميركا اللاتينية، إذ تتناوب المعجزات والعجائب في فضاء واحد. لذلك لن نفاجأ كيف طارت «ريميدوس» الجميلة في الملاءات إلى السماء، ولن نستغرب حكاية ساعي بريد وقع في حب فتاة لمحها من وراء نافذة، فظل ينتظرها «ثلاثاً وخمسين سنة وستة شهور وأحد عشر يوماً بلياليها»، أو كيف يبيض الدجاج مرتين كل يوم. عدا فرانز كافكا، ووليم فوكنر، وجوزيف كونراد، يدين ماركيز إلى جدته، في المقام الأول، في استعارة المفاتيح الأولى لحكاياته، كما يعترف بأنّ «نصف الحكايات التي بدأت بها تكويني سمعتها من أمي. وهي لم تسمع مطلقاً أي كلام عن الخطاب الأدبي ولا عن تقنيات السرد ولا عن أي شيء من هذا. لكنها تعرف كيف تهيئ ضربة مؤثرة وكيف تخبئ ورقة آس في كمّها خيراً من الحواة الذين يخرجون مناديل وأرانب من القبعة». هكذا استحوذ على الوصفة السحرية للكتابة، مقوّضاً المسلمات. ذلك أن «قانون الرواية يخترق كل القوانين» كما يقول، وهذا ما أتاح له بناء عمارة سردية متينة محمولة على الفانتازيا والشعر والحبكات الغرائبية. الواقع بالنسبة إليه «ليس مقتصراً على سعر الطماطم والبيض».
بنى عمارة
سردية متينة محمولة على الفانتازيا والشعر والحبكات الغرائبية
ناهض الاضطهاد والديكتاتورية ووقف إلى جانب القضية الفلسطينية
ولعل صورة ماركيز الصحافي لا تقل أهمية عن صورته كروائي. لطالما أشار إلى أهمية التحقيق الصحافي في بلورة مشروعه الروائي ورفده بوقائع كانت بمثابة المادة الخام لنزواته الروائية (حكاية بحار غريق). على أي حال، هو كان صاحب أشهر عامود صحافي لسنوات طويلة في الصحف الناطقة بالإسبانية، وقد جمع ما كتبه في أربعة مجلدات. سوف نتذكّر بعض مقالاته بوصفها قصصاً مكتملة، مثل «طائرة الحسناء النائمة» التي ستقوده إلى استعادة عمل أدبي عظيم للياباني ياسوناري كاواباتا، هو «بيت الجميلات النائمات»، الرواية الوحيدة التي تمنى لو كان هو من كتبها. وسينهي حياته الأدبية بتحية إلى هذه العمل الفذّ عبر روايته «ذاكرة غانياتي الحزينات» (2004) في تناصٍ صريح مع هذه الرواية.
ولكن ماذا عن ماركيز السينمائي؟ علينا أن نتذكّر أن «غابو» أنجز أكثر من ورشة لكتابة السيناريو في مدينة مكسيكو، كانت حصيلتها مجموعة من الأفلام، بالإضافة إلى ثلاثة كتب هي: «كيف تُحكى حكاية»، و«نزوة القصّ المباركة»، و«بائعة الأحلام». هنا نتعرّف إلى مطبخه السرّي، فهو يؤكد على ضرورة الإمساك فجأة باللحظة الدقيقة التي تنبثق منها فكرة «مثل الصياد الذي يكتشف فجأة، خلال منظار بندقيته، اللحظة التي يقفز فيها الأرنب». ويعترف في مكانٍ آخر بأنّ القصة تُولد ولا تُصنع، كما أنّ الموهبة وحدها لا تكفي بالطبع. المهم أن تتعلم كيف تروي الحكاية بخبرة وحب ومن دون ضجر، خلال تسعين دقيقة هي مدة الفيلم. كما يشبّه العمل في ورشة السيناريو بحرب العصابات: «عليها أن تضبط خطواتها على إيقاع خطوات أبطأ شخص فيها ثم تفتح النار».
تمازج الكتابة الصحافية وكتابة السيناريو وكتابة الرواية منحت نصّه السردي ثراءً متفرداً، ينطوي على صورة بصرية، في المقام الأول، كالصورة التي افتتح بها روايته «مائة عام من العزلة»: «بعد سنوات طويلة، وأمام فصيل الإعدام، تذكّر الكولونيل أورليانو بوينديا، عصر ذلك اليوم البعيد، الذي اصطحبه فيه أبوه، كي يتعرّف على الجليد». وعلى ضفة أخرى عمل ماركيز ببسالة على فضح تاريخ الحروب والديكتاتوريات في القارة المشبعة بالأسطورة والأبطال والطغاة. القارة التي لم تحظ ببرهة طمأنينة نتيجة العنف والمظالم، فعاشت عزلة قسرية، إلى أن كسرت قشرة البيضة بصناعة الجمال، لجعل الحياة معقولة. كما تبرز ثيمة أخرى في أعماله هي تمجيد الحب، فهو يرى أنّ الإنسانية قد استنفدت احتياطها من الحبّ الشهواني منذ حقبة الستينيات، وقد آن الأوان للالتفات جدياً إلى قوة المشاعر وخزّان الرومانسية، وإلا ما تفسير عودة روايات الحب إلى مكان الصدارة في المبيعات؟ الحروب والعنف والعزلة، فرضت نصاً آخر يعيد الاعتبار إلى معجم العشق، وها هو يهتف في إحدى مقالاته «لقد كنت مؤمناً على الدوام بأنّ الحب قادر على إنقاذ الجنس البشري من الدمار وهذه العلائم التي تبدو ارتداداً إلى الوراء هي على العكس من ذلك تماماً في الحقيقة: إنها أنوار أمل».
في روايته «الحب في زمن الكوليرا»، يبتكر كيمياء عشق فريدة. بعد طول انتظار، ستبحر سفينة العاشقين بعيداً من حمّى الكوليرا إلى الأبد، بقوة الحب وحدها، هذه الشحنة المتأججة كانت الوقود السحري كي تستمر السفينة في إبحارها في المجهول، ذهاباً وإياباً.
لا تتوقف فضيلة ماركيز عند اختراع الحكايات الممتعة التي تلقفتها أجيال من القراء بشغف، بل في مواقفه المناهضة للاضطهاد والعنصرية والديكتاتوريات المتناسلة في جغرافيات العالم. موقفه المنافح عن القضية الفلسطينية، واحد من مواقف كثيرة مضيئة في سيرته الحافلة بالمبادرات الخلّاقة. في أحد خطاباته الواردة في كتابه الأخير «لم آتِ لألقي خطاباً»، يتطلع إلى الألفية الثالثة بعين قلقة، معتبراً القرن العشرين أشدّ القرون شؤماً، بوجود كارثة كونية على الباب تتمثل في خمسين ألف رأس نووي جاهزة للاستخدام. لكن ما قد يخفّف نسبة الهلاك والكوارث، وفق ما يقول، هو الاحتياطي الحاسم من الطاقة لتحريك العالم باستثمار «الذاكرة الخطرة لشعوبنا»، والتراث الثقافي الهائل، وتصريف الطوفان الإبداعي الجارف بوصفه ثقافة مقاومة واحتجاج، «لا يمكن أن يروضها النهم الإمبراطوري، ولا وحشية الطاغية الداخلي».
وداعاً ماركيز، مقعدك سيبقى شاغراً.
رؤساء وسياسيون وكتاب ينعون غارثيا ماركيز
كولومبيا أعلنت الحداد لثلاثة أيام
لندن: فاضل السلطاني – مدريد: صبيح صادق – بروكسل: عبد الله مصطفى – الدمام: ميرزا الخويلدي – بيروت: سوسن الأبطح – بغداد: أفراح شوقي
أثارت وفاة الأديب الكولومبي غابرييل غارثيا ماركيز (87 سنة) الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1982، يوم الخميس أصداء كبيرة بين الشخصيات الأدبية والسياسية في مختلف أنحاء العالم، فقد وصفه الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بأنه «أشهر شخصية كولومبية في كل الأزمان»، وأعلن الحداد عليه لمدة ثلاثة أيام.
وقال ماريو باغاس يوسا، الحاصل على جائزة نوبل في الآداب: «لقد مات كاتب عظيم، ساعد بأعماله على شيوع أدبنا الإسباني وإبراز أهمية لغتنا».
وأعربت الكاتبة إيزابيل إليندي عن حزنها قائلة: «إنه خبر غاية في الحزن… لقد تأثرنا جميعا بأعماله». وكتبت الفنانة شاكيرا: «من الصعب علي أن أودعك، لأنك قد منحتنا الكثير، ستخلد في قلوبنا نحن الذين أحبوك وأعجبوا بك».
أما الرئيس الشيلي السابق رافائيل كوريا، فقد كتب: «لقد مات غابو (لقب غارثيا ماركيز) لكن أعماله باقية». كان الكاتب هيكتور أغيلار كامين زار منزل ماركيز حال سماعه بخبر وفاته وقال: «إن وفاته كما لو أنه قد توفي تشارلس ديكنز أو بلزاك».
وعبر الرئيس الفرنسي هولاند عن أسفه لرحيل الأديب الكبير بقوله: «إن ماركيز منح الأدب الإسباني أحد أروع أعماله وهو رواية (مائة عام من العزلة)».
وعبر الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو عن أسفه «لوفاة واحد من أعظم الكتاب في وقتنا الحاضر». أما الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون فقال إنه يفخر بأنه كان صديقا لغارثيا ماركيز، وكذلك أعرب الرئيس الأميركي أوباما عن أسفه لوفاته وقال: «لقد خسر العالم واحدا من أعظم الكتاب، واحدا من الكتاب المفضلين عندما كنت شابا». ووصفه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه «صديق للزعماء الثوريين». وكتب زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني ألفريدو بيريث روبالكابا أن ماركيز «من كتابه المفضلين له وللملايين من القراء».
وكان ماركيز دخل المستشفى يوم 31 مارس (آذار) قبل أكثر من أسبوع، بعد إصابته بالتهاب رئوي.
وفي آخر مقابلة معه قال: «إن عمر الإنسان ليس في الحياة التي يعيشها وإنما فيما يتذكره وطريقة تذكره لتلك الذكريات من أجل أن يرويها».
وكانت أخت الكاتب، آيدا غارثيا ماركيز، قد صرحت قبل أيام لراديو «كاراكول» بأنها رغم أن قلبها يتمنى أن يستمر أخوها على قيد الحياة «والإنسان دائما يريد من الحياة أن تكون خالدة، ولكن لا بد لنا أن نكون مستعدين لقبول إرادة الله. وكما تعرفون فإن حالة ماركيز ليست على ما يرام، وإن الحياة لها بداية ونهاية، وهذه هي الحقيقة، ولا بد لنا من أن نقبلها». وأضافت أنها متفقة تماما مع رأي زوجة ماركيز التي فضلت أن يترك زوجها المستشفى وينتقل إلى البيت، في مكسيكو. الأخت الأخرى لماركيز ليخيا قالت: «إننا نصلي من أجله، ونشعر بالارتياح من تعاطف الجميع مع أخي».
وكانت زوجة الكاتب ماركيز، ميرثيديس بارجا، وأولادها قد أصدروا بيانا قبل ذلك شكروا فيه كل الذين شاركوهم محنتهم هذه الأيام، وذكر البيان أن ماركيز «في حالة مستقرة ولكن صحته ضعيفة جدا، وهناك خطر أن تتدهور حالته بسبب تقدمه في العمر».
وكان صاحب «خريف البطريرك» قد دخل المستشفى قبل أسبوع ثم غادره، بسبب إصابته بالتهاب رئوي، وتحدثت بعض الصحف حول عودة مرض السرطان الذي أصيب به في نهاية التسعينات إليه.
معلوم أن ماركيز يعد واحدا من أشهر الروائيين العالميين، وتعود شهرته في الأساس إلى روايته «مائة عام من العزلة» التي كتبها في المكسيك، وقضى في كتابتها ثمانية عشر شهرا دون أن يخرج من غرفته، وكان يدخن خلالها ست علب يوميا. وأعماله كما هو معروف قد ترجمت إلى اللغة العربية، ومنها الرواية السابقة الذكر، و«الحب في زمن الكوليرا»، و«ليس لدى الكولونيل من يكاتبه»، و«ذاكرة غانياتي الحزينات»، وكذلك مذكراته «عشت لأروي».
الاتحاد الأوروبي: أعماله جعلت عالمنا أكثر ثراء
قدمت المفوضية الأوروبية ببروكسل التعازي في وفاة الأديب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. وقال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو في بيان إنه تلقى بحزن شديد نبأ وفاة ماركيز، «الذي كان صوت أميركا اللاتينية وأصبح صوت عالمنا. لقد جعلت أعماله عالمنا أكثر ثراء وبفقدانه سنكون أكثر فقرا ولكن أعماله ستدوم». وماركيز توفي في مكسيكو سيتي عن 87 عاما. وقد ولد ماركيز في كولومبيا في 6 مارس (آذار) 1927، وقضى معظم حياته في المكسيك وأوروبا. عمل أولا في المجال الصحافي ثم أخذ ينشر أعماله القصصية وقد توجها بأعظم عمل ألا وهو «مائة عام من العزلة»، وقد أثرت هذه الرواية على كثير من الأدب الروائي خصوصا في العالم الثالث. وحلق اسمه في عالم الرواية برائعته «مائة عام من العزلة» والتي نال شهرة كبيرة بعد نشرها مباشرة في عام 1967، فقد باعت أكثر من 30 مليون نسخة في أنحاء العالم وأعطت دفعة لأدب أميركا اللاتينية. وكانت له علاقة متينة مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، مما سببت له مشكلات كثيرة. ومن أعماله: «جئت أتكلم بالهاتف فقط»، و«الرحلة الأخيرة لسفينة الأشباح»، و«الحب في زمن الكوليرا»، و«ليس للكولونيل من يكاتبه» و«وقائع موت معلن». وقد ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، من بينها العربية حيث جرى فيها ترجمة 24 كتابا. وماركيز أحد المدافعين الرئيسيين عن الواقعية السحرية، وهو أسلوب أدبي قال إنه أسلوب يجمع بين «الأسطورة والسحر وغيرها من الظواهر الخارقة للعادة». ومن المشهور عنه أنه كان، في كثير من الأعمال، يحاكي شخصيات حقيقية وبشكل تهكمي. وبعض أعماله كانت تتوقع صعود الديكتاتوريات في أميركا اللاتينية.. وقالت الأكاديمية الملكية السويدية عند منحه جائزة نوبل في عام 1982 إن «ماركيز يقودنا في رواياته وقصصه القصيرة إلى ذلك المكان الغريب الذي تلتقي فيه الأسطورة والواقع».
من أعماله المترجمة للعربية
* مائة عام من العزلة
* الحب في زمن الكوليرا
* أجمل غريق في العالم
* ليس للكولونيل من يكاتبه
* خريف البطريرك
* ذاكرة غانياتي الحزينات
* عشت لأروي
* في ساعة نحس
* قصة موت معلن
* أشباح أغسطس
* بائعة الورد
من سيرته «عشت لأروي
* يقولون إنه يمكن لك، إذا ما صممت، أن تصير كاتبا جيدا. لم أكن قد سمعت مثل ذلك الكلام، من قبل، في الأسرة قط. فميولي منذ الطفولة، كانت تتيح الافتراض بأنني قد أصير رساما، موسيقيا، مغنيا في الكنيسة، أو شاعرا جوالا في أيام الآحاد. وكنت قد اكتشفت ميلا معروفا لدى الجميع، إلى أسلوب في الكتابة، أقرب إلى التلوي والرقة الأثيرية. ولكن رد فعلي في هذه المرة، كان أقرب إلى المفاجأة. فقد أجبت أمي: إذا كان علي أن أصير كاتبا، فلا بد لي من أن أكون أحد الكبار. وهؤلاء لا يصنعونهم، وهناك في نهاية المطاف مهن أفضل كثيرا إذا ما كنت أرغب في الموت جوعا. في إحدى تلك الأمسيات، وبدلا من أن تتبادل الحديث معي، بكت دون دموع. لو أن ذلك حدث اليوم لأثار هلعي، لأنني أقدر البكاء المكبوح كدواء ناجح ومؤكد تلجأ إليه النساء القويات لفرض نياتهن. ولكنني في الثامنة عشرة من عمري، لم أدر ما أقول لأمي، فأحبط صمتي دموعها، وقالت عندئذ: «حسن جدا، عاهدني على الأقل أن تنهي الثانوية، على أفضل وجه ممكن، وأنا سأتولى ترتيب ما تبقى مع أبيك».»
من أقواله
* أسعى أن أتخذ مسارا مختلفا في كل كتاب […]. الكاتب لا يختار أسلوبا.. بإمكان أي شخص أن يكتشف الأسلوب المناسب لكل موضوع. وكما أشارت، فإن الأسلوب يتم تحديده بناء على موضوع العمل. وفي حالة المحاولة في استخدام أسلوب آخر غير مناسب، ستظهر نتيجته مغايرة. وبالتالي، فإن النقاد يبنون نظرياتهم استنادا إلى ذلك، ويكتشفون أشياء لم تكن موجودة بالأساس. فقط أتجاوب مع أسلوب حياتنا، الحياة في منطقة البحر الكاريبي.
وفي الحقيقة، لو لم توجد حركة الحجر والسماء الكولومبية، فإنني لم أكن متأكدا من ظهوري ككاتب. وبفضل هذه الهرطقة، استطعت أن أترك خلفي خطابة راسخة ومميزة، كولومبية المنشأ… أعتقد أن حركة الحجر والسماء الشعرية الكولومبية ذات أهمية تاريخية كبيرة، إلا أنها في الوقت ذاته لم يعترف بها بشكل كاف… وهناك لم أتعلم كيفية توظيف الاستعارة فحسب ولكن أيضا عرفت كيف أكون أكثر حسما، إضافة إلى الحماس والتجديد في الشعر، والذي كنت أفتقده بدوري كل يوم عن سابقه والذي أعطاني حنينا كبيرا للعودة إلى المسار ذاته.
* كتاب سعوديون: الكبار يغيبون لكن لا يموتون
* غارثيا ماركيز أعطى أميركا الوسطى صوتها الأكثر علواً
* يقول الدكتور معجب الزهراني، الأكاديمي والروائي السعودي، في تعليقه على رحيل الروائي الكولومبي غابرييل غارثيا ماركيز: «إن الكتاب الكبار يغيبون لكنهم لا يموتون، لأن نصوصهم تبقى حية في اللغة التي نتكلم ونتواصل بها كل يوم».
ومضى الدكتور معجب الزهراني يقول: «من هنا نتحدث الآن عن الجاحظ، وابن المقفع، وأبي حيان التوحيدي، والمتنبي، وفيكتور هوغو، وشكسبير، وكأنهم يشاركوننا مائدة العشاء أو موائد الفرح والحزن».
وأضاف: «من هذا المنطلق أزعم أن ماركيز هو الذي أعطى لأميركا الوسطى صوتها الأكثر علوا وجمالا في العالم المعاصر، مثلما أعطاه بورخيس بالنسبة لأميركا الجنوبية في فترة سابقة ومعاصرة نوعا ما».
وقال: «يذهب كثيرون إلى أن (مائة عام من العزلة) هي أهم روايات ماركيز، لكنني أذهب إلى أن رواية (الحب في زمن الكوليرا) هي روايته الأجمل والأعمق والأهم، لأنها تحكي قصة تراجيدية – كوميدية فاتنة باذخة، أستعيد منها كل المفاصل العميقة لمعاناة البشر السعيدة والشقية، ولنا أن نتخيل الآن عجوزين أنيقين في يخت باذخ يتجول بين الموانئ، وربانه يدرك جيدا أن ليس مسموحا له بالرسو في أي منها.. ألا تذكرنا هذه الحكاية بآدم وحواء في الجنة؟ ألا تذكرنا بقيس وليلى في الصحراء..؟ ألا تذكرنا بعطيل وديدمونة في المسرح؟ أولا تذكرنا هذه الحكاية بنا ونحن نتيه بين الحلم واليقظة؟».
* شويخات: كانت حياته عجيبة كفنه
* ومن السعودية ايضا ، قال الروائي، والمترجم، وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور أحمد شويخات: لقد خسر العالم روائيا عظيما امتاز بقربه من هموم البسطاء.. وأمتع عبر عدد من أعماله ملايين القراء في العالم. كان ماركيز يكتب أحيانا بأسلوب خاطف، ويضع ذاك في سياق جمل طويلة ترسم لك الشخصيات والأحداث والأفكار في واقعية سحرية شغف بها القراء في أصقاع العالم، وهم يقرأون أعماله المتنوعة، منذ «ليس لدى الكولونيل من يكاتبه»، إلى روائعه الأكثر تدليلا على نضج أسلوبه الفريد، كما في «الجنرال في متاهته»، و«مائة عام من العزلة»، و«الحب في زمن الكوليرا».
لقد كانت حياة هذا الفنان عجيبة كفنه. ففي هذه الحياة انشغالات السينما والرواية والوساطات السياسية وسط الحراسات الأمنية والغرائبية الأسلوبية التي تتواشج مع حياته وغرائبية حياة شخوصه.
برحيله، يفقد المشهد الأدبي العالمي شخصية وُلدت على موعد مع المخاطرة في الفن والحياة، ومع الخيال المدهش الممتع الذي يرسم ببراعة أمكنة وأزمنة أميركا اللاتينية، مُجسدا بعض المرئي واللامرئي الإنساني.
* كتاب لبنانيون: فعل ما لم نستطع فعله
* في فضح الديكتاتوريات
* الروائية اللبنانية نجوى بركات تصف ماركيز بـ«الكاتب المؤسس للقارئ والأديب معا، سواء كان قارئا محليا أو عالميا»، فهو برأيها «فتح أفقا جديدا للأدباء سواء أكانوا غربيين أم عربا، وقد سموا هذا النوع من الكتابة بالواقعية السحرية. وللعرب من درس ماركيز ما يستحق الاهتمام أكثر من غيرهم، لأن أميركا اللاتينية تشبهنا في بعض الأماكن. فقد بنى عالما تحكمه الديكتاتوريات والشعوذة، وهو عبارة عن طبقات تحتها طبقات أخرى، كأننا نقرأ عن عالمنا. منه تعلمنا أن هناك طرقا أخرى للكتابة عن الواقع غير المباشرة السياسية التي وقعت فيها الرواية العربية. هذه الرواية التي أصابتها الأدلجة في كثير من الأحيان، في الصميم. شخصيات ماركيز تبقى حاضرة في ذهن القارئ، كأنها شخصيات واقعية. في (مائة عام من العزلة) لا أنسى إحدى الشخصيات التي يلمحها الناس وهي تطير وتحلق في الفضاء. عالمه يشبهنا في القهر والتخلف والطبقات المتعددة للشخصية اللاتينية، التي لها مرادفها في العالم العربي. ربما اكتشف العرب بعد سنوات أن ثمة ما يعنيهم في كتابات ماركيز، ففي (خريف البطريرك) نرى ديكتاتوريات ليس لها أي منطق، نحن حين نتحدث عن هذا النوع من المعاناة غالبا ما نربطه بأدب السجون وكليشيهات أخرى. لست ضد أدب السجون، لكن ماركيز قدم لنا أدبا مختلفا».
* عيساوي: أحببته وغيرت رأيي
* الشاعر اللبناني جوزيف عيساوي يقول «أكثر ما يعنيني في ماركيز بدايته كصحافي، وارتقاؤه في التقرير الصحافي إلى مستوى إبداعي. بالطبع هو بدأ قاصا وقصته (أجمل رجل غريق في العالم) اجتذبني عنوانها أكثر منها، وأحسب أن عناوين كتبه أجمل من صفحات سردية كثيرة فيها. بصراحة لا أريد أن أحمل المترجم النشيط صالح علماني المسؤولية، لكن قراءتي لرواية (مائة عام من العزلة) بالعربية لم تحقق لي المتعة الكبيرة التي أسمع عنها من عشرات القراء الآخرين. (الحب في زمن الكوليرا) أثرت في كثيرا إذ قرأتها وأنا في بداية الشباب، واستشهدت بأبطالها كثيرا وأنا أغوي النساء في ذلك العمر. بطلة ماركيز فيمينا التي لمحها العاشق في المرآة وبقيت في رأسه عقودا، لعلها كانت صورة عشيقة تراها في مرآة السوق حين تمر أمامها، وتعلق برأسها بينما أنت تعشق امرأة أخرى».
يكمل عيساوي «في ما بعد، حين تبدلت نظرتي للحب، أعدت النظر في الرواية التي شاهدتها صدفة فيلما منذ شهرين. أما نقد ماركيز للديكتاتورية من خلال (في خريف البطريرك) فأنا أفضل عليها ما قرأته عند ماريو فارغاس يوسا بحدته وتمسيخه لشخصية الحكام، وترعيته ومجونه وفساده. أما المفضل عندي من أدباء تلك القارة العجيبة والعارية كأرواح أهلها وأشباح غاباتهم وأساطيرهم فهو خوسيه ساراماغو الذي يذهب بالنزق الروائي والدقة السردية إلى أقاص لا محدودة».
* مثقفون عراقيون يصفون رحيل غارثيا ماركيز بالخسارة الكبرى
* أبدت أوساط ثقافية عراقية حزنها وتأثرها الكبير لرحيل الكاتب العالمي غابرييل غارثيا ماركيز، الذي يعده الكثير منهم بمثابة الروائي الذي لن يتكرر بإنسانيته العالية وحضوره وحبه لبلاده، وإن رواياته ستبقى حاضرة في الأذهان على مدى أجيال قادمة.
يقول الأديب فاضل ثامر، رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق: «يعد ماركيز من أهم القامات الأدبية الذين رسموا للقصة والرواية سحرها الأخاذ واستبسلوا عبر رواياتهم ضد الديكاتوريات، وستبقى رواياته حاضرة في النفس والذاكرة، وهي تحكي قصة وطن محارب بقلم أحد أبنائه البررة ورحيله أكبر الخسارات». وأضاف: «برحيل ماركيز نكون قد فقدنا أحد أهم رواد الواقعية السحرية والفن القصصي الفريد ولن يجود الزمان بروائي يحمل ذات عبقريته وإمكانياته التي خلدت رواياته وجعلته متوقدا بيننا على مر الزمان، عندما وقف هذا الروائي موقفا مشرفا أمام كفاح أميركا اللاتينية وعرى طغاة العصر وألبسهم العار».
أما الأديبة والروائية العراقية عالية طالب فقالت: «غابرييل روائي عالمي مهم أثرى المكتبة العربية والعالمية بروائع الأعمال التي ترجمت إلى لغات شتى، وهي روايات أقرب للفنتازية الساخرة بأجوائها العامة التي لم تغادر أرض الراحل وحبه لوطنه كولومبيا، وكنا نستشعر حبه لأرضه بين كلماته. وقد استطاع أن ينقل معاناة بلاده وأحداثها الثقافية والاجتماعية وحتى الخرافة الشعبية منها إلى كل أرجاء العالم، وهو ما نجح فيه ونحن بحاجة اليوم إلى مثقفين وروائيين لهم القدرة على تصوير ما يجري في بلادهم عبر نتاجهم الأدبي كما فعل ماركيز الذي سيبقى غيابه يشكل فراغا كبيرا في المشهد الثقافي العالمي.. سنستعيد رواياته ونعيد في طباعتها كيما نشعر بأنه موجود وحاضر بيننا، خصوصا أن روايتيه «مائة عام من العزلة»، و«الحب في زمن الكوليرا» كانتا ولا تزالان القصتين الأكثر تأثيرا لدى القراء وهما روايتان خالدتان في الأذهان.
ماركيز روائي «القارة» فرض سلطة المخيلة والالتزام/ كتب عبده وازن
كم كان غابريال غارسيا ماركيز مصيباً عندما سمّى مذكراته التي صدرت عام 2002 «عشتُ لأروي»، فهو عاش فعلاً ليروي ومات عن ستة وثمانين عاماً، وفي قلبه غصة الرواي الذي كان يحلم بسرد المزيد من الحكايات. فحياته كما يعبّر في هذه المذكرات، لم تكن الحياة التي عاشها بأيامها ولياليها، بل كانت حياة الذكريات التي رواها والحكايات التي كتبها. هذا سر ماركيز، روائي القارة الأميركية اللاتينية، بغرائبها ووقائعها الأغرب من الخيال وتاريخها الموشّح بالدم وثوراتها والديكتاتوريين الغريبي الأطوار الذين توالوا على الحكم فيها… إنها فرادة هذا الروائي الذي استهل مساره صحافياً لامعاً ثم أصبح صاحب أشهر عمود، كان ينتظره قراؤه «القاريون» مسمين إياه «عمود غابو»، وهو الاسم الذي كان أصدقاؤه يتودّدون به. وفي الصحافة كان ماركيز ايضاً كاتب ريبورتاج متميزاً، وهذا ما ظهر أثره في رواياته ذات الطابع السياسي الهجائي والتاريخي. لكنّ ماركيز كان ماهراً جداً في توظيف مهنة الصحافي في صميم صنيعه الروائي الذي راح ينحو منحى الواقعية السحرية التي سعى الى ترسيخها مع بضعة من الرفاق في القارة، وقد بلغت معه ذروتها في «مئة عام من العزلة»، هذه الملحمة الروائية التي تعدّ من عيون الروايات العالمية الخالدة مثلها مثل «عوليس» لجيمس جويس و»الصخب والعنف» لوليم فولكنر و»موبي ديك» لهرمان ملفيل و» في قلب الظلمات» لجوزف كونراد.
ولعلها مصادفة لافتة ان يرحل ماركيز في الشهر الذي صدرت فيه روايته «مئة عام من العزلة» وهو نيسان (ابريل) 1967 وبات عمرها الآن سبعة وأربعين عاماً، وهي الرواية التي صنعت له مجداً وشهرة ما كانا في حسبانه، كما يعترف، وفتحت أمامه الطريق الى جائزة نوبل عام 1982 وكرست اسمه روائياً عالمياً صاحب مدرسة وأسلوب غير مألوفين سابقاً. ومع صدور هذه الرواية الرهيبة، التي تجمع بين الفنتازيا والفانتاستيك أو الغرائبية والمأساة والسخرية والعبث اصبحت مدينة «ماكوندو» التي تدور الأحداث فيها وحولها، إحدى أشهر المدن الروائية العالمية، وهي بدت صورة مختصرة عن العالم المتوهم الذي ابدعته مخيلة ماركيز. وفي هذه المدينة التي لا حدود فيها بين الحقيقة والوهم تبرز شخصيات لا تُنسى، لا سيما عائلة «بونديا» التي تمثل بغرابتها ومأسويتها القدر الأميركي اللاتيني، المتخبّط في البؤس والمجهول. ومن هذه العائلة خرج الكولونيل أورليانو بونديا الذي يمثل نموذجاً كاريكاتورياً للديكتاتور الأميركي اللاتيني الذي يتزوج من سبع عشرة امرأة وينجب منهنّ سبعة عشر طفلاً يقتلهم واحداً تلو الآخر.
إلاّ أن ماركيز لا يمكن حصره البتة في «مئة عام من العزلة» التي تُرجمت الى ثلاثين لغة وتخطى مبيعها خمسة وثلاثين مليون نسخة وترجمت الى العربية في أربع صيغ عن الإنكليزية أولاً ثم عن الفرنسية وأخيراً عن الإسبانية مع المترجم صالح علماني. ماركيز هو أيضاً صاحب روايات وقصص غاية في الطرافة والواقعية السياسية كما السحرية، وهي تؤلف بذاتها «قارة» أدبية: «ليس للكولونيل من يراسله»، «الجنرال في متاهته»، «خريف البطريرك»، «الحب في زمن الكوليرا»، «قصة موت معلن» وبطل هذه الرواية البديعة سوري الأصل يُدعى سانتياغو نصار، وهو يقع ضحية مؤامرة تهدف الى قتله وقد أُعلن موته منذ مطلع الرواية. أما اللافت فهو اختتام ماركيز «مهنته» الروائية عام 2002 برواية «ذاكرة غانياتي الحزينات» التي سلك فيها سبيل الروائي الياباني الكبير ياسوناري كواباتا في روايته الشهيرة «الجميلات النائمات»، وكان ماركيز كتب مرة ان الرواية الوحيدة التي كان يتمنى ان يكون كاتبها هي «الجميلات النائمات». في هذه الرواية تحتدم ذاكرة ماركيز الإباحية التي يهيمن عليها خريف العمر. لكن ماركيز عكف بعد روايته هذه على اصدار مقالات له ونصوص سياسية، علاوة على مذكراته.
عاش ماركيز حياة بوهيمية متنقلاً بين اوروبا غرباً وشرقاً، وبين بلدان القارة الأميركية اللاتينية وبلغ نيويورك، هو المناضل الثوري الذي آزر حركات التحرر وواجه الثقافة الإمبريالية والكولونيالية، داعياً الى منح الشعوب المستعمرة حرياتها وحقوقها، وهاجياً القوى العظمى اليوم التي تهدد العالم بصواريخها النووية. ونجح ماركيز أيما نجاح في التوفيق بين كونه كاتباً ملتزماً ومنخرطاً في النضال السياسي و»الإنسانوي»، وروائياً متسامياً صاحب مخيلة ساحرة ونفَس ملحمي ونزعة تراجيدية تسائل ذاكرة التاريخ وعنف البشر ومأساة الحياة وعزلة الإنسان بصفتها قدراً مجهولاً وغامضاً. وكم كان موقفه جريئاً في إدانة المجازر التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفي توقيع بيانات الاستنكار العالمية في هذا الشأن.
رماد جثمان ماركيز سيتوزع بين المكسيك وكولومبيا
مكسيكو سيتي – إفي
أكد السفير الكولومبي في المكسيك خوسيه أورتيث أن رماد الأديب الراحل غابرييل غارثيا ماركيز سيتم تقسيمه بين بلاده والمكسيك.
وقال أورتيث في تصريح أمس (الجمعة ): «سيبقى جزء من الرماد في المكسيك، وسيتم نقل جزء آخر إلى كولومبيا»، مضيفاً أن مواطنيه يتطلعون إلى تكريم ماركيز، وذلك في تصريحات للصحفيين المحتشدين قبالة أبواب المنزل الذي عاش فيه حتى وفاته بالمكسيك، أول من أمس (الخميس)، عن 87 عاماً.
وكان ماركيز توجه إلى المكسيك مطلع الستينيات من القرن الماضي ليزور صديقه الكاتب الكولومبي ألبارو موتيس، لمدة أسبوع، إلا أنه استكمل حياته هناك دون أن يتنازل عن جنسية بلاده.
وأصبح منزل ماركيز في المكسيك خلال الساعات المنصرمة مركزاً لمراسم تأبينه، ولتلقي العزاء من محبيه الذين توافدوا حاملين باقات الزهور، كما شهد المنزل توافد عدد من الأصدقاء المقربين من أسرة ماركيز، وشخصيات بارزة من الوسط الثقافي والسينمائي في المكسيك، الذين وضعوا أيضاً أكاليل الزهور على أبواب منزله.
غابرييل غارسيا ماركيز.. صانع أسطورة أميركا اللاتينية/ إسكندر حبش
عـبر سنيّ حياتـه الطويلـة (87 عاما) ـ والتي لم تصل إلى المئة، أي إلى الحدود التي تشبه فيها عنوان إحدى رواياته ـ تحول غابرييل غارسيا ماركيز من صحافي وكاتب، إلى أكـثر من رمـز في أمـيركا اللاتيـنية، وربما في العالم أيضا. نجح ابن تلك القرية الكولومبـية الفقيرة، في أن يجتاز حدود مسقـط رأسـه، وأن يجـتاز هذه العـزلة التي كانـت مفروضة على قارة بأسرها، ليُسمع صوتا مخـتلفا. لنقل ذاك الصوت الأدبي في البدايـة، ومن ثـم السـياسي، وإن كـان الأدب الأمـيركي اللاتيني يغرف كثيرا من السياسة، إذ يلتقيان غالبا ليشكلا صنعا لوعي ثقافي وجد صداه في قارات أخرى عبر ما مارسه من تأثيرات على وعي الشعوب.
من هنا، وعلى الرغم من أنه كان يعتبر نفسه روائيا أي «شخصا غير مثقف»، إلا أننا لا نستطيع أن نتجاهل الدور الذي لعبه في الحياة العامة لقارته، بدءا من صداقته الطويلة والعميقة مع فيديل كاسترو التي لم يجعلها مادة إعلامية، إذ حاول دائما أن يلفها بضبابية ما، غير شارح لكنهها، مرورا بصداقاته مع الثوار الساندينيين ووصولا إلى دوره الكبير الذي لعبه في إطلاق سراح المخطوفين الذين احتجزتهم الميليشيات في كولومبيا. ربما ذلك كله يندرج في خط مؤسس لثقافة أميركا اللاتينية، بمعنى ذاك العمق الذي أرسى دعائمه كبير محرريها سيمون بوليفار، على الرغم من أنه لم يكن كثير الرحمة معه، وفق ما كتبه عنه في «الجنرال في متاهته»، وهي الرواية التي عالج فيها الشهور الأخيرة من حياة القائد بوليفار. بهذا المعنى «الثوري» قد نفهم جملة الرئيس الإكوادوري رافاييل كوريا الذي قال: «غادرنا غابو، سنعيش في سنوات من العزلة، لكن تتبقى لنا أعماله وحبه للوطن الكبير (أميركا اللاتينية)، قبل أن يختم باستعادته لجملة غيفارا الشهيرة:
Hasta la victoria siempre عزيزي غابو». أما في كولومبيا، موطنه، فقد أعلن رئيسها الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام من على كل الدوائر الرسمية.
مائة عام من العزلة
بهذا المعنى، تحول ماركيز إلى مثقف، وإلى حامل لوعي كبير بالتاريخ وبالشرط الإنساني كما للشرط الوجودي، إذ لم ينفك حضوره الشخصي عن الارتباط بالحضور العام، وبالتأكيد نجح في ذلك كلّه عبر الأدب، عبر الكتابة التي أفردت له هذه المساحة الكبيرة، وبخاصة روايته «مائة عام من العزلة» التي ساهمت في صنع اسمه. ربما من محاسن هذه الرواية أنها جعلت القراء يعودون إلى كتبه السابقة التي أصدرها: المجموعات القصصية، والريبرتوجات الصحافية، وبالتأكيد «ليس لدى العقيد من يراسله» تلك الرواية الصغيرة الساحرة التي تختصر عبر شخصية الكولونيل، نظاما كاملا من التاريخ الاجتماعي والسياسي والعسكري في أميركا اللاتينية.
«مائة عام من العزلة» مهدت الطريق أيضا لما أتى من بعدها وبخاصة «خريف البطريرك» التي لا تقل روعة عن سابقتـها، لكن القـراء توقفـوا في ذاكرتهم عند رواية العزلة، وإن كان بطريرك ماركيز لا يقل وحدة وعزلة بدوره. حتى «وقائع موت معلن» و«الحب في زمن الكوليرا»، نجد فيهما تلك العزلة الأثيرة على قلب الكـاتب، وإن كانت تأتي بصيغ مختلفة.
ثمة قصة، غالبا ما رددها ماركيز حول كتابته «مائة عام..»، تستحق أن تروى (ألم يقل هو نفسه في مذكراته «عشت لأروي»). إذ كلّ شيء بدأ بجملة. تقول القصة إنه في العام 1965، كان هذا الكاتب الشاب يشعر بأزمة كتابة منذ أشهر. حاول كثيرا لكنه لم ينجح في الوصول إلى أيّ جملة مفيدة. لذلك قرر أن يأخذ إجازة قصيرة (كان يعيش يومها في المكسيك) ليذهب مع زوجته وأولاده إلى أكابولكو. وفوق الطريق غير المعبدة التي أشعرتهم بالإرهاق، جاءت جملة لتحتل روحه وعقله. كانت تبدأ على الشكل التالي: «بعد مرور سنين عديدة، وأمام فصيل الإعدام، تذكر الكولونيل اورليانو بوينديا تلك الظهيرة البعيدة…». وأمام إلحاح هذه الجملة عليه، استدار وعاد إلى منزله، ليبدأ بكتابة تلك الرواية التي لم تجعل منه فقط واحدا من كبار كتاب القرن العشرين، وإنما أيضا لتؤسس لمرحلة أدبية، لم يستطع أدب قارة (والعالم أيضا) تجاوزها بسهولة. ويضيف ماركيز كيف أنه وبعد نهاية الكتابة، لم يكن لديه ثمن إرسال المخطوط في البريد فتدبرت الأمر زوجته، وحدث ما حدث بعد ذلك.
أول اسم
ربما هذه الحادثة أثرت أيضا في مخيـلتنا لقراءة هذا العـمل، بمـعنى هذه المعاناة التي تشدنا دوما إلى الكتّاب الذيـن يعانون من قسـوة الحـياة. قراءة جعلتنا نتناسى كثيرا بقية أدب أميركا اللاتينية. أقصد، حين نتطرق إلى الحديث عن أدب تلك القارة، وبخاصة نـحن الـعرب، نجد أن أول اسم يقفز إلى أذهاننا هو اسم ماركيز. صحـيح أنه كاتب على درجة كبيرة من الأهمية ولا يمكن لأحد أن يغض الطـرف عـن ذلك، لكن هناك أيضا العديد من الكتّاب الذين إن، لم يتفوقوا عليه بالأهمية، فإنهم يقفون على المستوى عينه: أين نضع بورخيس؟ أو خوليو كورتاثار؟ بدون شك لا يكتمل المشهد بدون أونيتي وبينيديتي وغاليانو وحتى يوسا وغيرهم كثر. في أي حال، لا يعني كلامي مطلقا، أن ماركيز كان من نوافل الكتّاب بل على العكس تماما، لكنه لا يشكل المشهد بمفرده، بالرغم من أن العديد من النقاد يعتبرون «مائة عام من العزلة» أكبر عمل أدبي مكتوب بالاسبانية ولا ينافسها في ذلك إلا كتاب ثربانتس «دون كيخوته».
رحيل ماركيز هو وقبل أي شيء رحيل رمز أدبي وسياسي، انفجر حضوره في ستينيات القرن الماضي إذ حـمل معـه أحلام العـدالة والمـساواة والحياة الجديدة، قبل أن يتم إجهاض ذلك كله إما بفعل التدخل العسكري الأميركي، وإما بتحول أبطال التحرير أنفسهم إلى دكتاتوريين. أليس من المفارقة أيـضا أن تصـدر «مائـة عام..» العام 1967 أي في السنة التي صدرت فيها أسطوانة البيتلز «سيرجنت بيبرز»؟ وجدت أوروبا يومها بعـض أحلامها الكـثيرة في أغـاني «الخنافس» وموسيقاهم، ووجدت أميركـا اللاتيـنية الكـثير من أحلامها في هذه الرواية. ربما ثمة تشـابه بين الأمـرين، نجد صداه في هذه الجملة التي قالها ماركيز في خطابه يوم تسلـمه جائزة نوبل العام 1982، يقول: «في وعي أوروبـا الجيـد، كـما في وعيـها السـيئ، انبجســت وبقـوة كبــيرة هــذه الراهنية الفانتاسـمية العائـدة لأمـيركا اللاتينية، أي هذا الوطن الكبير للرجال المهلوسين وللنساء اللواتي دخلن في التاريخ، حيث أن عنادهم غير المحدود يمتزج بالأسطورة».
لا أعرف إن كانت أميركا اللاتينية مجرد أسطورة، فما كتبه ماركيز «بواقعيته السحرية» (كما اصطلح على تسمية أدبه بذلك) ليس في الواقع سوى، وكما تقول إيزابيل الليندي، «هذا الصوت الذي روى للعالم ما نحن عليه، نحن الأميركيين اللاتينيين، لقد دلنا على أنفسنا في مرايا صفحاته. عزاؤنا الوحيد أن أعماله خالدة».
إسكندر حبش
ماركيز: الكاتب الجيد حين يرحل/ أمير تاج السر
في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وفي بداية تعرفي إلى سكة الكتابة السردية، بعد أن ظللت أكتب الشعر منذ الطفولة، وكنت طالبا في مصر، أصابتني حمى القراءة العنيفة لكل ما كتب من قصة ورواية ونقد، سواء أن أنتج عربيا أو ترجم لنا من لغات أخرى. لم تكن هناك بالطبع إنترنت ولا وسائل اتصالات من أي نوع ليتعرف المرء عن طريقها إلى الطرق التي تؤدي إلى أهدافه، مثل أي الكتب يقرأ، وأي الأفلام السينمائية يشاهد، ومن هم الكتاب الجديرون بمتابعتهم.
لكن كانت توجد المقاهي الثقافية، أي المقاهي التي يرتادها المثقفون في وسط القاهرة، ليجلسوا ساعات، يستمعون فيها إلى بعضهم، ويتناقشون في إصداراتهم وإصدارات غيرهم من تلك التي قرأوها وكونوا رأيا، ولم تكن تلك الجلسات يومية في الغالب، ولكن مرة أو مرتين في الأسبوع، وإن كان البعض يأتون بشكل شبه يومي. وقد نوهت كثيرا إلى أن تلك المقاهي كانت الفيسبوك، وتويتر، الخاص بذلك الزمان، حيث يمكن العثور بسهولة على أخبار الثقافة ونقلها مباشرة إلى الصحف، ويحدث في كثير من الأحيان أن ينطق أحدهم بفكرة ما، لم تصبح نصا بعد، ليجدها في اليوم التالي، تحتل مساحة لا بأس بها في صحيفة أو مجلة، بوصفها خبرا عن عمل منجز تحت الطبع، وأذكر في تلك الأيام أن ذكرت لعدد من الذين يجلسون معي إنني أكتب نصا اسمه: ذاكرات ميتة، وكان ذلك في الحقيقة مجرد فكرة خطرت ببالي، لم تنجز قط، لكن وجدت بعد عدة أيام، في إحدى الصحف اليومية، خبرا عريضا عن الذاكرات الميتة التي ستصدر عن إحدى دور النشر قريبا.
إذن كانت ثمة وسيلة لمعرفة ما يجري في المحيط الثقافي، وعن طريق تلك الوسيلة، وتزامنا مع حمى القراءة التي ذكرتها، دخلت آداب كثير من البلدان إلى حياتي كقارئ، ومنها أدب أمريكا اللاتينية، وعلى رأسه ما أنجزه غابرييل غارسيا ما ركيز. دخلت روايات مثل: جنازة الأم الكبيرة، ليس لدى الكولونيل من يكاتبه، إيرنديرا الغانية، مئة عام من العزلة، سواء في طبعات عربية أو إنجليزية، وتأتي بعد ذلك في فترة التسعينيات وبعد أن تركت مصر، باقي أعماله كلها، وحتى سيرته الذاتية التي حملت عنوان: عشت لأروي، أو تلك التي كتبها جيرالد مارتن، بعد أن أمضى سنوات طويلة في مصاحبة ماركيز، والاستماع لشهاداته وشهادات أصدقائه، في شتى الشؤون.
لقد أردت القول، إن ماركيز كما أعتقد، ولعل الكثيرين يوافقونني على ذلك، كان الأجدر وسط ذلك الزخم القرائي، بسرقة أي قارئ من الكتب الأخرى لآخرين، وتوظيفه في قراءته وحده. لم يكن ديكتاتورا عنيفا في ذلك، ولكن القارئ يستجيب برغبته، وكامل إرادته، ويصبح من الصعب أن ينتزع نفسه من عالمه بعد ذلك، ليغرسها في عوالم أخرى. الدهشة، الغرائبية التي تصبح حقيقة حين تعجن بفن داخل نصوص حقيقية. رواية القصص بانسيابية غريبة، والحوادث النادرة كأنها تحدث كل يوم، فالرجل الكبير حين يصاب بالخرف، يربط إلى جذع شجرة في حوش البيت، ولا يكون ذلك غريبا، والخادم يعود إلى بيت سيده بعد سنوات من الغياب ليردد إنه جاء ليشارك في جنازة السيد، ويكون السيد في تلك اللحظة في كامل صحته، ويتناول عشاءه، ثم ليموت في اليوم التالي، ويشارك الخادم بالفعل في الجنازة. إيرنديرا التي كانت من شدة ما كانت ترهقها جدتها، ساعات نومها كاملة وهي تعمل، ثم يحترق البيت من شموعها أثناء نومها النشط، وبعد تقدير خسائرها، توظفها الجدة عاهرة متنقلة، لتجميع مبالغ تعوض خسائرها.
لقد كان الخيال هو مفتاح الإدهاش عند ماركيز، وشخصيا لا أنسجم مع أي عمل روائي أو قصصي لا يتبل بالخيال، ودائما ما أقول، إن القراء لا يحتاجون لمن يكتب لهم حياتهم اليومية كما يعيشونها، ولكن تلك الحياة الموازية، التي ربما كانت ستكون حياتهم، وربما هي أحلامهم البعيدة التي لن تتحقق، ماركيز صنع ذلك، وكثيرون غيره من كتاب أمريكا اللاتينية والعالم صنعوا ذلك، فقط تأتي الريادة، الجرأة التي كسرت حاجز الخوف من التحديث، واستخدام الخيال في أقصى طاقته. نعم فقصة مثل قصة الملاك المسكين الذي عثر عليه في حوش أحد البيوت،لا تكتب إلا والخيال في قمة اشتعاله، وقصة مثل: أجمل غريق في العالم، كانت درة لأنها علقت على جيد الكتابة بقلادة من الخيال الخصب.
لقد كان ماركيز معلما كبيرا بلا شك، انتقل بموهبته وحدها، من تشرده الأخاذ في أوروبا خاصة باريس، في فترة من فترات حياته، إلى استقراره الأخاذ، في أي وجدان تهزها الكتابة الجيدة، وأي موهبة أخرى، تود أن تصبح موهبة مؤثرة. ولعله الكاتب الوحيد الذي يجري اسمه على كل لسان حين تذكر الملكة الكتابية المؤثرة، ولذلك لم يكن غريبا، أن يتم اختيار ملحمته: مئة عام من العزلة، من قبل نقاد وقراء، ومتخصصين، الرواية الأكثر تأثيرا في العالم، وهي كذلك لأن لا أحد قرأ مئة عام من العزلة إلا ضحك أو بكى أو استغرب أو اندهش، أو اضطرب. وفي رأيي إن: الحب في زمن الكوليرا، ملحمة أخرى لا تقل تأثيرا عن مئة عام من العزلة، لكن الأخيرة أضاعت شيئا من شهرتها، لأنها أتت أولا، ولأنها كانت حاضرة، كشهادة عظيمة أهلت المعلم ماركيز لجائزة نوبل.
منذ سنوات كتب ماركيز روايته الصغيرة: ذكرى غانياتي الحزينات، متأثرا برواية الياباني ياسوناري كاباواتا: الجميلات النائمات. كما هو معروف، وهذا تأثر لم ينكره ماركيز، حين كتب فكرة يا سوناري قصة قصيرة أولا عن المسافر الذي يراقب نوم امرأة جميلة، تجلس بجانبه في الطائرة، ثم كتبها رواية بعد ذلك. شخصيا أعتقد وربما يخالفني آخرون، إن غانيات ماركيز الحزينات، لم تكن رواية أصلية، ترتدي ثياب خياله البديع، ليست مثل أجمل غريق في العالم، ولا أحداث موت معلن، حين تكون الفكرة ضربة إدهاش موفقة، ارتدت ثوب خيال مطرزا في معمله الشخصي، بل صناعة لنص مهما حاول لن يخرج عن تساؤل الناس، مقارنته بالنص الأصلي البديع الذي كتبه كاباواتا. لقد كتبت في تلك الأيام عن شيخوخة الكتابة، وإن المبدعين أسوة بغيرهم ينبغي أن يتقاعدوا عن الكتابة حين تشح هرمونات الأفكار أو تنعدم. عموما ذلك لم ولن يقلل من حجم كاتب مثل غارسيا، لأن الكاتب الجيد، يحال لتجربته كاملة لا لنص عاق من نصوصه، كتبه تحت ظروف معينة.
المحصلة، إن غابرييل غارسيا ماركيز، سيد الكتابة، أستاذ الحكايات، قد رحل، وخسارة مثل هذه نحسبها من الكوارث.
‘ روائي سوداني
ماركيز مات؟/ عزت القمحاوي
هي جميلة جدًا، وهو كذلك، لكنه غالبًا لم يكتبها؛ تلك الرسالة التي عاودت الظهور بمناسبة موته المعلن وغير النهائي.
لا أذكر بالتحديد تاريخ ظهور خطبة الوداع المنسوبة إلى الروائي الأشهر في كل الدنيا غابرييل غارثيا ماركيز، لكن عمرها لا يقل عن خمس سنوات، عندما قطع شوطًا على طريق النسيان، امتثالاً لداء عائلته المتأصل الذي لمسناه في ‘مائة عام من العزلة’ أشهر روايات التاريخ بعد دون كيخوت.
‘لو شاء الله أن يهبني شيئًا من حياة أخرى، فإنني سأستثمرها بكل قواي، ربما لن أقول كل ما أفكر به، لكنني حتمًا سأفكر في كل ما أقوله، سأمنح الأشياء قيمتها، لا لما تمثله، بل لما تعنيه، سأنام قليلاً، وأحلم كثيرًا مدركًا أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة ستين ثانية من النور’ هذا المفتتح ذو المسحة الرسولية يصنع من ماركيز مسيحًا جديدًا، لكنه لا يبشر بالآخرة بل بالحياة الدنيا.
عذوبة الأسلوب في الرسالة، الوصية، أو العظة المنبرية تليق بماركيز الكاتب، وحب الدنيا ‘يلبق’ لماركيز الإنسان: ‘لو شاء ربي أن يهبني حياة أخرى، سأبرهن للناس كم يخطئون عندما يعتقدون أنهم لن يكونوا عشاقًا متى شاخو، من دون أن يدروا أنهم يشيخون إذا توقفوا عن العشق’ ذكاء المفارقة في الجملة الماركيزية يبدو واضحًا كذلك في الوصية، لكن الكآبة التبشيرية ليست له، وهذا اليقين بأنه قد اقترب ورأى ليس من طبيعته الأكثر ميلاً إلى التواضع المراوغ، وغياب السخرية في الرسالة عيب شنيع، لا أظن أن ماركيز يمكن أن يقع فيه، حتى في ظرف الاقتراب من الموت.
قيل في بداية ظهور النص الوداعي إنه منقول عن ماركيز عبر صديق مقرب، ولم يهتم ماركيز أو لم يجد الفرصة لينفي أو يؤكد إن كان النص العذب له أم لا! ولكن المؤكد أنه امتلك واحدًا من أجمل الأساليب، له سماته المميزة، ولذا فهو قابل للتقليد. مثاله في لغتنا العربية طه حسين، ولا تسعفني الذاكرة المرهقة بأسلوب كاتب آخر يغري المنتحلين بالانتحال.
من سخريات القدر أن الرجل الذي عاش حياته الطويلة ليروي عن الآخرين، انتهى مرويًا عنه، وأمست السنوات الأخيرة من حياته غيابًا غامضًا لا يشبه سوى غياب ملكلياديس، الغجري المشعوذ بالعلم، الذي يشبهه ماركيز بأكثر مما يشبه أي شخص آخر من أبطال رواياته.
ملكلياديس كانت قوته في معرفة بالكيمياء والفيزياء وظفها في إبهار سكان القرى باعتبارها معجزات، من المغناطيس الذي يجذب الحديد إلى أعجوبة لوح الثلج، ولا بأس من تمرير كذبة تحضير الذهب وسط المعجزات الظريفة!
وكذلك كان ماركيز، اشتغل على صنعته بدأب، عاش بحواس مفتوحة لاستقبال العالم واستفاد من كل ما مر به ليكون الروائي الأشهر والأكثر عذوبة في العالم على الأقل منذ نشر ‘مئة عام من العزلة’ عام 1967 إلى اليوم.
حتى الصحافة، مقبرة المبدعين استفاد منها ماركيز، ركبها ولم يقع تحت حافرها؛ ليس فقط باستعارته بعضًا من أعذب حكاياته من تغطياته الصحافية، بل باستعارة السهولة والاختصار والدقة، دون أن يسمح لماكينتها بتجريده من ذكاء المفارقة وعمق السخرية. وهكذا كان بوسعه أن يشبه هيمنجواي في تلمس لحم الواقع بالحانات وقصور الأغنياء وخنادق المحاربين وأن يجري الحوارات ويعقد الصداقات مع الزعماء ومرتكبي الجرائم الخطرين، على أن يبقى مثله الأعلى وليم فوكنر.
لم يترك ماركيز الصحافة إلا بعد أن منحها وظيفة أخيرة، عندما اخترع الصحافي المسن الذي روى حكايات غانياته الحزينات. لم تخرج من قلبه رواية كاواباتا ‘الجميلات النائمات’ منذ قرأها للمرة الأولى وشاء ألا يودع الدنيا دون أن ينسخها، وهو يعرف أن اتهامات اللصوصية لن تطارده، لأنه ماركيز!
وهذا ما كان؛ لم يجد القراء شيئًا في أن يزين ثري قصره الفخم بنافذة يابانية من زجاج ملون. ومن لا يعجبه ذلك يستطيع أن يتفادى النظر إلى تلك النافذة بالذات، وستجد عيناه في القصر الكثير الذي تتأمله.
ترك ماركيز الكثير الذي نتأمله، ويمكننا ألا نحب ‘حكايات غانياتي الحزينات’ أو نحبها، ونستطيع أن نصدق أو لا نصدق أن ماركيز كتب رسالته الوداعية التي ظلت تهب من صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية كلما تواترت أخبار عن تدهور صحته، لكن الأحمق فقط يستطيع رفض دعوتها للحب.
ويبقى أن الموت النهائي المعلن لماركيز، قد يكون مؤلمًا للكثيرين من محبيه، لكن المؤكد أن موته السابق، غير المعلن كان يؤلمه هو، عندما كان يستعيد ذاكرته للحظات ويعرف أنه ماركيز، الرجل الذي احتفى بالذاكرة في كل ما كتب.
استراح الرجل، لكن الكاتب سيعيش طويلاً، طويلاً جدًا سيعيش.
‘ كاتب مصري
رثاء عربي غير مكتمل لغابرييل غارسيا ماركيز
‘الاستثناء’ الذي أعاد إنتاج التراث المشرقي ليصنع أدبا عجائبيا
تونس ـ ‘القدس العربي’ ـ من حسن سلمان: شكل رحيل ‘أبو الواقعية السحرية’ غابرييل غارسيا ماركيز صدمة كبيرة لدى المثقفين العرب، وخاصة أن أغلبهم يدين في بعض نتاجه للأديب الكولومبي الكبير الذي عرف كيف يطوّع الخيال ليصنع ادبا عجائبيا يحمل هموم الواقع المغرق بالمحلية ويعيد إنتاجه بقالب عالمي يصلح لكل الأزمنة.
وإذا كان ماركيز انبهر، كغيره من أدباء أميركا اللاتينية، بالتراث العربي والشرقي عموما، فإنه رواياته المفعمة بالإنسانية شكلت موردا هاما لأغلب الأدباء العرب.
ويبدو أن ماركيز نجح إلى حد بعيد في توظيف خبرته الطويلة في الإعلام والسياسة ليلتقط تفاصيل صغيرة ويعيد نسجها في حكايات بسيطة شغلت أهل الفكر والسياسة لنصف قرن، ودعت عددا كبيرا من الزعماء في العالم لكسب وده، رغم انتقاده المتكرر لهم في نتاجه الإبداعي.
كمال الرياحي: فقدان ماركيز أهم من رحيل محفوظ
ويقول الروائي التونسي كمال الرياحي إن غياب ماركيز يمثل حدثا كبيرا لأي روائي عربي ‘من ناحية فقدان كبير لروائي كان له من الكفاءة الإبداعية والسردية ما جعله يستمر في الكتابة لسن متقدمة’.
ويضيف لـ’القدس العربي’: ‘أشعر أن ماركيز اقترب كثيرا من الأدب العربي، فرواياته تعبر عن البيئة العربية بكل تفاصيلها، وخاصة الجو السحري والتعلق بالموسيقى والأساطير وعوالم ألف ليلة وليلة وغيرها’.
ويذهب الرياحي بعيدا حيث يؤكد أن فقدان ماركيز قد يكون أهم من فقدان نجيب محفوظ بالنسبة للروائيين العرب، مشيرا إلى أن نتاج الأديب الكولومبي متوفر لدى أغلب القراء العرب وبلغات متعددة.
ويرى أنه ماركيز ‘أبو الأدب اللاتيني’ هو أحد الأسباب الرئيسية لانتعاش الجنس الروائي في العالم، و’إذا كان البعض يعتقد أننا في زمن الرواية، فإني أرى أن نعيش زمن ماركيز′.
وتحدث الرياحي عن العلاقة المتواترة بين ماركيز و’صديقه اللدود’ الأديب البيروفي ماريو فارغاس يوسا، مشيرا إلى أن ‘الصراع الأدبي’ بين الرجلين قادهما لاحفا لنيل جائزة نوبل.
وأضاف ‘ما يميز ماركيز هو أنه قادر على صناعة الأحداث حتى وإن لم يكتبها، نذكر على سبيل المثال اللكمة التي تلقاها من يوسا إثر خلاف مع يوسا، حيث لجأ إلى مصوره ليلتقط له صورة عينه المتورمة وهو يضحك، بمعنى أنه حوّل هذه اللكمة أو الحادثة البسيطة إلى حالة إبداعية’.
وكان يوسا اكتفى بالتعليق على حادث رحيل صديقه ماركيز بالقول ‘إن رجلا عظيما قد مات. أثرت أعماله الأدب الإسباني وحلقت به إلى آفاق أوسع′.
زهور كرام: استثمار رحيل ماركيز في الحديث عن راهنية الإبداع
وترى الأديبة المغربية زهور كرام أن رحيل مبدع حقيقي بحجم ماركيز هو خسارة للبشرية ‘التي تعيش الآن فوضى المفاهيم، والتباس معنى الوجود، بسبب دمار الوجدان الذي بدأ يفقد لماء الإنسانية، واختناق الخيال مع هيمنة التكنولوجيا التي تتحول مع سوء توظيفها من مجرد وسيط من المفترض أن يخدم الإنسان، ويهيئ له مساحة من التفكير الحر، وتنشيط خياله إلى سلطة تعطل الخيال والفعل’.
وتضيف لـ’القدس العربي’: ‘عندما تفقد البشرية قيمة إبداعية خلاقة، فإنها تعلن الفقد مأساة. قد يختزل هذا الإحساس رحيل الكاتب العالمي غابرييل ماركيز، الذي شكل حضوره الإبداعي ثروة إنسانية تمثلت في قدرته البليغة على استثمار الخيال، وجعله ملازما للواقعي من أجل بناء حالة إبداعية جعلت من كتاباته ملتقى التفاعل الإنساني’.
وترى أن رواية ‘مائة عام من العزلة’، التي كتبها ماركيز عام 1967 ونال عنها جائزة نوبل للآداب عام 1982، تشكل نقلة نوعية في مسار كتاباته و’أهم مدخل لعالم هذا المبدع الخلاق’.
وتشير إلى أن ماركيز قال ذات يوم إنه استوحى أحداث الرواية من الحكايات الشعبية والخرافات الغرائبية التي كانت تحكيها جدته عندما كان طفلا، وتقول إن ‘مئة عام من العزلة شاهدة عن كون زمننا أنجب مبدعا أجاد عشق الخيال’.
وتضيف ‘وهنا، لابد من استثمار بعض مقومات التجربة الرائدة عند ماركيز وهو جودة تدبير ذاكرة الطفولة واستلهام غناها الحكائي الذي جعل ‘مائة عام من العزلة’ تنفرد بتميز سرد العوالم الغرائبية وسحر العجائبية، إلى جانب قوة اللغة الإبداعية الإسبانية’.
وتتساءل كرام عن مصير الإبداع مع اختناق شروط الخيال، و’كيف يمكن للبشرية أن توثق رؤاها، وفلسفة وجودها في إبداع بدأ يقترب أكثر من الواقع؟ وكيف يمكن تمثل الإبداع في زمن تراجع الحكايات، وهيمنة التقنية؟ وهل من الممكن أن نتحدث عن توجه جديد للممارسة الإبداعية في ظل شروط تكنولوجية؟ كيف نستطيع أن نجعل من رحيل ماركيز المبدع الخلاق محطة مهمة لإعادة طرح سؤال راهنية الإبداع في الزمن الحالي؟’.
يوسف رزوقة: ماركيز الصحافي التقط الأحداث بعد أن اكتوى بحرائقها
ويؤكد الأديب التونسي يوسف رزوقة أن ماركيز كان ‘بمثابة الكاميرا التي تلتقط التفاصيل لكونه كان صحافيا أيضا ملما بالأحداث ويكتوي بحرائقها، وهو ما خوله أن يكون مرآة عاكسة لعصره وعاملا في مسار السرد العالمي’.
ويؤكد أن العالم لن يستطيع نسيان ‘كبير كتاب العالم’ الذي ‘أعطى زخما روائيا كبيرا جعل قراء العربية والعالم يحترمونه، وجعل من الرواية علامة فارقة في مستوى المصطلح’.
ويضيف ‘ماركيز أكبر رواد السرد وهو لن يموت لسبب واحد هو أنه أضاف للمدونة السردية روايات مثل ‘مئة عام من العزلة’ و’الحب في زمن الكوليرا’ وهي ستظل في الذاكرة وتؤسس لسرد مستوفي لشروطه الإبداعية بما له من زخم بالأحداث وعيون لاقطة لكل التفاصيل الصغيرة’.
وأكد رزوقة أيضا ولع أدباء أميركا اللاتينية بالمشرق وتطويع حكاياته في نقل واقعهم المعاش، وأشار في الوقت نفسه إلى أن ماركيز يشاطر أقرانه في كتابة سيرته الذاتية التي يمكن استثمارها سينمائيا لاحقا، مؤكدا أنه ‘لا يستغرب أن يكتب ماركيز عن الجانب الأنثربولوجي فيه لأنه يعتبره أيضا ارتدادا لرواياته السردية’.
مسعودة بوبكر: ماركيز نجح بتحويل الواقع المحلي إلى حالة عالمية
وتقول الأديبة التونسية مسعودة بوبكر ‘غابرييل غارسيا الأديب الكبير الذي تربينا على نصوصه وفي ذائقتنا الأدبية الكثير منه، ولا نستطيع أن نتصور أدبا سرديا أو رواية دون التفكير في ماركيز′.
وتشير إلى أن الأدب العربي تأثر كثيرا بماركيز كأبرز أعلام أمريكا اللاتينية ‘الذي تأثر بدوره بحكايات ألف ليلة وليلة والتراث العربي، كما أن الأدباء العرب تأثروا بأسلوبه في سرد الحكاية وتفاصيلها العديدة والتحليل النفسي والاهتمام بالواقع القريب الذي يجعل منه بمحليته أمرا عالميا، أي: تطوير الحالة المحلية إلى عالمية’.
هيام الفرشيشي: ماركيز كان قريبا جدا من الروح العربية
وترى القاصة التونسية هيام الفرشيشي أن رحيل أديب مثل ماركيز سيعيد تسليط الضوء على منجزه الإبداعي والنتاج الأدبي لأميركا اللاتينية عموما و’مدى ارتباطه بتحرر الشعوب من بوتقة القوى المهيمنة، والاشتغال على المحلية الضيقة التي تستثمر هموم الإنسان في كل مكان’.
وتضيف ‘يجب أن لا ننسى أنه اشتغل على سمات مهمة تفتح آفاق الفكر كالعزلة والبحر، وسيؤثر نتاجه على اعادة الاعتبار للأدب عموما’.
وتشير إلى أن ماركيز ‘أعاد إنتاج الخيال العربي من خلال إطار طبيعي وسياسي مختلف ولهذا كان قريبا جدا من الروح الشرقية والعربية’، مشيرة إلى أن رواياته شكلت جواز سفره إلى عدد كبير من الدول وخاصة أميركا التي كان ممنوعا من الدخول إليه حتى مجيء الرئيس الأسبق بيل كلينتون الذي ألغى هذا الأمر.
يذكر أن كلينتون أكد في وقت سابق أنه يشعر بالفخر لأنه كان أحد أصدقاء ماركيز طيلة عقدين، وأضاف ‘حين قرأت روايته مائة عام من العزلة قبل 40 عاما، شعرت بالذهول من قدرته على التخيل ووضوح الفكر، والأمانة العاطفية’.
رسالة إلى ماركيز.. جنّة من الذكريات/ عبّاد يحيى
كانت خطة لئيمة يا أستاذ، ولا شك أنك رتبت لها منذ أمد بعيد، بكامل وعيك وخيالك. فصل أخير أنت بطله الأوحد، والبقية – وهم هنا كل الناس غيرك- مجرد مؤدّين ثانويين في مشاهد خالدة، وفي الغالب لا تظهر منهم إلا أعقاب رؤوسهم وظهورهم، وأنت في قلب كل شيء.
هل تعلم، حين أفكر في الأمر على مهل أدرك أن الحبكة بسيطة وهذا سرّها، بل أبسط من حبكة أية قصة قصيرة كتبتها. لا أخفي عنك، وأنت في هذا الصباح قريب بعيد، أنني فكرت في مراسلتك أو مراسلة زوجتك. طبعاً أدركت أن مراسلتك لن تجدي. أما خيار مراسلة مرسيديس فكان وارداً، ولكنني أعدت التفكير مرتين، وقلت دع العجوز يؤدي دوره الأخير، لماذا التنكيد والتنغيص!
بصراحة كنت سأكتب لك رسالة من سطر واحد وهذا نصّها: “لم أكن أدرك أنك ممثل لامع يا أستاذ، بل ممثل أدوار طويلة أيضاً. هنيئاً لك. المهم أخبرني كيف رتبّت الأمر مع جوقة الأطباء وأقنعتهم بخطتك؟ ألا توجد لديكم رقابة على التقارير الطبية المزيّفة؟!”
بصراحة أكبر – وهل تجوز مع الراحلين غير الصراحة الخالصة! – وتفادياً لانتظار رسالة ردك على رسالتي التي لم تصل أصلاً، ها أنا أقترح حوارك مع كبير الأطباء، الأصلع ذاك الذي خرج على الملأ أول الأمر، وقال بنبرة واثقة حزينة إنك مصاب بخرف متقدم. ولتأثيث حواركما أفترض أنه حصل في مكتبك وأنت مستلق على ظهرك تنظر إلى السقف، والطبيب يجلس مؤدباً على كرسيه يستمع لحديثك العجيب:
أنت تعلم يا صديقي أن هذا البدن بكل علله وأمراضه كان ماثلاً دوماً بين يديك، وقد ائتمنتك على ما هو أهم من البدن، العقل والذهن والروح، أنت صديقي أولاً وطبيبي ثانياً، وما سأطلبه منك اليوم يعدل وهبي حياة ثانية، وبمجرد سماعك كلامي سيغدو نافذاً، واسمح لي أن ألزمك اليوم بما أقول لمرة أولى وأخيرة.
لقد تعبت، نعم تعبت مما مضى، ولا يعني ذلك أنني لست سعيداً، أبداً، أنت تعلم أن كل خلية في هذا الجسد سعيدة، ولكنني أشعر بدنو نهاية ما، والسرطان لا يرحم، ومكابدته الطويلة هي الانتصار في النهاية، وأريد أن أنتظر هزيمتي الجميلة كما أحب وأشتهي، وأنا وأنت فقط سنرتب للسنوات القلائل التي تفصلنا عن موعد رحيلي.
لقد كتبت الكثير كما تعلم البشرية كلها. يقول النقاد كلاماً كثيراً عن عيش الكاتب حيوات أبطاله، قد يكون ذلك صحيحاً من باب المجاز فقط، ولكنني أريده اليوم واقعاً، أريد دورا جميلاً انتظرته طويلاً، دوراً يليق بحياتي الطويلة، دوراً سحرياً، سحرياً أكثر من تلك التي يسمونها واقعية سحرية.
ستعلن يا طبيبي الجميل أن السرطان تحالف مع مرض ما يفقدني الذاكرة، لا أدري ما هي الصيغة الأنسب، خرف ربما، المهم أنه فقدان ذاكرة حاد مع أمل بسيط بالتذكر بين فينة وأخرى. فقدان ذاكرة يعفيني من الإجابة عن أي سؤال، ويعفيني من أية التزامات اجتماعية. فقدان ذاكرة يحوّلني إلى طفل يبتسم له الناس ويضحكون ويداعبون وجهه دون أمل بشيء أكثر من رد ابتسامة. فقدان ذاكرة يريحني من النقاد والقراء المزعجين ومن الصحفيين أيضاً. سلام تام.
ولكن لا بد من ترك مساحة بسيطة لأمل بالتذكر، أتدري لماذا أريدها؟ سيأتي الناس إليّ بكل جميل في حياتي ويضعونه بين يديّ لتنشيط الذاكرة المفقودة، تخيّل! لو أنني اليوم أعلنت عن رغبتي وحاجتي لرؤية كل جميل مضى في عمري، الجميلات اللواتي أحببتهن، أنحاء عشت فيها وعشتها، كتب بديعة عصرتني وعصرتها، أزهار علقتها على قلبي، روائح وأصوات ومذاقات ووجوه، هل يمكنني الحصول عليها؟!
يستحيل ذلك، ولكن إعلانك فقداني الذاكرة، ودعوتك المقربين والأحبة للمساعدة في بث أي تذكّرات فيّ سيأتياني بكل شيء، سيتنادى الجميع لمساعدة العجوز الحزين، سيحملون خلاصة حياتي إليّ، سأعيش في بضع سنوات حياتي كلها مرة أخرى، مكثّفة، مصفّاة، لا مكان فيها إلا للجمال.
سأعيش في جنة قبل الموت إن حصل هذا، تخيّل، سترتمي صبية جميلة عند قدميّ وتضع خدّها على ركبتي، وتحمل روايتي الأولى في حجرها، وتقرأ لي بصوتها المغلف بالضحك والبكاء، علّها تنشّط ذاكرتي المهترئة. ياه! أريد ذلك يا صديقي، بحق كل شيء جميل، بحق كل سطر كتبته وملأ الدنيا، أريد ذلك.
لا تقلق من العائلة، لا أريد أن يعرف غونزالو ورودريغو بالأمر، وربما أُخبر مرسيديس، وهذه مخاطرة، سأفوّت كل محاولاتها الساحرة في بعث الذكريات فيّ، ما رأيك؟ هل أخبرها أم لا؟
– غابو.. يمكنني أن أقنع الدنيا كلها بحالتك المزعومة إلا مرسيديس! ما بالك!
– ما رأيك أن تخبرها بخطتي وتطلب منها أن تتصرف كأنها لا تعلم شيئا؟!
– يا رجل بدأت تصعّب المسألة المستحيلة أصلاً. أنت طفل بجسد عجوز، تريد أن تعلب!
– بحق أيّ شيء .. خاتمة محكمة .. لعبة أخيرة صغيرة.. جنة من الذكريات!”
هيييه يا أستاذ، وهذا ما حصل. لك الرحمة أيها اللئيم.
* روائي من فلسطين
ماركيز كاتباً عربياً/ رائد وحش
قدّم ماركيز درسه الأكبر حينما أصدر سيرته الذاتية “عشتُ لأروي”، فالكتاب الذي أراده أن يكون بمثابة كواليس لنصوصه، أو حديقة خلفية لها، أو حتى فضحاً لأسرار الكار، علّمنا أنّ ذلك السرد الذي فتن العالم مشتقٌّ من حياة عادية تشبه أية حياة أخرى، وأنّ تلك الشخصيات الآسرة أناس عايشهم وعرفهم، لكن المفتاح: “كيف تُحكى الحكاية”؟
الروائي والصحافي بيلينيو ميندوثا آبييلو صديق ماركيز، الذي سبق وأجرى معه أفضل الحوارات (نُشرت في الكتاب الشهير “رائحة الجوافة”) عاد وأصدر في السنة الماضية كتاب “غابو- رسائل وذكريات” عن مرحلة الشباب والضياع.
يومها كان ماركيز في العشرين، وميندوثا في السادسة عشرة، حيث عاشا البؤس معاً في باريس، وسافرا إلى بلدان الاشتراكية، وعملا في فنزيلا وهافانا، وكانت بينهما مراسلات مستمرة. كما حوى الكتاب رسائل وصور لم تنشر من قبل، كرسائله وهو يكتب “مائة عام من العزلة” و”خريف البطريرك”، التي يصف فيها معاناته الشخصية وهمومه في الكتابة. إضافة إلى ألبوم من الصور غير المنشورة من قبل. كتلك الصورة الكوميدية، قبل لحظات من تسلمه جائزة “نوبل”، حيث جميع أصدقاءه بالبدلات، فيما هو بالملابس الداخلية. كما يتطرق الكتاب إلى الوضع الصحي الذي وصل إليه، حين بلغ مرضه مراحله القصوى ولم يعد يتذكر أصدقاءه. لكأنّ ميندوثا يكتب هنا لينقذ تلك الذاكرة.
حينما حصل المترجم صالح علماني على الكتاب سارع إلى قراءاته، وراح يسرد لنا بعض تفاصيله الصغيرة، سواء من الحوادث الطريفة، أو مما يضيء جوانب خفية من رواياته. فمثلاً يتحدث الكتاب أنهما (ماركيز وميندوثا) حين زارا موسكو، وشاهدا جثمان ستالين المحنط، قال له ماركيز، بعد خروجهما للتمشي في “الساحة الحمراء”: “هل انتبهت إلى اليدين؟”، “أي يدين؟” سأل ميندوثا، “يدا ستالين” قال غابو، “ما بهما؟” استهجن رفيقُه، “إنهما أشبه بيدي امرأة” قالها بدهشة من يكتشف أمراً عظيماً. وهنا يعلّق ميندوثا: “بعد سنوات طويلة من ذلك، سيضع تينك اليدين لديكتاتور روايته “خريف البطريرك”.
تجاوز تأثير غابرييل غارسيا ماركيز في الثقافة العربية تأثير الكاتب المترجَم عن ثقافة أخرى، ليصل إلى درجة تأثير ابن اللغة والثقافة ذاتهما. الفضل يعود على الأرجح إلى ترجمات صالح علماني (“مؤلف الظلّ” كما يدعوه أصدقاءه) ذلك أن الترجمات الأخرى ظلت تُعامل بوصفها ترجمات عادية، بينما ذهبت جهود علماني إلى نوع من تجذير كتابات ماركيز في العربية، فحتى الأمثال الشعبية الكولومبية والأمريكية اللاتينية جاءت بنكهة شعبية عربية.
عوالم الواقعية السحرية وجدت صدى مزلزلاً عندنا وقد خصص الناقد الرشيد بوشعير كتابه “أثر ماركيز في الرواية العربية” ليوضّح مساهمة ماركيز في تحرير الكتابة الروائية العربية من جفاف الواقعية التي ارتهنت لها طويلاً.
كانت الأسئلة التي تقلق “غابو” في أمريكا اللاتينية هي ذاتها التي تقلقنا في “شرق المتوسط”، وناهيك عن هول التشابه بيننا هنا، وبينهم هناك؛ كان الفن الروائي هو التعبير الأبلغ عن العالم الثالث، ليس في حركات تحرره ونضاله ضد الدكتاتورية والامبريالية وبحثه عن العدالة المفقودة، بل في كسره للمركزية الأوروبية كمرجعية روائية.
“شهرزاد عصرنا” فيها الكثير منا.. ماركيز عربي إلى حد كبير.
ماركيز في قلب أفريقيا/ محفوظ بشرى
دائماً هناك قصة عن اللقاء الأول لكلٍّ منَّا بماركيز (غالباً على صفحات “مائة عام من العزلة”، أو “الحب في زمن الكوليرا”)، ذلك اللقاء المذهل الذي يتسبب لكثيرين بدهشة قد تستمر أعواماً، وقد يلطم بعضَنا بكوابيس لذيذة.
فأن يقتحم عليك ماركيز صمت حياتك في سن الثالثة عشرة ـ كما حدث معي مثلاً ـ لهو أمر كاف ليزلزل مسلماتك عن الحياة، والموت، والمنطق، ويبذر فيك الريبة فلا تميِّز ما هو حقيقي عمّا هو ليس كذلك. بل قد يثير رياح مراكبك التي لم تبحر حتى ذلك الوقت في الأنهر الساكنة لحياة الريف المنسي في دولة تقع في قلب أفريقيا.
كيف تسلَّل إلى هناك؟ أية قوة تجعل ماركيز يصل إلى هذه المجاهل، يصل إليك، فتعرف أنه أفضل ما أنتجته كولومبيا، حتى قبل أن تعرف ما هي كولومبيا؟
أحبُّ ماركيز، مثل أكثر أبناء جيلي المفتقر إلى الحياة والحب. أحب ماركيز الذي جاء ليشبعنا ويُغْنِي فقرَنا ذاك بحكاياته، بعالمه المكوّن من عصير الرغبات والاحتمالات والخسارات الصغيرة.
تعرف بعد سنوات أن ماركيز غيَّرك، فترى النهر كالأنهر في قصصه، وحقول قصب السكر تصير حقول موز رطبة، والغابة الصغيرة الشوكيَّة تغدو غابة استوائية مطيرة، وترى الناس الواجمين في بلدتك المُهمَلَة يتدفقون سحراً، كما لو أنَّك تجول بين دفتي رواية، وتصيخ لماركيز يرصّ التفاصيل ليبني حلماً شاسعاً ناريَّ الجمال.
وداعاً الآن، غابرييل غارسيا ماركيز، سنهشُّ النسيان عن اسمك؛ سنهشُّ الموت عن دهشتنا الأولى بك، ولن تموت.
ماركيز.. حارس مرمى ضلّ طريقه إلى الأدب
ربما لا يعرف كثيرون من عشاق الأديب الكولومبي الراحل، جابرييل جارثيا ماركيز، أنه حلم في طفولته بأن يكون لاعب كرة قدم، لكنّ القدر غيّر مساره الى عالم الكتابة ليصبح أحد أهم وأشهر الأدباء في العالم.
عشق ماركيز لعب الكرة في شوارع مدينة أراكاتاكا، مسقط رأسه، وكان يهوى حراسة المرمى، لكن إحدى الكرات العنيفة كانت سببا في ابتعاده عن هوايته المفضلة، فبينما كان يستعد للتصدي لإحدى الهجمات، سدد الخصم بقوة في بطنه ليسبب له الأذى في معدته، ويقرر بعدها الاكتفاء بدور المشجع لفريقه المفضل “أتلتيكو جونيور” في سن الـ 23.
ومن الوقائع التي تدلل على شغفه بكرة القدم حين راهن صديقه دانيلو بارتولين، طبيب الرئيس التشيلي الأسبق سلفادور أليندي، على أن منتخب كولومبيا سيتوج بكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، وقد خسر الرهان الذي كان على “سيارة مرسيدس”، بحسب ما ذكرته صحيفة (سيمانا) الكولومبية.
وعقب البطولة نفسها، أدان جارثيا بشدة مقتل اللاعب أندريس إسكوبار على يد عصابات المافيا، بسبب تسجيله هدفا في مرماه خلال مباراة أمام الولايات المتحدة تسببت في خروج بلاده من المونديال.
وبالتزامن مع بدء عمله في الصحافة، كان ماركيز يمارس ايضا رياضة الملاكمة، ووجد بينهما تشابها في مسألة تلقي الضربات وردها للمنافس، مع قيمة المثابرة وعدم الاستسلام.
كما عرف بولعه برياضة البيسبول، ومن أقواله الشهيرة “الأفضل من البيسبول هو الكلام عن البيسبول”.
وتوفي ماركيز الخميس عن عمر 87 عاما في منزله في العاصمة المكسيكية، حيث عاش خلال الأعوام الأخيرة.
وكان مؤلف رواية “الحب في زمن الكوليرا” يتلقى خلال الأيام الماضية العلاج في منزله في المكسيك، منذ أن غادر مؤخرا مستشفى في مكسيكو سيتي قضى فيه ثمانية أيام لإصابته بالتهاب رئوي وفي المسالك البولية.
وولد ماركيز في السادس من مارس/آذار من عام 1927 ، وفاز عام 1982 بجائزة نوبل للآداب، ونشر العديد من الأعمال أبرزها “مائة عام من العزلة و “خريف البطريرك” و”قصة موت معلن” و”الحب في زمن الكوليرا”.(إفي)
كيف فعلها ذلك الساحر/ محمد ديبو
كثر هم الأدباء والمثقفون والفلاسفة الذين حصدوا شهرة تخطت حدود بلدانهم إلى آفاق ولغات العالم. إلا أن هذه الشهرة بقيت في أغلب الأحيان محدودة بإطار النخب الثقافية والفكرية في كل بلد.
وحده غابرييل غارسيا ماركيز كان استثناءً، كاسراً الحاجز بين النخبة والجماهير بكافة ألوانها وأجناسها واختلاف ثقافاتها. ففي أي شارع أو باص أو حديقة من العالم، قد نفتح حديثاً عابراً مع الناس العاديين الذين لا تشكل القراءة روتيناً يومياً لهم، أو قد يقرؤون عشرة كتب في حياتهم كلها، ونسألهم عما قرأوا، فيعطوننا اسمين أو ثلاثة بينهم ماركيز.
النخب بحكم قراءتها اليومية تشكل نوعاً من قبيلة عالمية، ذات ملامح تتجه يوماً بعد يوم للتوحد بفعل تطوّرات العالم المتسارع، في حين تبقى الشوارع العالمية التي لا تقرأ يومياً “منفلشة” في تنوعها وتجربتها، وبالتالي ثقافتها. ومع ذلك تمكن ماركيز من جذبها بكلمته دون أن يخسر النخب، بخلاف كثيرين غيره تحوّلوا إلى مجرد كتّاب شعبويين وإن حصدوا شهرة واسعة أيضاً، الأمر الذي يطرح سؤالاً كبيرا: كيف فعل ذلك؟
السر في الكتابة دائماً.
قد تكون روايته “الحب في زمن الكوليرا” هي التي حملته إلى قلوب الناس في كل أنحاء العالم، لما للحب من قدرة على اختراق الحدود والعبور إلى قلوب البشر الذين يدهشهم الحب في كل مرة، ولا تزال تدهشهم فكرة أن ينتظر العاشق حبيبته خمسين عاماً، قبل أن يعيشا معاً بكامل عدّة الشبق. إذ لم تزل فكرة الرواية حتى اللحظة مدهشة رغم مضي عقود على كتابتها، ولا نزال حندهش لقصة مماثلة نسمع بها في الواقع. إنه التقاط للجوهري من وحل هذا العالم ورفعه إلى مصاف الكتابة: الحب الذي لا يشيخ. ولم لا؟ أليس هو القائل: “سأبرهن للناس كم يخطئون عندما يعتقدون أنهم لن يكونوا عشّاقًا متى شاخوا، دون أن يدروا أنهم يشيخون إذا توقفوا عن العشق”.
إنها براعة الفكرة الخارجة من رحم الشارع وسوقيته، بعيداً عن قيم وتهذيب النخب التي تسير وفق قيمها التي تصنعها بنفسها وتتحوّل إلى قوانين جديدة وأصنام جديدة، في حين قال ماركيز: “سوف أسير فيما يتوقف الآخرون، وسأصحو فيما الكلّ نيام”، و”قل دائمًا ما تشعر به، وافعلْ ما تفكّر فيه”.
وهذا ما يفسّر كتابته في أواخر حياته ما كان يمكن أن يكتبه غيره في أوائل حياته (“ذكريات عاهراتي الحزينات”)، مكوّناً تجربته الفريدة التي قد تكون الصحافة ساهمت في تكوينها، فالتقط الجوهري والمشترك بين الشوارع العالمية والطرفية الغارقة في تخلّفها وطرفيتها، لكنها غنية في تعددها وقدرتها على الحب، فكانت روايته لغة عالمية في موضوعها لا في لغتها، ولهذا “ستعيش روايات غابرييل غارسيا ماركيز بعد موته، وسيفوز بِقرّاء في كل مكان من العالم”، كما قال خصمه اللدود وصديقه في آن، يوسا.
خريف البطريرك العربي.. وداعية مؤجلة/ بخالد الإختيار
خرج من منزله تلك الليلة محاولاً بالمشي شفاء نزلة الصدر الوجودية التي انتابته فجأة. أخرج هاتفه من جيب بنطال الجينز، وقبل أن ينبس صديقه على الطرف الآخر بحرف؛ بادره بالصراخ:
“ابن الـ…، لقد قاربت على الانتهاء من قراءة الجزء الأول، وأخو الـ… ما زال في الخامسة والعشرين فقط!”
لم يكن ذلك الشتّام اللعّان سوى أنا، ولم يكن ذلك الشاب ابن الخامسة والعشرين الذي زلزلني وأثار حنقي سوى غابرييل غارسيا ماركيز، ولم يكن الجزء الأول الذي تحدثت عنه لصديقي سوى الدفعة الأولى من مذكرات هذا الكاتب التي التهمتها بلقمة واحدة بعد صدور طبعتها الأولى في دمشق بعنوان “عشت لأروي”.
أن تجاوز الـ250 صفحة وأنت تقرأ عن الحياة (العادية) لشخص ما في منتصف العشرينات من عمره دون أن تجد متسعاً لوساوس إلقاء كتاب هذا المراهق المزمن جانباً؛ أمر لا يحدث كلّ يوم. ثمّ أن تقارن تلك الصفحات التي تطفر بأنفاس وعرق صاحبها بحياتك السائلة أمامك في رمادي الشام حينها؛ أدعى لأن تصاب بنوبة جنون رقيقة.
ستجري مياه كثيرة تحت الجسر إيّاه بعد ذلك، وستأخذ حلقات رواياته لبّك الطري، ثم ستنقلب عليه لتتمكن من قراءة كتّاب آخرين سواه، من دون أن تظلّ نظارته على عينيك تقيس بها كلماتهم وسطورهم بالسنتيمتر الماركيزي.
“الواقعية السحرية” لم تكن حلاً من “غابو” لتقديم تفسير علمي للخوارق المجتمعية التي تربينا عليها، كما يتربى غيرنا على القانون والمنطق؛ بل جاءت كتوصيف حال فج يقول إنّ القاعدة (عندنا كما في أميركا اللاتينية) كانت للشاذ والطارئ اللذين يستطيلان في حيواتنا فلا يعود هناك بد من بناء عش مؤقت فوق الأغصان المتكسرة تلك ريثما تنبت أجنحة للشجرة بكاملها، لا لسكانها من العصافير الصغيرة فقط.
الطاغية الذي درّب جنوده ليعملوا مجاناً و”يثبتوا بأنهم قادرون على تمزيق أمهاتهم إرباً إرباً وإلقاء المزق إلى الخنازير دون أن يتحرك لهم ساكن”؛ يرقد اليوم بثقب هادئ في رأسه، أسفل خندق محكم، ومبخّر بمواد تزرد اللحم الميت بشهوة كيميائية، بين “مصراتة” وساحل المتوسط.
الأب القائد الذي حزّ بنياشين انتصاراته الملحمية ستة رؤوس وكوّن لنفسه ستين عدواً، ومقابل الستين رأساً التالية صاروا ستمائة، “ثم ستة آلاف، ثم ستة ملايين، ثم كل البلاد”؛ افتقد الشامبو الأثير لديه في حفرته الدودية، قبل أن يخرج ليعتمر قلنسوته السوداء حتى عنقه، ويُربطَ له فوقها “كرافات” من أسلاك خشنة ستكون رسمياً آخر ما سيرتديه في حياته، وبدون سيجار أو بندقية صيد.
المستبد الشيخ الذي كان من الصعب التسليم بأنه لا يمكن إصلاحه “هو بقية إنسان، كانت سلطته من القوة بحيث سأل ذات يوم [كم الساعة الآن؟] فأجابوه: [الساعة التي تريدها سيدي الجنرال]”؛ يتمشى اليوم بكرسي الحكم الذي أضاف إلى ديكوره عجلات مدولبة تعين جسده الشبحي على ولوج القلم الانتخابي ليقترع لنفسه عن ولاية أبدية جديدة، ويقول بعد اضمحلال حنجرته إيماءً: “عاش أنا”.
الجنرال الذي أمر بتعليق الناس مقيدي الأرجل والأيدي ورؤوسهم إلى أسفل مدة ساعات وساعات، ثمّ “اختار واحداً من المجموعة الرئيسة، وأمر بسلخه حياً على مرأى الجميع. والجميع رأوا الجلد اللين الأصفر مثل غشاء جنين ولد حديثاً، وأحسوا بأنهم تبللوا بذلك السائل الدموي الغالي من لحم مسلوق يحتضر واثباً على بلاط الباحة”؛ توقف دماغه الفذ عن ابتكار مزيد من ضروب السحل والتمثيل بالأحياء، ودخل غيبوبة لمدة ثماني سنوات، رأى فيها أحلام جميع من قتلهم في حرب الأيام الستة، والسبعة، والسبعين عاماً.
والدكتاتور الوديع بعينيه السماويتين وضحكته الهوائية سيصدر عفوأً عامّاً بعد أن لم يبق مكان في سجنه لفرد، “منزعجاً من حشد من البُرص والعميان والمشلولين المتوسلين، ومن سياسيين متعلمين ومتملقين بلا حياء كانوا ينادون به قائداً أعلى للزلازل الأرضية، وللكسوف وللخسوف والسنوات الكبيسة، وأخطاء الرب الأخرى”؛ لن يتمكنّ من الاعتناء شخصياً بتجهيز “برميله” الأخير الذي كان سيدحرجه فوق مدينة ما في مزرعته التي ورثها عن أبيه “الخالد”، إذ أنّ العقبان ستنقض على شرفات قصره الرئاسي خلال نهاية الأسبوع، “ومع بزوغ شمس يوم الاثنين ستيتقظ المدينة من سبات قرون عديدة على نسمة رقيقة ودافئة. نسمة ميت عظيم، ورِفْعَةٍ متعفنة”.
كان بانتظار غابيتو، أن يكتب 6 روايات مفصّلة أخرى عن معتوهي تونس وليبيا ومصر واليمن والبحرين وسوريا والجزائر و..و.. لو أنّ جهازه اللمفاوي سمح له بهذا. لكنّه منحنا مع ذلك رؤوس الأقلام التي لا بدّ أن نخطّ بها يوماً سير هؤلاء، وعلى زاوية منضدتنا 500 ورقة بيضاء، وزنبقة صفراء في عروة القميص.
“الواقعية السحرية” هو التعريف “السوسيولوجي” الرصين لنمط الحياة التي صنعتنا بأيد عابثة (لكن صلدة) كفخار معدّ لشهوة التحطيم.
وهل أقلّ سحراً وعبثية من أن تبرمج نفسك لسنوات خلتها ستكون طويلة، كي تذهب في معرض الكتاب السنوي بدمشق إلى إحدى دور النشر، وتحاول تكراراً إقناع القائمين عليها بأنّ ماركيز يحبذ عنوان “خريف البطريرك” لروايته، وليس “خريف البطريق” كما يظهر العنوان على نسخة الدار من الكتاب؟
أصدقاء قالوا لي إنّ الرجل الكولومبي المرح كان مريضاً. وكأنّ الموت طبيعي في المرض، أو بعده. أين ماركيز ليقص عليهم حكاية من حكاياته يخبرهم فيها كيف أزاحت إحدى شخصياته القادمة حجر المدفن الثقيل وخرجت من القبر المائل بكامل زينتها، وأوقفت “تاكسي” عابراً لتلحق بالمشيعين وتواسيهم عن قطعهم روتين أشغالهم من أجل جنازة ليس اليوم هو الوقت الأمثل للسير في ركابها.
لقاء فوق السطوح مع غارسيا ماركيز/ إنعام كجه جي
بعد رحيل هذا وذاك من المشاهير، اعتدنا أن نقرأ في صحفنا «المقابلة الأخيرة مع فلان»، أو «آخر حديث مع علان». وللسخرية من تلك الظاهرة، كتب الناقد غالي شكري، ذات يوم، ما وصفه بأنه «أول حوار مع فلان بعد الموت». هل يملك الراحل أن يكذّب المدعين؟
بالنسبة لي، لم أكن صاحبة المقابلة الأخيرة مع الروائي الكولومبي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز. لكنني أجريت معه أول حديث لصحيفة عربية. وقد كان وسيطي، أي واسطتي باللغة الدارجة، للحصول على وظيفة ثابتة في مجلة واسعة الانتشار كانت تصدر من باريس. فقد نشروا المقابلة وطلبوا مني الاستمرار في العمل.
كنا في ربيع 1982، قبل حصوله على «نوبل» بأشهر قلائل، حين دعي ليكون عضوا في لجنة تحكيم مهرجان «كان» السينمائي في فرنسا. وهناك، على سطح القصر القديم للمهرجان، بعد مؤتمر صحافي لأعضاء اللجنة، تقدمت لتحية صاحب «مائة عام من العزلة» وشجعني لطفه فطلبت منه إجراء مقابلة خاصة لجريدة عراقية كنت أراسلها. ولم يتعلل بازدحام برنامجه بل أخرج من جيبه قائمة وكتب اسمي في آخرها، قائلا إن هناك 35 صحافيا قبلي طلبوا مقابلة. وفهمت أنه اعتذار مهذب والتقطت له بعض الصور ومضيت.
في الثامنة من الصباح التالي دقت صاحبة فندق «آلبير» المتواضع باب غرفتي، إذ لم يكن فيها هاتف، وقالت إن هناك مكالمة لي. وكان المتحدث هو غابرييل غارسيا ماركيز يدعوني لتناول الفطور معه، بعد ساعة، في «الكارلتون»، أفخم فنادق المدينة.
طلبت شايا غامقا وطلب صحنا من البيض المقلي، قائلا إنه سيكتفي به حتى المساء لأنه يحاول تخفيف وزنه. ثم شرح لي، كمن يبرر نزوة، أنه وجد نفسه ملزما بحضور المهرجان لأن الاشتراكيين قد فازوا بالحكم والرئيس ميتران «صديق عزيز» عليه، وكذلك وزير الثقافة جاك لانغ. وحرص على القول إن الدعوة كلفته مالا لأنه يحب الحفاظ على حياته الخاصة وقد اضطر لاستئجار شقة بعيدة يلتقي فيها بزوجته، بينما تبقى غرفته المحجوزة في الفندق عنوانا رسميا.
أخبرني، في السياق، أنه تجاوز التسلسل في قائمة الصحافيين وقدّمني عليهم لأنني من موطن «ألف ليلة وليلة»، الكتاب الذي وجده في مكتبة جده وكان أول كتاب يطالعه في حياته. «لقد بدأت منه ولم أنتهِ بعد». أما السينما فهي عشقه الثاني بعد الكتابة، وهي المهنة الوحيدة التي درسها في روما وجرّب، في البداية، أن يصبح مخرجا، وكان يرى أن السينما هي وسيلة تعبير أشمل من الأدب. ثم غير رأيه وآمن بأن الرواية هي العمل الوحيد الذي يتيح له أن يعبر عن كل ما يريد، من دون التزام بمنتج ومخرج، أي أن يتحمل المسؤولية بمفرده، يقطف النجاح أو يكابد الفشل.
قال إنه يكره الذهاب إلى دور العرض. لقد اختار أن يعيش في المكسيك. ولكي يذهب إلى السينما فإن عليه أن يدور بسيارته باحثا عن مكان للوقوف في عاصمة مزدحمة تعدادها 14 مليون نسمة (آنذاك). فإذا وجد موقفا فإن عليه أن يقف في طابور طويل لشراء التذكرة، تحت المطر غالبا، فإذا حصل على التذكرة فإنه سيجلس لمشاهدة الفيلم وراء عاشقين يتعانقان. واستدرك: «لست ضد العناق لكنهما يحجبان فسحة الرؤية أمامي فلا أستطيع متابعة الفيلم».
دهش حين أخبرته أن ترجمات رواياته تلقى رواجا بين الأدباء العرب الشباب وأن اسمه صار «موضة» المثقفين. وأبدى فرحته لأنه لم يكن يعرف شيئا عن تلك الترجمات، لكنه تساءل عن مستواها. قال إنه يحب البلاد العربية ويسعده أن تصل كتبه إلى القراء عندنا، لكن الترجمات غير القانونية تسلبه حقه كمؤلف، وهي حقوق اعتاد أن يتنازل عنها حين تصدر طبعات في بلدان فقيرة. غير أن الناشر ليس هو من يدفع حقوق المؤلف بل القارئ.
الإصغاء إليه ممتع مثل مطالعة رواياته. يأكل بنهم ويشفط القهوة ويتدفق في الكلام مثل حكواتي محترف. لا يا سيدتي، إن المقصود في «خريف البطريرك» ليس الجنرال الإسباني فرانكو بل هي صورة لكل ديكتاتوريات أميركا اللاتينية في القرون الماضية. يومها كان الحاكم المتسلط جزءا من تاريخ البلد وثقافته، له جانبه الوطني بشكل ما ويحافظ على هويته المحلية. في حين أن فرانكو كان «ديكتاتورا شاحبا، فقير الألوان، من دون صبغة فولكلورية». بعد ذلك صارت الديكتاتوريات في جنوب القارة مرتبطة بالولايات المتحدة وتتلقى الدعم منها. «كان هناك ديكتاتور معروف في فنزويلا يدعى خوان دي سانتا غوميز، بقي في السلطة 36 سنة، وكافح الإمبريالية بحيث أنه أعلن الحرب على ألمانيا. وقد جاء الأسطول الألماني واحتل ميناء كراكاس».
كيف خرج الصحافي الكولومبي من قوقعته المحلية وصار أديبا عالميا؟ رد باختصار: «بالقوة والجمال». وكلما توغل الكاتب في واقع بلده وكتب عن قريته أو مدينته تفتحت أمامه آفاق العالمية. «لقد نظرت إلى ناسي ولم أنظر إلى الآخرين». مع هذا، اشتكى من صفة العالمية ومن الشهرة التي تسلبه الراحة بحيث أنه يتمنى «لو أكتب رواياتي لتنشر بعد موتي فأتخلص من مشكلاتها».
الشرق الأوسط
خريف البطريرك العربي.. وداعية مؤجلة/ خالد الإختيار
خرج من منزله تلك الليلة محاولاً بالمشي شفاء نزلة الصدر الوجودية التي انتابته فجأة. أخرج هاتفه من جيب بنطال الجينز، وقبل أن ينبس صديقه على الطرف الآخر بحرف؛ بادره بالصراخ:
“ابن الـ…، لقد قاربت على الانتهاء من قراءة الجزء الأول، وأخو الـ… ما زال في الخامسة والعشرين فقط!”
لم يكن ذلك الشتّام اللعّان سوى أنا، ولم يكن ذلك الشاب ابن الخامسة والعشرين الذي زلزلني وأثار حنقي سوى غابرييل غارسيا ماركيز، ولم يكن الجزء الأول الذي تحدثت عنه لصديقي سوى الدفعة الأولى من مذكرات هذا الكاتب التي التهمتها بلقمة واحدة بعد صدور طبعتها الأولى في دمشق بعنوان “عشت لأروي”.
أن تجاوز الـ250 صفحة وأنت تقرأ عن الحياة (العادية) لشخص ما في منتصف العشرينات من عمره دون أن تجد متسعاً لوساوس إلقاء كتاب هذا المراهق المزمن جانباً؛ أمر لا يحدث كلّ يوم. ثمّ أن تقارن تلك الصفحات التي تطفر بأنفاس وعرق صاحبها بحياتك السائلة أمامك في رمادي الشام حينها؛ أدعى لأن تصاب بنوبة جنون رقيقة.
ستجري مياه كثيرة تحت الجسر إيّاه بعد ذلك، وستأخذ حلقات رواياته لبّك الطري، ثم ستنقلب عليه لتتمكن من قراءة كتّاب آخرين سواه، من دون أن تظلّ نظارته على عينيك تقيس بها كلماتهم وسطورهم بالسنتيمتر الماركيزي.
“الواقعية السحرية” لم تكن حلاً من “غابو” لتقديم تفسير علمي للخوارق المجتمعية التي تربينا عليها، كما يتربى غيرنا على القانون والمنطق؛ بل جاءت كتوصيف حال فج يقول إنّ القاعدة (عندنا كما في أميركا اللاتينية) كانت للشاذ والطارئ اللذين يستطيلان في حيواتنا فلا يعود هناك بد من بناء عش مؤقت فوق الأغصان المتكسرة تلك ريثما تنبت أجنحة للشجرة بكاملها، لا لسكانها من العصافير الصغيرة فقط.
الطاغية الذي درّب جنوده ليعملوا مجاناً و”يثبتوا بأنهم قادرون على تمزيق أمهاتهم إرباً إرباً وإلقاء المزق إلى الخنازير دون أن يتحرك لهم ساكن”؛ يرقد اليوم بثقب هادئ في رأسه، أسفل خندق محكم، ومبخّر بمواد تزرد اللحم الميت بشهوة كيميائية، بين “مصراتة” وساحل المتوسط.
الأب القائد الذي حزّ بنياشين انتصاراته الملحمية ستة رؤوس وكوّن لنفسه ستين عدواً، ومقابل الستين رأساً التالية صاروا ستمائة، “ثم ستة آلاف، ثم ستة ملايين، ثم كل البلاد”؛ افتقد الشامبو الأثير لديه في حفرته الدودية، قبل أن يخرج ليعتمر قلنسوته السوداء حتى عنقه، ويُربطَ له فوقها “كرافات” من أسلاك خشنة ستكون رسمياً آخر ما سيرتديه في حياته، وبدون سيجار أو بندقية صيد.
المستبد الشيخ الذي كان من الصعب التسليم بأنه لا يمكن إصلاحه “هو بقية إنسان، كانت سلطته من القوة بحيث سأل ذات يوم [كم الساعة الآن؟] فأجابوه: [الساعة التي تريدها سيدي الجنرال]”؛ يتمشى اليوم بكرسي الحكم الذي أضاف إلى ديكوره عجلات مدولبة تعين جسده الشبحي على ولوج القلم الانتخابي ليقترع لنفسه عن ولاية أبدية جديدة، ويقول بعد اضمحلال حنجرته إيماءً: “عاش أنا”.
الجنرال الذي أمر بتعليق الناس مقيدي الأرجل والأيدي ورؤوسهم إلى أسفل مدة ساعات وساعات، ثمّ “اختار واحداً من المجموعة الرئيسة، وأمر بسلخه حياً على مرأى الجميع. والجميع رأوا الجلد اللين الأصفر مثل غشاء جنين ولد حديثاً، وأحسوا بأنهم تبللوا بذلك السائل الدموي الغالي من لحم مسلوق يحتضر واثباً على بلاط الباحة”؛ توقف دماغه الفذ عن ابتكار مزيد من ضروب السحل والتمثيل بالأحياء، ودخل غيبوبة لمدة ثماني سنوات، رأى فيها أحلام جميع من قتلهم في حرب الأيام الستة، والسبعة، والسبعين عاماً.
والدكتاتور الوديع بعينيه السماويتين وضحكته الهوائية سيصدر عفوأً عامّاً بعد أن لم يبق مكان في سجنه لفرد، “منزعجاً من حشد من البُرص والعميان والمشلولين المتوسلين، ومن سياسيين متعلمين ومتملقين بلا حياء كانوا ينادون به قائداً أعلى للزلازل الأرضية، وللكسوف وللخسوف والسنوات الكبيسة، وأخطاء الرب الأخرى”؛ لن يتمكنّ من الاعتناء شخصياً بتجهيز “برميله” الأخير الذي كان سيدحرجه فوق مدينة ما في مزرعته التي ورثها عن أبيه “الخالد”، إذ أنّ العقبان ستنقض على شرفات قصره الرئاسي خلال نهاية الأسبوع، “ومع بزوغ شمس يوم الاثنين ستيتقظ المدينة من سبات قرون عديدة على نسمة رقيقة ودافئة. نسمة ميت عظيم، ورِفْعَةٍ متعفنة”.
كان بانتظار غابيتو، أن يكتب 6 روايات مفصّلة أخرى عن معتوهي تونس وليبيا ومصر واليمن والبحرين وسوريا والجزائر و..و.. لو أنّ جهازه اللمفاوي سمح له بهذا. لكنّه منحنا مع ذلك رؤوس الأقلام التي لا بدّ أن نخطّ بها يوماً سير هؤلاء، وعلى زاوية منضدتنا 500 ورقة بيضاء، وزنبقة صفراء في عروة القميص.
“الواقعية السحرية” هو التعريف “السوسيولوجي” الرصين لنمط الحياة التي صنعتنا بأيد عابثة (لكن صلدة) كفخار معدّ لشهوة التحطيم.
وهل أقلّ سحراً وعبثية من أن تبرمج نفسك لسنوات خلتها ستكون طويلة، كي تذهب في معرض الكتاب السنوي بدمشق إلى إحدى دور النشر، وتحاول تكراراً إقناع القائمين عليها بأنّ ماركيز يحبذ عنوان “خريف البطريرك” لروايته، وليس “خريف البطريق” كما يظهر العنوان على نسخة الدار من الكتاب؟
أصدقاء قالوا لي إنّ الرجل الكولومبي المرح كان مريضاً. وكأنّ الموت طبيعي في المرض، أو بعده. أين ماركيز ليقص عليهم حكاية من حكاياته يخبرهم فيها كيف أزاحت إحدى شخصياته القادمة حجر المدفن الثقيل وخرجت من القبر المائل بكامل زينتها، وأوقفت “تاكسي” عابراً لتلحق بالمشيعين وتواسيهم عن قطعهم روتين أشغالهم من أجل جنازة ليس اليوم هو الوقت الأمثل للسير في ركابها.
العربي الجديد
شاهدٌ على صبرا وشاتيلا/ غابرييل غارسيا ماركيز
منْح جائزة نوبل للسلام لمناحم بيغن هو أمر لا يصدّق. المهم أن بيغن هو فعلاً صاحب هذه الجائزة ولا سبيل الآن لتبديل ما حدث؛ فهو صاحب الجائزة منذ منْحِه إياها عام 1978 مع الرئيس المصري آنذاك أنور السادات عند توقيعهما، على انفراد، اتفاقية السلام في كامب ديفيد.
لم يحظ الاثنان بنفس المصير: فمصير السادات كان التبرّؤ الفوري منه في العالم العربي، ولاحقاً قتله؛ أما بالنسبة إلى بيغن، فالاتفاقية خوّلته المباشرة بمشروع استراتيجي لم ينته بعد، والذي أُشبِع قبل أيام قليلة بمجزرة وحشيّة لأكثر من ألف لاجئ فلسطيني في أحد مخيّمات بيروت. لا توجد جائزة نوبل للموت، لكنّها إذا وُجدت فقد تُمنح هذا العام، وبدون منافسة، لمناحيم بيغن وسفّاحه المحترف أرييل شارون.
اليوم، وبعد تكشّف الأحداث، نستطيع فهم غاية بيغن الوحيدة والمتستّرة خلف ستار كامب ديفيد: القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وبناء مستعمرات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية. بالنسبة إلينا ـ نحن الذين بوسعنا تذكّر ممارسات النازيّة ـ مشروع بيغن يعتمد على ركيزتين تثيران لدينا ذكريات فظيعة: نظريّة “المجال الحيوي”، التي أراد بها النظام النازي أن يبسط إمبراطوريته على امتداد نصف العالم؛ أما الركيزة الثانية فهي ما سمّاه هتلر بـ”الحل النهائي” لمشكلة اليهود، والتي حملت بأكثر من ستة ملايين من البشر إلى معسكرات الإبادة.
مشروع اتّساع رقعة المجال الحيوي لدولة إسرائيل ومشروع الحل الأخير للقضية الفلسطينية ـ كما يفهمهما الحائز جائزة نوبل للسلام عام 1978 ـ بدءا في ليلة 5 حزيران/ يونيو الأخيرة؛ ففي تلك الليلة، اجتاحت لبنان قوات عسكرية مختصّة في علم الدمار والإبادة.
إستراتيجية بيغن واضحة أشدّ الوضوح: يريد القضاء على منظمة التحرير الفلسطيني، وبهذا يقضي على الشريك الفلسطيني الوحيد الذي بإمكانه التفاوض على إقامة دولة فلسطينية مستقلّة في الضفة الغربية وقطاع غزّة؛ أراضي سبق لبيغن أن أعلنها أراضي يهودية.
كنت في باريس يوم اجتاحت الجيوش الإسرائيلية لبنان. كنت هناك أيضا عندما قام الجنرال جاروزلسكي، قبل عام، بفرض القوة العسكرية ضد إرادة أغلبية الشعب البولندي. وصدفة وجدت نفسي أيضا هناك عندما اجتاحت الجيوش الأرجنتينية جزر المالفيناس (“الفوكلاند”).
تصرّف وسائل الإعلام، والمثقّفين وكذلك الرأي العام، خلال هذه الأحداث، أظهر لي معادلة مقلقة: بينما نُظّمت في باريس أمسية تضامن مع بطولة الشعب البولندي (وكنت أنا من الموقعين على بطاقة الدعوة)، كان هناك شبه إجماع على الصمت عندما قامت الجيوش الإسرائيلية الدموية باجتياح لبنان (وكان الصمت حتى بين الأكثر متحمّسين لقضيّة بولندا، رغم أنه من المستحيل مقارنة عدد الضحايا وحجم الدمار بين بولندا ولبنان).
أكثر من ذلك، عندما استردّت الأرجنتين جزر المالفيناس من بريطانيا، لم تنتظر الأمم المتحدة يومين للطلب من القوات الأرجنتينية الانسحاب. وكذلك لم تفكّر السوق الأوروبية مرتين قبل فرض عقوبات اقتصادية على الأرجنتين.
بالمقابل، في حالة لبنان، لا الأمم المتّحدة ولا السوق الأوروبية طالبتا بانسحاب الجيوش الإسرائيلية. وشكّل حذر الاتحاد السوفييتي غير المفهوم وانعدام الأخوّة بين الدول العربية شرطَين كافيين للحرب الوحشيّة التي شنّها بيغن والجنرال شارون. لدي العديد من الأصدقاء الذين أرادوا ويريدون إسماع العالم بأسره صرخة قوية ضد “كرنفال الدم” في لبنان، لكنّهم يهمسون لي خوفهم من توجيه تهمة معادة الساميّة لهم؛ هل يعي هؤلاء بأنّهم هكذا يسلّمون أرواحهم لابتزاز مرفوض؟
* من مقالة بعنوان “مناحم بيغن وأرييل شارون: لهما جائزة نوبل للموت”، نشرتها صحيفة “ال اكسبرسو” الاكوادورية في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1982 ـ ترجمها عن الإسبانية شادي روحانا.
السوريون: “الدكتور” في متاهته/ سفيان طارق
أي حدث يجري في العالم اليوم، مهما كان حجمه أو نوعه، يأتي به السوريون ليوظفوه في معركتهم اليومية ضد “متاهة الاستبداد”.
فما إن أعلن عن موت ماركيز، حتى امتلأت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عنه. فإلى جانب التحسر والحزن، حضرت مأساة السوريين اليومية، وكيف لا، وهو الذي حمل هموم الفقراء والشعوب المستضعفة بوجه الأقوياء/ الطغاة. وكأن السوريين يستمدون من قيمه وعناوين كتبه ما يعينهم على مواجهة دكتاتورية أعادتهم إلى القرون الوسطى، ليكون ماركيز مفيداً لهم حتى بعد موته. أليست هذه مهمة الكتابة؟ أن تبقى قادرة على فضح الظلم والدكتاتورية حتى بعد رحيل كاتبها؟
عناوين كتب ماركيز تحولت إلى أداة مقاومة عند السوريين، وكأنهم أرادوا توديع الرجل بما يليق به، عبر القبض على جوهر مشروعه الكتابي الذي يقف مع الإنسان ضد الدكتاتوريات وميليشيات القتل التي خبرها في بلاده (كولومبيا)، فأضحت عبارات من نوع “الجنرال في متاهته” أو “ليس للكولونيل من يكاتبه” مترافقة مع صور بشار الأسد. وعبارة “الحب في زمن الكوليرا” قيام بعضهم بتحويرها لتصبح “الحب في زمن الموت/ البراميل/ القصف/..” مرفقة بصورة للرئيس الأسد وعقيلته.
روايته “مئة عام من العزلة” كان لها نصيب خاص عند السوريين، نظراً إلى ملامسة العنوان لعزلتهم وتخلي العالم عنهم. فصاحب “مولانا”، الكاتب المسرحي الشاب “الفارس الذهبي”، قال: “وداعاً لكننا لا نزال في عزلتنا المئوية ونعيش الحب في زمن الكوليرا، لكننا نشاهد خريف البطريرك… وداعاً غابو..”. وكتب نائل الحريري ساخراً: “السوريون نزلوا مناحة لأجلك عمي ماركيز…. جماعة أتقل واحد فيهن مقضي يومين ونص من العزلة، على طاق الفيسبوك”.
في حين اختار الشاعر السوري المقيم في دمشق حازم العظمة أن يودعه من موقع آخر قائلاً: “رحل ماركيز .. الكاتب الذي انتزع لنا، نحن شعوب المستعمرات، مكاناً أجمل.. وإن في الخيال.. الخيال الإبداعي والواقعي في آن”.
وحتى سخرية السوريين وخلافاتهم ونقدهم المكثف لبعضهم بعضاً برز هنا. إذ سخر الناشر المعارض خلف علي الخلف بالقول: “مات ماركيز… صرت أكره يموت كاتب مشهور ليس لأنه يجب ألا يموت، بل من ورا مناحة الفيسبوك. يكتبون وكأن الأمر سبق صحفي وما حدا يعرف إلّا هو أو هي، لكن الحمدالله ها المرة ما في صور للسوريين معو”، في إشارة واضحة لشغف السوريين على مواقع التواصل بإثبات صداقتهم وعلاقتهم بكل مبدع يرحل!
وكأن ماركيز بقدر ما ساعد السوريين على فضح الدكتاتورية، كشف لهم بعض عيوبهم، حين لم يتمكنوا من إرفاق صور لهم معه!
هذا الرحيل أحجيتك الأخيرة/ يحيى امقاسم
قالوا إن الروائي الكولومبي «غابرييل غارسيا ماركيز» رحل أخيراً في ركب مجهول لم يتوقف يوماً عن نسج ثوبه بمجموع الأساطير واللاواقع، ورحل أخيراً كأنما هو في أحجية جديدة يقرأها من أعالي قرية «ماكوندو» باسم الموت هذه المرة، فيخرج الساحر آخر حكاياته عن هذه الأرض، عن تلك السماوات من البشر والكائنات، عن اللبس الجميل، عن الركض المستمر ولا يتوقف، لأنه هذه المرة لن يعود في أوج الحكاية ليقول لنا أين «ريمديوس» التي طارت كفراشة في أول «مئة عام من العزلة»، ولا كيف نقل ذلك الكولونيل من روايته تلك إلى عزلة أخرى لدرجة لا أحد يكاتبه، ولا كيف أمضى الفتى فلورنتينو 50 عاماً ينتظر العاشقة والأمل في عهدة «الكوليرا»؟
قالوا لن يعود الماركيز هذه المرة فذهابه مع الموت سمّاه ذات أعجوبة جديدة بـ«يحدث أصلاً»، وما علينا إلاّ أن ننفذ به إلى واقع غير مرئي، هكذا قدّر شكل مرور الجنازة قبل أن يسكنها الموت، وهكذا تدارك لنا احتمال رحيله الأبدي، فيما مشروع كامل وتام لا يمكن أن نظن فيه نقصاناً، أو أن الماركيز حمل معه الكتاب والسحر، واصطفى لنفسه بعض القصص التي لن نقرأها.
إن جميعه جمالاً وإنتاجاً يتحقق أمامنا، فهناك «ماكوندو» أخرى لم تكتشف بعد، وسنقرأها مرات كثيرة في ما لم يصلنا بعد، وهناك الجدّة «أورسولا» في بلاد بعيدة ما زالت تخفي ذهباً لزمن التحولات، والموسيقى لن تموت بعد «فيرسبي»، فهو لن يغادر القرية مثل الماركيز صانعها من ماء الحياة، وسيظل العقيد أورليانو سيد المرحلة وإن قيد إلى مقصلة البطولة، مثلما نقاد اليوم إلى وداع خاطف، فهذا العالم متماسك من مخيلته ومدخر لكل جسور التحرر، والعالم الآخر الذي يقتفي أثر أورليانو الثاني ويفتش في قريته الخالدة، ولا تنتظر تلك القرية أحداً، أما ملكياديس فلن ترهنه الأمكنة ولا النسيان، فهو الغجري الموزع في اللامكان واللازمان، ولن يتخلى عن صاحبه الموثوق في شجرة ومؤسس القرية الممسوسة بالذكريات والانتظار، وما كان للزمن من سطوة على تلك الرغبات المشدوهة، ولا على فلورنتينو وهو يحضن حبيبته بعد العمر الناضح بنضال القلب حتى آخر نبض.
إن هذه الشخوص هي الوقت وبناية الزمن، فكلما غرب مجموع أتى آخر ليوسع من جغرافيا البقاء وينهض بالغرائب وكائنات الخفاء التي تسوغ الحرب والحب، النماء والجوع، القرية البكر والمدينة المهترئة. كل هذا العالم المشغول باقتدار لا ينفرط بذهاب سرمدي يراه الماركيز ضمن قلعة عاش لأجل أن يرويها ويهيئها قبالة خوفنا من الفقد وإيماننا بهذه العوالم المعبوبة بالحيوات من دون صمت.
والآن لم يترك لنا الماركيز أن نسأله كيف لنا أن نعالج المبهم في ثروته الباسلة، ولا كيف سنكتب إلى شخوصه المولعة بالضوء، وليس لنا أن نشكو حسرة الظلام والتجربة، فهو الذي حصد الزمن زمنين والمكان عالمين، أميركا اللاتينية أوله، ثم العالم بأسره هو انتشاره حين تنقل بين كل لغات العيش وأنار شيئاً من تراجيديا البشرية وحمولاتها المتعددة منذ الأزل، وحتى تمام القمة الإبداعية أوروبياً وأميركياً وآسيوياً، لتنضج على يديه بدعة تولد من رحم الخرافة، ويؤسس ما عرفه النقاد منذ خمسينات القرن الماضي بـ«الواقعية السحرية» في الأدب العالمي وأميركا اللاتينية خصوصاً، ليكون رائداً بما قدمه من مقومات أساسية وملامح تامة في مضمار صار علامة فارقة في تاريخ الأدب العالمي.
صار الماركيز بأعماله التي فاق عددها 20 رواية ومجموعة قصصية، عنوانَ الطبيعة البديلة في اللون والرائحة والتكوين، تلك الطبيعة التي نعرفها في الحكايات، والمقدر لها أن تجتاز أزمنة بالغة الأحوال، فهي بيده أشد حدوثاً وأكثر حضوراً بالفصول مهما تعاقبت الأجيال وابتكرت ذائقتها، وستقول لنا دوماً إن رحيله لم يكن إلاّ كتابة ختامية احتاجت إلى بلوغها إليه أعواماً طويلة بعد روايته الأخيرة «ذاكرة غانياتي الحزينات»، وهذا الرحيل سيكون حكاية الـ.. ما وراء، والتي سنبدأ الآن قصتها.
ماركيز… رسّام الحكايات/ منال أبو عبس
كيف بدأت الكتابة؟
بالرسم بالرسم… هكذا أجاب غابريال غارسيا ماركيز على سؤال لمراسل “باريس ريفيو”. قبل أن أكون قادراً على القراءة والكتابة، كنت أرسم في البيت والمدرسة. المضحك، أنني في المرحلة الثانوية كان يُعرف عني أنني كاتب، مع أنني لم أكن كتبت شيئاً بعد.
الرسم… الرسم. هذا هو بالضبط ما فعله غابريال غارسيا ماركيز الصحافي والروائي. رسم أميركا اللاتينية، ورسم ذاكرتنا عنها. رسم ناساً بملامح طغت على ملامحهم الحقيقة، ثم رسم أمزجتهم ورسم في الهواء رائحة أوراق الكينا، وكانت عطرة. رسم رجلاً ذا شاربين كثيفين وبشرة داكنة، يجلس على كرسي من الخيزران لونه بلون جذع الشجر، على شرفة أرضها من الخشب نفسه وخلفه تقف امرأة شابة. كلاهما يرتدي ملابس من الكتّان الابيض مع صدرية وساعة ذهب. هو يضع غليوناُ في فمه من دون أن يشعله وهي تنظر إليه. ومن حولهما تفوح رائحة أشجار الموز وزهور الاوركيديا وقصب السكر.
رسم الكولونيل بطل أميركا اللاتينية المطلق، وتركه يتنقل بين قصة وأخرى مرة شاباً وثانية عجوزاً. مرة يؤسس قرية تتحقق فيها اللعنة- النبوءة وتقضي عليها رياح مشؤومة، ومرة ينتظر رسالة في البريد ولا تأتي. مرة تفوح منه رائحة المانغا وأخرى تتعفن فيها أمعاؤه في أكتوبر.
رسم فلورنتينو اريثا شاباً هزيلًا في “الحب في زمن الكوليرا”، ورسم فيرمينا داثا. ورسم ببغاء ومظلة ونهراً وسفينة وميتاً ورائحة اللوز المر. وجعلنا ننشغل بالرسم، تاركاً فلورنتينو ينتظر فيرمينا داثا إحدى وخمسين سنة وتسعة شهور وأربعة أيام. رسم القبطان ينظر إلى فلورينتينو اريثا “بتماسكه الذي لا يقهر وحبّه الراسخ، وأرعبه ارتيابه المتأخر بأن الحياة، أكثر من الموت، هي التي بلا حدود”، ويسأله: “إلى متى تظن أننا سنستطيع الذهاب والإياب الملعون؟ وكان الجواب جاهزاً لدى فلورينتينو اريثا منذ ثلاث وخمسين سنة وستة شهور وأحد عشر يوماً بلياليها. فقال: مدى الحياة”.
رسم الحَر الخانق، ورسم الكولونيل “الواثق بأن نباتات فطر وزنابق سامة تنمو في أحشائه”، وجعله على مدى ست وخمسين عاماً، منذ انتهت الحرب الاهلية الاخيرة، لا يفعل شيئاً سوى انتظار رسالة مستعجله. رسم ديكاً “لا يمكن أن يخسر” في حلبة مصارعة. ورسم نهاية غير مألوفة لرواية من مئة صفحة قال إنها أفضل رواياته بلا شك.
رسم نهاية سانتياغو نصّار على أيدي التوأمين فيكاريو في جريمة شرف في أول صفحة من القصة. ثم راح يرسم ويرسم لتخرج “قصة موت معلن”، لوحة من يوم واحد تكثف حياة كاملة في أميركا اللاتينية وريفها.
هكذا كان غابريال غارسيا ماركيز منذ المرة الأولى التي رسم فيها قبل أن يتعلم القراءة والكتابة. يرسم فنرى بلداً وطريقاً ووحلاً نقفز فوقه، وتمسنا الرائحة العطرة للبخور وأشجار الكينا، والوصفات السحرية للجدة. وستظل رسوماته في سماء الكوكب إلى الأبد، تماما كتلك العبّارة التي تروح وتغدي على وجه النهر، يحركها الحب، والحب وحده.
جنازة ماركيز: بورتريه بالأصفر/ غدير أبو سنينة
ماناغوا (نيكاراغوا)
من المؤكّد أنّ الزّهور الصّفراء ستملأ قاعة الفنون الجميلة في المكسيك، حيث سيقام حفل تكريم كاتب كولومبيا الرّاحل غابرييل غارسيّا ماركيز بحضور رئيسي البلدين. كما ستمتلئ بها الأمكنة التي سيُكرَّم بها في مسقط رأسه. لكن الأمر غير المؤكّد هو المكان الذي دُفن فيه رفات ماركيز، وما إذا كان هذا الرّفات قد تقاسمتاه العاصمتان (بوغوتا ومكسيكو). كما لم يُعرف ما إذا كان حرق الجثمان قد تمّ بناءً على وصيّة الكاتب، أم نزولاً عند رغبة العائلة التي أقامت طقوس الدَّفن بتكتُّمٍ وتحفُّظٍ شديدَن.
أشخاصٌ قليلون تمكّنوا من دخول منزله لتعزية زوجته (مرسيدس) التي بدت هادئة لكن حزينة. منهم الرَّئيس المكسيكي السابق، كارلوس ساليناس دي غورتاري، وهو واحدٌ من السيّاسيّين المقرّبين لغابو.
ومع أنّ لغابو علاقات مع بعض السّياسيّين لكنه لم يكن يُجامل إذا ما خالفت تصرّفاتهم قناعاته. نقل الرّوائي النيكاراغوي، سيرخيو راميرس، عن غابو قوله إنّه قطع علاقته بنيكارغوا التي زارها احتفالاً بالسّنة الأولى من الثّورة السّاندينيَّة (عام 1980). وكانت تلك المرّة الأولى التي يزور فيها هذا البلد الذي ذكره في روايته “مائة عام من العزلة”، وكتب عنه تقريراً أسماه “الهجوم على القصر” (عام 1978). صرّح ماركيز إنه شعر أنه خُدع، وأنهم باعوه “ثورة”، لكنّ الواقع شيء آخر.
لربُّما تكون مراسم دفن الكاتب هي استكمال لطبيعته الانطوائيَّة في حياته. حيث تروي عنه ماريا بيلار (زوجة الكاتب التشيلي خوسيه دونوسو) فتقول: “إن شخصية غابو كانت مزيجاً من الخجل والكبرياء، اللطف والفظاظة، المودّة والصّد”. كما أنّه كان بعيداً عن الاهتمام بالماديّات: “إنّ ملايين النُّسخ التي بيعت من كتبه سمحت له بالعيش دون إعطاء ندوات ولا محاضرات جامعية. لدرجة أنه أودع أموال جائزة نوبل في بنك سويسري لمدة ستة عشر عاماً، إذ كان قد نسي أمر النُّقود”.
وبالعودة إلى اللَّون الأصفر (لون ماركيز المُفضّل) تتذكر أخته مارغريتا الفراشات الصفراء التي كانت في حديقة جدّيْها من الأم في أراكاتاكا (مسقط رأس ماركيز)، وكيف كان اصطياد الفراشات الصّفراء لعبتَه المُفضّلة فيما الأطفال يلعبون الكرة.
كانت لديه قناعة تقول: “من لا يؤمن بإله، فليؤمن بالخرافات”. ولذا كان لدى غابو الكثير من الزهور الصفراء في بيته، إذ اعتقد أنها تجلب الحظ. وكان يقول: “لو وُجدت الزُّهور الصفراء فلن يقع لك مكروه. وكي أكون مطمئنّاً فلا بد أن يكون عندي زهورٌ صفراء [من الأفضل أن تكون وروداً] أو أن أكون محاطاً بالنِّساء. لا أعرف كيف أكتب إن لم يكن هناك زهرة صفراء على المكتب”.
ومع حبِّه للّون الأصفر؛ إلّا أنّه كان يكره الذهب. فبالنّسبة له “الذّهب يرتبط بالبراز”، ولهذا لم يكن يستخدمه. لا قلائد من ذهب، ولا خواتم، ولا أساور، ولا أشياء مصنوعة من الذَّهب في بيته.
ويبدو أنّ ولعه بالأصفر أثّر على علاقته بالأطعمة. فخلافاً لجميع من أحضر في جنازته من الأصدقاء الزهور الصّفراء؛ قرّر صديقه سانشيس أن يحضر معه موزاً برّيّا، وخبز الذّرّة المخبوز يدويّاً، والذي كان غابو يُفضّلهما على معظم الأطعمة.
أمّا اليوم الذي تلقّى فيه جائزة نوبل فقد صعد المنصّة بزيِّ الـ”ليكي ليكي”(اللباس الكولومبي التّقليدي)، وحينها فقط لاحظ الوردة الصّفراء التي كانت زوجته مرسيدس قد وضعتها في عروة سترته.
غابرييل غارثيا ماركيز : تنظيم النبوءات وتوارد الخواطر/ مصطفى الحمداوي
يبدأ غابرييل غارثيا ماركيز، في مقال بعنوان ‘التخاطر اللاسلكي’ في كتابه ‘كيف تُكتب الرواية ومقالات أخرى’ يبدأ المقال على النحو التالي: ‘في ليلة مضت، روى لي أخصائي أعصاب فرنسي، وباحث مثابر، انه اكتشف وظيفة من وظائف الدماغ البشري يبدو أنها ذات أهمية بالغة.
وكان يواجه مشكلة واحدة فقط: لم يستطع أن يحدد فائدتها. سألته بأمل يقيني، إذا كان هناك احتمال ما بأن تكون تلك الوظيفة هي من تنظيم النبوءات، والأحلام الإستشرافية وتوارد الخواطر. فكان رده الوحيد أن نظر إلي نظرة مشفقة.’ ويورد ماركيز الجملة الأخيرة من الفقرة التي أحس بها من خلال لغة الإيحاء التي استعملها الأخصائي الفرنسي في الأعصاب، إذ يعبر عن ذلك بخيبة أمل كبيرة بأن الأخصائي الفرنسي اكتفى فقط بأن نظر إليه نظرة مشفقة. وكأن ماركيز بتركيزه على الجملة الأخيرة من الفقرة يود أن يقول لنا بأن الأخصائي الفرنسي سخر من كون فكرة احتمال أن تكون هذه الوظيفة هي من تنظيم النبوءات والأحلام الإستشرافية وتوارد الخواطر، وهي فكرة ساذجة لم تكن تستوجب حتى ردا كلاميا نافيا كما هو مُتوقع.
لم يخبر ماركيز القارئ، في مقاله ‘التخاطر اللاسلكي’، حول هوية هذا الفرنسي الأخصائي في الأعصاب والباحث المثابر، ولم يذكر اسمه على الأقل ليكون لهذه القصة مصداقية لمن يحبون مصداقية القصص الواقعية، وان كنا، وككل الذين يتابعون أدب ماركيز المخلصين، لا تهمنا مثل هذه التفاصيل الصغيرة بقدر أهمية ما يرويه غارثيا من أحداث بارعة. وطبعا ليست هذه هي المرة الأولى أو الأخيرة التي يكتب فيها غابرييل غارثيا ماركيز حول حوادث يزعم بأن أبطالها هم أصدقاء له، أو من معارفه، ولا يذكر اسم هؤلاء الأشخاص. وكما لاحظنا أعلاه، فقد أنهى ماركيز الفقرة بجملة لها دلالة عميقة، بل وستفتح له الأفق واسعا ليواصل الحكي على نفس النسق، وفي نفس الإطار الذي يدخل ضمن تنظيم النبوءات والأحلام الإستشرافية وتوارد الخواطر. بحيث يستحضر مرة أخرى حادثة مماثلة تقريبا، وتتشابه إلى حد بعيد مع قصته التي أوردها حول الأخصائي الفرنسي، وطبعا لأن الأمر يتعلق هنا دائما بالموضوع الذي يبدو أنه استأثر باهتمام ماركيز الشديد، أي الموضوع الذي أسماه في مقاله ‘التخاطر اللاسلكي’. يواصل ماركيز الحديث، وهذه المرة تذكره قصة اكتشاف الأخصائي الفرنسي في الأعصاب لوظيفة من وظائف الدماغ البشري التي يبدو أنها ذات أهمية بالغة، بصديق عزيز، وبحادثة قديمة تعود إلى ما قبل ثمانية عشر عاما من كتابة ماركيز لذلك المقال ‘التخاطر اللاسلكي’. وهذا الصديق العزيز هو باحث في الدماغ البشري في جامعة ميكسيكو كما نعلم من خلال ما يخبرنا به غابرييل غارثيا ماركيز، ولكن ماركيز مرة أخرى لا يذكر لنا اسم هذا الباحث. ويقول لنا في نفس المقال وحول نفس الشخص، ودائما الأمر يتعلق بالتخاطر اللاسلكي:
‘كنت أمازحه، بمداعبات تخاطرية، فيفندها على أنها محض مصادفات، رغم أن بعضها كان يبدو شديد الوضوح. ‘ففي إحدى الليالي اتصلت به هاتفيا كي يأتي لتناول الطعام في بيتنا. وبعد المكالمة فقط انتبهت إلى أنه لا يوجد في المطبخ ما يكفي من الأشياء. فعاودت الاتصال به لأطلب منه أن يحضر لي معه زجاجة نبيذ من ماركة لم تكن من الأنواع المتداولة، وقطعة سجق. وصاحت ميرثيدث ـ زوجة ماركيز ـ من المطبخ طالبة أن أقول له أن يحضر كذلك صابونا لجلي الأطباق. لكنه كان قد خرج من بيته. وفي اللحظة التي أعدت فيها وضع سماعة الهاتف، راودني إحساس صاف بأن صديقي، وبأعجوبة يصعب تفسيرها، قد تلقى الرسالة. فكتبت ذلك على ورقة كي لا يشك في روايتي. ولمجرد اللمسة الشاعرية فقط، أضفت انه سيحمل وردة أيضا. بعد ذلك بقليل وصل وزوجته، ومعهما الأشياء التي طلبناها، بما في ذلك صابون من النوع ذاته الذي نستخدمه في بيتنا. قالا لنا وكأنهما يعتذران: (شاءت المصادفة أن يكون السوبر ماركت مفتوحا، فرأينا أن نحضر لكم هذه الأشياء)، لم يكن ينقص سوى الوردة. وفي ذلك اليوم بدأنا، صديقي وأنا، حوارا مختلفا لم ينته حتى الآن’.
دعونا نكون أوفياء للحقائق، على الأقل لوقت قصير جدا لنتأمل كلام غابرييل غارثيا ماركيز، والتخاطر العجيب الذي حصل بينه وصديقه العزيز، ووصول الرسالة التي كان يود ماركيز إيصالها إلى دماغ صاحبه لاسلكيا، الرسالة التي وصلت فعلا وبإحساس صاف كان قد راود ماركيز في لحظة تجل غامضة، وبأعجوبة يصعب تصديقها كما يقول. بل أكثر من ذلك فان ماركيز، ولكي لا يدع مجالا لشك صديقه، فقد كتب على ورقة كل تلك الأغراض التي كان يريد أن يوصي بها صديقه. طبعا حصل ما توقعه ماركيز ـ كما يخبرنا ـ ، وجاء صديقه رفقة زوجته وهما محملان بكل تلك الأشياء، بما في ذلك الصابون الخاص الذي يُستخدم في بيت ماركيز، وكذلك زجاجة نبيذ من ماركة لم تكن من الأنواع المتداولة، وقطعة السجق. ولم يكن ينقص سوى تلك الوردة، الوردة التي قال عنها ماركيز بإشارة فيها الكثير من الإيحاء، بأنه دونها على الورق فقط من أجل السبب التالي ‘ولمجرد اللمسة الشاعرية فقط، أضفت انه سيحمل معه وردة أيضا’. انه توارد خواطر مدهش حسبما يبدو، بل وحتى الوردة التي أضافها ماركيز لم تكن إلا لمجرد اللمسة الشاعرية فقط، ولم تكن ضمن التوارد عبر الخواطر الذي تولد في ذهن ماركيز، وبأعجوبة يستحيل تصديقها، كما يصف. وبالتالي فالوردة مبعدة من الحادثة، لأنها كتبت على الورقة لأجل إضفاء لمسة شاعرية لا أكثر، وبمعنى آخر فقد تحقق التوارد في الخواطر بين ماركيز وصديقه على نحو كامل. وهنا علينا أن نقرأ هذه الحادثة بين ماركيز وصديقه على وجهين: أولا ماركيز سيكون ولا شك قد لاحظ في حياته اليومية، وما مر به وفي محيطه من أحداث، كغيره من الناس، أن هذا النوع من المصادفات، الغريبة جدا، يقع فعلا، ولو نادرا، وأنه غالبا يحدث على نحو يبعث على العجب. وثانيا، وهذا هو الأهم، فان ماركيز ككاتب كبير لديه قدرة باهرة على التقاط الجزئيات الحاسمة التي تضفي على الكتابة لذة ونكهة خاصة لا يقدر على صناعتها إلا روائي بحجم غابرييل غارثيا ماركيز، لم يكن ليهمل هذه الخاصية الفريدة في إبداعه، وسيلاحظ القارئ ولا شك الزخم الكبير الذي تزخر به كتابات ماركيز حول التنبؤات وقارئات الطالع وعلم التكهن. وهو هنا إذ يتحدث عن هذا التوارد العجيب في الخواطر الذي يقنعنا أنه يؤمن به، فإنما يفعل ذلك لكي يكتب مادة فريدة ومثيرة لاهتمام القراء. وهو في النهاية ينجح كما العادة لأنه يمتلك أدوات سرد مثيرة للإعجاب تجعل القارئ يتجاوز سؤال هل هذه الخوارق المتمثلة في التخاطر اللاسلكي يمكن أن تحدث. ورغم أن ماركيز يعطينا الانطباع بأنه يؤمن بهذه الحالات العجيبة، غير أن ذلك لا يحدث، في تقديرنا، إلا على المستوى الأدبي، ولأنه من جهة أخرى يجد فيه مادة ثرية ومدهشة للكتابة ليس إلا.
بل أكثر من ذلك يأتي بقصص أكثر غرابة، فيها الكثير من الإبداع وتفجير القدرة الاستيعابية للخيال الخصب على نحو عجيب. ويضيف في نفس المقال، ويروي بأنه ‘يعرف توأمين متشابهين تماما أحسا بألم في الضرس ذاته وفي الوقت ذاته وهما في مدينتين متباعدتين، وحين يكونان معا يراودهما إحساس بأن أفكار أحدهما تتداخل بأفكار الآخر’.
هل حقا إلى هذا الحد يمكن أن تحدث مثل هذه الظواهر؟ الجواب طبعا لدى ماركيز، فهو لم يعلق على هذا الأمر، فقط أشار، للتأكيد، بأنه يعرف التوأمين اللذين يتشابهان تماما. وهذه الإشارة ليست صدفة، بل وضعها ليجعل القارئ يشعر بأن ما يقرأه حقيقة وليس مجرد خيال، وماركيز يعرف بأن الكثير من القراء تستهويهم رواية الأحداث الواقعية، وأحداث العجائب والغرائب. ولهذا نجده يعزف عزفا بديعا على هذا الوتر. وإذا تأملنا قليلا أدب ماركيز، سنجد أن منبع الواقعية السحرية ينبثق من هذا المبدأ..ربما..مع أننا لسنا الآن بصدد الحديث عن ذلك.
ويواصل غابرييل غارثيا ماركيز ببراعة حكيه الأنيق رواية قصة غريبة إلى أقصى حدود الغرابة، فقد زعم أنه ‘تعرف في إحدى بقاع ساحل الكارايبي على مداو يفاخر بأنه قادر على معالجة بهيمة عن بعد إذا ما بينوا له أوصافها ومكان وجودها بدقة. وقد تأكدت بعيني هاتين، يقول: ‘رأيت بقرة متعفنة، والديدان تتساقط منها حية من قروحها، فيما المداوي يتلو دعاء سريا على بعد فراسخ منها’. مع ذلك لم يخبرنا ماركيز في المقال، ورغم معاينته، كما يزعم، للبقرة المتعفنة ما إذا كان ذلك المداوي قد أفلح في شفائها. ولكنه يتحدث بعد ذلك بطريقة تعطي الانطباع بأن الرجل يتحدث بصدق، إذ يقول: ‘لكنني لا أذكر رغم ذلك سوى تجربة واحدة حُملت فيها هذه القدرات على محمل الجد في التاريخ المعاصر، وقد قامت بتلك التجربة قوات الولايات المتحدة البحرية التي لم تكن لديها وسائط للاتصال مع الغواصات الذرية المبحرة تحت طبقة الجليد القطبية، فقررت محاولة الاتصال عن طريق التخاطر. حاول شخصان، أحدهما في واشنطن والآخر في الغواصة، التوصل إلى انسجام بينهما وإقامة نظام لتبادل الرسائل الذهنية. وكانت التجربة فاشلة بالطبع، لأن التخاطر أمر عفوي لا يمكن ضبطه، ولا يقبل أي نوع من المنهجية. وتلك هي وسيلته الدفاعية. فكل ما هو تكهن، ابتداء من النبوءات الصباحية وحتى’دهور’ نوستراداموس، يأتي مشفرا منذ إدراكه، ولا سبيل إلى فهمه إلا حين يكتمل. ولو لم يكن كذلك لهزم نفسه بنفسه مقدما’.
في هذه الفقرة التي يحدثنا فيها ماركيز عن التجربة التي قامت بها قوات الولايات المتحدة البحرية الأمريكية، ثم تفسيره لسبب فشلها، نكتشف أن غابرييل غارثيا ماركيز يحاول أن يقنعنا مرة أخرى بأنه يؤمن بهذا النوع من التخاطر إذا توفرت له بعض الشروط. بل يمكنني الذهاب بعيدا لأقول بأن ماركيز يجد نفسه على يقين بأن العلم مستقبلا سيصل إلى هذا الإنجاز، وبالتالي فهو في كتابته هنا يبشر بذلك العصر، ولا يستبعد أن يحدث ذلك على المدى المتوسط..ربما.
وينهي غابرييل غارثيا حديثه الممتع حول التخاطر اللاسلكي، كما يروق له أن يسميه، ويعود إلى جدته، والى قرية اراكاتاكا، والى عوالم غريبة وليست بعيدة جدا عن النمط الذي غلب على جل كتاباته الروائية. بل الأكثر من ذلك أن هذا الكلام يذكرنا تحديدا برواية ‘مئة عام من العزلة’، بحيث ترد هذه الخواطر عن جدته كشكل من السرد الروائي الكثيف في الأحداث والعوالم الغرائبية التي يضعها ماركيز أمام القارئ، لتعلن عن بروز النكهة المميزة لرواية ‘مئة عام من العزلة’. تلك الرواية الفاتنة، التي كلما قرأناها، لا ننتهي من أجوائها وعيش طقوسها في المُتخيل إلا لكي تراودنا الرغبة للعودة من جديد لقراءتها. يقول ماركيز:
‘إنني أتكلم في الأمر بكل خصوصية لأن جدتي لأمي كانت العلامة الأكثر جلاء على الإطلاق بين جميع من عرفتهم في علم التكهن. كانت كاثوليكية من الجيل الذي مضى، لكنها كانت أستاذة في تكهناتها. إنني أذكرها وهي في مطبخ بيتنا الكبير في اراكاتاكا، تترصد العلامات السرية في أرغفة الخبز الشذية التي تخرجها من الفرن.
في أحد الأيام رأت الرقم ( 09 ) مكتوبا في بقايا الدقيق، فقلبت السماء والأرض إلى أن وجدت بطاقة يانصيب تحمل هذا الرقم. خسرت. إلا أنها ربحت في الأسبوع التالي غلاية قهوة تعمل بالضغط، ببطاقة كان جدي قد اشتراها في الأسبوع السابق ونسيها في جيب سترته، وكان رقمها هو ( 09 ) كان لجدي سبعة عشر ابنا ممن كانوا يطلقون عليهم في ذلك الحين تسمية ـ الأبناء الطبيعيين ـ وكأن أبناء الزواج النظامي هم أبناء اصطناعيون، وكانت جدتي تعتبرهم أولادها. كانوا متفرقين على طول المنطقة الساحلية، لكنها كانت تتحدث عنهم جميعا في ساعة تناول الفطور، وتشير إلى صحة كل واحد منهم والى وضع تجارته وأعماله وكأن لديها اتصالات مباشرة وسريعة معهم. كان ذلك الزمن الرهيب هو زمن البرقيات التي تصل في وقت لا تخطر فيه على بال أحد وتدخل البيت مثل ريح رعب، تنتقل من يد إلى يد دون أن يجرؤ أحد على فتحها، حتى ترد إلى ذهن أحدهم الفكرة الملهمة بجعل طفل صغير يفتحها، وكأن للبراءة القدرة على تغيير لعنة الأخبار المشؤومة.
لقد حدث ذلك في بيتنا ذات يوم، وقرر البالغون المبهورون أن يتركوا البرقية مثل جمرة متقدة، دون فتحها، إلى أن يعود جدي. أما جدتي فلم تتأثر، وقالت: إنها من برودينثيا اغواران تخبرنا فيها بقدومها. لقد حلمت الليلة أنها آتية في الطريق إلينا.
عندما رجع جدي إلى البيت لم يكن بحاجة حتى لفتح البرقية، فقد جاءت معه برودينثيا اغواران التي وجدها مصادفة في محطة القطار، وكانت مقتنعة تماما من أن جدي قد ذهب إلى المحطة استجابة لسحر برقيتها الأكيد’.
هكذا يروي ماركيز حوادث حول جدته، ويوحي بثقة أنها حصلت في الواقع بالفعل، ونحن لا نملك أن نقيم مصداقية هذا الكلام، لأنه في البداية وفي النهاية، كلام يدخل في إطار الأدب. وهل ينبغي، أن نتساءل حتى، ما إذا كانت القصة واقعية أم هي مجرد نتاج خيال مبدع الهدف الأساسي الذي يحرك فيه هوس الحكي هو الإمتاع أولا وأخيرا. ونحن نستمتع بمثل هكذا نص مدهش، لا يعنينا من حقيقته إلا السرد الأنيق، والحدث الاستثنائي الذي نجده بين أيدينا، ونقرأه بشغف كبير. هذه هي قوة ماركيز والاستثناء الكبير الذي يتميز به. انه يمارس الأدب تماما كما يمارس الحياة، بكل تفاصيل الحياة الصغيرة والكبيرة.
في النهاية، نهاية مقال ‘التخاطر اللاسلكي’ من كتابه ‘كيف تكتب الرواية ومقالات أخرى’ يجرنا غابرييل غارثيا ماركيز نحو نفس الطقوس الغرائبية التي تنتمي لعوالم روايته الساحرة ‘مئة عام من العزلة’، ويروي بنفس النسق الذي يروي به رواية ‘مئة عام من العزلة’ ويتحرك في نفس العوالم العجيبة لنفس الرواية العبقة بنفس مدرسة الواقعية السحرية، هذه المدرسة التي طورها غابرييل غارثيا ماركيز ليتجاوز في كتاباته ونتاجاته فيها، ما أنتجه رواد هذه المدرسة. ولذلك نرى ماركيز في غير ما مرة يصر على تسمية هذه المدرسة بمدرسة الواقعية المأساوية، وهو إذ يسحب هذا المصطلح الجديد على نمط كتابته، فإنما لينسب هذا التطور الكبير، أو التحول الذي أحدثه في هذا النوع من الكتابة إلى نفسه، كما نحسب. وليقول ضمنيا، ربما: لقد تجاوزت مدرسة الواقعية السحرية، وان ما أكتبه ليس سوى نمط جديد من الكتابة ينزع إلى مدرسة جديدة، مدرسة الواقعية المأساوية.
وهكذا، وبنفس إيقاع وطقوس ‘مئة عام من العزلة’ يختم غابرييل غارثيا مقاله ‘التخاطر اللاسلكي’ بفقرة جد مثيرة في عمقها وواقعيتها السحرية، أو..واقعيتها المأساوية كما يفضل ماركيز:
‘ماتت الجدة عن نحو مئة سنة.. أصيبت بالعمى وصارت تهذي في أيامها الأخيرة حتى أصبح من المستحيل متابعة خيط عقلها. وكانت ترفض خلع ملابسها لتنام ما دام المذياع مفتوحا، رغم أننا كنا نوضح لها كل ليلة أن المذيع غير موجود في الغرفة. كانت تظن أننا نخدعها، لأنها لم تستطع أن تصدق أبدا أنه يمكن لآلة شيطانية أن تسمعنا صوت أحد يتكلم من مدينة أخرى نائية’.
أعتقد أن ماركيز، في هذه الفقرة الأخيرة، استطاع ببراعة أن يربط بين التخاطر اللاسلكي كحالة مرتبطة بالعقل، وبوظيفة غير مكتشفة بعدُ في الدماغ، وبين المذياع كحالة وآلة ‘شيطانية بحسب اعتقاد جدته’ آلة لاسلكية لتوصيل الصوت والخبر. وبين هذا وذاك، يكون ماركيز غير بعيد أيضا لا عن هذا ولا عن ذاك. هكذا عودنا ماركيز في كتاباته، فهو على كل حال يعتبر بأن حرفته هي (ساحر)، كما كتب في كتابه ‘مصائب مؤلف كِتاب’، بحيث يعدد في ذلك الكتاب البلايا التي يتكبدها الكاتب، وكيف أن الكتابة في آخر الأمر بالنسبة للكاتب هي قدر، تماما كما يمكن أن يولد أي شخص وهو أسود البشرة..وسيظل الكاتب الجيد يكتب باستمرار، حتى إذا كان حذاؤه بحاجة إلى إصلاح، وحتى إذا كانت كتبه لا تلقى رواجا’. هكذا يرى غابرييل غارثيا ماركيز الاخلاص الحقيقي للكاتب لصنعته.
ماركيز… ذلك المحظوظ الحاسد/صبحي حديدي
رحيل غابرييل غارثيا ماركيز (1927ـ2014) يعيدني، شخصياً، إلى ملفّين اثنين يخصّان أدبه الرفيع؛ يأخذ أولهما منحىً تقنياً صرفاً، يخصّ الترجمة إلى اللغات الأخرى؛ ويقترن الثاني بصفة الحسد التي ـ على نقيض ما يظنّ الكثيرون، غالباً ـ تتحكم بسلوك كبار المبدعين على مرّ العصور، وتلعب دوراً بنّاءً في تحفيز الفنون، وترقية حسّ التنافس والتجاوز والتفوّق. صحيح أنّ الروائي الكولومبي الكبير كان القاسم المشترك بين الملفّين، كلّ منهما بمقدار متفاوت، إلا أنّ الفوارق بين المنحى الأوّل والصفة الثانية كانت أقرب إلى صناعة التكامل الجدلي، بدل التناقض التناحري.
ففي مثال أوّل على الملفّ التقني، صدرت كما هو معروف ثلاث ترجمات، إلى العربية، لمذكّرات ماركيز: الأولى بعنوان ‘عشتُ لأروي’ من صالح علماني، والثانية ‘نعيشها لنرويها’ من رفعت عطفة، والثالثة ‘أن تعيش لتحكي’ من طلعت شاهين. وقد يهتف المرء، محقاً بالطبع: كم هو محظوظ هذا الـ’ماركيز′! روايته ‘مائة عام من العزلة’ قُيّض لها اثنان من خيرة آل الجندي معرفةً بالأدب والفصحى (سامي، وإنعام)؛ وذلك رغم أنّ المترجمَين نقلا عن الفرنسية، وليس عن الأصل الإسباني. وإذا كانت متابعتي سليمة، فإنّ سليمان العطار أنجز ترجمة ثانية للرواية ذاتها، صدرت في الكويت؛ وثالثة في لبنان، على يد محمود مسعود؛ ورابعة في لبنان أيضاً، من محمد الحاج خليل…
غير أنّ حظّ ماركيز في العربية لا يُقارن البتة بحظّه في لغة أخرى، جبّارة وكونية وكوزموبوليتية، هي اللغة الإنكليزية؛ إنْ لم يكنْ بسبب الذيوع الرهيب للشهرة الشخصية، فعلى الأقلّ لأنّ الترجمة الإنكليزية للرواية ذاتها هي التي جلبت له جائزة نوبل للآداب سنة 1982، كما قيل. وحين صدرت الرواية بالإسبانية للمرّة الأولى سنة 1967، تلقى ماركيز النصيحة الثمينة التالية من صديقه الروائي الأرجنتيني الكبير خوليو كورتازار: إعملْ على أن يترجمها غريغوري راباسّا، ولا تدعْ أحداً سواه يقترب منها، واصبرْ عليه حتي يقتنع بها، وانتظره حتى يشاء الله! ذلك لأنّ كورتازار كان يعرف ما يقول، حقّ المعرفة: لقد ترجم له راباسّا أصعب أعماله: روايته Rayuela، ‘لعبة الحَجْلة’ حسب قاموس منير البعلبكي، أو ‘الخَطّة’ كما نقول في بلاد الشام؛ العمل الوحيد (في ما أعلم) الذي يمنحك رسمياً قراءتين مختلفتين: الأولى ‘تقليدية’، تبدأ من الفصل الأول وتنتهي في ختام الفصل 56، حيث يعلمك كورتازار أنك تستطيع التوقف عن القراءة بضمير غير قلق أبداً، إذْ أنّ الفصول الـ 99 الباقية يمكن الاستغناء عنها؛ والقراءة الثانية ‘تركيبية’، يقترح الروائي ترتيب فصولها هكذا: 73 ـ 1 ـ 2 ـ 116 ـ 3 ـ 84 ـ 4 ـ 71 الخ…
وفي المثال على الملفّ الثاني، ثمة اعتراف ماركيز العلني أنه كتب ‘ذكريات عاهراتي الكئيبات’، 2004، بدافع الحسد الشديد من رواية ‘منزل الجميلات النائمات’، للروائي الياباني الكبير ياسوناري كاواباتا (1899ـ1972)، الحائز على نوبل الآداب لعام 1968. كما أقرّ ماركيز بأنّ روايته كانت تسعى إلى تحقيق حلم قديم هو مجاراة تلك الرواية اليابانية، بدليل أنه عاد إلى ذاك الحلم بعد توقف عن الكتابة الروائية دام قرابة عقد كامل، تفرّغ فيه لإنجاز سيرته الذاتية المعروفة. ولهذا، ليس ثمة ما يمنع من وضع ماركيز وجهاً لوجه أمام كاواباتا، في ساحة مقارنة أقرب إلى المفاضلة، وأشبه بغربلة فنّ لصالح فنّ آخر، أو ربما تصفية عبقرية إزاء أخرى كما يحدث في نهائيات الرياضات الكبرى. أميل شخصياً، وإذا جاز اللجوء إلى لعبة كهذه، إلى ترجيح كفّة الروائي الياباني في موضوعة أولى حاسمة وكونية، هي الشيخوخة وإغواء العذرية؛ وترجيح كفّة الروائي الكولومبي في موضوعة، ليست أقلّ حسماً وكونية، هي الاستبداد الواقعيّ ـ السحري.
كان كاواباتا ثالث ثلاثة عمالقة تربعوا على سدّة الرواية اليابانية في النصف الأوّل من القرن العشرين (إلى جانب جونيشيرو تانيزاكي وسوسيكي ناتسومي)؛ ولكنه كان الوحيد الذي طوّع التقاليد الأدبية اليابانية لكي تتصالح مع معطيات انقلاب البطل الملحمي إلى ‘شخصية’، وما يعنيه ذلك من مواجهات مع مقولة ‘النفس′، وما يستدعيه من رموز وموضوعات وطرائق سرد. وأمّا ماركيز، بوصفه أحد كبار آباء الواقعية السحرية، فإنّ نجاحاته الباهرة في دمج الواقع بالفانتازيا لم تكن تستهدف، عن سابق قصد أوّل، تحدّي قيود النوع وكسر أعراف الواقعية كما استخدمها الخطاب الغربي في سرد تاريخ الإمبراطورية؛ بل كانت، جوهرياً وبادىء ذي بدء، تردّ إلى المركز الإمبريالي ذلك ‘البريد الحداثي’ القائم على سرديات محلية واقعية تماماً، ممهورة مع ذلك بعجائب قرية ماكوندو، وببطاركة في خريف عمر غرائبي، وجنرالات ليس لديهم من يكاتبهم…
ويبقى أنّ قراءة ماركيز بترجمة راباسا لا تعادل قراءته في أية ترجمة إنكليزية أخرى، ولا مبالغة في إنّ الروائي الكبير يدين لمترجمه الكبير بقدر من الفضل يوازي الكثير من فضائل الأعمال ذاتها. كذلك يبقى أنّ حال الحسد التي سكنت المعلّم الكولومبي تجاه المعلّم الأسبق، الياباني؛ أسفرت عن رياضة اغتناء فريدة، ظلّ الرابح الأكبر فيها هو ذلك القارىء العريض، المتباعد/المتقارب، والمنفرد/الكوني.
«مئة عام من العزلة» … كيف كتب ماركيز هذا!/ علي الشدوي
منذ قرأت «مئة عام من العزلة» ثم في ما بعد أعماله، أبصرت خاتمة ماركيز. ولماذا الخاتمة؟ ما كان له أن يولد أصلاً. لكن بما أنه ولد وعاش وكتب، فلا بد من أن أساعده على بلوغ نهايته. أن يموت؛ لذلك دعوت عليه من قلبي. نعم. من قلبي، ذلك أن ما ربطني به ليس حباً ولا كرهاً، إنما شيء لا أجد له اسماً ولا وصفاً. ولم يكن في لغتي كلمات تستوعب ما ربطني بكتابته. كان لا بد من خنجر يجز الحبل. لو أنني أستطيع لاغتلته، لكن بما أنني لن ألتقي به، ولم أظن يوما أنني يمكن أن ألتقي به، اضطررت إلى الدعاء عليه كلما قرأت أو أعدت قراءة ما كتبه.
لا يمكن أن يكون ماركيز كاتباً طيباً. ماركيز كاتب شرير. ولأنه مات لن أذكر محاسن كتابته إنما سأذكر شرورها وما جنته على الآخرين؛ فعلى امتداد خمسين سنة كم من الشباب – أو الشابات – الذين مزّقوا ما كتبوه لأنهم قرأوا ما كتبه ماركيز! كم من الشباب – أو الشابات – الذين هجروا الكتابة لأنهم متأكدون أنهم لن يكتبوا مثل ماركيز؟! وكم من هؤلاء الذين توهّموا أنهم سيتجاوزونه لكنهم وقعوا في فخه؟ هل يوجد أكثر شرّاً من الكاتب ماركيز؛ الكاتب الذي نشر ديموقراطية القراءة بين الناس، ثم منعهم من أن يكتبوا مثله؟!
كم فرحت حين قرأت شذرة باسكال هذه: «إنها لعلامة سيئة أن ترى رجلا فتتذكر كتابته». فرحت لأنها تنطبق على ماركيز، ما إن أرى صورته حتى أتذكر كل شيء كتبه. علامة سيئة. نعم. لكنني أعرف أنها ليست علامة سيئة، فأعود أدعو على ماركيز الذي أشغلني؛ إذ لا فكرة إنسانية لم يخمّنها إلى حد أنني أجد في ما كتبه توضيحات لدوافعي أفضل مما لو كتبت.
ماذا يعني أن تصرخ بأعلى صوتك (يا إلهي كيف كتب ماركيز هذا!) ذلك شيء لا يدركه إلا من جرّب. ولو سأل أحد عن حالي لقلت: لعنته بعد كل قراءة، ثم ندمت على لعنه، لكنني عدت ألعنه لأنني أعدت قراءته. وقد كان دليلي دوستويفسكي، حين قال: «أحيانا لا تملك إلا أن تلعن».
يفوت الصدق من يقول إن كتابة ماركيز ممتعة؛ ذلك أن قراءة ما كتبه محوطة بالقلق: قبل القراءة وبعدها وحولها وخلالها. وما عدا ذلك فدعاية مغرضة. حين تقرأه هناك شيء يجعلك لست أنت. تغلقه وأنت تصرخ كما ميلفل في «موبي ديك»: «أيها الكتاب إنك تكذب. الحق أيها الكتاب أنه يجب أن تعرف حدك. لكنك تعرف أنه لا يكذب إنما أنت الذي لا تريد أن تتغيّر».
وأنا أتتبع أخباره عرفت أن ما يجعل الكتابة عما كتب هو أنه أحاط كتابته بكثير من الضجة، حكايات تلو حكايات. لكن ما يجعل الكتابة أكثر صعوبة أن الضجة قد تكون صحيحة. ألا يدفعك هذا إلى أن تتمنى موته لأنه يمتصّك ويتلاعب بك، ويحولك إلى مستهلك لروائعه.
حين رأيت صورته بكدمة في وجهه، تمنيت لو تتاح لي الفرصة لأقبل يد يوسا. تلك الكدمة التي رأيتها تحت عينه أقوى دليل على أن يوسا يحبه إلى حد الكره مثلي. هذا ما فكرت فيه وأنا أتأمل الدائرة السوداء، على الرغم من كل ما قيل عن أسباب تلك اللكمة.
إذا صدق ماركيز فقد حلم ذات مرة أنهم أنزلوه في قبر ثم عادوا وتركوه، عندئذ أكتشف أن الموت هو ألا يكون لأحد أصدقاء. وها هو الآن ماركيز بلا أصدقاء، ومنهم أنا، الذي لم ألتق به قط. أنا الذي أحببته وإن كنت سببْته؛ لأن المثل الجنوبي يقول «من سبّه حبّه».
وداع «أسطوري» على الأنغام الكولومبية في المكسيك لغارسيا ماركيز
كانت مكسيكو سيتي أمس (الإثنين) مسرحاً «أسطورياً» لمراسم تكريم رسمية أولى للأديب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز الذي توفي الخميس عن 87 عاماً في حضور عائلته ورئيسا كولومبيا والمكسيك (البلد الذي اختاره مقراً له).
وفي قصر الفنون الجميلة وضع وعاء أحمر قان يحوي رماد الكاتب الشهير على منصة نثر عليها الورد الأصفر، فيما مر آلاف الأشخاص على مدى أكثر من أربع ساعات أمامه.
وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس: «المجد الأبدي للشخص الذي أعطانا مجداً كبيراً».
وأضاف سانتوس الذي بدا عليه التأثر أن كولومبيا والمكسيك «تتحدان لتكريم الشخص الذي لفت انتباه العالم في يوم من أيام كانون الأول (ديسمبر) 1982 من ستوكهولم المصقعة، عندما تكلم عن عزلة أميركا اللاتينية».
وحيا الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو بعد ذلك (أكبر روائي في أميركا اللاتينية في كل الأزمنة)، وأشار إلى أن المكسيك «هي موطن غابرييل غارسيا ماركيز الثاني» موضحاً أن «غابو كما كان يسمى تحبباً وضع الأدب الأميركي اللاتينية في مقدمة الأدب العالمي».
وشكل الرئيسان مع وزراء عدة من البلدين، ثلة شرف حول الإناء ووقفوا دقيقة صمت قبل أن يصفقوا مطولاً في نهاية مراسم التكريم.
وكان آلاف المعجبين بالكاتب مروا أمام الإناء الجنائزي على أنغام رباعي كان يعزف مقطوعات لبارتوك وبيتهوفن. ومن وقت إلى آخر كانت فرقة صغيرة لموسيقى الكومبيا وفايناتو من ساحل كولومبيا تتولى العزف، ما دفع جزء من الحضور إلى الوقوف والرقص قليلاً.
وكان رماد الكاتب نقل إلى قصر الفنون الجميلة الرائع في وسط العاصمة المكسيكية من قبل أرملته ميرسيدس بارتشا وأبنائه وأحفاده الذين ارتدوا الأسود ووقفوا حول الإناء أيضاً.
وبين الجموع التي أتت لإلقاء تحية أخيرة، حمل كثيرون زهرة صفراء كان يعتبر الكاتب أنها تحميه من سوء الطالع. وخلال فترة الانتظار الطويلة كان قراء يتناوبون أمام مذياع في القصر لقراءة مقتطفات من رواية «مئة عام من العزلة» تحفته الأشهر.
وقالت جوسلين لوبيز وهي طالبة فنزويلية في الحادية والعشرين «أود أن أشكره لأنه زرع في حب القراءة. كما أنه أعطانا -مئة عام من العزلة- أتمنى أن يبقى راسخاً مئة عام إضافية في القلوب».
وكان غارسيا ماركيز يعتبر المكسيك بلده الثاني، إذ وجد فيها الاستقرار من أجل كتابة الجزء الأكبر من نتاجه الأدبي.
وفي بلده الأم تحضر السلطات الكولومبية مراسم تكريم له أيضاً. إذ يشارك الرئيس سانتوس اليوم الثلثاء في مراسم رسمية في كاتدرائية بوغوتا، وستعزف الأوركسترا السمفونية الوطنية القدس الجنائزي لموزار.
و في اليوم العالمي للكتاب الذي يوافق الأربعاء، قررت الحكومة الكولومبية قراءة رواية «لا رسالة للكولونيل» (1961) في أكثر من ألف مكتبة عامة ومتنزه ومدرسة. وسيعطي الرئيس الكولومبي إشارة البدء بالقراءة شخصيا.
وتنتظر كولومبيا قرار العائلة بشأن المكان الذي سيوضع فيه رماد غارسيا ماركيز، ويتم تقاسمه بين المكسيك وكولومبيا وربما في مسقط رأسه أراكاتاكا.
صيّاد السحر والحكايات/ الياس خوري
في ‘قصة موت معلن’، روى غابرييل غارثيا ماركيز حكاية موت سانتياغو نصار مذبوحا بالسكاكين. كل القرية، ما عدا الضحية، كانت تعلم أن المهاجر السوري-اللبناني سوف يموت. وعندما سقط سانتياغو أو يعقوب، أحسسنا، نحن القراء الذين أشركنا المؤلف في سره المعلن، بالمفاجأة. فالموت، حتى حين يكون معلنا هو المفاجأة الأخيرة التي تصفعنا ببرودتها وحقيقتها.
لم يكن ماركيز بطلاً كي يموت مذبوحا لأنه فض بكارة فتاة، كما مات المهاجر المشرقي الجميل، لكنه كان راوي الحكاية. وكي تروي يجب أن تعيش، أي أن لا تكون بطلا، بل ظلا للبطل أو رفيقا له، أو شاهدا على الحكاية.
لكن موت ماركيز المعلن منذ إصابته بالسرطان عام 1999، جاء مفاجئا كما يجيء الموت. حتى الرواة الذين اختبأوا خلف أبطالهم وحكاياتهم، يتحولون الى أبطال ولو مرة واحدة، حين تعلن بطولتهم موتهم.
منذ أن صدرت ترجمة ‘مئة عام من العزلة’، الى لغة الضاد، صار ماركيز كاتبا عربيا، من دون أن يدري. دخل سحر عوالمه في وجودنا وكأنه آتٍ من مكان عميق في وعينا وذاكرتنا.
ما أطلق عليه النقاد اسم الواقعية السحرية، لا يشبه سوى العجيب والغريب في التراث الأدبي العربي، الذي صنعته شهرزاد في كتاب ‘ألف ليلة وليلة’. واقع مسحور وسحر واقعي، السحر ليس خيالا لأنه ابن الحقيقة، والحقيقة ليست حقيقية لأنها ابنة الخيال. هذا المزج بين الواقعية والسحر، أوصل الرواية التي بدأت رحلتها السحرية مع كافكا وفوكنر الى إحدى قممها، عبر تحويله الحياة اليومية الى مرادف للحلم.
إحساسنا بأن هذا الأدب يأتي من مكان عميق في وجودنا سبق لبورخيس أن رسم ملامحه حين اخترع ليلة لا وجود لها في كتاب الليالي، ثم تشكل مع الأبطال السوريين في الرواية الأمريكية اللاتينية ليصل الى ذروته مع سانتياغو نصار، الذي دخل في ‘مجمع أسرارنا’، وصار بطلي الشخصي مع أقربائه اللبنانيين الذين شهدوا مذابح 1860 وكانوا ضحاياها.
هذا الأفق العربي- الأمريكي الجنوبي لم يجد حتى الآن من يدرسه. وانا هنا أستخدم صيغة الهوية بشكل رمزي، لأن ‘ألف ليلة وليلة’ ليست عربية الا لأنها تدور في أفق لغوي عربي وفي مناخات دمشق والقاهرة وبغداد، لكنها كانت تلخيصا للآداب الشرقية كلها. كما ان أدب أمريكا الجنوبية الذي ولد من رحم الحكاية الشهرزادية، ليس محليا إلا لأنه يدور في أفق لغوي واجتماعي محدد، لكنه يمتد ليلخص أدب القرن العشرين بعناصره الأساسية.
سر ماركيز أنه تعلم أن يكون راويا وشاهدا، لكنه لم يجلس في المقاعد الخلفية كي يحتمي من عصف الزمن. عاش في قلب العاصفة، وكان مناضلا يساريا حتى النهاية. كان تشيليا في مواجهته للإنقلاب العسكري الفاشي، وكوبيا في دعمه لحلم الثورة، وفلسطينيا في دفاعه عن الحق والحقيقة. من الصحافة الى الأدب، صنع هذا الكاتب أسطورة أدبية تشبه أساطير رواياته، تعلم فن الحب بالحب، وواجه ‘خريف البطريرك’ بالسخرية، وذهب الى متاهات الجنرال، وروى من دون توقف. كأنه كان يصطاد الكلمات ويعيد تأليفها من جديد، فاتحا للخيال أفقا جديدا، مكتشفا أن الحياة حلم من الرغبات والإحتمالات، وأن السحر بعد طرده من كل الأمكنة، عاد الى الكلمات التي كانت مهده وستبقى بيته الى الأبد.
اصطاد ماركيز الحكايات من ذاكرته ومن الواقع، او هذا ما أوحته لنا مذكراته التي أعطاها عنوان ‘عشت لأروي’، هكذا بعث في مذكراته كل شياطينه التي أوحت له، كي يبرهن انه لم يخترع شيئا، وان المؤلف لا يؤلف بل يصطاد القصص ويعيد صوغها.
لكنني أحسست وأنا اقرأ المذكرات أنني أمام عمل تخييلي بامتياز. لم أصدق المذكرات، لأنني شعرت أن حرفة الأدب وشياطين الخيال تداخلت فيها مع الوقائع، بحيث شعرت أنني أمام نسخة روائية جديدة لأعمال روائية سابقة، وأن ما حاول الكاتب أن يعطيه صفة المذكرات، لم يكن إلا مزجا للذاكرة بالخيال.
لنفترض أن شهرزاد كانت شخصية حقيقية، (بالمناسبة فإن الكتّاب الذين تعيش أعمالهم طويلا، يتحولون هم أيضا الى شخصيات من صنع الخيال من أمرئ القيس الى هوميروس وصولا الى شكسبير…) ولنفترض أنها ستكتب الآن ذكرياتها، فكيف ستتعامل مع السندبادين، هل بوصفهما خيالا تمرد على الحقيقة، أم حقيقة تستطيع أن تضبط الخيال؟ وكيف ستروي حكايتها مع الملك المجنون، هل بصفتها حيلة أدبية أم بصفتها حيلة حياتية؟ لا شيء يستطيع أن يكون أكثر حقيقية من خيال أدبي يلعب مع الحياة لعبة الموت، هذه هي لعبة الأدب الكبرى، بدل أن نترك للموت أن يصنع نصنا عن معنى الحياة، تقوم الحياة بكتابة نصها عن معنى الموت.
إنها لعبة معقدة بدأها أجدادنا العرب بالوقوف على الأطلال، كي تصير الكلمات وشما على جسد الرحيل، وصارت حقلا أدبيا عبر قدرتها على تحويل الموت الى أحد اشكال الحياة، ليس عبر الإنتصار عليه، بل عبر تحويله الى أحد احتمالات الواقع السحرية.
قال شقيق ماركيز إن الرجل بدأ يفقد ذاكرته منذ سنوات قليلة، وأثار هذا التصريح الكثير من الأسى والغضب، لكن ما فاتنا اكتشافه هو أن ذاكرة الموت أخذت الكاتب من مكسيكو الى ماكوندو، بلدة خياله الروائي في ‘مئة عام من العزلة’. ربما فقد ذاكرة المدينة التي أقام ومات فيها، لكنه لم يعد يحتاج الى هذه الذاكرة منذ أن قرر أن يعيش في ماكوندو، ويبدأ رحلته من جديد، متلاشيا في الكلمات، متخليا عن دوره كراو ليصير جزءا من الرواية.
القدس العربي
عن سيرة رجل جعل حياته الواقعية أسطورة وأسطورته حقيقةً واقعة غبرييل غارسيا ماركيز… الذي لطالما كان كذّاباً منذ طفولته/ رامي زيدان
من بين الأسماء الروائية في أميركا اللاتينية، يبدو الكولومبي الراحل غبرييل غارسيا ماركيز الأكثر غواية لكتابة سيرته، فهو يتفوق على ماريو فارغاس يوسا وايزابيل الليندي وكارلوس فوينتس وغبريال ميسترال وإدوارد غالينيو وجيمس كانيون وخورخي أمادو وخوليو كورتاثار. هو في أسطورته الحياتية مثل تشي غيفارا في الثورة، ودييغو مارادونا في كرة القدم، وفريدا كاهلو في التشكيل، وفيديل كاسترو في السلطة، وبابلو نيرودا في الشعر. هذه الاسماء كلها من أميركا اللاتينية، وتجمع بينها تقاطعات في الثقافة والسياسة والنجومية والجنون والخلق والشهرة.
ماركيز هو الروائي الكبير الذي أتى من عالم الصحافة، وهو الاسم البارز الذي حارب الديكتاتوريات في بلاده من خلال رواياته، خصوصاً “خريف البطريرك”؛ لكنه كان صديق الرؤساء من بيل كلينتون الى فيديل كاسترو وفرنسوا ميتران. وهو الكاتب النخبوي – الشعبوي الذي لا يتردد في الكتابة عن النجمة شاكيرا؛ وهو الحداثوي الذي وظّف حكايات الجدات في روايات معقدة؛ وهو الواقعي الذي أنقذ نفسه من الواقع بالسحر؛ وهو الروائي المرجع الذي استسلم روحية رواية “الجميلات النائمات” أو حسد ياسوناري كواباتا على روايته، وهو الآتي من الفقر المدقع وقد أصبح من الأثرياء الكبار.
سيرتان
جاء مشرداً إلى باريس منتصف الخمسينات. نام الليالي الباردة على مقاعد الحدائق. وكان رجال الشرطة يطاردونه، اعتقادا منهم أنه جزائري بسبب سحنته، في ذروة الحرب الجزائرية ضد الفرنسيين. على هذا تتسم سيرة ماركيز بالغواية وتجذب الكتاب المختصين لتدوين أسرارها، حيث كل جانب منها يمكن ان يكون محوراً لكتاب خاص. حتى ماركيز نفسه لم يتردد في البدء بتدوين سيرته بعنوان “عشت لأروي”، مستنداً إلى ما قاله جيمس ستيورات في فيلم “الرجل الذي قتل ستارة الحرية” من أنه “حين تكون الأسطورة أكثر جمالا من الواقع، قم بطباعة الأسطورة”.
تغطي هذه السيرة الماركيزية، “عشت لأروي”، المرحلة الأولى فقط من حياته، وبالتحديد الفترة من سن الخامسة إلى سن الثلاثين، أي سنوات الطفولة والشباب المبكر، وهي الفترة التي سبقت اتخاذه في سن الثلاثين أهم قرار في حياته، وهو قرار أن يصبح كاتباً. تمر فيها عبارات مثل “إذا كنت تظن أنك قادر على العيش من دون كتابة، فلا تكتب”، و”إن الشيء الوحيد الذي أريده في هذه الحياة هو أن أكون كاتباً، وسوف أصير كذلك”. في هذا النص يحافظ ماركيز على الكيفية نفسها التي كان يتصرف بموجبها في رواياته فيسرد أحداث حياته كما لو كان يسرد أحداث رواية. نعرف أن كل شيء أو كل حدث في روايات ماركيز، كان له أصل في حياته الحقيقية، ونعرف أيضا أن ماركيز لم يكن يقصد النقل الحرفي لهذا الأصل بل بالأحرى إعادة الاشتغال عليه بحيث تمتزج أحداث حياته الخاصة والأحداث السياسية التي عاصرها بأحلامه وتفسيراته ورؤاه الذاتية والخاصة. وكان المأمول أن تصدر السيرة في ثلاثة أجزاء لكن “عشت لأروي” ظل لمدة طويلة هو جزء السيرة الوحيد المتاح.
كان العالم ينتظر الأجزاء المتبقية من سيرة ماركيز لكنه فوجئ بصدور سيرتين لماركيز الأولى، بعنوان “غارثيا ماركيز، العودة إلى الجذور” للكاتب الكولومبي داسّو سالديبار (ترجمة صبري التهامي، المركز القومي للترجمة)، والثانية بعنوان “غبرييل غارسيا ماركيز: حياة” للناقد البريطاني جيرالد مارتن (ترجمها محمد درويش عن “الدار العربية للعلوم).
ثمة جهد جبّار في السيرتين. يتبين ذلك من المعلومات التي وردت فيهما، ومن تجاوب ماركيز في مساعدة المؤلفين، وقد سمح ماركيز لداسّو سالديبار، بأن يكتب بحرية قائلاً له: “أكتب كما لو أنّي كنت ميّتا”. تحدث الكتاب عن عالم “غابو” وحاول الإجابة عن أسئلة عديدة تخصّه بطريقة شبه روائية، بذل فيها جهداً حثيثاً ومجهوداً مضنياً طوال أربعة عشر عاماً.
مضى جيرالد مارتن في قراءة أعمال ماركيز ومنجزاته في القصة القصيرة والرواية والمقالات الصحافية والنصوص السينمائية والسفر إلى عدد كبير من بلدان العالم لمقابلة أصدقاء لماركيز من صحافيين وأدباء وروائيين وسياسيين وزعماء أحزاب ورؤساء دول، من ضمنهم الزعيم الكوبي فيديل كاسترو، والرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران، ورئيس وزراء إسبانيا السابق فيليبي غونزاليس، وغيرهم من الشخصيات، بهدف الإطلاع على تفاصيل علاقاتهم مع روائي “الواقعية السحرية”.
سيرة مارتن مختلفة كلياً عن السيرة التي كتبها ماركيز الذي ركّز في سيرته لا على حقائق الحياة نفسها بل على طريقة تذكّر هذه الحقائق وكيفية روايتها. يلتزم جيرالد مارتن حقائق حياة ماركيز نفسها ويسرد هذه الحقائق في كتابه بكل دقة. يبرهن على صرامة غريبة في الإحساس بـ”غابو” وفي إدراك شخصيته وحياته المدهشة. “ذلك الشخص، يقوم دوما بسرد الحكايات والقصص!” كما كان يردد غالبا أبوه.
استهلكت سيرة ماركيز ما يقارب ربع عمر مارتن كما يخبرنا في تقديمه للكتاب: “هكذا وجدت أنه من المستحيل القضاء على الأسطورة التي نشرها ماركيز بنفسه ويعتقد بها كما يبدو، حتى إنني، وهذا من مزايا هوسي المفرط، أمضيت ليلة هطلت الأمطار مدرارا وأنا جالس على مصطبة في الميدان في آراكاتاكا كي أتشبع بجو البلدة التي ولد فيها موضوعي كما يفترض”. ما يميز مارتن هو أنه لا يغفل في كل مرحلة من المراحل التي عبرها غابو الكثير من التفاصيل، خصوصا مسيرته الكتابية. في تموز عام 1966، نشر ماركيز تأملات ذاتية يسترجع فيها محنته في الكتابة بعنوان “مصائب مؤلف كتاب”، وفيها يؤكد أن “تأليف الكتب مهنة انتحارية، إذ ما من مهنة غيرها تتطلب قدراً كبيراً من الوقت، وقدراً كبيراً من العمل، وقدراً كبيراً من التفاني مقارنة بفوائدها الآنية. إني أعتقد أن عدداً كبيراً من القراء لا يسألون أنفسهم بعد الانتهاء من قراءة كتاب ما، عن عدد الساعات المؤلمة والبلايا المنزلية التي كلَّفت المئتي صفحة المؤلف، أو ما هو المبلغ الذي حصل عليه لقاء عمله؟”. لكن اصرار ماركيز على الكتابة لا يضاهيه إصرار آخر. حتى إن والده قال له يوماً ما: “إن المطاف سينتهي بك إلى أن تأكل الورق”، وذلك عندما قرر في عام 1949 أن يتخلى عن دراسة الحقوق بسبب إخفاقه في النجاح في السنة الثالثة من دراسته. وعندما حاول أحد أصدقائه أن يدافع عنه أمام أبيه، موضحاً له أن ماركيز بات اليوم واحداً من أفضل كتّاب القصة القصيرة في كولومبيا، انفجر الأب صائحاً: “إنه قصّاص، حسناً، طالما كان كذّاباً منذ طفولته!”. ماركيز نفسه يقول في “عشت لأروي”: “أكاذيب الأطفال هي علامة موهبة كبيرة!” من جهة أخرى، نجده يتلقى في عام 1952 رسالة مدمرة من دار لوسادا للنشر في بوينس آيريس، التي أرسل إليها مخطوطة روايته الأولى “عاصفة الأوراق” بغية نشرها، فيها يخبره مدير الدار غييرمو دي توري، وهو أحد أبرز نقّاد الأدب الأسبان في المنفى وأحد أقرباء الأديب الأرجنتيني بورخيس، انه ليس لديه أي مستقبل في كتابة الرواية، واقترح عليه أن يبحث عن مهنة أخرى. لكن أصدقاء ماركيز تجمهروا حوله، وقال له أحدهم: يعلم الجميع أن الأسبان أغبياء!
الذروة في مسيرة الشقاء الكتابي الماركيزي، كانت مع رواية “مئة عام من العزلة”. فمن الممتع جداً أن نقرأ في كتاب “العودة الى الجذور” التفاصيل التي قادت إلى صدور كتاب “مئة عام من العزلة”، بل أدقّ التفاصيل التي لا يعرفها من يشتري الكتاب جاهزا. نقرأ عن الظروف النفسية والاجتماعية التي رافقت الكتاب في تشكله، كما نقرأ عن الكتب التي ساهمت في تأليفه، وعن التداخل مع نصوص وكتب أخرى، عن التناص والاقتباس والاستلهام، وغيرها، مع نصوص بورخيس وماريو فارغاس يوسا وخوان رولفو وغيرهم. والى أن يرسل نصف مخطوطة الرواية بالبريد إلى الناشر الأرجنتيني لأنه لم يكن يملك ما يكفي من المال لإرسالها كلها. أما النصف الثاني من المخطوطة بحسب ما يبيّن جيرالد مارتن فقد أرسله بعدما رهنت زوجته المدفأة الكهربائية ومجفف الشعر ثم عادا إلى مكتب البريد لإرسال ما تبقى. لدى خروجهما، توقفت مارسيدس والتفتت الى زوجها قائلة: “غابو، لا ينقصنا الآن سوى أن يكون الكتاب سيئاً”. وحققت الرواية شهرة بعد نشرها مباشرة (1967)، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة في أنحاء العالم، وأعطت دفعة لأدب أميركا اللاتينية. فقد كان ظهورها في ذروة التحول بين الرواية الحداثوية وما بعد الحداثوية.
“مئة عام من العزلة” اعتبرها داسّو سالديبار “أروع رواية كتبت باللغة الاسبانية”، موضحاً ان الأولى ستبقى رواية “دون كيخوته” لأسباب كثيرة، لكن الرواية الأكثر روعة والمكتوبة بشكل أفضل حسب اعتقادي هي “مئة عام من العزلة”. كما هي حال بلدة لا مانشا في عمل ميغال ثرفانتيس و”كومالا” في عمل المكسيكي خوان رولفو، فإن ماكوندو المسرح الساحر لـ”مئة عام من العزلة” تظهر كذلك أن “الكوني هو في الأصل محلي متسام” على حد تعبير سالديبار.
كانت الأجواء التي رافقت صدور رواية ماركيز مشحونة نظرا لوجود كُتّاب كبار من أميركا اللاتينية كانوا يستحقون جائزة نوبل للأدب، من بينهم بورخيس وفارغاس يوسا وكورتاثار وغيرهم… وكانت العلاقات مميزة ما بين يوسّا البيروفي وماركيز الكولومبي، قبل أن تصل إلى القطيعة والعداء.
يصف داسّو سالديبار أول لحظة لقاء بين الكاتبين، ويتحدث عن تداخل نصوص أعمالهما وأعمال آخرين: “على رغم أنها كانت المرة الأولى التي يلتقيان فيها، وجها لوجه، فقد كانا قد تعهدا بصداقة طويلة، عبر المراسلة، وتطرّقا فيها إلى احتمال كتابة رواية مشتركة ذات يوم، عن الحرب التراجيدية والهزلية التي تعرض لها بلداهما في بداية الثلاثينات من القرن الـ20. وكان كلاهما قد قرأ نصوص الآخر باهتمام، وعاشا إعجابا كبيرا بأدب الفروسية، كان يوسّا، بالنسبة لماركيز “الفارس التائه الأخير للأدب”، بينما كان ماركيز، في نظر يوسّا “أماديس أميركا اللاتينية”. هذه العلاقة الصاخبة بين الروائيين النوبليين التي انتهت الى العدائية والاتهامات، هي أيضا تمارس الغواية للكتابة عنها. فصداقات ماركيز لم تكن عابرة بل هي اشبه بالحكايات الساحرة والغريبة. علاقته بزوجته أيضا فيها من السحر ما يكفي، وخصوصا حين يتحدث عن أصلها وفصلها وكيف تعرف اليها وكيف تزوجها. عالم كله حكاية في حياة أديب يمكن وصفه بسارق الحكايات.
الصحافة أفضل مهنة في العالم
تاريخ مسيرة ماركيز صحافيّاً، لا يقلّ إبهاراً عن تاريخه روائيّاً، وخصوصاً الفصول الشيقة في كتاب “العودة الى الجذور”، تلك التي تتحدث عن المرحلة الباريسية في حياة غابو وإقامته في الحي اللاتيني، حيث تأثر ماركيز كثيراً بثورة الجزائر، وتقاسم السجن مع المواطنين الجزائريين، فقد كانت سحنته توحي للشرطة الفرنسية بأصول مغاربية! في هذا الإطار يقول داسّو: “لم تكن حرب الجزائر تحتل الساحة الإعلامية بعدُ، ولكنها كانت واقعا مُهدِّدا لماركيز لسحنته العربية، وقد دفع الثمن، إذ لدى خروجه من قاعة سينما ذات مساء، اعتقد رجال الدرك الفرنسيون أنه جزائري، فأشبعوه ضربا ونقلوه إلى مقر الشرطة في سان جيرمان ديبريه مع جزائريين حقيقيين، حزينين وذوي شوارب مثله”.
الصحافة في نظر ماركيز، أفضل مهنة في العالم. شهد بأن الجوائز العالميّة، حتى نوبل، ليست سوى مسرحيّات اجتماعيّة حافلة بإيماءات أكاديميّة متعمّدة لإشهار بعض الشخصيات المغمورة اجتماعيّا. فقد حمل ماركيز في جعبته أسفا مضمرا، لأنّ الرواية هي التي قدّمته إلى العالم حتى كصحافيّ، وأسلوبه السردي في كتابة الريبورتاج الصحافي لم يكن مغايرا لأسلوب الرواية إلا في قليل من المكوّنات.
مارس ماركيز الغواية في سيرته وحتى في علاقته بالرؤساء والزعماء، على رغم انه جعل للديكتاتوريين حصة لا بأس بها في أعماله الروائية وغير الروائية. كما انه حلل سماتهم وتصرفاتهم في بعض أقوى صفحات نصوص له مثل “خريف البطريك”، حيث نلاحظ ان كثراً من زملائه الكتّاب العالميين (ماريو فارغاس يوسا، وسوزان سونتاع) يأخذون عليه مهادنته فيديل كاسترو. لكن تلك العلاقة بين الروائي والزعيم كانت أعقد من ان تختصر بموقف او برد فعل، وقد كتبت حولها عشرات المقالات وصدر عنها كتاب بعنوان “فيديل وغابو” لمؤلفيه انجيل استيفان وستيفاني، ورد فيه ان غابو جمعته صداقة قوية مع كاسترو قال عنها في لقاء صحافي عام 1977 إنه لم يعرف رجلاً أحسن منه وقد لا يكون معروفاً على نطاق واسع أن فيديل مثقف جداً. الكتاب يلفت انتباه القراء على أنه كان دراسة نشرت سابقاً عن ماركيز ومقابلات أجريت مع كاسترو وإن معظم صفحاته الـ 700 تحدثت عما كان يدور بينهما من قضايا أدبية وسياسية وحتى تاريخية وهي مثيرة للإهتمام حقاً، منها أن ماركيز كان يرسل مخطوطات رواياته وقصصه إلى كاسترو ليقرأها ويعلق عليها كما ذكر ذلك لصحيفة “البايس” الإسبانية عام 1996. ومع تطور هذه العلاقة يورد الكتاب كيف رتب ماركيز لإطلاق نحو 3000 سجين في الجزيرة الكوبية على الرغم من أن بعض مؤرخي تلك الحقبة يعتقدون أن العدد مرتفع ومغالى فيه لكنه يعكس في كل الأحوال العلاقة القوية بينهما حتى أن كاسترو منحه شقة في الجزيرة لتأكيد قيمة مكانته الفكرية لديه.
كان كاسترو جاذباً للمثقفين في معظم مراحله، وإن انتقده كثيرون بسبب ممارساته القمعية. وتبقى الصداقة بين كاسترو وغابو الأكثر ضجيجاً وصخباً، ولا شك في ان ماركيز كان يؤثر في السلطة ولا تؤثر فيه، وهذا سر من اسرار علاقته بالزعيم الكوبي.
النهار
نلتقي في شهر آب».. آخر روايات ماركيز/ إسكندر حبش
قبل رحيله في الأسبوع الماضي، كان الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز يعيش بعيدا عن الجو الإعلامي، إذ جعله المرض الذي عانى منه لسنوات طويلة، يُقلّ من أحاديثه الصحافية وتصريحاته. صحيح أنه تنقل في بعض السفريات القليلة، لكنه حافظ على «عزلته» بعيدا عن الحياة العامة، بالرغم من كل الإغراءات التي تعرض لها، كأن يُفتتح متحف باسمه، أو أن يُطلق اسمه على مؤتمر هنا أو هناك.
كل الإشارات كانت تدل على أنه كان يرغب في شيخوخة بعيدة عن الضوضاء في انتظار الرحيل الكبـير، أو ربـما «العزلة الأخيرة». من هنا، كانـت الأنباء الواردة تشير أيضا إلى أنه مبتعد عن الكتابة، وتحديدا الكتابة الروائية، إذ آخر كتبه كان رواية «ذكرى غانياتي الحزينات» (ترجمها صالح علماني إلى العربية وصدرت عن «دار المدى») التي صـدرت العـام 2004 والتي يتـحدث فـيها عن رجل بلـغ التسـعين مـن عمـره، يتذكر أنه في شبـابه كـان يتـردد بانتظام إلى المواخير، لدرجة أن العديدات من بنات الهـوى اخـترنه «زبون السنة». عشية ميلاده التسعين، تذكر أنه لم يذهب إلى هذه المنازل منذ عشرين سنة، من هنا دفعته روزا كاباركا، إحدى «مديرات» هذه البيوت إلى العودة، إلا انه اشترط عليها أن تكون الفتاة.. عذراء.
روايته هذه ـ وإن لم يجد فيها الكثير من النقاد روحية ماركيز ولا أسلوبه الكبير ـ اعتبرت بمثـابة تحـيّة إلى الكاتب اليـاباني ياسـوناري كاواباتـا وإلى روايته «الجميلات النائمات». إذ نعرف ما كتبه ماركـيز عن روايـة الكـاتب الياباني التي اعتبرها من أجمل روايات العالم وبأنه يتمنى لو أنه هو من كتبها.
في أي حال، لن تبقى رواية «ذكرى غانياتي الحزينات» الرواية الأخيرة لماركيز، إذ أعلن كريستوبال بيرا، من دار نشر «راندوم هاوس» في حديث مع الإذاعة الكولومبية (تناقلته العديد من الصحف البلجيكية وبخاصة «لو سوار» و«بلجيكا الحرة») أن هناك رواية أخيرة، ستصدر لماركيز قريبا، (بعد رحيله بالطبع).
التفاصيل القليلة التي أعلنت عن هذه الرواية، تفيد بأن الكاتب كان يعمل عليها منذ سنين، وقد غيّر فيها كثيرا في السنوات الأخيرة مثل عادته، إذ كان مشهورا عنه أن يعيد كتابة الرواية لمرات ومرات قبل أن يختار الصيغة النهائية كما أُعلن أن الرواية تحمل عنوانا مبدئيا هو «نلتقي في شهر آب»، وستصدر بشرط أن توافق عائلة الكاتب على عملية النشر.
الرواية التي أخفى ماركيز أنه يعمل عليها من سنوات، تروي قصة امرأة كانت تقوم يوم 16 آب من كلّ سنة بزيارة إحدى جزر الكاريبي حيث قبر والدتها المتوفاة. وعلى الرغم من أن هذه المرأة متزوجة وسعيدة في حياتها الزوجية، إلا انها التقت ذات يوم برجل حدثت بينهما مغامرة غرامية ذات رحلة من رحلاتها، وتمنت أن تُستعاد هذه المغامرة في كل زيارة لها من ذاك اليوم من شهر آب.
متى تصدر الرواية؟ لا شيء واضحا إلى الآن. لكن بالتأكيد لن تنجو ـ حين صدورها ـ من هوس «الماركيزيين» الذين بدأوا انتظارها من هذه اللحظة.
إسكندر حبش
السفير
سلمان رشدي عن ماركيز : كان أعظمنا
بوابة الشروق: لينة الشريف
هذا المقال نشره سلمان رشدي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لرثاء الكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز. بوابة الشروق تنشر ترجمة لمعظم ما جاء في المقال
جابو يعيش.هكذا يقول لنا الاهتمام العالمي غير العادي بوفاة جابرييل جارسيا ماركيز، والأسى الحقيقي الذي شعر به قراؤه في كل مكان . فكتبه لازالت حية بلامنازع.
في مكان ما، لا يزال هناك «بطريرك» ديكتاتوريجعل من خصمه وليمة حافلة تقدم لضيوفه على طبق كوجبة عشاء. ولا يزال هناك “كولونيل” عجوز ينتظر رسالة لا تأتي أبدًا، وفتاة جميلة تحولها جدتها القاسية الى بائعة هوى. ولايزال هناك بطريرك أكثر لطفًا يسمى خوسيه أركاديو بوينديا، أحد الاباء المؤسسين ل” ماكوندو” الجديدة، رجل يهتم بالعلم والكيمياء يعلن لزوجته أن «الأرض دائرية مثل حبة البرتقال» فيصيبها بالرعب.
نعيش في عصر العوالم المختلقة البديلة : “الأرض الوسطى” لتولكين، ومدرسة “هوجورتس” للسحر لرولينج، والعالم البائس لـ “ألعاب الجوع” The Hunger Games ، عوالم يصول ويجول فيها مصاصو الدماء والزومبي. هذه هى الاماكن التي تنتعش هذه الايام.
ولكن على الرغم من رواج الرواية الخيالية، هناك ما هو حقيقة وواقع في مثل هذه الروايات بأكثر من الخيال.
ففي “ماكوندو” الخيال وسيلة لخدمة الواقع وليس للهروب منه.
صدرت رواية «مائة عام من العزلة» منذ أكثر من أربعين عامًا الآن. وبالرغم من شعبيتها الضخمة والمستمرة، فإن أسلوبها المبني على الواقعية السحرية أعطى إلى حد كبير، في أمريكا اللاتينية، أشكالا أخرى من السرد، كانت في جانب منها نوعا من رد الفعل ضد الإنجاز الهائل لجارسيا ماركيز.
ولذا فان أهم كتاب الجيل الجديد ، روبرتو بولانو، لم يتردد في إعلان الواقعية السحرية «عفنة»، وسخر من شهرة ماركيز بوصفه «رجل يستمتع استمتاعا كبيرا بصحبة العديد من الروساء والاساقفة”.
لقد كانت هذه بمثابة “فورة” صبيانية، لكنها تعكس كيف كان العديد من كتاب أمريكا اللاتينية ينظرون الى وجود هذا العملاق وما يشكله من عبء ليس بقليل بالنسبة لهم.
قال لي كارلوس فوينتيس (روائي وعالم اجتماع مكسيكي) ذات مرة : «لدي شعور أن الكتاب في أمريكا اللاتينية لا يمكنهم استخدام كلمة «عزلة» مرة أخرى؛ لأنهم يشعرون بالقلق من أن الناس سوف يعتقدون أنها إشارة الى “جابو”.
وأضاف فوينتيس بخبث : «أخشى أننا لن نتمكن قريبًا من استخدام جملة 100 عام أيضًا».
لا يوجد كاتب آخر في العالم كان له تأثير مشابه لتأثير ماركيزطوال النصف الثاني من القرن الماضي. “إيان ماك إيوان” قارن وعن حق تأثيره بتأثير تشارلز ديكنز. فلا يوجد كاتب منذ ديكنز مقروءًا على نطاق واسع ومحبوبا بعمق مثل جابرييل جارسيا ماركيز.
وقد تضع وفاة هذا الرجل العظيم نهاية لقلق كتاب أمريكا اللاتينية من نفوذه، وقد تسمح بتقدير أعماله بعيدا عن مشاعر المنافسة.
فقصصه هى قصص عن أشخاص حقيقيين، وليست قصصا خيالية. و”ماكوندو” موجودة، وهذا هو مصدر سحرها.
إن الاشكالية في مصطلح «الواقعية السحرية» تكمن في إنه عندما يقولها الناس أو يسمعونها فإنهم يسمعون أو يقولون نصفها فقط «السحر»، دون الالتفاف إلى النصف الآخر «الواقعية».
إن كانت “الواقعية السحرية” ليست إلا مجرد سحر، لكانت دون أهمية. ولكانت الكتابة مجرد نزوة لان أى شئ قد يقع دون أن يحدث تأثيرا.
ولكن “الواقعية السحرية” لها تأثير لأن السحر بها له جذور عميقة في الواقع، ولأنه يخرج عن إطار الواقع ويتعداه ويضيئه بوسائل جميلة ومدهشة.
الواقعية السحرية ليست اختراع جارسيا ماركيز، فقد سبقه البرازيلي ماشادو دي أسيس، الأرجنتيني بورجيس والمكسيكي خوان رولفو.
ماركيز درس تحفة رولفو الفنية « Pedro Páramo » جيدا، وكان تأثيرها عليه مماثل لتأثير « Metamorphosis » لكافكا.
(في كومالا، مدينة الأشباح الموجودة في الرواية، يمكن بسهولة رؤية بذور ماكوندو).
فالواقعية السحرية غير قاصرة على أمريكا اللاتينية. فهى تظهر من وقت لأخر في جميع أدبيات العالم. غيرأن ماركيز كان مقروءًا بشكل كبير. وشكل هو و ديكينز سادة الإغراق الكوميدي.
فمكتب ديكنز الحكومي الذي لايؤدي أى عمل، يسكنه الواقع الخيالي نفسه الذي يسكن جميع حكام وطغاة ماركيز بما فيهم من تراخ وفساد واستبداد.
كما أن شخصية “جريجور سامسا” لكافكا، والتي تحولت إلى حشرة كبيرة، لها مكان طبيعي في ماكوندو، حيث التحولات أمر شائع.
وشخصية كوفاليوف لغوغول، تلك الشخصية التي تفصل الأنف فيها نفسها عن الوجه وتتجول في سانت بطرسبرج، لن تشعر ايضا بالغربة في ماكوندو.
إن السرياليين الفرنسيين ومؤلفي الخرافات الأمريكيين هم أيضًا جزء من هذه الشركة الأدبية المستوحاة من فكرة “خيالية الخيال”، فكرة تحرر الأدب من حدود الطبيعية، وإقترابه من الحقيقة بأساليب أرحب وأكثر إثارة.
كان ماركيز يعلم جيدًا أنه ينتمي إلى عائلة أدبية “خاصة جدا “. نقل عنه وليام كينيدي قوله «في المكسيك، توجد السيريالية في الشوارع» .
ولكن، أقول مجددًا: شطحات الخيال تحتاج أن تقوم على أرضية من الواقع.عندما قرأت جارسيا ماركيز للمرة الأولى لم أكن قد ذهبت مطلقًا لأمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية.
ومع ذلك، وجدت في صفحاته واقعية أعرفها جيدًا من تجربتي الشخصية في الهند وباكستان.
في أعمال ماركيز كما في الهند وباكستان، كان ولايزال هناك صراع بين المدينة والقرية، وهناك هوة واسعة بين الغني والفقير، بين القوي والضعيف، وعظيم الشأن وصغيره.
كلاهما مكان له تاريخ استعماري عريق، وفي كلاهما يحتل الدين أهمية عظمى. وفي كلاهما “الرب” موجود وكذلك وللاسف من يتحدثون باسمه.
عرفت “كولونيلات” و”جنرالات” جابرييل جارسيا، أو على الأقل نظراءهم من الهنود والباكستانيين. أساقفته كانوا “الملالي” الذين عرفتهم وأسواقه كانوا “بازارات مدينتي”.
لقد كان عالمه عالمي مترجمًا إلى الأسبانية. فلا عجب أنني وقعت في حبه، ليس لسحره (على الرغم من أنني ككاتب نشأت على الحكايات السحرية الرائعة للشرق) وإنما لواقعيته.
ومع ذلك، فعالمي كان عن الحضر بأكثر من عالمه. وبالتالي فإن روح القرية هي التي تمنح واقعية ماركيز نكهتها الخاصة، قرية تخيف فيها التكنولوجيا، ومع ذلك فان صعود فتاة الى السماء هو أمر طبيعي للغاية. قرية ككل القرى الهندية، تمتلأ بالمعجزات التي تتعايش مع الحياة اليومية.
لقد كان ماركيز صحفيًا لم يغفل يوما ما عن الحقائق. كان ماركيز حالما يؤمن بأن الاحلام حقائق. وكان ماركيز كذلك كاتبا قادرا على إبداع لحظات من الجمال الذي يفوق الخيال ملئ في معظم الأحيان بالكوميديا.
في بداية روايته «الحب في زمن الكوليرا» كتب :« رائحة اللوز المركانت تذكره دائمًا بمصير الحب من طرف واحد».
وفي قلب «خريف البطريرك»، بعد أن يبيع الديكتاتور منطقة بحر الكاريبي إلى الأمريكان، يحمل المهندسون الامريكان الكاريبي في اجزاء ليزرعوه في اريزونا. يأخذونه بكل ما فيه.
يصل أول قطار الى ماكوندو، وتصاب إمرأة بحالة من الرعب الشديد. وتبدأ في الصراخ :”هاهو آت. شئ مخيف وكأنه مطبخ يجر وراءه قرية”.
وبالطبع هذا المقطع الذي لا ينسى:
“قاد الكولونيل اوريليانو بوينديا اثنتين وثلاثين إنتفاضة خسرها كلها. وكان له سبعة عشر إبنا من سبع عشرة إمرأة قضوا كلهم الواحد تلو الاخر في ليلة واحدة ولم يبلغ أكبرهم الخامسة والثلاثين. نجا من أربع عشرة محاولة إغتيال وثلاثة وسبعين كمينا ومن نيران كتيبة. كما نجا من جرعة من السم في قهوته كانت كفيلة وحدها بالقضاء على حصان”.
أمام مثل هذه الروعة، لايسعنا الا الشعور بالامتنان. فهو كان أعظمنا بلامنازع.
خجل ماركيز/ سعدية مفرح
رحل، إذن، أحد أشهر أصدقاء الثقافة العربية، المولعين بسحر موروثها الأدبي، من دون أن ندعوه لزيارة بلاد العرب، أو نقدم له، أو باسمه، مهرجاناً أو فعاليةً أو جائزة، على كثرة مهرجاتنا الثقافية وفعالياتنا الثقافية وجوائزنا الأدبية واحتفالاتنا القومية، في طول البلاد العربية وعرضها.
رحل غابرييل غارسيا ماركيز، فلم ينعه زعيم عربي واحد، وربما لم يقرأ أحد منهم سطراً من سطور رواياته العظيمة التي فاقت شهرتها شهرتهم أجمعين، وفاق أثرها أثر أعمالهم، بأنواعها، على العالم، مجتمعين.
تعليقاً على خبر رحيل هذا الروائي الأشهر في العالم، الأسبوع الماضي، كُتبت عدة تغريدات احتفائية به، وردت في واحدة منها عبارة لماركيز من بيانه الشهير، والذي نشره في موقعه الإلكتروني في العام 2002، تأييداً منه للقضية الفلسطينية، وتعليقاً على أخبارٍ راجت، كما يبدو، آنذاك، عن نيّة مؤسسة نوبل منح جائزتها للسلام في ذلك العام لأرييل شارون. العبارة: “أُعلن عن إعجابي غير المحدود ببطولة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الإبادة، على الرغم من إنكار القوى الأعظم، أو المثقفين الجبناء، أو وسائل الإعلام، أو حتى بعض العرب لوجوده. بشكل منفرد إذن، أنا أوقّع على هذا البيان باسمي: غابرييل غارسيا ماركيز”.
ومع انتشار تلك التغريدة في أجواء “تويتر” يومها، وجدت مَن شكّك بها، أو بنسبة تلك العبارة إلى ماركيز، حتى إن أحد المتابعين طالبني برابط إلكتروني لبيان ماركيز، باللغة الإسبانية أو الإنكليزية بالذات، “حتى نتأكد من صحته، وأنه ليس ملفّقاً من قبل القومجيّة”، كما كتب ذلك المتابع حرفياً.
ليس البيان ملفقاً من “القومجية”، بل هو معروف ومنشور، وبأكثر من لغة فعلاً، إلا أنني ألتمس العذر لكل مَن شكّك به، أو حتى استغربه. فكثيرون من القراء، الشباب، لا يعرفون ماركيز إلا من رواياته المترجمة إلى اللغة العربية، وفيها، لم يرشح موقف ماركيز بوضوح من القضية الفلسطينية، على الرغم من انحيازه المبدئي، روائياً، في كل ما كتب، لكل القضايا الإنسانية، ومنها قضية العرب الأولى، بالإضافة الى إشاراتٍ كثيرةٍ بثّها بين ثنايا ما كتب عن تأثّره بالحضارة العربية عموماً، ولو من خلال بعض أسماء شخصياته الروائية الساحرة.
كان ماركيز قد تسلّم جائزة نوبل للآداب في 1982 عندما نشر، في صفحة اشتراها إعلاناً مدفوع الثمن، من إحدى صحف الإكوادور، بيانه الشهير الذي ندد فيه بمجزرة صبرا وشاتيلا بأقسى العبارات، وبأوضح الكلمات، ومن دون خشية من أحد ممّن يسيطرون على مسرح الإعلام العالمي.
وعلى الرغم من أن السنين، والأحداث التي جرت في إهابها، طوال ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، غيّرت مواقف كثيرين من غير العرب، بل ومن العرب أنفسهم، تجاه القضية الفلسطينية، إلا أن مواقف صديقنا “غابو” لم تتغيّر إلا وضوحاً مضطرداً تجاه هذه القضية تحديداً. ففي العام 2002، عندما أعاد الصهاينة احتلال مدن فلسطينية في الضفة الغربية مجدداً، بعد مذابح بشعة تعرّض لها سكان تلك المدن، كرّر الروائي العظيم كتابة بيانه القديم بصورة أخرى. وعندما أراد نشره، لم يجد وسيلةً إعلاميةً واحدةً من الوسائل التي طرق أبوابها ترحّب ببيانه، لا كمادة تحريرية، ولا كإعلان مدفوع الثمن، خوفاً من أية ملاحقات قضائية متوقعة من إسرائيل. فلم يكن أمام سيّد الواقعية السحرية من بد سوى اللجوء إلى ما بدأت التكنولوجيا توفيره للكتاب وغيره، من وسائل سحرية للنشر الحر. يومها، نشر بيانه على موقعه في الإنترنت، بالإنكليزية والإسبانية، بعنوان موجع: أوقّع هذا البيان منفرداً.
لم يذهب بيان ماركيز المنفرد أدراج التجاهل والنسيان، فقد تُرجم إلى لغات عديدة، وتناقلته مواقع الإنترنت بحماسة، ثم نشر باللغة العربية في صحيفة “العربي” المصرية، ترجمة أحمد يونس. وكان أثره الأكبر قد ظهر بتداعي بعض زملاء ماركيز، من كتّاب العالم الكبار، للتوقيع عليه، لكي لا يبقى كاتبه منفرداً، ثم ذهبوا إلى أبعد من مجرد التوقيع عندما شكلوا وفداً، ضم أسماء أدبية كثيرة شهيرة، كالنيجيري وول سوينكا، والبرتغالي ساماراغو، الذي زار الأراضي العربية المحتلة، مبدياً تعاطفه مع القضية الفلسطينية، ومعيداً لها بعض وهجها المفقود عالمياً.
يبيّن البيان حجم خسارتنا، نحن العرب، برحيل غابرييل غارسيا ماركيز، الكاتب الكولومبي الذي آمن بقضيتنا العربية، كما لم يفعل بعضنا، فقط لأنه آمن بالحق وبالحقيقة. ويستحق البيان الخالد أن نهديه لكل “المستثقفين” العرب الذين تخصصوا، في الأونة الأخيرة، بشن الحروب الخاسرة حتماً، ضد الحق والحقيقة.
العربي الجديد
غابرييل غارسيا ماركيز.. الكتابة والمرض والواقعية السحرية
اسكندر حبش
لا شك، فقد العالم الأدبي والثقافي، وجهاً بارزاً من وجوهه الكبيرة، التي لن تنسى. رحل غابرييل غارسيا ماركيز، تاركا وراءه العديد من الكتب التي ستبقى وراءه. يرحل الكاتب، ماديا، جسديا، لكن قد يبدو العزاء الوحيد، أن كتبه تعيش أكثر منه، وتبقى من بعده، وتخبر الأجيال المقبلة عن مروره في الأرض.
لكن الكتابة أيضا، هي أحيانا عادات وتفاصيل يومية، من هنا فكرة هذا الحوار المترجم مع الكاتب الكولومبي الراحل، الذي تم إعداده من ثلاثة حوارات مختلفة أجريت مع الكاتب، في أزمنة متفرقة، في كل من «لوموند» و«لو فيغارو» و«باري ماتش»، اخترت منها، كل ما هو متعلق بتفاصيل طريقة الكتابة، لأقدم من خلالها لمحة عن العادات اليومية التي كان يعتمدها ماركيز في الكتابة.
كذلك يتضمن هذا الملف الصغير عن ماركيز، ترجمة للمقالة التي كتبها الكاتب الروسي أوليغ شيشكين الذي كتبها غداة وفاته، والتي يتحدث فيها عن اكتشاف ماركيز وعن حلمه برؤيته، وهو حلم لم يتحقق.
أما الجزء الأخير فهي مقالة للناقد والكاتب وليام كينيدي، يدافع فيها عن الواقعية السحرية، وعن ماركيز تحديدا، معتبرا أن رواياته لم تكن فقط روايات ساحرة ورائعة بل هي روايات متفردة أسست لأسلوب وعالم خاصيْن.. وهي مستلة من «النيوزويك» التي طرحت قبل سنوات سؤالا حول «هل ماتت الواقعية السحرية»، وكانت إجابات عديدة، مع وضد السؤال، وقد اخترت ما له علاقة بماركيز مباشرة.
«العذاب هو أن لا أكتب الحب، أيديولوجيتي الوحيدة»
÷ بدأت العمل كصحافي في قرطاجنة؟
} أجل، كنت في العشرين من عمري، حين وصلت من بوغوتا. تقدمت من الصحيفة المحلية هناك، «إل يونفرسال». قلت للمسؤولين، إنه سبق لي أن كتبت بعض الحكايات وأرغب في أن أصبح صحافيا. أجلسني أحد رؤساء التحرير خلف آلة كاتبة كي أحرر خبرا. قرأ السطر الأول. شطب كلّ شيء. جعلني أعيد الكتابة من البداية. وبعد أن انتهيت، أعاد تصحيح كل ما كتبته، لكن وبالرغم من ذلك نشر ما كتبته. على مرّ الأيام، بدأ يشطب بشكل أقل، حتى اليوم الذي لم يعد يشطب فيه أي كلمة. هكذا أصبحت صحافيا.
÷ بالنسبة إليك لا تزال الصحافة «أجمل مهنة في العالم»؟
} أعمل في هذه الأيام على كتاب يحمل هذا العنوان. لن يتقبله الصحافيون، بيد أن الصحافة هي نوع أدبي مستقل، مثلها مثل المسرح والرواية والشعر.
÷ هل ينطلق الكاتب النجم أحيانا للقيام بتحقيق حاملا معه قلمه ودفتر ملاحظاته؟
} مؤخراً، رغبت بتحقيق مشروع عزيز على قلبي كثيرا، ويتمثل في أن أذهب متنكرا إلى قرية صغيرة أكل أهلها خبزا مسموما سبب بمرض السكان كلهم. رغبت في الذهاب لأكتب قصة هؤلاء الناس. لكني تيقنت سريعا أنه في اليوم الثالث ستذهب الصحافة الكولومبية بأسرها إلى هناك وبأني سأكون أنا موضوع التحقيق الصحافي.
÷ يقول أصدقاؤك بأنك تعتبر الكتابة مثل عملية التنفس، أي أنها حاجة حيوية؟
} هذا صحيح، إنها الشيء الوحيد الذي أفضله في العالم. لا شيء يمنعني من الكتابة. الكتابة تحتل جميع أفكاري.
÷ كم هو الوقت الذي يمكن لك أن تمضيه من دون كتابة؟
} لا أكثر من يوم واحد، مطلقا. لا أرتاح أبدا بين كتابين. ما أن أنهي كتابا، أجدني بحاجة لأن أبدأ بواحد آخر رأسا، إذ أجد أن يديًّ «ساخنتان» في تلك اللحظة. إن تركتهما تبردان، فلن يكون الأمر جيدا. إذ عليّ حينها أن أعود لتعلم الكتابة.
÷ ماذا تفعل كي ترضي نهمك الضاري للمعاجم؟
} في فترة من الفترات، كنت امضي يومي في قراءة «الموسوعة البريطانية» متنقلاً من مادة إلى مادة، وأنا مسحور. يتطلب ذلك وقتا كبيرا من اجل إيجاد كلمة واحدة. الآن، لا ابحث في القواميس إلا بين السادسة والثامنة مساء، إنها ساعات مجردة.
÷ وما هي الساعات المجازية؟
} تبدأ عندما استيقظ. في الخامسة صباحا، أصحح ثلاث أو أربع صفحات، موضوعة على طاولة العمل. في الماضي كنت أقوم بذلك قبل أن أنام. كان الأمر سيئا. كنت استمر في العمل وأنا نائم، استيقظ منهكا لأني صححت الليل بأكمله. حاليا احتفظ بالأوراق للفجر، ما عدا الأيام التي أسافر فيها.
÷ يعني أنت كاتب صباحي؟
} أجل، أنهض كل يوم الخامسة صباحا وأقرأ لمدة ساعتين. أقوم بذلك، في هذه الساعة، لأني بقية ساعات النهار، لن يكون لدي الوقت. بعامة، أصحح ما أكون قد كتبته قبل يوم. لا أعيد قراءة ما كتبته أبدا في المساء، فلو فعلت لما استطعت النوم بهدوء. إذ أستمر بالتفكير في ذلك خلال غفوتي.
÷ نسيت أن تشير إلى أهمية «الدوش» في إبداعك الفني..
} آه أجل، «الدوش» (يضحك). تأتيني الأفكار تحت الماء. إنه المكان الذي أجد فيه الوحي. ومع ذلك، سألني مؤخرا، أحد صحافيي «الواشنطن بوست» عن المدة القصوى التي أقضيها تحت مياه الدوش، فأجبته «عشر دقائق»، فظهرت خيبة الأمل على وجه الصحافي الأميركي.
÷ أنت اليوم في السادسة والستين من عمرك، وما من مرة ظهرت بهذا النشاط كما أنت عليه اليوم: رواية كل ثلاث سنوات، مذكرات، أبحاث في طور التحضير. لمَ هذا التدفق؟
} لأني بدأت أكتب على «الكومبيوتر».فيما مضى، كان يلزمني سبع سنوات لكل كتاب. كنت أضيع وقتا هائلا مع الآلة الكاتبة. اليوم، تكفيني ثلاث سنوات.
÷ ألا يلعب العمر دورا في ذلك؟
} لا أعرف. بأي حال، حتى لو عشت بعد مئة سنة أخرى، فإن ذلك لن يكفي لكتابة كل ما أرغب في كتابته. وهذا أكثر ما يحزنني.
÷ يشكل الحب الموضوع المركزي في أعمالك. أي مكانة يحتلها في حياتك؟
} إنه الأمر الأهم في العالم، الشيء الأهم في الحياة. غالبا ما رددت: الحب هو إيديولوجيتي الوحيدة.
العمر والمرض
÷ كيف تنظر إلى الشيخوخة؟
} ثمة أمر غريب أجده: حين أعيد قراءة أعمالي السابقة، وحين أجد أني أكتب عن «عجوز»، غالبا ما أجد أنه أكثر شبابا مني اليوم. لذلك، أضاعف الآن عمر «العجوز» في رواياتي الحالية.
÷ ما كانت عليه ردة فعلك، قبل سنتين، حين أعلن الأطباء أنهم وجدوا لديك ورما سرطانيا؟
} اعتبرت دائما، أنه في حالة مماثلة، سأشعر بالهلع وبأن علي أن أخفي الأمر عن عائلتي كي أتمكن من الاستمرار بالعيش بطريقة بريئة. حين اكتشف الأطباء «حبة العدس» هذه الصغيرة على رئتي وحين طمأنوني بأنها لن تكبر وتتسع أبدا، رغبت أن أعرف كل شيء عن الأمر. اتخذت القرار بإجراء العملية الجراحية. لقد تحكمت بحياتي.
÷ هل توقفت عن العمل؟
} لوقت قصير جدا. كنت يومها قد سلمت الناشر مخطوط كتابي «12 قصة تائهة». بعد 15 يوما من خروجي من المستشفى عدت إلى الكتابة.
÷ هل أثر المرض على حياتك وعلى وحيك الكتابي؟
} أصبحت أكثر استعجالا عما ذي قبل. كنت معتادا على القول: «يمكن أن أقوم بذلك بشكل أفضل بعد عشرين أو ثلاثين سنة». أعرف اليوم بأنه، حتى لو عشت بعد مئة سنة أخرى، فإنه لن يكون لدي الوقت للقيام بكل ما أريد أن أقوم به. إلا أنني أحاول التخلص من هذا الشعور. إذ، في كل عملية إبداعية، لا بدّ أن نلاحظ الاستعجال سريعا.
÷ لا نعرف إن كان علينا أن نشعر بالأسف لقلة نتاجك (أربع روايات منذ جائزة نوبل عام 1982) أو أن نغتبط بروايتك وأنت تنشر على الرغم من هذه الحياة التي تحياها…
} فكرت وأنا أتسلم جائزة نوبل بتلك اللعنة التي تلاحق هؤلاء الفائزين لعدم وجود الوقت لديهم كي يبدعوا. حاولت كل جهدي ألا أكون سجين الشهرة والنجاح والسياسة أيضا. إن مئة شخص لن يستطيعوا تلبية الدعوات والالحاحات، التي توجه اليّ والتي من الصعب رفضها دائما. لا اخضع إلا لقاعدة واحدة: لن تجدوني صباحا في أي مكان. اكتب كل يوم قبل الغداء.
÷ ما هي علاقتك بالطائرة؟
} كنت أخشى الطيران دائما. انه خوف لم اشفَ منه. ومع ذلك أسافر كثيرا، لا بسبب الشجاعة وإنما لأنني وجدت الوسيلة كي لا أفكر في خوفي. أصرف وقتي بالعمل الذي يأخذني أكثر: إعادة القراءة والتصحيح. في الأيام التي تسبق رحيلي، لا أصحح أوراقي أبدا. فأنا احتفظ برزمة جيدة كي أجد الوسيلة لأشغل نفسي. أتذكر رحلة، من مكسيكو إلى فرانكفورت، حيث أمضيت 7 ساعات وأنا أصحح من دون فترة استراحة واحدة «عن الحب وشياطين أخرى».
÷ يتراءى وكأن ذلك ذكرى سعيدة؟
} إن أخلاقيتي بصفتي كاتبا، هو النقد الذاتي تجاه عملي. إنني أجد لذة حقيقية وأنا أصحح نفسي.
÷ وحين تكتب؟
} بالنسبة إلي، الأمر سهل. اكتب حين يكون عندي قصة متكاملة. كذلك أنا في حاجة إلى إيجاد اسم كل شخص قبل أن ابدأ. وثم يتقدم كل شيء بسهولة، بلا تعقيدات، حتى نقطة النهاية. وعندما امسك بقصتي، استمر في العمر، بالتناوب. أحيانا اعمل على الإيقاع، وأحيانا على اللغة. وفي موازاة ذلك هناك اختفاء لجميع الشكوك النحوية. إن التصحيح مهمة لا تنتهي.
÷ ولكي تنشر، عليك الانتهاء من تصحيح مخطوط ما؟
} عليك الانتهاء من جميع حالات (روايات) النص المتلاحقة. إن جهاز الكومبيوتر يعطينا الاحتمال في أن يكون لدينا كل يوم مخطوط أصلي. إذاك، أمزق وأمزق. إن الذي يعمل عندي بشكل أكثر، ليس الستيريو أو التلفزيون، وإنما آلة تمزيق الورق. تجبرني زوجتي ميرسيدس على الاحتفاظ بالروايات المصححة من اللحظة التي أصل فيها إلى شيء متكامل. لدي 11 رواية مختلفة «عن الحب وشياطين أخرى». ثمانية على صعيد المخطوط و3 خارجة من الطابعة. لكنني شفيت قليلاً من إلحاحي الماضي. في فترة من الفترات كنت أظن انه لا ينبغي وضع نقطة بالطريقة ذاتها حين كانت تأتي ببساطة في الجملة، وحين كانت تسبق العودة إلى السطر. لقد ارتحت من ذلك. وبخاصة في هذه الأيام حيث اكتب كتابا على شكل تحقيق صحافي.
÷ هل يبدو الأمر أسهل؟
} ثمة خمول طبيعي يأخذك في الصحافة. عليك إن تبقى ناقدا في مواجهة المعلومات، منتبها إلى المواد. انه نوع أدبي أسهل من القص، مع متطلبات أسلوبية اقل، مع متطلبات إبداعية اقل. وبشكل مخالف، نستطيع استعمال كل مصادر القص. وكما دائما، لم أقرر أن اكتب هكذا: إن حجة الكتاب هي التي تحدد الأسلوب الضروري. إن مهمة الكتاب الذي يرى أسلوبا فرض نفسه، أن يكمله إلى النهاية. إن كتاب «خريف البطريرك» لم يكتب أبدا مثل «وقائع موت معلن». أن أقوم بكتابة صحافية، فذلك يطهرني. إن هوسي بالكمال يؤدي بي نحو المرض.
البنية
÷ أتتخيل لذة في الكتابة بعيدا عن أي بنية؟
} ليس بالنسبة إلي. إن أصعب شيء قبل الكتابة، ليس عدم وجود قصة وإنما إيجاد بنية القصة. إنني أتألم كثيرا في بحثي هذا. لا زلت متأثرا لغاية اليوم باكتشافي «اوديب ملكا» لسوفوكليس. إنها حلم كل كاتب: قصة تدور حول تحرٍ يتقصى، ويكتشف في النهاية انه هو القاتل. إنني أبقى، حتى نهاية الكتابة، مهووسا ببنيته. ونستطيع التحقق من ذلك: في كتبي، كل فصل يمتلك تقريبا عدد الصفحات ذاتها. إنني مخول أن انقل عنصرا من طرف إلى آخر، فقط كي أحافظ على هذا التوازن.
÷ تنتمي إلى جيل عرف كل أنواع أدوات الكتابة، من الريشة إلى الكومبيوتر.
} ولا اعتقد أن مهنة الكاتب تغيرت، بمرورها من القلم إلى الريشة، ومن الآلة الكاتبة الميكانيكية، ومن بعدها الكهربائية، ولغاية الكومبيوتر. صادفني الحظ بوصول الكومبيوتر في اللحظة التي كنت في خطر فقدان سيطرتي على إبداعي. كانت ايفلين فوغ، في نهاية حياتها، تخشى ألا تكتب رواية خشية ألا تتذكر كل كلمة في المخطوط الذي كانت تكتبه وعلاقة هذه الكلمة بجميع الكلمات الأخرى، هنا يساعدني الكومبيوتر…
÷ تدور أحداث جميع كتبك في الكاريبي باستثناء 12 قصة.
} ولماذا البحث عن مكان آخر؟ نجد فيه كل شيء. لأستدعي الكاريبي، لا استطيع أن أفكر إلا في تلك اللحظات، في طفولتي، حيث كانوا يبحثون عن جسد غريق. كانوا قد وضعوا شمعة مشتعلة في نصف قرعة فوق البحيرة.
أتذكر ذلك، كنت في السابعة. تبعت مع القرية كلها، ومن الضفة، الشمعة التي كانت ترقص من ضفة إلى أخرى، على الماء. انتهت في أن بدأت تدور فوق نقطة محددة. كان الغريق موجودا هنا. سحبوه من الماء كسمكة ضخمة. اعتقد أن الكاريبي اليوم، هو هذه النقطة حيث توقفت الشمعة، نجد فيه كل شيء.. نجد فيه الخلاسيين والسود والصينيين والعرب والأوروبيين، وعمال قناة باناما..
÷ والأوبئة أيضا.. مثلما تقول؟
} أحببت الأوبئة دائما. إنها تمزج التراجيديات الكبرى والعربدة، في المقابر. هذا صحيح، هناك وباء النسيان في «مئة عام من العزلة»، الطاعون في «الجدة الكبيرة» والكوليرا في «الحب في زمن الكوليرا». أريد أن أوقف هذه الأمراض الممزوجة بالحب..
÷ والحب أيضا..؟
} كلا، سأحتفظ به، انه محرك كتبي، حجتي الوحيدة، وايديولوجيتي الوحيدة..
سمات الجرح الخارق/ أوليغ شيشكين
بدأ تعرفي الشخصي على أدبه العام 1977. كنت في الثالثة عشرة من عمري، وكانت والدتي استعارت من مكتبة المستشفى الذي تعمل به، ولمدة أيام قليلة فقط، مختارات من أعمال ماركيز الصادرة ضمن سلسلة «أسياد النثر المعاصر». أكببت على الكتاب بشراهة. وتتوجب الإشارة هنا، أنه في عهد الاتحاد السوفياتي، كانت الكتب الجيدة موضوعة على لائحة الأشياء الثمينة التي كان الناس يذهبون لاصطيادها، سرقتها.
ها أن ماركيز يرتاح على طاولة مكتبي. لقد أصبحت روائح شتول البن والموز كما المطر المنهمر بدون توقف من صفحات «مئة عام من العزلة» بالنسبة إلي كما بالنسبة إلى كثيرين غيري، وللأبد، جواز مرور باتجاه أرض السحرة وأرض الانقلابات العسكرية.
فتح لنا ماركيز باب الواقعية السحرية. كان يملك هو نفسه، في داخله، شيئا إكزوتيكيا كاملا، غير مسمى، وفي الوقت عينه، يملك سمات جرح خارق، وبصمة أليمة خاصة، ما يحيل الأدب، بالضبط، إلى أدب كبير. آه، لرومنسية الشباب، لحلم هذه البقعة البعيدة التي تعيش وفق قواعدها الخاصة! كنت أرغب في أن أكون في ذلك العالم، رغبت في رؤيته، إلا أنني لم أكن أفهم جيدا، بأن بلدي «الاتحاد السوفياتي كان فخا كبيرا بالنسبة إلى الذين ولدوا فيه. وبأنني لن أرى كولومبيا، بلاد ماركيز. إذ لم يكن يستطيع السفر إلى الخارج إلاّ قادة الحزب الشيوعي وعملاء الكي. جي. بي، ولم أكن أنتمي إلى هاتين الفئتين.
بيد أن الحياة تغيرت، ففي نهاية الثمانينيات (من القرن الماضي) حين أصبحنا أكثر حرية في التنفس، جاء ماركيز إلى روسيا من أجل مهرجان سينمائي (كان ذلك في العام 1987). جاء بشرط أن يلتقي بغورباتشوف وأن يتحدث معه، ومن بعدها ذهب الكاتب إلى صالة سينما «اوكتوبر»، حيث كان سيتم العرض الما قبل الافتتاحي لفيلم تاركوفسكي «نوستالجيا».
يروي كاتب سيرته الروسي، سيرغي ماركوف، القصة التالية: «كان الفيلم قد بدأ. ولماركيز تلك العادة الدائمة: أن يصل متأخرا، كي يصفقوا له. بيد أنه شعر بالضياع في تلك اللحظة، فأحس بالانزعاج ورحل». كنت حاضرا ذاك العرض، إلا أني لم أشاهد ماركيز. بيد أني أعرف قصة خطابه الذي لم يلقه، من فم صديقي وأستاذي ألكسندر كايدانوفسكي.
أذكر بأني رأيت، وأنا خارج من صالة السينما، كايدانوفسكي وهو على درجات قاعة «اوكتوبر». كان يسير ذهابا وإيابا ويدخن بعصبية.
ـ هل حدث شيء ما؟ سألته
ـ هل تعرف، لقد رفض ماركيز بصراحة أن يتحدث وأن يقول ولو كلمة واحدة عن أندريه! عن تاركوفسكي! لقد أصبح، ماركيز هذا، بالنسبة إليّ، شخصا نتنا.
شتم كايدانوفسكي ماركيز ورحل. وبأي سخط! لقد رفض الكاتب الشهير أن يقول أي كلمة إيجابية حول أستاذ كايدانوفسكي، وهذا ما بدا له أمرا قاضيا.
الشيوعي
لكن، في الواقع، ما الذي كان يمكن لماركيز أن يقوله؟ كان رجلا ذا قناعات يسارية، وصديق الاتحاد السوفياتي، ومتسامحا تجاه ستالين، حتى أنه زار «المزار» (الضريح) الذي كان لا يزال «يرتاح» (يرقد) فيه هذا الأخير. كان مختلفا جدا. كان شيوعيا حقيقيا. ربما من نوع الشيوعيين الذين يمثلهم فيديل كاسترو الذي كان صديقه طيلة عمره. بينما كان تاركوفسكي يعتبر نجما معاديا للسوفيات، وماركيز، وهذا أمر بديهي، لم يكن يرغب في الحديث عنه.
وهنا تكمن المفارقة. كان كاتبا معترفا به في العالم. وحين تناقشت، قبل سنة، مع أحد الأصدقاء الذين يعملون في مجال الكتاب، قال لي بابتسامة: «هل تتخيل يا أوليغ، مستوى المكتبات اليوم في موسكو؟ أنظر مثلا في فهرست مكتبة الحي، لن تجد كتابا واحدا لماركيز! لكن وبخلاف ذلك، تجد في هذا الفهرست شخصا يدعى «غابرييل غارسيا، كاتب». ما سمعته كان غريبا ومزعجا. بيد أنه يمكن للأمر، أن لا يكون مهما جدا، في الواقع، معرفة كيف نسمي كاتبا، بل يكمن الأهم في أمر آخر، ومن بعيد: كيف قرأنا هذا الكاتب. لقد قرأنا ماركيز منذ أكثر من نصف قرن. وهذا زمن قصير جدا بالنسبة إلى الأدب الحقيقي! لكننا نعرف جيدا، أنه في اللحظة التي يُقرأ فيها الكتاب فإن «المدينة الشبح ستحمل من على وجه البسيطة، بإعصار، وستُمحى من ذاكرة الناس».
يضع الزمن نهاية الكائنات البشرية. لقد أغلق أيضا على حياة غابرييل غارسيا ماركيز، إلا أن كتبه بقيت مفتوحة. إنها تتحدث نيابة عن الكاتب، حتى أنها تتحدث عن مبدع «رواية الأرض» الذي غطس في صمت أبدي وحين أصبح جزءا من الأرض المغلقة.
السوريالية تخرج من واقع أميركا اللاتينية/ وليام كينيدي
بلغني للتو نبأ موت الواقعية السحرية. لقد قام أبناء هذا النوع الأدبي الذي جعل الرواية اللاتينية الأميركية شعبية مثل المامبو (= نوع من الرقص السريع) باغتياله. هل فوتّ عليّ فرصة ذلك؟ هل علينا القيام بسهرة حول الموتى؟ أيعني ذلك أن غابرييل غارسيا ماركيز قد دخل إلى الجنة وهو يحمل بين ذراعيه روايته الكبيرة «مئة عام من العزلة» بالطريقة ذاتها، التي صعدت فيها بطلته ريميديوس الجميلة، إلى السماء وهي حاملة شراشف السرير؟
إن أشهر كاتب قام بجريمة قتل أبيه يدعى ألبرتو فوغيه. فهذا الكاتب الأميركاني الشيلي قام في العام 1996 بإبدال ماكوندو قرية غارسيا ماركيز الخيالية بمدينة ماك أوندو. وهو يعتقد أن الموضوع القديم حول هوية أميركا اللاتينية. من نحن؟ قد تخطاه الزمن. إذ إن الموضوع الراهن يكمن في السؤال التالي: من أنا؟ انه مخرج للملحمة الجماعية: فجيل ماك أوندو يناضل من أجل الواقع الوسخ ومن أجل موطئ قدم للأفراد.
الواقعية السحرية
بحسب علمي، ولدت عبارة «الواقعية السحرية» تحت ريشة أنخل فلوريس، الأستاذ في «جامعة كوينز كوليدج» في نيويورك. لقد استعملها للمرة الأولى في محاضرة ألقاها في نيويورك العام 1954. باختصار، كان يعتقد بأن الحركة هذه بدأت بالتشكل بعد الحرب العالمية الأولى، بفضل بعض الفنانين من أمثال الكاتب فرانز كافكا والرسام جورجيو دوكيريكو، اللذين تأثرا بمن سبقهم وكانا أيضا على درجة كبيرة من الشهرة والحضور كغوغول وإدغار ألن بو وهيرمان ملفيل وسترندبرغ. لقد أشار (فلوريس في محاضرته) إلى تأثير كافكا على بورخيس، كما يتبدى في قصته «قصة الجوع العالمي» التي صدرت العام 1935، وهي من حدد بداية هذا الاتجاه في أميركا اللاتينية: «لقد تحلق حول بورخيس، بصفته رائدا (…) مجموعة من الكتاب ذوي الأسلوب البراق (…) وقد اتجهوا صوب الواقعية السحرية». ورأى المحاضر في ذلك، التحول من المألوف واليومي إلى فضاء مدهش، غير واقعي متفتح بطريقة رائعة، ونتمنى لو استمر إلى الأبد.
في الستينيات، انفجر نتاج ورثة هذه الحركة الأدبية الأميركية اللاتينية، عبر روايات على قدر كبير من الجودة. لقد أفضى ذلك، لما أسميناه في ما بعد، القنبلة اللاتينية الأميركية. ومن بين هذه الكتب، نجد الروايات الخارقة للكاتب البيروفي ماريو بارغاس ليوسا والمكسيكي كارلوس فوينتس والكوبي خوسيه ليزاما ليما والشيلي خوسيه دونوسو الذي كتب، هو نفسه، كتابا حول هذا الموضوع. لقد وضعت هذه القنبلة الواقعية السحرية في المدار الفضائي.
في العام 1970، قمت بكتابة مراجعة نقدية لرواية «مئة عام من العزلة». كانت أول رواية من روايات هذه القنبلة ولم نكن بعد نستعمل هذه الكلمة التي أقرأها. أذكر أنني كتبت بالمناسبة التالي «انه أول عمل أدبي، منذ التكوين، يستحق أن تقرأه البشرية جمعاء». بعد سنتين ذهبت إلى برشلونة كي أجري مقابلة مع غارسيا ماركيز (الملقب بغابو). الذي كان لا يزال مجهولا في الولايات المتحدة بالرغم من شعبية كتابه المتصاعدة. من الظهر وحتى الثانية صباحا، تناقشنا في جميع المواضيع التي تستحق أن تعالج، وببساطة شديدة أصبحنا أصدقاء. لقد رفضت مجلتان أميركيتان كبيرتان المقابلة، حتى أن أحد رئيسي التحرير نصحني بالقول بأن «أدعه يصبح مشهورا قبل نشر المقابلة». على كل، قامت مجلة «أطلانتيك» بنشر مقالتي، معرّفة بذلك، غارسيا ماركيز، للقراء في الولايات المتحدة. خلال حديثنا، لم نشر أبدا إلى كلمة الواقعية السحرية، بل أشار غابو فقط إلى السوريالية قائلا: «في المكسيك، نجد السوريالية في الشارع. إن السوريالية تخرج رأسا من واقع أميركا اللاتينية».
وعلى غرار أعضاء جماعة ماك أوندو الذين يرفضون اليوم الواقعية السحرية، رغبت أنا أيضا، في روايتي الأولى التي صدرت العام 1969 (ومع الروايات اللاحقة)، أن أرفض بعض الذين سبقوني وكانوا في أغلبهم ينتمون إلى المذهب الطبيعي وهم من الكبار من مثل تيودور درايسر وجيمس. تي. فاريل وحتى جون دوس باسوس الذي هو بالنسبة إلي بطل حقيقي. كانوا جميعهم، لا يرون في الكائن إلا رهان القوى الاجتماعية العدوانية الذي لا يمكن تجنبه. اليوم، يحاول كتاب ماك أوندو أن يتمايزوا بدورهم عن هذا النوع، فكما يقول فوغيه إن الكتيبة التي حاولت تقليد ذلك النوع «حولت الكتاب إلى بائعي حكايات خرافية». إن صرخة حربه تكمن في أن «ليس لأميركا اللاتينية أي شيء ساحر». في الواقع لم تكن «مئة عام من العزلة» ساحرة. لقد كانت رواية متفردة، كما أعمال كافكا، معلم «الاستشباح» الكبير، وكما همنغواي، شاعر الاقتضاب الكبير وكما جويس العبقري اللغوي الذين قلّدوا كلهم لدرجة أنهم أصبحوا ضحايا سرقة صافية وبسيطة في السلّم الكوني. بفضلهم، استطعنا أن نقترب من الواقع بطريقة جديدة. وعندما استعملوا أساليبهم، قام حشد المقلدين باختيار أقصر الطرق إلى القراءة. بيد أن أعضاء ماك أوندو لا يرغبون البتة في إيجاد الخيوط إلى ماك أوندو. حسن. من هنا، هل علينا أن نستنتج بأن الواقعية السحرية نفسها ليست خالدة؟ بأنها ماتت؟ حين أجريت المقابلة مع غابو، تحدثنا عن موت الرواية. ختم حديثه بالقول: «عندما نقول بأن الرواية ماتت، فهذا لا يعني أنها هي التي ماتت وإنما أنت».. إذا، عندما يصر أحدهم على القول بأن الواقعية السحرية ماتت، هل علينا أن نشاهد إشارة عن ذلك؟ ربما. برأيي، إن أصر كتاب ماك أوندو مطولا على هذه النقطة، عليهم ولمصلحتهم أن يراقبوا نبضاتهم.
أولاد الأبد/ عباس بيضون
يرحل ماركيز بعد فوانتس. الرواية العالمية تتشلع. من يقرأ كاتباً كماركيز يخيل إليه أن الموت طارئ عليه. أن مثله لا يموت كبقية الناس. من يشيدون هذه العمارات الكبيرة يرفعونها بقوة غير بشرية. سيكون غريباً أن يموتوا كبقية البشر. يقول إنهم خالدون في كتبهم، لكن لا يخلد أحد في كتبه، حتى الكتب نفسها لا شيء يؤكد خلودها. نحن الذين قرأنا «مئة عام من المعركة» و«خريف البطريرك» و«موت معلن» و«ليس للكولونيل من يكاتبه» لن نتلقى نبأ وفاة ماركيز بخفة. علينا أولاً أن نصدق موته، أن نقبل هذا الموت كما نقبل أي حادثة مثله. ليس هذا صعبا فنحن منذ سنوات صدقنا ودأبنا أن نصدق أرقام وفيات متصاعدة. أن ننظر أولاً في الرقم، نقول إن هذا اليوم وافق سقوط مئة أو عشرات أو بضع مئات، يأتي كل يوم بأرقامه. ننظر فيها ونهملها. ننظر فيها وننساها، ننظر فيها ولا نشعر إلا أنها أرقام. إلا أنه كمية معدودة، إلا أنها حساب عددي، إلا أنها فاتورة، وإيصال أو عدد فحسب. ننظر فيه بخوف أول الأمر ثم بارتياح ثم بحيرة، ثم بأسف، ثم باعتياد، ثم بمجرد النظر، قبل أن نبدأ الملل والإهمال والتجاهل. يصل إلينا الرقم ميتاً وقد لا يصل ولا نبحث عنه في الأساس. لقد اعتدنا الموت بل ودرجنا عليه، ليس إلا أنه خبر. نجتهد لنأبه لموت ماركيز، نستجمع أنفسنا ثم لا نأبه في كثير أو قليل. نحن من سنين نموت فحسب، نحن من سنين نعاشر الموت. من سنين نجمع أمواتاً، ثم لم نعد نهتم، ثم لم نعد نحفل. لم يعد الرقم رقماً، صار مختلطاً. لا أحد يعرف العدد. من الذين ماتوا في درعا وإدلب ودير الزور من الذين أخذوا إلى المعتقل، من منهم خرّ على الطريق، من منهم سقط تحت الركن أو على الدواليب أو فوق الآلات، من سيعود ومن سيبقى هناك إلى الأبد. لكن الأبد ليس بعيداً. إنه حاضر هنا، نحن في حضرته الزمن مفتوح عليه، الساعة موصولة به. الجميع منذورون للأبدية والأبدية وحدها أمام الجميع، نحن أولاد الأبد.
هل نقول إننا ارتعنا لموت ماركيز وهل بقي فينا عزم على الارتياع. هل بقيت فينا روح ترتاع أو نفس تختلج أو وجدان ينجرح. هل بقيت فينا طاقة لنرفع هؤلاء الموتى عن صدورنا. لنخرج من بينهم، لنهرب بعيداً عنهم. هل بقيت فينا طاقة على الصمود أمام أكوام القتلى وأكداسهم، هل بقيت لنا قدرة على النظر فعلاً إليهم، على التأمل فيهم، على تحريهم، عد شبانهم وأطفالهم. الأطفال، نعم الأطفال. ألم نشبع من رؤية الأطفال الموتى. ألم نتخم من رؤيتهم مصفوفين على الأرض. لماذا كل هذا العدد من الأطفال الموتى، أين يجدونهم وكيف يستطيعون اصطيادهم. كيف يعصرونهم بين الأيدي ويزهقون ابتساماتهم ولعبهم. كيف يمكن أن نراهم مرتين وثلاثاً وعشراً ومئات المرات بدون أن نخجل من أننا نراهم فحسب. من أننا لا نزال نملك عيوناً لرؤيتهم، من أننا لا نزال أحياء لنراهم. ألا نخجل من أننا مجرد نظارة لهم، مجرد متفرجين ومشاهدين، مجرد جمهور فحسب.
ذنب على ذنب، شعور بالذنب يخف لدى شعور آخر بالذنب. ذنب على ذنب حتى تنتهي المسألة. ذنب يطرد ذنباً آخر. ذنب يطمس ذنباً آخر. ذنب يشل ذنباً آخر. ثم تتكدس الذنوب على بعضها وتغدو جلداً أسود، تغدو مجرد بطالة عاطفية، لا قلب ليتحمل كل هذه الأوزار. لا قلب ليتحمل كل هذه الذنوب. إنه يخر تحت وطأتها. إنه يمَّحي تحتها، يغدو في النهاية محاكياً لها، يغدو مثلها، يصير شيئاً بعد شيء من طينتها، يصبح وقد تكدست عليها، من مادتها، يغدو القلب معتاداً على الذنوب بل يتكون منها. تغدو أليفة له بل يغدو الموت نفسه كامناً فيه، حتى كأنه يموت، حتى كأنه يتقوت من خجله ومن ذنبه. حتى كأنه ما عاد يهتم للجريمة أو يأبه للدم، بل عاد ليكون ضحية غير موصوفة للقتل لقد قتل من الداخل وبات لا يشعر ولا يحس ولا يفكر ولا يدين. لقد صار الواقع بالنسبة له هذه البراميل المتفجرة، هذه الطائرات والطوافات التي تلقي قذائفها على السقوف والرؤوس، بل صار الواقع أيضاً هو الخطف والإعدام والقتل على الهوية والرجم وحز الرؤوس.
لا نعرف عدد من ماتوا ولم يحط بهم عدد. لقد كان الحصاد في السنوات الأربع وفيراً وغير معدود. القتل في كل مكان. وفي كل بقعة حتى يستحيل أن نعرف له حداً. الموتى يفيضون عن كل إحصاء. ثمة طريق إلى الأبدية سالكة ليل نهار. الأبدية والواقع مختلطان متمازجان. الناس تعاشر الموت وتكلمه أكثر مما تفعل مع أي سواه. الموت شريك في الجنة ويغدو شيئاً بعد شيء صنواً لها. نعيش لنموت أو نموت لنعيش، الجملة هي نفسها. لقد صار الربيع العربي حداداً سابقاً. يمكن أن يقال إن هذه خيبته. يمكن أن نتفقد آمالنا ووعودنا، لكن ثورة، أي ثورة، هي أيضاً دمار عظيم هي وحشية ماثلة. الدم الأول لا يترك مجالاً لإنسانية من أي نوع. الدم الأول يستدعي دماً فدماً إلى أن يغدو الدم نهراً. إلى أن تمطر دماً، إلى أن تأكل الناس بعضها بعضاً، إلى أن يغدو اللحم البشري هو المأدبة. الثورة هكذا. زلزلة كاملة زلزلة تنفض الأسس وخلخلة تفكك كل شيء. الثورة هكذا وكانت دائماً هكذا. إنها قتل متبادل أو قتل صرف على الأقل، نقض أسس ونقض بنى ونقض هياكل. كل شيء يرتمي أرضاً ويتحلل ويتندر ويتفكك. المجتمع أولاً ينفك إلى نعرات وضغائن وغرائز. الثورة من يريد الثورة؟ من ينتظرها؟ لكن من يسعه تخطيها، عقود الاستبداد أنضجتها. عقود الاستبداد فجرتها. لكنها تبقى دماً ووحشية وعنفاً. وربما استبداداً أيضاً.
حساء العظم.. رحيق الذاكرة: ” عن غارثيا ماركيز”/ خيري منصور
في صباه اللاتيني شأن العديد من أبناء جيله حلم ‘ماركيز′ بالحياة في باريس، وهي ‘النّداهة’ التي اجتذبت إليها كتابا وفنانين وشعراء من كل القارات، لكن الفتى الكولومبي كان محظوظا، لأنه ظفر بالسكن في غرفة كانت احدى العائلات الفرنسية قد خصصتها لإستضافة كتاب من الشباب، وبالرغم من ذلك كانت حياة امثاله في باريس بالغة القسوة، مما اضطره وبعض اصدقائه الى تداول العظم من اجل وجبات من الحساء، لابد ان آخرها كان مجرد ماء، او اشبه بالحكاية المعروفة في تراثنا عن المرأة التي كانت تخدع اطفالها الجياع بغلي الحصى في الماء.
في تلك الآونة اجتذبت ‘النداهة’ الباريسية مبدعين في مختلف المجالات، وكان العراب الراعي كما يقول همنغواي هو الشاعر ‘ازرا باوند’ الذي لم يبق واحد ممّن استضافهم ورعاهم الا وطعنه في الظهر، وتلك بالطبع حكاية اخرى.
والمهم ان من تناول حساء العظم المستعمل لسدّ الرّمق عاد ليقدم حساءه الروائي الخاص الى الغرب وفي المقدمة منه فرنسا التي سحرتها الرواية المشحونة بالاسطورة والمضمخة بأسرار القارة البكر، ولم يكن اطلاق عنوان مثل رائحة الجوافة على حوارات مبكرة مع ‘ماركيز′ إلا تعبيرا عن ذلك الشغف المفقود، في القارة الداجنة، التي فقدت شبق الحياة وحوافزها في فترة ما بين الحربين، حين بلغت شكوك الأحفاد بما انجزه الأجداد حدا من العدمية التي كانت افرازاتها سلالة من اللامعقول سواء مسرحيا او فنيا، ولعلّ الدادائية وهي كلمة لقيطة لا جذر لها في المعاجم هي التعبير الأدق عن فترة الفراغ الروحي السحيق.
ما اجتذب اوروبا في المنجز الأدبي لأمريكا اللاتينية ليس فقط سحرية الواقع او ما سمي الواقعية السحرية، بل تلك الطّزاجة في تناول التفاصيل اليومية، ثم الإغداق الفنيّ عليها بحيث تجترح معمارا غير مسبوق في الرواية التي عرفت بأنها ملحمة البرجوازية الأوروبية.
وقدر تعلق الظاهرة بماركيز الذي مات مرارا وليس مرتين فقط على غرار ‘كانكان العوام’، فهو عبر الحدود كلها بموهبة من طراز فريد، زاوجت بين العسر واليسر، وبين المألوف والمستهجن، لكن هناك هاجسا لم يفارق الروائي على الاطلاق وهو الخوف من البطالة بمعناها الفكري والروحي وليس بالمعنى الاقتصادي المعروف، تجسد هذا الهاجس في بطالة الكولونيل المتقاعد، وفي خواتيم حيوات لشخوص لم تجد لديها ما تفعله غير ان تموت، وربما لهذا السبب عانى ‘ماركيز′ اكثر من اي مؤلف اخر مما يسمى قتل الأبطال في الادب، ففي احدى رواياته، اطال من فترة احتضار البطل لكنه كان مضطرا لاسباب روائية الى قتله، وحين قتله ارتمى لأكثر من ساعة على السرير وهو يبكي، وهذا يذكرنا بما قاله ناقد انجليزي عن ‘كازنتزاكي’ قال ان ‘كازنتزاكي’ خلق ‘زوربا’ لكنه لم يستطع قتله، وكأن الشخصية هنا تتمرد على المؤلف، ثم تصبح منافسه له في الشهرة، تماما كما هو ‘هاملت’ بالنسبة لـ’شكسبير’، و’جان فالجان’ بالنسبة لـ’فكتور هوغو’، ولعله امر يتجاوز المصادفة انني وجدت في عنوان مذكرات ‘ماركيز′ قبل اسبوع من رحيله احد تجليات ‘شهرزاد’ في الليالي الألف، فهو كما يقول عاش ليروي.
وشرط السرد هنا ان يتحول الواقع المعاش الى الذاكرة كي يعاد انتاجه محررا من شوائبه، لهذا كان من الممكن له ان يقول عشت لأتذكر ثم لأروي، بخلاف ‘نيرودا’ ابن القارة ذاتها الذي قال اشهد انني عشت، حيث لم يكن بصفته شاعرا مضطرا الى اعادة انتاج واقعه كي يقدمه مجروما من العظم او منقى من غبار النهار هذا اضافة الى الحسية المشهودة بوضوح في تجربة ‘نيرودا’.
ما اعتدناه في وداع امثال ماركيز هو طقس الاحتفاء، والتلويع بالورق الابيض بدلا من الكتابة عليه رغم ان مثل هذا الوداع كي يليق بهؤلاء يجب ان يقشر الطلاء الاعلامي الذي يتعامل مع المشاهير بالجملة وبالوصفات النموذجية باتجاه نخاع التجربة، وهذا ما قاله ‘لوركا’ ذات يوم حين اشار الى شكل العمل الادبي، ومضمونه باعتبارهما اللحم والعظم، والمسكوت عنه الأقنوم الثالث الذي يعطي النص نبضه واستمراره وهو النخاع.
*********
لم يجد ماركيز حرجا من ان اي نوع في الكتابة عن كل ظواهر الحياة، بدءا من البغايا حتى القراصنة البريين، وليس انتهاء بالفنانة الكولمبية ‘شاكيرا’، التي ودعته على طريقتها عشية رحيله، وكتب ماركيز تحقيقات صحافية، ولكن باسلوبه وعلى طريقته، منها ما كتبه عن المخرج الذي نفي عن تشيلي ثم عاد اليها متخفيا ومخترقا كل اسوار الديكتاتور بنيوشيه، واطلق على هذا العمل اسم رحلة المخاطر تقمص فيها صديقه الفنان ميغيل ليتين وتحدث بضمير المتكلم، رغم ان معظم ما كتبه كان قد استمع اليه خلال عدة ايام من ميغيل.
لهذا ليس عسيرا على الباحث الحصيف ان يعثر على الأسس والركائز الواقعية للكثير من اعمال ماركيز، تماما كما فعل الناقد فيليب يونع وهو يقرأ اعمال ‘همنجوي’، وتحديدا العجوز والبحر التي قيل انها حكاية صياد اصغى اليها الكاتب وثمة من يقولون انه اشتراها.
ان مجرد سرد قائمة باعمال ماركيز يكفي لتسويد صفحات مقالة احتفالية لكن الابعد من ذلك هو السؤال الاشكالي الذي حوله بعض النقاد الى مساءلة روائية حول ما انجزه ماركيز وبعض زملائه من قيامة ادبية في القارة المنهوبة والتي قفزت برشاقة من الهامش الى المتن، فهم عادوا الى اوروبا من خلال ابداعاتهم فاتحين بعد ان لاذوا بثقافتها كمهاجرين فهل كان هذا بفضل الفائض في واقعهم المضمخ بالاسطورة!.. ام بفضل فائض الموهبة الذي حول الفحم الى ماس، بحيث اصبح ماركيز بالتحديد اشبه بميداس لكنه لا يحول التراب اذا لمسه الى ذهب، بل يحول الحكي الى رواية ذات معمار باذخ.
انها مناسبة ايضا لاستقراء ظاهرة ثقافية عربية هي اننا نقرأ منتج الثقافات الاخرى مصحوبا بالنقد الذي واكبه او اعقبه في تلك الثقافات وكأن هناك اعترافا غير معلن بقصور نقدي ازاء اعمال غير مسموح لنا الا بالاختلاف حول اساليب الاحتفاء بها لهذا عندما عبر طه حسين عن رأيه برواية الغريب لألبير كامو ووجه بالاستهجان رغم انه لم يصل الى الحد الذي عبر عنه ‘تولستوي’ مثلا حول اعمال شكسبير التي قال بأنه لا يستطيع اكمال قراءتها وتكرر الامر مع اخرين منهم الروائي ادوارد الخراط حين كتب عن رباعية الاسكندرية من منظور نقدي مضاد للسائد وكان علينا كعرب ان ننتظر ما كتبه القس اوبراين عن رواية الطاعون لكامو التي اعتبرت رواية مقاومة لاستعمار الجزائر وقد استخدم الكاتب رمز الطاعون للتعبير عن الاحتلال، وما قاله اوبراين هو ان رواية اسماء شخوصها فرنسية وتخلو من اسم عربي واحد هي تعبير عن اللاوعي لدى المؤلف ازاء الحدث الذي كتب عنه، لهذا تسللت جرثومة الطاعون من صفحات الرواية لتصيب المؤلف!.
ان ثقافة تعتاش على الاصداء على حساب صوتها المختنق ومصابة بسايكولوجيا المغلوب انطلاقا من التوصيف المبكر لإبن خلدون عليها ان تتلقى فقط، فاذا كنا في الصناعة نتلقى المصنوع مع قطع غياره ففي الثقافة يحدث ذلك ايضا ونتلقى المنتج الادبي مع النقد الذي كتب عنه بلغته او بلغات اخرى، فالترجمة على ما يبدو مصطلح يتجاوز النصوص ليشمل واقعا بأسره بحيث يصبح واقعا مترجما لكن بتصرف!.
القدس العربي
مخاضات قرن من العزلة/ ادريس الجاي
‘ان الحياة هي ما نتذكر وكيف نتذكر’
غابرييل غارسيا ماركيز، مراسل، كاتب سيناريو، روائي مؤلف احد اعظم الاعمال الروائية فارقنا عن عمر 87 عاما في مدينة مكسيكو وبقي يمثل حالة نادرا ما سنحت ظروفها المتردية بإنجاب عمل ادبي كبير لم يساهم فقط في تحويل كاتبه خلال فترة وجيزة من ظهوره الى رجل غني، بل اعتبر ايضا مجدد الأدب العالمي بقوة الخيال، الشاعرية، النكتة والحس الإيقاعي. لقد انشأ غابرييل غارسيا ماركيز رؤية مذهلة واقعية وسحرية، تجاوز بها ايضا اعجاب النقاد الى افتتان ملايين من الجمهور الواسع.
تجربة العزلة – موضوع الحياة
لقد جاء هو نفسه من خط التماس، ولد الابن البكر من بين احد عشر طفلا في عائلة تلغرافي سنة 1927 في أراكاتكا، واحدة من مزارع الموز المحيطة ببلدة فقيرة قرب الساحل الكولومبي الشمالي . فقد تشكلت حياته من تجربة العزلة، الفردية والأسرية، ولكن أيضا الثقافية والتاريخية، التي ستصبح لاحقا موضوعا مركزيا للحياة. غادر مرتع طفولته منذ سن الثامنة من العمر، موطن ولادته، الذي سيخلق منه لاحقا ماكوندو، المركز الخيالي لكونه الأدبي، هذا المكان، الذي رغم انه متخلى عنه من الله والتاريخ، فهو عالم طافح بذكريات الاعجاب الطفولي، بالخدع الرائعة من حكايات الكاريبي، الاعتقاد في المعجزات والأحداث المثيرة، التي ازدهرت بشكل رائع في المناخ الاستوائي وركود يمكن جعله مطيعا في جو قائظ من الانتظار .
حين بلغ السابعة والثامنة والثلاثين من العمر استيقظ ذات يوم وهو يحمل في داخله قرار التخلي عن كل شيء سبق ان مارسه في حياته من اجل كسب قوته اليومي : العمل في الصحافة ومجال الاعلان . لم يكن يملك غير خياله وخمسة الاف دولار، التي كان قد ادخر جزءا منها عن طريق عمله والجزء الاخر حصل عليه بكيفية او بأخرى. ولاجل خلق اجواء كتابة ممكنة وضع مدخره المالي هذا في يد زوجته مرسيدس كنفقة مقدمة لستة اشهر، فترة اتمام كتابة رواية.
مثل ممسوس بالجنون بدأ يكتب روايته الكبيرة، ‘مئة عام من العزلة’، قمة اعماله الادبية، التي منحته لاحقا لقب غابو، الذي كان ربما أجمل تقدير لهذا المؤلف الحائز على الجوائز واجمل الألقاب الفخرية المتميزة. انه صوت الأدب العالمي في أمريكا اللاتينية، رمز الواقعية السحرية، كما يصفه البعض، الكاتب الأكثر شعبية منذ سرفانتس في عالم اللغة الإسبانية، بينما البعض الاخر يراه: ‘أعظم منهم جميعا’. ويتمدد الموعد المضروب ليصبح بدل الستة اشهر اربعة عشر شهرا دون ان تسعفه الكلمات حتى يضع النقطة الاخيرة خلف الحرف الاخير من عالم قرن من العزلة .
كتاب مثل الانعناق
ظهور رواية ‘مائة عام من العزلة’ سنة 1967، زامنت السنة التي فشل فيها إرنستو تشي غيفارا في بوليفيا فشلا ذريعا، وامكن قراءتها على أنها رفض لاي ثوري اجتماعي أوتوبي . لان غارسيا ماركيز، اليساري وصديق فيدل كاسترو، يروي قصة صعود وانهيار ماكوندو كمهزلة تاريخية اسطورية، التي تٌكرر فيها قبيلة بوينديا في عزلة الغاب وبلا كلل كافة الأخطاء، التي يتحدث عنها الكتاب المقدس وكتب التاريخ، هروبا من قدرهم، الذي سطرت خطوطه أنفا. ومع ذلك ليس هناك من طريق مخرج من ‘المدينة المرآة أو (الانعكاسات )’. تدور القصة في شكل دائري، ترمز الى ذيل خنزير مجعد، الذي ولد به كنتيجة لأنشطة علاقات زنى المحارم المتواصلة دون انقطاع آخر بويندي .
ان ما كان يشد الانتباه في حياة غارسيا ماركيز هو ذلك الثراء في العلاقات وربطه جملة من الصداقات مع اهم كتاب امريكا اللاتينية مثل كاريوس فوينتيس وماريا فارغاس يوسا وخوان رولفو، الذين اكتشف جميعهم وباحساس جد مبكر مواهبه الجبارة المتدفقة والمتنامية في شخصه، الذي كثيرا ما كان يوصف بالخجول. غير ان لقب غابو لاحقا كان أكثر من تعبيرعن المحبة والتقدير للروائي اسطوري مبجل، استطاع نيل اعجاب الجمهور العريض، حيث سحرغابرييل غارسيا ماركيز بموهبته الثرة المحتالة، كل الاحتمالات والصعاب، لجعل اللعبة تبدو سهلة ويصبح التحرر من أصعب الحالات حيلة أنيقة.
لقد كان الانتظار ملازما لمخاضات رواية مئة عام من العزلة حيث لم تصمد الخمسة الاف دولار في وجه زحف الايام وتراكم الشهور، وحين نفد المال لم ينفد صبر الكاتب ولا انتظار مرسيدس، التي عبأت كل طاقاتها لمقاومة هذا الزحف اليومي المتنافخ . تارة بالاستغناء عن اللوازم الحياتية واخرى برهن الممتلكات المنزلية حتى يبقى زورق الاسرة بمن فيه الكاتب الزوج وولداها، طافيا فوق سطح بحر تتفاقم فيه امواج مشاكل ابحار متأخر بما يزيد عن ستة اشهر وحيث ديون الجزار، البقال وبائع الخضر تملأ الدفاتر والكل ينتظر.
الانتظار العاجز
عند غارسيا ماركيز هناك دائما شخص ما في انتظار، وكيف يمكن أن تهمل الحياة، فقد سرده في كثير من الطرق المختلفة: في ‘ليس للعقيد من يكاتبه’ (1961 ) يأمل جندي قديم عبثا لمدة 56 سنة في الحصول على تقاعده. انه منسي مثل عدد كبير من شخصيات غارسيا ماركيز ، وحتى المشهورين ‘ 51 سنة، تسعة أشهر وأربعة أيام’، يربط بذلك فلورنتينو أريزا الحفاظ على عشق امرأة حياته في تدفق نهاية سعيدة. هكذا فقط، من اجل المضي في عزلة الحب الرومانسي، الذي يجعل الزوجين المسنين مجذومين ‘الحب في زمن الكوليرا’، (1985). عجز الانتظار يرافق مختالا عبث المعاملة كما جاء في مئة عام من العزلة : ‘السيد العقيد أوريليانو بوينديا يحرض اثنين وثلاثين من مسلحي الانتفاضة ويخسرهم جميعا. كان لديه من سبع عشرة امرأة مختلفة، سبعة عشر من الابناء المختلفين، الذين أبيدوا واحدا تلو الآخر في ليلة واحدة … ‘، في هذه الموازنة الشحيحة لحياة فيما يبدو جد نشيطة يتقلص الوضع الكئيب لأمريكا اللاتينية في جملة، يسمع وقعها وكأنها مزحة.
حين وضع غارسيا ماركيز النقطة الاخيرة وراء الحرف الاخير من الرواية واراد ارسالها الى الناشر في بيونس آيرس لم يكن لديه كفاية من المال لبعث الرواية بكاملها . فقد اكتفى اضطرارا الى ارسال عشرة اجزاء منها فقط . وحتى يمكن توفير المبلغ المتبقي لارسال الاجزاء الفاضلة، جمعت مرسيدس اخر ما بقي لديها من الممتلكات بما فيها مجفف شعرها وراحت تبحث عن راهن جديد.
كان للكتاب وقع مثل التحرر. فيما لا يبدو انه حقق سياسيا نجاحا، فقد فتن بشكل مذهل الملايين من خلال بساطة واقعية سحرية الطالعة من قمة خيال: لتحويل كآبة الخمول بعد قرون من الاستغلال والاضطهاد في جزء من العالم المنهك الى حيوية من الشاعرية الحسية المشحونة . فحتى وان كان غارسيا ماركيز قد استعمل على حافة الكاريكاتور وصف البوينديا على انهم ضيقا الافق كفحولة محدودة، غير انه منحهم في نفس الوقت قوة اعادة كرامة التعامل من اجل تقرير المصير، واعار احتجاجهم ضد الفشل
تراجيديا كوميدية كبيرة .
يبقى الراوي واقعيا
كان مركيز مشدودا قبل كل شيء وبشكل جلي الى الحضور القوي لجده نيكولاس ريكاردو ماركيز ميخا، الذي كان يأخذه في صحبته وهو طفل الى السيرك والكنيسة واهم من ذلك الى السينما. فقد عين نيكولاس ماركيز قائدا عاما لقوات حرب الالف يوم (1899-1902) كما خلف عددا كبيرا من الابناء غير الشرعيين، الذين عمل غابرييل غارسيا مركيز فيما بعد على ربط علاقاته بهم باحثا علنا عن نماذج عامة لرواية كبيرة تخدم اسطورة القائد بوينديا. إن تعلق غارسيا ماركيز بهذه الشخصيات الواقعية حقق للرواية نجاحا في جميع أنحاء العالم . حتى وان كان البعض يفضل الصور الفنية الغنية للتيارات اللغوية في ‘خريف البطريرك’ 1975، فإن ‘مائة عام من العزلة’ تشكل قمة قائمة اعماله الرائعة، وقد بدا مؤلفها ولا سيما بالنسبة للنقاد الاوروبيين، كمجدد للادب: كاتب كولومبي من زاوية مجهولة من منطقة الكاريبي، الذي ينفجر بسرد حيوي، أقنع المتعبين من مديري الحداثة، حيث يعثر عليه في أماثيل بداية الروائع. وقدم نفسه خلال ذلك على أنه ليس من السذاجة الغرائبية، وإنما كواحد، قد قرأ من الجانب الآخر من العالم، تاريخ الأدب مرة أخرى، ليشكل من منظور معاكس سرده الكبير .
لم يكن الاعجاب بغارسيا ماركيز خاليا من الانعكاسات الرومانسية الغرائبية، الأوهام والنكتة الجنونية المطلقة لقوة الخيال، وحين اعلن، بعد جائزة نوبل 1982 في ذروة شهرته، عن رواية عن المناضل الامريكي الجنوبي من اجل الحرية سيمون بوليفار، اعتبر كأقوى صوت من شبه القارة. لكن غارسيا ماركيز قام باحياء مقاومة أي إغراء، عبر شخصية تاريخية، التي تمثل رؤية قديمة لتحرر موحد لامريكا اللاتينية جديد، فحتى بلفار ايضا، ‘الجنرال في متاهته’ 1989 لم يجد أي مخرج. مع كل اللطافة وحتى الاعجاب بالأحلام، التي يقاسمها غابرييل غارسيا ماركيز مع شخصياته، يبقى مع ذلك كراو ودائما واقعيا، الذي تعلم من مهنته كمراسل صحافي والذي كتب ذات مرة، إن الحياة هي ‘ما نتذكر وكيف نتذكر، لنحكي عنه’، قد عرف، أنه مهما كانت الرؤية جميلة يمكنها أن تتنافس مع سحر الذاكرة: ‘في يوم من ايام اكتوبر الممطرة قصد اورليانو بوينيديا الكستناء وتذكر السيرك. وبينما هو يتبول حاول ان يجهد ذهنه بالتذكر لكنه لم يعد يجد اي أثر لهذه الذكرى عالقا بذاكرته. مثل فرخ خبأ رأسه بين كتفيه، الصق جبهته بجذع الشجرة وبقي واقفا دون حراك’.
بعد ان كتب غارسيا ماركيز هذه السطور على الورق، صعد الى غرفة نومه حيث كانت زوجته مرسيدس تقيل فأخبرها بموت القائد بعدها استلقى بجانبها وبكى ساعتين من الزمن.





